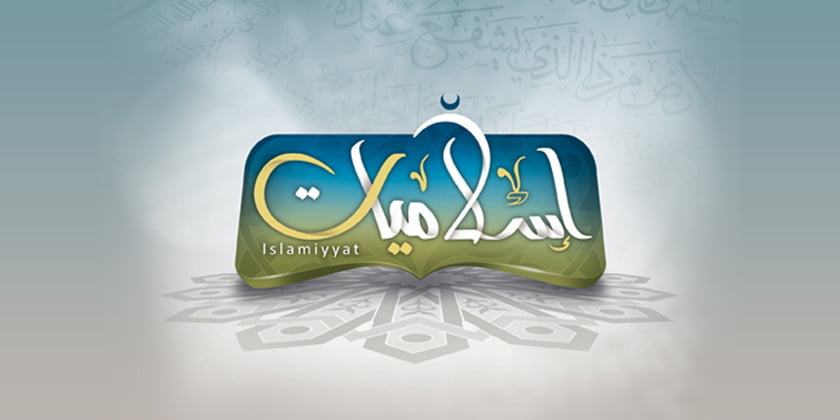الحلقة 212
إجابة على أسئلة المشاهدين
المقدم: في سورة النساء في ميراث الكلالة، وردت الكلالة مرتين في السورة (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (176)) وفي الثانية (وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ) فما الفرق بين الآيتين (ليس له ولد) و (لم يكن لها ولد)؟
د. فاضل: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. آية الكلالة (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ) وأيضاً (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ (11) النساء). لماذا قال (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ). (ليس) لا يمكن أن تقع بعد أداة الشرط
المقدم: (ليس) لا تقع بعد أداة الشرط؟
د. فاضل: إن ليس؟!
المقدم: لا.
د. فاضل: الجامد لا يقع بعد أداة الشرط (نعم وبئس) لا يقع. فإذن (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ) لا يصح فيها (ليس) أصلاً، هذا تعبير، إذن لا يصلح أن يوضع واحد مكان الآخر. تبقى ليس له ولد ولم يكن له ولد. (ليس) الغالب في دلالتها نفي الحال
المقدم: يعني آنية
د. فاضل: (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (177) البقرة) يعني لم يكن لكم البر؟ لا، الحال، هذا حكم عام. (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ (198) البقرة) الحال، (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ (128) آل عمران)، (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ (10) النساء) قد تكون للمستقبل أحياناً
المقدم: تكون للحال والمستقبل وليس للماضي
د. فاضل: (أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ (8) هود) مستقبل. (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ) في الأصل هذا ماضي، (ليس له ولد) هذا حال أو استقبال. لكن إذا وقعت بعد أداة الشرط (إن لم يكن له ولد) يقولون وقوعها بعد أداة الشرط يصرفها للاستقبال (إن زرتني أكرمتك). فإذن (ليس له ولد) لا يمكن أن تقع بعد (إن) ولا بد أن تكون (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ) هذا التعبير عندما وقعت بعد (إن) ذهب منها معنى المضي فإذن لا بد أن تكون هكذا.
المقدم: الدلالة بالفعل مختلفة تعبّر عن مراحل زمنية مختلفة.
سؤال: يقول الحق في سورة الرعد الآية الأخيرة (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43)) من الذي عنده علم الكتاب؟
د. فاضل: من أسلم من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام، أبي بن كعب هؤلاء عندهم علم الكتاب
المقدم: (من) مفرد أم مثنى أم جمع؟
د. فاضل: عامة، من أسلم.
المقدم: لا تحدد شخصاً معيناً.
د. فاضل: لا، هي عامة.
سؤال: استفسار في الآية 90 في سورة النساء (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90)) لماذا تكررت بهذه الصيغة اعتزلوكم، لم يقاتلوكم، ألقوا إليكم السلم، لماذا التأكيد؟ لم يقل مثلاً اعتزلوكم فلم يقاتلوكم؟
د. فاضل: (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ) يعني كفوا أيديهم لم يتعرضوا لكم.
المقدم: اعتزلوكم يعني لم يتعرضوا لكم
د. فاضل: لكن (وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ) معناها الصُلح يعني استسلموا.
المقدم: هي من السِلم؟ سِلم وسَلم
د. فاضل: من السِلم. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً (208) البقرة) يقولون السلم الإسلام و (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ (35) محمد) السلام في الحرب.
المقدم: هنا (وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ) يعني الصلح، استسلموا لكم واصطلحوا معكم
د. فاضل: نعم، الصلح
سؤال: في سورة البروج يقول سبحانه وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10)) ما دلالة إضافة الحريق على العذاب؟
د. فاضل: هو قال (فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ) لكنه ما اكتفى
المقدم: ما اكتفى فلماذا عذاب الحريق؟ (فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)
د. فاضل: الحريق يكون بالنار
المقدم: وجهنم نار
د. فاضل: جهنم ليست ناراً وحدها جهنم عذاب كثير. لكن ذكر عذاب الحريق لأنهم حرقوا المؤمنين.
المقدم: جهنم هنا ماذا؟
د. فاضل: عامة، جهنم فيها أنواع كثيرة من العذاب يا ستار يا رب (إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) المدثر) لا تعرف ما فيها من أشياء
المقدم: لكن النار إسم يطلق على الدركات، أليست هي أبواب؟
د. فاضل: نعم، كل صنف له باب
المقدم: هناك سقر وهناك الهاوية والحطمة ولظى وجهنم
د. فاضل: يقولون جهنم عامة
المقدم: يعني جهنم إسم للنار عامة وليست إسماً لدركة معينة؟
د. فاضل: هكذا يقولون جهنم عامة.
المقدم: يقال جهنم لعصاة المؤمنين
د. فاضل: هذه أسماء وضعها ربنا سبحانه وتعالى، جهنم عامة ولها أبواب (إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ) و(كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى (16) المعارج) هي دركات يا ستّار يا رب. لكن ذكر عذاب الحريق لأن هؤلاء أحرقوا المؤمنين بالنار
المقدم: لكنه قال (فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ)
د. فاضل: لا ليس هذا كافياً جهنم فيها أنواع من العذاب فيها الزمهرير فيها أنواع كثيرة
المقدم: إذن نفهم أن عذاب جهنم غير كافي (فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)
د. فاضل: نعم هذا تخصيص آخر، هنالك عذاب ينالهم في جهنم وإضافة إلى ذلك يحرّقون بالنار كما حرّقوا المؤمنين بالنار
المقدم: (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10))
د. فاضل: إقرأها (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾) هم حرّقوهم ورموهم في النار فربنا أيضاً يحرّقهم بالنار كما حرقوا المؤمنين بالنار، الجزاء من جنس العمل
المقدم: يا لطيف! سلِّم يا رب!
د. فاضل: لما ذكر التحريق ذكر عذاب الحريق
المقدم: إضافة إلى عذاب جهنم، هذا العذاب لا يلغي عذاب جهنم هذا مضاف إليه
د. فاضل: نعم الحريق مضاف إلى عذاب جهنم. عذاب جهنم دركات كثيرة وأنواع كلٌ بحسب العمل والجزاء من جنس العمل
المقدم: فكما أنهم حرّقوا يُحرّقوا (وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) هل هناك دراسة لصور العذاب في القرآن الكريم؟ ما رأيكم أن نقوم باستقصاء هذه الأمور في لمسات بيانية ونفرق بين صور النعيم ونفرق بين صور العذاب دلالياً من حيث الألفاظ؟
د. فاضل: أظن هناك رسالة في الجزاء في القرآن الكريم
المقدم: واضح بالفعل أن مسألة العذاب مع الحريق تحتاج لوقفة كبيرة. سبحان الله العظيم!
د. فاضل: ربنا قال (لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ (6) الغاشية) (وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (13) المزمل)
المقدم: صور كثيرة! لا إله إلا الله! مع آيات العذاب يقشعر بدني ولا أقوى كثيراً على الكلام، يهرب مني الكلام، اللهم اصرفنا عن عذاب جهنم
د. فاضل: اللهم آمين. (رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) الفرقان)
سؤال: في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قدّم قوم فرعون مرة (قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122) آل عمران) ومرة (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70) طه) ما دلالة التقديم والتأخير؟
د. فاضل: التقديم والتأخير ذكرنا سابقاً أنه بحسب المقام.
المقدم: هم قالوا ماذا؟ (رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) أو (آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى)؟
د. فاضل: الواو لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً
المقدم: من حيث اللغة. إذا قلنا دخل محمد وعليّ لا أفهم أن عليّ دخل بعد محمد؟
د. فاضل: لا،
المقدم: وإذا أردت أن أٌفهِم أن علياً دخل بعد محمد؟
د. فاضل: تستعمل الفاء
المقدم: دخل محمد فعليّ
د. فاضل: طبعاً.
المقدم: دخل محمد وعليّ تعني أن الاثنين دخلا أيهما قبل؟ مع بعضهما؟
د. فاضل: (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) الشورى). إذن هذا متعلق بالمقام. الآن نأتي إلى طه التي قدّم فيها هارون على موسى، نلاحظ أنه في سورة طه تردد ذكر هارون كثيراً في هذه القصة، من بداية (وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (29)) الرسالة كانت عامة (اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43)) كانت عامة وكان الجواب منهما (قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى (45)) قال (قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46)) إذن الكلام مبني على التثنية ثم قال (فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (47)) الكلام كله مبني على التثنية (قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى (49)) (قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ (63)) موسى وهارون، (يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (63)). في الشعراء ورد ذكر هارون قليل (فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13)) (قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ (15)) ثم الخطاب كله مع موسى، كلام موسى مع فرعون واحد لواحد (قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29)) (قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34)) في طه قال (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ). النقاش مع موسى (قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27)) إذن هذه ملاحظة عامة أولاً. في طه كان هارون مشاركاً، في الشعراء ورد ذكره مرتين ثم الكلام مع موسى. هذا أمر، الأمر الآخر أنه في طه ذكر أن موسى أوجس في نفسه خيفة ولم يذكر هذا في هارون، لم يذكر شيئاً (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى (67) طه) الآن في سورة طه ذكر أن هارون مشترك مع موسى بالرسالة والتبليغ ولم يخف ما ذكر أنه خائف، في الشعراء ذكر هارون قليلاً وذكر الحجاج مع موسى وأن موسى هو الساحر إذن الموقف ليس واحداً. وعلى هذا لا نضع التعبيران في موضع واحد، أحدهما خاف والآخر لم يخف أيهما نقدم؟
المقدم: كما ورد هكذا.
د. فاضل: إضافة إلى ملاحظة أخرى، في سورة طه تبدأ السورة بـ (طه) فيها حرف من حروف هارون (الهاء) ليس فيها حرف من حروف موسى وفي الشعراء تبدأ (طسم) فيها حرف من حروف موسى وليس فيها من حروف هارون، هذا كملاحظة عامة
المقدم: قد يتساءل سائل هم ماذا قالوا بالضبط؟ (رب موسى وهارون) أم (رب هارون وموسى)؟ أم قالوا الاثنين
د. فاضل: محتمل لكن عندما لا تفيد تعقيباً فأي شيء قالوه هو قول واحد، يعني ليس هناك اختلاف في الدلالة
المقدم: ليس عليها حكم معلق، هم قالوا ما قالوه لكن يبقى الاختيار بحسب اختلاف الحالة والموقف الذي فيه.
سؤال: قال إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء (الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81)) نلاحظ ضمير الحصر مع الخلق (فَهُوَ يَهْدِينِ) ومع المرض (فَهُوَ يَشْفِينِ) ليس غيره وبالنسبة للإطعام والسقي (هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) إلا مع الإماتة (يُمِيتُنِي) لم يقل والذي هو يميتني مع أن الموت حصراً لله فلماذا لم يحصر بالضمير؟
د. فاضل: (الَّذِي خَلَقَنِي) مجمعين على أن ربنا خالق ليس فيها شك لكن مختلفين في الإطعام والإسقاء هل هو الذي يُطعم ويسقي؟ قد يسقي ويطعم غيره، أنت تشتغل وقد يطعمك ويسقيك آخر.
المقدم: لكن الأرزاق بيد الله عز وجل
د. فاضل: الأرزاق بيد الله عامة، لكن عموم الناس. (الَّذِي خَلَقَنِي) حتى الكافر يقول خلقني الله لكن الإطعام والسقاية يقول أنت تشتغل قد يطعمك ويسقيك آخر، ليست كما خلقك الله. الخلقة من الله لكن الإطعام والسقاية قد تنسب إلى غيره، ممكن.
المقدم: إذا ذكرت (هو) ماذا تعني؟
د. فاضل: توكيد معناه هو بالذات
المقدم: توكيد يعني هو الذي يقوم بالفعل هذا، الذي خلقني فهو يهديني
د. فاضل: فهو يهديني لا أحد يهدي غير الله، هذه ليس فيها شيء
المقدم: لا أحد يهدي غير الله سبحانه وتعالى
المقدم: (وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ)
د. فاضل: الحقيقة هو وإن كنت ترى أن غيره قد يطعمك ويسقيك لكنه في الحقيقة هو
المقدم: (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)
د. فاضل: ليس الدواء وحده أو الطبيب. ما ليس فيه شك لا يقول (هو) لكن التي فيه شك يقول (هو)
المقدم: ما ليس فيه شك لا يقول هو إنما يقول (يميتني، يحييني، خلقني) والذي فيه شك مع الطعام والشراب والشفاء يقول (هو) ولذلك يأتي بـ(هو) للتوكيد
د. فاضل: للتوكيد والتخصيص أيضاً
المقدم: هل نقول في العربية من هو مؤلف الكتاب؟ أم نقول من مؤلف الكتاب؟
د. فاضل: من مؤلف الكتاب؟ هي اللغة الأعلى.
سؤال: (قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50)) فرد فرعون (قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) طه) هل نستطيع أن نقول هنا في الآية توقف موسى عن الكلام لأنه بعدها قال (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53)). كيف نعرف أن النبي توقف كلامه هنا؟ وهل نستطيع أن نقول أن موسى هو الذي رد على فرعون (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا) متى نعرف أن النبي هنا توقف وبعدها يتكلم الوحي؟
د. فاضل: قسم يقول نعم والباقي هو من كلام الله سبحانه وتعالى. وقسم يجعلها (وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء) و (فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى (53)) هذا كلام الله تعالى. قسم يرى أن عند قول (فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى) انتهى كلام موسى لكن ربنا الذي قال (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى)
المقدم: حضرتك تميل إلى أيّ القسمين؟
د. فاضل: هي تحتمل، لكن يمكن (فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53)) (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55)) والباقي يستمر على الإسناد للمتكلم
المقدم: لله سبحانه وتعالى
سؤال: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ (20) الحديد) لماذا ذكر في الأموال ولم يقل بالأموال؟
د. فاضل: (في) ظرفية والباء للإلصاق وقد تكون ظرفية أحياناً. التكاثر بالأموال يعني بما عنده، تكاثر في الأموال ينفق وقته في الحصول عليها، يتكاثر في الحصول عليها. أما الباء فبما عنده. ربنا يقول (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (274) البقرة) يعني في هذين الوقتين فقط. نحن نقول ينفق المال في الليالي الحمراء يعني يُذهب المال فيها، يصرفها فيها، تكون ظرفاً لصرف الأموال.
المقدم: وينفق بـ؟
د. فاضل: بهذين الوقتين.
المقدم: ينفقها في هذين الوقتين لأشياء حددها الله أما هذا فينفقها في الليالي نفسها
د. فاضل: يُذهبها في الليلة نفسها، يذهبها في هذا الأمر
المقدم: عجيب! ينفق بالليل والنهار جعل الليل والنهار زمناً لإنفاق الأموال في مصادر أخرى وينفق في جعل الليل ظرفاً تذهب فيه الأموال. وهنا (وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ)؟
د. فاضل: ينفق وقته في الحصول عليها، التكاثر ينفق الوقت في الحصول على المال.
المقدم: الدلالة مختلفة تماماً، تكاثر في غير تكاثر بـ يعني يزهو بها.
سؤال: قرأت على الانترنت أن أحد الإخوة يدّعي أن الآية القرآنية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) النور) وهو يدعي أنها تستأذنوا وليس تستأنسوا فما رأي الدكتور فاضل في هذا؟
د. فاضل: ليس هنالك قراءة متواترة ولا من القراءات الأربع العشر، في المعنى قد يكون تستأذنوا لكن لم يرد في قراءة من القراءات المتواترة ليس فيها تستأذنوا.
المقدم: إذن الآية تستأنسوا.
——–فاصل——-
المقدم: عودٌ على ما كنا نتحدث عنه قبل الفاصل أود أن نقف على الاستئناس (حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) هل معناها الطرق والاستئذان؟
د. فاضل: الإستئناس عكس الاستيحاش والوحشة يعني أن تختار الوقت المناسب للزيارة، تفكر هل هذا الوقت مناسب. مثلاً أنت تأتي الناس وتتوقع أنهم نائمين فهل تستأذن عليهم؟
المقدم: لا، هذا وقت غير مناسب
د. فاضل: أو طلاب عندهم امتحان فتذهب تستأذن؟ هذا ليس استئناساً حتى لو استأذنت هذا ليس استئناساً
المقدم: إذن هناك فرق بين الاستئذان والاستئناس؟
د. فاضل: الاستئناس هو اختيار الوقت المناسب مما لا يدعو إلى الوحشة بحيث يستأنسون بك وتستأنس بهم
المقدم: (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) (حتى) معناها الغاية؟
د. فاضل: طبعاً. أن هذا هو الوقت المناسب.
المقدم: ولو عندهم مشكلة معينة لا يحسن أن أذهب إليهم.
د. فاضل: تستأنس ثم تستأذن
المقدم: إذن الاستئناس قبل الاستئذان
د. فاضل: نعم. تختار الوقت المناسب للزيارة مما لا يدعو إلى الاستيحاش من قِبَلهم. حتى أنت لا ترتاح
المقدم: إذا كان الجو غير مناسب. كان قديماً يدخل الرجل هكذا ويقول دخلت كما كنا نقرأ ولهذا هناك استئذان واستئناس لا ينبغي أن تدخل البيوت هكذا.
سؤال: ذكر في آية أخرى (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ (60) المؤمنون) هناك من يقول ما أتوا وليس ما آتوا وكذلك يدعي أنه استند على ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الجزء 11 صفحة 7، فما رأي الدكتور في هذا الإدّعاء
د. فاضل: ليست هناك قراءة متواترة ولا من القراءات الأربع عشر، لكن يمكن قراءة تنسب إلى عائشة لكنها ليست قراءة متواترة.
المقدم: هل الفعلين أتى وآتوا بنفس الدلالة؟
د. فاضل: لا، آتوا أعظم. أتوا جاؤوا دلالة مختلفة تماماً.
سؤال: في سورة البينة (رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3)) صحف مطهرة فيها كتب قيمة هل هي إشارة عن القرآن الكريم ولماذا هي بهذه الصيغة؟
د. فاضل: نعم المقصود بها القرآن الكريم
سؤال: في سورة المائدة الآية 17 (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17)) (إن أراد أن يهلك المسيح) وكأنه يتكلم عن الماضي؟
د. فاضل: الفعل دخلت عليه أداة الشرط، أراد فعل ماضي إذا دخلت عليه أداة الشرط يُصرف للاستقبال.
المقدم: هذا من حيث اللغة. أراد ماضي، إن أراد استقبال.
د. فاضل: إن زرتني أكرمتك
المقدم: تجرّده من الدلالة الماضوية؟
د. فاضل: نعم عند النحاة تجرده، وقسم من النحاة يجعل لها شروطاً إذا دخلت على (كان) إن كان فعل، لكن عند الجمهور تجرّده وتخلّصه للإستقبال.
سؤال: في سورة المؤمنون الآية 31 و42 (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ (31)) (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آَخَرِينَ (42)) استعمال آخرين مع قرون ومع قرناً أليس المفروض أن يقال قرناً آخر؟
د. فاضل: القرن أهل زمان واحد
المقدم: أليس القرن مائة سنة؟
د. فاضل: هذا من المعاني.
المقدم: القرن أهل زمان واحد. يعني أنا وأنت في قرن واحد
د. فاضل: نعم، قال في قوم نوح (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ (31)) أمة آخرى، جماعة آخرين، (َأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ (32)) قرن أمة، قالوا عاد أو ثمود بعدها. ثم قال بعد ذلك (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آَخَرِينَ (42)) يعني أمم ثم قال (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا (44)) في الأولى قال رسول لأنها أمة وقال قرناً ولما قال قرون قال رسلنا، ثم (ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (45)) لما ذكر قروناً ذكر رسلنا ولما ذكر قرناً ذكر رسول
المقدم: (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا) تترا بمعنى متتابعة؟
د. فاضل: نعم
المقدم: تترا هذا فعل؟
د. فاضل: لا، إسم من وتر هذه التاء مبدلة من الواو أصلها وترا، متواترين
المقدم: أصلها وتراً إسم وليست فعلاً، إذن تترا إيم وليس فعل، هذه من الأخطاء الشائعة التي نستعملها.
سؤال: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا (229) البقرة) و(تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا (187) البقرة) ما سبب الاختلاف بين تعتدوها وتقربوها معها كلها حدود الله.
د. فاضل: إذا ذكر محرّمات يقول (لا تقربوها) (وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (187) البقرة)، وإذا ذكر أمور الحلال ينبغي أن لا تعتدي.
المقدم: ما الفرق بين تقربوها وتعتدوها؟
د. فاضل: المحرمات حرام لا ينبغي أن تقربوها، أما الحلال فهل تخرج منها إلى المحرمات؟
المقدم: لا تعتدوها يعني لا تجاوزوها إلى المحرمات.
د. فاضل: إذا ذكر محرمات مثل الخمر لا ينبغي أن تقربها، أما في الأمور الحلال فلا ينبغي أن تتجاوزها.
المقدم: إذن فلا تقربوها للمحرّمات ولا تعتدوها للحلال
د. فاضل: نعم للأمور الحلال لا ينبغي أن تُتجاوز، الأحكام التي ذكرها في الحلال (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا (229) البقرة). إذا ذكر الحرام (وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (187) البقرة) هذا حرام، هذه لا تقربها (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا) وفي الحلال (لا تعتدوها). في سياق المحّرمات ينبغي أن لا تقرب وفي الحلال لا ينبغي أن تُعتدى
المقدم: لا ينبغي أن تتجاوزها إلى غيرها.
سؤال: (أزواج مطهرة) لما أتت مطهّرة بالمفرد مع أن أزواج جمع؟
د. فاضل: جماعة أزواج مطهرة، المقصود جماعة وليست واحدة.
سؤال: يقول تعالى (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) الواقعة) وفي آخر السورة (وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92)) ما هو السر في التقديم والتأخير في الآيتين؟
د. فاضل: في تقديم الضالين ذكر قبلها أصحاب الشمال والسياق في أصحاب الشمال (وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41)) هؤلاء ضالين ثم ذكر تكذيبهم هؤلاء (وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47)) إذن هم ضالون مكذّبون، ضالّون (وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ) فناسب تقديم الضالين على المكذبين. في آخر السورة السياق في التكذيب (أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)) السياق في التكذيب لأن الإدهان هو التكذيب والغشّ
المقدم: فقدم التكذيب على الضلال
د. فاضل: (أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)) الكلام في التكذيب. فإذن لما كان الكلام أول مرة في الضلال والضالين ثم ذكر التكذيب قدّم الضالين. ولما كان الكلام في التكذيب قدّم المكذبين.
سؤال: (لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) الواقعة) باللام (لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70)) بدون اللام؟ فهل يمكن توضيح هذه الأمور
د. فاضل: هذا في الحرث (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾) اللام للتوكيد، اللام الواقعة في جواب (لو) إذن إحداهما آكد من الأخرى
المقدم: لماذا أكد الزرع ولم يؤكد الماء؟
د. فاضل: قال في الزرع (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا) لا تستفيد منه ولا تأكله وما أنفقته عليه ذهب هباءً، الماء لو جعله أجاجاً الأجاج يمكن تحليته يعني يمكن أن تستفيد منه. إذن أيُّ العقوبة أكبر؟
المقدم: الحطام. فأكّد مع الزرع (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾)
د. فاضل: (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾) كلها حطام ليس فيه فائدة أما الماء ففيه فائدة لأنه يمكن أن يُحلّى
المقدم: وكأنه يؤكد سبحانه وتعالى أنه قادر أن يضعهم في الحرمان وفي هذه الغرامة
د. فاضل: فوضع اللام حيث العقوبة أشد. لما ذكر النار (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾) لم يقل (لو نشاء) لأن الإنسان يمكن أن يعيش بلا نار لكن لا يمكن أن يعيش بلا طعام ولا ماء. إذن لم يؤكد
المقدم: لما كانت الخسارة في الزرع أكّد ولما كانت الخسارة في الماء لم يؤكِّد
سؤال: في الحجر (نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{49} وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ{50} وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْراَهِيمَ{51} إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلاماً قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ{52} قَالُواْ لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ{53} قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ{54} قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ{55} قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ{56} قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ{57} قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ{58} إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ{59} إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ{60} فَلَمَّا جَاء آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ{61} قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ{62} قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ{63} وَأَتَيْنَاكَ بَالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ{64}) لماذا في أول السورة الملائكة سلّمت على سيدنا إبراهيم ثم لم يرد السلام واستغرب وقال إنا منكم وجلون رغم أنهم بشروه ثم زاد سؤالاً آخر (فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ) إستغرب لمجيئهم بهذه الطريقة. وفي لوط نفس الأمر لكن لم يسلموا عليه وأخبروه بأنهم جاؤوا بعذاب على قومه فأريد بياناً لهذه الآيات.
د. فاضل: هم جاؤوا بالعذاب وليس بالسلام فكيف يسلمون عليه؟! (قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ) جاؤوا بالعذاب وليس بالسلام فكيف يسلموا عليه؟!
المقدم: أما مع سيدنا إبراهيم فالموقف مختلف
د. فاضل: سلام وتبشير بغلام تالمهمة مختلفة والمقام مختلف، هؤلاء جاؤوا بالعذاب فكيف يسلمون عليه؟!.
المقدم: ما معنى الوجل؟
د. فاضل: الوجل هو الفزع والخوف مع حصول القشعريرة في الجسد.
المقدم: فزع وخوف مع حصول قشعريرة، هذا وجل.
د. فاضل: قالوا مثل السعفة التي تحترق، كاحتراق السعفة
المقدم: هذا وجل، إرتعاش. (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ (60) المؤمنون) فيها نفس الدلالة؟
د. فاضل: في القرآن ما عدا قصة إبراهيم (قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (52) الحجر) الخوف من الله لم يرد الوجل إلا للقلوب فقط (وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (2) الأنفال)
المقدم: هذا من خصوصية القرآن أو اللغة؟
د. فاضل: خصوصية الاستعمال القرآني (قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ)
المقدم: لماذا تعجب من مجيئ الملائكة
د. فاضل: لا يعلم المهمة التي جاؤوا من أجلها.
المقدم: هل كان الملائكة يتجسدون؟
د. فاضل: نعم
سؤال: في سورة آل عمران (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133)) وفي سورة الحديد (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21)) فما اللمسة البيانية بين سارعوا وسابقوا وبين عرضها السموات والأرض وكعرض السماء؟
د. فاضل: المسألة ليست متعلقة فقط في هذين الفعلين. نحن في أكثر مناسبة أشرنا إلى أن السماء لأن سياق الآية يوضح الفرق (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)) تلك (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ) اختلاف في السياق.
المقدم: فيها أكثر من اختلاف، سارعوا – سابقوا، كعرض السماء والأرض – عرضها السموات والأرض، للمتقين – للذين آمنوا بالله ورسله
د. فاضل: السياق هو الذي يحدد اختيار اللفظة. نحن قلنا في أكثر من مناسبة فرقنا بين السماء والسموات وقلنا أن السماء قد تطلق على واحدة السموات السبع وقد تطلق على ما علاك.
المقدم: كل ما علاك فأظلك فهو سماء
د. فاضل: ليس بالضرورة ما أظلّك، هي كل ما علاك هو سماء (أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاء (79) النحل)، السحاب يسميه سماء (وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء (53) طه) باعتبار أن السحاب في السماء يعني في الجو.
المقدم: ويقول (وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) الذاريات)
د. فاضل: فيما قدّره الله، (كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء (125) الأنعام) هذه عامة، (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء (15) الحج) السقف يسمى سماء السماء تكون لكل ما علاك، الطير مسخرات في السماء، السحاب سماء، يصعد في جو السماء والسقف سماء والسموات سماء، أيُّ الأوسع السماء أو السموات؟
المقدم: السماء
د. فاضل: لأنها تشمل السماء وأكثر الأشياء، إذن اتسعت. عندما اتسعت قال (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ) لكنه قال (كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ) هذه الكاف للتشبيه
المقدم: مع سابقوا قال (كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ)
د. فاضل: لأن الكاف للتشبيه، معناها هي عرضها السموات والأرض لكن كعرضها لأن عرضها كبير لأنها تشمل أشياء كثيرة، فجاء بأداة التشبيه لأنها أقل من ذلك (عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ) لكن (كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ) تشمل كل شيء.
المقدم: لما أقول جنة عرضها السموات والأرض أو كعرض
د. فاضل: كعرض يعني الكاف للتشبيه، والمشبّه دون المشبّه به
المقدم: هنا المشبّه هو الجنة والمشبه به هو العرض
د. فاضل: هذا عرض كبير كعرض السماء والأرض فجاء بالتشبيه لأن هذه أوسع.
المقدم: مع سارعوا قال (عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ) إذن هذه جنة وتلك جنة؟
د. فاضل: الجنة هكذا شبهها لم تختلف قال (كعرض)
المقدم: أنا أفهم أن هذه جنة وهذه جنة أخرى منفصلة
د. فاضل: ليس بالضرورة، (كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ) عندما صار العرض واسعاً جداً شمل هذه وزيادة فجاء بكاف التشبيه، هذه أكبر
المقدم: (كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ) أكبر من (عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ) لأن السماء أكبر من السموات تشمل السموات وزيادة
د. فاضل: وزيادة إذن هذه أوسع إذن هذه الجنة التي ذكرها الآن أعرض، أكبر. إذن عندنا مكان أوسع وأكبر من الآخر. أيّ الأكثر المتقين أو الذين آمنوا بالله ورسله؟
المقدم: الذين آمنوا بالله ورسله
د. فاضل: أين يضعهم؟ في ما هو أقل أو فيما هو أوسع؟
المقدم: فيما هو أوسع
د. فاضل: (كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ) وضعهم في ما هو أوسع
المقدم: لأنهم أكثر
د. فاضل: أولئك متقين وينفقون في السراء والضراء فقط. لما ذكر العدد الأقل ذكر المكان الذي يناسبهم. لم يقل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإنما قال فقط الذين آمنوا بالله ورسله، إذن العدد مناسب.
المقدم: والعمل نفسه مناسب.
د. فاضل: نأتي إلى سارعوا وسابقوا المسابقة هي المسارعة وزيادة،
المقدم: في السباق مسارعة
د. فاضل: مسارعة ولكن ليس مسابقة تسرع إلى شيء ليس كما تسابق أحداً
المقدم: المسابقة مسارعة وزيادة.
د. فاضل: تريد أن تسبق. الخلق لما كانوا كثيرين يحتاجون إلى مسابقة يعني مسارعة وزيادة. قال سابقوا وهي المسارعة وزيادة وقال جنة عرضها كعرض السماء والسماء هي السموات وزيادة وقال الذين آمنوا بالله ورسله وهم المتقون وزيادة، لم يقل وعملوا الصالحات
المقدم: ولكنه قال (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134))
د. فاضل: هذه كلها تحديد لهم صاروا أقلّ كلما يذكر صفة يصبحوا أقل.
المقدم: إذن سارعوا فيها تقييد، سابقوا فيها إطلاق، فيها زيادة
د. فاضل: مسابقة وزيادة، وكعرض السماء فيها السموات وزيادة، والذين آمنوا بالله ورسله فيها المتقين وزيادة. أيّ الفضل أكثر؟ لما يُدخل ربنا المؤمنين أو المتقين؟
المقدم: المؤمنين
د. فاضل: قال (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء) لما اتسعت الدائرة ولما تفضل على المؤمنين وأدخلهم الجنة قال (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء) زاد هنا فضل الله ولم يذكره في الآية الأخرى
المقدم: بهذا المنطق تكون سارعوا في مكانها وسابقوا في مكانها حتى لا ينفع أن نبدّل واحدة مكان الأخرى.
د. فاضل: ولا ينفع أن تضع كعرض مكان عرض، كل واحدة في مكانها.
سؤال: في سورة آل عمران (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (96)) الآية الوحيد التي وردت فيها كلمة بكة في حين باقي السور والآيات وردت كلمة مكة فما السبب في ورود كلمة بكة في الآية تحديداً؟
د. فاضل: بكة من أسماء مكة. مكة وبكة.
المقدم: الإسمان على نفس البقعة الجغرافية؟
د. فاضل: نعم. في القرآن وردت مرة مكة ومرة بكة (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ (24) الفتح) وهنا قال (لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا) البكّ من الزحام. فعل بكّ يبُكّ يعني ازدحم. بك ذكرها في سياق الحج (إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (97)) هذا يصير فيه ازدحام يبك الناس بعضهم بعضاً،
المقدم: وكأنه مكان وضع البيت
د. فاضل: هو في البيت، يزدحمون فيه وقت الحج إذن قال (ببكة) يعني في مكان ازدحام الناس فجاء ببكة مناسبة لذكر الحج بينما في الآية الثانية ليس فيها ازدحام فقال مكة.
المقدم: أم نفهم أن بكة مكان البيت تحديداً، الحرم، المكان الذي يُحجّ إليه أما مكة عموم البلدة.
د. فاضل: هم يذكرون أشياء ولكنها كلها تأتي للمناسبة لما ذكر الحج ذكر بكّة
المقدم: صحيح، ومدار الكلام فيها على الازدحام جمعنا الله وإياكم في الحج د. فاضل.
بُثّت الحلقة بتاريخ 31/12/2009م
من قسم الفيديو
http://www.islamiyyat.com/video.html?task=videodirectlink&id=2055
الرابط علي الارشيف
http://www.archive.org/details/lamasat311209
رابط جودة عالية
http://ia341313.us.archive.org/1/items/lamasat311209/lamsat311209_chunk_11.AVI
رابط جودة متوسطة
http://ia341313.us.archive.org/1/items/lamasat311209/lamsat311209_chunk_11.rmvb
mp4 رابط
http://ia341313.us.archive.org/1/items/lamasat311209/lamsat311209_chunk_11_512kb.mp4
فيديو جودة موبايل
http://ia341313.us.archive.org/1/items/lamasat311209/lamsat311209_chunk_11.3gp
رابط صوت
http://ia341313.us.archive.org/1/items/lamasat311209/lamsat311209_chunk_11.mp3
2010-01-01 12:29:55الدكتور فاضل السامرائي>برنامج لمسات بيانيةpost