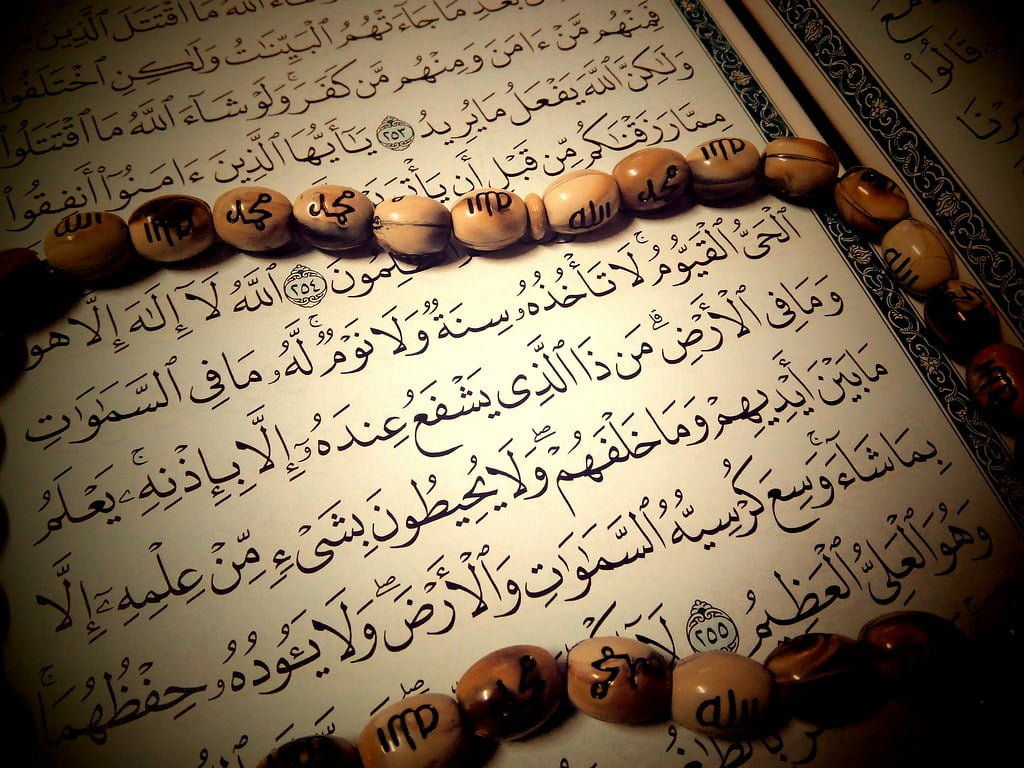سورة الأعراف من أطول السور المكية وهي أول سورة عرضت بالتفصيل قصص الأنبياء من بداية خلق آدم إلى نهاية الخلق مروراً بنوح، هود، صالح، لوط، شعيب، موسى عليهم وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام. والسورة تجسد الصراع الدائم بين الحق والباطل وكيف أن الباطل يؤدي إلى الفساد في الأرض، وفي قصص كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة تظهر لنا الصراع بين الخير والشر وبيان كيد إبليس لآدم وذريته لذا وجه الله تعالى أربعة نداءات متتالية لأبناء آدم بـ (يا بني آدم) ليحذرهم من عدوهم الذي وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في المخالفة لأمر الله تعالى. كما تعرضت السورة الكريمة إلى أصناف البشر فهم على مرّ العصور ثلاثة أصناف: المؤمنون الطائعون، العصاة ، والسلبيون الذين هم مقتنعون لكنهم لا ينفذون إما بدافع الخجل أو اللامبالاة وعدم الاكتراث. والسلبية هي من أهم المشاكل التي تواجه الفرد والمجتمع والأمة. وجاءت الآية لتحذرنا أنه علينا أن نحسم مواقفنا في هذه الحياة ونكون من المؤمنين الناجين يوم القيامة ولا نكون كأصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم وينتظرون أن يحكم الله فيهم.
وسميت السورة (الأعراف) لورود ذكر اسم الأعراف فيها, وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهما, وروى جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله تعالى فيهم.
· وقد بدأت السورة بمعجزة القرآن الكريم على الرسول r وأن هذا القرآن نعمة من الله تعالى على الإنسانية جمعاء فعليهم أن يتمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته ليفوزوا بسعادة الدارين ويكونوا من الناجين يوم القيامة ومن أهل الجنة. (كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ* اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ) آية 2 -3
· النموذج الأول من صراع الحق والباطل: قصة آدم مع إبليس ويبين لنا تعالى في هذه القصة كما في باقي السورة كيف أن الحق ينتصر في النهاية على الباطل. وقد جاءت كلمة (فدلاهما بغرور) (فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ) آية 22 في وصف إغواء الشيطان لآدم لتبين لنا معنا كيف أن الذين لا يحسمون أمورهم ومواقفهم كأنهم معلقين في البئر لا هم هالكون ولا هم ناجون مما يؤكد على أن علينا أن نحدد موقفنا من الصراع بين الحق والباطل. فسبحانه تعالى ما أبلغ هذا القرآن وما أحكم وصفه وألفاظه.
· عرض يوم القيامة وقصة أصحاب الأعراف: (الآيات 44 -51) تذكر الآيات قصة أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم وبقوا على الأعراف ينتظرون حكم الله تعالى فيهم. والأعراف قنطرة عالية على شكل عرف بين الجنة والنار والمكث عليها مؤقت لأن في الآخرة الناس إما في النار أو في الجنة. وأصحاب الأعراف كانوا يعرفون الحق والباطل لكنهم لم يحسموا أمرهم فحبسوا بين الجنة والنار حتى يقضي الله تعالى فيهم: (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) آية 46. فعلينا أن لا نضع أنفسنا في هذا الموقف ونعمل جاهدين على أن نكون من أهل الجنة حتى لا نقف هذا الموقف على الأعراف.
· عرض نماذج من صراع الحق والباطل عبر قصص الأنبياء على مر العصور: عرضت الآيات قصة كل نبي مع قومه والصراع بين الخير والشر وكيف أن الله تعالى ينجي نبيه ومن اتبعه على عدوهم. قصة نوح مع قومه (فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ) آية 64، قصة هود (فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ) آية 72، قصة صالح (آية 73 – 79)، قصة لوط (فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ) آية 83 ، قصة شعيب (قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ) آية 88.
· مقارنة بين الحسم والتردد في قصة موسى وفرعون والسحرة: الآيات توضح كيف حسم السحرة موقفهم من نبي الله موسى بعدما رأوا الحق وأخذوا موقفاً واضحاً من فرعون وأتباعه وآمنوا بالله تعالى وبما جاء به موسى (لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ* قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ * وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ) الآيات 124 – 125- 126، وتردد بني اسرائيل باتباع موسى (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ* قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (الآيات 128 – 129) وهذه عبرة لنا بأن التردد لا يؤدي إلى الحق والجنة.
· قصة أهل السبت: وكيف تحايلوا على الله تعالى لأنهم لم يحسموا مواقفهم بالتسليم الكلي لله وتطبيق ما يعتقدونه عملياً حتى يكونوا من الفائزين، لكنهم كانوا يعتقدون شيئاً ويمارسون شيئاً آخر. (واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) آية 163
· فئات بني إسرائيل: عرضت السورة فئات بني إسرائيل الثلاثة، فهم إما: عصاة، أو مؤمنون ينهون عن المعاصي، وإما متفرجون سلبيون وهذه الفئات موجودة في كل المجتمعات. السلبيون قالوا (وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا) آية 164 والمؤمنون ردوا (قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) آية 164. وقد ذكر الله تعالى لنا كيف نجّى الفئة المؤمنة وعاقب الفئة العاصية كما في قصة أصحاب الأعراف (فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ) آية 165، ولم يذكر هنا مصير الفئة السلبية، بعض العلماء يقولون أنهم مع الفئة الضالة الظالمة لأنهم لم ينهوا عن السوء والبعض الآخر يرى أنهم سكتوا عن الحق والله تعالى سيحسم وضعهم يوم القيامة لذا لم يرد ذكرهم في السورة والله أعلم.
إذن بعد هذا العرض للسورة نستنتج أنه علينا الابتعاد عن السلبية وعلينا أن نحسم مواقفنا من الآن لأننا تريد أن ندخل الجنة بإذن الله ولا نريد أن نكون مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وعلينا أن لا يثنينا عن نصرة الحق لا خجل ولا عدم مبالاة أو قلة اكتراث ولا ضعف. ولعل الغفلة هي من أهم أسباب التردد والسلبية فعلينا أن نسعى أن لا نكون من الغافلين لأن الغافل قد يكون أسوأ من العاصي، فالعاصي قد يتوب كما فعل سحرة فرعون أما الغافل فقد يتمادى في غفلته إلى حين لا ينفع معه الندم ولا العودة. (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) آية 179.
وتأتي ختام السورة لتركز على البعد عن الغفلة وحسم الأمر (وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ) آية 205
والسجدة في الآية الأخيرة كأنما جاءت لتزيد في النفس الاستعداد للحسم فربما بهذه السجدة يصحى الغافل من غفلته ويحسم السلبي موقفه إذا عرف بين يدي من يسجد فيعود إلى الحق (إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ) آية 206. وقد ختمت السورة بإثبات التوحيد كما بدأت به وفي هذا دعوة إلى الإيمان بوحدانية الله تعالى في البدء والختام. وهذه السورة مرتبطة بسورة الأنعام لأن الابتعاد عن السلبية وحسم الموقف هو من توحيد الله تعالى في المعتقد والتطبيق أيضاً.
في الأعراف بدأت بقوله تعالى: (المص (1) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2)) وقال في خاتمتها: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)) الكتاب الذي أنزل هو القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كتاب أنزل إليك فاستمعوا له وأنصتوا، هذا تناسب.
سؤال: ماذا يفيد التناسب؟ ليس كما يظن البعض أن القرآن جاء هكذا من دون منهج ومن دون ارتباط والقدامى ذكروا تناسب الآيات والسور وقالوا هو كالكلمة الواحدة في تناسبه، ذكروا تناسب الآيات والسور يعني تناسب السورة مع السورة التي قبلها وخاتمتها وما بعدها، هذا أمر مقصود لذاته. الذي نستفيده من هذا التناسب أن القرآن ليس كلاماً من دون رابط كما يظن البعض وليس بينها علاقة أو رابط وكنا نقرأ هذا الشيء أن القرآن ليس بينه ارتباط وقد سمعنا أنه يأتي بموعظة من هنا وموعظة من هناك، والتناسب حجة تلزمهم.
قال تعالى في أواخر الأنعام: (وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155)) (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161)) هذه خواتيم الأنعام، وآخرها (وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ) في أول الأعراف (كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (3)) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فاتبعوه في الأعراف، هذا مترابط. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فاتبعوه، هذا مترابط. ثم في خاتمة الأنعام قال (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (165)) وفي بداية الأعراف (وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ (4)) أولاً هو الذي جعلكم خلائف الأرض بعد من مضى من قبلكم وكم من قرية أهلكناها معناها جعلكم بعدها خلائف، إن ربك سريع العقاب فجاءها باسنا بياتاً هذه عقوبة إذن صار ارتباط في أكثر من موضع بين سورتي الأنعام والأعراف.
قال تعالى في أواخر الأعراف: (وَإِذَا قُرِئ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ (205)) وفي بداية الأنفال قال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)) كأنما تأتي بعد آية الأعراف كأنها امتداد لها، هذا ترابط وكأنها مكملة لما ينبغي أن يكون عليه الحال. وفي آخر الأعراف قال (إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206)) وفي الأنفال (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3)) الملائكة يسجدون في الملأ الأعلى وهؤلاء يقيمون الصلاة في الأرض.
كلما عايشت القرآن أكثر كلما فُتح عليك بمعاني ومبادئ قرآنية تتحرك في الكون من خلالها.
سورة الأنعام السابقة كانت بداية السور المكية ووسورة الأعراف أيضاً سورة مكية بعد شوط من السور المدنية البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مليئة بالأحكام. سورة الأنعام وقفنا مع معاني تعظيم الله عز وجل وهذا التنزيه الذي امتلأت به السورة والتسبيح، هذه السورة الطويلة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة في موكب رباني جميل من الملائكة سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح.
سورة الأعراف ترسخ معنى آخر وهو معنى الاختيار ويظهر من اسمها، الأعراف موقف ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ) أول مرة تذكر هذه الكلمة في القرآن (الأعراف). من أهل الأعراف؟ أهل الأعراف هم أناس لم يحسنوا الاختيار، ناس لم يكونوا كفار ولم يختاروا السيء الذي فيه الفجور والفحش والبعد عن الله عز وجل ولم يكونوا أيضاً طائعين لله عز وجل ولهم أعمال صالحة تسارع بهم إلى الجنة، إنما هم أُناس في الوسط على الأعراف بين الجنة والنار، بين المؤمنين والكفار ينظرون إلى أهل الجنة ويطمعون أن يدخلوها. هذا الموقف يلخص معنى من أم معاني سورة الأعراف، هو ليس المعنى الوحيد في السورة لأن معاني القرآن لا تنضب ولكن نركز على معنى الاختيار، ثلاثة أصناف من البشر أساسية:
1. صنف اختار الجنة عرف طريقه واختار طاعة الله عز وجل سبيله واضح لا يجد حرج في نفسه منه كما ذكرت بداية السورة (كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ) عرف طريقه، يريد الجنة ويعمل لأجلها.
2. وصنف آخر اختار الطريق الآخر كإبليس اختار الفجور والإسراف على النفس والكفر بالله عز وجل
3. وصنف غافل ومعنى الغفلة يتكرر في سورة الأعراف كثيراً.
هذا المعنى – معنى الاختيار – هو من أهم الوقفات التي سنقف عندها في السورة، ماذا اخترت؟ أهل الأعرف الذين سميت السورة باسمهم وقفوا في الوسط لم يعرفوا إلى أين يذهبون (لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46)) (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ (46)) يعرفون الصنفين بسيماهم لأنهم كانوا يختلطون معهم في الدنيا ( وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) يطمعوا أن يدخلوا الجنة (وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47)) يخافون من هذا المكان، يخافون أن يدخلوا النار! (وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48)) كانوا يرددون في الدنيا أنهم أصحاب المال والمنصب (أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ) ينتقل الكلام إلى أهل الجنة (ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ) بعدما تكلموا مع أهل النار نظروا لأهل الجنة وقالوا (ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ) أنتم الفائزون اليوم بعد أن كنا نقسم أنكم لن ينالكم الله برحمة! (وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾).
التوجيه الرئيسي والأساسي في سورة الأعراف الذي نريد أن نقف معه هو الذي يظهر في هذه الآية في السورة (كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ) لا تتردد ولا تفكر كثيراً بل اختر أن تتبع هذا الكتاب (لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ) دعوة للاختيار (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ) السورة تدعوك أن تختار، (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾) سورة الأعراف تقول ( يَا بَنِي آَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾)، سورة الأعراف تقول لك لا يكفي أن تكون صالحاً وإنما يجب أن تكون مؤمناً مصلحاً لك إيجابية، لك وجود وبذل لهذا الدين ولهذا تأتي الآية في السورة (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾) التمسك بالكتاب وإقامة الصلاة هذا صلاح، تمسك بطاعة الله عز وجل وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى (يمسّكون) وليس يمسكون وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يعني شديد التمسك بكتاب الله، وقيل يمسّكون غيرهم. وأقاموا الصلاة ليس فقط أداء الصلاة وإنما يقيمونها (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) لا يكفي أن تكون صالحاً وإنما يجب أن تكون مصلحاً ولهذا ذكرت السورة قصة شعيب عليه السلام (إِنْ أُرِيدُ إِلَّاالْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ (8) هود) يريد أن يصلح ويغير، اختار طريقه ومشى فيه وبذل فيه ولم يقف في الوسط.
للأسف أناس كثيرون لا يدركون خطورة أهل الأعراف. أذكر موقفاً في الجامعة كان أحد الأساتذة لا يحب الطلبة المتدينين المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاستهزأ يوماً وقال أنا أرضى أن أكون من أهل الأعراف. فاستغربت جداً، هل يعي هذا معنى أهل الأعراف؟! هل يعرف قدر يوم القيامة (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) المعارج) من يستطيع أن يقف في الوسط خمسين ألف سنة، أو ألف سنة أو سنة؟! وهو يسمع أن فلاناً بن فلان سيسعد سعادة لن يشقى بعدها أبداً ويسمع أن فلاناً بن فلان شقي شقاء لن يسعد بعده أبداً، وهو ينتظر أن يسمع اسمه، عذاب الانتار وعذاب عدم معرفة المصير هل سيكون في الجنة أم سيكون في النار والعياذ بالله! (لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) وقوفه يوم القيامة في الوسط على الأعراف لأنه في الدنيا كان في الوسط أيضاً، كان بين بين (مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ (143) النساء) صفة من صفات المنافقين، يعرف أهل الحق الذين كانوا يدعونه إلى الهدى (كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا (71) الأنعام) لكنه لم يختر أن يكون معهم ويعرف أيضاً أهل الباطل لكنه لم يختر لنفسه فسيتعذب عذاب الانتظار والتربص مع من سيكون؟!!!
سورة الأعراف مليئة بالقصص بعضها مفصّل كقصة أصحاب السبت التي ذكرت في سورة البقرة مجملة، وقصة المنتكس الرجل الذي أوتي آيات الله عز وجل فانسلخ منها ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾) واختار أن يكون مع الكفار والفجار بعد أن جاءته الآيات. سورة الأعراف سورة مليئة بالاختيارات. وفي قصصها نجد فيها ثلاث أنواع من البشر النوع الذي اختار أن يكون من الفجار والنوع الذي اختار طريق الحق وأن يكون من المؤمنين ونوع وقف في الوسط. وبعض القصص يذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة من اختار وعرف طريقه ومشى فيه وسلكه.
سورة الأعراف سورة مليئة بالقصص قال تعالى (تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾).
النوع الأول: أكثر الناس الفاسقون، أهل النار الذين اختاروا خطأ (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ﴿٤٠﴾) لا يفتّح، فيه معنى الطرد والإهانة (وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) مستحيل دخولهم الجنة (وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ). ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قائد هذا الصنف قائد المجرمين من خلال ذكر قصة إبليس في السورة وتفاصيلها وبداية ضلال إبليس وبداية اختياره.
سورة الأعراف فيها ثلاثة أنواع من القصص، ثلاثة أنواع من البشر نوع اختار طريق الشر ونوع اختار طريق الحق وطريق الخير صراط الله المستقيم وسار فيه وكان من المصلحين وممن يأخذون بأيدي الناس الذين يهدون بالحق وبه يعدلون ونوع ثالث مذبذب يقف في الوسط وهو النوع الذي سميت السورة باسمه موقف الأعراف.
قصة إبليس قائد النوع الأول وإمامهم، إمام المجرمين عليه من الله ما يستحق. قصته قصة انتكاس وسوء اختيار. إبليس كان يعبد الله مع الملائكة ولم يكن منهم وإنما هو من الجنّ وكان يعرف الله عز وجل وهو يختلف في هذه النقطة عن الملحدين لأنه لا ينكر وجود الله فهو يعلم أن هناك إله ويعلم أن لله سبحانه وتعالى عزّة يقسم بها (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) ص) ويعرف أن الله عز وجل حقّ لكن قضيته قضية تكبّر وبدأت قصته قصة انتكاس كما سيأتي أيضاً في قصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها. إبليس كان يعرف الله عز وجل لكنه اختار اختياراً خاطئاً، أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم فلم يسجد إبليس (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾) المؤمن الحق لا يتكبر “لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر” (قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾) لماذا أنظرني؟ ليكون له همّة في الباطل، اختياره في الفجور اختيار إيجابي لدرجة أنه سيقود جموعاً كبيرة أن تكون معه في نفس مصيره، اختار وتمادى في اختياره وعلت همّته وعزيمته في الباطل (قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾) يقسم، (ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾) يتوعد الجنس البشري أنه سيحاصره حصاراً كاملاً لأنه يريد أن ينتقم، له همة وعزيمة في الباطل فقال الله سبحانه وتعالى (قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾) الذي سيسير على نهجك ويسير في طريقك (لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ) وسنجد في قصص الأنبياء التي في السورة أن هناك قوم اتبعوا إبليس ومشوا على خطاه. سيدنا آدم عصى ولكن معصيته كانت زللاً خطأ نسياناً لكن لم يكن فيها من الكبر الذي أظهره إبليس ولذلك كل أمة من التي اتبعت طريق إبليس لا بد أن تجد فيها الكبر والاستكبار على طاعة الله عز وجل والامتثال لأمره، قال قوم نوح (قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾) قوم عاد ( قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾) (فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾) ثمود قمة الفجور قتلوا آية من آيات الله عز وجل وهي الناقة (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آَمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾) فجور! وقوم لوط فجورهم أكبر (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾) ابتكروا في الباطل! (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ) لماذا؟ (إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾) اختاروا النجاسة وأخرجوا آل لوط لأنهم يتطهرون وكذلك أهل الباطل لا يطيقون الطهارة ولا يطيقون الأطهار. وهكذا أهل مدين قوم شعيب (وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾) ويهددوا أهل الحق ( قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ) استكبروا أن يأخذوا طريق الحق (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾) كذلك قصة فرعون (قَالَ فِرْعَوْنُ آَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾) قصص كثيرة جداً منها قصة أصحاب السبت وفيهم أنواع ثلاثة، منهم الذين اعتدوا في السبت، الله سبحانه وتعالى طلب منهم أمراً ألا يصطادوا في يوم السبت، أمر واحد فتحايلوا ووضعوا الشباك يوم الجمعة كأنهم لم يصطادوا يوم السبت! وكذلك قصة الذي انسلخ عن آيات الله وقيل أنه بلعام بن باعوراء قيل أنه كان لديه اسم الله الأعظم، ذكر الله عز وجل قصته وهذه كلها آثار (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا) كان اختياره جيداً (فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾) الانسلاخ قد يكون تدريجياً يتدرج في تقليل أعمال الطاعات والخير ويتهاون في المعاصي حتى يحصل الانسلاخ الكامل وفي هذا فائدة أن آيات الله عز وجل كالجلد على اللحم، علاقتك بآيات الله لا بد أن تكون مثل علاقة الجلد باللحم لا يمكن أن ينسلخ عنه (فَانْسَلَخَ مِنْهَا) عدوه ينتظره (فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) تغير اسمه فبعد أن كان عالماً صار من الغاوين (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا) هذا الكتاب يرفع الله تعالى به أقواماً ويضع آخرين (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾)
النوع الثاني المذبذب، أهل الأعراف، الذي لم يختر اختياراً واضحاً وطريق واضح وسار فيه. أهل الأعراف وبنو إسرائيل نموذج واضح لهذا النوع. بنو إسرائيل اختاروا فيما بعد لكن في الوقت الذي ذكرت فيه قصتهم في هذه السورة تجد كلامهم مع موسى عليه السلام غريباً يقول لهم موسى عليه السلام نبيهم الذين رأوا الآيات التي معه (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾) فردوا عليه (قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا) قال (قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾) يروا آية أخرى (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾) بعدما رأوا الآيات يريدون إلهاً!! (وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾) إلى آخر الآيات. وفي قصة أصحاب السبت تجد أمراً غريباً: نوع لم يصطاد ولم يدع الذين ينهون عن المنكر ينهون عنه (وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا) إذا لم تأمر أنت بالمعروف ولم تعظ دع الذين يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾). النوع الذي في الوسط أو الغافلين يتكرر كثيراً في السورة ويتكرر ذكر الغفلة (الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾) (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾) (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴿١٧٩﴾) من هم؟ (أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ).
النوع الأخير هو النوع الذي ندعوا الله عو أن نكون منهم وهم أصحاب الجنة. (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾) اللعنة على الكافرين لأنهم اختاروا طريق الباطل أما أهل الجنة فاختاروا طريق الحق.
نجد في كل قصة من قصص سورة الأعراف أناساً اختاروا طريق الحق واتبعوا أنبياءهم من بداية قصة آدم عليه السلام الذي زلّ زلة لكنه اختار التوبة بسرعة (قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾) ليس كإبليس الذي اختار أن يزداد في الجحود أما أهل الإيمان فيرجعون بسرعة لأنه ليس لهم سبيل إلا سبيل الله عز وجل. سيدنا نوح أنجاه الله ومن معه في الفلك (فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾)، هود عليه السلام (فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾)، صالح (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾) صالح ومن معه، لوط (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾)، شعيب (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ) إصرار على الحق وثبات (بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾) واختيار السحرة رغم تهديد فرعون لهم (قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِآَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾) قوم موسى منهم أمة اختاروا طريق الحق (وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾) وفي قصة أصحاب السبت لما نهوا عن المنكر نجت هذه الطائفة (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾)
سورة الأعراف تطلب منك أن تكون مصلحاً وليس صالحاً فقط، اختر طريقك وامش فيه إلى الآخر وخذ الكتاب بقوة فالذي ينجح في النهاية هم الذين سلكوا مع الأنبياء طريقاً أو الذين نهوا عن السوء (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾) ولم يذكر مصير الناس المذبذبين في الوسط في هذه القصة قال العلماء إما أنهم عُذبوا مع من عُذّب وإما لأنهم حقروا أنفسهم ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر احتقرهم الله عز وجل ولم يذكر أين ذهبوا بعد ذلك.
في سورة الأعراف توجيهات كثيرة توجيهات إيجابية (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾) (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾) حق وثبات عليه وسير في طريقه (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾) لو ساروا في طريق الحق لأتتهم البركات (إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾)
ثم تختم السورة بالنهي عن الاستكبار الذي هو سبب في سلوك طريق الباطل (إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) سورة الأعراف تقول لك اختر طريقاً واضحاً طريق أهل الجنة ولا تكن من أهل الأعراف المذبذبين ولا من الفجار الفاسقين الذين اختاروا طريق الباطل بل اختر طريق الحق وطريق الصواب وسر عليه وكن من الذين قال الله عز وجل فيهم (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾)
سورة الأنعام ترتقي بالعقلية المسلمة في مواجهة العقلية الجاهلية وسورة الأعراف تطبيق عملي من خلال القصص القرآني.
سورة الأعراف رسالة الله عزوجل إلى البشرية عبر تاريخها من أول خلق آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وتبين كيف حادت الأمم عن رسالة الله وصدّت دعوة رسله.
وقد تكرر في السورة لفظ رسالة ومشتقاتها بشكل لافت جدا.
والسورة على طولها تبين أن أسباب الصدود عن رسالة الله للبشرية:
الاستكبار (تكرر لفظ الاستكبار كثيرا في السورة)
واتباع الشهوات
وهذا السببان نجدهما في كل قصص السورة وهما سبب كل صدّ عن الحق في كل زمان ومكان.
وتجلى السببان في قصة أول صدّ عن قبول رسالة الله تعالى في رفض إبليس السجود لآدم استكبارا (أنا خير منه) وصدّ آدم وذريته عن اتباع رسالة الله تعالى من خلال تزيينه للشهوات وتحريك نوازع النفس البشرية لحب الشهوات..
ونحن بحاجة أن نجاهد أنفسنا ضد الاستكبار لأنه ببساطة لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر
ونجاهد أنفسنا ضد اتباع الشهوات بالتقوى (ولباس التقوى ذلك خير)
(قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) الأنعام)
ختام سورة الأنعام خارطة طريق العبد الذي يرجو لقاء ربه ويرجو جنته تدبروا كل حرف فيها ففيه الحياة في سبيل الله والقلوب تتلهف لنهاية الطريق المستقيم: لقاء الله وجنته.
هذا والله أعلم
#رمضان_١٤٤٢
#وقفات_قرآنية
#الجزء_٩
تستوقفني كثيرا الإطالة في قصة موسى في سورة الأعراف ثم اقرأ آية العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم في عالم الذر (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ (172) الأعراف) فأفهم الرسالة:
يا أمة الإسلام أوفوا بعهدكم مع الله ولا تكونوا كبني إسرائيل الذين نقضوا العهود عهدا بعد عهد، أنجاهم الله من فرعون وجنوده أمام أعينهم وما أن جاوزوا البحر طلبوا إلها يعبدونه!!!
كم موقفا أنجانا الله تعالى منه ثم عدنا بعده مباشرة إلى اللهو واللعب والغفلة؟!
أما ختام السورة فأراها والله أعلم تحذير آخر من نقض العهد مع القرآن؛ القرآن بين أيدينا نقرؤه ليل نهار لكن هل استمعنا له حقا؟ هل أنصتنا له حقا؟! لو أننا فعلنا لما كان حالنا على ما هو عليه الآن!
القرآن عزيز وفيه عزتنا وشرفنا وذكرنا وحياة قلوبنا ورفعة شأننا بين الأمم لكننا هجرناه وهو ببن أيدينا ناقضين العهد معه فصرنا إلى ما صرنا إليه من الضعف والذلة والهوان ولا حول ولا قوة إلا بالله!
سورة الأعراف التي أبحرنا مع آياتها عبر التاريخ إلى بدايته مع خلق أبينا آدم رسالة تحذير وإيقاظ من غفلة وتنبيه للمتمسكين بالدنيا ظانين أن لا آخرة ولا حساب: راجعوا عهودكم وتمسكوا بكتابكم ففيه العزة والنجاة وفيه الرفعة وبه الشهادة على الأمم حين يجمع الله الخلق ليسألهم ماذا فعلوا بالعهد الأول؟!
خاتمة سورة الأعراف ميثاق مفصل في العلاقة مع الله (إن وليي الله)
والعلاقة مع الخلق بمكارم الأخلاق (خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)
والعلاقة مع العدو المبين (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم)
والعلاقة مع القرآن منهج الفلاح في الدارين (فاستمعوا له وأنصتوا)
والعلاقة مع عمرك لتزكو نفسك (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين)
عسانا إن وفينا بهذا الميثاق نبلغ منزلة الملائكة في العبودية (لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون)
سورة الأعراف
(كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ (2)) الحرج في حقيقته المكان الضيق من الغابات الكثيرة الأشجار بحيث يعثر السلوك فيه فأغمض عينيك أيها المتدبر لكتاب الله واعمل خيالك في هذه الصورة القرآنية لحال الآسف الحزين الذي امتلأ صدره حزناً فإنه يعسر منه التنفس من انقباض أعصاب مجاري التنفس فتخيل هذا الضيق النفسي بضيق مكان مليء أشجاراً كيف تستطيع تجاوزها. فها هي صورة القرآن التي ترسم بألفاظها المحكمة ما تعجز ريشة الفنان عن الإتيان به.
(وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ (4)) انظر كيف رسم القرآن مشاهده بأبدع رسم فهنا يعرض القرآن حقيقة الهلاك للقرية دون أن يأتي على ذكر أهلها لقصد الإحاطة والشمول. فتخيل مشهد القرية وهي تتدمر بأكلمها، ستجد نفسك أمام هذه الصورة الفظيعة وتتساءل بدهشة إذا كان هذا ما حل بالقرية وهي ثابتة مستقرة فكيف بأهلها؟ وستزداد دهشة إذا علمت أن ساعة الهلاك هي ساعة نومهم قال تعالى (بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ).
(قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (12)) لعل سائلاًً يقول إذا كان المنع يعني الكف والصد فلم جاءت الآية بحرف النفي (لا) في قوله (ألا تسجد) فيكون مقتضى الظاهر أن يقول ما منعك أن تسجد؟ إن (لا) هنا لا تفيد نفياً وإنما جيء بها للتأكيد و (لا) من جملة الحروف التي يؤكد بها الكلام تماماً كما في قوله تعالى (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) البلد) أي أقسم بهذا البلد قسماً محققاً.
(قَالَ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ (15)) هل نال إبليس تكرمة في استجابة طلبه بأن يكون من الكائنات الباقية؟ هذا ما تشير إليه الآية لكن في الحقيقة خاب فهو أهون على الله من أن يجيب له طلبه وقد نفى هذا التصوير للسامع قوله (قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ) فانظر كيف أفاد التأكيد بـ (إنك) والإخبار بصيغة (من المنظرين) أن إنظاره أمر قد قضاه الله وقدّره من قبل سؤاله وهذه هي النكتة في العدول عن أن يكون الجواب أنظرتك أو أجبت لك مما يدل على كرامته بعد الإجابة ولكنه أعلمه أن ما سأله أمر حاصل فسؤاله تحصيل حاصل.
(ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ (17)) انظر كيف يحرص إبليس على إغواء بني آدم فالآية ضرب من المجاز التمثيلي وليست الجهات الأربع المذكورة بحقيقة إذا علمت أنه ليس للشيطان مسلك للإنسان إلا من نفسه وعقله بإلقاء الوسوسة. فكما شبّه هيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق كذلك مُثّلت هيئة التوسل إلى الإغواء بكل وسيلة بهيئة الباحث الحريص على أخذ العدو إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة التي يتمكن فيها من أخذه أعاذنا الله من شرّه وغوايته.
(يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ (26)) تأمل هذا التصوير الرائع لمعنى التقوى (وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ) إنه تشبيه لملازمة تقوى الله بملازمة اللابس لثيابه وحسبك قليل من التحول لتشهد كيف تتحول تقوى الله وخشيته إلى لباس يستر عورات النفس ويزين صاحبها بكمالات الأخلاق الرفيعة كما أن بعض الجسد يستر عوراته. ولا شك أن عورات النفس أشد فظاظة ولذلك لا بد من ستر يمحو أثرها فكانت التقوى خير لباس لها.
(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (29)) الآية مبنية على تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله في موضاع عبادته، كيف ذلك؟ تخيل حال المتهيء لمشاهدة أمر عظيم حين يوجه وجهه إلى صوبه لا يلتفت يمنة ولا يسرة فذلك التوجه المحض يطلق عليه إقامة لأنه جعل الوجه قائماً لا متغاض ولا متوان في التوجّه. فتكون بذلك إقامة الوجوده تمثيلاً لكمال الإقبال على الله كأنه يراه أمامه.
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (32)) تخرج الأساليب في نظم القرآن عن حقيقتها فتأمل الاستفهام في الآية كيف خرج من معناه الحقيقي إلى الإنكار بغرض التهكم إذ جعل من حرم زينة الله على العباد جهلاً منه بمنزلة أهل علم يطلب منهم البيان والإفادة.
(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ (34)) لقد عدل الله عز وجل عن ذكر العذاب أو الاستئصال مع إرادته لذلك وذكر الأجل فقال (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ) وما ذاك إلا إيقاظاً لعقولهم من أن يغرهم الإمهال فيحسبوا أن الله غير مؤاخذهم على تكذيبهم كما أنه ذكر عموم الأمم في هذا الوعيد مع أن المقصود هم المشركون من العرب الذين لم يؤمنوا إنما هي مبالغة في الإنذار والوعيد بتقريب حصوله كما حصل لغيرهم من الأمم.
(لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ (34)) ألا ترى أن (وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ) لا تعلق له بغرض التهديد فمنتظر الوعيد يسأل التأخير لا التقديم وهذه السورة من روائع البيان القرآني. فكل ذلك مبني على تمثيل حالة الذي لا يستطيع التخلص من وعيد أو نحوه بهيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء.
(إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (40)) تأمل هذه الصورة القرآنية التي ترسم في خيال سامعها صورة متخيلة لفتح أبواب السماء أبواب وليس باباً واحداً وصورة متخيلة أخرى لولوج الجمل في سم الخياط وهو ثقب الإبرة. وتدب الحركة في هذه الصورة التخيلية بتخيل محاولات الجمل اليائسة المتكررة دخول ثقب الإبرة. إنها صورة جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضة واستحالة دخولهم الجنة بعدها.
(لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41)) صورة جديدة متخيلة لألوان العذاب في نار جهنم فانظر كيف تنقلب الألفاظ عن حقيقتها فالمهاد والغواشي ما يفرشه الإنسان ويتغطى به عند اضطجاعه للنوم. وفي الآية تتحول هذه الوسائل المريحة إلى أدوات للعذاب فشبّه البيان الإلهي ما هو تحتهم من النار بالمهاد وما هو فوقهم منها بالغواشي كناية عن إنتفاء الراحة لهم في جهنم أعاذنا الله من حسيسها. ولا يخفى ما في هذه الآية من التهكم والسخرية بأولئك الذين اتخذوا فراشاً وثيراً في الدنيا فأُبدِلوا هذا الفراش بفراش آخر ولكنه في نار جهنم.
(وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44)) الخطاب في الآخرة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة وعبَّر عنه بالنداء فلِمَ اختير النداء دون القول أي عندما قال تعالى (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ)؟ إن في خطاب أصحاب الجنة لأصحاب النار بالنداء دون القول كناية عن بلوغه أسماع أصحاب النار من مسافة سحيقة البعد فإن سعة الجنة وسعة النار تقتضيان ذلك لا سيما مع قوله (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ (46) الأعراف).
(فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَـذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51)) انظر في الآية وتدبر ألفاظها. فالنسيان في الموضعين نسيان ترك وإهمال لاحظ الآية (فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ) ولا حاجة لذكر اليوم لتمام المعنى دونه ولكن الله آثر ذكر (اليوم) لما فيه من إثارة تحسرهم وندامتهم وذلك لون من ألوان العذاب النفسي. ودلّ معنى كاف التشبيه في قوله (كَمَا نَسُواْ) على أن حرمانهم من رحمة الله كان مماثلاً لإهمالهم التصديق باللقاء وهذه المماثلة مماثلة اعتبارية مماثلة جزاء العمل للعمل.
(هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (53)) هل سمعت بالاستعاذة التهكمية؟ إنها لون من تفنن القرآن في تعبيره فالآية هنا تتحدث عن انتظار الكفار لوعيدهم فشبّه حال تمهلهم إلى الوقت الذي سيحل عليهم فيه ما أوعدهم به القرآن بحال المنتظرين وهم ليسوا بمنتظرين ذلك إذ هم جاحدون وقوعه. فهذه الصورة جرياً على الاستعارة التي أريد بها التهكم بحالهم فأنّى لهم أن يترقبوا عذاب الله. أوينتظر الإنسان العذاب أو يفر منه؟! لكنه تهكم من جانب وإظهار لما اختبأ في صدورهم من جانب آخر.
(يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا (54)) انظر كيف يخلع القرآن الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية لترقى فتصبح حياة إنسانية ففي هذه الآية يجعل البيان القرآني الليل والنهار شخصان يفيضان حياة وحركة. وقد صور لنا الليل هنا في سمت الشخص الواعي له إرادة وقصد فها هو يطلب النهار مسرعاً مستمراً دائماً لا ينقطع حتى قيام الساعة ولكنه محال أن يلحق به فقد قال تعالى (وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ (40) يس).
(فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا (64)) تأمل كيف يختصر البيان الإلهي الزمن فمع وجود الفاء في قوله (فَأَنجَيْنَاهُ) الدالة على التعقيب فأنت تعلم بأن التكذيب كان من القادة ثم العامة ثم أعقب الوحي وصناعة الفلك ثم بعد ذلك يرتب الوقائع بحسب الأهمية. إن الله أسرع في هذا الإخبار بالإنجاء وجعله مقدماً على الإخبار بالإغراق مع أن مقتضى العبرة تقديم إغراق المكذبين (فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا). قدّم الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلاً لمسرّة السامعين من المؤمنين.
(قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا (70)) لعل سائلاً يسأل ألا يصح أن يكتفي بقوله “ونذر ما يعبد آباؤنا” دون (كان)؟ وكيف يمكن الجمع بين الماضي والحاضر في الآية؟ لتدل على أن عبادتهم أمر قديم مضت عليه العصور. والتعبير بالفعل كونه مضارعاً في قوله (نعْبُدُ) ليدل على أن ذلك متكرر من آبائهم ومتجدد منهم.
(قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ (71)) تأمل التقديم والتأخير في الآية، فكلاهما يدل على بلاغة كلام الله تعالى. فقدّم (عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ) للاهتمام بتعجيل ذكر المغضوب والغاضب إيقاظاً لبصائرهم لعلهم يبادرون بالتوبة. وأخر الغضب عن الرجس لأن الرجس هو خبث نفوسهم قد دلّ على أن الله فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضلال أمراً جلياً. فدل ذلك على أن الله غضب عليهم لما وقع منهم من فسق ورجس. وقبل ذلك كله تجيء كلمة (قد) لتؤذن بتقريب زمن الماضي من الحال مثل قولك (قد قامت الصلاة).
(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (78)) حقيقة الأخذ تناول الشيء باليد. والرجفة اضطراب الأرض وارتجاجها. إذن هذه الآية تطرق سمعك وتُعمل خيالك بصورة حية مستعادة شاخصة تزخر بالحياة والحركة. يتحول الزلزال أو الصاعقة فيها إلى رجل يتلقف بيديه جميع المشركين من قوم صالح لتعبر في منتهاها عن شدة إلإهلاك الله لهم والإحاطة بهم إذ لا يفلت من قبضة عذابه أحد.
(وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82)) تدبر قوله تعالى (إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) وهو حكاية لكلام المشركين في لوط. فحقيقة التطهر تكلّف الطهارة فلِمَ جاء الفعل على هذه الصيغة دون أن يقولوا إنهم أناس طاهرون؟ إعلم أن القوم لما تمردوا على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافراً لطباعهم فلا يطيقون معاشرة أهل الكمال ويذمون ما لهم من الكمالات فيسمونها ثِقلاً. ولذلك جاؤوا بهذا الفعل على صيغة التهكم والتصنع والتأمل وهو مع ذلك كله تهكم بلوط ومن معه من المؤمنين.
(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا (84)) لقد ضمن الله سبحانه وتعالى هذه الآية ما من شأنه أن يلقي في نفس السامع العظمة والرهبة لذات الله. فانظر إلى الفعل أمطرنا أسنده إلى ضمير الجمع جرياً على التعظيم والدلال لذاته جل جلاله. ثم نكّر (مطراً) للتعظيم والتعجب أي مطراً عجيباً من شأنه أن يكون مهلكاً للقرى. وجاء بالظرف (عليهم) للإستعلاء المفضي إلى التمكن والأخذ فالحرف (على) يفيد التمكن من الشيء خلافاً لـ (في) التي تفيد الظرفية. فلو قال وأمطرنا فيهم مطراً لما أفاد إهلاكهم إهلاك تمكّن. والآية في مجملها محمولة على الاستعارة التخيلية إذا علمت أن ما أصاب القوم هو الجمر والكبريت وليس ماء نازلاً من السحاب وقرينة ذلك كلمة (وَأَمْطَرْنَا) التي تؤذن بنزول شيء من السماء يشبه المطر وليس بمطر وإنما للعذاب.
(قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا (88)) لقد آثر البيان القرآني أن يصف الملأ بالاستكبار دون الكفر مع أنه لم يحكِ هنا عن خطاب المستصعفين فهل لذلك الإيثار من عِلّة تدرج في بلاغة هذا البيان؟ نعم حتى يكون ذكر الاستكبار إشارة إلى أنهم استضعفوا المؤمنين كما اقتضت قصة ثمود. واختير وصف الاستكبار هنا لمناسبة مخاطبتهم شعيباً بالإخرج أو الإكراه على اتباع دينهم. وذلك من فعل الجبارين أصحاب القوة فاختيار القرآن لألفاظه يجري على نظم يجعل الآية في وحدة معنوية لا تتعارض معانيها.
(لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا (88)) لاحظ قوله تعالى على لسان قوم شعيب كيف جعلوا عودة شعيب إلى ملة القوم بأسلوب القسم فقالوا (لَتَعُودُنَّ) ولم يقولوا لنخرجنك من قريتنا أو تعودن في ملتنا وقد زاد هذا القسم الآية قوة لا تتأتى بدونه فتأمل كيف أرادوا ترديد الأمر بين الإخراج والعود في حيّز القسم لأنهم فاعلون أحد الأكريم لا محالة. وأنهم مصرون على إعادتهم إلى ملّتهم بتوكيد مؤذن بأنهم إن أبوا الخروج فإنهم سيُكرهون على العودة إلى ملة قومهم.
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ (96)) إنها صورة حسية متخيلة. وهذه الصورة تعمل عملها في الخيال لتترك في نفس السامع أو القارئ تذوقاً تاماً لمعناها فاستطاع البيان أن يستخدم سحر الإستعارة ليعبر عن إعطاء الخيرات لأهل الإيمان والتقوى فيشبه البركات بالبيوت التي تفتح أبوابها وقرينة ذلك قوله (لَفَتَحْنَا) فتعدية فعل (فتح) إلى البركات هنا إستعارة مكنية للانتفاع من بيوت البركة المحتجزة في السماء والأرض.
(أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ (97) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99)) الكلام في الآيات مسوق للتعجب من حال أهل الكفر في أمنهم لمجيء البأس. ولكنه يطالعك تقييد هذا التعجب بوقتي البيات والضحى وبحالي النوم والتعب هل يعني ذلك أن عذاب الله وبأسه لا يجيء في غيرهما من الأوقات؟ في الواقع أن الوقتين أجدر بأن يحذر حلول العذاب فيهما لأنهما وقتان للدعة والراحة. فالانسان يكره أن ينغِّص عليه وقت راحته فكيف إذا علم مسبقاً أن هذا الوقت هو مدعاة للعذاب والغضب؟ لا شك أنه سيجعله وقت راحة ولكنه خالٍ من المعصية.
(وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ (100)) ألا تجد أن الأولى ظاهراً أن يكون الزمن بصيغة الماضي فيكون وطبعنا على قلوبهم بدل (وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ)؟ بَيْد أن البيان الإلهي جاء بالفعل المضارع وما ذاك إلا ليدل على استمرار هذا الطبع وازدياده آناً فآناً. ثم داء بالفعل (لاَ يَسْمَعُونَ) وكان السامع ينتظر أن يقال لا يعقلون فعدل القرآن عن المنتظَر وعبّر عن عدم تعقل الآيات وتدبرها بعدم السمع وهو أول درجات تلقي الآيات. فشبّه حال إعراضهم عن تدبر ما ينزل من الآيات بحال من لا يسمع فالآيات لا تصل إلى أسماعهم وبالتالي فلن تصل إلى قلوبهم من باب أولى.
(يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112)) إنه من المحال في ذلك الوقت أن يجتمع كل السحرة لدى فرعون فعلام دلت كلمة (كل) الغارقة في الاستغراق والشمول؟ ولِمَ كان الطلب بجمع السحرة كلهم لا بعضهم؟ ما هذا الإستعمال إلا من باب البلاغة فكلمة (كل) مستعملة في معنى الكثرة فيصير المعنى بها أي بجمعٍ عظيم من السحرة يشبه أن يكون جميع ذلك النوع واستعمالها هنا يؤذن بشدة ما جاء به موسى على فرعون وملئه فطلبوا أن يجابه بأعظم مما جاء باجتماع كل السحرة لديهم.
(وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120)) تلقي الآية ظلالاً لا يمكن للسامع أن يتحصل عليها لو أنه قال “فسجدوا لرب العالمين” وإنما قال (وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ) فحقيقة الإلقاء تستعمل في سرعة الهوي إلى الأرض فيكون المعنى أنهم لم يتمالكوا أنفسهم فسجدوا دون تريث ولا تردد. وساعد على ذلك بناء الفعل للمجهول لظهور الفاعل وهو “أنفسهم” فيصير المعنى “وألقوا أنفسهم على الأرض ساجدين” وخص السجود هنا لما فيه من هيئة خاصة لإلقاء المرء نفسه على الأرض وذلك بقصد الإفراط في التعظيم.
(إِنَّ هَـذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123)) جاءت هذه الآية حكاية على كلام فرعون للسحرة المؤمنين وكلامه مسوق هنا للتوبيخ والإنكار والوعيد. وختم البيان الإلهي الآية بجملة حُذف مفعولها وهي (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) وما ذلك إلا لقصد الإجمال وإدخال الرعب في قلوبهم وكلام فرعون هذا مؤذن بعجزه فإنه لما أعجزته الحجة صار إلى الجبروت والظلم.
(وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (127)) للسائل أن يسأل لِمَ لم يعبِّر الله في هذه الآية إلا بقوله (وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) ولم يقل وإنا لهم لقاهرون؟ إن الظرف (فوقهم) في الآية مستعمل مجازاً في التمكن من الشيء وكلمة (فوقهم) مستعارة لاستطاعة قهرهم لأن الإعتلاء على الشيء أقوى أحوال التمكن من قهره فهي إذن صورة تمثيلية.
(فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ (131)) تمعن في روعة النظم الإلهي فلو تدبرت التقابل البديع الحاصل في الآية لوقفت خاشعاً في تحراب الله تعالى. فانظر كيف عبّر في جانب الحسنة بالمجيء في حين عبّر في جانب السيئة بالإصابة لأنها تحصل فجأة من غير رغبة ولا ترقب. وفي التعبير عن السيئة بـ (تُصِبْهُمْ) دقة لا متناهية فالإصابة وحدها توحي بالسوء فكيف إذا عدّ الإصابة بالسيئة فهو ألم فوق ألم.
(فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132)) لو قال آل فرعون صيغة غير التي حكيت عنهم لتأملنا منهم خيراً لكنهم صاغوا كلامهم على أعلى درجالت المبالغة في الكفر بموسى وآياته. فاسمع لقولهم (فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) وتأمل هذه الأمور: أولاً الجملة الإسمية وما تحتوي من الدلالة على ثبوت الإنتفاء ودوامه. ثانياً بما تفيده الباء الزائدة من توكيد هذا النفي (بمؤمنين) ألا ترى أن الباء يمكن أن تُحذف فذكرها فيه توكيد. ثالثاً قدّموا (لك) على متعلقه (بمؤمنين) ليؤكدوا رفضهم للإيمان بما جاء به موسى عليه السلام فهل ثمة تعنُّتٌ أشدُّ من هذا؟!
(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (133) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ (134)) تُرى ما هو المراد بالرجز في الاية الثانية؟ إنه مرض الطاعون لكن لسائلٍ أن يسأل لم لم يذكر في عداد الآيات المفصلات في الآية السابقة حين قال (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ)؟ كانت بلاغة القرآن تقتضي أن يستقل الرجز بالذكر تخصيصاً له فالآفات السابقة حلّت على بيئتهم ويمكن الإحتراز منها أما مرض الطاعون فقد كان شديداً لا مفر منه ولذلك عدّى وقوعه بـ (عليهم) دون (فيهم) لما تدل كلمة (عليهم) من تمكُّن ذلك المرض منهم. ولا أدلّ على شدته وعِظَمه من أنه ألجأهم إلى الاعتراف بآيات موسى والإقرار بربّه.
(فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ (138)) انظر إلى قوله تعالى (أَصْنَامٍ لَّهُمْ) فلِمَ اختار طريق التكير في (أصنام) ثم وصفها بأنها (لهم) ولم يقل أصنامهم؟ ما ذاك إلا للحط من شأن هذه الأصنام ولذلك نكّر (أصنام) للدلالة على أنها مجهولة. فالتنكير يستلزم خفاء المعرفة وقال (لهم) دون أصنامهم ليبين صغر عقولهم فهم يعبدون ما هو ملك لهم ويجعلون مملوكهم إلههم.
(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (142)) إن المراد بالليالي في هذه الآية هي الليالي وأيامها فما السر في الاقتصار على ذكر الليلة دون اليوم؟ إنه مما لا شك فيه أن المواعدة كانت لأجل الانقطاع للعبادة والنفس في الليل أكثر تجرّداً للكمالات النفسية منها في النهار. إذ اعتادت النفوس الاستئناس بنور الشمس للاشتغال بالدنيا وينحطّ ذلك في الليل. فجلّ جلال الله في دقة نظمه وحسن اختياره.
(وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ (148)) انظر إلى هذه الفائدة اللطيفة في دقة اللفظ القرآني فانظر إلى قوله (عِجْلاً جَسَدًا) إذ لم يقل عجلاً جسماً وذلك لأن الجسد هو الجسم الذي لا روح فيه وهو خاص بجسم الحيوان إذا كان بلا روح. وبهذه الصفة (جسداً) إستطاع القرآن أن يسلب من السامع الدهشة التي تصورها من تحويل قوم موسى الحُليَّ عجلاً فهم صنعوا هذا العجل لكن لا روح فيه.
(وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ (149)) هذه كلمة أجراها القرآن مجرى المثل إذ نظمت على إيجاز بديع وكناية بارعة. فإنك تعلم أن اليد تستعمل للقوة والنصرة فبها يضرب بالسيف وبها تحرك الأشياء وهي آية القدرة. وقد استعملت في الآية بمعنى الندم وتبين الخطأ. ففي الآية تمثيل بحال من سُقط في يده حين العمل أي تعطلت حركة يده بسبب غير معلوم دخل بها فصيرها عاجزة وهذا كناية عن الفجأة والدهشة.
(وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ (150)) انظر إلى هذه الزيادة في قوله تعالى (مِن بَعْدِيَ) فالخلافة أصلاً تفيد البعدية فلماذا آثر البيان ذكر (مِن بَعْدِيَ) عقب (خَلَفْتُمُونِي)؟ ما ذلك إلا للتذكير بالبون الشاسع بين حال الخلف وحال المخلوف عنه. وتصوير فظاعة ما خلفوه به أي بعدما سمعتم مني التحذيرمن الإشراك والتحذير من تقليد المشركين وقع منكم ذلك الضلال؟!
(وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ (154)) في هذه الجملة القرآنية صورة بلاغية تشهد للنظم القرآني تفننه في ألوان البلاغة فقد شبه القرآن الغضب وفورانه في نفس موسى بشخص مرتفع يغريه بالانفعال ويدفعه إلى أفعال تطفئ ثورة هذا الغضب.
(قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ (157)) انظر إلى رحمة الله تعالى المنزلة على عباده. فقد عبّر عنها بالكتابة وأعرض عن لفظ العطاء فقال (فَسَأَكْتُبُهَا) ولم يقل فسأعطيها، أتعلم لم قال ذلك؟ لأن الكتابة قيدٌ للعطاء المحقق حصوله المتجدد مرة بعد مرة. فالذي يريد تحقيق عطاء يتجدد في المستقبل يكتب به في صحيفة ليصونه عن النكران ويصونه من النقصان والرجوع. وتسمى الكتابة عهداً والله لا يخلف عهده سبحانه وتعالى. ولو كان العطاء لمرة واحدة لم يحتج للكتابة كقوله (إلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا (282) البقرة).
(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ (157)) لو وصفت رجلاً بأنه أمي لكان ذلك نقصاً فيه لكن الله في نظمه البليغ وقرآنه البديع جعل من هذه الصفة كمالاً وزيادة تشريف لشخص نبيّه الكريم عليه الصلاة والسلام. فأين وجه الكمال والتشريف في صفة الأميّة؟ إعلم أن الله أراد بذلك إتمام الإعجاز العلمي والعقلي الذي أيّد به نبيه فجعل الأمية وصفاً ذاتياً له لتكون بذلك آية على أن ما حصل له إنما هو من فيوضات إلهية. وبذلك كانت الأمية وصف كمال فيه مع أنها في غيره وصف نقصان.
(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ (158)) لعلك تسأل نفسك طالما أن المخاطبين هم بنو إسرائيل وهم أهل توحيد فلم يورد القرآن هذه الصفات الثلاث لله عز وجل وهم يقرون بها؟ إنما جيء بهذه الصفات لتذكير اليهود ووعظهم حيث جحدوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وزعموا أن لا رسول بعد موسى واستعظموا دعوة محمد وكانوا يعتقدون أن موسى لا يشبهه رسول فذكرهم الله بأنه هو وحده مالك السموات والأرض وهو واهب الفضائل فلا يستعظم أن يرسل رسولاً ثم يرسل آخر فالمُلك بيده. وفي ذكر الإحياء والإماتة تذكير لهم بأن الله يحيي شريعة ويحيي أخرى فلا تعجب إذن من ذكر هذه الصفات في هذا الموضع لأن القصة أعظم.
(وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ (161)) لا بد وأنك قرأت نظير هذه الآية في سورة البقرة لكنك مع التطابق الكبير ترى هذا الاختلاف البسيط في الضمائر فهنا استعمل ضميري الغيبة (وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ) (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) وفي آية البقرة استعمل ضميري الخطاب (وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (57)) وما ذاك إلا بقصد التوبيخ في الخطاب وبقصد عرض المِنّة وعرض العبرة في قصة بني إسرائيل في الغيبة وزاد على ذلك أنها عادة القرآن في تغيير أسلوب القصص استجداداً لنشاط السامع وذهنه.
(واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ (163)) سوف تجد إذا ما استعرضت القصة أن أسلوب الخبر قد تغير من الطلب إلى الإخبار فابتدأ هنا بطلب أن يسأل سائل بني إسرائيل لحاضرين عنها فقال (واَسْأَلْهُمْ) فهل لهذه القصة شأن غير شأن القصص الماضية؟ نعم، ففي هذا التعبير إيماء إلى أن هذه القصة ليست كما كتبت في توراة اليهود لأن كتب أنبيائهم حرّفت وغُيّرت ولكن أحبارهم يعلمون حقيقة ما جرى مع أسلافهم ولذلك افتتحت بسؤالهم بصيغة الأمر (واَسْأَلْهُمْ) لإشعار يهود العصر النبوي بأن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم وهم كانوا يكتمونها فعلمه الله من أحوالهم ما فيه معجزة لأسلافهم.
(إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً (163)) تأمل هذا التمثيل الرائع في تصوير إتيان الحيتان شُرّعاً. فحقيقة الشروع إنما تطلق لإتيان الإبل والنعم نحو الماء لتشرب وفي هذه الكلمة إضافة لمسة فنية على البيان القرآني لتمثيل حالة الحيتان في كثرتها واصطفائها بحال الإبل إذا شرعها الرعاة تسابقت إلى الماء فاكتظت وتراكضت وهذا شأن الحيتان هنا فهي لا تأتي إلى الشط وحسب بل وتتسابق في الإجتماع حتى تملأ المكان وتغري الصُياد بأخذها.
(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ (167)) تأمل دقة اللفظ القرآني الذي ينقلك إلى جو الحدث والقصة ويضعك أمام أحداثها فالله جل جلاله قال (لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ) ولم يقل ليرسلن إليهم ليدل على تمكن من يسومهم سوء العذاب من رقابهم فحرف الجر (عليهم) يدل على التمكن والفوقية وزاد الفعل (لَيَبْعَثَنَّ) الأمر وضوحاً فهو فعل مضارع يدل على التجدد في أوقات مختلفة ولكنه لا يقتضي الإستمرار يوماً فيوم فهم قد ذاقوا ألوان العذاب حيناً بعد حين وإن لم يستمر فيهم.
(وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا (169)) قال بنو إسرائيل سيغفر لنا ولم يقولوا سيغفر الله لنا مع أنهم يعلمون أن المراد هو الله فلِمَ بنوا الفعل للمجهول وقالوا (سَيُغْفَرُ)؟ أرادوا بهذا البناء العموم في المغفرة لا في خصوص الذنب الذي أنكر عليهم ولذلك حذفوا نائب الفاعل أيضاً فلم يقولوا سيغُفر لنا ذنبنا وما الباعث على ذلك إلا اعتقادهم الخاطئ بأن ذنوبهم كلها مغفورة دون سبب المغفرة من توبة وإنابة واستغفار.
(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا (172)) قد يظن الظانّ أن حرف الجر (بلى) مساوٍ لـ (نعم) وهذا خطأ شائع. فلو أجابت الأنفس بـ (نعم) لكان ذلك كفراً، فكيف ذلك؟ إن الحرف (بلى) هو حرف جواب لكلام فيه معنى النفي فيقتضي إبطال النفي وتقرير المنفي. أما الحرف (نعم) فهم يحتمل تقرير النفي وتقرير المنفي. فلو قال المرء لصديقه (ألست صديقك؟) فأجابه بـ (نعم) لكان المعنى لا لست صديقي وأما (بلى) فيعني بل أنت صديقي.
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175)) تأمل هذا اللفظ الذي يرسم لك صورة متكاملة. فكلمة (فَانسَلَخَ) ترسم صورة عنيفة قاسية للتخلص من آيات الله بظلِّها الذي تلقيه في خيال القارئ لأن الإنسلاخ حركة حسّية قوية. ونحن نرى هذا الكافر ينسلخ من آيات الله انسلاخاً، ينسلخ كأنما الايات أديم له متلبس بلحمه فهو ينسلخ منه بعنف وجهد ومشقة انسلاخ الحي من أديمه اللاصق بكيانه.
(فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ (175)) هذه صورة أخرى تلتصق بأختها لتكمل سلسلة الخيال في الآية. فهي حركة إنسان ضالٍ انسلخ عن آيات الله وسار في طريق الضلال فتبعه الشيطان بهدف غوايته حتى لا يفكر في العودة إلى الآيات التي انسلخ عنها وخلّفها وراءه.
(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)) انظر إلى قوله (أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ) جعلها الله كلمة مستأنفة وابتدأ بها الكلام لتصوير فظاعة حالهم ولتكون أدعى للسامعين. ثم جيء باسم الإشارة (أُوْلَـئِكَ) لزيادة تمييزهم بتلك الصفات وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيذكر من تسويتهم بالأنعام أو جعلهم أضل من الأنعام. ثم أتبع ذلك بـ (بل) فقال (بَلْ هُمْ أَضَلُّ) للانتقال والترقي في التشبيه بالضلال ووجه كونهم أضل من الأنعام أنها لا يبلغ بها الضلال إلى إيقاعها في مهاوي الشقاء الأبدي.
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (187)) صيغ الكلام في الآية على الاستعارة فما من شك أننا نعلم أن الإرساء إنما يطلق للسفينة إذا استقرت في الشط. وأطلق هنا على الساعة تشبيهاً لوقوع الأمر الذي كان مرتقباً أو متردداً فيه بوصول السائر في البحر إلى المكان الذي يريده. فالساعة تقترب كلما مضى يوم حتى تبلغ النهاية كما أن السفينة تقترب كلما مر يوم وهي تسير حتى تبلغ منتهاها ومرساها في الشط.
(قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ (188)) لو عدت إلى الآية القائلة (قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا (76)) في سورة المائدة لوجدت تقديم النفع في هذه الآية وتأخيره هناك فهل لذاك عِلّة توخاها بيان الله؟ الحقيقة نعم فإن الله قدم النفع على الضر هنا لأن النفع أحب إلى الإنسان وعكسه في سورة المائدة لأن المقصود هناك تهوين أمر معبوداتهم وأنها لا يُخشى غضبها فلئن كانت على جلب الضر عاجزة فهي لتقديم النفع أعجز. أما هنا فقدّم النفع على الضر لأنه يريد أن يبين لهم أنه لا يملك النفع لنفسه مع أن الإنسان يسعى أبد الدهر لينفع نفسه فكيف يملك ضُرّ ذاته؟!
(وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188)) لنحاول أن نتبين سبب تقديم (النذير) في الآية مع كثرة الآيات التي جاءت على تقديم البشير فلا بد لها من غاية ترتجى. إعلم أن المقام هنا خطاب المكذبين المشركين لذلك قدمت النذارة على البشارة لأنها أعلق بهم.
(أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا (195)) لسائل أن يقول طالما أن الرجل وسيلة المشي واليد وسيلة البطش والعين للبصر والأذن للسمع فلِمَ جيء بهذه الأوصاف بعد هذه الآلآت؟ أتى بيان الله بهذه الأوصاف لسببين: الأول لزيادة تسجيل العجز على الأصنام والثاني لأن بعض الأصنام كانت محمولة على صدر الآدميين كهُبل وسواع ولئن كان لها صور الأرجل والأعين ولكنها عديمة العمل والفائدة.
(إِنَّ وَلِيِّـيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196)) لقد أعرض البيان الإلهي عن كل صفات الله وأجرى الصفة بالموصولية في إنزال الكتاب فقال (إِنَّ وَلِيِّـيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ) وفي ذلك تلميح بأن إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الأميّ لأعظم دليل على توليه واصطفائه.
(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)) إنك تعلم أن حقيقة الأخذ هي تناول الشيء للانتفاع به فكيف جعل القرآن العفو شيئاً يؤخذ وأنت تعرف أن الإنسان إذا أخذ شيئاً أمسك به كاملاً دون إفلات شيء منه. ذلك لأن الله يريد أن يكون العفو مملوكاً لك دون تفريط بأي جزء منه.
(وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ (200)) بُني الكلام في الآية على التخيل لصورة وسوسة الشيطان في نفس المؤمن. فإطلاق النزغ هنا إستعارة إذ أن حقيقة النزغ هي النخر والغرز بالإبرة وعلى هذا يُشبِّه بيان الله حدوث الوسوسة الشيطانية في النفس بنزغ الإبرة ونحوها في الجسم فكلاهما له تأثير خفي وإيلام بسيط يتدرج حتى تفقد النفس الشعور بها.