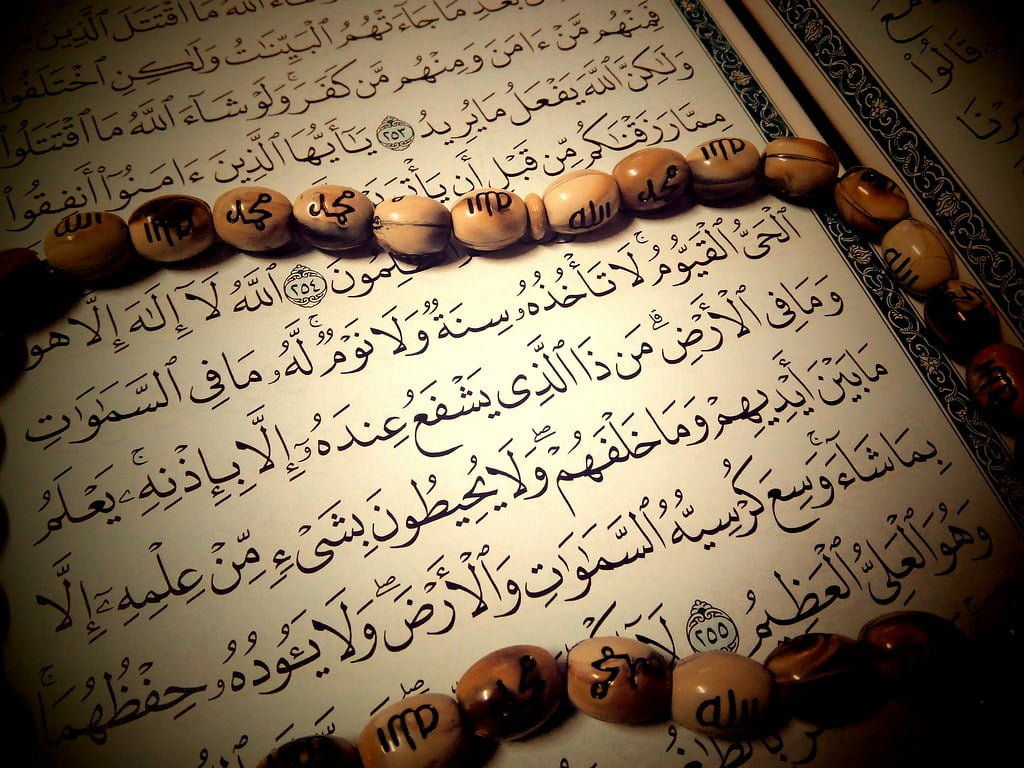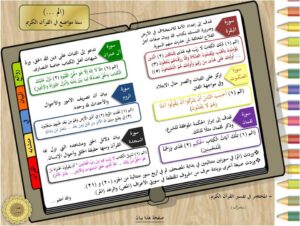سورة البقرة وآياتها (286 آية) هي أول سورة نزلت في المدينة بعد هجرة الرسول r، ومع بداية تأسيس الامة الاسلامية (السور المدنية تُعنى بجانب التشريع)، وأطول سور القرآن، وأول سورة في الترتيب بعد الفاتحة.
وفضل سورة البقرة وثواب قراءتها ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة منها: (يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما) وفي رواية (كأنهما غمامتان او ظلتان)
وعن رسول الله r أنه قال: “لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة” أخرجه مسلم والترمذي.
وقال رسول الله r : “اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة” أي السحرة، رواه مسلم في صحيحه.
هدف السورة: الاستخلاف في الأرض (البشر هم المسؤولون عن الأرض)، ولذا جاء ترتيبها الأول في المصحف، فالأرض ملك لله عز وجل، وهو خلقها، وهو يريد أن تسير وفق إرادته، فلا بد أن يكون في الأرض من هو مسؤول عنها، وقد استخلف الله تعالى قبل آدم الكثير من الأمم، وبعد آدم أيضاً، فمنهم من فشل في مهمة الاستخلاف، ومنهم من نجح، لذا عندما نقرأ السورة يجب علينا أن نستشعر بالمسؤولية في خلافة الارض.
كما أسلفنا، فإن هدف السورة هو الاستخلاف في الأرض، وسورة البقرة هي أول سور المصحف ترتيباً، وهي أول ما نزل على الرسول rفي المدينة مع بداية تأسيس وتكوين دولة الإسلام الجديدة، فكان يجب أن يعرف المسلمون ماذا يفعلون ومم يحذرون، والمسؤولية معناها أن نعبد الله كما شاء، وأن نتبع أوامره وندع نواهيه.
والسورة مقسمة إلى أربعة أقسام: مقدمة – القسم الأول – القسم الثاني – خاتمة. وسنشرح هدف كل قسم على حدة.
· المقدمة: وفيها وصف أصناف الناس وهي تقع في الربع الأول من السورة من الآية (1 – 29)
· الربع الأول: أصناف الناس:
1. المتقون (آية 1 – 5)
2. الكافرون (آية 6 – 7)
3. المنافقون (آية 8 – 20) والإطناب في ذكر صفات المنافقين للتنبيه الى عظيم خطرهم، وكبير ضررهم؛ لأنهم يظهرون الايمان، ويبطنون الكفر، وهم أشد من الكافرين.
· ثم ننتقل إلى القسم الأول من السورة، وفيه هذه المحاور:
· الربع الثاني:استخلاف آدم في الأرض (تجربة تمهيدية ) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) (الآية 30)، واللطيف أنه سبحانه أتبع هذه الآية بـ (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) (آية 31).
وهذه الآية محورية، فهي تعني أنك إذا أردت أن تكون مسؤولا عن الأرض يجب أن يكون عندك علم؛ لذا علّم الله تعالى الاسماء كلها، وعلّمه الحياة وكيف تسير، وعلّمه تكنولوجيا الحياة، وعلّمه أدوات الاستخلاف في الأرض: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)(آية 22). وهذا إرشاد لأمة الاسلام أنهم إن أرادوا ان يكونوا مسؤولين عن الأرض، فلا بد لهم من العلم مع العبادة، فكأن تجربة سيدنا آدم u هي تجربة تعليمية للبشرية في معنى وكيفية المسؤولية عن الأرض.
ثم جاءت الآية (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ( آية 36 ، ترشدنا إلى أن النعمة تزول بمعصية الله تعالى، وتختم قصة آدم بآية مهمة جداً (قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) آية 38 ، وهي تؤكد ما ورد في أول سورة البقرة (هدى للمتقين)، وترتبط بسورة الفاتحة (إهدنا الصراط المستقيم).
· الربع الثالث إلى الربع السابع: نموذج فاشل من الاستخلاف في الأرض: قصة بني اسرائيل الذين استخلفوا في الأرض فأفسدوا (الآية 40) (يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين).
وأول كلمة في قصة بني اسرائيل (أني فضلتكم على العالمين) اي أنهم مسؤولون عن الأرض، وأول كلمة في قصة آدم u (إني جاعل في الأرض خليفة) أي مسؤول عن الارض، وأول كلمة في قصة بني اسرائيل (واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم)، وأول كلمة في الفاتحة (الحمد لله رب العالمين) والحمد يكون على النعم، فذكر نعم الله تعالى واستشعارها هي التي افتتح بها القرآن الكريم، والتي افتتحت بها قصة بني اسرائيل.
· تعداد نعم الله تعالى على بني إسرائيل: الآيات 49 – 50 – 51 – 52
“وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ” (49)”وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ “(50)”وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ” (51)”ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمِ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ “(52)
· عرض أخطاء بني إسرائيل (بهدف إصلاح الأمة الإسلامية) الآيات 55 – 61
وفي عرض أخطاء بني إسرائيل التي وقعوا فيها توجيه لأمة محمد r وإصلاح لها، ومن هذه الأخطاء: أن بني اسرائيل لم يرضوا بتنفيذ شرع الله تعالى – المادية – الجدل الشديد – عدم طاعة رسل الله – التحايل على شرع الله – عدم الإيمان بالغيب.
وقصة البقرة باختصار أن رجلا من بني إسرائيل قُتل، ولم يُعرف قاتله، فسألوا سيدنا موسى، فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة لها صفات معينة، ويضربوا الميت بجزء من البقرة المذبوحة، فيحيا باذن الله تعالى، ويدل على قاتله :(الآيات 69 – 71)، وهذا برهان مادي لبني إسرائيل وغيرهم، على قدرة الله جلّ وعلا في إحياء الخلق بعد الموت، وذلك أن بني اسرائيل كانوا ماديين جدا، ويحتاجون الى دليل مادي ليصدقوا ويؤمنوا.
وهذه السورة تقول لأمة محمد r أنهم مسؤولون عن الأرض، وهذه أخطاء الأمم السابقة فلا يقعوا فيها حتى لا ينزل عليهم غضب الله تعالى، ويستبدلهم بأمم أخرى.
وتسمية السورة بهذا الاسم (البقرة) إحياء لهذه المعجزة الباهرة، وحتى تبقى قصة بني إسرائيل ومخالفتهم لأمر الله، وجدالهم لرسولهم، وعدم إيمانهم بالغيب وماديتهم، وما أصابهم جرّاء ذلك – تبقى حاضرة في أذهاننا فلا نقع فيما وقعوا فيه من أخطاء أدت الى غضب الله تعالى عليهم.
وهذه القصة تأكيد على عدم إيمان بني إسرائيل بالغيب، وهو مناسب ومرتبط بأول السورة (الذين يؤمنون بالغيب) وهي من صفات المتقين.
وفي قصة البقرة روايات لأخطاء كثيرة، لأنها تعرض نماذج من الذين أخطؤوا، وهي امتحان من الله تعالى لمدى إيماننا بالغيب.
وتتتابع أخطاء بني اسرائيل إلى الآية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(104)، وكان العرب يفهمون هذه الكلمة (راعنا)،على أنها عادية، ولكنها تعني السباب عند بني إسرائيل، فأراد الله تعالى أن يتميز المسلمون عن اليهود حتى في المصطلحات اللفظية، وأمرهم أن يقولوا (انظرنا).
· الربع الثامن: نموذج ناجح للاستخلاف في الأرض (قصة سيدنا إبراهيم u) وهي آخر تجربة ورد ذكرها في السورة.
· اولا ابتلى سبحانه آدم في أول الخلق (تجربة تمهيدية)، ثم بني اسرائيل فكانت تجربة فاشلة، ثم ابتلى إبراهيم u فنجح (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين)، وفي هذه الآية إثبات أن الاستخلاف في الأرض ليس فيه محاباة، فالذي يسير على منهج الله وطاعته يبقى مسؤولا عن الأرض، والذي يتخلى عن هذا المنهج لا ينال عهد الله (لا ينال عهدي الظالمين).
· امتحن الله تعالى سيدنا ابراهيم u بكلمات، فلما أتمهن قال تعالى (إني جاعلك للناس إماما)، ثم دعا إبراهيم ربه أن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) آية 136، وفي نهاية قصة سيدنا ابراهيم الآية: (قولوا آمنا بما أنزل الينا وما أنزل الى إبراهيم ) جاء ذكر الأنبياء كلهم، وهذا مرتبط بآية سورة الفاتحة (صراط الذين أنعمت عليهم)، فكأنما كل هؤلاء المذكورين في آية سورة البقرة هم من الذين أنعم الله تعالى عليهم، والذين يجب أن نتبع هداهم، والصراط الذي اتبعوه.
وملخص القول في القسم الاول من السورة أن القصص الثلاث : قصة آدم :(إني جاعل في الارض خليفة)، وقصة بني اسرائيل :(وأني فضلتكم على العالمين)، وقصة سيدنا إبراهيم u :(إني جاعلك للناس إماما)، هذه القصص الثلاث بدايتها واحدة وهي الاستخلاف في الأرض، وعلينا نحن أمة المسلمين أن نتعلم من تجارب الذين سبقونا، وأن نستشعر الأخطاء التي وقعت فيها الأمم السابقة، ونعرضها على أنفسنا دائما لنرى إن كنا نرتكب مثل هذه الأخطاء فتوقف عن ذلك، ونحذو حذو الأمم السابقة الذين نجحوا في مهمة الاستخلاف في الأرض كسيدنا ابراهيم u.
وفي القصص الثلاث ايضاً اختبار نماذج مختلفة من الناس في طاعة الله تعالى، فاختبار سيدنا آدم u كان في طاعة الله (أكل من الشجرة أم لا)، واختبار بني اسرائيل في طاعتهم لأوامر الله من خلال رسوله، واختبار سيدنا إبراهيم u بذبح ابنه إسماعيل أيضا اختبار لطاعة لله تعالى: (واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات). وخلاصة أخرى هي أن الآمة مسؤولة عن الأرض، والفرد أيضا مسؤول، وللقيام بهذه المسؤولية فهو محتاج للعبادة وللأخذ بالعلم والتكنولوجيا.
· القسم الثاني من السورة (الجزء الثاني): أوامر ونواهٍ للأمة المسؤولة عن الأرض
وفي هذا القسم توجيه للناس الذين رأوا المناهج السابقة، وتجارب الأمم الغابرة أنه يجب عليهم أن يتعلموا من الأخطاء، وسنعطيكم أوامر ونواه كي تكونوا مسؤولين عن الارض بحق وتكونوا نموذجا ناجحا في الاستخلاف في الارض. وينقسم هذا القسم إلى:
· الربع الأول: تغيير القبلة (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ * قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) آية (144-143)، لماذا جاءت الآية في تغيير القبلة من بيت المقدس الى بيت الله الحرام؟ المسلمون أمة أرادها الله تعالى أن تكون متميزة، وقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)، فبما أنكم ستكونون شهداء على الناس لا بد من أن تكونوا متميزين، فلا استخلاف بدون تميز؛ لذا كان لا بد من أن تتميزالأمة المسلمة:
بقبلتها (بدون تقليد أعمى لغيرها من الأمم السابقة) آية 144.
بمصطلحاتها (انظرنا بدلا من راعنا) آية 104.
بالمنهج (اهدنا الصراط المستقيم) سورة الفاتحة .
· الربع الثاني: التوازن في التميز :
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) آية 158. وسبب هذه الآية أن الصحابة لما نزلت آيات تغيير القبلة ليتميزوا عن الكفار اعتبروا أن الصفا والمروة من شعائر الكفار، وعليهم أن يدعوها أيضا حتى يكونوا متميزين، لكن جاءت الآية من الله تعالى أن ليس على المسلمين أن يتميزوا عن كل ما كان يفعله الكفار، فلا جناح عليهم أن يطوفوا بالصفا والمروة؛ لأنها من شعائر الله، وليس فيها تقليد للأمم السابقة. إذًا علينا أن نبتعد عن التقليد الأعمى لمن سبقنا، لكن مع الإبقاء على التوازن، أي أننا أمة متميزة لكن متوازنة.
o الربع الثالث:عملية إصلاح شامل
الآية (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177) وفيها اشياء كثيرة: فبعد أن أطاعوا وتميزوا مع الحفاظ على التوازن كان لا بد لهم من منهج اصلاحي شامل: (الإيمان بالله، بالغيب، إيتاء المال، إقامة الصدقة، إيتاء الزكاة، الوفاء بالعهود، الصابرين ، الصادقين، المتقين)، وكأنما الربعان الأول والثاني كانا بمثابة تمهيد للأمة، طاعة وتميز بتوازن وإصلاح شامل، وتبدأ من هنا الآيات بالأوامر والنواهي المطلوبة.
o أوامر ونواهٍ شاملة لنواحي الاصلاح:
o التشريع الجنائي: آية 179(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
o التركات والوصيات آية 180(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)
o التشريع التعبدي آية 183 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) التعبد واحكام الصيام.
o الجهاد والانفاق فيها دفاع عن المنهج، ولا دفاع بدون مال وإنفاق.( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) آية 195.
آية 177 (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) مفصلة في هذه الأحكام، وكلما تأتي الآيات بتشريع تنتهي بذكر التقوى؛ لأنه لا يمكن تنفيذ قوانين إلا بالتقوى، وهي مناسبة ومرتبطة بهدى للمتقين في أول السورة، ونلاحظ كلمة التقوى والمتقين في الآيات السابقة، إذًا، فالإطار العام لتنفيذ المنهج هو : طاعة – تميز – تقوى، ونستعرض هذا التدرج الرائع:
· (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) آية183 .
· (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون) آية َ179 .
· (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ )آية 144. (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)آية 158 .
وكل من هذه الآيات هي اول آية في الربع الذي ذكرت فيه.
· الربع الرابع: باقي أجزاء منهج الاستخلاف
· الجهاد والانفاق(وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ(190)وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ(191).
الحج وأحكامه (196 – 200).
لماذا جاء بآيات أحكام الحج بعد الجهاد؟ لأن الحج هو أعلى تدريب على القتال، وأعلى مجاهدة النفس. وأيات الحج بالتفصيل وردت في سورة البقرة استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم في الربع الثامن من القسم الأول (وأرنا مناسكنا) آية 128. ونلاحظ أن سورة البقرة اشتملت على أركان الإسلام الخمسة : الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولم تفصّل هذه الاركان في القرآن كما فصّلت في سورة البقرة.
الإسلام منهج متكامل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) آية 208 ، والسلم هو الإسلام، وهو توجيه للمسلمين أن لا يكونوا كبني إسرائيل الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) آية 85 ، وأن يأخذوا الدين كاملا غير مجتزأ، فكأنما يوجهنا الله تعالى في سياق السورة إلى الطاعة والتميز، ثم يعطينا بعض عناصر المنهج، ثم يأمرنا أن نأخذ الاسلام كافة، ولا نفعل كما فعل بنو إسرائيل، ثم يكمل لنا باقي المنهج، وهذ الآية (ادخلوا في السلم كافة) كان لا بد من وجودها في مكانها بعد الطاعة والتميز واتباع الأوامر والنواهي، والجهاد والانفاق للحفاظ على المنهج، ثم الأخذ بالدين كافة، ثم التقوى التي تجعل المسلمين ينفذون.
· الربع الخامس : اكتمال المنهج (الآيات 219 – 242).
وفيه إكمال المنهج من أحكام الأسرة من زواج وطلاق ورضاعة وخطبة وخلع وعدة وغيرها، وسياق كل ذلك التقوى، ونلاحظ نهاية الآيات بكلمة تقوى أو مشتقاتها. وقد تأخرت آيات أحكام الاسرة عن أحكام الصيام؛ لأن الله تعالى بعدما أعد المسلمين بالتقوى وبطاعته جاءت أحكام الاسرة التي لا ينفذها إلا من اتقى وأطاع ربه، فالمنهج الأخلاقي والعملي متداخلان في الإسلام. لا ينفع أن يبدأ بأحكام الاسرة ما لم يكن هنالك تقوى في النفوس البشرية.
· الربع السادس: قصة طالوت وجالوت (آية 246 – 251).
وهي قصة أناس تخاذلوا عن نصرة الدين، وجاء ذكرها في موضعها؛ لأن المنهج يجب أن يُحافظ عليه، ولا يتم ذلك إلا بوجود أناس يحافظون عليه.
· آية الكرسي (اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (آية 255)، موضعها في السورة مهم جدا، وتدلنا الى أنه إذا أردنا تطبيق المنهج يجب أن نستشعر قدرة الله وعظمته وجلاله (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)، فالمنهج ثقيل، ويتطلب الكثير من الجهد، لكنه يستحق التطبيق؛ لأنه منهج الله تعالى (الله لا إله إلا هو)
ثم تأتي بعدها آية غاية في كرم الله وعدله (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، أمر من الله بأن لا نكره أحدا على الدين لماذا؟ لأن الدين واضح معناه بعد قوله (الله لا إله إلا هو) فالذي لا يعرف معنى (الله لاإله إلا هو) ولا يستشعر عظمة هذا المعنى، لا مجال لإكراهه على الدين. فالرشد بيٌن والغي بيٌن.
· قدرة الله تعالى في الكون (دلائل احياء الموتى):من الآية (258 – 261) جاءت في ثلاث قصص:
· قصة ابراهيم مع النمرود آية 258 (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)
· قصة عزير والقرية الخاوية آية 259 (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
· قصة ابراهيم والطير آية 261 (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
وفي القصص الثلاث تأكيد على قدرة الله تعالى وأنه (لا إله إلا هو)، فكيف لا نقبل بتنفيذ المنهج أو نكون مسؤولين عن الأرض بعدما أرانا الله تعالى قدرته في الكون؟
· الربع الأخير: الإنفاق (الآيات 261 – 283)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )آية 278
وهو آخر جزء من المنهج، وفيه حملة شديدة على جريمة الربا التي تهدد كيان المحتمع، وتقوض بنيانه، وحملت على المرابين بإعلان الحرب من الله تعالى ورسوله على كل من يتعامل بالربا، أو يقدم عليه. وعرض للمنهج البديل، فالإسلام لا ينهى عن أمر بدون أن يقدم البديل الحلال، وقد جاءت آيات الربا بين آيات الإنفاق لتؤكد معنى وجود المنهج البديل للمال والرزق الحلال.
o الخاتمة: وهذه أروع آيات السورة (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) آية 285. فالتكاليف كثيرة، والتعاليم والمنهج شاق وثقيل، فكان لا بد من أن تأتي آية الدعاء لله تعالى حتى يعيننا على أداء وتنفيذ هذا المنهج (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) آية 286 .
اي أعنا يا ربنا على تنفيذ المنهج؛ لأنه سيوجد أعداء يمنعوننا من ذلك، ولن نقدر على تطبيق المنهج بغير معونة الله. واشتملت الخاتمة على توجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله عزّ وجلّ برفع الأغلال والآصار، وطلب النصرة على الكفار، والدعاء لما فيه سعادة الدارين (رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) وقد ختمت السورة بدعاء المؤمنين، كما بدأت بأوصاف المؤمنين، وبهذا يلتئم شمل السورة أفضل التئام، فسبحان الله العلي العظيم.
خلاصة: نحن مسؤولون عن الأرض والمنهج كاملا، وعلينا أن ندخل في السلم كافة، والمنهج له إطار: طاعة الله وتميز وتقوى. أما عناصر المنهج فهي: تشريع جنائي، مواريث، إنفاق، جهاد، حج، أحكام صيام، تكاليف وتعاليم كثيرة، فلا بد أن نستعين بالله تعالى على أدائها لنكون أهلا للاستخلاف في الارض، ولا نقع في أخطاء الأمم السابقة.
تنتهي سورة الفاتحة بذكر المنعَم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالين: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)) والبقرة تبدأ بذكر هؤلاء أجمعين، تبدأ بذكر المتقين (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2))، وهؤلاء منعَم عليهم، ثم تقول (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (6)) فتجمع الكافرين من المغضوب عليهم والضالين، وتذكر المنافقين (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8)) فاتفقت خاتمة سورة الفاتحة مع افتتاح سورة البقرة.
ذكر في خواتيم الفاتحة أصناف الخلق المكلفين: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)) وذكرهم في بداية البقرة.
المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه، والضالون الذين لم يعلموا الحق وإنما ضلوا الطريق، ويضرب لهم مثلاً اليهود والنصارى، والمغضوب عليهم، ومنهم اليهود والنصارى، وفواتح البقرة تحدثت عن هذه الأصناف المتقين والكفار والمنافقين، وجمعت المغضوب عليهم والضالين.
*سؤال: هل هذا الأمر مقصود في حد ذاته من قِبل الله سبحانه وتعالى، يعني هذه التوأمة بين خواتيم السور وبدايات السور التي تليها؟
قسم من الباحثين في عموم المناسبات قالوا: القرآن كتاب حياة، فخذ أي يوم من أيام الحياة، هل هي مترابطة في مسألة واحدة، أو أن فيها أمورا مختلفة متعددة كلها تجمعها الحياة؟ والقرآن كتاب حياة فيه ما فيها، تقع أمور كثيرة متعددة مترابطة، ولكن لا يبدو هذا الترابط ظاهراً، مثل الكتاب تقرؤه من مقدمته إلى خاتمته: فصل أول، وفصل ثان، نلاحظ في هذا الوضع التوقيفي ارتباطا واضحا في هذه المسألة.
ولذلك قال الرازي: إن آيات القرآن كلها كأنها كلمة واحدة من حيث الترابط، نحن لا نقول إنه غير مقصود، ولكننا الآن ننظر في شيء موجود أمامنا، ونبحث فيه: هل هنالك تناسب أو لا؟ في هذا الوضع الحالي نحن الآن نرى ترابطاً واضحاً، نحن نصف في تقديرنا، وفيما يظهر لنا كعلماء هذا الأمر، والله أعلم.
تبدأ سورة البقرة بقوله تعالى (الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6)) إذًا هو ذكر المؤمنين وما يؤمنون به، يؤمنون بما أنزل إليهم، وما أنزل من قبلهم، ثم ذكر الذين كفروا.
وقال في آخر السورة (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)) فهذا إيمان بالغيب، في مفتتح السورة قال (وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)، وهنا قال (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ). ثم قال (أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286))، وذكر في المفتتح الذين كفروا (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) ثم ذكر في الخاتمة الدعاء (فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)، هذا تناسب كامل.
في خواتيم البقرة قوله تعالى (لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284))، وفي بداية آل عمران (إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء (5) آل عمران) لله ما في السموات وما في الأرض، وإن تبدوا، ما في السموات وما في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كأنها جزء منها. (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء (6)) في آل عمران، وقال في البقرة (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)) ذكر ما يشاء في التصوير، وذكر ما يشاء في الخاتمة، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا في بداية الأمر والخِلقة، يتصرف كيف يشاء، ثم (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)) يتصرف كيف يشاء في الخاتمة، إذًا تصرف في التصوير كيف يشاء، وتصرّف في الخاتمة كما يشاء.
آية البقرة تقول (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء) والمفهوم من الآية أن الله يتصرف كما يشاء (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء) (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء) صار المبتدأ والخاتمة بمشيئته سبحانه.
في نهاية البقرة ذكر من آمن بالله والملائكة والكتب والرسل (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ (285))، وذكر في أول آل عمران الكتب (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ (3))، هذه كتب، والمنزَل عليهم هم الرسل، إذًا من آمن بهذه آمن بتلك، ذكر الكتب في آخر البقرة، وذكرها في أول آل عمران.
ثم قال في خاتمة البقرة (أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)) وفي بداية آل عمران (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (4))، (قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12))، قال: فانصرنا على القوم الكافرين، ثم قال: قل للذين كفروا ستغلبون، وكأنها استجابة لهم، استجاب لهم دعاءهم. ثم ذكر (فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286))، وفي أوائل آل عمران نصر المسلمين في معركة بدر (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا (13)) فكأنها استجابة للدعاء الذي دعوا به (فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)، قل لهم، وفعل، قل لهم موجهة للكفار، قال للرسول e قل لهم ستغلبون، هم قالوا فانصرنا على القوم الكافرين، فقال تعالى قل لهم ستغلبون وفعل، إذًا استجابة بالقول وبالفعل، فهذا هو الترابط.
وقد يكون من الترابط (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (7)) إلى أن يقول (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7))، وقال في البقرة (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (286))، أنتم لا تعرفون المتشابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولا يعلم تأويله إلا الله، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هذا ليس من شأنكم، ليس في طاقتكم معرفة المتشابه (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا) ليس في طاقتكم أن تبحثوا هذا الأمر، والله لا يكلفكم هذا الأمر (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (286)) في التفكير والقصد والفعل.
ربما تكون تتمة الآية (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) هذه في العمل، وتلك في آل عمران في الاعتقاد والتفسير. حتى في التكليف أو عدم التكليف بالاعتقاد، وسعها: أي شيء ليس في وسعك لا تفكر فيه، إذن صار ترابط من حيث العمل، ومن حيث الاعتقاد والتفسير والتأويل، الذي ليس في وسعك لا يكلفك ربك به، فصار هناك ترابط في أكثر من نقطة.
مشكاة التدبر
إعداد وتقديم
فوزية وخي
مشرفة الدبلوم العالي للتدبر بمعهد تدبر
رمضان سنة 1440
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة برنامج مشكاة التدبر
تعريف البرنامج:
تدبر موضوعي للقرآن الكريم كاملا خلال سنة ونصف.
– منهجية البرنامج:
– تعريف بالسورة: (مقصدها، اسمها، فضلها، سبب نزولها، أحوال نزولها،عدد آياتها، مناسباتها).
– خصائص السورة: (الكلمات البارزة والمكررة فيها، المتشابهات، النداءات في السورة، توجيه وتدبر القراءات، القصص الواردة في السورة من الأمم الغابرة أو السيرة النبوية، الأمثال الصريحة).
– التقسيم الموضوعي للسورة: (افتتاحية السورة، محاور السورة ومناسبة كل مقطع لمقصد السورة وما قبله وما فيه من هدايات، خاتمة السورة)
– ختام المجلس: (خلاصة ما تعلمنا من السورة، رسالة وتواصي).
—————————————————-
سورة البقرة
أولًا: مقصد السورة:
إعداد الأمة لحمل أمانة الدعوة وعمارة الأرض والقيام بدين الله _عز وجل_.
ثانيًا: اسم السورة:
سورة البقرة : وردت التسمية في الحديث؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم –: “من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه”.
وسميت بالبقرة لورود قصة البقرة في السورة، ولها دلالة واضحة على مقصد السورة، سنأخذه عند حديثنا عن قصة البقرة.
الزهراوين: مع سورة آل عمران، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “اقرأوا الزهراوين: البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان -أي الظلّة- أو كأنهما فرقانٌ من طير صوافّ، تحاجّان عن أصحابهما”.
سنام القرآن:) أي أعلاه)، عن ابن مسعود مرفوعا :”إِنَّ لِكلِّ شيءٍ سَنامًا ، و سَنامُ القرآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ ، و إِنَّ الشيطانَ إذا سمعَ سورةَ البَقَرَةِ تُقْرَأُ خرجَ مِنَ البيتِ الذي يُقْرَأُ فيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ”.
فسطاط القرآن: كان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن.
ثالثًا: فضلها والترغيب في قراءتها وحفظها والعمل بها، ونذكر منها:
• عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : “لا تجعلوا بيوتكم قبورًا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان”.
• قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “اقرأوا الزهراوين: البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان -أي الظلّة- أو كأنهما فرقانٌ من طير صوافّ، تحاجّان عن أصحابهما”.
• قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة”.
• خواتيم البقرة : عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: بينما جبريل قاعد عند النبي _صلى الله عليه وسلم_ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك، فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ـ لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
• صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، {لا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَاۚ} الآية ، قال «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباس، قال الله: قد فعلت.
• عن أبي مسعود ،قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه” : قيل في كفتاه أقوالا:
1. أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن.
2. عن قراءة القرآن.
3. كفتاه كل سوء.
4. كفتاه شر الشيطان شر الإنس والجن.
5. كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر.
ولا يمنع من الجمع بين كل الأقوال والله أعلم.
• قال مسلم: عن عبد الله، قال: لما أسري برسول الله _صلى الله عليه وسلم_ انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال تعالى: { إذ يغشى السدرة ما يغشى }[ النجم: 166]، قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله _صلى الله عليه وسلم ثلاثا_: أعطي الصلوات الخمس ، وأعطي خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات.
• قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: “من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت”.
رابعًا: أحوال نزول السورة:
فيها أول ما نزل في المدينة، وفيها آخر ما نزل من القرآن الكريم.
استمر نزول سورة البقرة 10 سنوات، وهي سنوات التأسيس للمجتمع المسلم، وهي سنوات الإعداد لعمارة الأرض، وسنوات التشريع وسنوات البناء.
وهي كذلك سنوات تمايز الناس تجاه هذه الدعوة بين مؤمن خالص، وكافر خالص، ومنافق، ولم يكن ذلك في العهد المكي.
والجدير بالذكر أنه ليس للسورة سبب نزول، إلا في بعض آياتها تذكر في حينها.
خامسًا: عدد آياتها:
عدد آيات السورة: 285 بعدّ أهل المدينة ومكة والشام، 286 بعدّ أهل الكوفة، 287 بعدّ أهل البصرة.
وَقَالَ الْعَادُّونَ آيَاتُهَا مِائَتَانِ وَثَمَانُونَ وَسَبْعُ آيَاتِ وَكَلِمَاتُهَا سِتَّةُ آلاف كلمة ومائتان وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ كَلِمَةً (6221) وَحُرُوفُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَخَمْسُمِائَةِ حَرْفٍ فَاللَّهُ أَعْلَمُ (25.500).
سادسا: من خصائص السورة:
1. فيها آخر آية نزلت، وأعظم آية، وأطول آية.
2. تميزت بنزولها من بداية العهد المدني إلى نهايته.
3. تميزت بأنها أطول سورة في القرآن.
4. ذكر ابن كثير: (قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَلْفِ خَبَرٍ وَأَلْفِ أَمْرٍ وَأَلْفِ نَهْيٍ).
5. فيها تشريعات لأركان الإسلام الخمس: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام والحج، ولم تجمع في غيرها.
6. فيها الحفاظ على الضروريات الخمس: الدين، والنفس (القصاص)، والعقل (آيات السؤال عن الخمر} ، والمال (آيات الإنفاق والربا والدين {ولا تأكلوا أموالكم …}، والعرض (أحكام العدة).
7. ورد في السورة لفظ الخليفة، كوظيفة لآدم _عليه السلام_، ولم يرد في غيرها، ويدور المقصد حول هذا اللفظ.
8. ورد لفظ العهد (وما يدل عليه): 11 مرة وهو من أبرز أسباب عزل بني إسرائيل وهو خيانتهم لعهودهم ومواثيقهم مع الله _عز وجل_ ومع الناس؛ ولذا تكرر هذا المعنى في السورة.
9. النداءات:
• يا أيها الناس: وردت مرتين {اعبدوا ربكم}[البقرة: 21]، {كلوا مما في الأرض}[البقرة:168].
• يا أيها الذين آمنوا: 11 مرة من ضمن 90 نداء في القرآن الكريم.
• يا بني إسرائيل: 3 مرات (ورد 6 مرات في القرآن الكريم: مرة في طه، ومرة في الصف، ومرة في المائدة على لسان عيسى _عليه السلام_).
10. الأمثال الصريحة الواردة في سورة البقرة: 13 مثلا، توفر أركان التشبيه (المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه).
1) {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}[البقرة: 13].
2) المثل المائي والناري في المنافقين: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ}[البقرة: 17-19].
3) مثل البعوضة: {إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ}[البقرة: 26].
4) {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}[البقرة: 74].
5) { وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}[البقرة: 171].
6) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[البقرة: 183].
7) {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ}[البقرة: 214].
8) {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }[البقرة: 259].
9) {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}[البقرة: 261].
10) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}[البقرة: 264].
11) {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}[البقرة: 265].
12) {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}[البقرة: 266].
13) مثل آكل الربا: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة: 275].
11. القصص الوارد في سورة البقرة:
1) قصة آدم _عليه السلام_.
2) قصة بني إسرائيل (أصحاب السبت، جزء من عهد موسى إلى عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_).
3) وردت قصة البقرة ولم ترد في غيرها.
4) قصة طالوت وجالوت ولم ترد في غيرها.
5) قصة إبراهيم _عليه السلام_ وبناء البيت.
6) محاجة إبراهيم _عليه السلام_ للنمرود ولم ترد في غيرها.
7) ورد في السورة ست قصص لإحياء للموتى:
1) إحياء بني إسرائيل بعد صعقهم.
2) إحياء القتيل في قصة البقرة.
3) إحياء الطير في قصة طلب إبراهيم- عليه السلام- رؤية كيفية إحياء الموتى.
4) إحياء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت.
5) إثبات إحياء الله للموتى _عز وجل_ في محاجة إبراهيم _عليه السلام_ للنمرود.
6) إحياء الذي مر على قرية وهي خاوية (لم يهتم القرآن بتعيين الشخص لأن المراد الآية في ذاتها أيا كان من مر عليها).
12. أسماء الله الحسنى الواردة في السورة: 28 اسما، 429 مرة.
الاسم في البقرة في القرآن
1 الله 281 2699
2 الرب 46 978
3 العليم 21 157
4 الرحيم 12 123
5 الغفور 8 91
6 الحكيم 7 91
7 السميع 7 45
8 العزيز 6 92
9 القدير 6 45
10 البصير 5 23
11 التواب 4 11
12 الواسع 4 9
13 الحليم 3 11
14 الخبير 2 45
15 الغني 2 18
16 الرؤوف 2 10
17 البارئ 2 3
18 الرحمن 1 57
19 الحميد 1 17
20 الولي 1 15
21 المولى 1 12
22 الشاكر 1 2
23 العظيم 1 9
24 العلي 1 8
25 المحيط 1 8
26 الحي 1 5
27 القيوم 1 3
28 القريب 1 3
سابعا: موضوعات السورة:
تنقسم السورة إلى مقدمة ومحورين وخاتمة :
• المقدمة وفيها مرتكزات عمارة الأرض وأقسام الناس: من الآية 1 إلى الآية 39.
• المحور الأول: بنو إسرائيل ومبررات عزلهم: من الآية 40 إلى الآية 141 حزب ونصف.
• المحور الثاني: مقومات استحقاق هذه الأمة للخلافة وعمارة الأرض: من الآية 141 إلى الآية 283.
• الخاتمة: من الآية 284 إلى الآية 286 وهي الثلاث آيات الأخيرة.
ثامنا: افتتاحية السورة وخاتمتها:
افتتحت السورة بالتنويه بالقرآن الكريم وختمت بمدح المؤمنين به وهو المنهج الذي به تستقيم عمارة الأرض كما يرضي الله -عز وجل-.
افتتحت السورة بمدح المتقين وختمت ببيان أنهم هم أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وهم من حمل أمانة عمارة الأرض على منهاج النبوة.
تاسعا: مواضيع السورة:
1. المقدمة من الآية 1 إلى الآية 39، وتشمل:
1. الآية 1 و2: التنويه بمكانة القرآن الكريم ومقصده في هداية الناس: وهو المنهج الذي تقوم عليه عمارة الأرض وفق ما يريده الله _عز وجل_ ويرضاه، وهو كذلك الذي سينقسم الناس تجاهه.
(1) الم : التحدي به، وكذلك جاء التحدي في السورة بقوله تعالى: }وإنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ{[البقرة: 23-24].
(2) ذلك: استخدام اسم الإشارة للبعيد يفيد التعظيم لهذا الكتاب.
(3) الكتاب: ال التعريف تفيد هيمنة الكتاب، وأنه مشتمل على ما لم تشتمل عليه بقية الكتب.
(4) وصفه أنه لا ريب فيه.
(5) هدى: حذف معمول هدى تفيد إطلاقها، أي هدى لجميع مصالح الدنيا والآخرة، ففيه صلاح دنياك وآخرتك، فنرى هنا إعجاز المنهج من بداية السورة، كيف لا وقد قال تعالى: }ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير{[الملك: 14].
فإذا علمنا كل هذه الصفات الجليلة لهذا الكتاب العظيم حُقَّ لنا الأخذ به بقوة، والاهتداء به كالعطشى على مورد الماء، والبلاغ به لكل العالمين فهو الحجة البيّنة التي لا ريب فيها.
وحُقّ لنا الاعتزاز به، والتنافس عليه تلاوة وحفظا وتدبرا ودعوة، رجاء أن نكون من أهله.
2. من الآية 3-20 : أقسام الناس تجاه الإيمان والعمل به: بين مؤمن خالص، وكافر خالص، ومنافق، وجاء التطويل بثلاثة عشر آية في المنافقين لبيان خطرهم على هذه الأمة وخطرهم على المنهج عموما.
القسم الأول المؤمنون : (التقوى، الإيمان، الصلاة، الإنفاق، اليقين، الفلاح).
1) التركيز على الإيمان بالغيب وذلك لأنه: أصل الإيمان، ولذلك يقفل باب التوبة حين ينتفي الغيب ويصير شهادة إذا غرغر الإنسان، أو طلعت الشمس من مغربها.
• كما أن الإيمان بالغيب شامل للإيمان بالكتب وما جاءت فيها من أخبار وحكم وغيرها.
• وأول الغيب الإيمان بالله _عز وجل_: وقد رأينا تكرر أسماء الله _عز وجل_ في السورة وتنوعها (28 اسما 429 مرة).
• والإيمان بالله -عز وجل- هو أساس أركان الإيمان: وبقية الأركان تابعة له.
• كذلك أكثر ما يدفع على العمل هو العلم بالله _عز وجل_ بأسمائه وصفاته.
• جاء في الآيات يؤمنون ويؤمنون ويوقنون، واليقين: هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، وهو الموجب للعمل.
• الآخرة هي أكثر ما يرغب في العمل.
اليقين الذي يدفع على العمل يحتاج منا صدقا مع أنفسنا، لنراجعها، ونحاسبها، وهذا يدفعنا لنسأل أنفسنا: هل نحن موقنون بالآخرة؟ ما مدى حضور الآخرة في قلوبنا؟؟ في أذهاننا؟
يقول الله عز وجل عن الأنبياء _صلوات الله عليهم_: {إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار}[ص: 46].
جميعنا لو سئلنا عن إيماننا باليوم الآخر لأجبنا باليقين في ذلك، ولكن هل حالنا مع الله حال من يوقن أنه ملاقيه ومجازيه على أعماله؟ هل عباداتنا وتعاملاتنا تعكس إيماننا بيوم الحساب؟
ما مدى حضور الآخرة في نفوسنا؟ ولا نقصد البكاء والخوف من الموت وترك الدنيا فليس هذا المطلوب، إنما أن تكون حاضرة في أعمالك، في صلاتك، في معاملاتك مع الناس، فالآخرة ليس بعدها شيء.
هذا هو المطلوب من اليقين بالآخرة.
هذه القيم التي يجب علينا أن نغرسها في أنفسنا ابتداء وفي أبنائنا.
2) عمل الجوارح : اقتران الإيمان بالغيب بالعمل (الصلاة والإنفاق يشمل الزكاة والنفقات عموما حتى على الأهل: ففيها صلاح النفس وتزكيتها بالإنفاق، وفيها صلاح الأسرة، وفيها التكافل الاجتماعي، وغير ذلك).
والفصل بين العموم والخصوص في قوله: }والذين يؤمنون بما أنزل..{ (يشمل الإيمان بالكتب واليوم الآخر): لبيان أهمية هذا الجانب.
ولا ينفع ولا يصدق إيمان بلا عمل : فجاء يؤمنون بالغيب ثم إقامة الصلاة ثم الإنفاق ثم إيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذا خصوص بعد عموم للإيمان بالغيب.
والواقع يشهد هذا الانفصام العجيب، فتجد مسلما مؤمنا بالله إلا أنه تارك للصلاة، بذيء اللسان.. أو زاهدة في الحجاب، نمامة بين الناس!
لذلك غالبا ما نجد في القرآن الكريم اقترانا بين الإيمان والعمل، فلا تُجدي الأماني المجردة ولا يجتمع إيمان صادق مع حب الهوى!
بل كلما ارتقى إيمان العبد استصغر أعماله مهما فعل صالحا، فهو يراها قليلة حقيرة في جنب الله _عز وجل_، ولا يعلم ما كان خالصا وقُبل منها.
3) وبدأ بالهدى وختم بالهدى لبيان أن طريق الهداية هو اتباع هذا المنهج.
4) ومقتضى الهدى هو العمل لتصح فعلا الهداية.
5) ختمها بالفلاح وهي الغاية التي يسعى إليها كل إنسان، والفلاح مطلق في الدنيا والآخرة.
القسم الثاني الكفار:
صفاتهم:
أنهم لا يؤمنون، الدوام على الكفر، ختم على قلوبهم، العناد، على أبصارهم غشاوة هم من وضعها: الحق أبلج لكنهم لا يرغبون في اتباعه.
الحقُّ أَبْلَجُ والباطل لَجْلَجٌ، والمعنى: الحق واضح مُشْرِق والباطل غامض، لكنهم لا يؤمنون ليس لأنهم لا يعلمون إنما لأنهم وضعوا الغشاوة عن رؤية الحق واتباعه. يرون الحق ولا يتبعونه.
وصفهم بعد ذلك بنقض الميثاق والفساد في الأرض }الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}[البقرة: 27].
أما جزاؤهم فعذاب عظيم، مقابل الفلاح جزاء للمتقين.
القسم الثالث المنافقون:
النفاق نوعان : نفاق عقيدة ونفاق معاملة.
ونفاق عقيدة نفاق كفر.
لكن لا نسميهم كفارا، لأننا نحكم بالظاهر ونوكل السرائر إلى الله.
صفات المنافقين:
1) الكذب (تكررت)
2) الخداع (تكررت).
3) الجهل، (تكررت).
4) الغفلة.
5) السفه وقلة العقل (تكررت).
6) مرض القلوب.
7) قلب الحقائق والمسميات.
8) الإفساد في الأرض.
9) السخرية و الاستهزاء.
10) المكر.
11) الطغيان.
12) عدم الرؤية وما ينتج عنه من الحيرة والتذبذب.
13) الضلال
وجزاؤهم خسران وإملاء، قال تعالى: }اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ{[البقرة: 15-16].
السؤال: أنا أين؟ مع أي فريق؟
كم مرة نرى الحق ولا نتبعه؟؟ وهذا يجعلني أنتبه وأخشى على نفسي.
عندما ندرس صفات المنافقين ليس الهدف فقط لنعلمها، نحن غالبا إن لم يكن دائما ننزه أنفسنا ونتهم الآخرين.
فنحن نرى المنافق وصفاته، فنرمي على فلان أو فلانة ممن نعرفهم وقد يكون صحيحا لكن الخطر هو أن تكون عندي أنا هذه الصفات.
أن يكون عندي النور ويكون حجة علي يوم القيامة.
الخطر هو أن تكون لي أنا بعض صفات المنافقين.
نسأل الله الهداية والثبات على الحق.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
3. دعوة الناس لعبادة الله -عز وجل- وحده: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون}[البقرة: 21] وهو المقصد الذي خلق الإنسان لأجله، وناسب أن كان أول نداء في القرآن الكريم.
فالإنسان ذكر مقصد خلقه في سورة الذاريات في قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}[الذاريات:56] ووظيفته في سورة البقرة في قوله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة}[البقرة:30].
فلا تستقيم عمارة الأرض إلا بعبادة الله -عز وجل-، وكذلك يتفرغ ويسهل على الناس العبادة إن عمرت الأرض بالمنهج الذي يريده الله- سبحانه-، قال تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا}[النصر:1-2]، فإن انتصر الدين وتمكن في الأرض دخل الناس في دين الله -عز وجل- أفواجا وصلح حال الأرض مؤمنهم وكافرهم.
لذلك جاء الخطاب للناس كافة لأن عموم الناس مكلفون بعبادة الله -عز وجل- وحده.
وتحداهم بالقرآن أن يأتوا بمثله، وجاء الترغيب والترهيب والمثل أدلة على هذا المنهج القويم، المنهج الرباني المعجز.
ختمت المقدمة بأصل الخلقة وقصة آدم -عليه السلام-:
وتميزت قصة آدم في سورة البقرة بثلاثة أمور:
• أولًا ذكر وظيفة آدم -عليه السلام- في قوله تعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة}[البقرة:30].
• ثانيًا : تميز آدم عن بقية الخلق: بالعلم، ذكرت كلمة العلم بمشتقاتها في أربع آيات ثمان مرات. وذكرت صريحة تعليم الله لآدم وتميزه بالعلم {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ}[البقرة:31-33].
• ثالثًا: تلقين آدم التوبة: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}[البقرة:37].
ودلالات ذلك:
o أن الإنسان ضعيف، سيخطئ وسيعصي، ويتوب من وفقه الله- عز وجل- للتوبة.
o أن من لقن آدم التوبة ووفقه إليها سيرسل له منهجًا ليحقق وظيفته على الأرض وهي عمارتها وفق منهج الله -عز وجل-.
فالله_جل وعلا_ الذي خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته ولقّنه التوبة، لن يتركه بعد كل هذا ضائعا تائها، بل من كمال عناية الله -عز وجل- بآدم وذريته إرسال المنهج له، ومثل ما علم آدم يعلم ذريته.
قصة معصية آدم _عليه السلام_ هي قصتنا جميعا، فما من بشر إلا وسيخطئ ويذنب، ولا حل له سوى التوبة فورا إلى ربه _عز وجل_ الذي تاب على آدم _عليه السلام_ وبإذن الله يتوب عليه.
ووظيفة آدم _عليه السلام_ الخليفة، المميز بالعلم، هي مسيرتنا جميعا من بعده، لذا فإن الترقي في العلوم الدنيوية والدينية بعد الإيمان بالله _عز وجل_ أكثر ما ينبغي أن نحرص عليه لنحقق الاستخلاف في الأرض على مراد الله _عز وجل_.
ليس المطلوب من الجميع أن يكونوا خطباء على المنابر، بل كذلك نريد الطبيب وعالم الذرة وعالم الفيزياء وعالم الفلك..إلى غيرها من العلوم التي هي الوسيلة لتحقيق غاية الاستخلاف.
2. المحور الأول : بنو إسرائيل ومبررات عزلهم : من الآية 40 إلى الآية 123 ختمت بقصة إبراهيم من الآية 124 إلى الآية 141.
ذكرت السورة صورًا من تاريخ بني إسرائيل، ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم، ومن مواثيقهم وعهودهم، ابتداء من عهد موسى -عليه السلام- إلى عهد محمد -صلى الله عليه وسلم-.
ففيها بيان نعم الله على بني إسرائيل ثم مقابلتهم لهذه النعم بالجحود والنكران، ولذلك لم يكن ذكر النعم أو القصص الواردة في السورة بالترتيب الزمني.
ابتدأت السورة بالمن على المسلمين بالكتاب.
وابتدأت بقصة بني إسرائيل بالمن عليهم بصور شتى:
1) المنّ بندائهم ببني إسرائيل: فيها تذكيرهم بنعمة نسبهم: انتسابهم لإسرائيل أي لنبيّ (فلم يناديهم يا أهل الكتاب أو يا أيها الذين هادوا أو غيرها …).
2) تكرر تذكيرهم بالنعم {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم} وردت ثلاث مرات: في مطلع الحديث عنهم مرتين وفي ختامه مرة.
3) أمرهم بالإيمان والتلطف معهم بالرغم من فسقهم ومعاداتهم للنبي _صلى الله عليه وسلم_ قال تعالى: {وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم}[البقرة: 41] وتذكيرهم بأنهم أهل كتاب.
4) تعداد النعم عليهم.
• تفضيلهم على العالمين: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ}[البقرة: 47].
• نجاتهم من الغرق: { وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ}[البقرة: 49].
• العفو عنهم بعد عبادة العجل: {ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[البقرة : 52].
• قصة بعثهم بعد موتهم لما طلبوا رؤية الله عز وجل: {ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[البقرة: 56].
• التظليل بالغمام
• المن والسلوى.
• الأكل من الطيبات.
{وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}[البقرة: 56].
وليست الغاية تعداد النعم : إنما كيف قابلوا هذه النعم، كيف كان جحودهم و كفرانهم للنعم.
وأقول ليست الغاية التعرف على خلق وطبع بني إسرائيل فحسب، حقيقة هو من الغايات للحذر منهم، فمعرفتك بعدوك سبب في نجاتك من مكائده بإذن الله، ولكن الغاية هي محاسبة نفسي.
عددي نعم الله -عز وجل- عليك وابحثي في نفسك كيف قابلت هذه النعم؟
أولها نعمة الهداية، نعمة الصحة، نعمة الكلام، ونعمة العلم، نعمة الدفء، نعمة الطعام، نعمة الشراب، {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم}[النحل: 18].
مما قيل من اللطائف في التعبير بالمفرد في كلمة النعمة أن النعمة الواحدة لا تحصي النعم التي فيها، فكيف بغيرها من النعم.
سؤال أسأله لنفسي: كيف قابلت هذه النعم؟؟؟
نعمة الصحة ثم مرضت؟؟ أتسخط؟؟
نعم المال ثم احتجت؟؟؟ كم من مرة يكون عندي ولا أحتاج؟
نعمة الزوج لكنه صعب؟؟ شديد؟ عصبي!!!!!
نعود إلى بني إسرائيل ونتتبع أخلاقهم وطبائعهم وكيف قابلوا نعم الله_عز وجل_ عليهم.
بعد المن عليهم جاء الأمر بالصلاة :{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}[البقرة: 43]. ومناسبة الأمر بالصلاة أنهم لو أقاموا الصلاة لصلح حالهم كله، مدار كل هذه الأخلاق الذميمة من تضييع الصلاة ولو حافظوا عليها لاستقام حالهم.
جاء الأمر بالصلاة مرة أخرى: {واستعينوا بالصبر والصلاة}[البقرة: 45].
ثم ذكر صفاتهم الذميمة التي كانت سببا في عزلهم:
1. خيانة العهود: أوفوا بعهدي وردت في الحديث عن بني إسرائيل 7 مرات (6 آيات) 4 مرات بلفظ الميثاق و3 مرات بلفظ العهد.
2. عدم الخوف من الله _عز وجل_: الخوف الحقيقي هو الباعث على العمل. أنا أخاف الله؟؟ ما صدقك؟؟ الخوف ليس كلمة تقال، إنما هو شعور وعمل قلبي يؤثر على الجوارح.
3. عدم العمل بالعلم: يعلمون الحق ويخالفونه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية.
4. كتمان الحق.
5. يقولون ما لا يفعلون : يأمرون الناس بالبر ولا يفعلونه {كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون}[الصف:3].
6. قلة العقل (مع ما عرف عليهم من الذكاء) أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ذكاء من غير تزكية فلم ينفعهم ذلك.
7. فسقهم.
8. حبهم للمحسوس (للشيء المادي) وللتفصيل : عكسها الإيمان بالغيب :{وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة}[البقرة:55].
9. سوء أدبهم مع نبيهم موسى _عليه السلام_: {قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا}[الأعراف:129].
10. جبنهم بسبب حبهم للحياة (أي حياة): عاشوا في التيه بسبب جبنهم ومع ذلك منّ الله -عز وجل- عليهم بالظلال والمن والسلوى.
11. ظلمهم لنفسهم.
12. الاستهزاء بأمر الله _عزوجل_.
13. تغييرهم أمر الله _عزوجل_.
14. فسقهم عن أمر الله _عزوجل_.
15. تفرقهم (اثنتا عشرة عينا : متفرقين على 12 فريقا : حتى ظلم فرعون لم يجمعهم) فما حالنا نحن الآن؟ الله المستعان.
16. قلة العقل باستبدالهم الذي هو خير بالذي هو دونه : للأسف الناس تجري وراء الموضة والتقليد حتى رأينا هذا بأم أعيننا في كل شيء.
17. الكفر بآيات الله _عزوجل_.
18. قتل الأنبياء بغير حق.
19. عصيانهم لأوامر الله _عز وجل_ وأنبيائهم_عليهم السلام_.
20. نقضهم للميثاق: {َواذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [المائدة:7]. ونحن كيف مع ميثاقنا مع الله _عزوجل_؟
21. التولي وترك ما أمر الله _عزوجل_.
22. قصة السبت: فيها تحايل وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
23. قصة البقرة وما فيها:
قصة البقرة : وقد سميت السورة باسمها: مع أنها امتثال لأمر الله عز وجل
ما أهمية هذه القصة، حتى تذكر في السورة وتسمى باسمها؟
هذه القصة لم تذكر في غير هذه السورة، وأهم ما نأخذ منها:
1. تلكؤ بني إسرائيل في تنفيذ أمر الله_عز وجل_.
2. معاندة الأنبياء -عليهم السلام- والاستهزاء بهم.
3. التنطع والتشديد في الدين.
4. قتل النفس.
5. حب الدنيا.
وهي عكس ما يجب أن تكون عليه الأمة التي تحمل أمانة عمارة الأرض، وحمل راية الدين التي من صفاتها:
1. المبادرة.
2. الطاعة.
3. الاستسلام.
4. الحفاظ على النفس.
5. حب الآخرة.
24. تحريف كلام الله -عز وجل-: التحريف بتغييره أو بتحريف معناه.
25. كتمان الحق.
26. الاستهزاء بالمسلمين.
27. الأماني: {وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة} [البقرة:80]. أليس هذا ما يقوله بعض المسلمين الآن، اعتمادهم أن المسلم لا يخلد في النار.
28. سفك الدماء.
29. الإيمان ببعض الكتاب وترك بعضه.
30. الكبر.
31. تكذيب الرسل وقتلهم.
32. قالوا قلوبنا غلف.
33. جاءهم ماعرفوا كفروا به.
34. الاعتراض على حكم الله_عز وجل_.
35. قالوا سمعنا وعصينا.
36. الحرص على حياة.
37. كره الملائكة والاعتراض على حكم الله_عز وجل_.
38. خيانة العهود 6 مرات.
39. عدم العمل بالكتاب.
40. السحر وأكثر ما يكون عند اليهود.
41. الحسد.
42. الكره والبغض للمسلمين ومحاربتهم.
إذا:
في علاقتهم بالله -عز وجل-: خيانة لميثاقهم مع الله -عز وجل-:
• عدم الإيمان بما أنزل مع علمهم بصدقه.
• عدم اتباع ما أمر وإن آمنوا به قولا.
• عدم العمل بما علموا.
• يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض: يقبلون ما يشاؤون ويردون ما يشاؤون.
• تحريف الكتاب: يحرفون كلام الله _عزوجل_(ويدخل فيه تحريف المعنى).
• يشترون بآيات الله ثمنا قليلا: يصدرون الفتوى على هواهم.
• يتنطعون ويتشددون في الدين.
• يتحايلون على أحكام الله _عز وجل_ (أصحاب السبت).
• يستهزؤون بأحكام الله _عز وجل_{وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة}[البقرة:58].
• الاستهزاء بالأنبياء وقتلهم بغير حق.
• كره الملائكة.
• قولهم سمعنا وعصينا.
في علاقتهم بببعضهم:
• تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• يقتلون بعضهم.
• الاختلاف والفرقة.
• يؤذون بعضهم البعض.
• كتمان الحق وتزييفه.
• يقولون ما لا يفعلون.
من سوء أخلاقهم {ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلماجاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين}[البقرة: 89]. وهنا ننتبه من رد الحق إن جاء ممن نراه دوننا في العلم أو المكانة، فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها، نحن نتبع الحق حيث كان ولا نتبع الأشخاص.
في علاقتهم بالمسلمين:
• كره المسلمين وبغضهم.
• الكيد للمسلمين والمكر بهم.
• كتمانهم الحق على المسلمين.
• الاستهزاء بهم.
• المكر لصدهم عن الدين.
• محاربة المسلمين بشتى الوسائل.
• الحسد.
• الكبر.
صفات ذاتية:
• العجب.
• الحسد.
• الكبر.
• خيانة العهود والمواثيق.
• الكذب.
• الخداع.
• الجبن وحب الحياة مهما كانت.
وهذه الصفات هي منبع كل شر صدر منهم، سواء مع الله _عز وجل_، أو مع أنبيائه، أو مع بعضهم، أو مع المسلمين.
ونلاحظ أن كلها أمراض قلوب!
وهي ليست منا كذلك ببعيد، بل هي أمراض تفشت وكثرت في المجتمع المسلم، فإذا رُمنا إصلاحا فالبداية من القلب، هذه المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
فالله الله في تعاهد القلوب وتزكيتها، ومعرفة دائها لمداواتها!
•
افتتح ذكر بني إسرائيل بنعمة تفضيلهم على العالمين وختمت كذلك بها: تذكيرا بتكليفهم بحمل الأمانة وعمارة الأرض وسبب عزلهم.
o ذكرت أحوالهم قبل بعثة النبي – صلى الله عليه وسلم -.
o كما ذكرت السورة جزءًا من أحداث اليهود المعاصرين للنبي -صلى الله عليه وسلم-.
o ما ذكرناه عنهم من صفاتهم هي ثابتة فيهم وليست خاصة بمن وقعت فيهم الأحداث بدليل 3 قبائل حصون لليهود في المدينة الثلاثة خانوا العهود: 100% خيانة، والآن نفس الشيء.
سؤال : ما حال أمة محمد_صلى الله عليه وسلم_؟
كثير من هذه الصفات والأفعال التي كانت سببا في عزلهم واستبدالهم موجودة فينا _ولا حول ولا قوة إلا بالله_! ، فلو أردنا أن تعود الأمة إلى مكانتها ويمكّن الله _عز وجل_ لها، علينا بمعالجة قلوبنا وتصحيح أفعالنا وجقيقة إسلامنا بالاستسلام لله _عز وجل_، لأن السنة الإلهية أن من يتولى يُستبدل، قال تعالى: {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم} [محمد: 29].
وأمة الإسلام هي خير الأمم بشهادة القرآن الكريم، لأن الخير فيها إلى يوم الدين، فمن تولى وتخاذل استبدله الله بخير منه من الأمة التي لا تُعدم من الأخيار.
o ختم المقطع ببيان حقيقة دعوة إبراهيم -عليه السلام -:
قصة إبراهيم قصة محورية: ناسب ذكر إبراهيم -عليه السلام- أنّ كلا من اليهود والنصارى والمشركين، يدّعون نسبتهم واتباعهم لإبراهيم -عليه السلام-؛ فجاءت السورة تبين حقيقته -عليه السلام- وما كان عليه من توحيد الله -عز وجل- واستسلام لأمره واتباعًا لنهجه.
وأن الانتساب لإبراهيم -عليه السلام- انتساب اتباع وليس انتساب نسب.
المنهج الرباني لا يفرق بين أحد بجاه ولا نسب، إلا بميزان العمل.
أنه أبو الأنبياء.
نبذه للشرك.
القدوة: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه}[الممتحنة: 4] في الولاء والبراء، في صحة العقيدة، في الثبات على الحق، في التوكل على الله -عز وجل-، في الابتلاءات.
نموذج لمن عمر الأرض واتبع النهج الرباني القويم.
سرعة استسلامه لله -عز وجل-: {إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين}[البقرة: 131].
فهو نموذج لحقيقة للاستسلام .
وهي حقيقة محورية في السورة، ومحورية في الأمة لتحمل أمانة عمارة الأرض على نهج النبوة.
من خصائص قصة إبراهيم_عليه السلام_ :
1. لم تذكر ابتلاءات إبراهيم _عليه السلام_، مجملة إلا في هذه السورة، ذكرت مفرقة في الصافات: ذبح الابن، في سورة إبراهيم وضع أهله في مكة، ورد في سورة الأنبياء وغيرها قصة رميه في النار. لكن في البقرة وردت أنه ابتلي فنجح في الابتلاء واستسلم لله _عز وجل_.
2. بناؤه لبيت الله الحرام: التي ستحول له في بداية المقطع الثاني قبلة للمسلمين.
3. هذا النبي هو استجابة دعاء إبراهيم وإسماعيل -عليه السلام-، فمن اعترض عن بعثة النبي _صلى الله عليه وسلم_ من العرب سواء من اليهود أو من العرب حقيقة هو استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم _عليه السلام_.
4. أهمية العلم والتزكية : ذكرنا أهمية العلم في الأمة التي تكون أهلا لعمارة الأرض، ولكن هل ينفع علم بلا تزكية؟؟؟ معروف أن بني إسرائيل فيهم العلم، وكثير من العلماء حديثا أو في العصور الأخيرة هم من اليهود، وقد بُشر إبراهيم بغلام عليم الذي هو أبوهم إسحاق، ولكن هل نفعهم العلم؟؟؟ علم بلا تزكية جر غضبا من الله _عز وجل_، وقد جاء قبل هذه الآيات عقوبة كتمان العلم. فبنو إسرائيل أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، لم يزكيهم هذا العلم، فجاءت دعوة إبراهيم وإسماعيل _عليهم السلام_ تأكيدا على هذا المعنى. تكامل العلم مع التزكية، طهارة النفس من الرذائل ونماء الخير فيها. فالأمة التي هي أهل لحمل الرسالة وأمانة عمارة الأرض هي التي جمعت بين العلم والتزكية، بين العلم والعمل.
5. استسلام إبراهيم عليه السلام، {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}[البقرة: 131]: هذا الاستسلام الحقيقي، هذا الإسلام حقيقة، ما فيه هو حقيقة الإسلام، استسلام لأمر الله _عز وجل_ وحكمه، علمنا الحكمة أم لم نعلم. فإبراهيم تنتسب له كل اليهود والنصارى والشركين على حد السواء، ولكن هو كذلك نموذج وقدوة في الاستسلام لله _عز وجل_.
6. فيها كذلك وصية يعقوب الذي هو إسرائيل لأولاده، وهي المرة الوحيدة التي جمع في آية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كانوا إخوة وأهل، لا تفرقة بينهم، الكل على دين واحد ووصية واحدة وهي الإسلام لله _عز وجل_.
لبيان أن تفضيل بني إسرائيل كان بسبب حملهم للرسالة ودعوة إبراهيم عليه السلام، فلما تولوا استبدلهم الله _عز وجل_بأمة محمد _صلى الله عليه وسلم_.
فما نحن فاعلون؟
الآن بعد ما ذكرنا الأمة المستبدلة نبدأ في المحور الثاني وهو:
3. المحور الثاني : مقومات استحقاق هذه الأمة للخلافة : من الآية 141 إلى الآية 283
ختم المحور الأول بنموذج للمستسلم لله _عز وجل_ وحكمه: إبراهيم _عليه السلام_، وافتتح المحور الثاني بالأمر بالاستسلام لله _عز وجل_ بتغيير القبلة.
وهذا الاستسلام فيه تميّز لهذه الأمة شكلًا ومضمونًا: بتغيير القبلة.
ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى- أمانة العقيدة، وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة.
المادة الأساسية لهذا الجزء، ولبقية السورة هي إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلفة، وشخصيتها المستقلة.
المستقلة بقبلتها وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلها والمهيمنة عليها وبمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك.
المقطع الأول من المحور الثاني : من الآية 142إلى الآية 177 :
1. افتتحت بتمييز القبلة: بتغييرها من بيت المقدس إلى مكة بيت الله الحرام وموقف أعداء الدين من هذا التميز.
• بداية هي استجابة لدعوة إبراهيم –عليه السلام-: { رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}[إبراهيم: 37].
2. عندما نذكر القبلة نذكر الصلاة، قال تعالى:{واستعينوا بالصبر والصلاة}[البقرة: 45]. وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة}[البقرة: 153] وردت مرتين ولم ترد في غيرها.
o وردت كلمة الصلاة في سورة البقرة 6 مرات. غير الأمر بتغيير القبلة وهو كذلك حديث عن الصلاة.
o بيان أهمية الصلاة في بناء الأمة، أهمية الصلاة في تحمل الأمانة.
o واستعينوا بالصبر والصلاة : الأصل أن الصلاة نستعين بها، فصرنا نستعين عليها، لم؟
o لأننا لم نفقه معنى الصلاة.
o الصلاة حقيقة منَّة من الله عليّ.
o منة في ملاقاته والوقوف بين يديه. منة في مناجاته، منة في إعانتك، الصلاة منّة بكل ما في الكلمة من معنى. بكل ما في الصلاة، بكل حركة وكل كلمة فيها.
o فيها دعاء مستجاب (هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)
o وفيها أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد.
هنا نفقه معنى أن نستعين بالصبر وكذلك بالصلاة، التي هي ذاتها من وسائل الصبر. وجاء الأمر بها في سياق الحديث عن بني إسرائيل وكذلك في ختام الحديث عن تغيير القبلة التي كانت فتنة للذين في قلوبهم مرض ولم يكن إيمانهم راسخا.
لكن في المقابل عندنا مثال الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في مسجد القبلتين. نموذج للاستسلام لله _عز وجل_.
3. تغيير القبلة فيه إشارة إلى أن هذه الأمة متبوعة وليست تابعة: وجاء هذا المقصد واضحا في قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول r عليكم شهيدا}[البقرة: 143].
4. هذا التميز سيكون له أعداء كثر، وصد وهي سنة صراع الحق والباطل وما يتبع ذلك من قتال فجاء الأمر بالأخذ بوسائل الثبات والتهيؤ لهذا الصراع {واستعينوا بالصبر والصلاة}[البقرة: 45]،{ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات} [البقرة: 154]، ثم تسلية بسنة الابتلاء{ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين} [البقرة: 155]، وبعض التفصيل في موقف أهل الباطل ومظاهر قدرة الله -عز وجل- ووجوب الإخلاص له.
5. جاءت آية الصفا والمروة :
• مثال على الاستسلام : وإن كانت لفترة طويلة من شعائر المشركين، فهي حقيقة من شعائر الله _عز وجل_ وعلى الحاج والمعتمر الطواف بهما.
• وقد يكون فيها إشارة إلى قصة هاجر لما كانت تسعى بين الصفا والمروة التي ابتليت بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وكذلك استسلامها لله _عز وجل_ لما قالت إذن لن يضيعنا.
• توازن الأمة المسلمة ولو في التميز.
6. في حادثة تغيير القبلة ظهر أمر من اليهود وهو كتمان الحق، اعتراضا عليه وكرها في الحق: فجاء التغليظ عليهم في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}[البقرة: 159] و {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[البقرة: 174].
7. التغليظ على من يكتم الحق وهو عالم به.
8. وأول ما يجب بيانه هو أن الله عز وجل واحد {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}[البقرة: 163]، ثم بين دلائل وحدانيته عز وجل:{إن في خلق السماوات والأرض …} [البقرة: 164].
9. هنا ناسب ذكر الشرك في الحب {النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ}[البقرة: 165]. لأن من الوسائل المثبتة على الاستسلام لله _عز وجل_في أمره وشرعه هو حب الله -عز وجل -وحب شرعه وتقديمه على هوى النفس. والعكس كذلك. من وسائل التولي والإعراض حب غير الله -عز وجل-، كلما كنت بالله سبحانه أعرف كنت له أحب: أول ثمرة من ثمرات معرف أسماء الله -عز وجل- هي حبه.
والحب حقيقته الاتباع. ما حقيقة حبك لله _عز وجل_؟؟ الحب هو المحرك للاستسلام والطاعة، فمن ادّعى الحب فعليه بالبيّنة والبرهان.
صدق المحبة في اتباع شرع الله،
10. لما ذكر الله _سبحانه وتعالى_ حال المؤمن من الاستسلام لله _عز وجل_ وتميزه عن غيره، بيّن دلائل وحدانيته وقبح توجه القلب لغير الله -عز وجل- وأنه من الشرك بالله -عز وجل- وتبرؤ المتبوع للتابع، وأردف بربوبيته سبحانه للناس كافة مؤمن وكافر على حد السواء وحذرهم من عدوهم.
11. قد يقدم الهوى أو حب الأباء والعشيرة وغيرها على حب الله _عز وجل_. وهذا ما حصل في قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البقرة: 170] ومن الأسباب التعلق بالعادات وحب ما كان عليه الآباء . (هذه لتثبيت الحفظ: ما ألفينا)
12. ولما ذكر كفر الكافر وجحوده لله _عز وجل_ أمر المؤمن بالشكر وبين له أنه أباح له الطيبات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)}
وهذا ما وقع فيه اليهود من تقديم حبهم لأنفسهم وهواهم عما أمر الله _عز وجل_، فحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم: وكتموا حكم الله _عز وجل_ فبين أنه:
13. وحده -سبحانه- المتفرد بالتحليل والتحريم. {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[البقرة: 173] وأن هذا من مقتضى الربوبية.
14. حقيقة البر: طاعة الله _عز وجل_ والامتثال لأمره مع الإيمان الراسخ وهذا هو صدق البر الإيمان وليس ادعاء.
ختم المقطع ببيان حقيقة البر، وهو وصف جامع لأبواب الخير والجمع بين الإيمان والعمل الصالح وهو نقيض ما كان عليه بنو إسرائيل.
وتشمل العبادات والمعاملات (تأتينا آية أخرى جامعة بين الصلاة والصبر) و أقامو الصلاة: حقيقة البر هو في علاقتك بالله وعلاقتك بعباد الله.
وهذا البر الصادق {أولئك الذين صدقوا}
وهذا كأنه مدخل لبقية الأحكام الشرعية، لأن من مقتضى الألوهية التفرد بالحكم {ألا له الخلق والأمر}[الأعراف: 54].
فيما سبق ذكر: القبلة، السعي بين الصفا والمروة، وحكم الأكل والشرب.
المقطع الثاني : من الآية 178 إلى الآية 242 : تفصيل في بعض الأحكام الشرعية :
ملاحظة : في هذا المحور من السورة المحافظة على الضرورات الخمس: الدِّينِ، والنَّفسِ، والمالِ، والعِرضِ، والعقلِ:
الحفاظ على الدين وهذا بالآيات التي تتحدث عن العقيدة وأركان الإيمان وتتحدث عن الجهاد.
الحفاظ على النفس بأحكام القصاص.
الحفاظ على المال بتحريم أكلها بالباطل وأحكام المعاملات المالية تحريم الربا وآية الدين والصدقة.
الحفاظ على العرض بأحكام العدة والأحكام الأسرية.
الحفاظ على والعقل بتحريم الخمر والدعوات المتكررة للتعقل والتفكر.
1. ابتدأ بالحفاظ على الجنس البشري الذي خلقه الله لعمارة الأرض من خلال أحكام القصاص.
2. الحفاظ على المال من خلال آية الوصية {كتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ }[البقرة: 180]
3. أحكام الصيام: مدرسة التقوى وفيه كذلك تميز هذه الأمة في هذه الشريعة (بالسحور): والصيام معين على تقوى الله -سبحانه وتعالى -، وهي الدافع الكبير والأساس للاستسلام لله -عز وجل-، وهو كذلك مدرسة للصبر والثبات والوحدة (وحدة الأمة).
4. ختمت آيات الصيام بالحفاظ على الأموال وعدم أكلها بالباطل: وفيها مناسبة لطيفة أن من ترك الذي في الأصل طيبا لله _عز وجل_ فمن باب أولى أن لا يأكل الخبيث وهو أموال الناس بالباطل {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188].
ثم جاء الحديث عن الأهلة وارتباطها بشعيرتي الصيام والحج، فكان الحديث عن الأهلة رابطا يصل بين العبادتين وبين الجهاد كذلك لارتباطه بالشهور القمرية (الأشهر الحرم)، وهذا هو محور الحديث في الآيات المتبقية من المقطع.
5. وقد ابتدأت الآيات بالحديث عن الجهاد والأمر به وبيان غايته وأحكامه {فلا عدوان إلا على الظالمين}، ثم جاءت الإشارة إلى جهاد المال بعد جهاد النفس، وانتقل الحديث بعد ذلك إلى الحج وتفصيل أحكامه: وفيها بيان شمولية الدين، بين العبادات والمعاملات.
6. ثم جاءت مدرسة الاستسلام لله _عز وجل_: أحكام الحج وهو أكثر شعيرة يظهر فيها الاستسلام التام لله- سبحانه وتعالى-، ففي خمسة أيام :حجر يطاف حوله، وحجر يقبل، وحجر يلمس، وحجر يرمى، وحجر يرمى به، وانتقال من مكان إلى مكان استسلامًا لأمر الله- عز وجل- وشرعه.
ونجد أن الأحكام بما يصلح به حال المجتمع من وحدة وقوة وتكاتف وتكافل ودفاع عن الحق وغير ذلك.
من الآية 204 إلى الآية 212:
في ثنايا التوجيهات والتشريعات القرآنية -التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية- يجد الناظر في هذه التوجيهات كذلك منهجًا للتربية قائم على الخبرة المطلقة بالنفس الإنسانية، ومساربها الظاهرة والخفية يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها، كما يتضمن رسم نماذج من نفوس البشر، واضحة الخصائص جاهرة السمات.
نماذج البشر: الأول نموذج المرائي، الذلق اللسان. الذي يجعل شخصه محور الحياة كلها.
والثاني نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها لمرضاة الله، لا يستبقي منها بقية، ولا يحسب لذاته حسابًا في سعيه وعمله؛ لأنه يفنى في الله، ويتوجه بكليته إليه.
وهذا النموذج يستسلم لله- عز وجل – من غير طلب لمعجزات وخوارق كبني إسرائيل. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ }[البقرة: 208]. وناسب ذلك الآية {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[البقرة: 211].من يردّ الحق ولو جئته بكل البينات لأنه لا يرد الحق جهلا إنما يرده عنادا وكبرا اتباعا للهوى.
من الآية 212 إلى الآية 214: مدرسة الاختلاف والابتلاء:
ثم تأتي الآيات تبين سنن الله في الاختلاف بين البشر، وما ينتظر هذه الأمة من البأساء والضراء والجهد وهي كذلك سنة من سنن الله –عز وجل- لقيته كل جماعة حملت هذه الأمانة من قبل. {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ}[البقرة: 214].
سنة الاختلاف والتصادم، والابتلاء حد الزلزلة، وعدم مثالية الدين بل هو واقعي يخاطب الفطر.
لنعلم ان سلعة الله غالية ولا بد من دفع الثمن، فهذا خير البشر _صلى الله عليه وسلم_ ابتلي بلاء شديدا هو وأصحابه _رضوان الله عليهم_ وهي سنة جارية في كل أتباع الحق، فلا يصدنا البلاء عن الثبات على الحق، بل هو العلامة اننا على الحق!
فكم من موحد عُذّب وقُتل؟وكم من محجبة اعتُزلت واتهمت بالتخلف؟، وكم من داعية حورب؟
فلا نتوانى ونرتاب حين نعلم أنها سنة الله _عز وجل_، بل نثبنت ونتصبر ونحتسب ونلجأ إلى الله _عز وجل_.
من الآية 215 إلى 242: مدرسة العلم الشرعي: رغبة المؤمنين بمعرفة الأحكام الشرعية في كل شأن من شؤون حياتهم اليومية.
وهذه علامة المسلم: أن يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياته، فلا يقدم على عمل حتى يستيقن من حكم الإسلام فيه، وناسب ورود لفظ يسألونك 6 مرات في هذا المقطع بسؤال مباشر يسألونك. (لفظ سأل بمشتقاته ورد 14 مرات في السورة) تسأل:4، سئل:1، يسألونك: 5، ويسأل: 3، سل: 1
الاستسلام لا يعني عدم السؤال في الدين إنما ترك السؤال في ما لا فائدة فيه والامتثال حال معرفة الإجابة على السؤال.
ويكون السؤال فيما ينفع، فلا نسأل عن التفاصيل أو الأسماء التي لا تهم، ولا سؤال الاستهزاء ولا سؤال التنطع والتكلف..بل نسأل عما ينفعنا بأدب وتواضع للعلم وأهله.
بعد ما ذكر أحكاما متعلقة بالجهاد وهو دفع الشر الخارجي ذكر أحكاما تتعلق بإصلاح المجتمع الداخلي
بدأها بالحفاظ على العقل والإنفاق وإصلاح اليتامى والأحكام الأسرية.
تفاصيل في أحكام الأسرة : 221 -242: مدرسة الأسرة: وهذا في مقاصد الإصلاح الأسري الذي هو أساس إصلاح الأمة، وهو أساس قوامة اللأمة.
1. يبدأ صلاح المجتمع بصلاح الأسر فبدأ بمفهوم العناية ورعاية الضعفاء ويمثلهم اليتيم (فمن اعتنى بالضعيف لن يظلم القوي).
2. أساس الصلاح الأسري هو اختيار الزوج: تحريم زواج المؤمن من المشركة والمؤمنة من المشرك.
3. أحكام العلاقة الزوجية: حسن المعاشرة والملاطفة وتنظيم العلاقات الزوجية الخاصة بما تحسن به العشرة ويؤلف بين الزوجين، ومنها أحكام الحيض: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[البقرة: 222]. وهو يدل على عناية الله _عز وجل_ ببيان تفاصيل دقيقة لكنها مؤثرة في الأسرةككل، كذلك فيه عناية بضعف المرأة، فجعل له أحكاما خاصة، مثل تحريم الطلاق فيه.
4. أحكام الإيلاء (وهو اليمين على ترك وطء الزوجة) والطلاق والعضل (وهو المنع والتضييق).
5. الإرضاع، لما ذكر أحكام الطلاق ذكر ما يتعلق بها من احكام الرضاع لما قد يقع من انتقام أحد الطرفين من الثاني بابنه.
ونلاحظ استعمال كلمة المولود وليس الابن في قوله تعالى: {وعلى المولود له}[البقرة: 233]:
1. تذكير للأم أنه مولودها.
2. تذكير للأب بفضل أم الولد.
6. النفقة.
7. العدة والمتوفى عنها زوجها.
أساس صلاح الأمة هو صلاح الأسرة.
لذلك جاء الحديث عنها مفصلا بأحكام قبله (حسن الاختيار على أساس الإيمان)، وخلاله (أحكام المحيض، حسن العشرة، وبعده (أحكام الطلاق والإيلاء والخلع والنفقة والعدة والإرضاع)، لأن الأسرة هي الحصن الأول للأمة فعلى هذا الحصن أن يكون منيعا، وإن انتهت العلاقة بين الزوجين فإن الحقوق تُحفظ، والفضل لا يُنسى..ومن كان مستسلما لأوامر الله _عز وجل_ في شأن زوجه وأسرته كان كذلك في غيرها، واستطاع تحقيق الخلافة.
وبيوت المسلمين لو قامت على هذه الأسس الربانية لما وجدنا فيها ظلما ولا فحشا، فإما أن يكون إمساكا بمعروف أو تسريح بإحسان.
ورد الحديث عن الصلاة في سياق أحكام الطلاق لبيان أن الإسلام منهج كامل وتشريع شامل، فكما يجب الإلتزام بما سبق من أحكام كذلك يجب المحافظة على الصلاة، والذي يؤدي حق العباد لا بد من باب أولى أن يؤدي حق الله _تعالى_ فإنه أعظم الحقوق.
كذلك لما كانت المشكلات الزوجية والأزمات الأسرية ممما يشغل الإنسان عن غاية وجوده، ذكّره االمولى _عز وجل_ بتلك الغاية الكبرى وهي عبادته تعالى التي من أجلها خلقنا، فلا ينبغي أن يشغلنا شاغل عن تلك الغاية.
كذلك فإن الصلاة ترويح للنفوس وتطييب للقلوب وزاد للأرواح، فعلى المؤمن أن يستعين بالصلاة على مواجهة مشاكله، فالصلاة قرة للعيون وتربية للنفوس.
بعد أن استفاضت الآيات في الحديث عن إصلاح المجتمع الصغير (الأسرة) شرعت في الحديث عن إصلاح المجتمع الأكبر والدنيا كلها: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ}[البقرة: 222]
ثم جاءت قصة طالوت وجالوت، وهي نموذج مشرق من بني إسرائيل ونموذج عكسي، وهو طبعهم الغالب ومنه الجبن والتخاذل والإستهزاء بالنبي والاعتراض على حكم الله –عز وجل-، ومعصية النبي (هل يحتاج النبي لآية تدل على صدقه من مصدقيه من قومه المصدقين به ليدخلوا الأقصى لينصرهم الله، ومع ذلك نصروا بالفئة القليلة التي صدقت وثبتت وتوكلت على الله –عز وجل- وحققت الشروط: ليس العبرة بالكثرة إنما العبرة بالصدق طالوت {قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين}[البقرة: 250] كانت هناك نماذج مشرقة في بني إسرائيل.
{وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين}[ آل عمران: 147].
المقطع السابع : قصص الإحياء والإماتة وحقيقة الموت والحياة في خمس قصص 243 – 260 :
1. قصة البقرة.
2. قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت.
3. الذي حاج إبراهيم في ربه.
4. الذي مات مائة عام (عزير).
5. إبراهيم وإحياء الطير.
مناسبة المقطع : بعد الحديث عن الإصلاح الأسري يعرف بحقيقة الدنيا : ثم بالحديث عن الجهاد وصلاح الأمة
وكل هذه الأحكام متعلقة بتعظيمك لله _عز وجل_: وكلما كان حب الله –عز وجل- في قلب العبد أكبر كلما استجاب العبد لربه أسرع.
ومن وسائل المعينة على حب الله وتعظيمه معرفة الله -عز وجل- بأسمائه وصفاته، وكذلك وقدرته على إحياء الموتى في الدنيا والآخرة.
لذلك كانت آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن تعرفك بربك وهي محور السورة من حيث معرفة العبد بربه دافع للاستسلام لحكمه وشرعه وعمارة الأرض على النهج الذي يرضيه.
الرابط بين أحكام الأسرة والجهاد : إن تُرك الجهاد فسدت الأسر {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم}[محمد: 22].
في هذا المقطع كذلك بيان لوحدة الرسالات وأساس التوحيد :المعرفة بأسماء الله وصفاته وأفعاله.
المقطع الثامن: آية الكرسي
وهي أعظم آية في القرآن لما اشتملت عليه من تعريف بالله _عز وجل_ وتعظيمه، الذي يدفع العبد إلى طاعته وحبه والاستسلام لأوامره، فهي آية محورية في السورة.
المقطع التاسع : المعاملات المالية : 261 – 283
حفظ المال وتنميته وهو من أهم أسس بناء المجتمع، وأهم هادمات العلاقات المالية في المجتمع الربا: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}[البقرة: 279].
1) الصدقة والترغيب فيها.
2) تحريم الربا والتغليظ فيه.
3) الدَّين.
وناسب الحديث عن المعاملات المالية في هذه السورة :
1) أن المعاملات المالية أكثر مايفسد العلاقات.
2) التكافل الاجتماعي أساس بناء الأمم وصلاحها.
4. الخاتمة : من 284 – 286 إخلاص العبادة لله، الشهادة للنبي والمؤمنين وصفاتهم.
صفاتهم:
• لا يفرقون بين الرسل.
• يجمعون بين الإيمان والعمل.
• أهمها الاستسلام لله –عز وجل- سمعنا وأطعنا والاعتراف بالتقصير.
هؤلاء الذين الذين استحقوا أن يكون الله مولاهم وناصرهم، قال: الله فعلت.
ختمت السورة بالشهادة للأمة بالإيمان والاستسلام لله- عز وجل-، وهي أهم مقومات الأمة المستحقة لأمانة الخلافة وعمارة الأرض على منهج رباني قويم، كرّمها الله _عز وجل_ بالتخفيف عنها {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها}، واستجابة الله _عز وجل_لدعائها.
خلاصة ما تعلمنا من السورة:
– إن الله -عز وجل- خلقنا لعمارة الأرض وأرسل لنا رسلا يبينون لنا المنهج القويم، فاختلف الناس حول المنهج بين مؤمن ظاهرًا وباطنًا، عاملًا بكتاب الله _عز وجل_، مستسلمًا لأمره، وبين مكذب بكتاب الله كافرًا به، وبين مسلم ظاهرًا وكافر باطنًا، وهو المنافق، وهؤلاء أشد خطرًا على الأمة من غيرهم.
– خلقنا الله -عز وجل – وميزنا بالعلم وأهّلنا لعمارة الأرض، فهل أخذنا بالأسباب لذلك؟
– فضَّل الله -عز وجل- بني إسرائيل على العالمين في زمانهم بما تميزوا به من إيمان، فلما فسقوا وبدلوا وخانوا عهودهم ومواثيقهم مع الله -عز وجل- ومع عباده، استبدلهم الله بأمة محمد -صلى الله عليه وسلم -خير الأمم، فهلا اعتبرنا؟
– ميز الله -عز وجل- هذه الأمة عن بقية الأمم، وأنزل لها كتابا يصلح به حالها في الدنيا والآخرة، فهل تمسكنا بهذا الكتاب وعملنا به؟
– تعلمنا من السورة أن من أهم مقومات الأمة الاستسلام لأمر الله- عز وجل-، علمنا الحكمة من التشريع أم لم نعلم.
– تعلمنا أن كل ما أمرنا الله -عز وجل- به هو خير لنا ولأمتنا.
– تعلمنا أن الله أكرمنا بهذا الكتاب الخاتم المهيمن على بقية الكتب.
– تعلمنا أن الدين عبادات ومعاملات، لتصلح علاقتي بالله -عز وجل- وبعباده.
– تعلمنا من هذه السورة تكامل الدين وشموله لجميع شؤون الحياة.
– تعلمنا من السورة قدرة الله -عز وجل- وسعة علمه وحكمته ،تقدست أسماؤه وكملت صفاته- سبحانه-، رب رحيم، خلق الخلق وأرسل لهم الرسل ليهدوهم إلى الطريق المستقيم، ويوفقهم للهداية والتوبة ويقبلها منهم.
– تعلمنا من السورة أن الله -عز وجل- خلق الخلق لعمارة الأرض ولم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملًا، وستكون العاقبة للمتقين.
– تعلمنا أن الله-عز وجل- مولانا ونعم النصير ما تمسكنا بهذا الدين القويم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
رحلة تدبر في سورة البقرة
د. محمد الربيعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والحمد لله الذي جعل هذا القرآن هدى للمتقين (إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (9) الإسراء) هذا كتاب الله عز وجل هو المعجزة الكبرى والمعجزة الخالدة إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء لعلنا نعيش وإياكم في ظل هذا الملتقى المبارك ملتقى “متدبر” مع سورة عظيمة تمثل إعجاز القرآن العظيم لنعلم أن كتاب الله تعالى هو الكتاب الخالد الكامل، هو الكتاب الذي لن يصلح العالم إلا به، ولن تهتدي الأمة ولن تبلغ سبيلا من العز والتمكين والاستقرار في جميع شوؤنها إلا بهذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح “تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله” فما أعظم أن نعي ونعلم عظمة هذا القرآن الكريمة وأثره في هذه الأمة “إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويخفض به آخرين” أيها الأحبة أيها المتدبرون الذين أتيتم إلى هذا الملتقى المبارك تسعون لتحقيق شعيرة من شعائر هذا الكتاب العظيم وهي شعيرة التدبر وما أعظمها من شعيرة، هذه الشعيرة التي من عاشها سيجد مع القرآن حياة أخرى بلا شك ولا مبالغة، سيعيش هيشة هنية والله سيعيش في سياحة وسيعيش في سعادة ويعيش في راحة نفسية لا يذوقها أحد من أهل الأرض، نعم أيها الأحبة (أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الرعد) وأعظم ذكر الله تعالى كتابه. أيها الأحبة دعونا في خلال هذه الدقائق أن نعيش مع سورة عظيمة سمعنا آيات منها في صلاة العشاء والتي نسميها فسطاط القرآن، هي سورة البقرة. ولماذا سميت سورة البقرة فسطاط القرآن؟ لأن الفسطاط هو الخيمة العظيمة البهيجة التي قد ارتفع إقامتها ولها من المنظر أو لها من الحجم والمساحة ما شملت فيه مكانًا واسعًا فكأن تسمية سورة البقرة بالفسطاط أي أنها جمعت كليّات الشريعة. والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قد بلغ مبلغًا عظيمًا في تدبر كتاب الله عز وجل وفهمه قد اختصر لنا هذه السورة في سطر واحد، عجيب هذا الإمام العظيم! يقول: وقد ذكرت في مواضع ليس في موضع واحد ما اشتملت عليه السورة من أصول العلم وقواعد الدين. أيها الأحبة قد نستعرض هذا القول فنقول كل القرآن فيه أصول العلم وقواعد الدين لكنه رحمه الله قد عاش مع هذه السورة عيشاً واسعًا استطاع أن يجعلها أمامه في سطر واحد والعجيب أن من عظمة هذه السورة العظيمة أنها قد استغرق نزولها عشر سنوات فأول ما نزل في المدينة بعد الهجرة من سورة البقرة وآخر آية نزلت في المدينة من سورة البقرة إذن هي قد اشتعرقت عشر سنوات أي الفترة المدنية كلها ولا يعني استغراقها في الفترة المدنية أنه لم ينزل غيرها، بلى، قد نزل سور عظيمة وكثيرة منها آل عمران والنساء والمائدة وغيرها لكن القرآن ينزل منجّمًا فينزل بحسب الأحداث. فهذه السورة استغرق نزولها وأحداثها هذه السنين. ما السر في ذلك؟ ما السر في استغراقها هذا النزول؟ لأنها تعالج قضية عظيمة في الدولة الإسلامية الأولى. هذا الذي نريد أن نصل إليه لنعيش في ظلال هذه القضية مع السورة كلها لنعرف كيف أن هذه السورة بموضوعاتها المتعددة وقضاياها المختلفة كلها تعالج قضية واحدة. عجيب! كيف أن سورة بهذا الطول تعالج قضية واحدة؟! نعم، وهذا من أسرار القرآن وإعجازه وهذا من بلاغة القرآن وكماله فتأملوا معي أيها الأحبة ولعلكم تأخذون مصحفًا من أراد أن يتدبر معي هذه السورة.
نقول وبالله التوفيق أولاً نعرف جميعاً فضل هذه السورة وأنها سنام القرآن وأنها فسطاط القرآن وأنها السورة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعملها أمراً “تعلموا سورة البقرة وفي رواية تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإن أخذها بركة ” أخذ هذه السورة بركة يعني من استطاع أن يأخذ هذه السورة فقط لكفى، “وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة” أي السحرة وغيرهم من أرباب وأصناف وأصحاب المذاهب المختلفة المفسدون في الأرض ومنهم المنافقون. هذه السورة تأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة والله عظيمة، تأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم “يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين عملوا به -ليس الذين قرأوه وإنما الذين عملوا به- تقدمهم سورة البقرة وآل عمران” فما أعظم هذه السورة التي يوم القيامة تقدم القرآن وتقدم أصحاب القرآن، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو غيايتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لن أستطرد في فضائل السورة لأني اريد أن أعيش وإياكم رحلة ماتعة بإذن الله تعالى في سياق هذه السورة. أولًا أيها الإخوة الكرام عن ماذا تتحدث السورة؟ ما هي القضية العظيمة التي تعالجها؟ هذا القرآن لو اتخذناه منهجًا والله لعشنا في كل كمال. هذه السورة تعالج قضية الأمة المسلمة في بداية تأسيسها وكأنها باختصار في إعداد الأمة المحمدية للخلافة وتكليفها بالشريعة وأمرها بالتبليغ. هذا باختصار عما تتحدث عنه هذه السورة. أرجو أن تركزوا معي في هذه الكلمة لأنه سيتبعها سياق نسترسل فيه في ذكر الآيات مستدلين على ذلك: إعداد الأمة المحمدية للخلافة في الأرض وتكليفها بالشريعة وأمانة الله عز وجل في الأرض وأمرها بالتبليغ ونشر دين الله عز وجل. تأملوا معي يرعاكم الله في هذه السورة آية عظيمة تدل على هذا المقصد العظيم آية أو جزء من آية -لعلكم تكتشفونها- إذا وصلنا إليها نسأل.
أولًا افتتح الله عز وجل هذه السورة بآية أو آيتين هما أعظم آيتين جاء فيهما وصف القرآن العظيم (الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2))، الله أكبر! والله إن هذه الآية العظيمة أو هاتان الآيتان فيهما من وصف القرآن من الكمال الذي بلغ وجوه الكمال كله. تأملوا معي هاتان الآيتان قد اشتملت على خمسة أوصاف من أوصاف القرآن الدالة على كماله ولو كان الوقت معنا لجعلنا الأمر فيه تدبر وفيه مدارسة وهو أفضل لكن الوقت ضيق. هاتان الآيتان اشتملت على خمسة أوصاف:
الوصف الأول كمال القرآن في التحدي في إعجازه، ما هي الآية؟ (ألم (1)) ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ما من سورة افتتحت بالأحرف المقطعة إلا وجاء بعدها أو جاء في ضمنها الانتصار للقرآن الكريم، وهذه قاعدة مهمة لأهل القرآن. ما من سورة افتتحت بالحروف المقطعة إلا وجاء فيها الانتصار للقرآن العظيم في أولها أو في آخرها، هذا لعله ليس مطردًا مائة بالمائة لكن في سورة العنكبوت ربما لم يأت فيها ذلك لكن في ثناياها، هذا كمال الاعجاز.
بعد ذلك كمال المنزلة والعلو. ما الذي تشير إليه في هذه الآية؟ في هاتين الآيتين؟ ما هي الكلمة؟ (ذلك)، ولم يقل ألم هذا الكتاب وإنما قال (ذلك) دلالة على بعد منزلته. ما رأيكم لو قلتم ذلك الرجل أو هذا الرجل لا شك أنك تشير بقولك (ذلك) إلى بعد منزلته وعلوه في الرجولة فقول الله عز وجل وكلامه الأعلى (ذلك) تشير إلى علو منزلته والقرآن هو أعلى كتاب وأعلى كلام ولا شك في ذلك.
الوصف الثالث: هو كمال المضمون، كل شيء فيه، كمال مضمونه ما ترك الله شيئًا إلا وفيه دلالة عليه (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ (38) الأنعام) (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (89) النحل) أليس ذلك دليل (الكتاب) الألف واللام دالة على الاستغراق يعني دلت على جميع معاني الكتاب وتضمنه لجميع الكتب السماوية، إذن هذا هو الوصف الثالث.
الوصف الرابع: كماله في سلامته من النقص والقصور والريب والشكّ. ليس هناك كتاب على وجه الأرض ليس فيه نقص أو قصور ككتاب الله عز وجل، كتب الله جميعاً لكن هذا الكتاب أكملها (لاَ رَيْبَ فِيهِ)، وتأملوا لم يقل لا شك فيه وإنما قال (لا ريب) والريب أدق من الشك لأن الريب يشمل الشك والقلق والخوف والاضطراب أو أدنى من ذلك.
ثم تأتي آيات الوصف الخامس وهو من أعظمها وهو كمال مقصده. لماذا أنزل هذا القرآن؟ لهداية الناس (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2)).
إذن انظروا وتأملوا وتدبروا هذا الافتتاح العظيم لهذه السورة بإثبات عظمة القرآن الذي هو مصدر هذه الأمة وكتابها فلا بد أن أول ما يحتاج الأمر إلى إثبات المصدر في كماله واستحقاقه وكمال مضمونه وكمال مصدره.
ثم بعد ذكر أصناف الناس في القرآن ومواقفهم من القرآن فذكر المتقين ولم يقل المؤمنين لأن الأمر يتعلق إشارة إلى أن من الذي ينتفع بالقرآن؟ هم المتقون يعني الذين جردوا قلوبهم من موانع الانتفاع من الكبر والمعاصي والغفلة والتكذيب وغير ذلك وحلوها بأسباب الانتفاع من الاخلاص والاقبال والرغبة والصدق وحضور القلب، هذا معنى المتقين إذن هو هدى للمتقين الذين حققوا أسباب الانتفاع وتجردوا من أسباب عدم الانتفاع. ثم ذكر بعد ذلك أصناف المتقين ولا نريد أن نفصّل فيها. ثم ذكر بعد ذلك الصنف الثاني صنف الكافرين (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (6)) أي الذين كفروا بهذا القرآن وأصروا وعاندوا لا يمكن أن ينتفعوا بهذا القرآن فمن أعرض عن ذكر الله وكتابه لا يمكن أن ينتفع. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن صنف ثالث وأطال فيه وهم المنافقون ولماذا أطال فيه؟ لأن السورة نزلت لإعداد الأمة المسلمة، ولا بد في إعداد الأمة المسلمة أن تُحذَّر من أعظم أعدائها، فمن أعظم أعداء هذه الأمة المحمدية الصنفان أطالت السورة في تقريرهما الطائفة الأولى هم المنافقون وذكر الله عز وجل من أوصافهم عشراً وقرر الله تعالى في ذلك أصناف لو استعرضاها لوجدناها كأنها تصف حال المنافقين اليوم ومن أبرزها قول الله عز وجل (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ (11)) أي لا تحدثوا في الناس إفساداً في دين الله عز وجل فتشتتوا الناس عن دين الله تعالى وتثيروا الشبهات والشهوات وتصرفوا الناس بما لديكم من لسان ووسائل أخرى (قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11)) نريد أن نحقق للمجتمع تقدمًا وإصلاحًا ورقيًا نصعد به إلى مرتبة الدول المتقدمة، قال الله عز وجل (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12)).
ثم ذكر الله عز وجل بعد ذكر المنافقين وأطال ومثّلهم بمثالين المَثَل المائي والمَثَل الناري وقرره ابن القيم تقريراً عجيباً أنصحكم بقراءته. بعد ذلك جاء أول أمر في القرآن الكريم، ما هو هذا الأمر الأول؟ الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له فجمع الأصناف الثلاثة بقوله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)) ثم قرر هذه الدعوة بما يوجبها من استحقاق الله عز وجل للربوبية وأثبت بذلك أيضاً خلال هذه الدعوة كمال القرآن (وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ (23)). ثم ذكر وعيد الكافرين ثم ذكر وعيد المؤمنين وفي ذكر وعيد المؤمنين هذه الآيات من أبرز الآيات التي جاءت في وصف وعيد المؤمنين بأقسى العبارة (وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً (25)) ما معنى هذه الآية؟ ما معنى (كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ)؟ هذا المعنى أن ثمرة الجنة بعكس ثمرة الدنيا، كيف ذلك؟ ثمرة الدنيا أنت إذا أكلت الفاكهة اليوم غدًا ماذا سيكون طعمها؟ أجمل أو أقل؟ أقل، ثم بعد ذلك ربما لا تشتهيها أما ثمرة الجنة ففي كل يوم تزداد لذة في كل يوم، في كل يوم تزداد اللذة لكن الشكل هو الشكل تأتيك الرمانة هي الرمانة فتقول هذا الذي رزقنا من قبل فماذا اختلف طعمه وزاد؟ فيقال كُلوا، النوع نوع واحد والطعم مختلف. فما أجمل هذه الحياة! كل يوم يزداد لذة، تصوروا هذا النعيم! وأهل الجنة في كل أسبوع يزدادون جمالًا في كل أسبوع يزداد أهل الجنة ونساؤهم جمالًا فإنهم يذهبون لرؤية ربهم يوم الجمعة فتهب عليهم ريح الشمال فيزدادون بها جمالًا وبهاء، حسناً وجمالًا فيرجعون إلى أهليهم وزوجاتهم من الحور العين فيقول أزواجهم لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالًا فيقولون وأنتم والله ازددتم بعدنا حسناً وجمالًا في كل أسبوع! الله أكبر! ما أعظم هذا النعيم.
ثم يأتي بعد ذلك آيات في الرد على الطاعنين في القرآن يوم أن أعجزهم الله أرادوا أن يدخلوا عليه الشُبه أو الشكوك فقالوا كيف يضرب الله في القرآن المثل بالبعوضة والحمار والذباب؟ أنى لكتاب الله أن يكون كذلك، هذا كلامهم، فقال الله عز وجل (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا (26)) أي أن هذا كتاب الله عز وجل يضرب فيه ما يشاء، وهذا من كمال القرآن لتوضيح الناس بالمثال. ثم بعد ذلك تأتي القصة الأولى التي هي دليل على ما ذكرت من أن السورة في إعداد الأمة للخلافة، ما هي هذه القصة؟ هذه قصة آدم ولاحظوا وتدبروا قال الله عز وجل (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً (30)) ما قال آدم وإنما قال خليفة، من هو أول خليفة على وجه الأرض من بني البشر؟ هو آدم فذكر الله قصته لتكون تذكيرا بالأصل الأول كأن الله تعالى يقول يا بني آدم هذا أبوكم استخلفناه ليتبع الهدى ويطيع أمر الله ولذلك قال في السورة (فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (38)) من الذي اتبع الهدى آدم أم إبليس؟ هو آدم أما إبليس وذريته من الكافرين، ذريته ليست كلها كافرة لكن من الكافرين هم ممن كذبوا وكفروا. ثم في هذه الآيات ذكر الله عز وجل فضائل آدم عليه السلام ومناقبه. ما هي هذه الفضائل؟
الفضيلة الأولى الخلافة. انظروا بماذا شرفكم الله عز وجل لتعرفوا فضل الله علينا كيف أن الله شرفنا تشريفا عظيماً فأول التشريف أن الله اختارنا خلفاء في الأرض.
ثم التشريف الثاني لآدم وذريته أن الله علمه الأسماء كلها واختلاف المفسرين في هذا كبير لكن الصحيح أن الله تعالى علم آدم جميع الأسماء الدالة على المسميات والدليل على ذلك أنه أعجز الملائكة والملائكة عندهم من علم الله عز وجل لكن ليس عندهم العلم كله. قال تعالى (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ (31)) تحدى الملائكة لأجل آدم ما أ’ظم هذا من شرف! والله إنه لشرف عظيم! أريد أن أثق مع الآيات لكني أريد أن نسترسل معكم خلال السورة كلها عسى أن نقف فيها على مواضع من العبرة نعي حقيقة هذا الكتاب العظيم وهذه الآيات البينات.
من المواضع التي شرف الله تعالى فيها آدم الموضع الثالث هو موضع إسجاد الملائكة له، الملائكة المقربون البررة يسجدون لآدم! إنه والله لشرف عظيم! ما أعظم هذا لو استحضرناه (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ (34)) هذا الشرف والمنقبة الثالثة.
والمنقبة الرابعة إدخاله الجنة ما قال له اهبط إلى الأرض وقد أمرتك باتباع الهدى أولًا شرّفه بسكن الجنة ليقول له هذا مستقرك أنت وذريتك وليس إكرامًا له أن يبقى في الجنة دائمًا لأن الله تعالى خلقه ليكون خليفة في الأرض وليكون من ذريته أنبياء ورسل وصالحين وشهداء وحفظة وعلماء وما أعظم هذا الميراث العظيم! الذي سيورثهم بعد هذا الابتلاء سيورثهم تلك الجنة العظيمة. انظروا أيّ سِرٍّ عظيم وراء هذا التكريم في إدخاله الجنة ليشرفه بها ويقول له هذه جنتك ثم ينزله إلى الأرض ليختبره هو وذريته.
ويأتي التكريم الخامس في تعريضه للتوبة وتلقي توبته بالقبول ورفع شأنه وإنزال إبليس في أسفل سافلين. ما أعظم هذا الشرف! وما أعظم أن يبعثنا هذا الهدي النبوي لآدم عليه السلام أنه تلقى وتعرض لكلمات الله ولاحظوا أنه قال كلمات أي كلمات التوبة وهي في قول الله عز وجل في سورة الأعراف (قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)) هذه هي الكلمات كما ذكر بعض المفسرين وإن كانوا اختلفوا فيها.
ثم بعد قصة آدم جاءت قصة بني إسرائيل وعجيب تلك القصة كيف أن الله تعالى أطال فيها، وما شأننا ببني إسرائيل؟! نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فما الشأن وما السِرّ الإلهي العظيم حول التفصيل والتطويل والاستطراد والتبيين الواضح لقصة بني إسرائيل؟ أولاً لأنهم هم الأمة المستخلفة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يذكر الله عز وجل هذه الأمة المخالفة المعاندة التي لم تتلقَ أمر الله تعالى بالقبول ولم تحمل أمانة الله تعالى بالخلافة كما أمر الله. يبينها تعالى ويفصلها ويطيل في تقريرها لنحذر أشد الحذر من مخالفاتها وجناياتها وطبائعها ولذلك استطرد. وذكر بعض المفسرين سراً آخر في ذكر التفصيل لبني إسرائيل. أولًا من الذي نزلت فيه هذه الآيات؟ أهل المدينة، ومَنْ في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها طائفتان العرب واليهود فلا بد أن يخاطبهم القرآن ولذلك جاءت في هذه الآيات نداء إلهي عظيم، والله لقد ناداهم الله في هذه الآيات بأشرف اسم لهم “إسرائيل”. أشرف اسم عند اليهود “اسرائيل” ولذلك سموا دولتهم هذه إسرائيل. واسرائيل هو يعقوب أبوهم عليه السلام ومعنى إسرائيل عبد الله فهو اسم شريف ناداهم الله به في هذه السورة ثلاث نداءات كلها نداء فيه تلطف وفيه ترغيب وتحفيز إلى أن يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم وهذا الرسول r العظيم الذي كان في كتبهم إخبارٌ عنه (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40)) (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47)) (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122)) ثلاث مرات في أول القصة وفي وسطها وفي آخرها كل ذلك رعايةٌ من الله تعالى ودعوة لهم ولذلك قال تعالى عنهم (وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ (41)).
الأمر الثاني في سر إطالة هذه القصة قصة بني إسرائيل ذكرها بعض المفسرين قالوا أن اليهود أمة ذات جمود عقلي، جامد العقل لا تكفيه الإشارة لا بد أن تفصّل له ولا بد أن تؤكد عليه ولا بد أن تبين له فلا تكفيهم الإشارة فأراد الله عز وجل أن يبين لهم كل البيان حتى لا يكون لهم حجة واليهود هم أهل مراوغة وأهل جدل وأهل حيلة لذلك ذكر الله عز وجل هذه الصفات في هذه القصة.
أريد أن أسأل سؤالًا وعليه جائزة: ذكر الله تعالى في ثنايا قصة بني إسرائيل قصة البقرة وسمى الله تعالى بها السورة، فما سر تسمية السورة بالبقرة مع أنها من قصص بني إسرائيل وفي السورة ما هو أعظم من البقرة الكرسي، قصة طالوت، تحويل القبلة، إبراهيم (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ (124)) إلى غير ذلك فلماذا سميت هذه السورة بالبقرة وذُكِرت فيها قصة البقرة؟ قد يقول قائل لأن قصة البقرة ذكرت فيها، صحيح لكن هناك سر عظيم متعلق بهدف السورة وسياقها وهو إعداد هذه الأمة للخلافة وتكليفها بالشريعة وأمرها بالتبليغ والدعوة. ما هذا المعنى العظيم الذي نلتمسه من قصة البقرة العظيمة؟ تشير هذه القصة إلى موقف من مواقف بني إسرائيل التي هي سبب سلب الخلافة منهم، لماذا سلب الله الخلافة منهم؟ لعدة أمور منها عنادهم وقتلهم الأنبياء ومجادلتهم لكن هذه القصة تدل على صفة من صفاتهم في تلقيهم لأوامر الله. ما سرّ ذكر هذه القصة؟ كأنها تحذير لهذه الأمة من أن تشابه بني إسرائيل في تلقيها أوامر الله وتوجيه لهذه الأمة المحمدية أن تتلقى أوامر الله عز وجل بالقبول والتسليم التام والمبادرة. هذه القصة لها علاقة بالسورة كلها، كل السورة ستمر على أي حكم وأي آية ستتذكر هذه القصة. هذه القصة تشير إلى موقف بني إسرائيل من تلقيهم شريعة الله وأوامر الله، كيف تلقوها؟ انظروا إلى سفاهة هؤلاء القوم وسفولهم ودناءتهم يوم أن قال موسى عليه السلام لهم (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً (67)) لم يقل أنا آمركم وإنما قال (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً)، ماذا قالوا عياذًا بالله؟ (قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً) موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ثم يقولون بدناءتهم أتتخذنا هزوا؟ قال موسى (قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67)) ثم لم يمتثلوا وقالوا (قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ (68)) ثم لم يمتثلوا قالوا (قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا (69)) ثم لم يمتثلوا لما بينها ثم قالوا (قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70)) لما قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون بينها الله بياناً يكفي ثم ذبحوها. أرأيتم هذه الدناءة وهذا السوء في تلقي أوامر الله؟! تردد وتلكؤ وتشدد فشدد الله عليهم. ولذلك هذه السورة وهذه القصة تحذير لنا أمة الإسلام أن نتلقى أوامر الله وشريعة الله بالتردد والتلكؤ والتشدد والتباطؤ وعدم الامتثال! ولذلك قال الله عز وجل (أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ (108)) لكن هذه الأمة المرحومة والله لقد رحمها الله قد تلقت كتاب الله وشريعة الله في أكمل حال وأحسن تلقّي واستجابة وإيمان تام. ما أعظم الله! وما أرحمه بهذه الأمة!! فهذه الأمة أمة القبول والتسليم لله عز وجل (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (36) الأحزاب). الدليل على خيرية هذه الأمة وكمالها في تلقي أوامر الله شهادة الله عز وجل في آخر السورة. بعد أن بيّن الله عز وجل لهم تلك التشريعات العظيمة التي لا يحملها إلا من هيأه الله لها، بعد هذا التعليم والتربية والاعداد والتشريع، الله أكبر! تأتي الشهادة. تأتي الشهادة من الله عز وجل لهذه الأمة، ما هذه الشهادة؟ شهادة نزلت من تحت العرش “أبشر بنورين أنزلهما الله تعالى لم يؤتهما نبي قبلك” ما هاتان البشارتان؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. كنز وفي رواية “كنز” وفي رواية “بنور” وهما والله كنز!. أليست الشهادة التي يحصل عليها الطالب -ولله المثل الأعلى- كنز؟ أليست شرف؟ أليست هي نتيجة جهد سنوات بعد التعب والدراسة والسنوات التي قضاها للتعليم؟ ثم يأخذ الشهادة فيها خلاصة الأمر يتعين بها. هذه الشهادة جاءت من الله عز وجل بقوله (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ (285)) لاحظوا قوله (بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ)، (مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ) الله أكبر! شهادة للرسول وشهادة للمؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم (كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ) كما فرّق بنو إسرائيل. (وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) ولم يقولوا سمعنا وأطعنا وأننا يا ربنا قد كمُلنا في ديننا، ما قالوا كذلك! قالوا (غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) يعني يا ربنا مع أننا مستجيبين وممتثلين ونسمع ونطيع إلا أننا بشر مذنبون مقصّرون فتب علينا واغفر لنا. فماذا قال الله وهو الرحيم المعلّم؟ علمنا الدعاء ثم عفا عنا قال الله (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (286)) أي افعلوا ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. الله أكبر! هذه الأمة رفع عنها الله الآصار رفع الله عنها الأغلال والتشديد يوم أن أقبلت فمن أقبل على الله واستجاب لأمره يسّر الله أمره (فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) الليل) ما قال سنيسره لليسرى في كذا وكذا! فسنيسره لليسرى، من أقبل على دين الله برغبة وبكل شوق وكل إيمان وبكل طواعية وتذلل لله فوالله سييسر له الأمور كلها سيجد حياته مستقرة، سيجد حياته في طعم وراحة وطمأنينة.
بعد هذه القصة، قصة بني إسرائيل الطويلة التي يختمها الله بندائهم (لعلهم يرجعون) ولم يرجعوا، كم آمن من بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟! مع هذه النداءات الطويلة والآيات الطويلة والنداءات والتحذيرات والتأكيدات، كم آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما آمن إلا أقل من عشرة! أقل من عشرة آمنوا في عهد الرسول r صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا اليوم ما زال اليهود معاندون، كم سمعنا من يهودي أسلم؟ والله ما أظني سمعت إلا ثلاثة أو أربعة ولا أدري ما حالهم! لأنهم أمة غضبية غضب الله عليهم فكتب عليهم الجمود لما شدّدوا شدّد الله عليهم، لما عاندوا زادهم الله عنادًا وأضلهم وكتب عليهم الغضب (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ (7) الفاتحة) وأختم أقول والله إن القرآن لمعجز حقًا وهو المعجزة الكاملة الخالدة التي ستبقى لأمة الإسلام لو أن أمة الإسلام ارتبطت بكتاب الله عز وجل ارتباطا علميا عمليا والله ستكون أعلى أمة في الأرض حتى في زمن التقنية والتكنولوجيا وعصر الأفلاك وعصر تفجر المعلومات والله ستكون هذه الأمة أعظم أمة بهذا القرآن كما قال تعالى (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (53) فصّلت) (أنّه) أي القرآن، وكل يوم يكتشف العالم إعجازًا جديدًا فإذا القرآن يأتي ويبيّنه.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه العالمين به العاملين وأن يفتح لنا من أبواب فهمه لكتابه وأن يجعلنا من أهله حقًا في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرًا على صبركم وتحملكم وكتب الله أجركم ورفع الله قدركم بالقرآن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
متشابه رقم (1): سورة البقرة الآية 1.
قال تعالى: ﴿الم١﴾ (البقرة: 1):
ست سور افتتحت (ب الم)، وهي -حسب ترتيب المصحف-: البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة.
تميزت ب:
1. كونها غير متتالية، ويبعد القسم الثاني منها عن الأول: البقرة وآل عمران رقم 2 و3، والعنكبوت والروم ولقمان السجدة متتالية برقم 29 و30 و31 و32.
2. البقرة وآل عمران مدنية، والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة مكية.
أول وجه من أوجه الربط بين الست سور وهو الموضوع:
1) سورة البقرة: تبين المنهج الرباني لعمارة الأرض.
2) سورة آل عمران: تركز الثبات على المنهج الرباني، وتعالج بذلك قضية الشهوات والشبهات وهي أهم أسباب الزلل والزيغ، وتردّ أساسًا على شبهات النصارى.
3) سورة العنكبوت: تركز على قضية الثبات والصبر حال الابتلاء والفتن وعاقبته، فهي مواصلة لموضوع سورة آل عمران لكن من وجهة مختلفة.
4) سورة الروم: تركز على بيان الحقيقة الكونية في أن تصريف الأمور والأحوال والأحداث لله وحده، وهذا مما يقوي الإيمان واليقين في الله -عز وجل-، فهي كأنها متممة لموضوع سورة العنكبوت بتبين دلائل الوحدانية وغرس عظمة الله -عز وجل- في النفوس الداعية لإفراده سبحانه بالعبادة..
5) سورة لقمان: تركز على إبراز الحكمة الموافقة للشرع، وتذكر لقمان مثلًا لذلك، فسورة آل عمران ذكرت اصطفاء آل عمران وذلك بسبب توحيدهم لله -عز وجل- وقنوتهم له، وسورة لقمان تبين اصطفاء الله -عز وجل- للقمان بإيتائه الحكمة بتوحيده لله -عز وجل- والدعوة إلى ذلك.
6) سورة السجدة: تركز على بيان دلائل الحق ومشاهده التي نزل بها القرآن، ومنها حقيقة الخلق وأحوال الإنسان.
الخلاصة: بينت سورة البقرة المنهج الرباني الذي تستقيم به خلافة آدم -عليه السلام -على الأرض وعمارتها، وبينت وركزت سورة آل عمران على الثبات على الحق بمعالجة قضية الافتتان بالشهوات وفندت شبهات النصارى، ثم جاءت السور الأربع الباقية تعالج مسألة العقيدة من أساسها بغرس وحدانية الله -عز وجل- بالاستدلال عليها بدلائل مختلفة جمعت بين السور الأربع دلائل الخلق وهو أول دليل على الوحدانية.
وجه آخر من أوجه الربط بين الست سور وهو بدأ الخلق:
1) ذكرت في سورة البقرة قصة بدأ خلق الإنسان -آدم عليه السلام-؛ قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ٣٠﴾ (البقرة: 30).
2) وأشير إليها في سورة آل عمران قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ٥٩﴾ (آل عمران: 59).
3) وفي سورة العنكبوت ذكر بدأ الخلق؛ قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ٢٠﴾ (العنكبوت: 20)
4) ومثله في سورة الروم؛ قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ١١﴾ (الروم: 11)، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ٢٧﴾ (الروم: 27)، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ٢٠﴾ (الروم: 20).
5) وفي سورة لقمان؛ قال تعالى: ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ٢٨﴾ (لقمان: 28).
6) وفي سورة السجدة؛ قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ٩﴾ (السجدة: 7-9).
متشابه رقم (2): سورة البقرة (الآية 18 والآية 171):
قال تعالى: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ١٨﴾ (البقرة: 18).
قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ١٧١﴾ (البقرة: 171).
السؤال: ما الحكمة من نفي الرجوع في الآية الأولى ونفي العقل في الآية الثانية؟
الجواب:
المثل الأول كان في المنافقين الذين فقدوا كل استعداد للاهتداء فلا آذانهم تسمع صوت الحق ولا ألسنتهم تنطق به، ولا أعينهم تبصر آثاره، وذلك لتوغلهم في الفساد؛ فلذا هم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان بحال من الأحوال ؛ قال تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ١٧ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ١٨﴾ (البقرة: 17-18).
أما المثل الثاني فهو في الكفار الذي سُلب العقل باتباعه خطوات الشيطان واتباعه ما ألفه عن آبائه مع بطلانه، إذ لو كان يعقل لدله وسائل إدراكه (السمع والبصر) على خطيئته ولاهتدى إلى الحق؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ١٦٨ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ١٦٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٧٠ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ١٧١﴾ (البقرة: 168-170).
متشابه رقم (3): سورة البقرة (الآية 23):
1. قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ٢٣﴾ (البقرة:23).
2. قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ٣٨﴾ (يونس: 38).
3. قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ١٣﴾ (هود: 13).
ترتيب نزول السور:
السؤال الأول: ما الحكمة من التعبير في سورة البقرة (بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ) وفي سورة يونس بدون من (بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ) وفي سورة هود (سُوَر ٍمِّثْلِهِ)؟
في سورة البقرة: اختلفوا في مرجع الضمير في كلمة مثله في عوده على القرآن الكريم أو على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعلى القول الثاني المراد بالآية إراءتهم ما يرفع شكهم في نبوة محمد -- فكأنه قد قيل إن شككتم في نبوته وتخصيصنا إياه بما نزلنا عليه فأتوا برجل منكم غيره يصدر عنه أو يأتي بسورة واحدة من نمط ما سمعتم من محمد -- وإن كان كذلك فأتوا بشهداء يشهدون أن غيره قد سُمع منه ما طلبتم.
وأما المراد من سورة يونس وسورة هود: هو الإعجاز بالمجيء بما يماثل القرآن الكريم.
فمقصد آية سورة البقرة: نفي شخص يماثل الرسول -- في أن يُسمع منه ما يماثل سورة واحدة من مثل القرآن مطابقة له في فصاحته وبلاغته وعجائبه.
جمعت الأمرين نفي القدرة على إنزال (؟؟؟العبارة ناقصة راجعي الأصل )
فلما كانت سورة البقرة سورة مدنية ناسب مجيء الآية بنفي ادعاءاتهم من جميع الوجوه وتعجيزهم بها، فمنهم من قال أن القرآن ليس كلام الله -عز وجل-، ومنهم من قال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ساحر أو شاعر أو مجنون وليس مرسلًا من عند الله -عز وجل-، فجاءت مِّن مِّثْلِهِ تنفي قدرتهم على المجيء بسورة مثله، وبسورة من رجل مثله.
السؤال الثاني: ما الحكمة من التعبير في سورة البقرة (بِسُورَةٍ) ولم ترد مفتريات ومثلها في سورة يونس، أما وفي سورة هود (بِعَشْرِ سُوَر ٍمِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ)؟
جاء التعجيز في كلا سورتي البقرة ويونس بالمماثلة مطلقًا في إحكامه ونظمه وبلاغته وأنه حق وما أخبر به حق، وأحكامه حق، وأنه كتاب هداية ونور، فكان أصعب وأشق عليهم مع عجزهم في كل حال.
فجاءت موسعة في سورة هود من حيث الشروط والعدد، حيث تحداهم بأن يأتوا بالسور مفتريات، والكلام المفترى أسهل من الحق حيث لم يبق لهم من الإعجاز إلا لغتهم التي برعوا فيها، فناسبه التوسعة في العدد المطلوب.
فجاء التحدي بسورة مطابقة لسور القرآن الكريم في أوجه الإعجاز في سورتي يونس والبقرة، وجاء التحدي أن يأتوا بمثله مطابقة في بلاغته وإن كان مفترى، وجاء التحدي بأن يأتوا برجل مثله يأتهم بما يأتهم به محمد -صلى الله عليه وسلم-، فلما عجزوا عن ذلك عُلم أنه لم يبق لهم إلا العناد.
وذُكرت لطيفة في كتاب أسرار التكرار للكرماني (505 هـ) أن في هود إِشَارَة إِلَى مَا تقدمها من أول الْفَاتِحَة إِلَى سُورَة يونس وَهُوَ عشر سور .
السؤال الثالث: ما مناسبة التعبير في سورة البقرة بقوله (وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم) وفي سورتي يونس وهود (مَنِ اسْتَطَعْتُم)؟
المراد في سورة البقرة: من يشهد لكم أن شخصًا مثل محمد -صلى الله عليها وسلم- سُمع منه ما سُمع من محمد --. إذ لا يكتفي في مثل هذا بمجرد دعوى المدعى ولكن لابد من شهداء على ذلك.
أما في سورة يونس فالمراد أن يأتوا بسورة مثله ويستعينوا على ذلك (أي النظم والتأليف) بمن يقدروا لأن سماع ذلك منهم -أن لو كان ولا سبيل إليه- لا يحتاج شهادة شاهد وكذلك في سورة هود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متشابه رقم (4): سورة البقرة (الآية 34):
1. سورة البقرة: قال تعالى” ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِين﴾ (البقرة: 34).
2. سورة الأعراف: قال تعالى” ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (الأعراف: 11).
3. سورة الحجر: قال تعالى ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ٣٠ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ٣١﴾ (الحجر: 30-31).
4. سورة الإسراء: قال تعالى” ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ (الإسراء: 61).
5. سورة الكهف: قال تعالى” ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ (الكهف: 50).
6. سورة طه: قال تعالى” ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ (طه: 116).
7. سورة ص: قال تعالى” ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ٧٣ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (ص: 73-74).
السؤال: ما مناسبة مجيء وصف إبليس مجملًا في سورة البقرة ومفصلًا في باقي السور؟
ورد الأمر بالسجود لآدم في القرآن الكريم سبع مرات، في ست سور مكية وسورة مدنية وهي سورة البقرة، فجاء الحديث عن صفات إبليس مجملة في سورة البقرة، وفصلت في سائر السور المكية.
ولأن سورة البقرة تتحدث عن المنهج الرباني لعمارة الأرض، وافتتحت واختتمت بصفات المؤمنين، جاء الحديث عن معصية إبليس الظاهرة والباطنة وأسبابها، وذلك تحذيرًا لأمة محمد- صلى الله عليه وسلم- من خطورتها والوقوع في مثلها:
المعصية الظاهرة: وهي معصية الجوارح بعدم السجود لآدم -عليه السلام-: (أبَى).
سبب المعصية الظاهرة: وهو مرض القلب: الكبر (واستكبر).
سبب مرض القلب: هو جحوده نعم الله -عز وجل- ورد النعمة إلى نفسه (وكان من الكافرين).
وفي هذا بيان لعلاج هذا المرض الخبيث (الكبر) برد النعمة إلى المُنعِم- سبحانه وتعالى-.
متشابه رقم (5): سورة البقرة (الآية 35):
1. سورة البقرة: قال تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾(البقرة:35.)
2. سورة الأعراف: قال تعالى: ﴿َيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ” (الأعراف: 19.)
السؤال الأول: ما دلالة نسبة القول إلى الله -عز وجل- في نداء آدم في سورة البقرة وَقُلْنَا يَا آدَمُ وعدم نسبته في سورة الأعراف وَيَا آدَمُ؟
السؤال الثاني: ما الحكمة في العطف بالواو في قوله (وكلا) في سورة البقرة والعطف بالفاء (فكلا) في سورة الأعراف؟
السؤال الثالث: ما الحكمة في زيادة (رغدًا) في البقرة دون الأعراف؟
السؤال الرابع: ما الفرق بين (حيث شئتما) في البقرة، (ومن حيث شئتما) في الأعراف؟
في سورة البقرة جاء الحديث عن تفضيل آدم -عليه السلام- بوظيفته على الأرض، وبالعلم وبتلقينه التوبة، فناسب المقام زيادة امتنان وتكريم لآدم -عليه السلام-.
1. فجاء القول في سورة البقرة منسوبًا إلى الله تعالى: (وَقُلْنَا يَا آدَمُ) وفي سورة الأعراف: لم يأت القول منسوبًا (وَيَا آدَمُ).
2. وناسب ذلك زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع بين السكنى والأكل، فبينت أنّ كلاهما نعمة مستقلة، أما في سورة الأعراف أتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكل على السكنى المأمور باتخاذها، لأن الأكل بعد الاتخاذ.
3. وناسب زيادة كلمة: (رغدا) في سورة البقرة.
4. وناسب (حَيْثُ شِئْتُمَا) في سورة البقرة لأنه أعم من (من حَيْثُ شِئْتُمَا) في سورة الأعراف.
لطيفة: وردت كلمة رغدًا بمقابلة ما ورد في الأمر بدخول بني إسرائيل القرية وأكلهم منها ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ٥٨ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ٥٩﴾ (البقرة: 58-59)، فعصوا ربهم فخرجوا منها كما عصى آدم -عليه السلام- ربه فخرج من الجنة، وفيها توجيه لهم بالتوبة كما تاب آدم -عليه السلام-.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متشابه رقم (6): سورة البقرة (الآية 35):
قال تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: 35).
قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: 58).
السؤال الأول: ما مناسبة تقديم رغدًا في أمر آدم بالأكل من الجنة وتأخيرها في أمر بني إسرائيل بالأكل من القرية؟
كلمة رغدًا: الراء والغين والدال أصلان: أحدهما أطْيَب العيش، عِيشَةٌ رَغْدٌ ورَغَدٌ: واسِعَةٌ طَيِّبَةٌ
جاءت كلمة رغدًا في قصة آدم في الحديث عن الأكل من الجنة ولا شك أنها أكثر رغدًا من الأكل من القرية والتي يحتاج فيها إلى عناء وجهد على خلاف الجنة، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى١١٩﴾ (طه: 118-119)، فنعيمها قطعًا لا يقارن بما سيجده بنو إسرائيل في القرية..
وإن كانت الجنة هي جنة الآخرة فهي أنعم وأنعم، فجاء التقديم والتأخير للتفريق بينها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متشابه رقم (7): سورة البقرة (الآية 38):
قال تعالى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ” (البقرة38)
قال تعالى: ﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ٢٤﴾ (الأعراف24)
قال تعالى: ﴿قالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ (طه:12)
السؤال الأول: ما مناسبة مجيء الخطاب في البقرة والأعراف بالجمع (اهبطوا) وفي طه بالمثنى آدم وحواء (اهبطا)؟
السؤال الثاني: ما مناسبة ورود كلمة جميعًا في سورة البقرة وسورة طه، وعدم ورودها في سورة الأعراف؟.
السؤال الثالث: ما الحكمة من ورود (بعضكم لبعض عدو) في الأعراف وطه وعدم زيادتها في البقرة؟
السؤال الرابع: في البقرة (فمن تبع هداي) وفي طه (فمن اتبع هداي)؟
السؤال الخامس: ما مناسبة التعبير بنون المتكلم الجمع (قلنا) في البقرة والمفرد المتكلم (قال) في كل من الأعراف وطه؟
جواب السؤال الأول:
التوجيه الأول: جاء الخطاب في البقرة عن منهج عمارة بني آدم للأرض، وجاء في الأعراف سنة الصراع وجاء الخطاب لبني آدم بعد سياق القصة فناسب الخطاب بالجمع.
أما في سورة طه فجاءت في سياق الحديث عن الضعف البشري، وحملت آدم مسؤولية المعصية، ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا١١٥﴾ (طه: 115)﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى(١٢٠) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى(١٢١)﴾ (طه: 120-121). فلعله ناسب الخطاب لهما آدم وحواء.
التوجيه الثاني: في سورة البقرة جاء الحديث بالجمع عن عاقبة من اتبع وعاقبة من كفر، ومثله في سورة الأعراف، قال تعالى في سورة البقرة: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ٣٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ٣٩﴾ (البقرة: 38-39).
وفي سورة الأعراف؛ قال تعالى: ﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ٢٤ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ٢٥ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ٢٦﴾ (الأعراف: 24-26).
أما في سورة طه فجاء الخطاب لكل فريق بالمفرد؛ قال تعالى: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى١٢٣ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى١٢٤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا١٢٥﴾ (طه: 123-125).
جواب السؤال الثاني:
في سورتي البقرة وطه انتهت قصة آدم -عليه السلام- مع بيان عاقبة كل فريق من اتبع ومن أعرض، فناسب مجيء كلمة جميعا لتأكيد هبوط آدم وحواء وذريتهم، أما في سورة الأعراف تواصل الحديث عن بني آدم وندائهم في الآيات أغنى عن كلمة جميعا.
جواب السؤال الثالث:
(بعضكم لبعض عدو) لم تذكر في البقرة اكتفاء بما جاء في الآية قبلها وهو قوله “قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو”.
فلو قيل ذلك في الآية بعدها مع الاتصال لكان تكرارًا لا يُحرِز فائدة بخلاف ما في سورتي الأعراف وطه فورد كل على ما يجب ويناسب.
جواب السؤال الرابع:
(تبع)، (اتبع) محصلان للمعنى على الوفاء (أي بمعنى واحد وهو الوفاء).
وتبع فعل ثلاثي وهو الأصل، واتبع فعل خماسي مزيد فرع عنه على وزن افتعل، وزيادة المبنى زيادة المعنى.
فقدم الأصل في البقرة (تبع)، وأخر الفرع في طه (اتبع) وموافقة لقوله في سورة طه ” ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (طه: 108)”.
التوجيه الثاني: وقيل إن مناسبة الفعل الثلاثي في سورة البقرة التي تتحدث عن المنهج الرباني أنه كان تخفيفًا على أمة النبي- صلى الله عليه وسلم- مناسبة لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ٢٨٦﴾ (البقرة: 286)، أما في سورة طه فجاء على عادة القرآن الكريم بالأمر بالاتباع وفيه معنى الأخذ بقوة.
مع ثقل المسؤولية جاء بيان يسر هذا المنهج.
لما جاء ثقل المسؤولية في التكليف لآدم بالخلافة…
جواب السؤال الخامس:
في سورة البقرة جاء الأمر بالهبوط بصيغة المتكلم الجمع ((قلنا) اهبطوا منها جميعًا) وفي آية سورة الأعراف بصيغة الغائب المفرد ((قال) اهبطوا بعضكم لبعض عدو) وفي سورة طه بصيغة الغائب المفرد ((قال) اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو).
آية سورة البقرة (قلنا) جاءت مناسبة لما ذكر قبلها (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين).
آية سورة الأعراف جاءت مناسبة لما ورد قبلها (وناداهما ربهما) ألم أنهكما عن تلكما الشجرة (وأقل) لكما..) وما بعدها ((قال) فيها تحيون وفيها تموتون) بصيغة المفرد.
آية سورة طه جاءت مناسبة لما ورد قبلها (وعصى آدم (ربه) فغوى) (ثم (اجتباه ربه) (فتاب) عليه وهدى) وما ورد بعدها (فإما يأتينكم (مني) هدى) (ومن أعرض عن (ذكري)) بالمفرد هذا والله أعلم
ولعلي أضيف أن:
قصة آدم في سورة البقرة جاءت في سياق تكريمه، وبيان ميزته، وعناية الله به، ولعله ناسب معها نون العظمة قلنا تكريما لآدم.
أما في سورة الأعراف فجاءت في سياق وصف ما حصل، وبيان طريقة إغواء إبليس لآدم فناسب معها المتكلم المفرد.
وكذلك في سورة طه والتي جاءت في سياق بيان مسؤولية آدم في المعصية (فنسي وعصى فغوى).
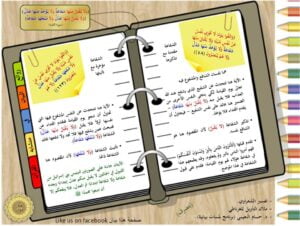 متشابه رقم (8): سورة البقرة (الآية 45):
متشابه رقم (8): سورة البقرة (الآية 45):
قال تعالى﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (البقرة:45)
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚإِن اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (البقرة:153
السؤال الأول: ما مناسبة النداء في الآية الثانية للذين آمنوا دون الآية الأولى؟
الآية الأولى كانت خطابًا للبني إسرائيل، أما الآية الثانية جاءت بالخطاب للمؤمنين في سياق بيان الأحكام للمؤمنين.
السؤال الثاني: ما سبب اختلاف التعقيب على الاستعانة بالصبر والصلاة ومناسبة كل تعقيب لسياقه؟
التوجيه الأول: قوله تعالى ” وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ” هذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل فهي تشير إلى التثاقل والتكاسل عنها الجاريين في الغالب والأكثر مع ضعف اليقين وقلة الإخلاص وذلك مناسب لحال بني إسرائيل والذي أشارت إليه الآيات من قبل.
وقد بين الله -عز وجل- في كتابه إضاعتهم للصلاة، قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا٥٩﴾ (مريم: 599).
فكلما ضعف اليقين بالله -عز وجل- كبرت الصلاة على النفس، مثل حال المنافقين الذين قال الله -عز وجل- فيهم: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا١٤٢﴾ (النساء: 142) كما قال تعالى .
أما آية ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚإِن اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ” فكان خطابًا للذين ءامنوا وحال من وسم بالإيمان هو الرضى والاستقامة ولذلك ناسب وصفهم بالصبر إذ الصبر على الطاعات يؤدى إلى حصول الدرجات فجاء كل على ما يناسب. كما تبين حال المسلم الذي يفزع إلى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة يستعين بها على أحواله مثل ما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: يا بلالُ أقمِ الصلاةَ، أرِحْنا بها فكان الجزاء معية الله -عز وجل- للصابر.
توجيه ثاني:
في بداية الحديث عن بني إسرائيل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء.
يستعين على هذه الأحكام ترغيبًا لحمل هذه الأمانة.
بيان لأثر الصلاة على الفرد في صدق تعامله مع الناس أو مع الله.
لو صلحت صلانهم لصلحت أعمالهم.
الأولى في سياق خيانتهم للعهد تركهم للصلاة.
أيضًا الثانية في سياق الحديث عن الصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع.
والأولى فى سياق عن الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متشابه رقم (9): سورة البقرة (الآية 49.)
قال تعالى:” ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (البقرة:48.)
قال تعالى:” ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (البقرة 123).
السؤال الأول: ما معنى شفاعة وعدل؟
السؤال الثاني: ما مناسبة تقديم الشفاعة في الآية الأولى وتأخير العدل والعكس في الآية الأخرى؟
السؤال الثالث: ما مناسبة مجيء فعل القبول مع الشفاعة في الآية الأولى وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ والنفع في الآية الثانية وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ؟
جواب السؤال الأول:
شفاعة: شَفَعَ فلانٌ لفلانٍ إذا جاء ثانِيه ملتمسًا مطلبه ومُعِينًا له، الشفيع هو الذي يتوسط لقضاء حاجة المشفوع له.
العدل: هو الفداء
جواب السؤال الثاني والثالث:
التوجيه الأول: الضمير في الآية الأولى راجع إلى (النفس الأولى) (الشافعة) وفي الآية الثانية يعود على (النفس الثانية) (المشفوع عنها).
فبين في الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العطاء (النداء) منها (أي من النفس الثانية المشفوع عنها)، قبل تقديم الفداء.
أما في الآية الثانية فبينت أن النفس المطلوبة بجُرمِها لا يُقبل منها عدل عن نفسها ولا تنفعها شفاعة شافع فيها؛ لأن هذه النفس ترغب في تقديم ما لديها لتفتدي به نفسها، فإن لم يكن فتطلب الشفاعة من غيرها.
ولذلك قال تعالى في الآية الأولى (ولا يقبل منها شفاعة) لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع وقال في الثانية (ولا تنفعها شفاعة) لأن الشفاعة تنفع المشفوع له.
التوجيه الثاني:
وقيل الآية الأولى إشارة إلى ما هو من طبع بني إسرائيل في الحب الشديد للمال، فقد يطلب لذلك الشفاعة فإن لم ينجح قدم ماله فداء لنفسه.
والآية الثانية: تبين نفسية الخاسر يوم القيامة وتقديمه كل ما يستطيع لفداء نفسه، فلا يقبل منه، ويرى شفاعة الشافعين في المؤمنين لكنه لا ينتفع بها، وهذه مناسبة ذكر عدم قبول الشفاعة في الآية الأولى وعدم الانتفاع بها في الآية الثانية.
فالآية الثانية زيادة في تيئيسه من النجاة من العذاب، ولذلك ناسب مجيء لا يؤخذ منها عدل في الآية الأولى، ومجيء لا يقبل منها عدل في الآية الثانية والقبول يسبق الأخذ.
وذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير قريب من هذا المعنى؛ قال: والحاصل أن الذي نفي عنه أن يكون مقبولًا قد جعل في الآيتين أولًا وذكر الآخر بعده، وأما نفي القبول مرة عن الشفاعة ومرة عن العدل فلأن أحوال الأقوام في طلب الفكاك عن الجناة تختلف، فمرة يقدمون الفداء فإذا لم يقبل قدموا الشفعاء، ومرة يقدمون الشفعاء فإذا لم تقبل شفاعتهم عرضوا الفداء .
التوجيه الثالث:
الآية تيئيس.
آخر ما يتعلق به الكافر وما يأمله وهو الشفاعة.
متشابه رقم (10): سورة البقرة (الآية 499).
قال تعالى:” ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُم بَلَاء مِّن رَّبِّكُم عَظِيم ﴾”( البقرة:49)
قال تعالى:” ﴿وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖيُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظيم﴾” (الأعراف: 141)
قال تعالى:” ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْۚوَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ “(إبراهيم:6).
السؤال الأول: جاء في التعبير في البقرة بقوله (نجيناكم) بينما في الأعراف (أنجيناكم) وفي إبراهيم (أنجاكم) فما الفرق بينها؟ وما مناسبتها للآية؟ الفعل الرباعي فعّل وأفعل
السؤال الثاني: ما مناسبة مجيء الذبح َيُذَبِّحُونَ في سورة البقرة، وسورة إبراهيم، والقتل يُقَتِّلُونَ في سورة الأعراف؟
السؤال الثالث: ما مناسبة عطف يذبحون بالواو في سورة إبراهيم، وَيُذَبِّحُونَ دون ما في سورة البقرة َيُذَبِّحُونَ وسورة الأعراف يُقَتِّلُونَ؟
جواب السؤال الأول:
(نجيناكم): نَجَّى: على وزن فَعَّل: والصيغة تدل على: التكثير والسلب والإزالة كقولك: جلَّدت البعير أي أزلت جلد البعير.
(أنجيناكم) و(أنجاكم): فعل أنجى: على وزن (أفعل): وهذه الصيغة تدل على:
1. الصيرورة: وهي انتقال الأمر من حال إلى حال.
2. الدخول في الشيء زمانًا كان أو مكانًا كأعرق أي: دخل في العراق أو أصبح: أي دخل في الصباح.
3. التمكين.
في سورة البقرة وردت قصة بني إسرائيل في سياق الامتنان على يهود المدينة ومن بعدهم بنعم الله -عز وجل- على آبائهم، وفي الآية نعمة النجاة من فرعون وعذابه وقد تمت وزال أثرها وقت الخطاب ولهذا قال: (نَجَّيناكم).
أما في كلا موضعي سورة الأعراف وسورة إبراهيم كان الخطاب فيه لبنى إسرائيل الذين تحققت لهم النجاة، فناسب المجيء بالفعل الدال على الصيرورة والدخول في الشيء والتمكين (أنجى).
جواب السؤال الثاني:
الذبح: يدل على القتل وصفته ففيه زيادة.
القتل: يدل على إعدام الحياة، فهو دال على الفعل من غير صفه.
التوجيه الأول: جاءت الآيات في سورة البقرة وسورة إبراهيم في سياق الامتنان على بني إسرائيل وتعداد النعم عليهم، ففصل فيه وذكر القتل بصفته َيُذَبِّحُونَ.
أما في سورة الأعراف فجاءت الآية في سياق ذم وتوبيخ لهم بعد طلبهم لآلهة يعبدونها بعد أن نجاهم من عذاب فرعون ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ١٣٨﴾ (الأعراف: 138).
فجاء بالفعل الدال على القتل دون الصفة يُقَتِّلُونَ. فيكفي فيه القليل.
سياق القصص وصف لما حدث بدون إضافات.
التوجيه الثاني: كذلك أن في سورتي البقرة وإبراهيم كان تذكيرهم بعد الإنجاء بفترة ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ٥﴾ (إبراهيم: 5) وفيها زيادة في الامتنان.
أما في سورة الأعراف فكانت حال خروجهم، فلا زالوا حديثي عهد بالقتل والتعذيب.
جواب السؤال الثالث:
في سورة البقرة وسورة الأعراف جعلت جملة يذبحون وجملة يقتلون بدون عطف على أنها بدل من جملة يسومونكم سوء العذاب، أما في سورة إبراهيم فجاءت جملة ويذبحون معطوفة بالواو وكأنه صنف آخر غير سوء العذاب اهتمامًا بشأنه، فعطفه من عطف الخاص على العام . وناسب ذلك آية سورة إبراهيم التي جاءت استجابة لأمر الله -عز وجل- لموسى -عليه السلام- بتذكره قومه بنعم الله عليهم. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ٦﴾ (إبراهيم: 5-6)
زيادة من موسى في بيان هذه النعم.
هل هناك تعارض بينها بالواو ومن غير.
متشابه رقم (11): سورة البقرة (الآية 51).
قال تعالى:” ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ﴾ “(البقرة:51).
قال تعالى:” ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِين لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةًۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ “(الأعراف:142).
السؤال الأول: جاءت البداية في البقرة (وإذ واعدنا) وفي الأعراف (وواعدنا)؟
السؤال الثاني: ورد عدد الليالي في البقرة مجملًا (أربعين ليلة) وفي الأعراف مفصلًا (ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر)؟
جواب السؤال الأول:
في سورة البقرة وردت الآية مبتدئة ب (وإذ) موافقة لما قبلها في تعداد النعم، أما في سورة الأعراف فالآيات قبلها معطوفة على بعضها ب (الواو)، فالبداية موافقة لسياق الخطاب والعطف في كل سورة.
جواب السؤال الثاني:
في سورة البقرة إجمال (أربعين ليلة) وفي الأعراف تفصيل (ثلاثين ليله وأتممناها بعشر) وذلك ملائمًا لجو التفصيل في سورة الأعراف فقد أفاضت في قصة موسى -عليه السلام- عمومًا، وفي قصة الميقات خصوصًا فضلًا عن كونها سورة مكية ففيها تفصيل القصة.
والإجمال في البقرة ملائم لجو تعداد النعم وسردها على سبيل الامتنان والتذكير وكذلك هي مدنية.
سياق السورة الوصفي للأحداث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متشابه رقم (12): سورة البقرة (الآية 54).
1. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ٥٤﴾ (البقرة: 54).
2. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ٦٧﴾ (البقرة: 67).
3. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ٦﴾ (إبراهيم: 6).
4. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ٥٤﴾ (البقرة: 54)
5. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ٢٠﴾ (المائدة: 20)
6. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ٥﴾ (الصف: 5)
السؤال: ما مناسبة ذكر النداء في بعض الآيات وعدم ذكره في الأخرى؟
مقصد النداء يَا قَوْمِ هو التلطف مع قومه في الخطاب ليجذب قلوبهم إلى سماعه، وكذلك تذكير لهم بما يربطهم به من رابطة الدم والقرابة التي تجعله منهم، وقد ورد النداء في سورة البقرة الآية (54)، وسورة المائـــدة الآية (20)، وسورة الصف الآية (5)، وفي كل منها مناسب لمقصد الآية.
وهذا يعطينا أدب الخطاب، مع ثقل المسؤولية أن نتلطف في الأمر.
في سورة البقرة الآية (54): جاءت الآية بالأمر بالتوبة وقتل من عبد العجل. فجاء التلطف معهم لحملهم على قبول حكم الله -عز وجل- فيمن عبد العجل.
وفي سورة المائـــدة الآية (20): جاء التذكير بنعم الله -عز وجل- العظيمة حملًا لهم على قبول الأمر بالجهاد ودخول الأرض المقدسة؛ قال تعالى: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ٢١﴾ (المائدة: 21).
وفي كلا الموضعين فيها مشقة على بني إسرائيل خاصة مع حبهم الشديد للحياة وكرههم للموت، قال الله _عز وجل_ عنهم: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ٩٦﴾ (البقرة: 96).
أما في سورة الصف الآية (5): فهو عتاب على إيذائه -عليه السلام- مع علمهم بأنه رسول من الله -عز وجل-، وهو منهم.
فناسب مجيء مزيد من العناية بالخطاب بورود النداء يا قوم.
أما بقية المواضع:
في سورة البقرة الآية (67): الأمر بذبح البقرة لمعرفة القاتل.
في سورة إبراهيم الآية (6): تذكير بني إسرائيل بنعمة نجاتهم من ءال فرعون وما كان يسومهم من ذبح الذكور واستحياء النساء للمهنة وكان ذلك مما مضى زمانه، حملًا لهم على شكر المنعم سبحانه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ٥﴾ (إبراهيم: 5).
لم يأت بمزيد اعتناء واقتصر على خطابهم دون نداء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متشابه رقم (13): سورة البقرة (الآية 57):
1. قال تعالى:” ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ “(البقرة:57).
2. قال تعالى:” ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚوَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَر فَانبَجَسَتْ مِنْه اثْنَتَا عَشْرَة عَيْنًا ۖقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚوَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚوَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (“الأعراف: 160).
3. ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ٧٠﴾ (التوبة: 70).
4. ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ٣٣﴾ (النحل: 33).
5. ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ١١٨﴾ (النحل: 118).
6. ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ٤٠﴾ (العنكبوت: 40)
7. ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ٩﴾ (الروم: 9).
8. قال تعالى:” مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚوَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ “(آل عمران:117).
9. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ٤٢ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ٤٣ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ٤٤﴾ (يونس: 42-44).
السؤال الأول: جاءت زيادة (كانوا) في سبع مواضع في القرآن الكريم -في البقرة والأعراف والتوبة ومرتين في النحل والعنكبوت والروم- وخلت منها في آيتين: آية سورة آل عمران وآية سورة يونس؟
الجواب:
لأن في السبع المواضع جاءت إخبارًا عن قوم ماتوا وانقرضوا وما في آل عمران (مَثَّل) وفي سورة يونس قاعدة وسنة من سنن الله -عز وجل-.
السؤال الثاني: مختلف الصيغ في ظلمونا.
الجواب:
في 4 آيات من سورة البقرة (57) والأعراف (160) والتوبة (70) والنحل (118): وناسب ظلمونا لبقية الأفعال بالآية وكلها بنون العظمة.
1. قال تعالى:” وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ “البقرة:57: جاء الحديث عن جحودهم لنعم الله -عز وجل- عليهم، وهم بذلك لا يظلمون إلا أنفسهم، وناسب ظلمونا لظللنا.
2. قال تعالى:” وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚوَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَر فَانبَجَسَتْ مِنْه اثْنَتَا عَشْرَة عَيْنًا ۖقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚوَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚوَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ “(الأعراف: 160) جاء الحديث عن جحودهم لنعم الله -عز وجل- عليهم، وهم بذلك لا يظلمون إلا أنفسهم، وناسب ظلمونا لبقية الأفعال بالآية وكلها بنون العظمة.
3. ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ٧٠﴾ (التوبة: 70): جاء الحديث إهلاك الله للأمم السابقة فعقب أنه لم يكن الله ليظلمهم، وناسب اسم الجلالة ما توعد به من عذاب الكفار والمنافقين، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ٦٨﴾ (التوبة: 68).
4. ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ١١٨﴾ (النحل: 118): جاء الحديث عن تحريم طيبات على الذين هادوا بسبب ظلمهم، ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا١٦٠﴾ (النساء: 160) وهذا التحريم نُسخ بشريعة محمد- صلى الله عليه وسلم-، فناسب نفي الظلم عن، وناسبت ظلمناهم حرمنا.
5. ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ٣٣﴾ (النحل: 33): جاء الحديث عن إهلاك الله للأمم السابقة فعقب أنه لم يكن الله ليظلمهم، ولما جاء اسم الله الرب ناسب مجيء اسم الجلالة، فمع إقرارهم بالربوبية أنكروا الألوهية فحق عليهم العذاب.
6. ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ٤٠﴾ (العنكبوت: 40): لما جاء تفصيل إهلاك عدد من الأمم السابقة جاء نفي الظلم بصيغة أبلغ وهي قاعدة، وبيان أن الله حرم الظلم على نفسه وما ينبغي له أن يظلم.
7. ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ٩﴾ (الروم: 9): ومثلها ما في سورة الروم.
8. قال تعالى:” مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚوَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ “(آل عمران:117).
﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ١١٣ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ١١٤ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ١١٥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ١١٦﴾ (آل عمران: 113-116) الآيات السابقة باسم الجلالة الظاهر.
9. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ٤٢ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ٤٣ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (يونس: 42-44): جاء بيان لوسائل الإدراك والتي كان ينبغي أن يستدل بها على وحدانية الله -عز وجل-، وناسب بعدها مجيء قاعدة من قواعد القرآن الكريم وهي أن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
السؤال الثالث: ما مناسبة تقديم المفعول في كل الآيات؟
إعراب القرآن وبيانه (1/ 107)
(أَنْفُسَهُمْ) مفعول به مقدّم ليظلمون (يَظْلِمُونَ) فعل مضارع والواو فاعل والجملة الفعلية خبر كانوا.
تقديم المفعول به أنفسهم على الفعل يظلمون: مزيد في الإنكار والتوبيخ، فالإنسان يكره الظلم من جبلته فكيف يظلم نفسه، ويستمر على ذلك.
بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متشابه رقم (14): سورة البقرة (الآية 58-59):
قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚوَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ “(البقرة: 59،58).
قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ . فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ “(الأعراف: 161،162).
السؤال: 10 اختلافات بين الآيتين من سورتي (البقرة) و (الأعراف)، ما مناسبتها للسور؟
الجواب: وردت الآية في سورة البقرة في سياق المن على بني إسرائيل وتعداد النعم عليهم، ومقابلتهم لها بالجحود والنكران.
أما آيات سورة الأعراف جاءت في مقام الذم والتوبيخ والتقريع، كما أن القصص سيقت في أغلبها كوصف .
سورة البقرة سورة الأعراف
1.(وإذ قلنا):
لما افتتح ذكر بني إسرائيل بذكر نِعَمِهِ تعالى عليهم بقوله “يا بني إسرائيل ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ …﴾ (البقرة: 40).
ناسب ذلك نسبة القول إليه –سبحانه- فقال (وإذ قلنا) للتكريم. 1. (وإذ قيل):
لما افتتحت الآيات بما فيه توبيخ بني إسرائيل وهو قولهم (اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون). ثم اتخاذهم العجل.
ناسب ذلك عدم إسناد الفعل إليه والبناء لما لم يسم فاعله (وإذ قيل) للتفريع.
2. (ادخلوا هذه القرية فكلوا):
لما جاء التعبير بالدخول ناسب وجود الفاء في (فكلوا) الدالة على الترتيب والتعقيب لأن الأكل لا يكون إلا بعد الدخول ولا يكون قبله بأي حال من الأحوال وإنما يكون مرتبًا عليه فجيء بالحرف المحقق لذلك المعنى.
وكذلك لأن الدخول سريع فجيء (بالفاء) الدالة على التعقيب من غير مهله.
بداية النعمة بالدخول. 2. (اسكنوا هذه القرية وكلوا):
لما جاء التعبير بالسكنى وهي معناها الاستقرار وهو ممتد يجامعه الأكل ولا يمكن أن يكون مرتبًا عليه فجيء بالحرف الدال على ذلك وهو الجمع بين السكنى والأكل (الواو).
3.(حيث شئتم رغدا):
زاد في البقرة رغدًا لأنه- سبحانه- أسند الفعل إليه والمقام مقام تكريم فالنعم به أتم. 3.(حيث شئتم):
بخلاف الأعراف جاء فيها بالقليل لأنه مقام ذم وتوبيخ.
4.(وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة):
ابتدأ الأمر في البقرة بالدخول فأتبعه ببيان كيفيته.
وحطة دعاء بمعنى حط عنا خطايانا وذنوبنا أي ارفع عنا ذنوبنا
والسجود أفضل الحالات فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقدم ما هو أفضل (وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة) لأن السجود أفضل من القول. 4.(وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا):
ابتدأ الأمر بالسكنى عمومًا فقدم القول الذي ينبغي أن يقولوه.
لما جاء الحديث عن السكن ومعناها الاستقرار قدم الحديث عن الفعل المتكرر وهو الاستغفار وأخر الفعل حال دخولهم القرية وهو الدخول سجدا. والله أعلم.
5.(نغفر لكم خطاياكم):
خطايا: جمع تكسير (يدل على الكثرة).
فلما جاء إسناد الفعل إليه -سبحانه- (وإذ قلنا) ناسب تكثير النعم والفضائل فأتى بما يدل على الكثير وذلك ليدل على كرمه- سبحانه- عليهم بتكفير خطاياهم الكثيرة.
ففيها تعظيم لمنة الله -عز وجل- عليهم –سبحانه-؛ فكأنه قال نغفر لكم خطاياكم كلها جمعاء. 5.(نغفر لكم خطيئاتكم):
خطيئات: جمع ملحق بجمع المؤنث السالم وهو يدل على القلة.
ولما كان الفعل غير مسند لله -عز وجل- بل جاء بالبناء لما لم يسم فاعله، إضافة إلى ورودها في سياق التوبيخ والذم جاء بما يدل على جمع القلة
6.(وسنزيد المحسنين):
جاء عطفًا بالواو وهو مناسب لتكثير الفضل والإنعام.
6.(سنزيد المحسنين):
جاءت الزيادة مقطوعة عن العطف (الواو) لما كان الفعل غير مسند لله والمقام توبيخ.
7.(فبدل الذين ظلموا):
في سورة البقرة لم يتقدم تمييز ولا تخصيص قبل قوله (فبدل الذين ظلموا). 7.(فبدل الذين ظلموا منهم):
لما سبق في الأعراف بتبعيض الهادين لقوله تعالى ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ١٥٩﴾ (الأعراف: 159) ناسب تبعيض الظالمين منهم بقوله (فبدل الذين ظلموا منهم).
8.(فأنزلنا على الذين ظلموا):
الإنزال أخف من الإرسال؛ لأن الإنزال يفيد حدوث الأمر واحدة وهو مناسب لمقام التكريم. 9.(فأرسلنا عليهم):
الإرسال أشد وقعًا من الإنزال؛ لأن الإرسال متواصل ومسترسل ففيه استمرار، قال تعالى: (وأرسلنا الرياح لواقح) (فأرسلنا عليهم الطوفان).
فالذي يحتاج إلى استمرارية يقول فيه الحق (فأرسلنا) وهو مناسب لمقام التقريع.
9.(على الذين ظلموا):
إظهار في مقام الإضمار؛ لأنه قوله تعالى” فبدل الذين ظلموا ” فيه إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا لعدم التخصيص من الأصل، ولذلك جاء قوله ” فأنزلنا على الذين ظلموا ” للتنصيص عليهم. 9.(عليهم):
ليس فيه تصريح بنجاة غيرهم فناسب التخصيص المقدم (فبدل الذين ظلموا منهم) ولذلك لم يتكرر”الذين ظلموا” فلم يتم التنصيص عليهم لأنه خصصهم في أول الآية (منهم) .
10.(بما كانوا يفسقون):
لما أظهر الظلم في قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا ناسب مغايرة الصفة ووصفهم بالفسق وهو الخروج عن طاعة الله- عز وجل-.
ولبيان جمعهم بين الظلم والفسق. 10.(بما كانوا يظلمون):
لما أضمر فأرسلنا عليهم ناسب التأكيد على سبب العقوبة وهي ظلمهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متشابه رقم (15): سورة البقرة (الآية 60):
قال تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَى ٰلِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖفَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًاۖ قَدْ عَلِمَ كُل أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾”(البقرة:60).
قال تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚوَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖفَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًاۖقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنّ َوَالسَّلْوَىٰۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾”(الأعراف:160)
البقرة الأعراف
1.(فانفجرت):
الانفجار: انصباب الماء بكثرة وغزارة وهذا مناسب لسياق القصة في الامتنان على بني إسرائيل. 1.(فانبجست):
الانبجاس: ظهور الماء وهذا مناسب لتقريعهم وتوبيخهم.
وقد قال بعده (كلوا من طبيات ما رزقناكم) وليس فيه (واشربوا) فلم يبالغ فيه.
2. (كلوا واشربوا)
جاءت في سياق تعداد النعم والامتنان فجاء بالأكل والشرب. 2.(كلوا من طبيات ما رزقناكم)
ناسب التقريع والتوبيخ فجاء بالأكل دون الشرب، وهو أقل في التكريم.
3.
وذكرت في سورة البقرة في آيات سابقة (الآية 57) مناسبة لزيادة تعداد النعم 3. (وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى):
ذكرت في الأعراف
4.(من رزق الله):
عمم في البقرة لأنه سيفصل بقوله (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير). 4.(كلوا من طيبات ما رزقناكم):
خصص في الأعراف مناسبة لذكر المن والسلوى قبله وهو من الطيبات.
5.(ولا تعثوا في الأرض مفسدين):
خاتمة الآية في سورة البقرة تحذير ليهود المدينة من الإفساد كأسلافهم. 5.(وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون):
خاتمة الآية في سورة الأعراف بيان ظلمهم لأنفسهم؛ لأن الخطاب في توبيخهم وتقريعهم. والقصة في سياق وصف الأحداث.
**(الخلاصـــــــــــــــــــــــــــــة)**
*سياق ذكر بني إسرائيل في ” البقرة ” الامتنان بالنعم وتعدادها على يهود المدينة تذكيرًا لهم بنعم الله على آبائهم فنسب القول إليه سبحانه فيها (وإذ قلنا) وأخبر عن أول الأمر (وادخلوا) ولازِمُه من مباشرة الأكل (فكلوا….رغدا) وأعاد الأمر بالدخول مقترنا بالقول .
(وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة) ووعد على ذلك مغفرة الخطايا على كثرتها والزيادة للمحسنين (خطاياكم- وسنزيد) وبالغ في وصف النعم (فانفجرت، كلوا واشربوا).
*سياق ذكر بني إسرائيل في “الأعراف ” سياق القَصِّ والإخبار عن ذم الله وتوبيخه لبنى إسرائيل الذين ذاقوا النعم وعاصروها وذلك :
لجحودهم وعدم شكرهم لنعم الله عليهم؛ لذا أخبر بما لم يسم فاعله (وإذ قيل) وأخبر عن آخر شأنهم (اسكنوا) ثم أخبر عن قولهم ودخولهم .
(وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدًا) وذكر غفران الخطيئات بجمع المؤنث السالم المفيد للقلة (خطيئاتكم) ولم يعطف الزيادة بالواو لأنه :
ليس مقام امتنان وتعداد للنعم (سنزيد) في حين لم يبالغ في الأعراف (فانبسجت- كلوا من طيبات…..).
وقفات تدبرية رمضان 1442هـ
سمر الأرناؤوط
#رمضان_١٤٤٢
#وقفات_تدبرية
#الجزء_١
#الجزء_٢
غالب آيات الجزء الأول في سورة البقرة نزل في السنة الأولى للهجرة وغالب آيات الجزء الثاني نزل في السنة الثانية للهجرة وفيه أحكام وتشريعات هي أسس وقواعد الأمة المسلمة الخاتمة إذ لا تقوم أمة دون منهج وتشريع وأحكام تضبط أمورها التعبدية والاقتصادية والمادية والاجتماعية والنفسية وغيرها.
🔸في الجزء الأول آية نحتاج أن نتدبرها مليّا وكم مررنا عليها سابقا دون توقف ومن توقف عندها توقف باحثا عن الإعجاز العلمي فيها وفاته الكثير من معانيها! هي آية خطيرة يرتجف القلب لها خشية أن يكون أحد الموصوفين فيها..
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27))
نتدبر (يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا) كثيرون يقرأون القرآن بما فيه من القصص والأمثال والآيات لكن هل سألنا أنفسنا من أي الكثير نحن؟
ممن ضلّ به أو ممن هُدي به؟
وهل سألنا أنفسنا ما هي صفات الفاسقين الذين ضلوا به؟ وهل فينا شيء من هذه الصفات؟
نقض عهد الله من بعد ميثاقه
قطع ما أمر الله به أن يوصل
الإفساد في الأرض
كل صفة مرتبطة بالأخرى، فمن نقض عهد الله سهل عليه قطع ما أمر الله به أن يوصل ومن فعل هذا لا يحسب للآخرة حسابا فيعيث في الأرض فسادا..
فلنراجع عهودنا مع الله لنراجع علاقاتنا وما أمرنا الله أن نصله وهو عام يشمل صلتنا بالله ورسوله والقرآن والارحام والناس ولنراجع أنفسنا هل نشارك بشيء من الفساد في الأرض؟!
تدبر الآية بقلب صادق يحدد الخلل ويمهد الطريق للإصلاح…
هذا والله أعلم.
🔹في الجزء الثاني قال تعالى في آيات الصيام (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وهذه الكلمات اليسيرة قامت عليها التشريعات في الفقه الإسلامي وهو التيسير فعندما نتدبر آيات الأحكام في الجزء الثاني من سورة البقرة علينا أن نتلقاها بمفهوم التيسير الذي أراده الله بنا عندها سنقول مباشرة سمعنا وأطعنا ربنا لكل شرعك وأحكامك وبهذا نحقق مقصود السورة بالاستسلام لأمر الله محبة وثقة ويقينا أنها تجلب التيسير لنا من رب رحيم بنا.
🔸في الجزء الثاني ذم الله تعالى بني إسرائيل على كتمانهم ما أنزل الله من البينات والهدى فقال:
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159))
ثم في آيات الصيام قال تعالى:
(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)
أنزل الله تعالى القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهل سنكتمه كما كتم بنو إسرائيل كتابهم بعدما علموا أنه الحق المبين وأنه الهدى من ربهم وأنه البينات الواضحات؟!
تحذير ينبغي أن يوقظ قلوبنا فترتيب الآيات في سور القرآن له حكمة وله رسالة أسأل الله تعالى أن يهدينا لتلقيها وفهمها والعمل بها لنكون من الذين يأخذون الكتاب بقوة وجدّ وعزيمة ليصلحوا في الأرض ولا يفسدوا وليقيموا منهج الله تعالى في أرضه وفي خلقه.
هذا والله أعلم.
#رمضان_١٤٤٢
#وقفات_تدبرية
#الجزء_٢
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) البقرة)
في الفاتحة يعلن المؤمن كل يوم توحيده الخالص لله واستعانته به وحده لأنه لا رب له ولا معين سواه، وفي سورة البقرة إرشاد من الله عزوجل للذين آمنوا إلى سبل الاستعانة به وهي:
الصبر والصلاة
ورغّبهم بهما (إن الله مع الصابرين) فما أشرف هذا الترغيب!
ثم ورد بعدها آية حتمية الابتلاء في الدنيا (ولنبلونكم.. ) فكأن الصبر والصلاة زاد المبتلى..
وسبق في الحديث عن بني إسرائيل في الجزء الأول آية مشابهة اختلفت نهايتها فقال تعالى:
(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة: 45-46]
وقد حذر القرآن من صلاة المنافقين (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) لأنهم لا يرجون لقاء الله أما المؤمن فهو متعلق بالصلاة محافظ عليها مقيم لها في أوقاتها بأركانها وواجباتها وخشوعها مستحضرا وقوفه بين يدي ربه يوم القيامة..
وفي الجزء الثاني من سورة البقرة حديث عن تحويل القبلة وتكرر في السورة بدءا من مفتتحها بصفات المتقين (ويقيمون الصلاة) إلى تكرر الأمر بإقامتها (وأقيموا الصلاة) وفي آية البرّ ذكر للصلاة (وأقام الصلاة) وذكر للصبر (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس)
وبين أيات أحكام الطلاق جاء الأمر الإلهي (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) وكلها إشارات تربط المؤمن بالصلاة لتكون مفزعه في الابتلاءات وسبيل استعانته بربه في سائر أمره فقد شرعت صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة لتعلمنا أن خير الاستعانة بالله تكون بما شرع الله عزوجل.
هذا والله أعلم.
جعلني الله وإياكم من الموحدين لله المستعينين به بالصبر والصلاة ومن الخاشعين المقيمين للصلاة..
#رمضان_١٤٤٢
#وقفات_تدبرية
#الجزء_٣
(وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) البقرة)
آخر آية نزلت من القرآن وقد وردت بين الآيات التي تتحدث عن الأحكام المالية من إنفاق، صدقات، والتحذير من خطورة الربا ثم آية الدَيْن لتوجّه العبد أن يتقي الله تعالى في تعاملاته لأنه سيحاسب عليها في الآخرة ومن أخطر التعاملات التي تشغل الناس بالدنيا وتوقعهم في الذنوب ما هو متعلق بالحقوق المالية.
(لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) البقرة)
لما نزلت الآية جثا الصحابة على الرُكب خوفا فأنزل الله تعالى بعدها التخفيف (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فالحمد الله عزوجل على رفع الحرج عن الأمة فما كنا لنطيق أن نحاسب على ما نخفي وما نعلن! ومن منا كان سينجو؟!
خواطر في سورة البقرة
(آلم “1”) بدأت سورة البقرة بقوله تعالى”ألم” .. وهذه الحروف مقطعة ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بمفرده. لأن الحرف لها أسماء ولها مسميات .. فالناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه .. فعندما تقول كتب تنطق بمسميات الحروف. فإذا أردت أن تنطق بأسمائها. تقول كاف وتاء وباء .. ولا يمكن أن ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم ودرس، أما ذلك الذي لم يتعلم فقد ينطق بمسميات الحروف ولكنه لا ينطق بأسمائها، ولعل هذه أول ما يلفتنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يكن يعرف شيئا عن أسماء الحروف. فإذا جاء ونطق بأسماء الحروف يكون هذا إعجازاً من الله سبحانه وتعالى .. بأن هذا القرآن موحى به إلي محمد صلى الله عليه وسلم .. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شيئا عاديا أن ينطق بأسماء الحروف. ولكن تعال إلي أي أمي لم يتعلم .. أنه يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف .. يقول الكتاب وكوب وغير ذلك .. فإذا طلبت منه أن ينطق بمسميات الحروف فأنه لا يستطيع أن يقول لك. أن كلمة كتاب مكونة من الكاف والتاء والألف والباء .. وتكون هذه الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه. وأن هذا القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى. ونجد في فواتح السور التي تبدأ بأسماء الحروف. تنطق الحروف بأسمائها وتجد نفس الكلمة في آية أخرى تنطق بمسمياتها. فألم في أول سورة البقرة نطقتها بأسماء الحروف ألف لام ميم. بينما تنطقها بمسميات الحروف في شرح السورة في قوله تعالى: {ألم نشرح لك صدرك “1” } (سورة الشرح) وفي سورة الفيل في قوله تعالى: {ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل “1” } (سورة الفيل)
ما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ينطق “ألم” في سورة البقرة بأسماء الحروف .. وينطقها في سورتي الشرح والفيل بمسميات الحروف. لابد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعها من الله كما نقلها جبريل عليه السلام إليه هكذا. إذن فالقرآن أصله السماع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد أن تسمعه. لتعرف أن هذه تقرأ ألف لام ميم والثانية تقرأ ألم .. مع أن الكتابة واحدة في الاثنين .. ولذلك لابد أن تستمع إلي فقيه ولا استمعوا إلي قارئ .. ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن كأي كتاب. نقول لا .. القرآن له تميز خاص .. أنه ليس كأي كتاب تقرؤه .. لأنه مرة يأتي باسم الحرف. ومرة يأتي بمسميات الحرف. وأنت لا يمكن أن تعرف هذا إلا إذا استمعت لقارئ يقرأ القرآن. والقرآن مبني على الوصل دائما وليس على الوقف، فإذا قرأت في آخر سورة يونس مثلا: “وهو خير الحاكمين” لا تجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة، موصولة بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت غير موصولة لوجدت عليها سكون.. إذن فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل .. ما عدا فواتح السور المكونة من حروف فهي مبنية على الوقف .. فلا تقرأ في أول سورة البقرة: “ألم” والميم عليها ضمة. بل تقرأ ألفا عليها سكون ولاما عليها سكون وميما عليها سكون. إذن كل حرف منفرد بوقف. مع أن الوقف لا يوجد في ختام السور ولا في القرآن الكريم كله. وهناك سور في القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى: {ص والقرآن ذي الذكر “1” } (سورة ص) {ن والقلم وما يسطرون “1” } (سورة القلم) ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة. بينما “ألم” في سورة البقرة آية مستقلة. و:”حم”. و: “عسق” آية مستقلة مع أنها كلمة حروف مقطعة. وهناك سور تبدأ بآية من خمسة حروف مثل “كهيعص” في سورة مريم .. وهناك سور تبدأ بأربعة حروف. مثل “المص” في سورة “الأعراف”. وهناك سور تبدأ بأربعة حروف وهي ليست آية مستقلة مثل “ألمر” في سورة “الرعد” متصلة بما بعدها .. بينما تجد سورة تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل: “يس” في سور يس. و”حم” في سورة غافر وفصلت .. و: “طس” في سورة النمل. وكلها ليست موصلة بالآية التي بعدها .. وهذا يدلنا على أن الحروف في فواتح السور لا تسير على قاعدة محددة. “ألم” مكونة من ثلاث حروف تجدها في ست سور مستقلة .. فهي آية في البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم والسجدة ولقمان. و”الر” ثلاثة حروف ولكنها ليست آية مستقلة. بل جزء من الآية في أربع سور هي: يونس ويوسف وهود وإبراهيم .. و: “المص” من أربعة حروف وهي آية مستقلة في سورة “الأعراف” و “المر” أربعة حروف، ولكنها ليست آية مستقلة في سورة الرعد إذن فالمسألة ليست قانونا يعمم، ولكنها خصوصية في كل حرف من الحروف. وإذا سألت ما هو معنى هذه الحروف؟.. نقول أن السؤال في أصله خطأ .. لأن الحرف لا يسأل عن معناه في اللغة إلا إن كان حرف معنى .. والحروف نوعان: حرف معنى .. والحروف نوعان: حرف مبني وحرف معنى. حرف المبنى لا معنى له إلا للدلالة على الصوت فقط .. أما حروف المعاني فهي مثل في. ومن .. وعلى .. (في) تدل على الظرفية .. و(من) تدل على الابتداء و(إلي) تدل على الانتهاء .. و(على) تدل على الاستعلاء .. هذه كلها حروف معنى. وإذا كانت الحروف في أوائل السور في القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة الوصل لأنها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة .. أولا لنعرف (آلم “1”)
ولذلك ذكرت في القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن الكريم أنا نأخذ حسنة على كل حرف. فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم. يكون لنا بالباء حسنة وبالسين حسنة وبالميم حسنة فيكون لنا ثلاثة حسنات بكلمة واحدة من القرآن الكريم. والحسنة بعشر أمثالها. وحينما نقرأ “ألم” ونحن لا نفهم معناها نعرف أن ثواب القرآن على كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم لم نفهمه .. وقد يضع الله سبحانه وتعالى من أسراره في هذه الحروف التي لا نفهمها ثوابا وأجرا لا نعرفه. ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر.. والقرآن الكريم ليس إعجازا في البلاغة فقط. ولكنه يحوي إعجازا في كل ما يمكن للعقل البشري أن يحوم حوله. فكل مفكر متدبر في كلام الله يجد إعجازا في القرآن الكريم. فالذي درس البلاغة رأى الإعجاز البلاغي، والذي تعلم الطب وجد إعجازا طبيا في القرآن الكريم. وعالم النباتات رأى إعجازا في آيات القرآن الكريم، وكذلك عالم الفلك.. وإذا أراد إنسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخذها على قدر بشريتنا .. ولكن نأخذها على قدر مراد الله فيها .. وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة. فكل منا يملك مفتاحاً من مفاتيح الفهم كل على قدر علمه .. هذا مفتاح بسيط يفتح مرة واحدة وآخر يدور مرتين .. وآخر يدور ثلاث مرات وهكذا .. ولكن من عنده العلم يملك كل المفاتيح، أو يملك المفتاح الذي يفتح كل الأبواب.. ونحن لا يجب أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف. فحياة البشر تقتضي منا في بعض الأحيان أن نضع كلمات لا معنى لها بالنسبة لغيرنا .. وأن كانت تمثل أشياء ضرورية بالنسبة لنا. تماما ككلمة السر التي تستخدمها الجيوش لا معنى لها إذا سمعتها. ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت .. فخذ كلمات الله التي تفهمها بمعانيها .. وخذ الحروف التي لا تفهمها بمرادات الله فيها. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يبقى معناها في الغيب عنده. والقرآن الكريم لا يؤخذ على نسق واحد حتى نتنبه ونحن نتلوه أو نكتبه. لذلك تجد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة بدون ألف بين الباء والسين. ومرة تجدها مكتوبة بالألف في قوله تعالى: {اقرأ باسم ربك الذي خلق “1” } (سورة العلق)
وكلمة تبارك مرة تكتب بالألف ومرة بغير الألف .. ولو أن المسألة رتابة في كتابة القرآن لجاءت كلها على نظام واحد. ولكنها جاءت بهذه الطريقة لتكون كتابة القرآن معجزة وألفاظه معجزة. ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة في بداية بعض السور بحروف .. نقول إن لذلك حكمة عند الله فهمناها أو لم نفهمها .. والقرآن نزل على أمة عربية فيها المؤمن والكافر .. ومع ذلك لم نسمع أحداً يطعن في الأحرف التي بدأت بها السور. وهذا دليل على أنهم فهموها بملكاتهم العربية .. ولو أنهم لم يفهموها لطعنوا فيها. وأنا انصح من يقرأ القرآن الكريم للتعبد .. ألا يشغل نفسه بالتفكير في المعنى. أما الذي يقرأ القرآن ليستنبط منه فليقف عند اللفظ والمعنى .. فإذا قرأت القرآن لتتعبد فاقرأه بسر الله فيه .. ولو جلست تبحث عن المعنى .. تكون قد حددت معنى القرآن الكريم بمعلوماتك أنت. وتكون قد أخذت المعنى ناقصا نقص فكر البشر .. ولكن اقرأ القرآن بسر الله فيه. إننا لو بحثنا معنى كل لفظ في القرآن الكريم فقد أخرجنا الأمي وكل من لم يدرس اللغة العربية دارسة متعمقة من قراءة القرآن. ولكنك تجد أميا لم يقرأ كلمة واحدة ومع ذلك يحفظ القرآن كله. فإذا قلت كيف؟ نقول لك بسر الله فيه. والكلام وسيلة إفهام وفهم بين المتكلم والسامع. المتكلم هو الذي بيده البداية، والسامع يفاجأ بالكلام لأنه لا يعلم مقدما ماذا سيقول المتكلم .. وقد يكون ذهن السامع مشغولا بشي آخر .. فلا يستوعب أول الكلمات .. ولذلك قد تنبهه بحروف أو بأصوات لا مهمة لها إلا التنبيه للكلام الذي سيأتي بعدها. وإذا كنا لا نفهم هذه الحروف. فوسائل الفهم والإعجاز في القرآن الكريم لا تنتهي، لأن القرآن كلام الله. والكلام صفة من صفات المتكلم .. ولذلك لا يستطيع فهم بشري أن يصل إلي منتهى معاني القرآن الكريم، إنما يتقرب منها. لأن كلام الله صفة من صفاته .. وصفة فيها كمال بلا نهاية. فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم .. فإنك تكون قد حددت معنى كلام الله بعلمك .. ولذلك جاءت هذه الحروف إعجاز لك. حتى تعرف إنك لا تستطيع أن تحدد معاني القرآن بعلمك.. أن عدم فهم الإنسان لأشياء لا يمنع انتفاعه بها .. فالريفي مثلا ينتفع بالكهرباء والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعي وهو لا يعرف عن أي منها شيئا. فلماذا لا يكون الله تبارك وتعالى قد أعطانا هذه الحروف نأخذ فائدتها ونستفيد من أسرارها ويتنزل الله بها علينا بما أودع فيها من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أو لم يفهمها. وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر .. ولو أراد الإنسان أن يحوم بفكره وخواطره حول معاني هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئا جديدا. لقد خاض العلماء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف .. بل كل منهم يقول والله أعلم بمراده. ولذلك نجد عالما يقول (ألر) و(حم) و(ن) وهي حروف من فواتح السور تكون اسم الرحمن .. نقول إن هذا لا يمكن أن يمثل فهما عاما لحروف بداية بعض سور القرآن .. ولكن ما الذي يتعبكم أو يرهقكم في محاولة إيجاد معان لهذه الحروف؟! لو أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن يريد أن يفهمنا معانيها .. لأوردها بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعنى. فمثلا أحد العلماء يقول إن معنى (ألم) هو أنا الله اسمع وأرى .. نقول لهذا العالم لو أن الله أراد ذلك فما المانع من أن يورده بشكل مباشر لنفهمه جميعا .. لابد أن يكون هناك سر في هذه الحروف .. وهذا السر هو من أسرار الله التي يريدنا أن ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها.. ولابد أن نعرف أنه كما أن للبصر حدوداً. وللأذن حدوداً وللمس والشم والتذوق حدوداً، فكذلك عقل الإنسان له حدود يتسع لها في المعرفة .. وحدود فوق قدرات العقل لا يصل إليها. والإنسان حينما يقرأ القرآن والحروف الموجودة في أوائل بعض السور يقول إن هذا أمر خارج عن قدرته العقلية .. وليس ذلك حجراً أو سداً لباب الاجتهاد .. لأننا إن لم ندرك فإن علينا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا سبحانه وتعالى التي هي بلا حدود. وفي الإيمان هناك ما يمكن فهمه وما لا يمكن فهمه .. فتحريم أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لا ننتظر حتى نعرف حكمته لنمتنع عنه. ولكننا نمتنع عنه بإيمان أنه مادام الله قد حرمه فقد أصبح حراما. {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب “7” } (سورة آل عمران)
إذن فعدم فهمنا للمتشابه لا يمنع أن نستفيد من سر وضعه الله في كتابه .. ونحن نستفيد من أسرار الله في كتابه فهمناها أم لم نفهمها.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهداية في القرآن … من خلال سورة البقرة
هل تعلم أن الله يحب لك الهداية وللناس أجمعين ؟!
مدخل :
إن أمراً فرضَ الله طلبه فرضا ، وجعل الدعاء به واجبا ومكررا في اليوم والليلة وفي مقام عظيم من أعظم مقامات العبد بين يدي ربه ؛ إذ يدعو به المصلي وهو قائم يصلي لله سبحانه وتعالى ؛ إن هذا الأمر لهو أهم ما ينبغي الانشغال به والاهتمام به والقلق لأجله .
ذلك الدعاء والطلب هو المذكور في قول الله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) .
إنه أول دعاء في القرآن وهو أوجب دعاء أوجب الله الدعاء به وقراءته يوميا ؛ إذ قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها وفيها هذا الدعاء العظيم.
وسورة البقرة أولت موضوع الهداية عناية خاصة وواضحة ولذلك قال برهان الدين البقاعي رحمه الله في سورة البقرة ” مقصودها : إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع في كل ما قال ، وأعظم ما يهدي إليه الإيمان بالغيب ، ومجمعه الإيمان بالآخرة ؛ فمداره الإيمان بالبعث التي أعربت عنه قصة البقرة التي مدارها الإيمان بالغيب “[1] ومحور السورة هو ” بيان الصراط المستقيم على الإستيفاء والكمال أخذا وتركا ، وبيان شرف من أخذ به وسوء حال من تنكب عنه “[2] وفي السورة دلالات واضحة على العناية بموضوع الهداية ومن ذلك :
أولا : الملامح العامة لعناية السورة بموضوع الهداية :
1- أول صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى للقرآن في القرآن هي أنه هدى في الآية الثانية من سورة البقرة في قوله تعالى بأنه ” هدى للمتقين ” .
2- ذكر الله في صدر السورة أصناف الناس من حيث موقفهم من الهداية وذكر مصير كل صنف ، فذكر الذين اهتدوا ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، والذين رفضوا الهداية ظاهرا وباطنا وهم الكفار ، والذين قبلوا الهداية ظاهرا ورفضوها باطنا وهم المنافقون .
3- التفصيل في ذكر موانع الهداية فتجد في السورة – والله أعلم – ما يقارب خمسين مانعا من موانع الهداية .
4- توضيح طرق الهداية وبيان أسبابها فيظهر – والله أعلم – في السورة أكثر من عشرين سببا من أسباب الهداية .
5- لفظ كلمة ” هدى ” ومشتقاتها ذكرت في السورة 30 مرة تقريبا .
6- ذُكر في السورة عدد من النماذج لأحداث ووقائع وشخصيات كانت الهداية أحد المواضيع الرئيسة في ذكر تلك النماذج وسيأتي التمثيل ببعض منها .
7- ثناء الله تعالى على الذين اهتدوا وذمه للذين لم يقبلوا الهداية في ثنايا السورة وفي أكثر من مناسبة.
8- تحدثت السور عن كثير من أبواب الخير التي تعين على الهداية وتؤكد محبة الله سبحانه وتعالى الهداية لخلقه مثل الحج والصيام والصلاة والإنفاق والجهاد .
ثانيا : من موانع الهداية المذكورة في السورة :
1- الختم على القلوب والأسماع كما في قوله تعالى عن الكفار الآية السابعة “: خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7) أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان، ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم، ولا يسمعون ما يفيدهم.[3]
2- الغشاوة على الأبصار كما في قوله تعالى ” وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ” من الآية السابقة : أي: غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير، قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم، ولا خير يرجى عندهم[4] .
3- مرض القلوب كما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المنافقين وسبب عدم إيمانهم وخداعهم لله وللمؤمنين فقال سبحانه في الآية العاشرة من السورة : ” فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10)
4- تفضيل الضلالة على الهدى كما ذكر المولى عز وجل عن المنافقين فقال ” أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16).
5- الفسق : ضرب الله مثلا فقوم اهتدوا وعلموا أنه حق من ربهم وقوما ضلوا واعترضوا بسبب فسقهم ، قال الله سبحانه وتعالى :” إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26)
6- الكبر كما حكى الله عز وجل عن إبليس لعنه الله لما رفض السجود ، قال الله :” وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34)
7- اتباع خطوات الشيطان وذكر الله ذلك في قصة آدم وزوجه لما أزلهما الشيطان وأخرجهما من الجنة قال الله سبحانه وتعالى “: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36)
8- الكفر والتكذيب بالآيات كما ذكر الله في الموقف من الهدى الذي يأتي به للناس فيكونوا على موقفين منهم من يتبع ومنهم من يرفض ، قال الله :” قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39)
9- حب الدنيا :” وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41).
10- خلط الحق بالباطل لأن مقصود تميز الحق هو هداية الناس فخلطه يضلهم فقال الله سبحانه وتعال محذرا : ” وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ” (42)
11- كتمان الحق : ” وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ” (42)
12- الإعراض والتولي قال الله عز من قائل ” ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ” (64)
13- الجدال والتعنت في المسائل وهذا واضح في قصة بني إسرائيل لما طلب منهم نبي الله موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة كما في الآيات من 67 – 71 والتي بدأت بقوله سبحانه :” وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) إلى قوله تعالى :”… قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71)
14- تحريف كلام الله : قال الله سبحانه وتعالى :” أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75)
15- الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض قال تعالى :” ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)
16- الحسد قال سبحانه وتعالى :” وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ…” (109) .
17- محاربة المساجد كما قال سبحانه وتعالى ” وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) . قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله عند تفسير هذه الآية في التحرير والتنوير : فبين أن ظلمهم في ذلك لم يبلغه أحد ممن قبلهم إذ منعوا مساجد الله وسدوا طريق الهدى وحالوا بين الناس وبين زيارة المسجد الحرام الذي هو فخرهم وسبب مكانتهم وليس هذا شأن طالب صلاح الخلق بل هذا شأن الحاسد المغتاظ)
18- التشبه باليهود والنصارى فيما يخص دينهم وإتباع أهوائهم قال الله سبحانه وتعالى :” وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120)
19- التولي عن هدي الصحابة – رضي الله عنهم – قال الله تعالى ” فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137)
20- السفه ؛ والسفيه هو الذي لا يعرف مصلحة نفسه وهو قليل العقل والحلم والديانة كما ذكر الله عن الذين اعترضوا عن تحويل القبلة :” سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)
21- كتمان العلم لأن العلم طريق موصل للهداية فكتمانه يمنع الهداية كما قال الله سبحانه وتعالى :” إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159)
22- محبة غير الله كحب الله قال المولى عز وجل :” وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ” (165)
23- إتباع خطوات الشيطان قال الله :” يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ” (168)
24- التقليد الأعمى إذ يفقد المرء بصيرته كفقد بصَرِه إذا سلّم أمره لتقاليد وعادات وإلْفٍ ألفه دون بينة ولا حجة قال الله سبحانه وتعالى :” وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170)
25- الاختلاف في الكتاب ورد بعضه ببعض قال الله :” ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) وإن الذين اختلفوا في الكتاب فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه, لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب[5]
26- الخصومة بالباطل ، قال الله :” وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ” (204)
27- العزة بالإثم قال الله عز وجل :” وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)
28- الجزع وقلة الصبر قال الله تعالى :” فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) .
29- الظلم إذ يصبح الظلم حاجزا بين الظالمين وبين الهداية قال الله تعالى :” أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)
30- الريا قال المولى عز وجل :” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)
31- الكفر وهو أصل موانع الهداية ورأسها ، قال الله :” …… وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)
32- القياس الفاسد قال الله تعالى في الذين قاسوا الربا على البيع : ” الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)
33- العودة إلى المعصية قال الله تعالى :” وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)
34- إتباع الفتنة قال الله تعالى :” وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ” (102)
35- عدم العمل بالعلم قال الله تعالى :” أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ” (44)
ثالثا : أسباب وطرق الهداية المذكورة في السورة :
1- القرآن وهو أصل الأسباب وأولها قال الله تعالى في وصفه : ” هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ” (2)
ولكن ( لا بد لمن يريد أن يجد الهدى في القرآن أن يجيء إليه بقلب سليم . بقلب خالص . ثم أن يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى ، ويحذر أن يكون على ضلالة ، أو أن تستهويه ضلالة . . وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره وأنواره ، ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه متقياً ، خائفاً ، حساساً ، مهيأ للتلقي)[6]
2- العلم قال تعالى :” وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ” (31) والعلم النافع والموصل للهداية هو العلم المستمد من الله ومن وحي الله سبحانه ولذا كما أن الآيات دلت على فضل آم عليه السلام على الملائكة بالعلم إلا أنها صرحت ( أن علمه مستمد من تعليم الله له ، فإن إمداد الله له بالعلم يدل على أنه محاط منه برعاية ضافية ، ثم إن العلم الذي يحصل عن طريق النظر والفكر قد يعتريه الخلل ، ويحوم حوله الخطأ . فيقع صاحبه في الإِفساد من حيث إنه يريد الإِصلاح ، بخلاف العلم الذي يتلقاه الإِنسان من تعليم الله ، فإنه علم مطابق للواقع قطعاً ، ولا يخشى من صاحبه أن يحيد عن سبيل الإِصلاح)[7]
3- العبادة والطاعة قال الله تعالى :” يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ” (21)
4- الإيمان بما جاء من عند الله قال الله تعالى :” إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ” (26)
5- التسليم وإرجاع الأمر لله قال الله تعالى :” قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32)
6- التوبة قال الله تعالى : ” فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)
7- إتباع الهدى الذي ينزله الله قال الله تعالى :” قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38)
8- الاستعانة بالصبر والصلاة قال الله تعالى :” وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46)
9- إتباع الكتاب والأنبياء قال الله تعالى :”وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53)
10- الإيمان والعمل الصالح قال الله تعالى:” وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82)
11- الإيمان بالملائكة قال الله تعالى :” قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97)
12- الإيمان والتقوى قال تعالى :” وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103)
13- الصلاة والزكاة قال تعالى :” وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)
14- التسليم لله قال الله تعالى :”وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)
15- الإحسان قال الله تعالى :” بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)
16- تلاوة كتاب الله حق التلاوة قال المولى عز وجل :” الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121)
17- الثبات قال تعالى :” وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)
18- الدعاء قال تعالى :” وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127)
19- اتباع ملة إبراهيم قال الله تعالى :” وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131)
وقوله تعالى : ” وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135)
20- الإيمان بما أنزل على الرسل قال الله تعالى :” قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136)
21- الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة قال الله تعالى :”فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137)
رابعا : أقسام الهداية في سورة البقرة
ذكر أهل العلم أن الهداية النافعة أربعة أقسام[8] :
أحدها : الهداية إلي مصالح الدنيا كما قال المولى عز وجل في سورة طه : ” قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50)
وفي سورة البقرة التي آيات تدل على هذا القسم كثيرة منها قوله تعالى :” هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) وقوله سبحانه وتعالى :” يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168)
وغيرها من الآيات – والله أعلى وأعلم – مثل آية : 22 – 57- 60- 61- 164- 172- 173 .
الثاني : هداية البيان والدلالة مثل قوله تعالى :” إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7)الرعد ” وقوله سبحانه ” وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52)الشورى ، وقوله سبحانه وتعالى :”وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى “(17) فصلت .
ومما يدل على هذا القسم في سورة البقرة آيات كثيرة مثل آية : 38- 87- 92- 99- 129- 132- 151- وغيرها – والله أعلم – ومن ذلك قوله تعالى :” {وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }53
وقوله سبحانه :” كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ (213)
الثالث : هداية التوفيق والإلهام وهو الذي لا يقدر عليه إلا الله وهو جعل الهدى والإيمان في القلب ومنه قوله تعالى:” وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ “(17)محمد ، وقوله: “وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ” (11)التغابن ، وقوله: “إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) يونس .
ومن الآيات التي في السورة وهي تدل على هذا القسم – والله أعلم – قوله تعالى :” {أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }5 وقوله عز وجل :” فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)
وكذلك في الآيات :26- 62- 120 – 137- 143- 257- 285- 286 ما يدل على ذلك والله أعلى وأعلم .
القسم الرابع : الهدى في الآخر إلى الجنة ومنه قوله تعالى في سورة الحج :” وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) وقوله :” إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24) الحج .
وفي هذه السورة قوله تعالى :” وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25)
وكذلك قوله سبحانه وتعالى :” وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82)
من هذه السورة يدل على ذلك – والله أعلم – ومن ذلك آية 62- 218
خامسا : لفظ ( هدًى ) في السورة :
كرر لفظ ” هدًى ” في السورة في خمس آيات على النحو التالي :
1- في الآية الثانية في قوله تعالى ” ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) .
2- في الآية الخامسة في قوله تعالى “أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)
3- في الآية الثامنة والثلاثين في قوله تعالى ” قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38).
4- في الآية السابعة والتسعين في قوله تعالى ” قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97)
5- في الآية المائة وخمسة وثمانين في قوله تعالى “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)
ومن خلال النظر في الآيات السابقة مرتبة يتبين – والله أعلم – الآتي :
1- الآية الأولى وصف للقرآن .
2- الثانية تقرير أن الهدى من الله سبحانه وتعالى .
3- الثالثة أن الهدى يأتي للجن والأنس .
4- الرابعة تشير إلى وسيلة نزول الهدى وإيصاله للخلق من الملائكة ومن البشر( جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ) .
5- الخامسة ذكرت وقت نزول الهدى وهو شهر رمضان .
فجمعت هذه الآيات – والله أعلم – الهدى ومصدره والمقصود به وواسطته ووقته .
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى
وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه
والحمد لله رب العالمين
—————————-
[1] ) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور – برهان الدين البقاعي (1/ 55 ) عن التفسير الموضوعي لسور القرآن – جمعة الشارقة 1 / 27
[2] ) البرهان في تناسب سور القرآن – أبو جعفر بن الزبير الغرناطي صـ88 – عن التفسير الموضوعي لسور القرآن – جمعة الشارقة 1 / 27
[3] ) تفسير السعدي ص 24 ط : مؤسسة الرسالة .
[4] ) السابق .
[5] ) التفسير الميسر – تفسير الآية 176
[6] ) الظلال ( 1/ 9 ) .
[7] ) الوسيط – سيد طنطاوي ( 1 / 58 )
[8] ) انظر الفتاوى الكبرى – (1 / 100) ومختصر الفتاوى المصرية – (1 / 122) وذكرها ابن القيم في مدارج السالكين