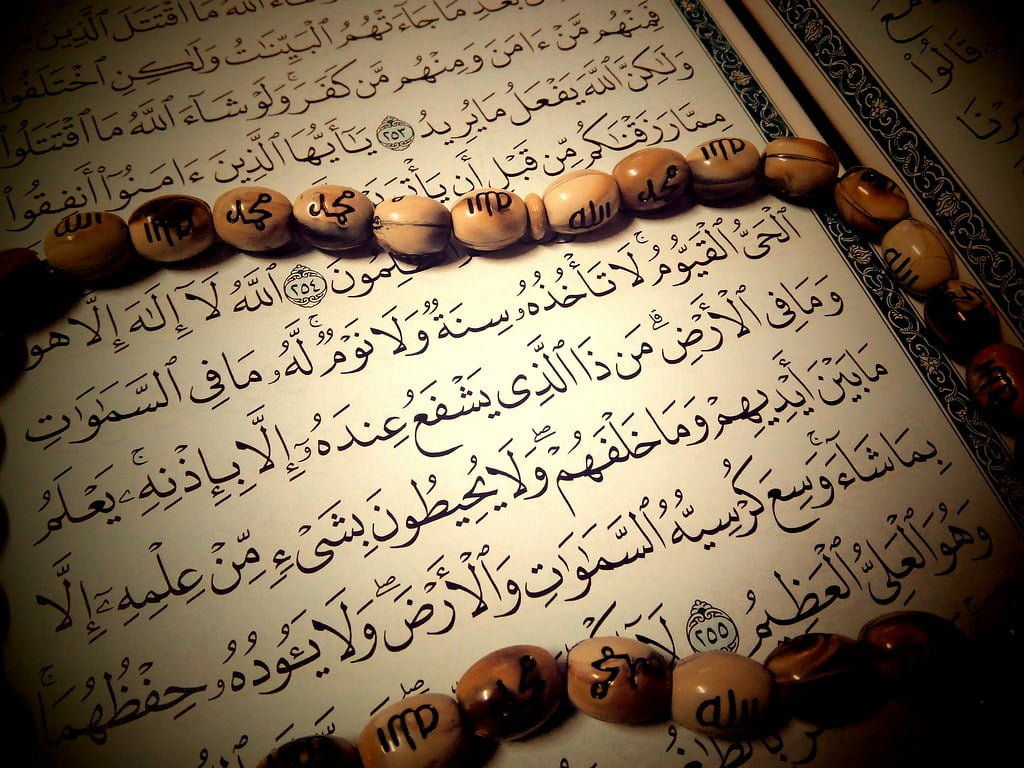سورة الفرقان سورة مكيّة, وقد سميّت بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر فيه الكتاب المجيد الذي أنزله على عبده ورسوله محمد وكانت النعمة الكبرى على الإنسانية وهو الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل والكفر والإيمان فاستحق هذا الكتاب العظيم أن يسمّى الفرقان وتسمى السورة بهذا الاسم تخليداً لهذا الكتاب الكريم. والسورة تدور آياتها حول إثبات صدق القرآن وبيان سوء عاقبة المكذّبين به.
والآيات في هذه السورة تسير بسياق متميّز فتبدأ بآيات فيها ما قاله المكذبون (وقالوا) ثم تأتي آيات تهدئة الرسول r وتعقيب على ما قالوا، ثم تأتي آيات تتحدث عن عاقبة التكذيب ويستمر هذا السياق إلى في معظم آيات السورة الكريمة. وهذا التسلسل والسياق في الآيات مفيد جداً للمسلمين في كل زمان ومكان لأنها تعرض عليهم عاقبة التكذيب فيرتدعوا عن التكذيب بالفرقان وبدين الله الواحد.
الآيات من 4 (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا) إلى 9 (انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَالْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا) تعرض ما قاله المكذبون، ثم تأتي آيات التهدئة للرسول الكريم (تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْرًامِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا) آية 10 ثم آيات إظهار عاقبة التكذيب (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا * إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا * وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا * لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ) من الآية 11 إلى 14 . ثم يتكرر السياق نفسه (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُأَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا)آية 21 ثم عاقبة التكذيب (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَالرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا) الآيات 27 إلى 29، وآيات التعقيب(وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) آية 30 والطمأنة للرسول (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا) آية 24. وكذلك في الآية32 (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) ثم التهدئة للرسول (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) آية33 ثم عاقبة التكذيب (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا) آية 34. وهكذا حتى نصل إلى آية محورية في هذه السورة (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا) آية 43 وهي تعرض لماذا يكذب المكذبين؟ لسبب واضح جليّ هو أنهم يتّبعون أهواءهم فالمشكلة إذن تكمن في اتّباع الهوى وهذا هو أساس تكذيب الناس للحق.
بعد كل الآيات التي عرضت للتكذيب بالقرآن، تأتي آيات إثبات قدرة الله تعالى في الكون وقد نتساءل لماذا تأتي هذه الآيات الكونية هنا في معرض الحديث عن التكذيب؟ نقول إنه أسلوب القرآن الكريم عندما يشتّد الأذى على الرسول r وعلى المسلمين تأتي الآيات الكونية تطمئنهم أن الله الذي أبدع في خلقه ما أبدع وخلق الخلق والأكوان كلها قادر على نصرتهم فكما مدّ الله تعالى الظل للأرض سيمدّ تعالى الظلّ للمؤمنين ويذهب عنهم ضيقهم والأذى الذي يلحقهم من تكذيب المكذبين فسبحان الله الحكيم القدير (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا) آية 45. وفي استعراض هذه الإشارات الكونية تبدأ الآيات بجوّ السكينة أولاً (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا * وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا) آية 47 و48. فاختيار الآيات مناسب لمعنى الطمأنة التي أرادها تعالى لرسوله وهي تخدم هدف السورة تماماً.
ثم تنتقل الآيات من تكذيب المكذبين بالقرآن إلى ما هو أعظم وهو التكذيب بالرحمن سبحانه(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَاالرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا) آية 60، والرد على هؤلاء المكذبين بالرحمن يأتي بصيغة هي غاية في العظمة فالله تعالى ردّ عليهم بعرض صفات عباد الرحمن (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) آية 63 إلى (خَالِدِينَفِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) آية 76، ولم يعرض صفاته جلّ وعلا، فهم لا يستحقون الرد على سؤالهم من الرحمن؟ فكأنما يقول لهم أن هناك أناس أمثالكم لكنهم صدقوا القرآن وآمنوا بالله الرحمن وعبدوه حق عبادته فاستحقوا وصفهم نسبة إليه سبحانه نسبة تشريف وتكريم بعباد الرحمن. وفي صفات الرحمن صفة هامة هي دعاؤهم بأن يكونوا للمتقين إماماً وهكذا يجب أن يكون المسلم إماماً وقدوة لغيره من الخلق لأنه على الحق القويم وعلى الصراط المستقيم. وتختم السورة بآية تلّخص فيها رد الله على هؤلاء المكذبين (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ) آية 77.
وقد قال القرطبي: وصف الله تعالى عباد الرحمن بإحدى عشرة خصلة هي أوصافهم الحميدة من التحلي، والتخلي وهي التواضع، والحلم، والتهجد، والخوف، وترك الإسراف والإقتار، والبعد عن الشرك، والنزاهة عن الزنى والقتل، والتوبة، وتجنب الكذب، وقبول المواعظ، والابتهال إلى الله. ثم بيّن جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة أي الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنّة وأفضلها أعلى مساكن الدنيا.
قال في أولها:(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2)) ثم ينتقل إلى الكافرين والمشركين بعد هذا (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5))وقال في أواخرها (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61)) وذكر في الآية الأولى (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وذكر في الآخر (وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا) له ملك السموات والأرض وتبارك الذي جعل في السماء بروجاً هو تعالى الذي يملكها هو جعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وإزاء هؤلاء الكافرين المشركين ذكر عباد الرحمن. انتقل بعد البداية إلى ذكر المشركين والكافرين ثم ذكر عبد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً إلى آخر السورة. ذكر الكافرين ثم ذكر المؤمنين وهذا في القرآن كثير وذكر جزاء كل منهم فذكر المؤمنون أولاً وذكر غيرهم في الآخر، هذا مقابل هذا.
في آخر سورة النور قال تعالى:(أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64)) وفي أوائل الفرقان: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2)) ألا إن لله ما في السموات والأرض الذي له ملك السموات والأرض يعني له ملكهما وما فيهما.
سؤال: قد يقول قائل أنه ربما يكون في هذا تكراراً؟ هذا ليس تكراراً, أولاً ثم إن هذا أمر عقيدة يركزها ويركز ظواهرها، في أواخر النور قال:(لله ما في السموات والأرض) له ما فيهما وفي الفرقان: (له ملك السموات والأرض) له ملكهما فقد تملك شيئاً لكن لا تملك ما فيه فقد تملك داراً ويستأجرها منك أحد فأنت تملك الدار لكنك لا تملك ما فيها وليس بالضرورة أن تملك داراً وتملك ما فيها كونه يملك السموات والأرض ليس بالضرورة أنه يملك ما فيهما ولذلك أكد القرآن أنه له ملك السموات والأرض وله ما فيهما ولا يكتفي بإطلاق الملك فقط بأنه يملك السموات والأرض حتى في حياتنا نملك الظرف ولا نملك المظروف ونملك المظروف ولا نملك الظرف، إذن هو ذكر أمرين: ذكر له ملك السموات والأرض وذكر لله ما في السموات والأرض الأمران مختلفان فله ملكهما وله ما فيهما.
في آخر النور قال:(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) هذا إنذار وفي أول الفرقان: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1)). وفي آخر النور قال:(وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64)) وفي أول الفرقان: (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2)) الذي يخلق كل شيء ويقدره هو بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم وخلق كل شيء فقدره تقديراً.
آخر الفرقان قال تعالى:(قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77)) يعني العذاب يلازمهم وقال في بداية الشعراء (فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6)) التكذيب للمخاطبين والقدامى (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آَيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6))(قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77)) يعني سيكون العذاب حقاً عليكم ولزاماً عليكم، (وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6)) تهديد. الخطاب للفئتين لكن يجمعها صفة واحدة وهو التكذيب والتهديد في الفرقان (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77)) وفي الشعراء نفس الشيء (فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6)) وفي السورتين إقرار بأنهم كذبوا. في آخر الفرقان ذكر عباد الرحمن (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63)) وفي الشعراء ذكر المكذبين فاستوفى الخلق (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3)) استوفى الخلق الصالح والطالح عباد الرحمن والكافرين. في سورة واحدة قد يذكر الصنفين ويقولون كأنما الشعراء استكمال لما ذكر في الفرقان.
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (2) وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً (3)
مقدمة سورة الفرقان
هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس لرسول الله [ ص ] وتسرية , وتطمين له وتقوية وهو يواجه مشركي قريش , وعنادهم له , وتطاولهم عليه , وتعنتهم معه , وجدالهم بالباطل , ووقوفهم في وجه الهدي وصدهم عنه .
فهي في لمحة منها تصور الإيناس اللطيف الذي يحيط به الله عبده ورسوله ; وكأنما يمسح على آلامه ومتاعبه مسحا رفيقا ; ويهدهد قلبه , ويفيض عليه من الثقة والطمأنينة , وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف والمودة .
وهي في اللمحة الأخرى تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله ورسوله , وهي تجادل في عنف , وتشرد في جموح , وتتطاول في وقحة , وتتعنت في عناد , وتجنح عن الهدى الواضح الناطق المبين .
إنها البشرية التي تقول عن هذا القرآن العظيم: (إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون). . أو تقول: (أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا)والتي تقول عن محمد رسول الله الكريم: (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا). . أو تقول في استهزاء: (أهذا الذي بعث الله رسولا ?). . والتي لا تكتفي بهذا الضلال , فإذا هي تتطاول في فجور على ربها الكبير:(وإذا قيل لهم:اسجدوا للرحمن قالوا:وما الرحمن ? أنسجد لما تأمرنا ? وزادهم نفورا). أو تتعنت فتقول: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ? .
وهي هي من قديم كما يرسمها سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير مع رسولها الأخير . . لقد اعترض القوم على بشرية الرسول [ ص ] فقالوا: ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ? لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا !).
واعترضوا على حظه من المال , فقالوا: ( أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها).
واعترضوا على طريقة تنزيل القرآن فقالوا: ( لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة !).
وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والافتراء الأثيم .
ووقف الرسول [ ص ] يواجه هذا كله , وهو وحيد فريد مجرد من الجاه والمال , ملتزم حده مع ربه لا يقترح عليه شيئا , ولا يزيد على أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه , ولا يحفل بشيء سواه:” رب إلا يكن بك علي غضب فلا أبالي . لك العتبى حتى ترضى ” . .
فهنا في هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه , ويمسح على آلامه ومتاعبه , ويهدهده ويسري عنه , ويهون عليه مشقة ما يلقى من عنت القوم وسوء أدبهم وتطاولهم عليه , بأنهم يتطاولون على خالقهم ورازقهم , وخالق هذا الكون كله ومقدره ومدبره . . فلا عليه أن ينالوه بشيء من ذاك ! (ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا). .(واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون , ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا). . (وإذا قيل لهم:اسجدوا للرحمن قالوا:وما الرحمن ?). .
ويعزيه عن استهزائهم به بتصوير المستوى الهابط الذي يتمرغون فيه:(أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ? إن هم إلا كالأنعام , بل هم أضل سبيلا !).
ويعده العون والمساعدة في معركة الجدل والمحاجة:(ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا). . وفي نهاية المعركة كلها يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل:قوم موسى ونوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وما بين ذلك من قرون .
ويعرض عليه نهايتهم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة:(الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا). . (بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ادعوا ثبورا كثيرا) (ويوم يعض الظالم على يديه يقول:يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتا ! ليتني لم أتخذ فلانا خليلا). .
ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق). .(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين . وكفى بربك هاديا ونصيرا).
ويكلفه أن يصبر ويصابر , ويجاهد الكافرين بما معه من قرآن ,
واضح الحجة
قوي البرهان
عميق الأثر في الوجدان:(فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا). .
ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه (وتوكل علي الحي الذي لا يموت وسبح بحمده , وكفى به بذنوب عباده خبيرا . .
وهكذا تمضي السورة:في لمحة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من الله لرسوله . وفي لمحة منها مشاقة وعنت من المشركين لرسول الله [ ص ] وتتبير ونكال من الله الكبير المتعال
. حتى تقرب من نهايتها , فإذا ريح رخاء وروح وريحان , وطمأنينة وسلام . . وإذا صورة (عباد الرحمن). . (الذين يمشون على الأرض هونا , وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . . .)
وكأنما تتمخض عنهم معركة الجهادالشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة ; وكأنما هم الثمرة الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن في شجرة البشرية ذات الأشواك .
وتختم السورة بتصوير هوان البشرية على الله , لولا تلك القلوب المؤمنة التي تلتجىء إليه وتدعوه:(قل:ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم . فقد كذبتم فسوف يكون لزاما). .
هي ظلال السورة من تفسير الظلال للأستاذ / سيد قطب
فجاءت سورة الفرقان تؤكد عظمة وقدسية الرسالة (القرآن الفرقان) وتؤكد أهلية الرسول الداعية صلى الله عليه وسلم المبلّغ رسالة ربه ويؤيده بالأدلة الدامغة والبراهين الساطعة ودحض كل الشبهات التي يحتج بها المعارضون للرسالة. سورة هي بيد الرسول وكل داعية إلى الله فرقانا يفرق به بين الحق والباطل بشتى صوره: تكذيب، اتباع هوى ضالّ، شبهات، افتراءات، تهيئ للتمكين من خلال أدلة الحق.
ورسالة الحق لا بد لها من وسائل لإيصالها للناس، لا بد لها من إظهار ونشر وإعلام واستخدام كل التقنيات المتاحة فالمعارضون للحق دعاة الباطل لا يألون جهدا في استخدام كل وسيلة ممكنة لنشر باطلهم ويبذلون لأجله الكثير من الجهد والمال ويدافعون عن الباطل بأجر مادي يبيعون لأجله كل القيم والمبادئ والأخلاق، كحال بعض الشعراء يمدح للمال ويهجو للمال ويرثي للمال ويداهن للمال ويبيع كرامته ومعتقده لأجل حفنة من مال وصرّة من ذهب أو فضة! ويظن أنه على خير..
أما دعاة الحق فرأسمالهم عقيدة راسخة (لا إله إلا الله) ومعرفة تامة المهمة الموكلة إليهم (إني لكم رسول أمين) ووضوح الرسالة (فاتقوا الله وأطيعون) لا مواربة ولا إخفاء لبعض الحقائق ولا تدليس لا إيهام للناس بالباطل، وترفع عن حطام الدنيا (وما أسألكم عليه من أجر) وتطلع إلى ما هو أعلى وأشرف (إن أجري إلا على الله) وحرص من الداعية على المدعويين أما دعاة الباطل فلا يأبهون لسلامة ونجاة المدعويين غرضهم إظهار يأكله بأي ثمن وعلى حساب أيّ كان!
وتأمل في سورة الشعراء السحرة قبل الإيمان يطلبون الأجر المادي (أئن لنا لأجرا) والشعراء يتكسبون بشعرهم أما أنبياء الله (وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله) -وما قالها موسى لفرعون الذي ربّاه ولا إبراهيم لأبيه – يترفعون عن الدنيا ويطمعون بما عند ربهم فإذا كان عباد الرحمن يجزون الغرفة بما صبروا فكيف بأنبياء الله ودعاة الحق؟
الحلقة 25
ضيف البرنامج في حلقته رقم (119) يوم السبت 25 رمضان 1431هـ هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، الأستاذ بجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة سابقاً .
وموضوع الحلقة هو :
– علوم سورة الفرقان .
– الإجابة عن أسئلة المشاهدين حول السورة وحول الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم .
—————–
سورة الفرقان
إسم السورة
د. مصطفى: تسمى السورة سورة الفرقان والفرقان إسم أو وصف من أوصاف القرآن الكريم. البعض يسمي هذه الأسماء كلها أسماء للقرآن القرآن والفرقان والكتاب والتنزيل بعضهم يقول الإسم العلم هو القرآن والباقي أوصاف له. على كل حال الفرقان سواء كان إسما من أسماء القرآن أو صفة من صفات القرآن الكريم فإسم السورة “الفرقان”. وهو الإسم الوحيد لها. وهي سورة مكية نزلت في المرحلة الثالثة كما قسّمنا مراحل القرآن المكي إلى أربعة مراحل فهي في المرحلة الثالثة مرحلة إثارة الشبهات ومحاولة إبطال الحجة بالحجة، محاولة بيان أن هذا القرآن الكريم ليس من عند الله يلقون الشبهات ويثيرون الشبهات حول هذا الأمر لكي يبطلوا أمر القرآن وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك محور السورة كله يدور على قضية أن القرآن منزّل من عند الله سبحانه وتعالى سواء عن طريق رد شبهاتهم أو بيان مزايا القرآن الكريم ولذلك أنا عندما سميت الكتاب “المعجزة والرسول” لأن المعجزة التي هي معجزة القرآن الكريم أثبتت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعجزة كانت طريقًا إلى إثبات صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام
د. عبد الرحمن: وإلا فموضوعها الأصلي هو عن القرآن
د. مصطفى: عن القرآن أنه منزّل من عند الله. من باب اللازم يلزم من هذا الأمر إذا كان القرآن من عند الله منزّل على من؟ على رسول الله فالرسول رسول صدق من عند الله سبحانه وتعالى فالأمران المعجزة والرسول مترابطان. كون القرآن من عند الله وكونه معجزة يثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرسلٌ من عند الله. ولذلك في هذه السورة ما اجتمعت أمور كثيرة من وجوه إعجاز القرآن كما اجتمعت في سورة الفرقان فيها الإعجاز البياني وفيها الاعجاز العلمي وفي هذه السورة الإعجاز التشريعي وفيها الاعجاز الغيبي، أنواع الإعجاز الأربعة كلها مذكورة في هذه السورة.
د. عبد الرحمن: إذن موضوعها هو عنوانها
د. مصطفى: لذلك قضية المناسبة بين الإسم والمحور واضحة جدًا وبين المقاطع والمحور واضحة جدًا.
د. عبد الرحمن: لنأخذ المناسبة ما بين سورة الفرقان والسورة التي سبقتها سورة النور
د. مصطفى: مناسبات عظيمة جدًا. في آخر سورة النور جاء توقير وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (62)) هذا نوع من التكريم عندما ينصرف الإنسان عن المجلس أن يستأذن من ريس الجلسة توقير للمجلس ولرئيس الجلسة. (لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) لا تنادوه باسمه المجرّد ولا تنادوه نسبة إلى أبيه محمد بن عبد الله، أبو القاسم ولكن بلقب الرسالة ولذلك أعتب على بعض الإخوة الدعاة عندما يتكلمون في كلامهم قال محمد بن عبد الله، رسول الله ما تشرّف بنسبته إلى عبد الله وإنما شرفه في الرسالة ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله، فديتك يا رسول الله، تعظيم رسول الله بلقب الرسالة، بلقب النبوة أما إسمه وإسم أبيه كأي شخص أو اي عظيم لا يستساغ هذا، (لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا). هذه في تعظيم رسول الله في سورة النور وفي افتتاحية سورة الفرقان نأخذها من (عبده) (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (1)) كل مقام أضيفت العبودية إلى الله أو إلى الضمير العائد إلى الله فهي إضافة تشريف وتكريم ولذلك كل الأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام التشريف نودي بالعبد: في ليلة الاسراء (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ (1)) في مقام المعراج جبريل تخلى عنه قال لو تجاوزت هذا لأحرقت سبحات وجهي وأحرقتني وقف عندها، خوطب بلقب العبودية الرسول صلى الله عليه وسلم (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) النجم)، (وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا (23) البقرة) مقام العبودية مقام تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحكمة في ذلك أن الشيء إذا صُنِع لأمر ما فتحقيق هذه الغاية هو اشرف شيء لهذا الشيء. ربنا سبحانه وتعالى يقول (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) الذاريات) إذا كانت الحكمة من خلق البشر هي العبودية فإذن صفة العبودية أشرف الصفات للبشر ولذلك في تشريف وتعظيم لرسول الله في نهاية سورة النور وفي أول سورة الفرقان.
د. عبد الرحمن: هل هناك تناسب بين أول الفرقان وآخرها؟
د. مصطفى: نعم، ذُكِر في أول الفرقان (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (1)) والكتاب الذي نزل وهو الفرقان والعبد الذي نزل ومهمة العبد الذي نزل عليه القرآن كلها تكررت في آخر السورة: الله المنزِل الرسول المنزل عليه والكتاب المنزل ومهمة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الإنذار.
د. عبد الرحمن: ندخل في التفاصيل حتى لا يدركنا الوقت لأن سورة الفرقان مليئة. من الأشياء التي تلفت النظر فيها الحديث عن أميّة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السورة وكان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلق القرآن وهذه التهمة حتى اليوم تكررفي بعض كتابات الذين يطعنون في القرآن من المستشرقين وبعض الذين يقلّدون المستشرقين بإتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ وكان يكتب
د. مصطفى: أمية الرسول صلى الله عليه وسلم هي مسلّمة عند المشركين ولذلك كان المشركون من العرب من قريش أكثر إنصافًا من المستشرقين الآن، هم سلّموا أن محمدًا أميّ. وقبل أن نسترسل في الأمر الأميّة صفة نقص في كل البشر إلا في رسول الله فهي صفة كمال لأنها أبرز لمعجزة القرآن الكريم. لو كان غير أميّ لو كان كاتبًا قارئًا يحاول اختلاقه المستشرقون الآن يقولون اطلع على كتب السابقين وجمع من هنا وهنا أشياء فألّف هذا القرآن نسبه إلى الله تعالى، فلما كان مسلمًا عن العرب أنه أميّ ما خطً خطًا في كتاب ولا قرأ في كتاب ولا تعلم على يد بشر ثم جاء بهذه المعجزة العظيمة تحدّى الإنس والجن (قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) الإسراء) أبرز شيء أنه جاء على لسان أمّيّ، فيكم القارئ يا مشركون وفيكم الكاتب والشاعر والخطيب أنتم تقولون محمد اختلق، إختلقوا، إئتوا بعشر سور مثله مفتريات افتروا من عند أنفسكم ثم إلى سورة واحدة. فما دام عندما جاء من أميّ فكانت أبرز مكانة للقرآن الكريم. هم قالوا (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5)) ما قالوا هو كتبها لأنه أمي ولكن طلب من غيره يكتبها له وهي تُملى عليه، من فطنتهم المشركون كانوا أذكياء عندما يتهمون ما نسبوا وقالوا محمد تلقى أو أعانه أو أعطاه المعلومات واحد كبار قريش لأن كبار قريش واحدهم منهم يعرف الآخر ويعرفون قدراتهم ويعرفون الوليد بن المغيرة شيء وأبو جهل كلهم يعرفون بعضهم لكنهم نسبوا من الذي يملي على محمد هذه الأساطير؟ قوم آخرون، صهيب الرومي، يسار، فلان، من الموالي الأعاجم حتى يوهموا الناس بأن هؤلاء الأعاجم عندهم ثقافة، عندهم معلومات ما هي معروفة في أهل مكة حتى تلقى الشبهة رواجًا لدى الآخرين.
د. عبد الرحمن: فقولهم (فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) وقولهم (وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا) فيها تبرئة له أنه لا يكتبها
د. مصطفى: ما نقلها من كتاب، ما أخذها من كتاب. أما المستشرقون يحاولون بذل الجهود وجاؤوا بروايات قد تكون هنالك رويات أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مسح كلمة “رسول الله” ترضية لهم لأنه يريد أن يصل معهم إلى حلّ واقعي فهم اتخذوا هذه وبنوا عليها أنه كيف عرف صلى الله عليه وسلم كلمة “رسول الله” فمسحها حينما أبى عليّ أن يمسحها؟! العلماء المسلمون كتاب السيرة بينوا أن هذه آخر كلمة نطقها وكتبها عليّ فمد إصبعه ومسحها، حتى لو لم يكن كذلك يعتبروها معجزة لرسول الله إذا كتب شيئًا أو مسح شيئًا معينًا يعتبرونها خارقة ومعجزة لرسول الله لكن أميته معلومة للناس جميعًا
د. عبد الرحمن: وأثبتها الله تعالى في قوله (وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) العنكبوت)
د. مصطفى: (النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ (157) الأعراف) مكتوب في كتبهم ولكنهم يتجاوزون كل ذلك أن محمد كان قارئًا
د. عبد الرحمن: لأن هذا يعينهم على ترويج تهمة اختلاقه، حتى الذين يقولون أنه أخذها من التوراة والإنجيل أتحداهم أن يأتوا بالتوراة الانجيل ويستخرجوا منها مثل القرآن
د. مصطفى: كثير من الأمور التي حرفوها أو كتبوها ذكرها القرآن الكريم وما استطاعوا أن يعملوا شيئًا حيال ذلك.
د. عبد الرحمن: لفت نظري في أول سورة الفرقان أن الله سبحانه وتعالى ذكر تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بأنه يكتتب هذه الأساطير ويأتي بهذا القرآن من هنا وهناك ثم قال سبحانه وتعالى في الرد عليهم (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11)) فهل سبب تكذيب هؤلاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وطعنهم في القرآن هو تكذيب بالساعة فقط؟
د. مصطفى: ينبغي أن نقدم لنقطتين قبل أن ننتقل لهذه. هم أخفوا هذا الدافع ما قالوه مثلًا في بعض السور يأتي (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) يس) ولذلك جاء الرد عليهم في تلك المواطن استدلال برهاني (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) يس) ثم قدرة الله العظيمة المحيطة بكل شيء، فصّل, هنا الدافع الحقيقي لهم تكذيب الساعة ولم يبينوا هذا الدافع الله سبحانه وتعالى رد عليهم بذكر مشاهد الساعة كأنها واقعة ويتحدث عن مشاهدها فعلًا هؤلاء هذا الدافع لهم ما يريدون أن يؤمنوا بالساعة لماذا؟ كل الكفار وإلى يومنا هذا لا يريدون أن تذكرهم بالموت ولا بقيام الساعة. ولذلك صاحب الجنتين في سورة الكهف قال (وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (36)) ليس هناك ساعة وإن كانت هناك ساعة فكما أُوثرت في الدنيا بالمال والحسب والرجال سيكون لي مقام هناك أيضًا مفاهيم مختلة!. ما الدافع لتكذيبهم بالساعة؟ لا يريدون التكذير بالموت ولا قضية أن هناك قيام الساعة. الدافع للكفار بشكل عام في إنكار الساعة أنهم سيزولون عن هذا النعيم أو هذه المكانة والجاه والغنى الذي هم فيه فإما يزولوا عنها أو تزول عنهم لأن بالموت إذا بقوا في النعيم جاءهم الموت فزالوا
د. عبد الرحمن: إما يزال هو أو يزولون هم
د. مصطفى: هذه نقطة ضعف الإنسان، الإنسان لا يريد الزوال عن الشيء أو زوال الشيء عنه إذا كان في متعة أو شهوة أو غير ذلك هذه نقطة ضعف الإنسان قضية حب الخلود يريد أن يبقى خالدًا ولذلك الله سبحانه وتعالى لما رد عليهم (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11)) هؤلاء الدافع الحقيقي لإنكارهم للرسالة للقرآن الكريم وإثارة الشهبات وإنكارهم لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثارة الشبهات حوله أيضًا كلها لأنه جاء في القرآن ورسول الله يؤكد على قيام الساعة، ومعنى قيام الساعة زوال النعمة عنهم بل ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة عملوها في الدنيا والأمر الثالث أنهم كانوا على باطل وهؤلاء المستضعفون وهؤلاء الخصوم انتصروا عليهم وهم لا يريدون هذا الشيء لا يعترفون بالساعة لأن في ذلك زوال هذه النعم عنهم ومحاسبتهم على هذه النعم التي هم فيها وانتصارهم على
د. عبد الرحمن: وهذه نقطة الضعف التي دخل بها إبليس على آدم
د. مصطفى: نعم، قال تعالى (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى (120) طه) ولذلك في سورة الفرقان أكد الله سبحانه وتعالى الناحيتين أن النعيم مخلّد وأنتم مخلدون في النعيم (قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِيرًا (15)) فهي جنة ونعيم لا يزول عنكم. (لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا) لهم فيها ما يشاؤون خالدين، أنتم خالدون أيضًا لا الجنة تزول عنكم ولا أنتم تزولون عنها فأكّد على هاتين النقطتين اللتان هما دائمًأ مثار تخوّف الناس أن هذا النعيم الذي أنا فيه سيزول عني أو أنا سأزول بالموت، في الجنة النعيم مخلد وأنتم مخلدون فهنالك حياة
د. عبد الرحمن: هل يمكن ربطها بالسنة التي كان يسنها صلى الله عليه وسلم وهي زيارة المقابر، ذكر هادم اللذات؟
د. مصطفى: تذكير، أكثروا من ذكر هادم اللذات لأنها تبين لكم أن هذه ليست دار خلود وأنتم ستحاسبون ستزولون إحسبوا حساب لدار الخلد التي هي الحياة الحقيقية هناك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر بالموت ويأمر بزيارة القبور لأنها تذكر بالموات. دائمًا عندما يكون الموت أمام ناظري أحد منا لا يتمادى في الباطل لا يريد أن يكثر من الأمور التي سيحاسب عليها. ولذلك كثير من السلف كان لا يتكلم بالكلمة يقول حتى أعرف مكانها هل هي لي أو علي؟ ما دام سأحاسب عليها إذن لا أُكثر من الكلام، لا أكثر من هذه الأمور التي ستثقل ميزان سيئاتي أو على الأقل التي سأحاسب واسأل عنها.
د. عبد الرحمن: مسألة أخرى في السورة في قوله سبحانه وتعالى (وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ (20))
د. مصطفى: هذا رد على قولهم (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7)) وهذا موجود إلى يومنا هذا مع الدعاة عندما يعجزون عن الرد بالدليل والحجة على الدعوة يحاولون إثارة الشبهات على الداعية على صاحب الدعوة، في زماننا الحاضر بعض الدعاة اتهموه وقالوا أنتم تدعون إلى الحجاب والستر والعفة بنت فلان من الناس الذي تقولون أنه داعية تعمل كذا وكذا ثم تبين أنه ليس له بنات أصلًا، يحاولون إثارة الشبهات على الداعية نفسه فلما قالوا (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا) عندما استبعدوا أن يكون من البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وتعتوره الأمور الطارئة مرض وغيره هم لا يدركون حكمة الله سبحانه وتعالى في إرسال الرسل، سنة الله في الرسالات أن يكون الرسول من جنس المرسَل إليهم وهذه سنة إلهية، والحكمة في ذلك لأنه لو كان من غير البشر كيف يتفاهمون معه؟! لو كان الرسول من غير البشر لقالوا هذا عنده إمكانات وقدرات للتطبيق ليست عندنا فعندما يأتي الرسول منهم وهو قدوة لهم في كل أوامر الشرع سيكون التطبيق ممكنًا. العلماء يقولون هناك ثلاث احتمالات للتكليف، الله سبحانه وتعالى خلق الناس لعبادته فكيف يكلّفهم بالمطلوب منهم في هذه العبادة واستخلافهم في الأرض كيف يبلّغهم؟ إما بالوحي المباشر وهذا لا يحقق الحكمة لأن قضية الاختيار وأن يكون له إرادة واختيار هذا أمر مهم في التكليف، إذا أوحى إلى كل واحد من البشر أنت كطلف بهذا زالت قضية الاختيار، إذن هذه الطريقة لا تحقق الحكمة من التكليف. لو كان من غير البشر كيف يتفاهمون معه؟! لو كان من الملائكة؟ لو كان من الجن؟ من غير جنس البشر؟ إذن لا يمكن إلا أن يكون ممن اصطفاهم الله من البشر ليكون قدوة في التطبيق فكان حكمة الله في هذا.
د. عبد الرحمن: والله ذكر (قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً)
د. مصطفى: (قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً (95) الإسراء) الرسول من جنس المرسل إليهم هذا يحقق الحكمة الإلهية في ذلك.
د. عبد الرحمن: نأتي إلى مسألة أخرى في قوله سبحانه وتعالى (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30)) هذه مسألة أريدك أن تنبه إليها الآن ونحن في رمضان والناس ولله الحمد يقبلون كثيرًا على القرآن والكل يلاحظون ذلك أن الناس في رمضان يقبلون على القرآن وعلى القرآءة والحفظ والمراجعة لكن في شوال يرفعون المصاحف بعض الناس عنده مصحف يحفظه في البيت فإذا جاء رمضان أخرجه وقرأ فيه فإذا انتهى رمضان أعاده
د. مصطفى: هذا لون من ألوان هجر القرآن واللون الأهم الأخطر من الهجر أن لا يتدبروا القرآن ويطلعوا من خلاله على الآيات والبراهين الدالة على أنه منزّل من الله وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق. الله سبحانه وتعالى ربط بين ثلاثة أشياء وأمرنا بتدبرها أولا الكون الذي يحيط بنا أمرنا أن نسير في الأرض وننظر كيف بدأ الخلق وفي آيات كثيرة جدًا ولا نهاية لها مهما تقدمت البشرية في دراسة الكون ومعرفة أسرار الكون لا نهاية لها إلا أن تنتهي البشرية. الأمر الثاني القرآن الكريم (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) محمد) تدبر القرآن الكريم عندما يتخدوه مهجورًا لا ينظرون إلى هذه الآيات، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ آيات آخر سورة آل عمران (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ (190)) قال “ويل لمن قرأها ولم يتدبرها” هذا نوع من الهجر أن لا نتدبر الآيات، بعض الناس قد يقرأ ويختم لكن وقفات التدبر قليلة. الأمر الثالث التي ربط القرآن الكريم بها قضية النفس البشرية، النفس البشرية مهما تعمق الإنسان في دراسة النفس (وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) الذاريات) لن يصل إلا إلى أجزاء صغيرة، ولذلك ربنا ربط بين الأمور الثلاثة (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ) الذي هو الكون (وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (53) فصلت) أن القرآن حقٌ منزّل من عند الله. إذا تدبر في الكون وفي النفس البشرية سيصل بعد ذلك إلى أن القرآن الذي ذكر هذه الأشياء في الكون كلها حقائق ولذلك في الآية الكريمة (قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (6))
د. عبد الرحمن: ولذلك تدبره يدلك على الخالق
د. مصطفى: لو تدبرت القرآن ما اتخذته مهجورًا وتدبرته قرأته قرآءة واعية لوصلت أن هذا القرآن منزّل من عند الله والنفس البشرية التي جاء بمفاتيحها وأسرارها، ولذلك أقول أنه مهما تقدمت البشرية ستبقى واقفة على أعتاب النفس البشرية كل ما هنالك درسوا وظائف الأعضاء أما النفس البشرية لأنهم ما أخذوا المفتاح الذي يفتح النفس البشرية الجانب المعنوي في الإنسان فلن يبقوا إلا خارج النفس البشرية. وهم يجرون تجارب على القرود والفئران ثم يطبقوها على البشر هذا ما يعطي! النفس البشرية العاقلة عالم آخر ومفتاحها في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام ما يأخذون هذا المفتاح يفتحون به النفس البشرية سيكونون على أعتاب النفس البشرية
د. عبد الرحمن: من اللفتات أيضًا الآيات التي تتحدث عن القرآن الكريم وتنزيله (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) ) ما الحكمة من تنجيمه التي نص عليها في هذه الآية؟
د. مصطفى: قبل أن أدخل هذه النقطة أنا أريد جانب آخر في آيات كثيرة في الاعجاز العلمي (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا (53)) جاء قبلها آية أنا إلى الآن أقول لم يعط العلم الحديث تفسيرًا مقبولًا لها ولم يصل العلماء إلى قضية مقنعة فيها تطمئن لها النفوس وأنا أعتبرها سرٌ من أسرار القرآن لم يصل إليه العلم (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (46)) قضية الظل، مدّه، قبضه، هذا سرّ من الأسرار، العلماء المفسرون قالوا قضية الظل ومده بعد الفجر إلى طلوع الشمس ليس هناك شمس لكن تبقى قضية (ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا) بعض المعاصرين قالوا هذا يدل على دوران الأرض حول نفسها لأن القبض قبض الظل المحور الذي تدور حوله الكرة الأرضية يقابله الشمس ثم يقبض فتنتج الليل والنهار من دوران الأرض والفصول الأربعة من الدوران حول الشمس ولكن أنا اقول كلها ليس مقنعة قناعة تامة وهنا سر إلهي في هذا الظل لم يصل إليه العلم الحديث وحبذا على موقعكم ملتقى أهل التفسير إذا كان عند أحد من القراء تفسير مقنع لهذا الشيء دل عليه العلم الحديث نكون له من الشاكرين.
د. عبد الرحمن: أحيلكم إلى كتاب الدكتور مصطفى “المعجزة والرسول في سورة الفرقان” ففيه تفاصيل كثيرة حول سورة الفرقان.
سؤال الحلقة
في الجزء الخامس والعشرون آية قدّم الله فيها ذكر الإناث على الذكور فما هي؟
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة الفرقان – 1
تفريغ الأخت نوال جزاها الله خيرا لموقع إسلاميات حصريًا
المقدم: أنزل القرآن في رمضان ورمضان شهر القرآن (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) ووصلنا إلى سورة الفرقان قال الله تعالى في مطلعها (تبارك الذي نزل الفرقان) وهذا من الموافقات، نبدأ الحديث حول ارتباط رمضان بالقرآن وعلاقة القرآن برمضان.
د. المستغانمي: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد كما تفضلت شهر رمضان هو شهر القرآن، الشهر الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنزول القرآن على محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وقرر ذلك وصرّح به في آية سورة البقرة ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾.
ومن الموافقات الجيدة الربانية بدون تخطيط منا جاءت سورة الفرقان، وهي السورة الوحيدة في القرآن كله التي تحمل اسم القرآن الفرقان، يوجد سورة الفاتحة تنطبق على جزء من القرآن وهي الفاتحة، أم الكتاب، وسور أخرى هي من سورة القرآن، لكن سورة الفرقان تحمل عنوان القرآن نسبة لقوله تبارك وتعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾.
في الحقيقة إن كانت من نصيحة أقدمها لنفسي وللمشاهدين الكرام! لابد من أن نقرأ القرآن بتؤدة وبتمهل وتمعن وتدبر، والله تبارك وتعالى حثنا على ذلك لقوله جلّ من قائل: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ وفي الآية الأخرى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ وفي آية سورة المؤمنين: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾. ولو أن المسلمين أدركوا عظمة هذا الكتاب والله كلنا لشكرنا الله شكراً عظيماً أن اختار لنا هذا الكتاب العظيم الوثيقة الإلهية الوحيدة التي لم تحرّف ولم تزيّف، ولم تطلها أيدي المنتحلين أحد الشعراء قال:
هيهات أن يعتري القرآن تبديل ٌ وإن تبدّل فتوراة وإنجيل
ما تبدّل فتوراة وإنجيل، أما القرآن فمحفوظ بحفظ الله جل جلاله، وانتدبنا إلى قراءته بتأنٍ ﴿وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ منجماً على الأحداث ليعالج القلوب.
المقدم: تقول بأن القرآن أنزل في رمضان، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وليلة القدر في رمضان، كيف يستقيم هذا الأمر وتقول الآن: بأن القرآن نزل منجماً أي: مفرّقاً، فهل اكتمل تنزيله في رمضان أم بداية تنزيله في رمضان؟
د. المستغانمي: بداية تنزيله في ليلة القدر في رمضان لعظمة هذه الليلة العظيمة: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ الرواية الموجودة أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة من بيت العزة من السماوات العلى إلى السماء الدنيا، وكان جبريل بأمر من الله يفرقه وينجمه بأمر من الله سبحانه وتعالى إذاً هو أُنزل جملة وأُنزل مفرقاً. لكن الجمال في تنظيم القرآن ونظمه أنه نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة، وآيات قبل آيات، وسور ممكن تنزل السورة وآياتها في سنوات، وعندما جُمع يعكس هذا الإحكام هذا التناسق في النظم. أنت الآن اطلب من أيّ عالم في الدنيا اطلب من مجموعة علماء ودكاترة ومساقعة في الكتابة إذا كتبوا مقالات متنوعة في أوقات مختلفة وجاءوا لضمّها فإن الأسلوب يتفكك، فما بال هذا القرآن العظيم من أوله إلى يائه محكم منسق منضد، إنه تنزيل رب العالمين!!.
في الحقيقة كنت أفكر في رمضان لو أن المسلمين تذكروا آية واحدة القرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن القرآن، القرآن يتحدث عن القرآن: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ الجبل يخشع لكلام الله. ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ وكثير من الآيات، لكن أريد أن أقف المشاهد على آية واحدة وهي قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآَنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ هذه آية عظيمة، وكل القرآن عظيم. الله تعالى يقول: لو ثمة قرآن يسيّر الجبال من أماكنها أو يقطّع الأرض الكرة الأرضية أو يكلّم الموتى الجواب: لكان هذا القرآن، والجواب ما ورد لكي تتخيله ذكرنا سابقاً أن (لو) كثيراً ما يحذف جوابها، (ولولا) كثير ما يحذف جوابها. لو أن قرآناً يفعل ذلك ويقطع الأرض ويسير الجبال فهو هذا، لكان هذا، فما بال قلوب المسلمين لا تتحرك؟! ما بال قلوب العقلاء لا تتحرك لخطاب هذا القرآن؟! فنحن بحاجة إلى أن نربط المسلمين بالجسر الذي يقربنا إلى كلام الله.
المقدم: هناك نقطة دكتور أشرت إليها قبل أن نلج سورة الفرقان وهي قضية التأني والتؤدة في قراءة القرآن، لا يفهم من الكلام هذا بأنه ونحن في شهر رمضان المبارك بأنه لا يجب علينا أن نقرأ القرآن كثيراً، لأن البعض ربما يفهم يقول: والله قيل في برنامج في رحاب سورة بأنه نقرأ القرآن بتمعن فنقرأ في اليوم صفحة واحدة تكفي أفضل من أن نختم مثلاً جزء أو جزئين، نقول: لا، اقرأ جزء أو جزئين ولكن بتؤدة وبتمعن، فإذا كنت تجعل من يومك العادي في غير رمضان عشر دقائق للقرآن اجعلها الآن ساعتين، ثلاث ساعات هكذا قدر المستطاع، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة القيامة: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ * ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ﴾ فالعجلة في قراءة القرآن غير محبذة وخاصة ونحن في شهر رمضان.
د. المستغانمي: ونحن بحاجة أن نبذل جهداً، قبل أن نبدأ السورة الكريمة: أحد العلماء زميل لي قال لي: أنا كنت أتعجب عندما أسمع كبار الزاهدين والتابعين يختمون في ليلة ويختمون في ليلتين قال: الآن في العصر الحديث عندما رأيت أبناءنا وبناتنا مع هذا التلفون النقال يعني الهاتف بالعشر الساعات زال العجب، أولئك كانوا عاكفين على القرآن، فأبناؤنا عاكفون على بعض التكنولوجيا نسأل الله أن يوفقهم وأن يهدي قلوبهم للقرآن.
المقدم: إذاً اعتدنا دائماً حينما نتحدث عن سورة نتحدث عن علاقتها بما قبلها، وبما بعدها، وخاصة بما قبلها على اعتبار أنه في الحلقة الأولى تحدثنا بأن القرآن حينما وزعت أو وضعت أماكن سوره هذا الوضع هو توقيفي فبالتالي له دلالات وله إعجاز كذلك.
د. المستغانمي: نحن قلنا: سورة النور حينما ختمناها وقفنا عند قوله تبارك وتعالى : ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ (قد يعلم) أي: قد يعلم يقيناً (قد) تفيد التأكيد هنا نحن كثيراً ما نقول في النحو (قد) إذا سبقت الماضي تفيد التحقيق، وعندما تسبق المضارع في القرآن الكريم كثيراً ما تفيد التحقيق، ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ﴾ هو يعلم جل جلاله، لذلك نحن ندرس شيئاً في النحو ونترك أشياء، (قد يعلم ما أنتم عليه)، فهذه الآية العظيمة: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ نقرأ سورة الفرقان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ * ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.
لم يكتف هنا قال: (ألا إن لله ما في السماوات والأرض) هنا ثنّت الآية (له ملك السماوات) والفرق بينهما: ممكن أنت –ولله المثل الأعلى- تملك هذه الدار كما قال أحد العلماء الشيخ فاضل أنت تملك هذه الدار ولكن استأجرها عنك غيرك أنت تملك الدار ولكن لا تملك ما فيها هي للمستأجر مثلاً، الله ولله المثل الأعلى له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض هذا من باب التأكيد على ملك الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول.
المعنى الثاني: في أواخر سورة النور كما رأينا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ توجيه قرآني للذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ جاءت سورة الفرقان تثبت صفة النذارة في رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ وما ذكر بشيراً وفي بعض الآيات بشيراً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ وأحياناً: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ سأذكر لك بعد قليل فقط أربط لك آخر توجيه إنذار شديد اللهجة: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه﴾ وهذا له ارتباط وثيق بمقدمة السورة الذي بعث محمداً صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيراً، هذا من بين ما ذكره العلماء في المناسبة بين سورة النور وسورة الفرقان.
المقدم: الحذر يتوافق دائماً مع الإنذار، إذاً هذا فيما يتعلق بالارتباط بين سورة النور والفرقان. سورة الفرقان نفسها دعنا نتحدث عن خصائصها نتحدث عن محورها العام، نتحدث عن صفاتها، الألفاظ التي فيها، العلاقة ما بين بدايتها ووسطها وختامها، كعادتنا في كل السور.
د. المستغانمي: نعم نحن في رحاب سورة نعرّف بالسور القرآنية، وقد نعرج على بعض التفاسير أو النكت أو اللمسات البيانية. أولاً: بدايتها بديعة وهذا من براعة الاستهلال البديعة في القرآن كما قلنا والقرآن كل سوره بديعة، لكن هناك التي تظهر براعة الاستهلال ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ يعني بداية مختلفة تشد الناظرين والسامعين. هنا كذلك: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ معنى: (تبارك) تزايد خيره، كثُر خيره كثرت البركة ممن أنزل هذا القرآن، كأنه يقول: تبارك الذي نزل هذا القرآن مباركاً، فيه بركة، موجود آية ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾ ما معنى البركة ؟ هي الخير والخير الخفيّ، لما تلقى إنسان داعية إلى الله وزاهد تقول: والله هذا إنسان فيه بركة، وفي آية تقول: فاتبعوه: ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ﴾ إلى أن قال: ﴿اتَّبِعُوا﴾ نعم موجود في سورة الأعراف.
فهذه البداية العظيمة براعة استهلال عجيبة: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ على عبده: هو محمد صلى الله عليه وسلم، ينذر ويعلّم.
المقدم: هذا الاستهلال يذكرني بالاستهلال في سورة الكهف: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾.
د. المستغانمي: تلك بدأت بالحمد وهذه بدأت بالمباركة والثناء.
المقدم: وهناك أنزل على عبده، وهنا أنزل على عبده، ولكن هناك قال: (الكتاب) وهنا قال: (الفرقان).
د. المستغانمي: ونحن ذكرنا في سورة الكهف أن لفظ الكتاب تكرر في سورة أيقونة من أيقونات سورة الكهف، أما هنا (الفرقان) وسأقول لك: لماذا الفرقان؟ إذاً هذه البداية العظيمة، وفي نهايتها من التناسق أذكر لك الآن أيضاً قبيل نهايتها: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ يعني: كأن الله يقول: تبارك الذي نزل الفرقان كتاباً يُقرأ وتبارك الذي خلق الكون قرآناً يُنظر إليه الكون المقروء الكون الذي ننظر إليه ويدل على الله سبحانه وتعالى. السراج فالسراج: هو الشمس: وجعل فيها سراجاً وقاداً، والقمر هو القمر نحن في المجموعة الشمسية، وكم في السماوات من أقمار كثر كلها سرج، وكلها مصابيح.
المناسبة الثانية: ﴿لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ وآخر آية من سورة تبارك الفرقان: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ ما هو الذي يكون لزاماً؟ العذاب فهو إنذار شديد اللهجة لمن لم يستجب لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم ولم يستجب لنداء الله تبارك وتعالى، إذاً ثمة تناسق بين المطلع والنهاية. وأيضاً عندما انتهت بهذا الإنذار شديد اللهجة جاءت سورة طسم الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم ﴿طسم﴾ * ﴿تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ * ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ * ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آَيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ هل ثمة إنذار أشد من هذا؟! الله جل جلاله يقول: لو شئت وشاءت قدرته جل جلاله لأنزل آية عظيمة تظل أعناق القرشيين لها خاضعين إنذار شديد! فثمة تناسق أيضاً بين الفرقان وبداية سورة الشعراء.
المقدم: لماذا سميت بالفرقان؟
د. المستغانمي: ذكر الفرقان فيها مرة واحدة. سورة الفرقان هي سورة القرآن وكلمة (الفرقان) ذكرت: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ من الهدايات والفُرقان يفرق بين الحق والباطل.
المقدم: ﴿وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ﴾
د. المستغانمي: بمعنى: نجمناه لتقرأه على الناس على مكث. وأيضاً موجود في بداية سورة آل عمران: ﴿الم﴾*﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾*﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾*﴿مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ الفرقان: يفرق بين الحق والباطل، طبعاً لو ذهبنا إلى معظم المفسرين سميت بسورة الفرقان لورود هذه الكلمة، والله أنشأ الثناء على ذاته العلية: تبارك وتزايد خيره وعظم خيره الذي نزل الفرقان الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيراً.
المقدم: يعني كأن الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه بالبركة بسبب تنزيله القرآن؟
د. المستغانمي: وكأن القرآن أيضاً كتاب مبارك هو يوحي به: تبارك الذي نزل هذا القرآن مباركاً للعالمين، لكن لا نكتفي بهذه التسمية.
أولاً: ونحن في رحاب سورة نحيط المشاهد الكريم: أن التسمية كانت موجودة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع مقرئا وهو هشام بن حكيم يصلي به في سورة الفرقان فسمع لفظاً أو قراءة ليست كما أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كما تعرف أنزل على سبعة أحرف كلها شافٍ كاف، فانتظره عمر ولم يكد يصبر عن الصلاة هو يقول، فلما انتهى لببته من ثيابه وأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: شده، قال: سمعته يقرأ سورة الفرقان – وهذا الدليل- على غير الوجه الذي أقرأتنيه أو كما قال. فقال له: اقرأ يا عمر! فقرأ، قال: هكذا أنزلت، اقرأ يا هشام! هكذا أنزلت، والقرآن نزل لو قلنا: (قد أفلح المؤمنون) (قدَ افلح المؤمنون) أو (يخادعون) (يخدعون) هي قراءات تزيد في ثراء المعنى، إذاً التسمية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذي أريد أن أشير إليه في هذه البداية: أن سورة الفرقان: فرقت بين الحق والباطل في جميع السورة ليس فقط لوجود كلمة (الفرقان) القرشيون أو المشركون يومها حاولوا قدر الإمكان أن يأتوا بشبهات، تعلّات، أباطيل، والسورة هذه تدحظها وتفندها وتبطلها، كل ما أتوا بشبهة جاء القرآن ليبطلها، وأنا جمعت لك بعض الأمثلة حتى نتبين كيف جاءت تلك الشبهات ودحضتها.
من البداية بعدما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ إلى أن يقول: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ﴾ طبعاً الإشارة إلى القرآن يعني: ما هذا إلا إفكٌ بأسلوب القصر (ما هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون) الجواب: ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ في نفس الآية، أحياناً يتأخر الجواب إلى الآية الثانية، وأحياناً في الآية نفسها: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ﴾ بمعنى: اختلقه ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ هذه شبهةٌ وهذا جوابها. الآية التي وراءها ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ هذه شبهة أخرى بعدما قالوا: (إفك) قالوا: (أساطير الأولين) يعني مكذوبة فرد عليهم قائلاً: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وهذا رد على الشبهة الثانية يعني: القرآن أنزله ونزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض.
بعد ذلك: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ يعني: أنكروا بشرية الرسل قالوا: لو كان رسولاً من عند الله يتفرض أن يكون ملكاً لا يأكل ولا يشرب، وهذا ورد في سور أخرى، ولكن أريد فقط أن أربط لك بين العنوان وبين المضمون، وردت فيها شبهات وأباطيل، فنّدها القرآن بطريقة عجيبة عندما قالوا: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ بعد قليل ليس شرطا في نفس الآية قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ رد عليهم وأعطى أدلة: المرسلون لابد أن يكونوا من الناس ويمشون ويأكلون، لو كانوا ملائكة الأقوام قالوا: والله الملائكة يستطيعون أن يصوموا يستطيعون، نحن لا نستطيع، فهم يتعللون فجاءت الشبهة وجاء ردها.
وأعطيك شيئا آخر: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾*﴿أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ﴾ يعني من السماء ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ فجاء الردّ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا﴾ خيراً مما يقولون وخيراً مما يقترحون. فهي شبهات وإبطال لها وردود عليها، لكن ردود مفنّدة وردود داحضة قوية.
المقدم: بل استمر: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ كأنه يقول: بل قالوا أشد من ذلك
د. المستغانمي: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ وهذا إضراب انتقالي. جمعت بعض الشبهات: (وقال الذين ظلموا) ولابد وأنت ستتبين معي والمشاهد مرة قال: (الذين كفروا) ومرة قال عنهم: (الذين ظلموا) ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ هذه شبهة يعني قالوا عن الرسول: أنه مسحور ليس ساحرا مسكين أصابه سحرٌ ومما جعله يختل عقلياً أو شيء من هذا النوع الله سبحانه رد عليهم: ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ إلى أن يقول جل جلاله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾ شبهة كبيرة إن أردت أن نؤمن وأن نعبد الله أولاً: نرى الله ربنا، وينزل علينا الملائكة، رد عليهم الله سبحانه وتعالى: ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ العتو: أشد من العلو.
المقدم: وهنا يكمل يقول لهم: أنهم سوف يرون الملائكة، لكن متى يرون الملائكة؟ ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾.
د. المستغانمي: يرونها لا على الوجه الذي طلبوه، هذه فيها نكتة رائعة سنطرحها يعني: هم طلبوا أن يروا الملائكة، الملائكة سترونهم، لكن ترونهم حين يأتونكم بالعذاب، هذا يسمى تهكم بطريقة عجيبة!.
بعد ذلك شبهة أخرى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ هم أتوا بشبهات بأباطيل وبثوها، أنت تقول: هذا كتاب من السماء، لولا نزل عليه مرة واحدة، الجواب: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ أنزله منجماً مرتلاً مفرقاً حتى يثبت قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ويثبت المؤمنين معه.
﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ بمعنى: فرقناه منسقاً مرتلاً وبعض المفسرون يقولون: وأمرنا بترتيله ترتيلاً، لكن رتلناه ترتيلاً تشبه قوله تعالى تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ فهو من هذا القبيل. إذاً سورة الفرقان تفرق بين الحق والباطل، فرقت بين جميع الشبهات التي ألقوها في وجه الإسلام، في وجه القرآن، في وجه محمدٍ صلى الله عليه وسلم واضح؟ وأتت بالردود فما أحراها أن تسمى سورة الفرقان.
أما لفظ (الفرقان) ذكر في مستهلها وهي براعة استهلال عجيبة، لأننا لو ربطنا فقط لأن الفرقان ذكر فيها، لقال قائل: ولماذا لم تسم سورة البقرة سورة الفرقان؟ لأنه ذكر فيها الفرقان، ولماذا لم تسم سورة آل عمران الفرقان وأنزل الفرقان؟ لا، هنا أتت بالشبهات ودحضتها وأبطلتها وفنّدتها.
المقدم: هل تحدثت عن القرآن بخلاف الآية الأولى؟
د. المستغانمي: تحدثت عليه في مواطن تحدثت ماذا قال عنه الكافرون: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ﴾ ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ في معرض الحديث عن الشبهات وعالجتها، وتحدثت عنه عندما الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى لما اتخذ قومه القرآن مهجوراً ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا﴾ هذا القرآن الذي سميت به سورة الفرقان اتخذوه مهجوراً متروكاً مفارقاً، ولم يتدبروا فيه، والله لو تدبروه لعلموا الحق وعلموا وحدانية الله.
المقدم: والصياغة جميلة ما قال: (هجروا القرآن) وإنما قال: (اتخذوا القرآن مهجوراً).
د. المستغانمي: هذه نكتة رائعة، لأنه لو قال: ( وقال الرسول يا رب إن قومي هجروا القرآن) المعنى واضح، وإنما قال اتخذوا القرآن مهجورا يعني اتخذوا منه موقف، فعل: اتخذ من خصائص السورة، (اتخذ) أيقونة لفظية في سورة الفرقان وردت كثيراً يعني حتى ذلك الكافر –والعياذ بالله- ويدخل يقول: ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ والله كان أبسط يقول: يا ليتني اتبعت الرسول (اتخذت مع الرسول سبيلاً) ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ كان يستطيع أن يقول: ليتني لم أصطحب فلاناً، الاتخاذ هنا أيقونة سأشرحها في وقتها إن شاء الله.
المقدم: إذاً بما أنك تحدثت فضيلة الشيخ عن الأيقونات نتحدث عن المحور العام للسورة كلنا في كل سورة نقول: بأن هذه السورة محورها العام كذا وكذا وكذا، لعلي من حديثك أفهم بأن من محاورها العامة دحض الشبهات محور أساسي.
د. المستغانمي: دائماً الخطيب الذي يخطب خطبة له ديباجة، الكاتب الذي يكتب كتاباً عظيماً له خطبة لمقدمة الكتاب، ولله المثل الأعلى -نحن لا نمثل فقط أقرب الفكرة – فعظمة سورة الفرقان كعظمة أخواتها المكيات والمدنيات مطلعها: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ تبارك: إنشاء الحمد والثناء على الله، ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ الحديث عن القرآن إذاً إنشاء الحمد والثناء حديث عن الفرقان حديث عن الفرقان وتنويه بشأنه ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾ حديث عن محمدٍ صلى الله عليه وسلم ودحض الشبهات ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ في القصص والإنذار، إذاً آيةٌ واحدة جمعت كل المواضيع في سورة الفرقان لا تخرج عنها.
فمحاور السورة ذُكرت في الآية الأولى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ الآية الأولى: هي خطبة الديباجة في هذه السورة العظيمة، براعة الاستهلال مركزة (تبارك): إنشاء المدح لله تبارك وتعالى، تزايد خيره تعاظم خيره، والسورة الوحيدة التي وردت فيها عبارة (تبارك) ثلاث مرات: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ﴾، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ سور أخرى ذُكرت فيها تبارك مرة، سورة الملك مثلاً.
المحور الثاني: نأتي إلى: ﴿نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ الحديث عن الفرقان حديث عن القرآن بكونه فرقاناً يفرق بين الحق والباطل، ممكن أن نتحدث عن القرآن بكونه أبلغ كتاب، ممكن أن تتحدث عن القرآن بكونه أفضل إيقاع صوتي وفواصل، ممكن القرآن شفاء، لكن هو يتحدث عن القرآن بكونه فرقاناً يفرق بين الشبهات ويدحضها، هذا المحور الثاني.
المحور الثالث: أنزله على عبده، وهي أعظم مرتبة يصلها الإنسان وهو بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أرادوا أن يبطلوا كل الإسلام وقالوا: هذا بشر والله لو جاءنا ملك لاتبعناه: لولا أنزل إليه ملك، لولا، لولا، حاولوا أن يلصقوا تهمة البشرية بأنها تعارض الرسالة فجاء القرآن وأثبتها من البداية (عبده) لا تتوقعوا أن أنزل عليكم ملكاً ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾.
المحور الرابع: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ أنت في البداية قلت لي: لم يقل: (بشيراً) السورة كلها إنذار شديد اللهجة للمشركين ما فيها تبشير فيها ربما بشرى أو اثنين، ولكن يغلب عليها طابع الإنذار والنذارة من البداية إلى النهاية، حتى عندما جاء القصص القرآني وأنت تذكر لما تحدثنا في سورة الأنبياء وسورة المؤمنين القصص يؤتى به ليخدم الموضوع، موضوع السورة النذارة، وما معنى النذارة؟ الإخبار بعاقبة سيئة، وردت فيها قصة موسى ﴿وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ * ﴿فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ هذه قصة موسى، وردت في الأعراف في إحدى عشر صفحة أو عشر صفحات، ووردت في سورة الفرقان في آيتين: (اذهبا إلى فرعون) كذب فرعون ومن معه فدمرناهم تدميراً.
المقدم: وهو يتناسب مع الإنذار.
د. المستغانمي: نعم هذا الذي نريد أن يقف عليه المشاهد الكريم: نوح بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وردت في سورة هود، ووردت في سورة نوح، ووردت مفصلة في مواضع وهنا قال: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَةً﴾ آية واحدة للإنذار.
لذلك المحاور هي:
- الثناء على الله، والحديث عن وحدانيته،
- وثناء على القرآن والتنويه بكونه فرقاناً،
- الثناء على عبده وتأكيد بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم،
- الحديث عن النذارة والإنذار.
المقدم: هذه المحاور الأربعة هل مقسمة موزعة في السورة بشكل واضح جلي؟
د. المستغانمي: بارك الله فيك على هذا السؤال: نعم نحن قلنا مراراً:لكل سورة ثوب، وتحدثنا في سورة النور –لعلك تذكر- كيف قسمتها الآيات البينات: (إن في ذلك لآيات بينات مبينات) قسمها الله، وسورة الرحمن: (فبأي آلا ربكما تكذبان). وهنا قسمها الباري جل جلاله بكلمات ثلاث: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ تحدث فيها عن القرآن وعن التوحيد، بعد ذلك: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) بعد ذلك تحدث عن الشبهات التي ذكرت لك بعضاً منها، في وسط الشبهات جاءت تبارك الأيقونة اللفظية تقول: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا﴾ في الشبهات أجاب عن شبهة واستعمل لفظ تبارك، في آخر السورة لما تكلم عن وحدانية الله تعالى والأدلة ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾، ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾، ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ وهو وهو، تعريف بالخالق، قال ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ إذاً نجد كلمة تبارك أيقونة تفصل، وهذه الفكرة هي طريقة اتبعتها في تحليل كثير من السور المفسر الوحيد الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير هو قرب إليها وذكرها يقول: وهذه الدعامات الثلاث وذكر كيف أن كلمة تبارك (فصل) لكن لم يفصل على الطريقة التي نتناول بها.
المقدم: هل هناك بعض الألفاظ الخاصة التي وردت كثيراً في السورة؟
د. المستغانمي: نعم لكل سورة ثوب وخصائص وأيقونات تتكرر، لبنات لفظية يعني تُظهر ثوبها عن غيرها. من بين ما تتميز به سورة الفرقان مثلاً: المركّب الوصفي: ﴿حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ هذه الكلمة العربي يقولها عندما يرى يتخيل وادياً فيه جنّ يقول: ﴿حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ أي: منعاً مانعاً ساتراً يتعوذ العربي بها إذا نزلت به نازلة يقول: حجراً محجوراً من هذا العدو، فاستعملها عندما يرون الملائكة لا بشرى يومئذٍ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً، اللهم إنا نعوذ بك اجعل بيننا وبين هذه حجراً حجاباً ساتراً مانعاً، حجراً يعني: سترًا يمنعنا منها، والعربي كان يتعوذ بالكلمة، والحجر في اللغة كما سنصل: هو المنع، وسمي العقل حِجراً لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ وسمي حِجر إسماعيل؛ لأنه يمنع فيه الطواف، لابد أن نطوف خارج حجر إسماعيل، أنا أعطيك المفردة. إذاً استعملها المشركون لما رأوا العذاب، لما تحدث عن البرزخ بين البحرين قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ ولم ترد في القرآن كله إلا هنا، هذا من أيقوناتها. في سورة الرحمن مثلاً قال: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾*﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ برزخ لا يوجد حجر محجور، هنا سورة الفرقان المشركون الظالمون استنجدوا ولاذوا بكلمة حجراً محجوراً بمعنى: اجعل بيننا برزخاً ومانعاً وساتراً، ولما جاء الحديث عن البرزخ قال: ﴿بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ هذا من التجاذب اللفظي من خصائصها.
سؤالي المطروح: لماذا كلمة حجراً محجوراً الوصف والموصوف فقط في هذه السورة جاء هكذا؟ لأن هذا من التجاذب يختار البيان القرآني من الألفاظ ما يتناسق مع السورة وثوبها.
أيضاً من الأيقونات التي تستوقفنا في السورة وسوف نراها بعض المصادر على وزن (فعول) هذه قليلة الاستعمال لا أقول لم تستعمل، أنا أقول: قليلة نادرة مثلاً كلمة (ثبور) على وزن (فعول) عندما قالوا: ﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾*﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ الثبور الهلاك، انظر كلمة (ثبور) ثلاث مرات في آية، هذه قليلة الاستعمال.
لو جئنا إلى كلمة (العتو) ﴿وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ فعولاً، وكذلك (نفوراً) ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾.
عندما نجد ثبوراً، ونشوراً: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ النشور (فعول) أولاً: الإيقاع الصوتي، ولأن ثمة حضور واضح لصيغة فعول، نشوراً كفوراً، شكوراً، واضح الكلام؟ فمن الأيقونات المستعملة فيها هذه.
أيضاً نجد فيها المفعول المطلق على وزن تفعيل، وهذا من خصوصياتها، أنا فتشت في القرآن كله لا يعني كلامي حتى لا يفهم المشاهد أن هذه اللفظة أو تلك لم ترد ممكن وردت في سورة أخرى، لكن هنا مضطردة عندما نجد تقديراً وتنزيلاً، نزلناه تنزيلاً، قدرناه تقديراً، رتلناه ترتيلاً، وقدره تقديراً نزل تنزيلاً، رتلناه ترتيلاً، دمرناهم تدميراً، تبرناهم تتبيراً بمعنى: الهلاك شيء مطّرد. اذهب إلى سورة النور التي انتهينا منها في الأسبوع الماضي لا نجدها، فهي من أيقوناتها اللفظية.
أيضاً حديث عن الحشر بطريقة تهز النفوس: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ إلى أن يقول: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ اذكروا هذا اليوم واجعلوه في بؤرة شعوركم كأنه يقول هكذا: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ بعد ذلك يقول: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ لم يقل: لا يبشر المجرمون: (لا بشرى) نفي الجنس هذه عظيمة.
﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ يا ويلك أيها الكافر أيها المشرك من هذا اليوم: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي﴾. ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾ وفي النهاية يقول: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ هذه من الألفاظ التي تكررت.
وعندما قلت لك في بداية السورة: تبارك الذي أنشأ الثناء على ذاته العلية أيضاً نجد أدلة الوحدانية، وتكررت عندما قال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا﴾، ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ﴾، ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾، ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ هو الذي هو الذي كأن الآية تعرّف ألا تعرفون الله؟ هم قالوا: من الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا، فهذا هو تعريف الله.
إذاً محورها العظيم: رد الشبهات، وثمة مواضيع جاءت في أول آية وجاء التفصيل في السورة.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ تحدثنا حول هذه الآية إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هنا (الذي) بدل من الأولى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ المفعول المطلق موجود هنا.
د. المستغانمي: هذه الآية في الحقيقة: بدأت بالجزء الأول من الآية: ألم نقل: (تبارك الذي) من هو؟ الله (الذي) الثانية هي بدل من الأولى، وممكن أن تكون مبتدأ هو الذي، وأحد المفسرين قال: (ممكن أعني الذي) مفعول به لفعل محذوف. (الذي) بدل من الأولى هو واحد.
المقدم: يمكن لأن الذي اسم موصول فبالتالي الحركة فيه لا تظهر، مقدرة، فجعلهم يقدرونها.
د. المستغانمي: إذاً الذي له ملك السماوات من هو؟ الله، من الذي نزل الفرقان؟ هو يقرب لك المعنى: الذي له ملك السماوات والأرض. هل أحد في الخلق ادعى أنه يملك السماوات والأرض، هل ثمة دولة تدعي من في السماوات والأرض؟ لا يوجد الذي أنا أعرفكم كأنه يقول: أعرفكم بمن هو الله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً للأسف هناك من قال: ولد ولداً، وهناك من قال ولد ولداً، وهناك من قال: (اتخذ ولداً) جاءت الآية الثانية تنزه الله عن الولد وعن الشريك: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ ممكن واحد يقول: (له ملك السماوات والأرض) لكن له شريك، وهكذا كانت قريش: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ لكن لماذا تعبدون الأصنام؟ ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم ما أنكروا أنه خلق السماوات وأنهم لهم قصة أنكروا جعلوا معه شريكاً، وهناك من قال الملائكة بنات الله جعلوا له ولداً، مثل النصارى عندما يدعون أن عيسى ابن الله. إذاً الآية الثانية توحد الله وأثبتت له ما يليق بجلاله من صفات:
أولاً: له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولداً، ولم يكن شريكٌ في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديراً، من الذي خلق هذا الكون؟ الله سبحانه وتعالى وخلقه بمقدار دقيق كل شيء عنده بقدر، وبمقدار آيتان: في سورة الرعد: (بمقدار) وفي القمر: (بقدر) للتناسق اللفظي.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يذكر كثيراً في القرآن دائماً يقول: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مع أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وله ملك كل شيء، فلماذا دائماً يذكر باطراد ملك السماوات والأرض، ويذكر خلق السماوات والأرض؟
د. المستغانمي: لما يقول: السماوات هي كل الكون، يعني هذا الأرض التي نعيش فوقها هي نقطة في هذا الكون، نحن نتبع المجموعة الشمسية إحدى عشر كوكب أو تسعة على ما اكتشف، المجموعة الشمسية ولا شيء في مجرة درب التبانة على طولها مائة ألف سنة ضوئية كما يقول الفيزيائيون أهل الفلك شيء بسيط من الحائط العظيم حائط المجرات.
المقدم: تقصد أن الوجود كله محويٌ في السماوات والأرض؟.
د. المستغانمي: لكن خلق السماوات الآن كل الأبحاث العلمية الدقيقة أنفقوا الملايير وصلوا إلى القمر، وما زالت الأبحاث حول المريخ لم يصلوا إليه هذه في مجموعتنا، أين نحن من ملك السماوات ومن علم السماوات؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ليس الظاهر، (ظاهراً) نكرة جزء من الظاهر، والباطن أين نحن منه؟ لذلك يقول الله: (له الملك) هذه كلمة لا يقولها إلا إله، لذلك وأنا أقرأ ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ يعني: أيّ كاتب أيّ عالم أيّ دكتور يكتب يقول: وأعتذر وإن كان ثمة خطأ، هذا كلام الله يقول محمد كبشر لا يستطيع أن يقول: (لئن اجتمعت الجن والإنس) الإنس ملايين ما يستطيعوا، لأنه كلام إله.
فالآية الأولى فيها أربع مسلمات، أو أربع قضايا: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ المشركون كانوا يعترفون: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ القضية الأولى والرابعة مسلمة، لكن القضية الثانية والثالثة فيها شكوك عندهم، ماذا فعل الله جل جلاله؟ أتى بالمسَلَّمة الأولى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وأتى بالمسلّمة الأخيرة: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ ثم أتى: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾.
المسلَّمة الأولى والأخيرة تدل على المسلمتين في الوسط، فإن كنتم توقنون أن الله خلق وأن الله يملك السماوات مالك السماوات لا يحتاج إلى ولد وإلى شريك ما أغناه عن الشركاء، فهذه تثبت صفات الواحدانية وتثبت هذه الصفات التي يتصف بها الله.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾*﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ في سورة تبارك يقول: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ هنا (الذي له ملك السماوات والأرض) يعني: معرفة بالإضافة، لكن هناك بـ(أل) للتعريف.
د. المستغانمي: الملك المعروف يعني كل الملك الذي ورد ذكره في جميع السور وفي سورة الفرقان: (تبارك الذي بيده الملك) بشكل عام، وعلى كل حال: أنا أعددت لك شيئاً في الحلقات القادمة إن شاء الله سأذكره لك ببعض من الإعجاز الذي يتميز به هذا الكتاب ولا تنتهي غرائبه.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة الفرقان – 2
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
المقدم: كثر في هذا الزمن من يحمل الغثاء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فيتحدث باسم القرآن ويفسر القرآن تفسيرات غير صحيحة لذلك لا بد من الحذر عند الاستماع البعض ممن يريد أن يشتهر على حساب القرآن ويتكسب على حساب القرآن ففسر تفسيرات خاطئة قد تأتي على المسلمين بالويل.
يقف على ملامح السورة أولها ثم خصائصها حتى ننطلق إلى توضيح جوانب من الإعجاز في القرآن الكريم والإعجاز لا بد لمن يتكلم فيه أن يكون عنده دلائل.
د. المستغانمي: نحن لا نخرج عما قاله علماء التفسير مثل الإمام ابن كثير، الإمام الطبري، نسنتير بكلام أصحاب الرأي لكن الكلام يوافق ما جاء في التفسير وعلى منهج أهل السنة والجماعة.
المقدم: في الحلقة الماضية توقفنا عند قول الله تعالى (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾) وفي آية أخرى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) فما الفرق بين نزّل وأنزل؟
د. المستغانمي: العلماء يفرّقون: أنزل تنطبق أكثر على الإنزال جملة واحدة فهو أنزله جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزّل منجمًا، فالتنزيل (فعّل) هذه تفيد التكثير وتفيد التدرج. التضعيف يفيد التدرج لما نقول كسّر الأمر يعني كسره قطعًا قطعًا نزّله تنزيلا أي على أحداث متواليات على فترة 23 سنة إذن هذا تنزيل منجّم أما أنزل فمباشرة هذا الفرق بينهما والقرآن أنزله الله في ليلة القدر ونزّله منجمًا حسب الأحداث.
المقدم: قرأت أن الإنزال في العادة يكون من علو ولكن التنزيل (نزّل) أي وضعه في منزلته، هل هذا يستقيم؟
د. المستغانمي: تحتاج إلى بحث. الإنزال من علو هذا صحيح والله أعلى وأجلّ أنزل القرآن والكتب الأخرى.
المقدم: ورد اسم الموصول (الذي) كثيرًا فلماذا لم يستعمل أداة العطف؟
د. المستغانمي: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ) حديث عن القرآن وإنزاله، الثانية (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) تغيّر الموضوع، في غير القرآن يمكن القول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وله ملك السموات والأرض، هو الله ذاته لكن الآية الأولى تنوه بالقرآن وتشيد بهذا الكتاب العظيم ففيها امتنان على المسلمين بالقرآن العظيم أما الثانية تتحدث عن الملك. إذن هذه لتوحيد الله والحديث عن مخلوقاته وهذه لإظهار الامتنان بإنزال القرآن العظيم لذلك جاء البدل (الذي) بدل من الأولى بإذن الله.
المقدم: (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾) إلى أن يقول (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾) كرر فعل الخلق والملك
د. المستغانمي: السياق الأول يختلف عن الثاني. بدأ بإنشاء الثناء على ذاته والامتنان بإنزال الفرقان وتحدثنا كيف أن الفرقان يدحض الشبهات ويبطلها ثم ذكر لذاته العلية أنه له ملك السموات والأرض وذكر صفاته أربع صفات هي: له ملك السموات والأرض، لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء، هذه الصفات. (وَاتَّخَذُوا) أي المشركين لم يذكروا لكن السياق يُفهمنا أن الحديث عن المشركين. إذن (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً) هذه الآية كأن الجواب جاء قبل أن يذكر أباطيل معتقداتهم جاءت الحقائق (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً) هذا يناقض (وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ)، (لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) ضده (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا) ثم (وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا) ضدها (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) الذي له ملك السموات والأرض بيده كل شيء الموت والحياة والضر والنفع. إذن الآية الثانية مقابلة التي وصف بها المشركون آلهتهم المزعومة الأصنام مقابلة لما وصف الله عز وجلّ به ذاته العلية، وهذه عظمة القرآن. (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) أتى الحقائق ليثبتها في قلوب المؤمنين ثم أتى بالأباطيل انظروا إليهم (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) جناس جميل! (لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) هل الأصنام تُخلَق؟ الأصنام من خشب تصنع ولا تخلق وإنما قال (وَهُمْ يُخْلَقُونَ) من باب المشاكلة (وَهُمْ يُخْلَقُونَ) أصلها يُصنعون، مشاكلة في التعبيرللتجاذب. (وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) في سورة الأنبياء ذكرنا أن ثمّة فرق بين الضّر والضُر، الضُر في الجسم والضَر عام، ضرر عام، إهلاك.
المقدم: الإنسان لا يملك لنفسه الضر بل قد يملك أن يدفع عن نفسه الضر فلماذا قال (وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا)؟ ولماذا يقدم الضر على النفع؟
د. المستغانمي: أولا الضر والنفع في القرآن موضوع طويل، لا يوجد عاقل لا بشر ولا جن ولا يوجد إله يبتغي لنفسه الضر، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين حقارة الأصنام التي إن طُلب منها أن تضرّ فلا تضر فمن باب أولى لا تنفع، الضر للإنسان أسهل من النفع ولو طلب من هذه الأصنام أن تضر لا تضر فمن باب أولى لا تنفع! لذلك قدّم الضر على النفع. الأصنام لا تملك أن تضركم، الإنسان تسأله لماذا تعبد هذا الصنم؟ إذا لم يكن راجيًا للمنفعة من الأصنام يقول أخاف أن تبطش بي! هذه الأصنام لا تبطش، لا تضر ولا تنفع فلماذا تشرك بالله؟ هذه أولًا، ثانيًا (وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا) تقديم الضر على النفع يتناسب مع تقديم الموت على الحياة. لو قلنا هذه الأصنام، المعبودات من دون الله إما عقلاء وإما غير عقلاء، غير عقلاء الأصنام وعقلاء عزير، عيسى، الذين اتخذهم الناس وعبدوهم من دون الله، هؤلاء العقلاء منهم لا يتحكمون في الموت ولا في دفع الموت، هل الأصنام وعيسى عليه السلام الذي اتخذوه إلهًا وهو ليس إلهًا وإنما عبد الله ورسوله أو العزير أو الملائكة هل يملكون أن يمنعوا أنفسهم من الموت؟ لا يملكون موتًا لأنهم هم أحياء فلا يستطيعون دفع الموت ولو كانوا يستطيعون دفع الموت لكان الأمر مختلفًا فالترتيب متناسب لا يدفعون ضرًا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة وأضاف لهم شيئا جديدا (ولا نشورا) وهذا من باب التهكم عليهم يعني هم لا يملكون موتًا ولا حياة ولا يملكون البعث وهم لم يدّعوا البعث أصنامهم لم تدّعي أنها تبعثهم، هو من باب أن يقول لهم: هذه الأصنام لا تملك ضررا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا تكذبون به. هذه الآية تقابل ما أثبته الله لذاته العلية. والأسلوب الخبري إذا قلت: الشمس مشرقة، هو أحد أمرين إما أن أخبرك بالخبر أنت لا تعلم أن الشمس مشرقة وإما أحيطك علما بالخبر بأني أعلم الشمس مشرقة، إفادة الخبر أو لازم الفائدة. هنا في الحقيقة لما يقول الله عز وجلّ (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) هو يعجّب منهم، الأسلوب الخبري غرضه التعجيب اتخذوا من دون الله آلهة ليتها تنفع، ليتها تضر! فهو يعجّب من أناس يعبدون أصنامًأ لا تنفع ولا تضر فللتعجيب من أمرهم انظر يا هذا كيف يعبدون أحجارًا وأصنامًا؟!
المقدم: (وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا) الموت لا يُملك لكن أراد به دفع الموت. (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾) هذه أول شبهة من شبهات المشركين من هم القوم الآخرون؟
د. المستغانمي: الآية الكريمة (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) من هم الذين أعانوه؟ هم يدّعون أن ثمّة بعض الموالي مثل عدّاس، بعض الموالي من الفرس كانوا يعتنقون النصرانية ولهم بعض العلم بالتوراة والإنجيل مثل عدّاس ومثل حويطب هم من الموالي، هذا اتهام، بعض الموالي الذين آمنوا، بعض المماليك قالوا اختلف إليهم فعلّموه وأعانوه، لكن هؤلاء لا يستطيعون أن يصيغوا مثل هذا الكلام الفصيح، هم من الفرس ولم يكونوا فصحاء وأعظم إنسان لا يستطيع (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ (103) النحل) فقالوا (إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ) أي كذب والعياذ بالله واختلاق (إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ) افتراه بمعنى خلقه وأعانه عليه قوم آخرون فردّ الله تعالى عليهم (فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا) وأصل الكلام جاؤوا بظلم، بكلام ظلم يظلمون به هذا الرجل بتهم جائرة ظالمة ضيزى (فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا) في الإعراب نقول: منصوبة على نزع الخافض، جاؤوا بظلم. لم يقل فقد ظلموا أو فقد كذبوا إنما (جاؤوا ظلما) قد لفّقوا وكذبوا واتهموا محمدا صلى الله عليه وسلم البريء الذي هو بريء من كل هذه التهم (وَزُورًا) الظلم هو الاعتداء على الآخرين والزور الكذب المموه المحسّن التزوير يكذب ويزوّر يحسّن، شهادة الزور فيها تمويه، كذب محسّن مزوّق ظاهره جميل (فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا). (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) ما قال (وقالوا) في البداية قال (واتخذوا) هؤلاء ليسوا قوما آخرين وإنما هم أنفسهم وأظهر هنا بدل الإضمار ليقول لنا أن هذا الكلام صادر عن كفر لا يقول إنسان عاقل هذا الكلام، كفرهم حجبهم عن معرفة الحقيقة لو لم يحجبهم كفرهم لتبينوا أن هذا هو الحق.
المقدم: هو تعمّد أن يذكر صفة الكفر هنا
د. المستغانمي: هذا هو الإظهار بدل الإضمار. دائما في القرآن الكريم إذا وجدت كلمة أظهرت بدل إضمارها فثمّة نُكتة في إظهارها، وأذكر في قصة الكهف عندما يقول (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ) ما قال “إذ أووا إلى الكهف”، الفتية ذكروا في الآية الأولى وتكرر ذكرهم (إذ أوى الفتية) أظهرهم بلفظ الفتية لما ذكر (أصحاب الكهف) ما عرفنا هل كانوا كبارًا أم صغارا أو شيوخا لكن لما أظهرهم (إذ أوى الفتية) إظهار بدل الإضمار بيّن حقيقتهم.
المقدم: (إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا) هل هناك ارتباط بين هذه الآية وما قبلها؟
د. المستغانمي: (إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ) هذه شبهة الله عز وجلّ دحضها في البداية (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ)، الله سبحانه وتعالى يقول (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ) وهم يقولون (إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ) هذا كلام منزّل، الله عز وجلّ لم ينتظر حتى يقولوا إن هذا إلا إفك فدحضهم قبل أن يذكروها وفي العادة أن الشبهات تدحض بعد ذكرها، وهنا دحض الله تعالى الشبهة في البداية وأبطلها لما قال (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ) ولما نطقوا قال لهم (فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا) إذن هذه الشبهة داحضة من جانبين: المطلع العجيب يقول (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ) الله يقول نزّله وأنت تقول إن هذا إلا إفك! ألا تستحي أيها الإنسان والواقع يكذبك؟! ليس اختلاق، هذا كلام عجيب منسّق منضد عجز البشر كلهم قاطبة أن يأتوا بمثله ولو كنتم مستطيعون أيها القرشيون البلغاء فانسجوا على منواله ولو آية!
المقدم: (إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ) ما هذا الأسلوب؟
د. المستغانمي: أسلوب القصر، يعني ما هذا إلا إفك
المقدم: يريدون أن يقولوا أن هذا القرآن لا يوصف إلا بالإفك
د. المستغانمي: هذا قولهم والقصر أنواع، هذا قصر قلب، قلب الحقائق هو قال هذا تنزيل وهم قلبوا الحقائق وقالوا (إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ) لو قالوا هذا إفك فالمستمع البسيط من المشركين يقول هذا إفك، لكنهم قالوا (إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ) هذا توكيد وقصر للحقيقة على أن القرآن إفك والقرآن بريء من الإفك.
المقدم: لماذا قال (افتراه)؟ ما هي الفرية؟
د. المستغانمي: الفرية هي الاختلاق والكذب، افترى بمعنى كذب واختلق واصطنع من عنده. القصر هنا في قضيتين لأن الواو جامعة: (افتراه وأعانه) هم قالوا هذا إفك افتراه من عنده وأعانه عليه لأنهم يعلمون أن أولئك لا يستطيعون المجيء بمثله، هم كانوا يظنون أن محمدًا عبقري أتى بشيء من عنده وأعانه عليه قوم آخرون ووالله هو بريء من هذا ومن ذاك!
المقدم: الحديث لا زال متواصلًا في ذات الشبهة، الله عز وجلّ يقول (وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾)
د. المستغانمي: لم يقولوا كتبها وإنما اكتتبها، تكلّف كتابتها لأنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أميّ. اكتتب على وزن افتعل التي فيها تكلّف. هم لو شاؤوا لقالوا أساطير الأولين كتبها، يمكن أنه كلّف غيره أو كتبها هو بيده ولكنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميّا (وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) العنكبوت) لو كان الأمر كذلك لارتاب المبطلون. كلمة أسطورة صيغة أُفعولة، مثل أكذوبة أغلوطة، أحذوثة تدل على الكلام الملفّق الخطأ، كلمة أسطورة بمعنى قصة مسطورة قصة ملفّقة مفتعلة.
(اكْتَتَبَهَا) أي اصطنع والتمس من يكتبها له (فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) كأن هناك من يمليها عليه ممن قالوا عنهم (وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ) يكلف من يكتبها هم يشيرون ويلمّحون أنه أميّ ومع ذلك ألصقوا به تهمة أنه أتى بالكتاب من عنده! وهو يقول أنا بريء منكم ( قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16) يونس) لا بد أن نتحاكم إلى العقل، الناس تكتب بحوثًا تكتب مقالا فيقولون أنا كتبت وكتبت ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى بكتاب عجيب لو كان هو الذي صدر منه لنسبه إلى ذاته وإنما قال (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ) أين عقلاؤكم؟! لذلك هذه شبَه وإبطالها بعدها مباشرة.
المقدم: (فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) أول النهار وآخره
د. المستغانمي: لإفادة الديمومة كأنهم يقولون تملى عليه في كل حين لأنه باغتهم كل يوم يأتيهم بشيء جديد، لا يقصدون البكرة والأصيل وإنما يقصدون استمرارية الإملاء عليه وهذا كلام خطأ.
المقدم: (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾)
د. المستغانمي: لو شاء لقال: أنزله الله جلّ جلاله باسمه الأعظم (الله) لكن قال (أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ) يريد أن يبين لهم أن هذا القرآن يتضمن من الحقائق العلمية والإعجاز في كل ميدان ما لا يستطيع أحد أن يفنّده، هذا الكلام لو جاء به بشر لتبين لكم خطؤه وعواره وضعفه لكن أنزله الذي يعلم السر في السموات، من علّّم محمدا صلى الله عليه وسلم النجوم والكواكب كل في فلك يسبحون؟ من علّم محمدا انشقاق السماء وانفطارها ومواقع النجوم؟ الإعجاز العلمي في القرآن عجيب، (والسماء والطارق) (والسماء ذات البروج) هذا الكلام لا يصدر عن بشر أنزله الذي يعلم (السرّ) جنس السر في السموات والأرض وسوف يتبين لكم من حقائقه ما يثبت أن هذا القرآن صادر من رب العالمين.
المقدم: ختم الآية (إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) ولم تختم مثلا (عليما حكيما) على اعتبار أن الأمر متعلق بالعلم
د. المستغانمي: الخطاب موجّه لكفار قريش، الله تعالى يلقّن النبي صلى الله عليه وسلم ليتحدث مع كفار قريش، الله عز وجلّ يريدهم أن يتوبوا (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) النساء) الإسلام جاء للهداية لا للمحاسبة. فمع كل ما تقولون هناك فرصة للتوبة والعودة والشاهد (إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) لو قال عليما حكيما لتناسق مع صدر الآية لكن (إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) أما حان لكم أن تتوبوا؟ أما آن لكم أن تثوبوا إلى رشدكم وتستدلوا على عظمة الخالق؟!
————-فاصل————
المقدم: بعد الحديث عن تهمهم بنسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه اكتتب قوما فهم يملون عليه القرآن بكرة وأصيلا إلى أن تحدثوا في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم كأن لسان حالهم يقول هو بشر مثلنا (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾) في موضع آخر طلبوا من الله أن ينزل ملكًا عليهم وهنا طلبوا أن ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم ملكًا معاونًا له
د. المستغانمي: في البداية نحن في محور سورة الفرقان ذكرنا المواضيع ومن بينها: الثناء على الله عز وجلّ والتوحيد، الفرقان، بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم والإنذار. لكا حاولوا أن يبثوا بعض الشبهات والأباطيل الخطأ في القرآن (إن هو إلا إفك، أساطير الأولين..) انتقلوا إلى الرسول وهم لا زالوا يبثون السموم لم يتوقفوا عن وضع الأحجار في الطريق والقرآن كان يعالجهم، فبعد أن دحض شبهاتهم عن القرآن (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) انتقلوا إلى شخص رسول الله كأنهم يقولون فرضًا أن هذا القرآن من عند الله ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟
المقدم: لماذا يعترضون عليه أن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟
د. المستغانمي: هذا كناية عن بشريته، لا يريدون أن يكون الرسول بشرًا وهنا جاؤوا بها بطريقة الكناية الذي يأكل الطعام كناية عن موصوف هو البشر، البشر يأكل وينام ويرتاح ويغضب وله شهوات معينة ويمشي في الأسواق لكنهم أظهروا المتبادر المشهود العام، البشر يأكل ويمشي في الأسواق هذا المشهور فقالوا (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) قالوا (الرسول) هل يعترفون برسالته؟! المفروض أن يقولوا هذا الرجل، لا هم استهزاء ومجاراة، فرضًا وجدلًا أن القرآن من عند وأنه رسول ما به يأكل الطعام؟! ما به بشر؟! كان المفترض أن يكون ملكًا.
المقدم: ما نوع الاستفهام هنا (مَالِ هَذَا الرَّسُولِ)؟
د. المستغانمي: استفهام تعجيبي من حال الرسول من حال بشريته، يستنكرون ويتعجبون بالدرجة الأولى، المفسرون يذكرون أنهم يعجّبون من حاله ويستنكرون فهم لا يعترفون له بالرسالة، اعترفوا بها مجاراة واستهزاء (مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ). بعد ذلك قالوا (لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا) في البداية كأنهم تدرجوا قالوا المفترض أن ينزل هذا القرآن على ملك بدليل إنكار البشرية (مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) فرضًا لم ينزل الله ملكًا كان قد أنزل معه ملك، رضوا ببشريته مع ملك، نزلوا عن مقترحاتهم، قللوا من مطالبهم، في البداية كانوا يريدون ملكا (مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) ثم قالوا دعنا ننزل إلى (لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا) نحن نقبل به ونقبل معه ملك، بعد ذلك قالوا (أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ) ما عادوا يريدون أن يكون ملكا ولا أن يكون معه ملك، قالوا على الأقل يلقى إليه كنز من السماء فإن لم يأت بكنز من السماء أن تكون له جنة في مكة في جوها الشديد الصعب أن تجد جنة فيحاء وفيها اخضرار، هذا من الخوارق بالنسبة لهم أما بالنسبة لله فستعود بلاد العرب مروجًا وأنهارًا. تنزلوا معه في الاقتراحات وتدرج القرآن في وصفها (لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا) وثمّة قرآءة صحيحة (نأكل منها) قال أحد المفسرين: تكون له جنة ونحن نذوق ونطعم حتى نتبين إن كانت فاكهة حقيقية أو يسحرنا! (لولا) هنا للتحضيض التي تحثّ لولا أنزل بمعنى هلّا أنزل.
المقدم: (أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ) كيف يلقى إليه كنز؟ كأن فيه اعتراف أن الله في السماء، ومن سيلقي للنبي كنز إلا الله فبالتالي قالوا (أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ)
د. المستغانمي: الكنز يُخرج من الأرض، هم يعترفون، العجائز لما كنّ يؤمنّ يقلن الله في السماء. الله المهيمن جلّ جلاله استوى على العرش. بعض المفسرين قالوا يُخرج له كنز. هم معترفون بعظمة الله سبحانه وتعالى (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الزخرف) يعترفون (أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ) ومن معانيها أو يُخرج إليه كنز، لكن نحن تحدثنا عن التجاذب وسيأتي بعد قليل في جهنم (وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾) ثمة تجاذب صوتي، قد يكون القرآن اختار هذا الفعل لهذا وقد يكون اختاره لأسباب وحكم أخرى.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى (وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا) لماذا وصفهم بالظالمين هنا؟
د. المستغانمي: لأن وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم مسحور ظلم! الرسول أعقل العقلاء في فصاحته وبيانه وعقله وأمنته وصدقه قالوا عنه مسحور فعندما وصفوه بأنه مسحور اختل عقله ظلموه بهذه التهمة فقال الله سبحانه وتعالى قال الظالمون بهذه التسمية وهذه إظهار بدل الإضمار، مرة قال عنهم (قالوا) ومرة (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) وهنا قال (وَقَالَ الظَّالِمُونَ) وسيأتي بعد قليل (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا) اثبت لهم صفات مرة الظلم ومرة الكفر ومرة عدم رجاء لقاء الله فلو أنهم كانوا يرجون لقاء الله ويحسبون حساب ذلك اليوم ما تلفظوا بهذه الكلمة.
المقدم: الآية التي تلي تبين أنهم تنزلوا في طلباتهم (ملك، معه ملك، كنز، جنة…) ثم يقول الله تعالى (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾)
د. المستغانمي: الأمثال الباطلة فضلّوا فلا يستطيعون سبيلا، هذه الآية تدل على تخبطهم وتسلّي الرسول صلى الله عليه وسلم انظر يا محمد، الله جلّ جلاله يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال ليسلّيه، انظر كيف ضربوا لك الأمثال الباطلة وحاولوا أن يختلقوا تهمًا باطلة مرة ساحر، شاعر، مجنون، معلّم مجنون، سحور، ما تركوا شيئا إلا الصقوه وذهبوا إلى الوليد بن المغيرة وقال ما قال، قال ساحر وهو غير مقتنع لكنه أقرب شيء (إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ المدثر). الأمثال المقصود منها القصص المختلقة، ضربوا له الأمثال، ضربوا له شبيها بالمسحور، أمثال باطلة، انظر كيف لفّقوا لك التهم. (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا) لا يقدرون على إيجاد طريق صحيح يتهمون به محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى كلام دقيق صحيح علميا يتهمون به محمدا فلا يستطيعون أن يهتدوا سبيلا.
المقدم: (تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾) هنا المرة الثانية التي ورد فيها (تبارك) (خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ) خيرا مما يقولون (جنات) هم قالوا (جنّة) (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا) وهذا ما طلبوه ولكن الله تعالى يقول إن شاء يجعل لك ذلك.
د. المستغانمي: (تبارك) الثانية جاءت مع الشبهات لم تأت في البداية، القرآن مقسّم بطريقة عجيبة وليس عبثًا. لا يسأل أحد لماذا لم تأتي (تبارك) في بداية الشبهات (لا يُسأل عما يفعل) البشر يُسألون في رسائل الماجستير والدكتوراة لماذا فعلت كذا ولماذا قسمت الباب الفلاني ويجب أن تذكر الأسباب أما الله جلّ جلاله حاول أن تسبر وأن تغترف من معين القرآن وسلّم الأمر لصاحب الأمر. (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ) جاءت في البداية عندما تحدث عن القرآن وعظيمته، ولما جاءت الشبهات جاءت (تبارك) الثانية ردّا عليهم، هم يطلبون أن تكون لك جنة وأن ينزل إليك كنز والله تبارك وتعالى وزادت عظمته وزاد خيره وتعاظم خيره الذي إن شاء جعل جنات تجري من تحتها وليس جنة وجعل لك قصورا عظيمة، العلماء قالوا هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ جمهور المفسرين يقولون في الدنيا لأن الحديث في الدنيا، الله جلّ جلاله وإن شاءت قدرته يجعل لك جنات ويدعل لك قصورا. (إن شاء) (إن) هنا بمعنى (لو) لو الامتناعية، لماذا لم يجعل له جنات؟ لم تشأ الحكمة الإلهية أن يربط الناس بجنات، لو كان رسولا غنيا والله لا يعجزه ذلك لارتبطت أذهان الناس بالجنات والقصور، جعله الله تعالى فقيرًا مسكينًا أتى بالقرآن، من شاء أن ينتبع محمد فللقرآن لا لأن لديه جنات، لم يشأ أن يربطهم بالمادة لأنه يعلم أنهم مفتونون بالمادّيات. بعض المفسرين ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز يقول: تبارك الذي إن شاء الذي شاء فعلاً وحقا وسيجعل له الجنات والقصور في الآخرة في الجنة، يقول (إن شاء) هنا لعظمة المشيئة ذكرنا في سورة من السور أن المشيئة تبقى مفتوحة حتى لما يُدخلهم الجنة كما في سورة هود (ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء الله) الذين في الجنة خالدون فيها إلا ما شاء الله والذين في النار خادون فيها إلا ما شاء الله، فعظمة المشيئة دائمًا مفتوحة. يقول ابن عطية: قد يكون المعنى في الآخرة وله ذلك والمعنى يكون: تبارك الذي جعل لك جنات ويجعل لك وقرآءة ابن كثير وابن عامر الدمشقي (يجعل) بالاستئناف لا بالجزم تدل على هذا المعنى والقرآن حمّال ذو وجوه والله جلّ جلاله لا يعجزه أن يجعل للرسول صلى الله عليه وسلم جنات في الدنيا ولا يعجزه جلّ جلاله أن يعجزه في الآخرة.
المقدم: كأن في الآية شيئا محذوفًا (تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾)
د. المستغانمي: إن شاء جعل في الدنيا لكن الله جلّ جلاله لم تشأ حكمته أن يربط الناس بالمال والماديات.
المقدم: كأن السامع ينتظر أن يقال: بل لم يشأ الله لأنه كذا…
د. المستغانمي: هناك مقدّر وقوله (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ) تدل على أن هناك كلام مقدّر محذوف أما ما قبلها فلا يدل على ذلك. (إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا) ثم (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ) (بل) تفيد الإضراب الانتقالي، كذبوا بشأن الرسول وكذبوا بالبعث فهم في ضلال كبير والنتيجة (وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا) إضراب ينتقل بهم من كفر إلى كفر، هم كذبوا بالرسول ثم كذبوا بالساعة والساعة عَلَمٌ على يوم القيامة ولكن هي مبدأ القيامة، هي أول القيامة. لما نقول (كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ) كأننا نقول كذبوا بيوم القيامة.
ثم أوضح (وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا) هذا الدليل يشفع رأي الذين يقولون يوم القيامة، الذين كفروا بالساعة أعتدنا لهم سعيرا ومحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه أعد لهم جنات وقصورا.
(تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾) هو ردّ للشبهة التي وردت من قبل (أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا) يوم ردّ عليهم (وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا) كأنه فتح قوسين (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا) ثم عاد ففنّد شبهتهم.
المقدم: الذي أفهمه من الآية (تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾) الله سبحانه وتعالى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك في يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار ولكنهم هم كذبوا بالآخرة
د. المستغانمي: المعنى وارد والقرآن حمّال. جمهور العلماء الذين قالوا في الدنيا، رأي صحيح، والرأي الذي قال إن شاء يجعل لك وسيجعل لك ولكن للأسف هم لا يؤمنون بالساعة فكيف سيرون ما في الجنة وهم يكونوا في السعير وساءت مصيرا؟!
المقدم: (سعيرا) يقصد بها نار جهنم، اسم من أسمائها وصفة من صفاتها، تسعّر بهم النار
د. المستغانمي: أي تلتهب، سعيرا أي التهابًا، وقودًا، لما نقول سعيرا بمعنى مسعورًا (وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا) أعتدنا لمن كذب بالساعة نارا مستعرة متقدة سعيرا فهو وصف للنار واسم من أسمائها بالغلبة لما تطلق يذهب الذهن إلى النار. سعير من الناحية اللغوية على وزن فعيل بمعنى مفعول (سعير بمعنى مسعور) فهي تسعّر بأهلها.
المقدم: (إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾)
د. المستغانمي: الحديث عن النار، إذا رأتهم. هل النار ترى؟ هنا معنيان ونقف عند ما يقف عنده المفسرون. نستطيع أن نفهمها مجازيًا ونحن الآن لا نتحدث عن صفات الله وأسمائه، جمهور المفسرين قالوا: يجوز أن يكون المعنى المجازي مقصود، إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا اصبحوا عندما يساقون إلى النار ويُزجى بهم إلى النار بمكان المرأى منها – هنا حديث مجازي – سمعوا لها تغيظًا، صوتًا وهي تحترق، التغيظ هو الغضب الشديد، سمعوا صوت المتغيظ كالإنسان الغضبان وزفيرًا الهواء الشديد الحار السموم شًبّه . والمعنى الثاني الذي يقول به أهل السنة والجماعة ونحن نميل إليه أيضًأ: أحوال الآخرة مجهولة عنا لا نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا فليس ببعيد عن الله أن يخلق لها إدراكا وتنظر وعندما يأتي ليها أهل جهنم تراهم وتتحدث وتقول هل من مزيد في سورة ق واشتكت النار إلى الله كما في الحديث الصحيح فجعل لها نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فلا يبعد أن يخلق لها إدراكا ولو قلنا مجازيا فالقرآن نزل على لسان العرب ولكن المشهد مخيف!
المقدم: وهذه الآية تذكرنا بآية سورة تبارك قال (إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ الملك)
د. المستغانمي: تكاد تنفجر وتتميز قطعها وتفترق من الغيظ والغيظ شدة الغضب وهنا قال (سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا) تغيّظ تفعّل، الغيظ شدة الغضب والتغيّظ أشد الغيظ.
المقدم: (وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ يس) أي تفرّقوا، (تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ) تتفرق وتتشتت. (وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ)
د. المستغانمي: مصفّدين بالأغلال أو مقرّنين بالأصفاد.
المقدم: (وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾)
د. المستغانمي: إذا ألقوا في جهنم والعياذ بالله وهنا في البلاغة يسمى الإدماج، (وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا) أصل الحديث: إذا ألقوا في مكان ضيّق، هنا السرعة في الحديث دائما في الإعراب نقول منصوبة بنزع الخافض لأن التقدير: إذا ألقوا في مكان ضيّق، إدماج، كأنه يصور لنا جهنم من داخل، من يعرف أن جهنم ضيقة أو واسعة؟! هذا إدماج. لو قال إذا ألقوا مقرّنين دعوا هنالك ثبورًا المعنى واضح، ألقوا فيها مصفّدين بالأغلال أو مقرّنين بالأصفاد (في سورة إبراهيم ورد: (مقرنين بالأصفاد)) والقرآن يقاس بعضه على بعضه دعوا هنالك ثبورا قالوا يا ثبوراه! واثبوراه! الثبور هو الهلاك، يدعون الثبور أن يأتي، هذا أوانك فإت! هم لا يريدون البقاء، يدعون بالهلاك أن يأتي إليهم (يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا) هذا الإدماج من باب تصوير جهنم من داخل كأن عدسة بيانية تصوّر (وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ) هي مصيبة إذا ألقوا فيها بدون أن يكونوا في مكان ضيق وبدون أن يكونوا مقرّنين فما بالك بكل هذه الأوصاف؟!
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة الفرقان – 3
تفريغ الأخت نوال جزاها الله خيرًا لموقع إسلاميات حصريًا
المقدم: وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ (منها) من نار جهنم،
﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ قل يا محمد! أذلك ما المقصود باسم الإشارة هنا؟ اسم الإشارة يدل على البعيد إلى من يعود؟
د. المستغانمي: قوله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ مرتبط بالآية السابقة، الآية السابقة تحدثت عن مصير الكافرين المشركين المشؤوم وهو جهنم حيث قال ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِين﴾ أي: مصفدين مسلسلين بالأصفاد والأغلال ﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ دعوا بالهلاك على أنفسهم، فقال الله على وجه التهكم بهم ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ لا تدعو بهلاك واحد وادعوا ثبوراً كثيراً لن يستجاب لكم! الثبور هو الهلاك كما شرحنا. هنا التلقين كما تعرفون قل: يا محمد! أذلك خيرٌ أذلك المصير المشؤوم، أذلك المكان الضيق من جهنم خيرٌ أم جنت الخلد؟! هل هناك عاقل يشك في أن جهنم خير أم الجنة خير؟ هذا الأسلوب أسلوب تهكم، حسب المخاطب (قل أذلك خيرٌ) أذلك المصير الجهنمي المشؤوم خيرٌ أم جنة الخلد؟! ﴿الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾.
المقدم: (وعد) من الأفعال التي تستوجب مفعولين، فأين المفعول الثاني هنا؟
د. المستغانمي: وعد الله المتقين الجنة.
المقدم: الجنة ليست مذكورة هنا؟
د. المستغانمي: الجنة التي وعدها المتقون، وهي محذوفة، وهنا لأنه بني للمجهول فكأنه يقول: (أذلك خيرٌ أم جنة الخلد التي وعدها المتقون) والهاء حذفت والكلام واضح. الخطاب هنا المفسرون وقفوا عنده في الحقيقة لمن وجّه الخطاب؟! والقرآن يحمل، وما دام يحمل هذا هو التنوع، وهذا هو الثراء، لو كان الحديث موجهاً للمشركين هنا تهكم.
المقدم: إذاً لمن هو موجه؟
د. المستغانمي: هو يجوز الوجهان: إذا قلنا: الخطاب موجه للمشركين معنى ذلك تهكم بهم كأنه يقول: قل أذلك المصير المظلم المشؤوم الضيق في جهنم خير أم جنة الخلد؟! لا أحد يجهل أن جنة الخلد أفضل، إذاً هو تهكم بهم. لكن ممكن أن يكون الحديث موجهاً للمسلمين والمؤمنين قل لهم يا محمد! على وجه التمليح والتلطف بهم، هاهنا المعنى اختلف يجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين، ويكون من باب التمليح (أذلك خيرٌ) مصير الجهنميين (أم جنة الخلد التي وعد بها المتقون)؟ فهو يخاطبهم وهو يرفع من معنوياتهم ويتلطف بهم كما يقول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ من هو المزمل؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: يا محمد! يا أيها النبي! يا أيها المتزمل، يا أيها المتدثر، تلطُّف والتلطف هذا موجود، فهنا يتلطف الله يعني الأسلوب مع المؤمنين من باب التلميح. في آيات أخرى ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ في سورة الصافات فهنا من باب التمليح ﴿أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ كانت لهم جزاء وفاقًا لأعمالهم.
المقدم: عندما قال الله تعالى: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾ في سورة النبأ هل يقصد الجنة أم النار؟
د. المستغانمي: يجوز الوجهان
المقدم: حينما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ هل الجزاء يكون دائماً للعقاب؟
د. المستغانمي: لا ليس شرط الجزاء للعقاب وللثواب، وهنا كما قال ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾، وأيضاً ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ المقدم: فإذاً معنى ذلك هنا يتحدث عن الجنة ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾؟
د. المستغانمي: نعم الجنة كانت لهم جزاء ومصير ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾. وإذا كان الخطاب للمؤمنين فأيضاً فيها نكتة بلاغية رائعة القياس أن يقول لهم: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعدتم، قال: ﴿أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ وأنتم منهم، إظهار بدل الإضمار بيّن أنهم من المتقين، للتعميم، إفادة العموم فقط المخاطبون؟ لا، كل من اتقى الله يدخل في هذا الخطاب؛ ولبيان أن التقوى هي سبب ذلك الجزاء العظيم. بينما لو قال لهم: (أم جنة الخلد التي وعدتم) الخطاب لهم، وُعد المتقون بسبب تقواهم، فالجملة تحتمل والقرآن حمّال ذو وجوه.
المقدم: الآية في سورة النبأ ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾ حينما يتحدث عن المشركين عن عذاب النار في سياق الآيات (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِلطَّاغِينَ مَآَبًا ﴿٢٢﴾ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾)
د. المستغانمي: الجزاء يأتي للثواب وللعقاب ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ فالجزاء يأتي للاثنين.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ لماذا الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾؟
د. المستغانمي: ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ بداية الآية الجنة لهم فيها ما يشاؤون وكما ورد في آية أخرى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ خالدين: جنة الخلد، ثم يقول: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ هذه الآية تحتمل معنيين أيضاً الله سبحانه وتعالى يتفضل بالجنة على عباده يعني هو فقط لو جازنا على أعمالنا أعمالنا لا تصل فهو يتفضل ويضاعف الحسنات ويضاعف الأجور، ومع ذلك وعد عباده الصالحين بهذا الجزاء العظيم، وعدهم وعداً، والله لا يخلف الميعاد. ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ كأنه يقول: من حقكم أن تسألوا هذا الثواب، كأنكم تستحقونه استحقاقاً، يعني بما معناه: أخذتم الجنة عن جدارة. أعطيك مثالاً في الواقع: أحد الأشخاص أردت أن تعمل معه معروفاً، عملت معه معروف قوي تقول: تفضلت علينا يا أخي، ويقول لك: لا والله هذا واجبي، هو ليس واجباً عليه، لكن أنت تقول: هذا من الواجب، الله سبحانه المتفضل الكريم يعطينا الجنة ويقول لك هذا من حقك أن تسأل عنه ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ يريد أن يبيّن جدارة واستحقاق المؤمنين الصادقين لهذا الثواب، هذا أولًا وهو تفضل منه جلّ جلاله. ثانيًا بعض المفسرين أتوا بنكتة رائعة قالوا: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ وعد الله لا يتخلف والملائكة دائماً تطلب تقول ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ الملائكة يسألون الجنة للمؤمنين، أدخِلهم جنات عدن التي وعدتهم فهو وعدٌ مسؤول من قبل الملائكة للمسلمين حتى الآيات إذا وصلناها إن شاء الله في سورة غافر ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ إلى أن يقول ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الملائكة تستغفر للذين آمنوا، هذا كان وعداً مسؤولاً أي مطلوبًا.
المقدم: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ يحشر من؟ (وما يعبدون) (ما) لغير العاقل
د. المستغانمي: (ما) لغير العاقل وتأتي للعاقل أحيانًا، (ما)عامة تنطبق على العقلاء وعلى غير العقلاء. في الواقع العملي غالبًا تأتي لغير العاقل لكن أحيانًا تأتي للعاقل ولغير العاقل فهي أعمّ وأشمل.
المقدم: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) هل هناك شيء من التعارض الذي يفهمه القارئ العادي من (أأنتم أضللتم) وبين (وما يعبدون)؟
د. المستغانمي: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ الكلام عن المشركين الكافرين، أما المؤمنون يجمعهم ويسوقهم صحيح هو يوم الحشر، لكن هنا ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ لأنه ستأتي بعدها آيات أخرى ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ هنا تقول الآية ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، وآيات أخرى ستأتي ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ والذي يُحشر على وجهه –والعياذ بالله- هو الكافر منكباً على وجهه. (ويوم يحشرهم) واذكر يا محمد، المفسرون يقولون: دائماً يقدر الفعل: (اذكر) واذكر ذلك اليوم الفظيع العسير العظيم المفزع ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ المشركون والكافرون في العالم كله ماذا يعبدون؟ إما يعبدون الأصنام وهم المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدون النار، أو بعض الناس يعبدون الحيوانات، أو الأجرام وهي أيضًا لا تعقل، أو يعبدون الملائكة من دون الله، أو يعبدون عيسى، أو يعبدون العزير وهو عاقل فقوله تعالى ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ هي أعمّ للعاقل وغير العاقل، لأننا كثيراً ما قلنا مثلاً ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ * ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ وما سواها: الله سواها جل جلاله ولما يقول القرآن: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (ما) هي أشمل (من) فقط للعاقل لن يدخل في ضمنها غير العاقل. فنحن اعتدنا في النحو نقول: (ما) لغير العاقل (ومن) لكن إذا تعمقنا في النحو (ما) أشمل وهذا ما قاله سيبويه وقاله العلماء. إذاً: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ يوجه لهم الخطاب: ﴿فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾ الخطاب للمعبودين للذين عُبدوا من دون الله: الملائكة، والمسيح، وعزير، والأصنام، والنار.
المقدم: فكيف يخاطب النار ويخاطب الأصنام، ويخاطب البهائم التي عُبدت، ويخاطب الأجرام التي عُبدت، يعني ربما يخاطب عزير ويخاطب المسيح، ويخاطب فرعون الذي عُبد، لكن كيف يخاطب النار؟
د. المستغانمي: هذا الكلام طرحه المفسرون، عندما خاطب المعبودين وقال: ﴿أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي﴾ الخطاب للعقلاء هذا ظاهر الملائكة وعيسى وكذا. ولكن غير العقلاء لا يمتنع في حق الله أن يخلق فيهم إدراكاً ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ تقول قولاً لا يمتنع ذلك، وأن نأخذ الأمور على حقيقتها كما قال الإمام الألوسي البغدادي.
المقدم: لأن البعض يقول: بأنها تقول: فعلاً أي: أنها تستقبل المزيد تعبير مجازي؟
د. المستغانمي: هذا وارد وهذا وارد، ما دامت المسألة لا تتعلق بصفات الله وأسمائه الحقيقة واردة والمجاز وارد، ولا خلاف حتى عند أهل السنة، فيحملونها هذا المحمل، فالله تعالى لا يعجزه جل جلاله أن يخلق في الأصنام إدراكاً للرد ﴿أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ والدليل على ذلك أنهم قالوا (سبحانك) ردّوا، فلا يمتنع ذلك على الله سبحانه وتعالى.
لكن السؤال: ﴿أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ﴾ فيه شيء جميل جداً ﴿أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ يعني هل أنتم طلبتم منهم عبادتكم؟ أم هم عبدوكم وضلّوا من تلقاء أنفسهم؟ مثلما قال لعيسى ابن مريم ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾
لم يقل لهم: (ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أضللتم عبادي أم ضلوا السبيل؟ وضع المسند إليه (أأنتم)؛ لأن الإضلال وقع وانتهى حصل، السؤال ليس لوقوع الإضلال أم لم يقع، من الذي أضلهم؟ يريد هل أنت الذي أضللت أم هم ضلوا من أنفسهم، وليس السؤال عن الفعل، الفعل وقع وحصل، إذاً فالسؤال يراد منه الاستنطاق والإقرار، إما تقولون: أنتم أضللتموهم أم قل: هم ضلوا السبيل وحدهم، هذا الذي يراد من السؤال، يراد منه الاستنطاق، لذلك صيغ بصيغة تقديم المسند إليه، والخبر عنه فعل (أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ).
المقدم: سؤال آخر: نحن نقول: ضل السبيل أو حاد عن السبيل ضل عن السبيل؟
د. المستغانمي: في اللغة العربية في الاستعمال العادي نقول: ضل عن الطريق، ضل عن السبيل. أما هنا: النحويون يجيبون بجوابين: الجواب الأول: ضُمن الفعل (ضل) بمعنى: (أخطأ) كأنه يقول: أم هم أخطأوا السبيل؟ ضلوا السبيل بمعنى أخطأوا الطريق، هذا المعنى الأول.
المعنى الثاني للنحويون: يقولون: منصوبة بنزع الخافض، الخافض موجود: (ضلوا عن السبيل) (وضلوا السبيل) نزع الخافض في اللغة هذه تقنية لغوية رائعة.
المقدم: إذاً الجواب: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾.
د. المستغانمي: هذا الجواب، جواب البيان القرآني ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ﴾ أولاً: سبحانك كلمة (تنزيه) وكلمة (تنزيه) تقال عند التعجيب، أنت لكل مُعجبة سبحان الله! وعندما يكون المقام مقام خضوع واعتراف، سبحانك! كما قال عيسى عليه السلام لما خاطبه الله: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ لم يجد كلمة إلا أن قال ﴿ سُبْحَانَكَ﴾ أنزهك يا ربي من أن أقول هذا الكلام! من المستحيل، وكذلك الأصنام، والملائكة، والشجر والنار التي تعبد تقول: سبحانك! تعظيم لله وتنزيه لذاته العلية، واستنكار من المستحيل أن يصدر منا ذلك.
المقدم: لكن بعض الآلهة قالت للناس اعبدوني مثل فرعون قال ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾.
د. المستغانمي: يوم القيامة يندم الندم الأكبر وفرعون عندما رأى الماء فقط قال ﴿قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ لما يرى نفسه في وسط الجحيم سيتبرأ ويقول هذا الكلام، هو لا يريد شيئاً. لذلك (سبحانك ما كان ينبغي لنا) نفي شديد، لو شاؤوا لقالوا: سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ، (قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ) هذا أسلوب الجحود عندما نقول: (ما كان) وننفي الخبر عن طريق (ما كان) يعني من المستحيلات. ما قالوا: ما كان يصح، ما كان يستقيم، لا (ما كان ينبغي) (ينبغي) فعل مطاوعة لبغى، بغى وانبغى، كأنهم يقولون: سبحانك ما كانت أنفسنا تطاوعنا أن نطلب أن يعصوك، هذا أسلوب المطاوعة. أبداً ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء! انظر إلى (اتخاذ) نحن قلنا في الحلقة الأولى من الأيقونات اللفظية في هذه السورة الفعل (اتخذ) لم يقولوا له: ما كان ينبغي لنا أن نطلب، أن نلتمس، لا، بل قال أن نتخذ أتباعاً وأولياء، الاتخاذ فيه تكلف يعني: الذي يطلب من إنسان أن يعبده هذا يتكلف، الفطرة تقول: لا إله إلا الله، والفعل (الاتخاذ) ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ لما تحدث عن المشركين قال ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً﴾ اتخذوا بمعنى: تكلّفوا، وإلا ما في شجر طلب منك أن تعبده، لما يندم المشرك يقول: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ لم يقل: يا لتني اتبعت الرسول، لو اتبعته فالاتباع جميل، ليتني اتخذت وكلفت نفسي وقرأت السنة وقرأت القرآن واتخذت سبيل الرسول فيه مشقة، الاتخاذ هنا شيء عجيب وجمل رائعة تدل على ثوب السورة اللفظي.
المقدم: وهنا يقول: ﴿مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾.
د. المستغانمي: (دون) هو ظرف، ما كان لنا أن نتخذ عباداً من جانب غير جانبك، ابتداء الغاية قبل الظرفية كأنه يقول: لا يحسن بنا ولا يصح ولا يستقيم أن نتخذ عباداً لا يعترفون لك بالإلهية من دونك، من الجانب الآخر، كما قال تعالى ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي يقف في شقٍ غير شق الله والرسول، هذا قريب منها.
(ومن) الأخرى للجنس من جنس الأولياء، والأولياء جمع: ولي، وولي كلمة تجمع المتناقضين، الولي هو الله ولي الذين آمنوا، يعني يتولاهم ويحبهم. الولي في اللغة تأتي على: المولى، وعلى العبد، على الناصر وعلى المنصور، من الكلمات المشتركة اللفظية التي تدل على المتناقضين. فلما يقول الله: (الله ولي الذين آمنوا) ناصرهم ومربيهم، ولما نقول: ما كان لنا أن نتخذ من دونك أتباعاً نقول: الله مولانا، ويقال: فلان مولى فلان، أي: عبده أو خادمه، إذاً هذه من التي تجمع المتناقضين والأضداد.
المقدم: ﴿مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآَبَاءَهُمْ﴾ السؤال: الله تعالى يعرف الأسباب وهم كأنهم يبررون فلماذا أدخلوا آباءهم ولم يأت الحديث عن آبائهم الحديث عن المشركين، لماذا تحدث هنا هؤلاء الذين عُبدوا لماذا ذكروا سيرة الآباء في هذا السياق؟
د. المستغانمي: كلام وجيه جداً قالوا: ﴿مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ﴾ أولاً: أقف عند (متعتهم) التمتيع كل الدنيا مهما كانت بزخرفها وملذاتها متاع! كل ما في الدنيا من ملذات متاع، أما ما في الآخرة والجنة فهو نعيم، وكل ما في الدنيا من شهوات وملذات وزخرفها ومن ذهب متاع.
وجذر الكلمة (متع): أمتع الشيء يعني: تمتع بمعنى: وجد لذته في ذلك الأمر. متعتهم وأعطيتهم من المتاع الكثير، هذا المتاع الكثير أعطيتهم وأعطيت آباءهم، القرآن يصور تجذّرهم في النعم، كان الأولى أن تلك النعم التي أسبغها الله عليهم أن تدعوهم إلى الاعتراف بالمنعِم، ولكن متعتهم وآباءهم للأسف حتى قادتهم تلك النعم إلى الكفران، حتى نسوا الذكر. يريدون أن يبينوا الآلهة المزعومة الأصنام تبيّن أن أولئك المشركين انغمسوا في متاع الدنيا وكان ذلك متأثلّا متجذراً في الآباء.
المقدم: أنا الذي لا أفهمه هنا: كيف أن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله حينما جاءوا يذكرون السبب -الذي أفهمه- كأنما نسبوا السبب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الذي فهمته كأنهم يقولون: سبب عبادتهم لنا هو: أنك يا الله متعتهم وآباءهم (حتى) لانتهاء الغاية حتى وصلوا إلى أنهم نسوا؟
د. المستغانمي: جميل، لكن الواحد إذا قلت لك: يا رب متعتهم، وهل من الضروري أن يدعوهم المتاع والتمتيع إلى الكفران؟! هذا كأنه من باب كفران النعمة، كان الأولى بهم أن يشكروا الله يعني باختصار هو لما سألهم (أأنتم أضللتم عبادي أم هم ضلوا)؟ هم يريدون أن يقولوا: هم ضلوا السبيل لكن ما قالوا: هم ضلوا السبيل، قالوا يا رب أنت متعتهم، ووسعت لهم في أموالهم وأرزاقهم والصحة والسيارات، والأموال والملايين، حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً، وكان الأولى بهم ألا ينسوا الذكر، وألا ينسوا هذه العقيدة السليمة، والفطرة تدعوهم إلى الإيمان. وذكروا (الآباء) جواباً على سؤالك لزيادة التعريض بالمشركين وآبائهم حتى الآباء ليسوا معذورين في الإشراك، حتى أهل الفترة المختلف فيهم جاءتهم الرسل السابقون. (حتى نسوا الذكر) هم يعلمون أن القرآن هو الذكر، وأن الدعوة هي الذكر ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ كانوا قوماً هلكى هالكين.
المقدم: حتى لتقريب المثل – ولله المثل الأعلى- كأني أشبه الأب يخاطب أبناءه فيلومه لائم يقول: لماذا أبناؤك مثلاً لا يتبعونك لم يعملوا مثل ما أنت تعمل؟ لم يمشوا على صراطك لم يمشوا على طريقك؟! فيرد فيقول: أنا دلعتهم وأنا وفرت لهم المتاع بدل من أن يشكروا ويتبعوا ويدرسوا، فانحرفوا.
د. المستغانمي: في الحقيقة الجواب ضمني من خلال الكلام التي ذكرته المعبودات التي لا تسمع ولا تنفع أنطقها الله، يا رب أنت متعتهم وعوضاً أن يشكروا تلك النعم هم وآباؤهم كفروا ونسوا الذكر، هم في الحقيقة نسوا الذكر أم أعرضوا عن الذكر؟ هم في الحقيقة أعرضوا. شبّه البيان القرآني إعراضهم عن القرآن بالنسيان لأن الفطرة تقول لك: يا أخي! أنت عبد لله، الفطرة موجودة في كل إنسان فطرة الله التي خلق الناس عليها وفطر الناس عليها، نحتاج إلى التذكر فقط فهم قالوا: حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً هلكى وهالكين.
وانظر إلى التعبير لم يقولوا: حتى نسوا الذكر وباروا يعني: هلكوا، لا، حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً متمكنين في البوار، البوار: هو الهلاك، وورد: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ دار البوار: هي جهنم يصلونها دار الهلاك دار التدمير والعذاب. أنا يعجبني هذا التعليق القرآني: كان البور متمكناً منهم، أما لو قال: حتى نسوا الذكر وباروا أقل في التعبير.
المقدم: ما المقصود بـ (الذكر)؟
د. المستغانمي: الذكر هو القرآن يذكر بالحقيقة ويذكر بالحق ويذكر بالعقيدة الصحيحة، كل ما يذكر لكن هنا المقصود هو القرآن.
المقدم: والقرآن بالقرآن يفسر كما في سورة طه ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ * ﴿قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾. نريد أن نكمل بعد قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ الآن سوف يأتي كذلك خطاب الله سبحانه وتعالى للجهة الأخرى المقابلة.
المقدم: حياكم الله من جديد لا زلنا في رحاب سورة الفرقان من سور القرآن الكريم وكأني أرى صورة ولا أستطيع أن أقول: إلا صورة جميلة تمثيلية واضحة جداً الله سبحانه وتعالى يبدأها فيه: (ويوم يحشرهم) واذكر يا محمد! يوم يحشرهم فالحشر حاضر يحشرهم وما يعبدون، عندنا فريقين: يحشر المشركين والذين عبد المشركون، يعني: الذين عُبدوا، فالسؤال الأول سأله الله سبحانه وتعالى للذين عُبدوا من دون الله قال لهم الله سبحانه وتعالى ﴿أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي﴾؟ فأجابوا ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي﴾ أجابوا جوابهم الذي كنا وقفنا عنده، لما انتهى كلامهم كلام الذين عُبدوا كأن الله سبحانه وتعالى اتجه إلى الذين عبَدوا، إلى المشركين قال لهم ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ﴾ الذين عبدتموهم كذبوكم بما تقولون ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ أي: لا تستطيعون، صورة عجيبة غريبة.
د. المستغانمي: وأنت وقفت على معالمها. هو في الحقيقة الآن الخطاب توجه للمشركين للعابدين الذين أشركوا مع الله، لكن ما الذي دلنا وما الذي دلك؟ هذا المشهد القرآني العظيم، لم يقل: وتوجه الخطاب إلى المشركين، هذا يسمى في التقنيات اللغوية وفي فن الرواية: الاقتطاع من الحدث، كأننا الآن بعدما قال ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ يحشر المشركين ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ هنا فريقين قدّم لهم وقال لهم ﴿أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ بعدما أجاب المعبودون من دون الله الأصنام الآن توجه الخطاب كأننا الآن في مشهدٍ من مشاهد القيامة ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ﴾ فما أنتم قائلون؟! المشهد هذا المشهد نقول: انتقل البيان القرآني إلى تصوير المشهد، لأنه لو أتى بالفعل (قال) ويقول للعابدين، ما زلنا في شيء خيالي، لكن لما قال مباشرة: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ﴾ وهذا فن الاقتطاع من المشهد نعيشه نحن الآن. وسأقول شيئين: (الفاء) هنا في قوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ﴾ واقعة في جواب شرط محذوف يقدّره الفاهم: إن كنتم تقولون هؤلاء آلهة فقد كذبوكم، لما يقرأ المسلم ويتدبر (فقد كذبوكم) أصل الكلام محذوف إن كنتم تقولون هؤلاء آلهة فقد كذبوكم، الفاء واقعة في جواب شرط محذوف. فن الاقتطاع هذا في القرآن ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ يقال لهم: تقول لهم الزبانية، فالفعل يحذف لتقريب المشهد، هذا في القرآن، أين الكاميرا المعاصرة، أين الإخراج السينمائي المعاصر من الإخراج البياني القرآني؟! يوسف عليه السلام لما عبر الرؤيا لللذين كانا معه في السجن، فقال لهم ذلك الشاب الذي قال: ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ هذا عند الملك، الشاب الذي خرج من السجن ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ * ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ مباشرة يعني وافق الملك وذهب الشاب ودخل السجن، كل هذا مختصره: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ هذا فن الاقتطاع من الخبر، يعني القرآن يجعلنا نعيش يوم القيامة في هذا المشهد العظيم.
المقدم: إذاً الله سبحانه وتعالى حين يقول ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾ ما المقصود ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾؟
د. المستغانمي: فما تستطيعون صرف العذاب عنكم ولا نصر أنفسكم. هذه الآية فيها قراءات: تقرأ: ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾ وتقرأ في رواية صحيحة: ﴿فَمَا يسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾ فعلى القراءة الأولى: فما تستطيعون أنتم صرف النار عن وجوهكم كما ورد في الأعراف ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ وكما وردت في سورة الفرقان في النهاية ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ إذاً (فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا) عن أنفسكم نار جهنم (ولا نصراً) لأنفسكم ولا لغيره.
ولو كان الخطاب على قراءة:(فما يستطيعون) بقراءة صحيحة أخرى قرأها القراء العشرة: فما تستطيع الآلهة لكم صرف النار عنكم ولا نصركم، فكِلا الفريقين لا يستطيعان، ضعف الطالب والمطلوب.
المقدم: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ ماذا يظلم؟
د. المستغانمي: ومن يظلم منكم في الدنيا نفسه بالشرك ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ من يظلم غيره، هذه تذييل عام كل من يظلم ويقع في الظلم وأعظم الظلم هو الشرك نذقه عذاباً كبيرًا، والآية واضحة.
المقدم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ أول سؤال: ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟
د. المستغانمي: لعلك تذكر عندما قلنا سورة الفرقان سورة فرّقت بين الحق والباطل، فرّقت بين حقائق التوحيد والإسلام والشُبَه، وتعللات المشركين كانوا يلقون في وجه الإسلام الشبهات، في وجه الرسول، قالوا لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ لماذا أرسل رسولاً بشراً؟ نحن قلنا الآية قالت: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ * ﴿أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ﴾.
المقدم: لماذا جاء الآن هذا الجواب هنا؟
د. المستغانمي: قبل أجابهم هم لديهم شبهات كثيرة، الشبهات سنعيد قراءتها ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ أي: ما لهذا الرسول بشر، ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ﴾ يريدون ملكاً معه منزل، ﴿أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ الجواب الذي أتاهم. أتاهم عن الاثنتين الأخيرتين: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا﴾ أجابهم عن المطلبين الأخيرين. والآن أجابهم عن البشرية، هذه سنة الله في الكون في الحياة: وما أرسلنا يا محمد قبلك أحداً من الرسل إلا كان بشراً يمشي في الأسواق ويأكل ويشرب وينام ويتزوج.
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أين المفعول به؟ وما أرسلنا قبلك رسولاً من المرسلين، أحداً من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام. ما وراء (إلا) من الناحية الإعرابية هو (حال) ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا حال كونهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لا بد أن يكونوا رسلا. وأنا أتدبر في هذه الآية الكريمة، نحن قلنا هذا في الحلقة الأولى والثانية قلنا: تنزّلوا يعني: وتنازلوا، في البداية قال: قالوا لم يكن ملك لو أنزل إلينا ملك، أو قالوا: معه ملك يعني: نحن نقبل أن يكون بشرٌ ونطلب أن يكون معه ملك رديفاً له ثم قالوا: نقبل أن يكون بشراً، لكن يلقى إليه كنز، ونزلوا أو جنة في مكة في شدة الحرارة، هذه في الحقيقة استوقفتني مع آية سورة الإسراء عندما قالوا أيضاً في تعنتهم والشبهات قالوا ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ أي نبع ماء، ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا﴾ هنا الترقي غير التنازل، العكس، هذا الذي لفت انتباهي وأحببت أنقل لك هذه المعلومة. أيهما أكثر الينبوع أو الأنهار؟ الأنهار أكثر، ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ المطالب زادت ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ﴾ يعني بيت من ذهب، تعجيز ما فوقه تعجيز، ﴿أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ﴾ نلمسه بأيدينا ونقرؤه، الله أجاب ولقن رسوله قل لهم: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ ما أنا إلا بشر رسول. الذي لفت انتباهي أن في سورة الفرقان تنازلوا كما قلنا: ملك، رجل مع ملك، رجل غنيٌ له كنز، ورجل له جنة. لماذا في سورة الفرقان هذا التنازل؟ لأن السورة جوّها جو إنزال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ هذا هو المفتاح، لما كان القرآن يتنزل من السماء وكان المفتاح (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ) جاء التنازل.
في سورة الإسراء سورة ارتقاء من الأرض إلى السماء، نكتة عجيبة! – ولله في خلقه شؤون وفي القرآن أسرار- في سورة الإسراء الذي أسرى بعبده من مكة إلى المسجد الحرام، ومن المسجد الحرام عرج به إلى سدرة المنتهى عند الجنتين يغشاها ما يغشى، هذا الارتقاء ناسب فيه أن يذكر العكس، وطلبوا الينبوع والجنات إلى أن ترقى في السماء، الله أجابهم قال: ليس الرقي الذي تطلبونه، إنما الارتقاء بالتكريم وكرّم نبيه وعرج به، ولم يعرج بنبيٌ كما عُرج بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم.
انظر إلى التوافق بين المطالب والشبهات، وبين روح السورة وجوها، ونحن في رحاب سورة.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ من؟
د. المستغانمي: (بعضكم لبعض) تركها مبهمة: الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، الصحيح فتنة للمريض، والمريض فتنة للصحيح، هذا مريض يقول: يا أخي لماذا لم يعطني؟ فتنة، عليك أن تصبر ويرزقك وراء الصبر الكثير، جعلك غنياً فاشكر وتصدق واصبر، جعلك فقيراً اصبر فإن الله سيرزقك. المفسرون قالوا: الناس للناس فتنة، محمدٌ صلى الله عليه وسلم حالة محمد الفقير المسكين النبي فتنة لهم ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ يعني تريدنا أن نؤمن أنزل هذا القرآن على رجل من أغنى أغنياء مكة أو الطائف ذو شأن عظيم، فجعل الله النبي فتنة لهم؛ لأنهم استكبروا بالمال وبالذهب. حالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الفقراء: بلال وصهيب وعمار فتنة، أبو جهل وأمية بن خلف قالوا: كيف نؤمن وقد سبقنا هؤلاء الأعبُد؟! ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴾، وفي عهد نوح قالوا له: لن نؤمن لك حتى تطرد هؤلاء فقال لهم نوح ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ﴾. بل محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له نهياً موجهاً لمحمد ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أنت تحاسبهم؟ ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ * ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾، هذا التفسير، يعني: هذا الأقرب إلى الشرك وإلى التوحيد، لكن أيضاً الفقير فتنة للغني، فنحن بحاجة أن نأخذ دروساً الله يقول: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾؟ لنرى أتصبروا؟ هذه واحدة، (أتصبرون) أصلها: (اصبروا) لما قال القرآن ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ انتهوا. أحياناً الاستفهام يخرج للحثّ، هنا (أتصبرون)؟ معناها: اصبروا بارك الله فيكم، وسيأتيكم خير كبير.
وبعض العلماء قال: لنرى أتصبرون أم لا تصبرون؟ هنا للإقرار. لكن الأولى الحثّ، وأنا أميل إلى هذا الرأي، لماذا؟ فهل أنتم منتهون؟ انتهوا إن كنتم عقلاء.
المقدم: لكن ختام الآية أو تذييلها ربما يدل على المعنى الأول ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ بمن يصبر أو لا يصبر.
د. المستغانمي: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ هو يقول: أتصبرون؟ صبركم خير لكم والله بصير وسوف يجازيكم. هذا التذييل يجذب محمداً صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين معه ليتوبوا توبة نصوحاً وليصبروا، لأنه ليس من السهل أن تصبر على مكر الأعداء، وبلاء الأعداء.
المقدم: هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ البصر والإبصار والرؤية مترادفات وردت في السورة كثيراً، أو بشكل مضطرد يعني هنا يقول الله سبحانه وتعالى عن نار جهنم ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ الآية التي بعد هذه السورة أو بعد هذه الآية مباشرة ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾ ثم يقول مباشرة بعدها ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ هذا فقط الآن اطلعت إليه ما أدري إذا وردت كذلك مصطلحات أخرى.
د. المستغانمي: كلامك صحيح الفعل (رأى) له حضور مكثف، وبصيرا وخبيرا من أسماء الله الحسنى أيضاً وردت أيضاً مكررة، فالله سبحانه وتعالى بصير: ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ ونصيراً، وانظر أيضاً ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ الذي يربك ويربيك ويرزقك ويحنو عليك ويعتني بك، (ربك) فيها الكثير من التسلية من الطمأنة للرسول، لم يقل له: (وكان الله بصيراً) موجود في آيات أخرى. ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ ربك فيها تسلية لقلب محمد صلى الله عليه وسلم، تخيل الله يقول لمحمد: وكان ربك الذي معك الذي يؤيدك هذه الكاف إضافة الكاف للرب موجودة في كثير من السورة، من التعابير المكثفة ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ (وكان ربك) كثير من الأيقونات المكررة لتسلية قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة تقع بلسماً على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآية الثانية هذه لها كلام طويل.
المقدم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾.
أول سؤال: لماذا لم يقل: وقالوا لولا أنزل إلينا الملائكة؟ كما قال هنا: وقالوا كذا وقالوا كذا، لماذا وصفهم بالذين لا يرجون لقاءنا؟
د. المستغانمي: سجّل صفة من صفاتهم أكثر، دائماً هذه قاعدة مضطردة في القرآن وهو أسلوب بلاغي: أظهر بدل الإضمار لو قال: (وقالوا) المشركون، الحديث عنهم لكن قال: (وقال الذين لا يرجون) وسمهم بسمة جديدة هذا المقصود: أنهم لا يريدون لقاء الله، ولا يرجون لقاء الله، ولا يؤمنون بلقاء الله. في البداية وصفهم بالكافرين بأنهم (قال الذين كفروا) ووصفهم مرة بأنهم ظالمون، ووصفهم بأنهم المكذّبون، هنا وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله، فهم يؤمنون بالله، ويشركون معه غيره ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ لكن يشركون معه الأصنام، لكن لا يرجون لقاء الله بمعنى: لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يرجون لقاءه ولا يخافون عقابه.
المقدم: هم لا يرجون لقاءه، أو هم لا يؤمنون بذلك اللقاء؟ لأن الذي لا يرجو هذا الأمر معناه أنه يعلم أن هنالك يوم للقيامة، لكنه لا يرجو أن يبلغه، أن يصل إليه.
د. المستغانمي: لأنه كفر ولم يعد له شيئاً وفي آية أخرى بعدها ستأتي ﴿لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ لا يرجون النشور، لأن النشور سيعرّضهم للمساءلة، أي: لا يبغونه ولا يؤمنون به، فكل الآيات تتضافر ومن اللبنات اللفظية لهذه السورة: فعل الترجي: ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ وبعدها قال: ﴿لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ هو مكرر بطريقة حكيمة. سجّل عليهم بالإظهار بدل الإضمار صفة جديدة، وسمهم بالكفر وبالظلم وبالإشراك وهنا قال ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾.
المقدم: وهذا مقصود كما أنه أظهر المتقين في تلك الآية؟
د. المستغانمي: هذه تقنية رائعة (لولا أنزل علينا)، في البداية كانوا يريدون (لولا أنزل معه) مع محمد صلى الله عليه وسلم، هنا تبجحوا أكثر ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾ نحن بأعيننا ليخبرنا أن محمداً رسول الله.
المقدم: هنا لولا أنزل علينا الملائكة بالتكليف أو بالتبليغ؟
د. المستغانمي: (لولا) لما يأتي بعدها الفعل تكون تحضيضية (هلّا أنزل) كأنهم يقولون: قال الذين لا يرجون لقاءنا هلا أنزلت علينا الملائكة لتدلنا على أن محمدًا رسول لا لتكلّفنا الملائكة بأن نكون نحن أنبياء، هذا معنى آخر. حسب السياق لولا أنزلت علينا الملائكة لتخبرنا بصدقك، ترقّوا أكثر: لولا نرى الله حتى يخبرنا بصدقك أنك نبي.
المقدم: هل لما وصفهم الله بالاستكبار هل لأنهم طلبوا هذين المطلبين؟
د. المستغانمي: نعم طلبوا هذين الاثنين أولاً: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ﴾ هذه واحدة، فأجابهم: ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا﴾ هم لم يؤمنوا بمحمدٍ ببشريته، يريدون ملائكة تبلغهم عن الله أو يريدون ملائكة تشهد له، فاستكبروا في أنفسهم، ما معنى في أنفسهم؟ جعل الله نفوسهم ظرفاً للتكبر، هو يريد أن يقول البيان القرآني: لقد استكبروا استكباراً متمكناً في نفوسهم في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً والعتو: هو التجاوز في الظلم، ظلموا ظلماً عظيماً في هذا القول.
المقدم: ربما يقول قائل حينما يقولون: (لولا أنزل علينا الملائكة) بالفعل هم استكبروا، لكن حينما يقولون (نرى ربنا) موسى عليه السلام طلب رؤية الله قال ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ لكن لا شك أن هنا الأمر مختلف، نجيب عن هذا الأمر في الحلقة القادمة لأن وقت البرنامج انتهى.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة الفرقان – 4
تفريغ الأخت نوال جزاها الله خيرًا لموقع إسلاميات حصريًا
المقدم: أتذكر بشكل جلي كيف أننا أنهينا الحلقة الماضية عند قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ حينما طلبوا هذا الطلب ﴿وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾، فسألتك سؤالاً لم تجبني عليه لانتهاء الوقت، فأرجأنا الإجابة عليه لهذه الحلقة. قلت لك: لماذا لامهم الله سبحانه وتعالى في هذا المطلب الثاني وقال: ﴿اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ لاشك أن المطلب الثاني أشد من المطلب الأول حينما طلبوا رؤية الله سبحانه وتعالى، وقلت لك: بأن موسى عليه السلام قال: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ صحيح أن الله سبحان وتعالى قال: ﴿قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾ ولكن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل. فالقصد السؤال هو: أن موسى طلب رؤية الله وكان طلبه مشروعاً بينما هنا وصف بما وصف؟
د. المستغانمي: سؤالك وجيه، لكن أنا أجيبك باختصار: اختلف الغرضان من الطلب صح كلاهما موسى قال: أرني أنظر إليك وهم المشركون قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾. أما موسى عليه السلام من باب الاطمئنان غرض سؤاله (أرني) ليزداد قلبي اطمئناناً يعني كان الله اختاره ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ كما تعرف، ورباه وأوحى إليه، وجعله كليمه وكلمه، ثم قال ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ زيادة اطمئنان وكان تعليماً له صلى الله عليه وسلم وعليه السلام.
بينما المشركون قالوا ذلك تعنتاً وتجبراً وعتواً، كانوا مشركين لا يعترفون، ينسبون إلى الله ما لا يليق، ويعبدون معه الأصنام تقربهم إلى الله زلفى كما يدعون، ومن هنا قالوا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ﴾ هلا أنزل يعني: يريدون أن ينزل الله عليهم ملائكة سواءٌ على وجه التبليغ لهم يعني: الملائكة يبلغونهم الشرع، أو ينزلونهم ليثبتوا لهم صدق محمد عليه الصلاة والسلام. أو نرى الله جهرة حتى ينبئنا جل جلاله -سبحان الله- هذا مطلب عسير يعني: مطلب يدل على عتو، على تجاوز للظلم.
المقدم: الأقوام السابقة طلبت هذا المطلب كذلك.
د. المستغانمي: الإسرائيليون الذين كانوا مع موسى في ذلك الوقت أو اليهود قالوا ﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ في سورة البقرة. فقط أريد أن أبيّن لك لما علّق القرآن قال: ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا﴾ (اللام) موطئة لقسم محذوف (قد) تفيد التحقيق قبل الفعل الماضي (استكبروا) تفيد المبالغة (الألف، والسين، والتاء) هنا استجاب، أجاب استجاب لا تفيد الطلب، تفيد المبالغة في وصفهم بالكبر، (لقد استكبروا) وليس تكبروا بالغوا في الاستكبار، ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ جعل الكبر مظروفاً في أنفسهم، ووصفهم ﴿وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾. (العتو) هو تجاوز الظلم أي: الظلم الفاحش، تجاوزوا كل حد في هذا الطلب.
في سورة الإسراء ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ لما عبّر عن بني إسرائيل وقال: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ الذي استوقفني ﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ وهنا قال ﴿وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ بنو إسرائيل وصفهم بالعلو، والحقيقة أنت تقول لي: هل المشركون كانوا أعتى من بني إسرائيل؟ هم صحيح كانوا عتاة غلاظاً جفاة، لكن بنو إسرائيل أيضاً كان لهم علو واستكبار كبير ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ وهل أشدّ من فرعون وأخطر؟! الذي ادعى الإلوهية، وجعل أهلها شيعاً، ولقي حتفه، قصدي فعل العلو أيضاً ليس من صفاتهم، يعني لا يستحقون هذا العلو، لما قال القرآن ﴿علواً كبيراً﴾ من بين ما أريد أن أعطيك لما نصل إن شاء الله إلى سورة الإسراء من بين مراعاة النظير فيها ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾.
لما جاء في سورة الإسراء حديث عن الله وتنزيه له سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً جاء وصف بني إسرائيل (علواً كبيراً) بينما هنا لا، ﴿وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ والوصف من الناحية المعنوية دقيق، ومن الناحية الصوتية دقيق للسورة.
المقدم: تجعلني دائماً أفكر بمفردات السور ومناسبتها للسورة، أقول ربما كذلك لأنك قلت لي في الحلقة الماضية على ما أذكر: لماذا تدرجت مطالب المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء ارتقاءًا وارتفاعاً، بينما هنا نزولاً، فقلت: لأن الإسراء والمعراج، لأن الحديث هناك عن المعراج يناسبه العلو، فجاء وصف بني إسرائيل بالعلو أيضاً، وهنا النزول على اعتبار الفرقان ينزّل؟
د. المستغانمي: نعم.
المقدم: هل في ذلك إشارة بأنه (علوا علواً)؟
د. المستغانمي: أنا قلت لك: استنباط جميل جداً صحيح هم علوا في أنفسهم، والفعل (علا) من بينه الارتقاء، ودائماً في السورة الواحدة تلتقي مفردات من نفس الجنس، من نفس العائلة، لما قالوا له ﴿أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ﴾ والإسراء هو المشي ليلاً، لكن فيه إشارة إلى المعراج، وفيه العلو، والله تعالى علواً كبيراً جل جلاله.
أنت لماذا ذهبت إلى سورة الإسراء؟ نحن في السورة التي بين أيدينا هنا قال ﴿وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ السورة هذه كما سوف ننتهي إليها إن شاء الله عندما ننتهي، فيها مفردات الإهلاك، البوار الذي رأيناه المرة الماضية ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾، ﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ الثبور هو الهلاك.
المقدم: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾.
د. المستغانمي: وهذا لم يتكرر في السور الأخرى بهذا الأسلوب (الثبور) والهلاك، البور والبوار عندنا التدمير ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ ستأتي الآيات ﴿فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ عندنا التدمير، بعدها يتكلم عن الأقوام السابقة كما سوف نرى قال ﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا﴾ أي: دمرناهم، ما هذه المفردات من العائلة الواحدة؟! كيف لمحمد صلى الله عليه وسلم الرجل البسيط الأميّ الذي لم يقرأ ولم يكتب، يأتي بمفردات عائلة واحدة يبثها هنا وهناك، والقرآن يتنزل منجماً مفرقاً؟! لا يستطيع بشر أن ينسج على هذا المنوال، لذلك من بين – كما سوف نرى إن شاء الله – أسباب تنزل القرآن منجماً، ثم جمعه الإعجاز.
المقدم: يعني الإعجاز ليس في تنزيله فقط، وإنما حتى في مواضعه أو مواضع الآيات من السورة الواحدة؟
د. المستغانمي: نعم أنا أسألك وأسأل المشاهدين: هل هناك عالم في الدنيا دكتور كاتب مجمع علمي، يكتب اليوم جملة وغداً جملتين، وبعد غداً فقرة فقرات وبعد سنة فقرة، ثم تجمع وتصبح لوحة فنية نظماً رائعاً متناسقاً؟!! هنا القرآن أنا قلت لك: عائلة واحدة: الدمار، البوار، الثبور، التتبير، شيء عجيب!!
المقدم: مما لفت نظري ونحن في رحاب سورة: بعد البرنامج وكما يقول الإخوة المشاهدون حتى يقولون: بتنا نقرأ القرآن بطريقة مختلفة عن ما كنا عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل اجتهادك جزاك الله خيرا.
أقول وأنا أقرأ سورة الفرقان وجدت في مطلعها ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ وأنت قلت: بأن الفرقان نزل تنزيلاً صحيح، فوجدت أن فعل (أنزَلَ) و(نزَّل) مضطرد بشكل كبير جداً ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أو حتى لما نرى هنا يقول الله سبحانه وتعالى ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾.
د. المستغانمي: وهذا من الأفعال ومن الكلمات المستعملة في السورة الواحدة، وسنصل إن شاء الله لمزيد من الإيضاح، كل سورة لها ثوب، لها أنماط تعبيرية، لها مواد معجمية معينة، مثلما قلنا قبل قليل (عائلة الدمار). لها أساليب نحوية تعتمد، هنا ماذا قلنا قبل قليل ﴿وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ (عتواً) مفعول مطلق. هذا الأسلوب مضطرد وهو نمط في سورة الفرقان ﴿وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾، ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾، ﴿وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا﴾، ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾، ﴿رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾.
الآن اذهب إلى سورة النور الذي انتهينا منها قبل أسابيع لم نجد هذا النمط من المفعول المطلق، أنا أريد أن أقول: الله جل ثناؤه جل في عليائه يختار من الألفاظ ما يشاء، يختار من المواد المعجمية ما يشاء، يختار من الأساليب، ومن الوظائف النحوية من الكلمة ما يشاء، لذلك هو معجز من كل ناحية أتيته، هنا حضور مكثّف للمفعول المطلق، حتى لما يقول: ﴿وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ في النهاية (عباد الرحمن) ﴿يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ دون أن يخلّ بالمعنى، والإيقاع الصوتي جميل، والإعجاز العظيم. اذهب إلى سورة مريم ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ لماذا هنا قال ﴿وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾؟ بنيت على المفعول المطلق.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ * ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾. أول أمر: هم طلبوا رؤية الله سبحانه وتعالى ﴿أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾ الله سبحانه وتعالى يقول ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ ما المقصود هنا؟
د. المستغانمي: هذه الإجابة أو هذه الآية استئنافية كأنه يقول: واذكر يوم يرون، ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ جواب عن الجزء الأول، هم قالوا ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾ هذا جواب عن الجزء الأول، هم يطلبون الملائكة جاءت الآية وفيها تهكم بطريقة عجيبة كأن القرآن يقول لهم ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ قف عند الملائكة، هم قالوا (يا رب لولا أنزل علينا الملائكة) أجابهم الله سبحانه وتعالى ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ فيه تطميع إطماع لهم وترغيب كأنكم سوف ترونهم، لكن لا على الوجه الذي تريدون، بل على الوجه الذي يريد الله ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ هذا تيئيس! هذا أسلوب تهكمي فيه إطماع، هذا من باب ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.
﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ كأنه في البداية يقول: معقول؟! أنت وأنا مستمع ما جاءتني الكلمة الأخيرة بعد ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾، ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ أنا وأنت أجهل، معقول استجاب الله لهم؟! ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ في ذلك اليوم، معنى (لا بشرى يومئذٍ)؟ أي: لهم النذر ولهم السوء، ولهم الحزن الشديد.
المقدم: يعني كأنه كما نقول نحن: طلبت شيئاً، خذ هذا الشيء، ولكن ليس بالطريقة التي طلبت بطريقتنا نحن.
د. المستغانمي: جل جلاله هكذا الله تعالى يقول، ولله المثل الأعلى. ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ هو في الحقيقة لم يقل: (لا يبشر المجرمون) قال: (لا بشرى) (لا) نفي للجنس، جنس البشرى معنى ذلك قال العلماء: جنس الغمّ والهمّ يكون مسلطاً عليهم، العكس تماماً. ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ﴾ لم يقل: (لهم) كلما أظهر شيئاً بدل الضمير فيه معنى وهنا أضاف صفة الإجرام مثل ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ﴾. هو كأنه يقول: أو القياس اللغوي ما دام الحديث عنهم كان يقول: (يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم يومئذٍ) لكن قال: ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ﴾ اهتمام بالزمن للمجرمين فهم مجرمون بعدها يقول ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾.
(حجراً محجوراً) كلمة كان يقولها العربي الجاهلي عندما يتعوذ عندما يرى قاتل أبيه أو واحد يريد أن يقتله في الحرم أو في الأشهر الحرم يقول: (حجراً محجوراً) جعلت بيني وبينك حجراً كأنه يقول: أناشدك ألا تقتلني وأن تجعل بيني وبينك برزخاً وحجراً في هذا المكان الآمن، أعيذ نفسي منك بالله ويقول: (حجراً) منعاً (الحجر) في اللغة العربية من المنع، وسمي العقل حِجراً؛ لأنه يمنع صاحبه من الخطأ والزلل، وسمي حِجرُ إسماعيل حِجراً؛ لأنه يُمنع الطواف داخله.
المقدم: مع أنه يشك في نسبته لإسماعيل عليه السلام، لكن يسمى (الحِجر).
د. المستغانمي: الحجر: هو المنع في اللغة، فيقولون: منعاً وستراً من هذه النار يا رب! الآن وقد كفرت من قبل؟!!.
فقط أنبه المشاهد الكريم إلى أن لفظة (حِجوراً محجوراً) من خصوصيات سورة الفرقان، لم ترد في كل القرآن إلا هنا، وعلى كلٌ: كل سورة فيها ألفاظ خاصة بها، في كل سورة فيها مفردة أو مفردتان أو ثلاث حسب جو السورة وألفاظها، لم ترد إلا فيها، هذا قرآن، هذا معجز من أي جهة أتى.
المقدم: معنى ذلك ونحن في شهر القرآن وفي شهر رمضان الإنسان حينما يقرأ القرآن يجب أن يفطن على الأقل لهذه المفردة التي خصت بهذه السورة.
د. المستغانمي: ﴿حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ من خصوصيات الفرقان وحتى لا يقول قائل ولا يظنّ ظانّ ولا يهيم واهم أنها جاءت هكذا كررها جل جلاله كررها في موضع آخر: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾، بينما في سورة الرحمن: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ واضح الكلام؟ فهي من خصوصياتها يعني تتجاذب الألفاظ في السورة الواحدة. ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ * ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ لم تتكرر، وكذلك ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ أقصر سورة لم تتردد الكوثر، وكذلك ﴿إِنَّ شَانِئَكَ﴾ لم تتردد، وكذلك ﴿الْأَبْتَرُ﴾ لم تتردد، نخشى لو انتقلنا إلى سور أخرى يضيع المشاهد الكريم، أنا فقط أعطي مفاتيح، وهذا من الإعجاز المتجدد لكل سورة شخصية قلنا (ثوب لفظي) كلمات لا تتكرر أبداً، وهذه منها بإذن الله سبحانه وتعالى.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ما مناسبة هذا الحديث الآن في هذا الموقع؟
د. المستغانمي: عندما تحدث عن أعمالهم أو عن مصيرهم المشؤوم في جهنم ويقولون حجراً محجوراً، كأن سائلاً يسأل: يا أخي! المشركون صح كانوا مشركين، لكن كانت عندهم أعمال صالحة أحياناً، وكانت أعمال خيرية، وكانوا يرأفون بالفقير، على الأقل يسقون الحجيج، وعلى الأقل كانوا يكسون البيت، وكانت لديهم مكارم وأخلاق يجيرون على بعضهم البعض، ويقرون الضيف، وكانوا يكرمون اليتامى (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) معناه مكارم الأخلاق كانت موجودة، فأتى لإتمامها، كأن قائلاً يقول: جيد وأعمالهم الأخرى أين هي؟! هذه آية أتت وتقول ﴿وَقَدِمْنَا﴾ الله يتحدث جل جلاله ﴿إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ من جنس العمل استغراقية لجميع أعمالهم ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾.
(والهباء) هو الغبار الدقيق الجسيمات الغبارية الدقيقة جداً التي لا تُرى إلا عند أشعة الشمس، فتخيل ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ولم يكتف بـ (هباء) بل (منثوراً) هو أصلاً لا تُرى، فكيف إذا كانت منثوراً، فعملهم لا يجازون عنه، لماذا؟ لأنه عملٌ خالٍ عن الاعتقاد الصحيح، خالٍ عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خالٍ عن الإيمان الذي ينجي صاحبه، مهما عملت صالحاً بدون عقيدة صحيحة لا ينجيك شيء، أحد الشعراء يقول:
يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت
وليست لي أعمالٌ يوم الحشر تنيجيني
وجئتك بالتوحيد وحبّ
النبي وهذا القدر يكفيني
هو إنسان كان مسرفًا على نفسه، لكنه كان شاعراً، يقول: وجئتك بالتوحيد وحب النبي، وهذا القدر يكفيني. فنسأل الله أن نأتيه بالتوحيد الصحيح. مهما عملنا صلاتنا صيامنا، ونحن في هذا الشهر العظيم، قيامنا للتراويح، والله إذا لم يكن صادقاً لوجه الله الكريم، ولم نشفع ذلك ونقوّيه بالعقيدة الصحيحة، فالعمل لا ينفع. وهذا يوافق ما ورد في الحديث القدسي الصحيح: (لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة). ما أحوجنا أن نرغب في هذا الشهر العظيم، حقيقة ونحن في برنامج ليس للترغيب، لكن هذه الآية تقول: عملٌ بدون إيمان يذهب أدراج الرياح.
المقدم: الآن –سبحان الله- وأنت تتحدث في تفسير هذه الآية تذكرت سورة النور التي لم نغادرها إلا من أسابيع بسيطة حينما يقول الله سبحانه وتعالى ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.
د. المستغانمي: وفي سورة إبراهيم ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ﴾ والرماد يظهر واضحًا، أما ﴿هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ يعني أعمالهم تصبح كالهباء هنا تشبيه بليغ لو جئنا للتحليل البلاغي، أعمالهم هباء منثور، أو كالهباء المنثور في عدم النفع والجدوى، حذف وجه الشَبَه، وحذفت الأداة فنحن مع التشبيه البليغ العظيم.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾.
د. المستغانمي: هنا المقابل يظهر بذكر المقابل، عدل عن الحديث عن المشركين وأتى بما يقابله وهم المؤمنين، أتى بوضع المؤمنين في الجنة أصحاب الجنة، وأنتم أين تكونون؟ في جهنم والعياذ بالله!!.
المقدم: هنا حتى حينما تحدث عن أعمال المشركين قال ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا * وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ قال ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ كأن أعمالهم ليست كأعمال المشركين؟
د. المستغانمي: طبعاً، أعمال المؤمنين الصادقين الذين شفعوا الإيمان بالعمل الصالح تورثهم بتوفيق الله وفضله الجنة، ثم وصف الجنة فقال ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ أي خيرٌ مقاماً، خيرٌ مكاناً، ستقول لماذا قال ﴿مُسْتَقَرًّا﴾ ألم يصف المشركين بجهنم بمكان ضيق، مكاناً ضيقاً هنا قال خيرٌ مستقراً.
المقدم: وأصحاب الجنة يوصفون بالخير المستقر؟
د. المستغانمي: أصحاب الجنة يكونون في المكان الخيّر.
المقدم: يعني يقصد: أصحاب الجنة يومئذٍ مستقرّهم خيرَ المستقر.
د. المستغانمي: هذا هو في حذف مائة بالمائة: (خيرٌ مستقر) قد يكون مستقرهم خير المستقر، هنا (خير) أخير، ولكن العرب في التفضيل تحذف الهمزة. قال تعالى ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ لو قال جل جلاله: خيرٌ مستقراً ومقيلاً، الخيرية تكفي، لكن قال ﴿خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ المقيل هو عندما الإنسان يستروح في الظلال، وليتنعّم بدل من الآن يعاني في كبد، وفي مشقة، وفي صيام وفي تعب، وفي اجتهاد، يوم القيامة خيرٌ مستقراً وأحسن مقيلاً يجذبهم ويحبّب لهم الجنة وصفها لهم. وهذا يغيظ الكافرين الذين يكون مقامهم مكاناً ضيقاً.
المقدم: وهذا يزيد المشركين حسرة وندامة. ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ هنا يأتي الحديث عن يوم القيامة ومشهد من مشاهد يوم القيامة. مشاهد يوم القيامة كثيرة لماذا اختار هذا الوصف ﴿تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ هل في ذلك علاقة بأنهم طلبوا إنزال الملائكة؟
د. المستغانمي: هذا هو التفسير الصحيح هم طلبوا الملائكة الله قال لهم: لا يوجد ضرورة لإنزال الملائكة، سُنة الله في الخلق أن يبعث رُسلاً بشراً يأكلون الطعام، ويشربون من الماء، ويمشون في الأسواق، ويبشّرون ويعلمون. إنزال الملائكة يكون لغايات أخرى، يوم يرونهم في جهنم يرون الزبانية تسوقهم سوقاً لا بشرى لهم يومئذٍ! بعد ذلك تحدث عن أصحاب الجنة عاد الكلام يركّز ويثبّت هذا المعنى تريدون الملائكة؟ سيأتي وقتهم، وترونهم ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾ الآن السماء ليست منشقة، يعني يوم تتشقق السماء مصحوبة ملابسةً بتشقق الغمام، أو تشقق السماء بسبب من الغمام، المفسرون وقفوا وقفة هذه تحتاج –والله أعلم- أنا رأيي تحتاج إلى رأي من الفلكيين يعني في الإعجاز العلمي الفلكي، لكن أنا أقول: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ﴾ واذكر يا محمد ذلك اليوم. في الحلقة الماضية أو ما قبلها قلت ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ﴾، ﴿يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾، ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ هو بدأ وجلب لنا بعض المشاهد ليثبت الإيمان في قلوبنا.
المقدم: الذي أقصده من سؤالي: ما المقصود بتشقق السماء بالغمام؟
د. المستغانمي: قرب وقوع الواقعة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾.
المقدم: انشقاق السماء بالغمام هذا الذي أسألك من الناحية العلمية؟
د. المستغانمي: لا أذكر، أنا قلت لك: نسأل الفلكيين أكيد فيها شيء، لكن أنا ما وقفت عليه عند المفسرين اللغويين: (تشقق) مصحوبة بانشقاق الغمام، أو تنشق السماء ويظهر الغمام، ونزلت الملائكة تنزيلاً، سيحدث هذا، كيف؟ أحداث يوم القيامة مجهولة، لكن قد تظهر بعض الإشارات العلمية التي العلم الحديث يثبتها.
المقدم: ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ مفعول مطلق.
د. المستغانمي: مفعول مطلق، أيقونة نحوية مكررة بطريقة تثبت المعاني. ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ هذا هو المراد: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ﴾ لا يوجد تحاكم لفلان أو علان –والعياذ بالله- ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ تقديم (يومئذٍ) هذا يوم عظيم للعناية بالزمن، وهو يوم القيامة، الملك الحق (الحق) صفة للمُلك، (للرحمن) خبر مستحقٌ للرحمن وحده، الملك في الدنيا قد يكون هنا ثمة ملك أنا أملك سيارة، والثاني يملك دولة، لكن هناك: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ كأنه يقول: الملك الثابت الحق المستحق للرحمن، لا ملك لغيره.
المقدم: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾.
د. المستغانمي: أصل الكلام: وكان يوماً عسيراً على الكافرين. انظر إلى التقديم ماذا فعل ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ أي: على المؤمنين يسير إن شاء الله.
————فاصل————–
المقدم: الله سبحانه وتعالى هنا لا زال الحديث مسترسلاً عن يوم القيامة، لكنه في إطار الكافرين، في إطار المشركين، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ أولاً: لماذا يعض الظالم على يديه؟ ثانياً: وهل يقال في اللغة: ﴿اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ أو يقال: اتبعت الرسول أو جعلت سبيلي مع سبيل الرسول؟ لكن اتخذت مع الرسول سبيلاً، ما أعرف كيف؟
د. المستغانمي: أولاً: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ الظالم، جنس الظالم، المفسرون قديماً جزاهم الله خير ورحمهم الله قالوا: عقبة بن أبي معيط هو الظالم، وخليله هو أُبيّ بن خلف الذي كان يوسوس له. هذا نعم من الممكن أن تعنيهم الآية، فنقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ جنس الظالم على يديه، هذه الحركة عندما يعضّ اليدين كناية عن الندم عن شدة الندم، بدليل اليهود عندما كانوا يمرون على المؤمنين في المدينة ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ عضوا الأنامل أم الأيدي؟ الأنامل؟ في الدنيا كانوا يتحسرون ويندمون يكفي الأنامل في وصف غيظهم، فالقرآن وصف غيظهم، وتحسرهم بعضّ الأنامل، وهذا من لغة الجسم في القرآن الكريم، التعبير الجسدي والجسمي موجود في القرآن.
المقدم: (الأنامل) جمع: أنملة، والأُنملة: الأصبع أو طرف الأصبع.
د. المستغانمي: الأنملة الاصبع والبنان هو طرف الأصبع.
أنا أقول لك فقط: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ يمسك بأسنانه على يديه، لماذا القرآن الكريم عدل عن الأنامل إلى اليدين؟ حتى اليهود واغتاظوا وتحسروا على المؤمنين، لكن حسرتهم في الدنيا لن تبلغ حسرتهم يوم القيامة. يوم القيامة لا يكفي العض على الأنامل، بل على كلتا يديه، إذاً شدة الندم والتحسّر، كناية عن ذلك، الكناية: كلام يطلق ويراد لازم معناه.
﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي﴾ (ليت) تُفيد التمني. المفسرون والعلماء يقولون: ينادي هذا الظالم والمجرم ينادي ليته يا ليته، فـ (ليت) تفيد التمني والندامة والحسرة، كأنه يقول: يا أيتها الندامة هذا وقتك فاحضُري.
بعض المفسرين النحويين يقولون: المنادى محذوف (يا قوم ليتني اتخذت مع الرسول) كلاهما موجود، ولكن انظر إلى المعنى الأول طريف، ليت ينادي اسمها يريد أن تحضره الندامة لتسعفه لن تسعفه الندامة شيئاً!!!
﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ أصلها (يا ليتني اتبعت الرسول) لكن الاتباع أن تتبع خطط الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تتبع منهجه، أو تتبع سنته، لكن هو لشدة الندم يقول: يا ليتني تكلّفت وعرقت ونصبت واجتهدت واتخذت مسلكاً وسبيلاً كسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا ﴿اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ فيها تشبيه دعوة الرسول بالسبيل المستقيم، يعني اتخذت مع سبيل الرسول سبيلاً. الأسلوب بهذا النوع: يا ليتني تكلّفت على نفسي واجتهدت واتخذت سبيلاً مشابهاً لسبيل الرسول بمعنى شبّه الإسلام والصراط المستقيم والقرآن بالسبيل، وليتني سلكت هذا السبيل فأوصلني إلى الجنة. بينما لو قال (ليتني اتبعت الرسول) لا تفيد هذه المعاني.
إضافة على أننا قلنا (اتخذ) هذه من لوازم هذه السورة ستأتينا: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾، أو ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾، ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آَلِهَةً﴾ هنا قال: ﴿لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ثم يندم ويقول: ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ لم يقل: (ليتني لم أسمع كلام فلان) (ليتني لم أطع فلان) بل قال: (لم أتخذه خليلاً) هو اشمئز من صداقته.
﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى﴾ هنا ترقّي. (يا ويلتى) الألف منقلبة عن ياء هكذا يقول المفسرون وكذلك نحوياً أصلها: (يا ويلتي) ألف منقبلة عن ياء، لكن أنا أقصد: في البداية دعا الندم (ليت) والثانية دعا (الويل) يا ليتني يا ويلتى، وهذه من معاني الثبور والهلاك.
﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ لم يندم ولم يقل: ليتني لم أسمع كلام فلان، ليتني لم أطع، إنما تبرأ من خُلّته، ومن صداقته، والخُلة هي شدة الصداقة، إذاً اشمئز من صداقته. وفي آية في سورة الزخرف ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾. فانظر إلى التناسق في التعبير على ألسنة المشركين –والعياذ بالله- ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ لا يكتفي (يا ويلتى) جملة اعتراضية؛ لأن الثانية بدل الأولى.
المقدم: في البداية كان النداء لـ(ليت) وهنا النداء (للويل والثبور والهلاك)؟
د. المستغانمي: نعم، (يا ويلتى) هذه جملة اعتراضية هو أصل الكلام: ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً، الذي يتخذ مع الرسول سبيلاً يشتمل أن تكون صداقته طيبة، فالثانية بدل اشتمال من الأولى، لأن الثانية ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ اتباعي لسنة رسول الله كان الأولى كان من الجدير باتباعي لسنة الرسول أن تمنعي من خلة فلان – فلان تطلق في العربية على أي إنسان يكنّى ولا يُذكر – إذا أخذنا الآية على محمل عقبة بن أبي معيط الخليل كان أُبي بن خلف هكذا يقول المفسرون، وليس معنى هذا أن هذان المشركان وحدهما اللذان سيعاقبان، فأنا أقول لك جازماً: الآية عامة، والظالم عام، فكل واحد في الدنيا من المشركين من الظالمين من المجرمين إلا وتجد خليلاً يوسوس له، عندما يهتدي أو يقارب الاهتداء يقول: يا أخي! ماذا تريد بهذه الصلاة؟ وماذا وماذا؟! يوسوس له ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ تنطبق على كل موسوس بالشرور والعياذ بالله!!
المقدم: ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾.
د. المستغانمي: هو موقن أن ما جاءه هو الذكر (بعد إذ جاءني)، وصله، بلغه (وإذا) هنا زمانية. هذا التصوير والتعبير أن هذا المشرك كان مقارباً للاهتداء قوله: (لقد) اللام تفيد موطئة لقسم محذوف (قد) تفيد التحقيق دائماً. ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ﴾ هو المفترض أن يقول: لقد صرفني عن الذكر، الآن تبين لنا لماذا قال في البداية (اتخذت مع الرسول سبيلاً) هو قال ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ هذا الفلان أضلني عن ذلك السبيل، كان الأولى في منطقنا أن يقول لقد صرفني عن سبيل الله بل قال (لقد أضلني) لأن الضلال هو البُعد عن الطريق الصحيح، عندما أنت تضل عن الطريق أنا أذهب من هنا إلى أبو ظبي، لو ضللت الطريق معنى: لم أهتد، فكلمة (ضلال) تستدعي سبيل طريق، فهذه من المجاذبات والمصاحبات اللفظية.
﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ يعني: وصله سواءٌ كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يستمع، الآن القرآن موجود بين العرب في الدول العربية كلها في الإذاعات في التلفزيونات في الكتب في المكتبات مترجم معانيه ترجمت معاني القرآن باللغة الانجليزية والفرنسية بكل لغات العالم ومعظمها، الآن كل العالم يتحدث عن الإسلام، هل هناك من يجهل ما معنى القرآن؟ والله لو قرأوه، ولو بلغة ثانية قرأوا الترجمة، المعاني لا أقول القرآن، فهو لا يترجم، هذا الكلام الذي الآن نحن نقربه إلى العالمين، لا أحد يستطيع أن يترجم كلام الله، إنما يترجم المعاني ويقرّبها، والله لو قربوا لهذه المعاني لوجدوا فيها هداية عظيمة. فإذاً (إذ جاءني) كل الناس قد جاءهم، ولذلك المسلمون مقصرون عندما لا يبينون حقائق الإسلام للعالمين.
المقدم: هنا لما قال: ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ ما المقصود بخذلان الشيطان هنا؟
د. المستغانمي: (وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا) الشيطان يخذل الإنسان، خليله الذي وسوس له، أيضاً الشيطان وسوس لذلك الخليل ليوسوس له، والشيطان دائماً ديدنه أن يوسوس للناس وأن يبعدهم في الدنيا ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ﴾ الذي يزين ويوسوس الشيطان. يوم القيامة يخذل، معنى الخذل: تخذل إنسان تتخلى عنه، فلان خذل فلان بمعنى: لم ينصره، ما بالك إذا أعان على إدخاله في النار؟! لذلك لم يقل الله: وكان الشيطان للإنسان خاذلاً بل قال: (خذولاً) شدة الخذلان؛ لأنه لو لم ينصره مقبولة، لكن الشيطان دلّه على جهنم خذله وزجّ به في جهنم لذلك قال الله ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ فلا ينصره، بل يوقعه في جهنم والعياذ بالله!!.
المقدم: طبعاً هنا كل الحديث عن هذا الذي يدعو الثبور والويل والهلاك لنفسه، على لسان الظالم ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ لكن هنا حديث الله سبحانه وتعالى.
د. المستغانمي: نعم هذا حديث من الله سبحانه وتعالى، هذا تذييل الشيطان للإنسان خذولًا هذا تقرير قاعدة من قواعد الحياة.
المقدم: ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن موضوع أراه بشكل عام بشكل ملاحظ بعيد تمام البُعد عن هذا الموضوع، عن الآية السابقة ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا﴾ لا حول ولا قوة إلا بالله! ونحن في شهر القرآن وللأسف أغلبنا يرجع للقرآن في هذا الشهر، فإذا ما انقضى وانتهت أيامه، نسي القرآن، وإذا ذكره في الأسبوع أو الشهر مرة، نسأل الله العفو والعافية!!. السؤال لماذا الآن جاء هذا الموضوع في هذا الوقت بالتحديد؟
د. المستغانمي: أنا سأحدد لك: أنت تقول: بعدما تحدث عن الظالم وعضه لليدين أنت رأيت إلى هنا، لماذا لم تنظر إلى آخر جملة ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ من الذي أضلّه؟ زميله المشرك مثله، خليله، الشيطان. ما هو الذكر؟ القرآن. بعد ذلك ناسب أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الشكوى وأن يبثها لله، والله يعلم جل جلاله ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ﴾ هذا النداء (يا رب) ورد في القرآن مرتين، أما الواردة دائماً (رب آتيتني) بدون أداة نداء، وردت (يا رب) مرتين: هنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم هنا قال ﴿يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا﴾، وفي سورة الزخرف على ما أذكر: ﴿وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.
وقول محمد ﴿وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ على لسان محمد لشدة بثّ الشكوى، لهذا أتي بالياء هنا. خصوصية في حديث محمد بينما دائماً (رب) لما تأتي النداء لرب العالمين تحذف الياء ﴿رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي﴾، ﴿رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾، ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾.
المقدم: هنا طبعاً (يا رب) فيها آخر شيء ياء النسبة.
د. المستغانمي: ياء المتكلم المحذوف لكنها حذفت، ودلّت عليها الكسرة.
المقدم: وهذه سبحان الله فيها تلطّف أن الإنسان حينما يناجي الله سبحانه وتعالى يناديه بشيء كأنه شيء يملكه (يا ربي) يضيف ذاته إلى الله.
د. المستغانمي: فيها تقرّب إلى الله. انظر: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ﴾ هذه شكوى عجيبة وأنا أقرأها وقرأت سورة الفرقان –والحمد لله- عند عدد المفسرين: الرسول يثب شكواه لله ضد قومه، لم يقل: وقال الرسول يا رب إن قريشاً إن المشركين إن المخاطبين، بل قال (إن قومي) الذي كان يفترض أن ينصروني، قومي الذي أنتمي إليهم ﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا﴾ رجعنا إلى (اتخذوا) لم يقل: وقال الرسول يا رب إن قومي هجروا القرآن، هجروا ما توفّي بالمعنى بل قال ﴿ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا﴾ أشد مبالغة في وصف هجر القرآن، كيف هجروه؟ لم يقرأوه، وإذا قرأوه لم يتدبروه، وإذا تدبروا لم يطبقوه، الهجران: اتخذوه متروكاً مهجوراً، وتكلفوا هجرانه!! فهذا التعبير عجيب، لماذا هذا الحديث عن القرآن؟ لأننا في سورة الفرقان يتفق مع سورة الفرقان وأتى ﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا﴾ (هذا) هذا القرآن العظيم كان يستطيع أن يقول: يا رب إن قومي اتخذوا القرآن، (هذا) للتقريب، هذا الذي نقرأه هذا الذي يجدر ألا يهجره هاجر، هذا الذي يجدر أن يتقرب به العباد حبل الله المتين الذي وهبه الله للبشر ليستمسكوا به، هذا أسلوب عظيم! (هذا القرآن مهجوراً) على وزن (مفعولاً) وهذا (مهجوراً، مخذولاً، مسؤولاً) هذه أيضاً أيقونة سأتحدث لك عنها إن شاء الله.
المقدم: ﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا﴾ مثل ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ يعني القصد ما قالوا (باروا) وإنما كانوا قوماً بوراً، وهنا لم يقل: القرآن هجروه وإنما قال: اتخذوه مهجوراً.
د. المستغانمي: لبيان ووصف التمكن من الهجران، فهو وصفهم أشد وصف.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ هنا الخطاب لمن؟
د. المستغانمي: للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدنا الآن إلى التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عاد السياق:﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ لا تحزن يا محمد لا تذهب نفسك عليهم حسرات، سنّة الله في خلقه أن يجعل لكل نبي عدواً من المجرمين ومن الشياطين من الإنس والجن.
المقدم: لماذا ﴿عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ ولم يقل (أعداء) مجرمين هنا (جمع)؟
د. المستغانمي: أولاً (عدو) كلمة تطلق على المفرد وعلى الجمع، فتقول: هذا عدواً، وهؤلاء عدوٌ، هذه واحدة.
ثانياً: عندما قال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ جعل الأعداء من زمرة المجرمين لو قال: أعداءً مجرمين وصفهم، الوصف لا يأتي مثل عندما جعلهم من ضمن زمرة المجرمين.
ثانياً: أعداء الأنبياء هم طائفة من زمرة المجرمين الكبار، فالإجرام أوسع وأعداء الأنبياء طائفة منهم (عدواً من المجرمين) بينما لو قال (أعداءً مجرمين) كان وصفهم لا تأتي صفة الإجرام ثابتةً فيهم كما جاءت في هذا الأسلوب.
المقدم: ثم يقول الله سبحانه وتعالى ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ ربما يقول قائل: ما مناسبة هذا التذييل؟
د. المستغانمي: ألم يقل له ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ لكن لا تيأس سيهدي لك كثيرين وسينصرك نصراً مؤزراً، هذه تطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترغّبه وتحنو عليه هذه الآية ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ﴾ انظر! أصلها (وكفى ربك) كفى حرف جر زائد، (رب) اسم مجرور لفظاً مرفوع محلاً، فاعل أصلها (كفى ربك هادياً) (هادياً) تمييز، نصيراً. كأنه يقول: إن كان هؤلاء المجرمون كثيرين أيضاً فإن الله سيفتح باب التوبة والقلوب وسيهدي الكثيرين، وسينصرك، يعني يشوقه ويزيد من مؤازرة قلبه صلى الله عليه وسلم.
المقدم: رجعنا إلى شبهات المشركين والكفار، والآن يقول ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ الحديث عن القرآن لأنه سبق الحديث عنه
د. المستغانمي: تحول السياق والكلام من شبهة إلى شبهة، تحدثوا عن شبهة الرسالة للبشر وتحدثوا عن الملائكة وهنا لما تحدث الرسول عن القرآن جيء بشبهة القرآن.
المقدم: مع أنه في الواقع في التأريخ ربما يكون الحديث ليس هنا
د. المستغانمي: لله في كتابه أسرار.
المقدم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ لماذا يريدون القرآن جملةً واحدة؟
د. المستغانمي: هم يظنون أن الكتب السابقة أنزلت جملة وفي الحقيقة هذا فيه خلاف، بعض العلماء لكن الراجح أنها أنزلت متفرقة، حتى إن الألواح التي أنزلها الله على موسى كانت تضم عشر كلمات أو عشر وصايا، فكل الأنبياء – على رأي بعض العلماء – أنزلت كتبهم متفرقة منجمة، إلا أن التحدي وقع بنصوص القرآن لا بنصوص التوراة والإنجيل والزبور، بمعنى: هم يريدون كتاباً واحداً معجزاً، يعني مرة واحدة، القرآن أجاب محمد صلى الله عليه وسلم ﴿َكذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ أعطاه الحكمة في التنجيم، يعني: كذلك الإنزال المنجم لماذا؟ لنثبت به فؤادك يا محمد ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾.
كذلك الإنزال المنجّم لنثبت قلبك وفؤادك.
المقدم: ما مناسبة الترتيل هنا في قوله ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾؟
د. المستغانمي: هنا كلمة (ترتيل) في اللغة العربية أولاً: نعود إلى أصل اللغة نقول (ثغرٌ مرتلٌ) بمعنى منسّق مفرّق مفلّج يعني: بينه مسافات وهذه المسافات تعطي جمالاً للثغر المرتل، ومنه ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا﴾ أي: اقرأه متناسقاً جميلاً على مهلك، ﴿وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ هنا تشير إلى هذا المعنى ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ أي وفرّقناه تفريقاً؛ لأنهم قالوا: لولا أنزل جملة، كذلك لنثبت، ورتلناه ترتيلاً أي جعلناه مفرقاً، هذا معنى.
المعنى الثاني: أمرنا بترتيله ترتيلاً جميلاً متناسقاً عذباً نعطي لكل حرف حقّه من المخرج والصفة، الترتيل هو إعطاء الحروف حقوقها من المخارج والصفات. إذاً: (رتلناه): أي: جعلناه متناسقاً منضوداً محكماً مفرقاً في التلاوة لنثبت به فؤادك، كيف كان يتنزل القرآن؟ تقع حادثة فيتنزل، ونحن في سورة النور تقع حادثة فتأتي آية بلسماً شافياً، بينما لو أنزل القرآن جملةً مثلما نحن الآن لدينا كل هذا الكتاب العظيم ونبحث عن الحلول فيه، بينما هم كان يتنزّل جرعات منجّمة لتداوي مشاكل الناس، ولتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
آخر شيء: الإنزال المنجم إعجاز، يعني لا يستطيع البشر أن يكتبوا اليوم جملة وغداً فقرة وغداً فقرتين، وبعد عشرين سنة ثم يجمعها وتتناسب وتتناسق وتصبح وحدة متكاملة غير معقول هذا الكلام! لكن الله سبحانه وتعالى قادر، ففيه دليل الإعجاز.
المقدم: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ سوف إن شاء الله نتحدث عن هذه الآية في الحلقة القادمة إذا مد الله في أعمارنا.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة الفرقان – 5
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
المقدم: وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾) تحدثنا عن الآية وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يقول بأن الكافرين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هلّا نزِّل عليك يا محمد القرآن مرة واحدة؟! هم يعاجزونه، هم لم يطيقوا آية واحدة فكيف بالقرآن كله؟! قال الله سبحانه وتعالى (كذلك) أي أُنزل كذلك مفرقًا منجمًا مرتّلا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أي نجمناه أو وزّعناه فرّقناه، يقال هذا ثغر مرتّل أو الأسنان مرتلة فيه أي مفرّقة، مفرّق منضّد. إلى أن قال الله تعالى (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾) ما المثل؟
د. المستغانمي: (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾) ولا يأتونك بشبهة من الشبهات، كلمة مثل في العربية هي المشابِه ولكن هنا المقصود منها في هذا السياق أنه لا يأتونك بشيءء يريدون أن يعاجزوك به ولا يضربوا لك مثلًا بمعنى يقترحون مقترحًا، يتعللون بشبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. المثل بمعنى المشابِه، المثل في اللغة العربية عندما يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون كما قلنا في سورة النور (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾) هذا مثل والمثل في اللغة العربية عندما يضرب في موضع محدد ترسم به صورة معينة لمعنى معين يشبه به صورة أخرى، هذا المثل اللغوي البلاغي. لكن هنا لا يأتونك بمثل ولا يضربون لك مثلا هم قالوا عن محمد ساحر وشاعر ومجنون هم يضربون له مثلا أي يبحثون عن صفة يلصقونها به. المراد في هذا السياق لا يأتونك بشبهة ولا يقترحون مقترحا باطلًا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا. لا يأتونك بمثل يقابلها إلا جئناك بالحق، جئناك بالحق معناه أن الذي أتوه به باطل، ولا يضربون مثلا باطلًا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
أتى وجاء هذا ترادف، لما قال ولا يأتونك أنت يا محمد بمثل ويأتون بتعلّة ويضربون شبهة إلا جئناك، هنا عدل عن أتى إلى جاء لأن جاء يفيد معنى أتى بقوة، أتى جاء بسهولة الأتيّ هو النهر السهل والأتيّ فيه سهولة، أما المجيء في القرآن جاء فيه قوة وتأكيد وثقة (أن جاءه الأعمى) فيه جهد جاءه مجيئا يريد النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى حروف الكلمة فيها قوة اجتماع الجيم جرف شديد مجهور مع الألف مع الهمزة القوية). كاف الخطاب في (ولا يأتونك) في غير القرآن لو قال: ولا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق لكن قال لا يأتونك أنت ليعجزوك ويفحموك أنت كأنهم ضربوا المثل خصيصًا للمعاجزة ولإفحامك (إلا جئناك) تأييد رباني (وأحسن تفسيرا).
باختصار هذه خلاصة الشبهات المتقدمة ضربوا له شبهات متعددة قالوا (أساطير الأولين) (ما لهذا الرسول يأكل الطعام ) ثم قالوا (لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً) أجابهم وأفحمهم وألقمهم الحجر كما قال أحد المفسرين ثم هنا أتى بالقاعدة النهائية (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ) على طريقة: وإن عدتم عدنا.
الختام (وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) يعني أي أحسن بيانًا وأوضح تفسيرًا وبيانًا وكشفًا، التفسير في اللغة هو البيان.
المقدم: ما الارتباط بين هذه الآية وما سبقها (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾)؟ من هؤلاء الذين يحشرون على وجوههم؟ ولماذا على وجوههم؟ وهل يحشر الناس على وجوههم؟
د. المستغانمي: هذا السؤال سأله أحد الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يمشي الله الناس على وجوههم؟ آية سورة الإسراء أوضح (يحشرون وصما)؟ قال الذي أمشاه على رجليه يمشيه على وجهه. علاقة هذه الآية بما سبق (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾) لها ارتباط وثيق بما سبق ولكن النظم اختلف، قبلها قال (ولا يأتونك بمثل) هؤلاء المعاجزون المشركون الذين يريدون إيقاع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الأحجار والعراقيل والعوائق أمامه قال له جلّ جلاله ولا يأتونك بشبهة وبتعلّة إلا جئناك بالحق واضحًا مفسرًا، هؤلاء في الحقيقة هم شر مكانًا وأضل سبيلًا وسوف يحشرون على وجوههم يوم القيامة. عكس البيان القرآني فقال: الذين يحشرون على وجوههم، تبين لك كقارئ تريد أن تتدبر القرآن فقلت ما علاقة هذا بهذا؟ لكن القرآن نظمه عجيب وفيه أسرار: عوض أن يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا هم شر مكانا وأضل سبيلا ويحشرون على وجوههم عَكسها وقال (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ) وبنى عليها اسم الإشارة (أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا) حتى يصفهم ويميزهم عن غيرهم، المشركون عددهم كثير، هؤلاء المتعنتون المعاجزون هم شر مكانًا وأضل سبيلًا، فحتى يسمَهم ويصفهم قال أولا بشّرهم وأنذرهم أنهم يحشرون على وجوههم وبنى عليها. لو قلنا العكس ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أولئك شر مكانا لا يستقيم الكلام بالطريقة التي استقام النظم الجليل. فأتى بالاسم الموصول الذي يعود عليهم ثم أشار إليهم. قال: الذين يحشرون على وجوههم أولئك شر مكانًا. لو في غير القرآن لكان يستقيم: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا هم شر مكانا وهم يحشرون، عكسها الله عز وجلّ ليبني شيئًا على شيء وهذا كثير في القرآن.
المقدم: هنا لغة قوية شديدة، كلنا سيُحشر يوم القيامة ولكن أن يحشر المرء على وجهه لفظ قوي وليس فقط يحشر على وجهه وإنما يحشر إلى جهنم، حدد مصيره وانتهت المسألة (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ) إضافة إلى أن الله تعالى يقرر (أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا) فيه وعيد شديد!
د. المستغانمي: والذي فعلوه والذي اتهموا به الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية السورة يستحق هذا العقوبة قالوا أساطير الأولين وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وأعانه عليها قوم آخرون ما آلوا جهدا في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء شر مكانا وأضل سبيلا. وشر مكانا هو مكان في جهنم يليق به (وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ) فأعاد هنا وقال (أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا) السبيل هو الطريق الذي يقود إلى جهنم، أسند الضلال إلى السبيل لا يوصف السبيل بأنه ضال وإنما الإنسان يضل وهذا من المجاز العقلي. قال إذا كان السبيل ضالًا وأضلّ فما بالك بالذي يمشي عليه؟ هو في ضلال بعيد، هذا على طريقة (في عيشة راضية) إذا كانت العيشة راضية فما بالك بالذي يعيشها؟ هنا السبيل وصفه الله بالضلال فما بالك بالذي يعيش عليه؟ هو في ضلال بعيد.
المقدم: بعد ذلك يأتي القصص النبوي والسورة سورة الفرقان وقلنا بأن من محاورها الرئيسة قضية الفرقان وبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم والإنذار (ليكون للعالمين نذيرا) ثم يتحدث عن موسى ثم أخاه هارون ويتحدث عن نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا أحاديث مختصرة آية آيتان، فما علاقة هذا بمحور السورة؟
د. المستغانمي: هذا في رحاب سورة الفرقان. سورة الفرقان تعالج محورًا عظيما وهو إثبات أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى والتنويه بشأن الفرقان وأنه من عند الله، التنويه بعبودية النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبدٌ بشر، الإشارة إلى أنه جاء لينذر، هو في الحقيقة جاء ليبشر وينذر لكن سورة الفرقان فيها ذكر لأحوال المشركين المكذبين المعاجزين الذين يجحدون كل الآيات الساطعات وحاولوا أن يأتوا بالشبهات ويلقوها في وجه الإسلام وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هو بشر (ما لهذا الرسول ) وقد وردت في السورة (مبشرا ونذيرا) مبشرا مرة واحدة مقابل أربع مرات (نذيرا). (نذيرا) أربع مرات وعندما ذكر التبشير ذكره (مبشرًا) لا بشيرًا وثمة فرق بين بشير ومبشّر، مبشر اسم فاعل وبشير مبالغة أكثر على وزن فعيل وصيغ المبالغة: فعيل فعول مفعال تفيد شدة مبالغة اسم الفاعل. فهنا حتى لما ذكره بالبشرى بأنه يبشّر أتى باسم الفاعل بينما في سورة فصلت (حم ﴿١﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾) لأن سورة فصلت بنيت على شيء من البشرى. أما في سورة الفرقان أتى بـ(مبشرا) لإثبات وظيفته لكن ليس على وجه المبالغة لأن المبالغة في المشركين والمكذبين يحتاج معها الإنذار أكثر.
هذه الآيات التي وردت في القصص القرآني جاءت لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له لست وحدك يا محمد على طريق الدعوة وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. انظر إلى الترتيب بدأت القصص بقصة موسى عليه السلام مع أن نوح قبل موسى، أقرب القصص إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم هي قصة موسى من أولها إلى آخرها، حياة موسى شبيهة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تعرضهما للابتلاء والفتن، موسى تعرض لفرعون ومحمد صلى الله عليه وسلم تعرض لشرك المشركين، بدأ ترتيب القصص بأقرب الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، عيسى أقرب تاريخيا لكن قصة موسى وقصة بني إسرائيل وفرعون قريبة إلى قصة محمد صلى الله عليه وسلم والمشركين ما عاناه موسى مع بني إسرائيل تكاد القصتان تتطابق. من هذا بدأه بقصة رجل نبي من أولي العزم يقول له تأسّ بموسى وقد لاقى من فرعون ما لاقى وكذبه الأقباط وكذبه فرعون وصدّق به بنو إسرائيل الذين اتبعوه.
المقدم: لماذا يبدأ قصة موسى بقضية الكتاب؟ لما تحدث عن نوح قال (وقوم نوح ) ولما تحدث عن عاد وهود لكن بدأ قصة موسى (وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾)؟
د. المستغانمي: لأن الآيات قبله تجادل في الكتاب هم يجادلون في الكتاب (لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً) فآية في قصة موسى تعرّض بجهلهم أنتم تجهلون كيف أنزل الله الكتب السابقة منجمة، مرة واحدة؟ يقال أن التوراة نزلت مرة واحدة لكن ثمة من المفسرين من يقول عندما أنزل الله الألواح كان فيها عشر وصايا لا تزيد عن سورة الليل ثم أنزل الله التوراة كأن الحديث موجه للمشركين يعرّض بهم أنتم تجهلون تاريخ الكتب وتاريخ الديانات وكما أعطينا محمدًا كتابًا عظيمًا أعطينا موسى كتابًا عظيمًا إلا أن الفرق أن الكتب السابقة لم يكن الإعجاز فيها من الناحية البلاغية والنظمية إنما كانت بما تحمل من معان ودلالات أما القرآن فمعجز نظمًا ومحتوى ولن يأتي بشر ولا جنّ بمثل هذا النسيج العجيب.
تبدأ قصة موسى (وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾) اختلف الأسلوب، لما يتكلم عن قوم لوط (وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ) انظر إلى تغيير الأسلوب، الله جلّ جلاله وهو خالق الأكوان ومنزل القرآن وفصاحة القرآن لا فصاحة فوقها! عجبت وأنا أتأمل في سورة الفرقان: مشاهد منتظمة بدقة لما تعلق الأمر بالشبهات بناها القرآن بـ (قالوا) و(وقل) (قالوا أساطير الأولين) (قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام) (قال الذين لا يرجون) (وقال الذين كفروا). الشبهات مقترحاتهم المعاجزة جاءت في ثوب (قالوا) ولقنّ الله النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم. لما جاء إلى القصص أعطاها التأكيد (ولقد آتينا موسى) (ولقد أتوا على القرية) اللام موطئة لقسم محذوف: والله لقد. ولما تكلم عن يوم القيامة عرضه بشيء آخر (يوم يعض الظالم على يديه) (يوم يحشرهم) (يوم ) هذا مشهد. أنا أرى سورة الفرقان فيها مشاهد وسورة الفرقان هي لوحة واحدة فيها عدة مشاهد وكل مشهد له ثوبه وألفاظه: عندما قال (يوم يحشرهم) (يوم تشقق السماء) (يوم يعض الظالم) كأنه يقول أنا أعطيتك هذا المشهد الرباني: يوم القيامة ويم كذا ويوم كذا. ولما جاء القصص أتى يحقق لمحمد صلى الله عليه وسلم (ولقد) ولما جاء إلى التوحيد قال (وهو الذي) (وهو الذي مرج البحرين) (وهو الذي جعل) (هو الذي أرسل الرياح) أعطاها صبغة التوحيد لا يستطيع الأصنام أن يفعلوا هذا ولما ذكر عباد الرحمن أعطاها لوحة أخرى، جاء بصيغة (الذين يمشون) (الذين يبيتون) (الذين يقولون ربنا اصرف عنا) لا يستطيع خلق ولا بشر ولا مجمع علمي من عظماء العلماء أن ينسجوا مثل هذا البيان القرآني، في سورة واحدة أعطاك مشاهد كأنك أمام لوحة في البحر – ولله المثل الأعلى – وأنت تنظر الأمواج وتنظر السماء! هذه سورة عجيبة والقرآن كله عجب.
المقدم: (وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾) حين يتحدث الله سبحانه تعالى عن قصة موسى أحيانا يذكر هارون وأحيانًا لا يكذره وهنا ذكره على الرغم أن القصة قصيرة في هذه السورة جاءت في آيتين فقط (وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا) وصفه بالوزير فما دلالة ذكر هارون هنا؟
د. المستغانمي: القصص الذي ورد في سورة الفرقان يخدم موضوع سورة الفرقان وبما أن المشركين تعنتوا وتصلبوا وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكأن القرآن يقول يا محمد لست وحدك في الدعوة رسل من قبلك كُذبوا وأنت واحد من كوكبة من هؤلاء العظماء الذين يدعون إلى الله، ولأنهم تعنتوا في بداية السورة وقالوا (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) لولا أنزل إليه ملك أو معه ملك، وأكدوا إما أن يكون ملكًا أو يكون رجلًا معه ملك، هنا قال الله تعالى بطريقة ضمنية مبطنة: لو كان الأمر يقتضي أن أؤيدك بأحد لأيدتك برجل كما أيدت موسى بأخيه هارون، هذه حكمة من الحكم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون معه أحد. هم طلبوا ملكًا لم يقتنعوا بالبشرية والله تعالى يقول لو كان الأمر يقتضي أن يكون معك رديفًا لكان بشرًا كما جعل الله لموسى أخاه هارون ولذلك قال (وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ) عرّض بجهلهم ثم قال (وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا) لو كنت باعثًا رجلًا مؤيدًا به محمدا صلى الله عليه وسلم لكان رجلًا. الوزير هو الذي يحمل من أوزار الملك هو الذي يساعد الملك ويؤيده ويظاهره، يكون نائبًا عنه ويساعده ويؤازره.
المقدم: (فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾) الله سبحانه وتعالى كأنه حينما يقرأ القارئ قرر مصيرهم قر موقفهم من دعوة موسى وأخاه هارون، لم يصلوا بعد فكيف قال (الذين كذبوا)؟
د. المستغانمي: لو قال في غير القرآن اذهبا إلى فرعون وقومه مثلا كما وردت في آيات أخرى لكن هنا في الحقيقة وصفهم (اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا) حيّز الصلة كما يقول البلاغيون (إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا) وصفهم بالتكذيب، القرآن موجه لقارئ القرآن بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فكأن القرآن يُعلمنا ويشعرنا وينبئنا بأنهما ذهبا وكلّما فرعون وقومه وملأه ويعطينا الخلاصة لأن القرآن موجه إلى قارئ القرآن (اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا) نفهم أن موسى وأخاه ذهبا وبلّغا الدعوة وكانت النتيجة أن كذبوا وبالتالي استحقوا (فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا) ليبني على التكذيب دمرهم تدميرا أتى بالصفة التي اقتضت التدمير والإهلاك. أعجبني د. عبد الكريم الخطيب عالم أزهري عنده التفسير القرآني للقرآن في 16 مجلد يقول: لا يهمنا الأقوام في ذاتهم، تهمنا الصفة، لو قال له اذهبا إلى فرعون وقومه فدمرناهم تدميرًا، أنت تسأل لماذا دمرهم تدميرا؟ لكن لما قال (اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا) صفة التكذيب هي التي تهمنا في سورة الفرقان فاستحقوا التدمير. و(فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا) صيغة المفعول المطلق أيقونة نحوية مكررة من أيقونات السورة.
المقدم: هنا يبدأ بداية أخرى (وَقَوْمَ نُوحٍ) وقلنا قومَ منصوبة
د. المستغانمي: (قومَ) منصوبة لوجهين: يقولون فدمرناهم تدميرا ودمرنا قوم نوح لأن قوم نوح معطوفين على ما سبق، (اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ) (هم) ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، (وقومَ) نوح أي ودمرنا قوم نوح. ثمة وجهان نحويان ذكرهما السمين الحلبي وذكرهما صاحب البحر المحيط:
وجه هو معطوف على (ودمرناهم) ودمرنا قوم نوح: لما كذبوا، أغرقناهم. هذه جملة أخرى وهكذا يستقيم الكلام
الرأي النحوي الثاني: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، يفسرونها منصوبة بفعل محذوف هو أغرقنا الذي دلّ عليه: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم، الفعل الثاني دلّ على الأول. منصوبة بفعل جاء تقديره بعد ذلك أو دلّ عليه الفعل الموالي. والرأيان ذكرهما أصحاب النحو.
المقدم: (وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾)
د. المستغانمي: (وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا) ما قال وقوم نوح لما تكبروا، لما أجرموا، ذكر التكذيب فقط لأن مشركي قريش كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيبا كبيرا فلما ذكر القصص ذكر كذبوا قوم فرعون كذبوا، قوم نوح لما كذبوا، إذن هذه هي الصفات التي استدعت هذا النوع من التدمير.
المقدم: (وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ) قوم نوح أرسل الله إليهم نوح فلماذا قال كذبوا الرسل؟ هل هو رسول أم رسل؟
د. المستغانمي: (كَذَّبُوا الرُّسُلَ) من كذب برسول فقد كذب جميع الرسل من هذا الباب. قوم نوح في سورة المؤمنين قالوا (ما هذا إلا بشر مثلكم ) أنكروا على نوح بشريته فلما كذبوا نوحًا لكونه بشرًا والرسل كلهم بشر يستلزم أنهم كذبوا كل الرسل، هذا أمر وثانيًا من كذب رسولًا من أولي العزم فقد كذب جميع الرسل الرسل وقوم نوح من أوائل الأقوام فلما كذبوا رسولهم نوحا فكأنهم سنّوا للأقوام سنة في تكذيب الرسل ومن سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها.
المقدم: (وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَةً) لمن جعلهم آية؟
د. المستغانمي: لجميع الأقوام الذين جاؤوا من بعدهم وكذبوا رسلهم كان قوم نوح لهم آية وعبرة ونكالًأ ودليلًا كل من كذب رسل اللله يحيق به العذاب. جمع بين قوم نوح وفرعون لأن مصيرهم سواء، فرعون أغرقه الله وجنوده وقوم نوح أغرقهم الله تشابه الجزاءات فعطف قوم نوح على فرعون لأن هنا الترتيب التاريخي غير مقصود.
المقدم: في كثير من الآيات حين يذكر قوم نوح يقول (من قبل) أو (من بعد) وهنا لم يذكره ولم يذكر التسلسل التاريخي على اعتبار أن نوح قبل موسى
د. المستغانمي: لأن العبرة فيمَ سيقت له القصة. القصص في سورة الفرقان سيق لتثبيت تكذيب الأقوام للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وتثبيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم فبدأ بقصة موسى لأنها الأقرب إليه ولأن اليهود الذين كانوا في المدينة وكانوا يستمعون لأخبار الإسلام كانوا أقرب إلى دين موسى عليه السلام وكانوا يعلمون التوراة والكتاب فبدأ بالأقرب. ربطت بين الجزاءين لفرعون وقوم نوح وهو الإغراق (وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَةً). ثم قال (وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا) أظهر بدل الإضمار (أغرقناهم) هم، (وجعلناهم) هم، المقتضى أن يقال وأعتدنا لهم لكن قال (وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا) أظهر بدل الإضمار لبيان ظلمهم الذي استوجب ذلك التدمير والعذاب الأليم، الإظهار دائمًا يعطينا نُكتة جيدة من باب (وُعد المتقون). لما قال (وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا) تنطبق على قوم نوح وتنطبق على كل ظالم فكأنه تذييل يمكن الاستشهاد به في الخطب أو الكتابة (وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا) كل الظالمين بما فيهم قوم نوح أصبحت مثلا يُستشهد به. كذلك قول الله تعالى (لا بشرى يومئذ للمجرمين) تضرب مثلًا لا بشرى للمجرمين.
المقدم: (وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ) كلها منصوبة، عاد وثمود معروفين، من هم أصحاب الرس؟
د. المستغانمي: أصحاب الرسّ مختلف فيهم لدى المفسرين. الرسّ هي البئر باتفاق أصحاب اللغة. أصحاب الرس قالوا عنهم قوم كانوا في اليمن جاءهم نبي حنظلة بن صفوان ولما قتل العنقاء التي كانت تؤذيهم وتفترس أولادهم بعد ذلك لم يصدقوه وكذبوه. قوم قالوا هم أصحاب الأخدود قوم من المفسرين قالوا أنهم أصحاب أنطاكية الذين كانت لهم رسّ وبعث الله لهم حبيب النجار وقال يا قوم وذكروا في سورة يس حتى قتلوه ولما قتلوه قال (يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي) فهم مختلف فيهم ما جاء في وصفهم أنهم من أواخر الأمم، هكذا يقول المفسرون في جميع التفاسير ولا نستطيع أن نجزم بأي رأي منها لأنها تحتاج إلى بحث تاريخي. (وعادا) قوم سيدنا هود وثمود قوم صالح عليه السلام وأصحاب الرسّ مختلف فيهم.
ننظر إلى الأسلوب (وعادًا) ما قال قوم لأن اسم القوم عاد ونبيهم هود (وثمودَ) وفي قرآءة وثمودًا لأن ثمود اسم علم إذا كان ينطبق عى القبيلة يكون ممنوعًأ من الصرف وإذا كان ينطبق على الأب الكبير ثمود بن عاد بن إرم يكون منصرفًا كما يقول السمين الحلبي وأبو حيان الغرناطي. في آية من سورة هود وردت مرتين منصرفة وغير منصرفة على اختلاف القراء. جاءت منصوبة إما بـ(دمرنا) السابقة: ودمرنا عادًا ودمرنا ثمودًا بعضهم يقول (وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾) تبّرنا يعني دمّرنا أي دمرنا عادا وثمودا وأصحاب الرس بفعل محذوف يفسره ما يأتي والوجهان جائزان في اللغة العربية.
(وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا) تدل على أن البداية بقوم نوح والنهاية بأصحاب الرس ووردت كذلك في سورة ق، والقرون بين ذلك تروى رواية في التفسير أن أحدهم كان يدّعي أنه يعلم كل شيء فجاء إلى علي بن أبي طالب فقال له: ما قولك (وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا)؟ قال أنا أعلم ذلك الكثير، فضحك علي بين أبي طالب قال: كيف تعلم ذلك الكثير إذا كان الله أبهمها؟!
المقدم: (وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾) الأمثال هنا هل هو ذات المثل الذي ورد في أول السورة؟
د. المستغانمي: (وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ) بمعنى أوضحنا قصصهم بيّنا شؤونهم ضربنا لهم الأمثال وبيّنا لهم العبر منهم من اهتدى واقتدى وعاد إلى الإسلام ومنهم من غوى ولم يرشد. (كلاً) يسمى تنوين العوض عن قول محذوف، كل قوم من الأقوام السابقين ضربنا له الأمثال، (كلًا) يسمى تنوين العوض منصوبة بفعل محذوف يبينه ما يأتي (وضربنا لهم) خاطبنا كلًا ضربنا له الأمثال، حذّرنا كُلًّا ضربنا له الأمثال. (وكلا تبرنا تتبيرا) تبرنا أي أهلكنا لكن أيّ إهلاك؟ فتتناهم، التبر هو الذهب الفتات الخالص الذي يكون كالتراب
والتَّبْرَ كالتُّرْبَ مُلْقَى في أَمَاكِنِه والعودُ في أرضه نوعً من الحطب
سمي الذهب تبرًا لأنه كالتراب مفتت وهنا جاء من نفس المادة (وتبرناهم تتبيرا) أي فتتناهم.
في السورة وردت ألفاظ الهلاك (دمرنا تدميرا) (دعوا هنالك ثبورا) (تتبيرا) وعندما نصل إلى صفات عباد الرحمن (إن عذابها كان غراما) من أشد معاني الغرام الهلاك.
المقدم: ذكرتم سابقا أن كل سورة في القرآن مفردات خاصة بها فهل تتبيرا وردت في غير سورة الفرقان؟
د. المستغانمي: وردت في سورة الفرقان ووردت في سورة الإسراء أيضًا (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾) وأتت أيضًا بالمفعول المطلق، ليتبروا المؤمنون المسلمون يتبرون ما علا اليهود تتبيرا، هذا وعد من الله: المسلمون يتبرون ما علا اليهود تتبيرا. (فإذا جاء وعد الآخرة) وعد الآخرة آتٍ بنصّ القرآن الكريم.
المقدم: لا زال الحديث في القصص القرآني ولكن اختلف الأسلوب (وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾) لماذا اختلف الأسلوب؟ ما هذه القرية التي أمطرت مطر السوء؟ لمن الخطاب هنا (أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا)؟
د. المستغانمي: القصص كان (وقوم نوح) (وعادًا) ثم توقف (ولقد أتوا على القرية). من سمات القصص هنا أن بدأها (ولقد) (ولقد) أعطانا مشهدًا. (ولقد) والله لقد لام موطئة للقسم. ساق لهم القصص السابق قوم نوح وموسى مع فرعون وعاد وثمود وأصحاب الرس، ساق لهم هذه القصص حتى يعتبروا (كلا نقص عليك من أنباء الرسل) يعتبر الكفار، المفترض أن الكفار يرون في الأقوام السابقة الذين كذبوا رسلهم وحاق بهم الدمار عليهم أن يعتبروا، المشركون من قريش كان الأولى بهم لما دمر الله قوم نوح وقوم فرعون وعادا وثمود كان الأولى أنهم يخشون من هذا المصير لكنهم ما فعلوا ذلك وإنما ازدادوا عنتًا وتكذيبًا لم يتعظوا برسالة القصص. هنا قال الله تعالى لهم (وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ) قرية قوم لوط وهي قرية سدوم كبرى قرى قوم لوط جعل الله عاليها سافلها وخسف بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من سجيل. هذه القرى الخمس المؤتفكات كانت على طريق فلطسين وكان القرشيون يمرون عليها في تجارتهم، كانوا يأتون من مكة والمدينة يمرون على بلاد فلسطين يدخلون الشام، كانوا بالفعل يمرون عليها (ولقد أتوا على) لما تكلم عن القرية قال (ولقد أتوا على) أنت تقول أتيت السارقة الفعل أتى لا يتعدى بحرف الجر (على) لكن هنا ضمّنها معنى (مرّ) (أتوا على) أتوا ومرّوا على، لكن انظر إلى ديدن القرآن في التعبير، لما تحدث عن القرية قال (أتوا على) ولما تكلم عن القوم قال (وإنكم لتمرون عليهم مصبحين) فالمرور يكون على الأقوام والإتيان يكون للقرى. في اللغة العربية نقول: أتيت الشارقة ومررت بأهل الشارقة. (إنكم لتمرون عليهم) فكان المفترض أن يتعظوا بالأقوام السابقين الذين كذبوا لكنهم لم يتظعوا (ولقد أتوا على القرية). وأبهم اسم القرية هنا وذكرها بالصلة ولأنها قرية قوم لوط التي خسف بها وعذّبت كانت مشهورة لدى العرب ولدى أهل الكتاب يعرفون القرية التي أمطرت مطر السوء ويمرون عليها، هي في الأذهان، خطاب لما في الأذهان القرية التي أمطرت مطر السوء. ثم قال (أفلم يكونوا يرونها) هنا حذف: أعموا عنها أفلم يكونوا يرونها؟ هنا الفاء الفصيحة التي تعطف على كلام محذوف (أفلم يكونوا يرونها) تقدير الكلام: أعموا عنها فلم يكونوا يروها؟! كان الأولى أن يأخذوا العبرة لكنهم لم يتعظوا.
(بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا) هم أنفسهم و(بل) هنا انتقالية، (بل) تفيد الإضراب ولكن ليس إبطالي وإنما انتقالي: أعموا فلم يكونوا يرونها وانتقل من موضوع عماهم وعدم الإدراك إلى أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. أفلم يكونوا يرونها؟ لكنهم لم يتعظوا بعقولهم وإيمانهم وكانوا لا يرجون النشور أن يبعثهم الله وينشرهم النشور هو الحشر أي البعث لكن لم يقل البعث لأن السورة فيها النشور ولأن الآلهة التي كان يتخذها المشركون (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾) هنا ادماج كان الأولى بهم أن يؤمنوا بيوم النشور وأن يؤمنوا بالله الذي يبعث أما آلهتهم فلا تغني ولا تسمن ولا تملك نشورا.
المقدم: بعد نهاية القصص القرآني عدنا إلى المحور السابق (وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾)
د. المستغانمي: ساق القصص له ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما أعطاه من أمثال الأقوام السابقين مع رسلهم عاد إليه وإليهم (وَإِذَا رَأَوْكَ) لا تحزن يا محمد. (إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا) لا يتخذونك إلا هزوا هذا أسلوب حصر وقصر نفي مع استثناء، معناها الحقيقي: لا يتخذونك إلا هزوا كأنه لا عمل لهم ولا شغل لهم إلا الاستهزاء، حصر كل أعمالهم وقصرها على الاستهزاء فلا تبالي يا محمد ولا تحزن (إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا).