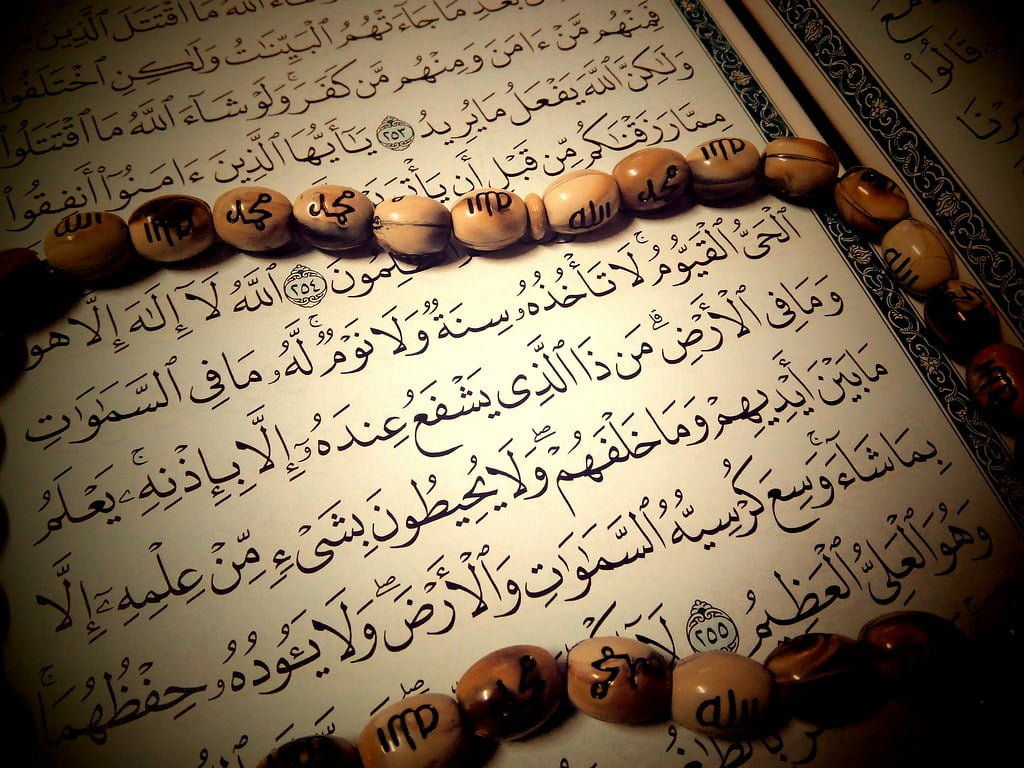سورة الكهف هي من السور المكية, وهي إحدى خمس سور بدأت بـ (الحمد لله)؛ (الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر), وهذه السورة ذكرت أربع قصص قرآنية هي: أهل الكهف، صاحب الجنتين، موسى r والخضر, وذا القرنين.
ولهذه السورة فضل كما قال النبي r : ” من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء”, وقال: ” من أدرك منكم الدجال فقرأ عليه فواتح سورة الكهف كانت له عصمة من الدجّال”, والأحاديث في فضلها كثيرة.
وقصص سورة الكهف الأربعة يربطها محور واحد وهو أنها تجمع الفتن الأربعة في الحياة: فتنة الدين (قصة أهل الكهف)، فتنة المال (صاحب الجنتين)، فتنة العلم (موسى r والخضر)وفتنة السلطة (ذا القرنين). وهذه الفتن شديدة على الناس, والمحرك الرئيسي لها هو الشيطان الذي يزيّن هذه الفتن؛ ولذا جاءت الآية (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا)[آية 50], وفي وسط السورة أيضاً. ولهذا قال الرسول rأنه من قرأها عصمه الله تعالى من فتنة المسيح الدجّال لأنه سيأتي بهذه الفتن الأربعة ليفتن الناس بها. وقد جاء في الحديث الشريف: “من خلق آدم حتى قيام الساعة ما فتنة أشدّ من فتنة المسيح الدجال”, وكان r يستعيذ في صلاته من أربع, منها فتنة المسيح الدجال.
ويعقب الحديث عن كل فتنة من تلك الفتن طريقُ العصمة منها:
1. فتنة الدين: قصة الفتية الذين هربوا بدينهم من الملك الظالم فآووا إلى الكهف, حيث حدثت لهم معجزة إبقائهم فيه ثلاثمئة سنة وازدادوا تسعا, وكانت القرية قد أصبحت كلها على التوحيد. ثم تأتي آيات تشير إلى كيفية العصمة من هذه الفتنة (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا * وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا) آية 28 – 29. فالعصمة من فتنة الدين تكون بالصحبة الصالحة وتذكر الآخرة.
2. فتنة المال:قصة صاحب الجنتين الذي آتاه الله كل شيء فكفر بأنعم الله وأنكر البعث, فأهلك الله تعالى الجنتين. ثم تأتي العصمة من هذه الفتنة (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا * الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا) آية 45 و46. والعصمة من فتنة المال تكون في فهم حقيقة الدنيا وتذكر الآخرة.
3. فتنة العلم: قصة موسى r مع الخضر, وكان موسى r ظنّ أنه أعلم أهل الأرض فأوحى الله تعالىله بأن هناك من هو أعلم منه, فذهب للقائه والتعلم منه, فلم يصبر على ما فعله الخضر لأنه لم يفهم الحكمة في أفعاله وإنما أخذ بظاهرها فقط. وتأتي آية العصمة من هذه الفتنة (قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا) آية 69. والعصمة من فتنة العلم هي التواضع وعدم الغرور بالعلم.
4. فتنة السلطة: قصة ذي القرنين الذي كان ملكاً عادلاً يمتلك العلم وينتقل من مشرق الأرض إلى مغربها يعين الناس ويدعو إلى الله وينشر الخير, حتى وصل لقوم خائفين من هجوم يأجوج ومأجوج, فأعانهم على بناء سد لمنعهم عنهم, وما زال السدّ قائماً إلى يومنا هذا. وتأتي آية العصمة (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)[آية 103 و104]. فالعصمة من فتنة السلطة هي الإخلاص لله في الأعمال وتذكر الآخرة.
5. ختام السورة: العصمة من الفتن:آخر آية من سورة الكهف تركّز على العصمة الكاملة من الفتن بتذكر اليوم الآخرة (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) [آية 110] فعلينا أن نعمل عملاً صالحاً صحيحاً ومخلصاً لله حتى يقبل، والنجاة من الفتن في انتظار لقاء الله تعالى.
ومما يلاحظ في سورة الكهف ما يلي:
1. الحركة في السورة كثيرة (فانطلقا، فآووا، قاموا فقالوا، فابعثوا، ابنوا، بلغا، جاوزا، فوجدا، آتنا)، وكأن المعنى أن المطلوب من الناس الحركة في الأرض, لأنها تعصم من الفتن, ولهذا قال ذو القرنين: (فأعينوني بقوة) أي دعاهم للتحرك ومساعدته, ولهذا فضل قراءتها في يوم الجمعة الذي هو يوم إجازة للمسلمين حتى تعصمنا من فتن الدنيا.
2.وهيالسورة التي ابتدأت بالقرآن وختمت بالقرآن: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا) [آية 1] و (قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا)[آية 109]. وكأن حكمة الله تعالى في هذا القرآن لا تنتهي وكأن العصمة من الفتن تكون بهذا القرآن والتمسك به.
3.الدعوة إلى الله موجودة بكل مستوياتها:فتية يدعون الملك وصاحب يدعو صاحبه ومعلّم يدعو تلميذه وحاكم يدعو رعيته.
4. ذكر الغيبيات كثيرة في السورة: في كل القصص: عدد الفتية غيب, وكم لبثوا غيب, وكيف بقوا في الكهف غيب, والفجوة في الكهف غيب، وقصة الخضر مع موسى r كلها غيب، وذو القرنين غيب. وفي هذا دلالة على أن في الكون أشياء لا ندركها بالعين المجردة ولا نفهمها ولكن الله تعالى يدبّر بقدرته في الكون وعلينا أن نؤمن بها حتى لو لم نراها أو نفهمها وإنما نسلّم بغيب الله تعالى.
سميت السورة بـ(سورة الكهف): الكهف في قصة الفتية كان فيه نجاتهم مع إن ظاهره يوحي بالخوف والظلمة والرعب, لكنه لم يكن كذلك إنما كان العكس (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إلى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا) آية 16 . فالكهف في السورة ما هو إلا تعبير أن العصمة من الفتن أحياناً تكون باللجوء إلى الله حتى لو أن ظاهر الأمر مخيف.وهو رمز الدعوة إلى الله فهو كهف الدعوة وكهف التسليم لله, ولذا سميت السورة (الكهف) وهي العصمة من الفتن.
أولها (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2)) إذن هو ذكر أمرين الإنذار والتبشير، نلاحظ آخر السورة ذكر الأمرين الإنذار والتبشير (وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (102) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106)) هذا إنذار،( إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108)) هذا تبشير، إذن في أول السورة وآخرها إنذار وتبشير. لو وضعت هذه الآيات بعد الآيات الأولى لكان هنالك تناسب فيما بينها. يا أيها الناس.. الذي لا يؤمن جزاؤه جهنم, وذكر صفات جهنم, والذين يؤمنون لهم الجنة, وذكر صفات أهل الجنة.(لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) لأن الإنسان بطبيعته يملّ من المشهد إذا تكرر ومن المقام إذا طال يريد غيره يعني الإنسان إذا رأى مكاناً جميلاً ويروقه مدة ثم يملّ ويذهب إلى مكان آخر ليبدله وهنا قال (لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) كأن الإنذار بجهنم وما فيها والتبشير بالجنة وما فيها لا يملون منها مطلقاً ولا يريدون التحول عنها (لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) معناه إما لأن المشاهد متغيرة والأشياء تتجدد أو النفوس تتغير أو كلاهما (لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا)، لينذر بأساً شديداً بالنار ويبشر المؤمنين بالجنة التي لا يبغون عنها حولا.
قال تعالى في خاتمة الإسراء: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111)) وقال في بداية الكهف:(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2)).
في الإسراء قال تعالى: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) وفي الكهف قال:(الْحَمْدُ لِلَّهِ) (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ), الخطاب مُوجه للرسول r فقال: الحمد لله؛ كأنه استجاب، يعني أمره بحمد الله في خواتيم الإسراء فاستجاب في أول الكهف (الحمد لله).
وذكر الكتابَ في ختام الإسراء: (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105)) وفي الكهف قال:(الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا) وبالحق أنزلناه وبالحق نزل لم يجعل له عوجاً قيّماً، أكّد نزوله من قِبَل الله سبحانه وتعالى قيماً لم يجعل له عوجاً.
في خواتيم الإسراء قال: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) وفي الكهف قال:(لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ) من ينذر ومن يبشر؟ قسم؛ قال في سورة الإسراء: الرسول rهو العبد المبشِّر, وقسم؛ قال القرآن وكلاهما واحد.
في ختام الإسراء قال: (الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا) وفي الكهف قال:(وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4)).
نلمح أن بعض آيات القرآن توضح وتفسر وتضيف إلى آية أخرى وتجعلها في سياقها.
في خواتيم الكهف قال:(قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109)) وما فعله مع زكريا عندما طلب زكريا من ربه أن يهب له غلاماً (ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6) يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8)) أليس هذا من كلمات ربي؟ الكلمات يعني القدرة. كلمات ربي يعني قدرته لا تنتهي. الكلمات يعني علمه وقدرته سبحانه. ما فعله مع مريم (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16)) وهو سمى عيسى كلمة فقال (إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (45) آل عمران) (إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (47) آل عمران) هذه من كلمات الله. قال في بداية مريم (ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2)) وسورة الكهف كلها في الرحمات؛ رحم المساكين أصحاب السفينة بأن أنجاهم ورحم الأبوين المؤمنين بإبدال خير من ابنهما ورحم الغلامين بحفظ الكنز ورحم القوم الضعفاء من يأجوج ومأجوج ورحم الفتية أصحاب الكهف عندما حفظهم، سورة الكهف كلها رحمات فهذه في رحمة عباد الله وسورة مريم بدايتها في رحمة عبد من عباد الله (ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2)).
نموذج القيادة في سورة الكهف
بقلم د. خالد فارس
(حصريًا لموقع إسلاميات)
1- الأخذ بأسباب العلم : لم يكتف القرآن بتحديد العلم فقط كصفة قيادة و لكنه أتبعه بضرورة العمل بهذا العلم و الأخذ بأسبابه فقال (فأتبع سببا(85) الكهف) وهذا يدحض نظرية العلم قوة، فالعلم لن يكون قوة إلا إذا تم استخدامه وتطبيقه لصالح المؤسسات. ومن الملاحظ تكرار (اتبع سببا) ثلاث مرات فدلت على ضرورة الأخذ بالأسباب في كل خطوة وتوظيف العلم لتحقيق الأهداف.
2- المرجعية : القيادة وفق منهج واضح المعالم قائم علي نظرية الثواب و العقاب و لا يترك الناس لهواهم (قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا(86) الكهف).
3. العدل : الحكم بين الناس بالعدل مبدأ يكفل راحة و طمأنينة الرعية و المرؤسين و من شاكلهم فالظالم يؤخذ علي يديه لتستقر الحياة و يأمن الناس (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا(86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا(87) وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا(88)الكهف).
4- التحفيز لإجادة العمل : شكر من أحسن عمله يكون حافزا له علي الإجادة و الصلاح و قد يكون أيضا بتذكيره بمردود هذا العمل عليه في الدنيا أو الآخرة (وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا(88)الكهف).
5- ديناميكية الحركة : القائد الناجح هو الذي يجوب نطاق عمله من أوله إلي آخره و لا يجلس في مقر قيادته و ينتظر من ينقل إليه الأخبار و لذا طاف ذو القرنين في أرجاء ملكه شرقا و غربا ليحقق ما أراد الله منه باستخلافه علي الأرض (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا(86) الكهف) (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا(90)الكهف).
6. التواصل و الاستماع للشكوي: فالقيادة التنفيذية في حالة تواصل مستمر مع من فوقها ومن تحتها، فالقائد لابد من تبرير قراراته بمنتهى الشفافية لمن هم فوقه حتى يظهر من بيانه عدله والتزامه بالمنهج (قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا(87) وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا(88)الكهف) ويؤخذ منه رفع التقارير المستمرة عن أداء العمل وتحقيق النتائج كما أنه يبين واحدة من مهارات التواصل وهي حسن الإستماع للناس وكسر كل الحواجز التي قد تعيق هذا الإتصال فقد كان هؤلاء القوم لا يفقه أحد كلامهم ولا يفقهون هم كلام أحد بحسب ما جاء في القراءات المتواترة (يَفْقَهون) بفتح الياء والقاف وقرأ حمزة والكسائي (يُفْقِهون) بضم الياء وكسر القاف. لابد للقائد الناجح من فتح قنوات اتصال بينه و بين من هو مسئول عنهم و أن يستمع إليهم علي كافة درجاتهم و طوائفهم و أن يكون الاتصال مباشرا دون عائق (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا(94) الكهف) (قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا(95) الكهف).
ثم يأتي موقفٌ يمر عليه الكثيرون مرورا عابرا و لكنه يرسم مجموعة من الصفات الأخلاقية في القائد عندما يعرض عليه رعيته مكسبا دنيويا مقابل القيام بعمل لهم فيرفض رفضا قاطعا و يفضل ثواب الله عليه (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا(94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا(95) الكهف) و من الصفات المستنبطة من هذا الموقف الرائع
7. غلق باب الكسب غير المشروع : فلا يحق للقائد أخذ أجر علي عمل مكلف به إلا ممن كلفه بالعمل فلا يقبل هدية أو عطية بسبب منصبه أو ما مكنه الله له.
8. الإحساس بالمسئولية : عندما يشعر القائد بالمسئولية تجاه من يقودهم فإن هذا يكون دافعا لتحقيق مصالحهم دون التكسب من وراء ذلك.
9. العفة و طهارة اليد : القائد الحق هو من لا يستغل حاجات رعيته و ينهب ثرواتهم بحجة أنه يقوم علي رعايتهم و تحقيق مصلحتهم.
10. نصرة المظلوم : نصر المظلوم واجب لا يحتاج إلي مقابل.
11. العمل الجماعي : و هذا بين في قوله: (قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا(95) الكهف).
12. التوظيف الأمثل للطاقات البشرية : فلقد وظف ذو القرنيين طاقات القوم فيما يحسنوا و طلب منهم العون بالقوة و ليس بالمال أو العلم.
13. وضوح التعليمات و الأوامر الصادرة من القيادة (خطة تشغيل محكمة) : فلقد كان ذو القرنين محددا فيما يطلبه وواضحا وضوحا شديدا كما في قوله: (آَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا(96) الكهف).
14. استغلال الموارد المتاحة : فلقد استخدم ما لديهم من مواد مثل الحديد والنحاس وغيرها ليحقق النتائج المرسومة بالموارد المتاحة في دمج عجيب لمبدأ الكفاءة في استغلال المتاح مع الفاعلية في تحقيق أفضل النتائج.
15. التعليم والتوجيه : فلقد علمهم ذو القرنين كيفية بناء سد منيع.
16. التدريب على رأس العمل: أشركهم ذو القرنين في العمل ليكون التعليم واقعا عمليا ملموسا وليس نظريا.
17. استخدام القوة في التعمير و الإصلاح.
18. إدارة المخاطر وتحقيق المطلوب بأيسر الطرق وأقل خسارة ممكنة فلقد كان ممكنا لذي القرنين أن يقاتل يأجوج ومأجوج ولكنه فضل عزلهم ودفع شرهم بأبسط الطرق.19. التواضع و رد الفضل لله : التوفيق من الله و علي كل قائد ناجح في مؤسسته أن يعلم أنه لولا توفيق الله له ما كان لينجح و لذلك قال ذو القرنين (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا(98) الكهف) كما أنه على كل قائد ناجح أن يرد الفضل إلى أهله وألا ينسب لنفسه ما ليس له.
وفي سورة الكهف (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا * قيّما…)
القرآن قيّم على كل أمرنا صغيره وكبيره نحتكم إليه فقد صرّف الله تعالى فيه للناس من كل مثل
قيّم على تعاملنا حال الاستضعاف (فليتلطف) كما في قصة فتية الكهف
قيّم على تحديد من نصاحب (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي.. )
قيّم على كلامنا لا نجادل فيما لا فائدة منه ولا نماري ولا نكون أكثر جدلا
قيّم على أعمارنا بم نملؤها ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا)
قيّم على أهدافنا: الجنة ونعيمها لا النار وعذابها
قيّم على ما يكتب في صحائفنا حتى لا نتحسر يوم القيامة (يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها)
قيّم على ما نتعلم وكيف نتعلم وممن نتعلم (قصة موسى مع العبد الصالح)
قيّم على أخذنا بالأسباب واتباعها في حال التمكين في الأرص فنحكم بالعدل وندافع عن المظلومين ونستخرج ونستثمر طاقات الشعوب والأفراد في ما فيه خيرهم وأمنهم (قصة ذي القرنين)
قيّم على بصائرنا وعقولنا لترى بمقاييس الآخرة مواطن الأمور لا ظواهرها التي إما أن تكون خادعة ببريقها وإما أن تعطينا نصف الحقيقة…
قيّم على عقيدتنا فلا نشرك بربنا أحدا
قيّم على أعمالنا لتكون صالحة مقبولة
بين سورة الإسراء وسورة الكهف رحلة حياة بمنهج قرآن قيّم يهدي للتي هي أقوم… ألا ما أسعدها من حياة!!
هذا ما رُزقت تدبره أسأل الله تعالى أن يغفر لي إن قصرت ويعفو عني إن تجاوزت لكني سطّرت ما قرأته بقلبي في آيات السورتين..
هذا والله أعلم
#رمضان_١٤٤٢
#وقفات_تدبرية
#الجزء_١٦
روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بني إسرائيل الكهف ومريم وطه والأنبياء ، هن من العِتاقِ الأُول وهُنَّ من تِلادي”[صحيح البخاري]
من العتاق الأُول يعني أن نزول هذه السور متقدم أو أنها من المفضلات والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقا، يريد تفضلي هذه السور لما تضمن مفتتح كل منها من أمر غريب وقع خارقا للعادة: الإسراء، قصة أصحاب الكهف وقصة مريم وولادة عيسى. و”من تِلادِه” يعني: من السور التي حفظها قديما فالتليد أي القديم.
هذا التعريف للسور التي توسطت المصحف يستدعي التوقف عنده نلتمس شيئا من تميزها..
ونرجع إلى خواتيم سورة النحل (ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) ثم تتالت السور بعدها من الإسراء إلى الأنبياء كأنها تطبيق عملي لهذه الآية والله أعلم..
سورة الإسراء تكليف بالدعوة وحث على الدعوة بالقرآن وما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة كما في الوصايا العشر في السورة.
سورة الكهف أيضا بينت نماذج من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بدءا من فتنة الكهف إلى ذي القرنين
وسورة مريم نموذج من الدعوة داخل الأسرة الواحدة ولا ننسى أن جعفر بن أبي طالب قرأها على النجاشي في الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة فأعطاهم الأمان للعيش في الحبشة.
سورة طه نموذج دعوة أعتى طاغية مستكبر “فرعون” (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) وسورة طه هي السورة التي ذكرت الروايات أن عمر بن الخطاب أسلم بعدما سمعها في بيت أخته..
سورة الأنبياء تمثل مسيرة دعوية عبر تاريخ الرسالات..
ولو تدبرنا آيات السورة في الجزء ١٦ في سورتي مريم وطه نجد أنهما تمثلان:
الدعوة داخل الأسرة ومقوماتها في سورة مريم
والدعوة خارج الأسرة ومقوماتها في سورة طه
1= قال تعالى: {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب}
يستفاد من هذه الآية: أن القرآن منزل من الله غير مخلوق.. منه بدأ وإليه يعود.. تكلم به حقيقة.. وأجمع العلماء على أن من قال بخلق القرآن فقد كفر وخرج عن الملة.
2= قال ابن القيم: ذكر الله نبيه بوصف العبودية في أشرف المقامات:
- إنزال القرآن… {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب}.
- حادثة الإسراء.. {الحمد لله الذي أسرى بعبده}.
- الدعوة إلى الله.. {وأنه لما قام عبد الله يدعوه}.
3= قال تعالى: {إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً}.
يستفاد من هذه الآية: أن حسن العمل يبنى على الأمرين التاليين: الإخلاص والمتابعة.
4= قال تعالى: {نحن نقص عليك نبأهم بالحق}.
يستفاد من هذه الآية: الرد على من يقولون بعدم جواز ذكر القصص.. كبرت كلمة تخرج من أفواههم.. فالقصص منهج قرآني رباني.. والله سبحانه وتعالى قد حثَّ نبيه على ذكر القصص.. قال تعالى: {فاقصصِ القصص لعلهم يتفكرون} فليحذر الذين يتكلمون في هذا الجانب.. ولينتبهوا.. وليعلموا أن من رفض القصص فقد رفض القرآن…
5= قال تعالى: {وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد}.
قال بعض الصالحين: من أحب أهل الخير نالته بركتهم.. كلبٌ أحبّ الصالحين ذكره الله في القرآن.
6= قال تعالى: {ولا يشعرنَّ بكم أحداً}.
يستفاد من هذه الآية: مشروعية كتمان بعض الأعمال وعدم إظهارها.
7= قال تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله}.
قال العلماء: المشيئة تكون في الأمور المستقبلية القادمة، لا الماضية.
8= قال تعالى: {واضرب لهم مثلاً رجلين}.
في هذه الآية دليل على ضرب الأمثلة.. وهي طريقة مثالية ونافعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى..
9= قال تعالى: {قال له صاحبه وهو يحاوره}.
فالحوار والجدال مطلوب.. وهو من أنفع الوسائل التي يستخدمها الداعية في طريق دعوته.. قال تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن}.
10= قال تعالى: {ولولا إذ دخلت جنَّتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله}.
إستدل العلماء بهذه الآية: على أن كل من دخل بيتاً أو رأى نعمة.. أن يعترف بفضل الله.. وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله..
11= قال تعالى: {والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك}.
فسَّر العلماء هذه الآية أنها تشمل جميع الحسنات.. وأعمال الخير والبر..
12= قال تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم}.
ـ سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة.. وإنما سجود طاعة لله سبحانه وتعالى.. تشريفاً وتكريماً لآدم..
ـ ليس إبليس من الملائكة.. وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم.. والدليل قوله تعالى: {إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه}، ولأن الملائكة خلقوا من نور والشيطان خلق من نار..
13= قال تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيئ جدلاً}.
فالجدال نوعان:
= جدال من أجل طلب الحق.. فهذا لاشيء فيه، بل مشروع..
= جدال من أجل إتباع الهوى.. وهذا هو الذي ينبغي تركه..
14= قال تعالى: {وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين}.
تنبيه: عدم صحة من يسمي المنصرين بـ {التبشير} فهم مبشرون ولكن بنار جهنم والعياذ بالله..بل الرسل هم الذين سماهم الله بـ {مبشرين ومنذرين}.
15= قال تعالى: {فوجدا عبداً من عبادنا}.
العبد: هو الخضر عليه السلام، وسبب تسميته بذلك: لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء.. البخاري.
16= قال تعالى: {وعلَّمناه من لدنا علماً}.
بهذه الآية إستدل العلماء على نبوة الخضر عليه السلام.. والدليل الثاني: قوله تعالى: {وما فعلته عن أمري}.
17= قال تعالى: {قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علِّمت رشداً}.
يستفاد من هذه الآية: تلطف طالب العلم بشيخه ورفقه به.
18= قال تعالى: {قال ستجدني إن شاء الله صابراً}.
يستفاد من ذلك: إستحباب ذكر المشيئة في الأعمال المستقبلية.
19= قال تعالى: {وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين}.
يستفاد من هذه الآية: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.. فكفر الأبوين بالله جل شأنه.. أعظم من موت هذا الغلام..
20= قال تعالى: {وكان أبوهما صالحاً}.
إستدل العلماء بهذه الآية: على أن صلاح الآباء صلاحٌ للأبناء.. قال سعيد بن المسيب: إني لأزيد في الصلاة من أجل ابني..
{فاحفظ الله يحفظك}.. يحفظك في دينك وأهلك ومالك..
21= قال تعالى: {فأردت أن أعيبها}.
في هذه الآية: تأدب الخضر عليه السلام مع ربه.. حيث نسب الفعل إلى نفسه مع أن الله هو الذي أمره بذلك.. وهذا زيادة أدب مع الله جل شأنه..
وقد كره بعض السلف قولك: أخزى الله الكلب.. لأنها جمعت بين لفظ الجلالة وبين هذا الحيوان..
22= من فوائد قصة موسى والخضر:
ـ الرحلة في طلب العلم.. وقد حثَّ العلماء على هذا، وإستحبوا أن يرحل الطالب إلى العلماء لملاقاتهم والجلوس بين أيديهم. وقد كان بعض السلف يرحل من أجل حديث واحد..
ـ الموافقة في الصحبة طريق إلى دوامها.. وهذا في الأمور الدنيوية السهلة.. لا في الأمور الشرعية العويصة..
23= قال تعالى: {ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً}.
أجمع العلماء على أن من إستهزأ بشيء من الدين فقد خرج من الملة.. وكفر بالله سبحانه وتعالى.. سواء كان ذلك ذاكراً أم ناسياً.. قاصداً أم لم يقصد.
24= قال تعالى: {قل إنما أنا بشرٌ مثلكم}.
في هذه الآية رد على غلاة الصوفية الذين بالغوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.. ووصفه بأوصافٍ لا تليق..
25= كل الأحاديث التي جاء فيها الوصف الخلقي ليأجوج ومأجوج لا يصح منها شيء.
إختصار لمحاضرة بنفس العنوان لشيخنا: سلطان العمري..
الكاتب: عبد الرحمن السيد.
المصدر: موقع يا له من دين.
الحلقة الأولى
فضائل سورة الكهف
سورة الكهف يقرؤها الناس كل جمعة، نستعرض هذه السورة نستخرج ما فيها من كنوز ونفهم معانيها ما فيها من مرامي ومن قصص ثم نفهم القصص الموضوعية في السور وأوجه الربط بين القصص القرآنية في هذه السورة من ناحية وما بين قصص السورة والآيات التعقيبية على هذا القصص يعني الآيات غير القصصية ما علاقتها وما وحدتها الموضوعية مع الآيات القصصية وغير هذا من القصايا لعلنا نتعلم منهجاً في التعامل مع القرآن العظيم، في تذوق حلاوة القرآن العظيم، في استكناه واستخراج الكنوز من هذا البحر الزخّار ذو المعاني. هذا النص القرآن غصنٌ – إن جاز التشبيه – مليء بالثمار مثقل منحني على الجاني الذي يريد أن يجني من هذه الثمرات، قريب المنال سهل الفهم لكنه عميق كالمحيط.
في فضلها أحاديث كثيرة، في فضل هذه السورة روى مسلم صاحب الجامع الصحيح: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عُصِم من الدجال. (الراوي: أبو الدرداء، المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 809، خلاصة حكم المحدث: صحيح) وفي رواية “من آخر سورة الكهف” أمِن فتنة الدجّال. ما العلاقة؟ ولماذا سورة الكهف بالذات؟ الأستاذ أبو الحسن الندوي علّامة الهند رحمة الله عليه له كتاب رائع “تأملات في سورة الكهف” أو الصراع بين المادية والإيمان من خلال استعراضه لسورة الكهف يقول: ما أشبه الحضارة الغربية اليوم بماديتها الغليظة ما أشبهها بالدجال، الدجال عنده الأسباب وعنده الأشياء ولكن ليس عنده الإيمان. سورة الكهف تمثل الصراع بين المادية والإيمان كأن الإيمان الذي يمثله فتية الكهف ويمثله موسى والعبد الصالح ويمثله ذو القرنين هذا الإيمان سيكون له التفوق والغلبة وإن كان أصحاب الإيمان مجرّدين من الأسباب المادية نسبياً بالنسبة لأعدائهم المدججين بالأسباب المادية، في هذا الصراع سيكون الشأن والغلبة للإيمان.
نرى هذا المعنى في قصة صاحب الجنتين وصاحب صاحب الجنتين كيف أنه صاحب صاحب الجنتين مؤمن ليس عنده الدنيا ولا عنده المال ولا عنده الجاه الذي عند ذاك لكن تنبّأ وصدقت نبوءة ولا نقول نبوءة بل هي قرآءة في السنن أن من حارب الله، من عادى الله قصمه الله تبارك وتعالى وأخذه أخذ عزيز مقتدر (فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ (42))، عرفنا لماذا قرآءة سورة الكهف تعصم من فتنة الدجّال؟. سورة الكهف تعمّق الإيمان وإن كان أصحاب الإيمان ليس عندهم الأسباب، ليس في أيديهم الدنيا ولذلك جاءت سورة الكهف تقول (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (46)) كل هذا عَرَض زائل لكن الحقيقة الباقية والمستقرة الثابتة في الوجود والكون والآخرة الإيمان وما يمتّ إلى الإيمان. من هنا كانت هذه السورة الكريمة فيما يرى الشيخ الندوي رحمة الله عليه صراع بين المادية والإيمان كالذي سيكون بيننا وبين الدجال في آخر الزمان، الدجال عنده الدنيا والأسباب والمادة تماماً كالحضارة الغربية اليوم، الحضارة الغربية هي الدجّال بمعنى أن أخلاق الدجال منطبقة على الحضارة الغربية. من عصى الحضارة الغربية حاصرته ومنعت عنه الأسباب وقاومته حتى يركعوه بالإذلال والتجويع والحصار والتعطيش حتى ينزلوه إلى الأرض وبالإيمان يستعلي أصحاب الإيمان على المادة والأسباب ومن مَلَكَ المادة والأسباب. إذن هذا في فضل هذه السورة حديث مسلم أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عُصِم من الدجال.
في فضلها أيضاً روى البخاري رحمة الله عليه أنه: “كان رجلٌ يقرأ سورةَ الكهفِ، وإلى جانبه حصانٌ مربوطٌ بشطَنَينِ، فتغشُّته سحابةٌ، فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسُه ينفرُ، فلما أصبح أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر ذلك له، فقال: (تلك السكينةُ تنزَّلت بالقرآن) الراوي: البراء بن عازب المحدث:البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 5011، خلاصة حكم المحدث: [صحيح]. غشيت السكينة من يقرأ هذه السورة العظيمة. السكينة الطمأنينة. هل كان مع السكينة ملائكة؟ الله أعلم لكن هذا نص الحديث.
هذه السورة لها ميزات كثيرة
• أولاً هذه قلب المصحف (في الجزء الخامس عشر)
• هذه قلب سور الحمد، سور الحمد خمس فاتحة القرآن كله والأنعام فاتحة الربع الثاني من القرآن العظيم، الكهف وبعدها سبأ وفاطر إذن هي في قلب سور الحمد
• هي تتحدث عن نعمة هي قلب النِعَم. قلب النعم نعمة القرآن العظيم (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا (1)) قلب النعم تماماً مثلما هذا القلب في الجسد، بقاء الحياة في القلب، قلب النعم هذا القرآن العظيم، ليس هناك نعم إطلاقاً إذا لم يكن هذا القرآن في حياتنا موجوداً لا طعم لشيء لا مذاق لشيء لا هناءة لشيء إذا لم يكن في قلوبنا القرآن العظيم.
• أيضاً هذه السورة نزلت في أواسط مدة بعثة النبي عليه أزكى الصلوات
• يقول المفسرون بإجماعهم إذا عددنا كلمات القرآن وبعضهم يقول حروف سنجد منتصف القرآن عند كلمة (وَلْيَتَلَطَّفْ).
• إذن هذه السورة واقعة في وسط المصحف الجزء الخامس عشر في قلب سور الحمد تتكلم عن نعمة هي قلب النعم فيها كلمة هي وسط القرآن العظيم (وَلْيَتَلَطَّفْ). ثم هي نازلة في منتصف مدة بعثة النبي، فهي مزايا على مزايا وفضل لهذه السورة العظيمة الجليلة أمِن عجبٍ بعد هذا أن يقرأها المسلمون في كل جمعة ويواظبون عليها ويداومون وأغلب البيوت يحفظها لدرجها على ألسن الناس.
• عدد آيها 110 لا نظير لهذا العدد في القرآن العظيم
• هي السورة رقم 18 قبلها سورة الإسراء وبعدها سورة مريم.
ما علاقة هذه السورة العظيمة بجارتها سورة الإسراء؟ قاعدة: لا يوجد سورتين متجاورتين وأنا أسمي هذا الكلام التوأمة بين السور إلا ويكون بين الجارتين علاقات حتماً وقطعاً وإنا مستعرضون وإياكم أوجه عديدة جداً من العلاقات بين السورتين الكريمتين العظيمتين الإسراء والكهف.
الحلقة الثانية
في التفاسير يروون لهذه السورة الجليلة سبب نزول. خذوا قاعدة: جُلّ القرآن وأغلب القرآن ليس له سبب نزول، ليس هناك داعي أن نتمحل سبب نزول لكل آية ولكل سورة. يروون لها سبب نزول في نظري الضعيف هذا السبب لا يصح ولهذا لست حريصاً على أن أرويه أو أعتمد عليه أو أربط الآيات به، السورة نقرؤها مطلقة عن سبب النزول. لكن سنذكره – لكني لن أعتمده ولن أربط فهمي لهذه السورة الكريمة بهذا السبب من أسباب النزول – ثم نستعرض أوجه العلاقات بين سورة الإسراء وسورة الكهف.
سبب النزول يقولون في روايات أسباب النزول للسيوطي والواحدي وفي كل كتب التفاسير يقولوا أن وفداً من قريش من العرب ذهب إلى المدينة المنورة كي يستعينوا باليهود ليسألوهم كيف يُحرجون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقاومون النبي ودعوة النبي؟ تنسيق جهود ما بين اليهود وبين العرب، نتكلم عن أول وقت نزول القرآن طبعاً. فذهب وفد من العرب إلى المدينة المنورة يسألون اليهود كيف يقاومون النبي؟ فلقّنوهم – تقول الرواية – مجموعة أسئلة، إسألوه عن وعن وعن فإذا أجاب.. وبعدما أجاب النبي جواباً قاطعاً حاسماً ماذا حصل؟ هذه كلها مماحكات وتمحلات إن صحت الرواية – هذه أخلاقهم صحّت الرواية أم لم تصح – قالوا إسألوه عن الروح فسألوه وأجاب في سورة الإسراء السابقة لهذه السورة (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85)) ثم إسألوه عن فتية مضوا في الزمن الأول ثم إسألوه عن رجل طوّاف طاف المشارق والمغارب ما شأنه ما قصته فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أن النبي قال لهم غداً أجيبكم. النبي العظيم سيد المتأدبين مع رب العالمين سبحانه، النبي الكريم عليه أزكى الصلوات لا يقول غداً أجيبكم هو عبد لا يمكن أن يتألّى على ربه أنه غداً أجيبكم، أنا ما أضمن أن ينزل الوحي بأمري غداً. من نقص هذا المتن من هنا أرى أن هذه الرواية ينبغي أن يكون فيها مراجعة ونظر. أبطأ الوحي على النبي يوم ويومين وثلاثة وأسبوعين مروا دون أن ينزل الوحي فتكلمت قريش وتكلم الداعمون الخفيون لقريش ثم نزل الوحي الكريم (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ (24)) قد يقول قائل أن الآية تؤيد الرواية، لا، الآية تقول (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ (24)) هذا توجيه مطلق بقطع النظر أن يكون لهذا النزول سبب معين، ولماذا نخترع له سبب نزول؟! لو صحّ نتقبّله أما وإنه روايات رواها فلان وفلان. من البخاري ومسلم على الرأس والعين وما تبقى لا نأخذ بهذا الكلام.
ننتقل إلى موضوع التوأمة بين السورتين الجارتين التوأمين سورة الإسراء وسورة الكهف وقد نجد أكثر من ثلاثين وجهاً من أوجه الربط. وتستطيعون بالتأمل أن تستخرجوا أحسن مما استخرجت وهذا ليس حكراً على أحد كل من نظر إلى كتاب الله أسعفه كتاب الله بمدد وأسعفه بمعاني أسعفه بلالئ وجواهر، انظروا في القرآن ودرّب عقلك على استخراج العلاقات ما بين السور ستجد نفسك عندك دربة ومران وعين ناقدة تستخرج النظائر والنظائر وتضم الأشباه إلى الأشباه والنظائر إلى النظائر وترى أوجه التلاقي والعلاقة والتناسق بين والتناغم ما بين السور العظيمة. القرآن مبناه على التناسق والتعانق والارتباط، القرآن العظيم من الفاتحة إلى سورة الناس سلسلة واحدة ليس هناك قطع ليس ربط بعد القطع إطلاقاً، خيط واحد متصل، نهر جارٍ، هذا هو القرآن.
1. أول سورة الإسراء (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً) أول سورة الكهف (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ) العبد نفسه طالع إلى السموات في سورة الإسراء وفي سورة الكهف الوحي نازل إلى العبد، أرأيت التقابل. العبد عليه أزكى الصلوات في أول سورة الإسراء هو العبد ذاته في أول سورة الكهف ولكن الفرق أنه في الأولى هو الذي يصعد وفي السورة الثانية الوحي هو الذي ينزل، تكامل ما بينهما.
2. أول الإسراء (سبحان) وأول الكهف (الحمد) ونعرف أن سبحان الله والحمد لله ذكران متلازمان مقترنان مترابطان على مر الزمان وعلى كل لسان “سبحان الله والحمد لله”. إذن سورة الإسراء (سبحان) وسورة الكهف (الحمد) وسبحان والحمد متلازمان.
3. في ختام الإسراء (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا) وفي أول الكهف (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا)
4. السورتان فاصلتهما واحدة (الألف) ( أحدا – تكبيرا – ) كأنك تنتقل في نسق واحد.
5. عدد الآيات في الإسراء 111 وعدد الآيات في سورة الكهف 110 لو جمعنا عدد آيات السورة مع رقم السورة سيكون الناتج واحداً
6. في السورتين ذكر موسى عليه السلام. في الإسراء (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (101)) وفي الكهف (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ (60))
7. في خواتيم الإسراء (وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِهِ (97)) في فواتح الكهف (مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا (17))
8. في آخر الإسراء (وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) آخر الكهف (وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) الكلام عن الشرك
9. التبشير والنذارة في آخر الإسراء (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105)) والتبشير والنذارة في اول الكهف (قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2))
10. عدد كلمات آخر آيتين في السورتين 42 كلمة، هذا ليس من فراغ، هناك علاقة تحتاج إلى توضيح
11. في السورتين (ويسألونك) كلمة مشتركة بين السورتين في الإسراء (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ (85)) وفي الكهف (وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ (83)) هناك سائلين
12. في السورتين الكلام عن كتاب الأعمال (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (49)) في سورة الكهف، (وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (13) اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14)) (فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ (71)) كتاب الأعمال في الإسراء وكتاب الأعمال في الكهف
13. نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى في السورتين: (وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (71)) في سورة الإسراء، (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49)) في سورة الكهف
14. في السورتين قصة آدم (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (50) الكهف) (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ (61) الإسراء)
15. الحديث عن الجن في السورتين (إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ (50) الكهف) (قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ (88) الإسراء)
16. في السورتين ذكر هلاك القرى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا (59) الكهف) (وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (58) الإسراء)
17. في السورتين (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَّسُولاً (94) الإسراء) (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) الكهف) نفس النص مشترك بين السورتين
18. ذكر البحر ثلاث مرات في السورتين (فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) الكهف) (وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) الكهف) (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْر (79) الكهف)
19. في سورة الإسراء (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ (33)) في سورة الكهف (قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ (74))
20. في السورتين ذكر الحق (وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ (105)) (وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)) وفي سورة الكهف (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ (29))
الحلقة الثالثة
تتمة أوجه الربط والتوأمة بين السورتين المتجاورتين:
1. توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والثبات في السورتين (وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً (74))، في سورة الكهف (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (28))
2. الكلام عن بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم (قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً (93)) في سورة الإسراء وفي الكهف (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ)
3. في الإسراء (أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا (91)) في سورة الكهف (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33))
4. الشمس مذكورة في السورتين (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (78) الإسراء) (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت (17) الكهف)
5. الأموال والأولاد في السورتين (وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ (64) الإسراء) (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (46) الكهف)
6. الجبال موجودة في السورتين (وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً (37) الإسراء) (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ (74) الكهف)
7. (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا (41)) في الإسراء وفي الكهف (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54))
8. الموعد في كل من السورتين، سورة الإسراء موعد أن ندخل المسجد (وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ (7)) (فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً (5)) وسورة الكهف مليئة بالقصص التي لها حديث عن المواعيد، موعد موسى مع العبد الصالح وقصة ذو القرنين وموعد القرى التي جعل الله لها موعدا (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا (59))
9. الإسراء سورة الصراع مع بني إسرائيل والنصر عليهم إن شاء الله وإنهاؤهم من الوجود ليس ظلماً ولا عدواناً إنما بما صنعت أيديهم جزاء وفاقاً. سورة الكهف فيها التركيز على اسمها (الكهف) لا بد هؤلاء الذين يملكون الجو والطيران أن تختفي من تحت أنظارهم في هذا الصراع يعني كأن الكهف في هذا الصراع وقاية لك وحماية لك في صراعك مع بني إسرائيل
10.
سورة الكهف جُل آياتها في القصص يعني هي سورة قصصية، فيها قصة آدم، قصة صاحب الجنتين وصاحبه، موسى والعبد الصالح، أول السورة قصة أصحاب الكهف، آخر السورة قصة ذي القرنين، وكل واحدة من هذه القصص تحتاج كتاباً خاصة ذو القرنين وموسى والعبد الصالح تحتاج إلى تحليل النص بعيد عن الإسرائيليات والأباطيل، نتعلم فن تحليل النص ونستخرج من الكنوز الكامنة في هذا النص وتحليل النص، هل أترك هذا النص وتحليله وأنقل من الشعبي الذي كله كذب ونقص؟!
خذوا قاعدة: ما من سورة من سور القرآن العظيم تضم جناحيها على مجموعة من القصص إلا ويكون بين قصص هذه السورة تعانق وتناسق بالضرورة حتماً مقضياً، هذا كلام الله لا يمكن أن يكون مجموعة من القصص في سورة واحدة ليس بينها ناظم ينظمها ولا رابط يربطها، بينها علاقات لكن هذه العلاقات قد نختلف في وجهات النظر من حيث أوجه الربط لكن نتفق أنه لا بد أن هناك أوجه ربط.
الندوي علّامة الهند رحمه الله يرى أوجه الربط ملخصة في كلمة واحدة “الصراع بين الإيمان والمادية” ينتظم قصص سورة الكهف جميعاً.
صاحب الظلال رحمه الله يرى وجه الربط مختلفاً يقول: سورة الكهف فيها تصحيح ميزان العقيدة وتصحيح قيم الفكر والنظر وفق منهج الله وتصحيح القيم. الكلام عن العقيدة والتوحيد (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4)) آخر السورة (وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) وفيما بين أول السورة وآخرها تجد الحديث عن التوحيد والشرك ينتظمها. إذن تصحيح العقيدة وعمود العقيدة وركنها توحيد الإله العظيم سبحانه، أخطر حقيقة في الوجود أنه لا إله إلا الله، من أين جاؤوا لله بولد؟! من أين زعموا لله شركاء وأندادا؟! هذا ينقض نظام الكون كله وينقض الدين كله. موضوع الشرك موضوع طويل، ليس الشرك أن تعبد حجراً، هذا انتهى وانقضى ومضى، لا يعني أن الشرك اختفى وإنما الشرك الآن في صور مختلفة، الشرك في القوة، اليوم من ملك القوة تألّه على الناس في الأرض وأغلب الناس مفتون بالقوة. الدجّال عنده قوة يقول للرجل أنا ربك فيقول لا، ربي الله، فيقتله من أجل عقيدته، فتنة شديدة!! إذن القوة شرك، أغلب الناس في نهاية الزمان يتبعون الدجّال. الآن الشرك الأخطر شرك القوة من ملك القوة استعمر الناس واستضعفهم، من عدِم القوة استُضعِف. لا ترى قوياً إلا الله لا تخشى إلا الله، هذا هو التوحيد. عبادة الحجر بطلت من زمن لكن الشرك الآن تخفّى بأثواب جديدة فانتبهوا أن لا يكون في قلبنا خوف من أحد لأن القوة لله جميعاً، العزّة لله جميعاً، لا أحد يملك العزة إلا الله، لا أحد يملك القوة إلا الله. اليوم الدعاة يجب أن يركزوا على شرك القوة، الناس تغض النظر عن شرك القوة بينما هذا هو الشرك الذي ينبغي أن يُحذَر منه كل الحذر لأن فيه كل الخطر، شرك القوة والقرآن جاء يخلصنا من كل صور الشرك وينقّي قلوبنا بالتوحيد، نقّى الله سرائرنا وقلوبنا وضمائرنا بتوحيده سبحانه لا يجعل فيها محبة وخشية إلا له ومنه.
http://www.youtube.com/watch?v=uDtyihvUQw0
إضافات تدبرية للمواضيع المشتركة بين السورتين سورة الإسراء والكهف (إعداد موقع إسلاميات)
1. كلمة المسجد وردت في السورتين في الإسراء (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى (1)) (وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ (7)) وفي الكهف (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا (21))
2. قصة رفض ابليس السجود لآدم وردت في السورتين. في الإسراء (فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (61)) وفي الكهف (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ (50))
3. ذكر وسيلة النقل في البحر، في الإسراء ذكرها بلفظ الفلك (رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ (66)) وفي الكهف بلفظ السفينة (فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ (71))
4. ذكر الباطل في السورتين. في الإسراء (وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)) وفي الكهف (وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ (56))
5. ذكر اليتيم في السورتين. في الإسراء (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ (34)) وفي الكهف (وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ (82))
6. ذكر المساكين في السورتين. في الإسراء (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ (26)) وفي الكهف (لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ 79))
7. الدعوة إلى التوحيد في السورتين. في الإسراء (لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَـهًا آخَرَ (22)) (وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ (39)) وفي الكهف (أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ (110))
8. ذكر السنين في السورتين. في الإسراء (وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ (12)) وفي الكهف (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ (25))
9. ذكر الرحمة في السورتين. في الإسراء (عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ (8)) وفي الكهف (فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا (65)))
10. ذكر الأذن في السورتين. في الإسراء (وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا (46)) وفي الكهف (فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ (11))
11. ذكر العلم في السورتين. في الإسراء (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (36)) (وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85)) وفي الكهف (مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ (5)) (وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا (65)) (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66))
12. الكفر بآيات الله وردت في السورتين. في الإسراء (ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا (98)) وفي الكهف (أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ (105))
13. جهنم جزاء الكافرين وردت في السورتين. في الإسراء (مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا (98)) وفي الكهف (ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106))
الحلقة الرابعة
إن قصص سورة الكهف بينه ناظم ينظمه وناسق ينسّق بينه وعلاقات بالقطع ممكن أن تختلف هذه النظرات وبدأنا بكلام صاحب الظلال قال: أن القصص في هذه السورة يتكلم عن تصحيح العقيدة، تصحيح الميزان ومنهاج النظر والفكر وتصحيح ميزان القيم. في موضوع القيم على سبيل المثال صاحب الجنتين معتزٌّ بماله، معتز بجنتيه، معتزٌ بأولاده، وصاحبه المؤمن ليس عنده شيء من هذا القبيل لكنه معتز بإيمانه، معتز بربه تبارك وتعالى فكانت العاقبة له، يريد أن يصحح منهاج الفكر.
الكلام عن فتية الكهف رب العالمين يصف معلومات المتكلمين عنهم (رَجْمًا بِالْغَيْبِ (22)) وفتية الكهف يقولون عن أهلهم (هَؤُلَاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ (15)) اتخذوا مع الله آلهة فليأتوا ببرهان عن أن هذه آلهة. إذن هذا العقل جوهرة ثمينة وأمانة عظيمة ينبغي ألا يدخل العقل معلومة إلا مفلترة مثبتة منقّاة إما حقيقة دينية ثابتة وإما حقيقة كونية ثابتة ولا يدخل هذا الذهن معلومة أوهام، ظنون أو تقليد أو تسريبات غير قائمة على أصول، كل معلومة قد تحرف مسارك ومصيرك، المسير والمصير مرتبط بما يدخل إلى عقلك من فكر ومن علم فإذا كان العلم الداخل إلى العقل فاسداً فسد العقل (إلا من أتى الله بقلب سليم) والعقل والقلب في هذا شيء واحد. القلب والعقل بينهما طُرُق، القلب مستشار الملك (العقل) والمستشار يؤثر على قرار الملك. أي معلومة في القلب أو العقل خاطئة قد يؤدي إلى اضطراب في العلاقة بينك وبين الله عز وجل وقد تضلّ وأنت لا تشعر. كم ضلّت أقوام وأناس وأصحاب مِلل ونِحَل! مئات البشر يعبد بقرة أو فئران أو ما تيسر من موجودات الوجود نتيجة هذه التقاليد.
الناسق ما بين قصص سورة الكهف بحسب صاحب الظلال ثلاثة أشياء: العقيدة، الفكر، والقيم. القيم يعني أن تُعلي من الباقي، الباقيات الصالحات، الدنيا ظل هل يستطيع أحد أن يُمسك الظلّ؟! الدنيا ظل زائل، اِمسك بالباقي، العمل الصالح مدخر لك عند الله عز وجل، ثواب الله باقي، امسِك بهذا لكن للأسف أغلب الناس يحبون العاجلة ويذرون الآخرة لأن هناك اضطراب في القيم، تضخمت وعظمت الدنيا في نظره وفي ميزانه شعارهم : عصفور في اليد خير من عشرة في الغد، وهو شعار باطل لا ينبغي أن يقال إنما اعتزازنا بالكبير المتعال سبحانه وأن يكون عملنا لأجل دخول جنة ذات ظلال إن شاء الله تعالى، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن اجعل قيمك أخروية وهذا لا يعني أن تخرج من الدنيا فنحن نعيش فيها لكن لا تجعلها في قلبك أبداً. الدنيا مثل الماء إن عمت فوقها حَمَلَتك وإن دخلت جوفك قتلتك، إياك أن تدخل الماء في جوفك. السفينة تعوم على الماء لكن إن بدأ الماء يدخل السفينة تغرق السفينة ومن فيها.
أقول في موضوع الربط ما بين قصص سورة الكهف. في قصة فتية الكهف هناك هجرة من الوطن، ترك للديار من أجل الفرار بالدين، بالعقيدة. (إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20)). قصة موسى والعبد الصالح عليهما السلام فيها هجرة من الديار والأوطان ولو مؤقتة طلباً للعلم. قصة ذي القرنين طاف مشارق الأرض ومغاربها ترك الديار للجهاد في سبيل الله. هناك تدرج منهجي صاعد والغايات صاعدة، فتية الكهف فرار بالدين، موسى والعبد الصالح هجرة لطلب العلم وذي القرنين هجرة للجهاد في سبيل الله، الذروة والسنام والأعلى من بين الثلاثة.
نبتدئ في تفسير السورة
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا) الحمد لله كأن كل ربع من القرآن مفتتح بالحمد: الربع الأول مفتتح بالفاتحة، الربع الثاني الأنعام، الربع الثالث الكهف، الربع الرابع سبأ وفاطر تباعاً كأن القرآن مقسم أربعة أرباع كل ربع مفتتح بالحمد.
النصف الأول من القرآن ليس فيه سورة مفتتحة بـ (سبحان) يبتدئ (سبحان) من النصف الثاني (سبحان الذي أسرى بعبده) إلى الجزء الثلاثين (سبح اسم ربك الأعلى) ولله حكمة في ترتيب قرآنه.
(الحمد لله) كلمة جامعة وهي جملة خبرية تخبرك أن الحمد لله (مبتدأ وخبر) الحمد كائن لله عز وجل لكن في ظل هذه الجملة الخبرية طلب وانشاء أي اِحمد ربك أيها الإنسان طالما أن الحمد والثناء العاطر الجليل على الله المنعم بالجزيل ينبغي أن تحمده. كل ما وعيت آلآء الله عليك زدت له حمداً. والذي لا يستحضر نعمة الله كيف يحمَد؟ إذا تذكرت نعمة البصر وتعرف كيف يعمل البصر، نعمة السمع والسمع هذا المعجزة الهائلة، أذن داخلية وأذن خارجية ووسطى وأعصاب سمع وسندان ومطرقة وسائل ينقل الأصوات وذبذبات تترجم إلى أصوات في خلال جزء بسيط من الثانية! إذا سمعت صوت بوق سيارة خلفك تتحرك مباشرة لكن لو استغرق وصول الإشارة إلى الدماغ دقيقة مثلاً لتحللها تكون السيارة دهستك!
الحمد لله، نحمده على أجزل النعم وأعظم النعم نعمة إنزال الكتاب على عبده. ودلالة استخدام (عبده) لأن أعلى مقامات المخايق جميعاً العبودية لله كما في سورة الإسراء ( بعبده ) وقد ارتقى المصطفى مرتقى لم يرتقه أحد من قبل ولا من بعد ومع هذا قال (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) حتى يؤكد أنه مهما ارتقى العبد يظل في مقام العبودية.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ) أنزل فيها إشعار بعلو المنزِل وعظمة قدر المنزَل وجلالة شأن المنزَل عليه هي عظمة على عظمة، عظمة المنزِل، عظمة المنزَل، عظمة المنزَل عليه، عظمة الرسول الواسطة بين الله والرسول والشعب الذي سيحمل هذه الرسالة، إذن عظمة على عظمة في المطلق، هذا كتاب عظيم ومعانيه جليلة.
الحلقة الخامسة
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ) (على) فيها معنى العلو المطلق وفيها عظمة من أُنزِل عليه القرآن وفيها التكليف والإنزال (على عبده) إلزام من الله عز وجل ذي الجلال لعبده أن يا عبد اِحمل هذه الرسالة ووصِّل وبلِّغ هذه الرسالة أعظم مهمة يمكن أن تحملها أكتاف بشر “أمانة الدعوة”. الناس في حالة من الضيق ومن الغرق والمعاناة والبؤس يحتاجون إلى علاج سريع الخلود في جهنم مصيبة المصائب، من ينقذ الناس من الخلود في جهنم إن لم تنبري أمة محمد صلى الله عليه وسلم لاستنقاذ الناس. كلمة (على) فيها اِنزال واستعلاء. (الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ) إضافة العبد إلى السيد المطلق تشريف، نسبه إلى نفسه.
(الكتاب) حرف إلى حرف كلمة، كلمة إلى كلمة جملة، جملة إلى جملة آية، آية إلى آية سورة، سورة إلى سورة، الكتِب بمعنى الضمّ ومنه الكتيبة. جندي إلى جندي صاروا حظيرة، حظيرة إلى حظيرة صاروا سريّة، سرية إلى سرية صاروا كتيبة. إذن معنى الكتب الضم والتأليف. (أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ) هذا الكتاب العظيم الجليل، سورة الإسراء ركّزت على القرآن، سورة الكهف ركّزت على الكتاب إذن هو محفوظ في الغيب فيُقرأ فهو قرآن ولكنه مسطور أيضاً فهو محفوظ بالكتابه فالتقت وسيلتا الحفظ: القرآءة عن ظهر قلب مصاحفنا في صدورنا إن شاء الله ومصاحفنا محفوظة في سطورنا إن شاء الله تعالى.
(الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ) ما معنى الكتاب؟ هل القصد هذه السورة أو ما نزل حتى هذه السورة أو ما نزل وما سينزل؟ أقول (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ) باعتبار ما سيؤول إليه أمر التنزيل أن سيكتمل هذا الدين وسيكتمل نزول هذا الكتاب وسيظهر هذا الدين بأمر مولانا الملك الحق المبين سبحانه وقد حصل. إذن (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ) باعتبار اكتمال النزول، القرآن يتكلم عما سيكون أن سيكتمل نزوله. هذه السورة في ترتيب النزول يمكن أن تكون في وسط النزول فهي من حيث العدد أوسط ما نزل، تتكلم عن الكتاب باعتبار تمامه وكماله.
(وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا) العوج ضد الاستقامة، انحراف عن سواء السبيل عن الصراط السوي. (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ) هل (له) بمعنى (فيه)؟ بعض العلماء يقول أن حروف الجر تنوب بعضها عن بعض لكن القرآن لما قال (لم يجعل له) يقصد هذا الحرف للجر بالذات، كأن العوج لن يجد سبيلاً لهذا الكتاب وأنّى يجد العوج سبيلاً لهذا الكتاب وهو محمي محروس. لو قال يجعل فيه عوج ينفي أن يكون العوج في داخله. (له) أبلغ لأن العوج لن يجد له طريقاً يسلك بها إلى الكتاب فكيف يكون فيه عوج والطريق لبلوغ العوج لهذا الكتاب مسدودة ومستحيلة. إذن (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا) أبلغ في النفس من (يجعل فيه). العوج المتعرج كثير التعاريج، نفى عنه العوج ثم أثبت له الاستقامة (قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا) قيّماً من الاستقامة وقيّماً من القوامة (ابن القيّم كان والده قيّماً ناظر مدرسة فسمي ابن القيم). هذا الكتاب مهيمن وقيّم على كل الكتب. إذن (قَيِّمًا) مستقيماً تأكيد لنفي العوج (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا) نفى عنه العوج ثم أثبت له الاستقامة (قَيِّمًا) لأن نفي العوج بحد ذاته نفينا السلب لكن لا بد أن نثبت الإيجاب، نفى العوج وأثبت الاستقامة وأثبت مع الاستقامة القوامة والهيمنة لهذا الكتاب على سائر الكتب. إذن وصف الكتاب، امتنّ بهذا الكتاب على الرسول، أُنزل كنز على هذا الرسول ألا وهو القرآن فيا أيها المناوؤن هل تناوؤن نبيي وتجادلونه وتعرقلون سبيله صلى الله عليه وسلم وأنا أمتن عليه بأني أنزلت عليه أعظم كتبي وخاتم رسالاتي؟!! فليكن موقفكم من هذا الكتاب ما يكون فهذا الكتاب قيم على الوجود كله ومستقيم لا عوج له.
لِمَ كان نزول هذا الكتاب؟ (لينذر) لام التعليل هذا القرآن العظيم ينذر الناس أنه إن لم يتّبعوا هذا الكتاب يوشك أن يصيبهم البأساء واللأواء والضراء والبلاء وينزل عليهم من السماء ما لم يكونوا يحتسبون من أنواع العقاب. (لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ) من عنده سبحانه. الكتاب من عنده فمن لم يحترم الكتاب الذي أُنزل من عنده يتوقع أن يأتيه من عنده سبحانه بأس شديد في الدنيا وباس شديد واشد مطلقاً في الآخرة. لكن على طريقة القرآن في كفتي ميزان لا بد أن يكون كل شيء متوازن والكفتين متعادلتين، ذكر البأس الشديد فلا بد أن يبشر (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا). (قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ) هذا المنذَر به فأين المنذَر؟ المنذَر محذوف. (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ) المبشَّر موجود والمبشّر به موجود. (لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ) أنذرهم البأس الشديد من لدنه، من هم؟ الكافرون لكن لم يذكرهم. (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ) لا بد للإيمان من أن يكون مقترناً مع العمل الصالح، شجرة لا بد أن تطرح ثمراً، شجرة من غير ثمر يكون فيها عيب. إيمان بلا عمل فيه خلل، لا بد تلقائياً أن الإيمان يخرج وينبت ويفرز العمل الصالح فالإيمان والعمل الصالح قرينان لا ينفكان لا يفترقان بل هما دائماً يلتقيان. (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا) أجرا حسناً وإذا كان رب الوجود يقول عن هذا أجر حسن فسيكون شيء هائل جداً وعظيم جداً لأنه ملك الكون العظيم لا يقول عن شيء حسن وعظيم إلا إذا كان عظيماً جداً. إذا قال لك بليونير اليوم ربحنا من فضل الله مبلغ وافر، ماذا تتوقع؟ يكون ربحه بالملايين! هذا بشر فكيف برب البشر! إذا قال (أَجْرًا حَسَنًا) لك أن تتصور أن الحسن في هذا الأجر هائل عظيم جزل مطلق (أَجْرًا حَسَنًا). وأعظم من مجرد هذا الأجر ديمومة هذا الأجر (مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا) أعظم النعيم خلود النعيم وأجزل أوجه هذا النعيم البقاء في هذا النعيم لأنه مهما كان النعيم إن كان له أمد أو نهاية سيكون منغّصاً وستحسب حساب هذه النهاية. رزقنا الله وإياكم النعيم المقيم
الحلقة السادسة
هذا الكتاب من شأنه أن ينذر وأن يبشر وقد النذارة على البشرة لأن السياق يقتضي ذلك فالكلام عن المناوئين للرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم نعيم للمؤمنين الخلود فيه (مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3)). ثم أعاد الإنذار مرة ثانية، الإنذار أخبار ربما لا يستريح لها المرء تتعلق بالمستقبل مبنية هذه النذارة على أعمال يمكن يعملها الإنسان أو تقصير عن أعمال قصّر فيها الإنسان، إذا لم تعمل بما هو مطلوب منك وإذا عملت بنقيض المطلوب منك إذن توقّع أخباراً سيئة تأتيك، هذا معنى الإنذار، فالنذارة هي خبر يضر أو يسوء بناء على عمل سيء أو ترك عمل صالح أوجب عليك أو نُدبت إليه. التبشير عكس ذلك وهو خبر يظهر أثره على البشرة ارتياحاً فرحاً سروراً.
(وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) ينذرهم بماذا؟ في الإنذار السابق (لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ) ذكر المنذر به ولم يذكر المنذَر وهنا ذكر المنذَر ولم يذكر المنذر به اعتماداً علىما مرّ فكأنما الآيتين متكاملتان. (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) ترك الإنذار مفتوحاً ولم يذكر ينذرهم بماذا لأنه قال في السابقة (لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ).
(مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ) جاء بالإنذار مرة ثانية ليذكر حكاية اتخاذ الولد لله عز وجل ثم ينقض هذا الاتخاذ، ما الحاجة إلى الولد؟ أولاً هذا افتئات على الله واعتقاد فاسد باطل ما أنزل الله به في كتاب من كتبه من سلطان، يستحيل أن يكون في الكتب التي أنزلها الله تعالى أن يكون لله ولد. نحن نحتاج للولد لأننا نكبر ونموت والولد يكمل المسيرة ويرث الأموال إن وجدت. الله سبحانه يرث كل شيء ولا يرثه أحد ولا شيء، فالله سبحانه هو القوي لا يموت ولا يغفل ولا ينام فما الحاجة إلى الولد؟!
هؤلاء الذين قالوا (اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) يفترون على الكذب ويزعمون لله النقص وتعالى سبحانه عن كل نقص واتصف سبحانه بكل صفات الكمال الجلال والجمال. (مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ) إما علم واقعي تراه أو شيء تجده في كتاب سماوي أنزله الله تعالى، هذه مصادر العلم. هذا عالم الغيب هل رأيته يا من زعمت أن لله ولدا؟! طبعاً لا، قرأته في كتاب من كتب الله المنزلة من عند الله والمحفوظة لا التي لعبت بها الأيدي والتزوير؟! لا، إذن (مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ) الآباء اخترعوا والأبناء توارثوا ما اخترع الآباء وسرت الفرية جيلاً فجيلاً ومع الوقت تجذرت في العقول فكل قوم يزعمون أحداً ممن يرونه ولداً لله (قالت اليهود عزير ابن الله) (قالت النصارى المسيح ابن الله) وقال غيرهم شيئاً غير هذا الكلام، وهذا كله افتراء وكذب. البشر بطبيعتهم يعظّمون من يحبون فإذا أحبوا بالغوا، إذن يدّعون أن في هذا المحبوب صفة من صفات الله تعالى الله. ولذلك رب العالمين يصف رسوله بأنه عبد حتى نفهم أن كل العباد بالغاً ما بلغت مرتبهم عند الله يظلون في مقام العبودية صحيح هم أعلى العباد لكنهم ضمن إطار العبودية لا يخرج عن إطار العبودية أحد بالمطلق. إذن (مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ) كلام تتشدق به الأفواه ليس له مصداقية ليس له جذر لا في القلب ولا في العقل ولا في الكون ولا في الكتب السماوية إنما تلقفه الألسن قولاً عن قولاً (تلقونه بالسنتكم) كلمة خرجت من أفواههم ثم أصبحت عقيدة تعتقد وملة يتبعها مئات ملايين من الناس وما هي إلا افتراء باطل (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ) كانوا يقولون الملائكة بنات الله، من أين جاؤوا بهذا الكلام؟ هم يريدون أن يكسروا عقيدة التوحيد فإن كسرت عقيدة التوحيد انهار كل شيء وأصبحوا هم آلهة مع الله – تعالى الله – هذا في عقول بعض العوام والغوغاء، باب البنوة مقفل مطلقاً يستحيل على الله (أنى يكون له ولد ولم يكن له صاحبة). هذا من أبطل الباطل وأفسد العقائد أن يدّعي أحد لله تعالى ولداً (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا) (إن) بمعنى (ما) حرف نفي، أي ما يقولون إلا كذباً، ليسوا يقولون شيئاً يتعلق بهذه المسألة إلا كذباً.
(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم (فلعلك) يا رسول الله هل تراك تقتل نفسك ذبحاً (باخع نفسك) تبكي على آثارهم لأنهم لم يؤمنوا؟ أسفاً حزناً عليهم، تقتل نفسك حزناً عليهم أن لم يؤمنوا ؟! دعهم، أنت عليك البلاغ وليس مطلوباً منك أن تحزن إلى درجة ازهاق نفسك وإذهاب روحك حزناً عليهم. هذا من شدة شفقته ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الرحمة المهداة. أحرص من الأم على ابنها، شدة حزن النبي يكاد الغم يقتله فربنا ينهاه عن الاغتمام، اهتم ولكن لا تغتم إلى هذه الدرجة ولهذا الحد (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا) زينة نضعها يوم يومين ثلاثة ثم تنتهي، الدنيا كلها زينة، في أوجها حلوة ثم تصبح عبئاً. (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ) ما على الأرض كله (زينة) كم ستدوم الزينة؟! تصبح مشوهة جداً. (زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) نختبرهم أيهم أحسن عملاً، المفروض أن نتسابق في مرضاة الله، أن نتنافس في طاعة الله، نُخرج أحسن ما عندنا لمرضاة الله سبحانه وتعالى.
الحلقة التاسعة
مشهد دعاء فتية الكهف، بعد دعائهم اعتراض منهم على قومهم يقولون (هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً(15)) (هؤلاء) اسم إشارة مع أن المشار إليه غير موجود، هذه إضاءة، أحياناً أشير إلى موجود وأحياناً أشير إلى معهود وإن كان غير موجود. هؤلاء قومهم لهم في الذهن حضور وأذاهم للفتية حاضر فقال (هؤلاء قومنا) يقولونها بمرارة وألم لأن ظلم ذوي القربى مؤلم خاصة إن حاربوك في دينك فيكون الألم مضاعف أضعافاً كثيرة. (هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً(15)) أي من دون الله عز وجل (آلهة) للتكثير، آلهة كثيرة، كل قبيلة من قبائل العرب كان لها إلهاً، العقلية الشركية والكفرية عند الناس عقلية واحدة، مبدأ واحد، ومن العرب من كان يتخذ إلهاً فإذا جاع أكله، وبعض الناس الآن يتخذ مصالح وبعدما ينتهي من مصالحه يأكلها بعضهم يتاجر بالوطن وبعدما ينتهي من المتاجرة بالوطن يأكله! آلهة تُعبد من دون الله ثم تؤكل. (هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا) لولا هنا بمعنى (هلّا) غير (لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ(24) يوسف) لولا هنا حرف امتناع لوجود. بينما في آية سورة الكهف بمعنى (هلّا) مثل (فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ(116) هود) يا بني لولا درست. (لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ) منهجية الفكر والعلم والنظر منهجية هذا العقل خطير جداً إما أن يزلك ويضلك وإما أن يقودك إلى الله سبحانه، العقل نفسه إما أن تستخدمه في المكر والدسّ والوقيعة والشر والعربدة في الأرض وإما تستخدمه في إدخال النور والعقل إلى الناس، العقل هو العقل لكن توظيفه توظيفاً خاطئاً أو توظيفه توظيفاً إيجابياً. تعلّمنا السورة بطريقة مباشرة وغير مباشرة بدلالة النص وبإشارة النص تعلمنا قيماً كثيرة جداً من ضمنها كيف نرشّد هذا العقل، لا تقل قضية إلا وعليها برهان.
(لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ) دليل واضح، (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) جعلوا نهاية الكلام صياغة بشكل قانون عام (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) الجواب لا أحد. أقصد قومنا الذين افتروا على الله كذباً وزعموا أن له أنداداً وشركاء وآلهة أخرى معه، من أظلم ممن افترى مثل هذه الفرية على الله عز وجل؟ الجواب لا أحد (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) كلام فتية الكهف متواصل (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ) إذ ملازمة في العرض القرآني القصصي في أثناء هذه المشاهد والعروض القصصية. (اعتزلتموهم) اعتزلوا قومهم – وليسوا من المعتزلة – سمي المعتزلة بهذا الاسم لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري من أكبر التابعين والخاسر من اعتزل مجلس الحسن البصري. الفتية اعتزلوا قومهم اي أخذوا لنفسهم منهجاً غير منهج قومهم وطريقة حياة غير طريقة قومهم. (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ) التحوّط في الكلام، اعتزلوا عبادة قومهم إلا عبادة الله على فرض أنه قد يكون أحدهم يعبد الله عز وجل احتياطاً (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ) هم لم يعتزلوا عبادة الله ولم يعتزلوا من يعبد الله، نعتزل كل عبادة سوى عبادة الله ونعتزل كل من يعبد سوى الله عز وجل. (فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ) إذا اعتزلتموهم انحازوا إلى هذا الكهف واجعله مأوى لكم مأوى مؤقتاً ويشاء الله عز وجل أن يناموا ثلاثمائة وتسع سنين، دخلوا مأوى مؤقتاً فمرت أجيال وراء أجيال وهم ممددين في الكهف لا يشعرون بالزمن. (فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا) قبل آية ذكرت الرحمة، أنت أيها العبد في رحمة الله عز وجل فلا تخرج من رحمة الله، دعك في رحمة الله عز وجل دنيا وآخرة. (يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا) نقول مرافق البيت أي ما يُنتفع به من جوانب البيت وأجزاء البيت وتجهيزات البيت، نسميه مرافق (مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا) تنتفعون به تقضون حوائجكم به.
الآن مشهد جديد (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لكل مخاطب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب عام لكن أول المخاطبين سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ) طريقة السرد الطبيعي المألوف بالنسبة لنا لكن منهج القرآن في العرض والسرد غير منهجنا نحن، (وترى الشمس) جعلك جزءاً من القصة، كأنك مشارك في أحداث القصة وكأنما اسقط فاصل الزمان والمكان الذي يحجبك ويحجب القصة عنك (وترى الشمس) فصرت تعاين ما يُقصّ عليك. ورحم الله من قال القصص القرآني يقع في القلب عن طريق العين قبل أن يصل القلب عن طريق الأذن كأنما تشاهد قصة مصورة ولا تسمع حكاية مروية.
(وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ) هل هو الكهف الذي في جنوب عمان أو الكهف الذي في سوريا أو الكهف الذي في تركيا؟ كل هذا لا يعنينا ولا يعني منهج القصة القرآنية وهذا لا يعني أننا لا نبحث ولا ندرس ولا نأتي بخبراء آثار ويدرسوا الكهوف ويرجّحوا أي كهف هو، لا مشكلة لدينا في الدرس والبحث فلينشط الباحثون والدارسون لكن لا ينبني شيء على كون القصة وقعت هنا أو هنالك ولا يعول عليه كبير تعويل وليس من مقاصد القصة الرئيسية أن يقول لك موضعهم في كيت وكيت من الأماكن.
(وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ) الشمس نورها يصل إلى الكهف، يستفيد النائمون من شعاعها ولا تؤذيهم بمباشرتها لهم، فهي مائلة عنهم إذا طلعت جهة اليمين وإذا غربت مائلة عنهم تقرضهم يقع شعاعها منكسراً لا مباشراً لأن الجسم يحتاج للأشعة ففائدها تصلهم وأذاها محجوب غير واصل لهم.
(وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا(17)) الرشد مر بنا سابقاً والآن مر ثانية وسيمر بعد هذه الآية.
الحلقة 13
(سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ(22)) وقفنا عند اختلاف العالم قديماً وحديثاً في عددهم (سيقولون) متواصل مستمر إلى ما لا نهاية (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ) هناك اجماع على وجود الكلب، وكل الأقوال وتر ثلاثة خمسة سبعة، في الذهن بقايا أطلال من المعلومة، كانوا وتراً ثلاثة؟ خمسة؟ سبعة؟ إجماع على أنهم كانوا وتراً في العدد وإجماع أن معهم كلب. ما الحقيقة؟ ربنا وصف المعلومات (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) قال عنها رجماً بالغيب بينما ميّز القول الأخير (وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) هذا القول هو الحقيقة لأنه لم يوصف بأنه رجم بالغيب وثانياً ميّزه بالواو قالوا هذه واو الثمانية، القرآن مليء بأشياء ما كان سبعة وما بعدها تأتي بالواو (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا(73) الزمر) أبواب الجنة (سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا(7) الحاقة) وضربوا شواهد من هذا القبيل لكنه هذا الكلام مع أنه على الرأس والعين لكني لا أعتقد إلا ما أراه ثابتاً منطبقاً على اللغة والسياق. هذا القول هو الحقيقة وهناك مراعاة شديدة للأدب طبعاً (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) كأنهم جعلوا الفتية والكلب على قدم المساواة. لو قلت لأحدهم أتشرب الشاي؟ فأجاب لا وجزاك الله خيراً، هذه الواو واو الأدب وليست واو الثمانية. إذن المؤمن عنده الحقيقة وعنده الأدب في عرض الحقيقة. (سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) فصل ما بين الفتية والكلب بالواو.
(قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ) هذه الآية لتدل على أن العدد ليس هو عمود القصة ولا العبرة من القصة ولا عقدة القصة وإنما عبرة القصة القدرة على البعث، هذه الآية المعجزة في إيقاظ هؤلاء الفتية من نومهم الطويل. (مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ) قليل من الناس وهم نحن المسلمون المؤمنون بهذا الكتاب المبين نعلم عدهم ولكن ليست هذه الفحوى الأساسية للقصة.
(فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا) لا تجادل فيهم إلا بمقدار ما يتعلق بالعظة بالعبرة بالخط الأساسي من القصة، دعك من أسمائهم وأعمارهم وملكهم والمدينة التي هم فيها. (فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا) نحن نبني على قصة من الكتاب فلا ينبغي أن نزيد ما ليس فيها.
(وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا) هذا النص في وجه الذين لا يزالون يعتنقون ما ورد في الإسرائيليات نقول لهم (وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا) مطلقاً. (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا(23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا) الرشد مرة أخرى، مرشد، رشداً يتكرر في السورة، إذن من خطوط السورة الرئيسية موضوع الرشد. أمة الرشد والخلفاء خلفاء راشدين. فهم الناس القصة في ضوء الرواية التي ذكرناها عن سبب نزول الآية وقلنا أن النص لا يثبت وأن الآية توجيه مطلق بقطع النظر عن هذه الرواية فلا تضيق فهمك ولا تأسره على هذه الرواية. (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ) لم ترد كلمة (لشيء) في القرآن بالألف وعليها دائرة سكون إشارة إلى حرف لا يُنطق مثل (مائة) تكتب بالألف ولكنها تلفظ بدون ألف (مئة) تكتب بالألف فوقها سكون يعني لا تُلفَظ. شيء وإن كتبت بالألف (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ) لم ترد في القرآن بهذا الرسم إلا في هذه الآية وليست خطأ من الذين كتبوا الآيات. (شيء) هنا مقصود أن تكون متميزة عن كل شيء في القرآن. (ولا تقولن لشيء) شيء مطلق وشيء أعمّ شيء في الوجود لأن كل شيء في الوجود يصلح أن يكون شيئاً (قل أي شيء).
(وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا) خطط ورتب يومك وضع برنامجاً وأولويات لكن لو أصبحت مريضاً يضيع برنامجك الذي وضعته لكن إياكم أن تفهم أن هذا الدين ضد التخطيط، معاذ الله! بل رتّب وخطط وضع برنامجك ساعة بساعة دقيقة دقيقة، هذا عين المطلوب لكن لا تقل أنا سافعل هذا غداً، بل قل (إن شاء الله) إن بقينا على قيد الحياة، إن لم يداهمنا مرض، إن لم يداهمنا مشاغل تمنعنا من تنفيذ البرنامج(إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ).
(وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) كيف؟ إذا نسيت فاذكر ربك، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله وتربط كل أمر بمشيئة الله، الغرب يأخذون علينا كثرة ترديدنا لكلمة (إن شاء الله) والغلط ليس في الكلمة نفسها وإنما نحن فهمناها غلط وطبقناها غلط ونفّرنا الناس منها لأنه يُفهم منها أننا لا نريد أن نفعل الشيء، وهذه إساءة لديننا، بل نقول إن شاء الله إن لم يحل حائل قسري بيني وبين هذا الشيء سأنفّذه إن شاء الله، هكذا معناها. لا تعد أحداً بشيء إلا أن يشاء الله.
إذا نسيت أن تقول إن شاء الله وذكرت قل إن شاء الله، أو إذا نسيت شيئاً استعن على استحضارة بذكر الله أو إذا نسيت الذكر في لحظة من اللحظات استأنف، استمر على الذكر، قلب وذكر لسان إياك أن يغيب الذكر والذُكر أن تكون على ذُكر أي على حضور عقلي في بؤرة التركيز استحضار عظمة الله وجلالة الله وارتباطك بالله عز وجل (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا) أنت على الرشد لكن اِسعى دائماً أن تكون أقرب إلى الرَشَد الكامل إن شاء الله تعالى.
الحلقة 14
توقفنا عند مدة لبث الفتية في الكهف. لو عددنا من أول القصة (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ) إلى (ولبثوا في كهفهم) 309 كلمات بالضبط، هذا قرآن معجز من كل وجه، معجز بالمطلق (أعظم أوجه الإعجاز أن لا تتناهى أوجه الإعجاز – بنت الشاطئ). (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا(25)) هي مقصودة بهذا الترتيب (ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا) هم يحسبوا بحسابهم الشمسي ثلاثمائة سنة تقويم جوستينيان الروماني كل مائة سنة تفرق ثلاث سنوات في حسابنا إذن ازدادوا تسعاً. (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا(26)) ثلاثمائة وتسع سنين لكن دوماً نفوض العلم إلى الله. (لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ) السمع يسبق في قرآننا البصر بالنسبة لنا البشر وبالنسبة لله لا يفوت سمعه ولا بصره ولا احاطته شيء على الإطلاق (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) كلمة (ولي) تكررت في السورة الكريمة لترسيخها في الذهن (الولاية لله الحق) (الولي) موضوع الولاية لله عز وجر نقّ ولاءك لله لأنه ناصرنا سبحانه. الولي الحقيقي والناصر الحقيقي الذي ينقذك من النار هو الله. (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) لا يحتاج للشريك. هل تقبل أنت شريكاً في مزرعتك؟ في بيتك؟ فكيف تقبل لله شريكاً؟! الشرك أخبث فكرة تفسد الكينونة والمعتقد والفكر والأخلاق وعلاقات الناس لذا حرّم ربنا الشرك وجعله أظلم الظلم.
(وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ) اتلُ نقول جاء عمر تلو أبو بكر، تلاوة يعني اقرأ آية فآية وسورة فسورة. (لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا) كلماته في القرآن لا تتبدل، كلماته في قدره لا تتبدل. هذا الكتاب يتحدى الكون أن كلمة ترفع أو تزاد أو تؤخر أو تقدم، لا حرف يزيد ولا حرف ينقص، إذا قبل زيادة حرف قبل زيادة ألف، إذا انكسر المبدأ خربت الدنيا. كتابك غير قابل لزيادة حرف ولا نقص حرف. ما قبل الزيادة أو النقص يعني أنه غير محفوظ. النسخة التي كان يقرأ بها عثمان بن عفان لا زالت موجودة لو طابقناها على هذا الكتاب سنجدها منطبقة حرفاً حرفاً ولله الفضل والمنة.
(لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا) ملاذ، ناصر، ملجأ، لا أحد لنا سوى الله عز وجل
(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ) توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة النبي من بعده. (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ(28)) أول النهار وآخره كناية عن أنهم يدعون ربهم طيلة النهار، في الصلاة، في الدعاء، دعوة إلى الله، يدعون ربهم أن يسيروا على منهج الله. (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ) احبس نفسك مع أهل الدين، مع أهل التقى مع أهل الدعوة إلى الله عز وجل مع من يحملون كلمة الله منهج الله يبلّغونه في الأرض اربط مصيرك بهم فإنهم المؤتمنون على دنياك وآخرتك لكن لا تأمن لمن سواهم. الشيطان قد يزين لك اصحاب المال والحظوة والسمعة، إياك (وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ) لا تلتفت إلى سواهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم مع أهل الصفّة إذا سمعوا نداء للجهاد لبّوا مباشرة، الصفّة دِكة في المسجد يأكلون ويشربون ما تيسر والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يرابط معهم. (وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) حاشاه ولكنه تأديباً لنا من خلال مخاطبته صلى الله عليه وسلم (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا) قلبه غافل بعض الناس لا يخطر بباله الله ولا الآخرة إطلاقاً. الموت مصير كل حيّ ودفن الرأس في الرمل لا ينجي من الموت فاعمل لما بعد الموت.
(وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) مسبحة انفرطت فتناثرت حباتها في كل أرجاء البيت أمره مفروط مثل المسبحة انقطع خيطها.
الحلقة 15
توقفنا عند قوله تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ(29)) يا حامل الحق قل هذا هو الحق أيها الناس من ربكم الذي يربيكم (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) الكلام قد يحمل معاني وأحياناً الكلمة نفسها تحمل معاني متناقضة ومتضاربة فلا نفهم الكلام خطأ. (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) ليست هذه دعوة لمقاطعة الناس، هذا الفهم ليس مراداً بالإطلاق لكن أيها الناس أنا أعرض عليكم الحق وأنت بالخيار تختارون أو لا تختارون لا إكراه في الدين لا نُكره أن يكونوا مؤمنين أو مسلمين إنما مهمتنا أن نعرض الحق ثم أنت تختار ما يروقك ولن تجد أصفى مورداً ومشرباً من هذا الحق فعلينا أن نُحسن عرض هذا الحق بالرفق الكامل وليس بالفظاظة. نعامل الناس بالحسنى واللطف والرفق هذا حق ينبغي أن يُعرض بما يليق به من الجمال والجلال ومن كمال الأسلوب وليس من الغلظة والخشونة والفظاظة، ليس بالضرورة أنه إذا كان الحق عندي أن أستعلي على الناس! سبل الشيطان على رأس كل سبيل يزينوا للناس أن يدخلوا في تلك المتاهات والسبل والنفس تأبى الشيء الثقيل فلا تعن الشيطان على الناس ولكن أعن الناس بحسن الأسلوب على الشيطان والحق مرّ. الدواء فيه شفاء ولكن فيه بعض مرار نحتال على الطفل حتى يتجرعه. “قل الحق ولو كان مُرّاً” كما قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. حتى نوصل هذا الحق المر والثقيل في بعض الأحيان لا بد أن يكون مع هذا الحق حسن أسلوب وحسن تأتي وحسن مدخل إلى قلوب الناس (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ) الدين اختيار وليس اجبار (وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) لا تعني أنك حر وليس عليك مسؤولية! أنت تختار وتتحمل مسؤولية اختيارك وهذا منتهى كرامة الإنسان، أترك لك حرية الاختيار لكن تتحمل المسؤولية والقرار.
(إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) أسات الاختيار عليك أن تنتظر الجزاء وهو النار. إذن اعتبر من اساء الاختيار ظالم لنفسه ظالم للحقيقة ظالم للبشرية الأرض الآن تعاني من وطأة ظلم ثقيل وظلمات بعضها فوق بعض يزيحها حملة الحق الذين هم متقاعسين عن الحق وغير فاهمين له ولا فاهمين ما رسالتنا؟ رسالتنا انقاذ البشرية نحن المسلمون، أن تنطلقوا في الأرض حملة الحق تنقذوا الناس من الظلم. الحضارة اليوم أُسّها الظلم. (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا) الظلم ثمرة شركية لمعتقد شِركي خبيث. الشرك سيحمل ظلماً (إن الشرك لظلم عظيم). (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا) مهولة جداً، جاءت نكرة. (سرادقها) سرادق خيمة كبيرة النار كأن لها سرادق ضخم أينما توجهت ستجد السرادق. يا أيها الظالم السرادق محيط بكل النازلين فيه (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ) عطشانين يريدون الشرب فيصبوا عليهم ماء يشوي وجوههم من شدة حرارته (كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) بئس الشراب شراباً وساء المرتفق مرتفقاً.
في المقابل يعطي القرآن الشيء ومقابله، ذكر النار يذكر بعدها الجنة، (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا(30)) إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً، قلنا السورة في البداية (أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا(2) الملك) (أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا) أفعل التفضيل مكررة في هذه السورة. (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) كما نسعى في الدنيا أن نحسّن من دنيانا لماذا لا نحسّن في الدين ولا نحسّن في درجاتنا عند الله فنكون كل يوم أحسن حتى نلقى الله فنحاسب على أحسن ما عملنا ويتجاوز عن أسوأ ما عملنا.
(جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ(31)) هذا الموضع الوحيد الذي فيه (مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ) (يُحَلَّوْنَ فِيهَا) ما كان محرما عليهم أساور الذهب، الدنيا دار التقشف والزهد وهناك دار النعيم. (وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) يقولون هذه كلمات أعجمية، كل ما جاء في القرآن كلمات عربية. (مُتَّكِئِينَ فِيهَا) على المتكآت جلسة الراحة (نِعْمَ الثَّوَابُ) نعم الثواب ثواباً وونعم المرتفق مرتفقاً، هذا نعيم أهل الجنة في الجنة مقابل عذاب أهل النار في النار.
نقف على قصة جدية هي قصة المثل، هي قصة أو مثل؟ هي قصة لكن لتكررها في الواقع كأنما هي مثل يتردد على مر الزمان.
آية وتفسير – 87
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
مدارسة سورة الكهف
(هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾)
بعد أن حكى الله عز وجلّ قولهم وإعلانهم بالتوحيد ذكر حديثًا آخر دار بينهم (هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾)
انظر إلى قولهم (هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا) أي أهلنا وعشيرتنا تربطنا بهم صلة النسبة والجوار والقربى وهذه الصلات توجب علينا أن نجتهد في دعوتهم وإرشادهم وهدايتهم وبيان الحق لهم.
وفي قولهم (هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا) كذلك إشارة أنهم وإن كانوا أكبر منا سنا وأكثر تجربة قد أشركوا مع الله غيره فهلّا أتوا بحجّة بينة على صدق ما يقولون كما أتينا بأدلة بينة على صدق ما قلناه بالأدلة الظاهرة!
(هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً) أي اخترعوا سوى الله عز وجلّ اتخذوها آلهة فهي ليست بآلهة في الحقيقة فإنها لا تخلق ولا ترزق لا تنفع ولا تضر ولكن الشيطان سوّل لهم ويّن لهم ذلك الباطل والدليل على ذلك أنه ليس عندهم برهان على استحقاق هؤلاء الآلهة المزعومة للألوهية ولذا قال أولئك الفتية المؤمنون (لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ) أي هلّا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحًا صحيحًا. ما أجمل هذا التدرج، فإن لم يأتوا بذلك الدليل الواضح على صحة قولهم فذلك برهان على أنهم قد أقاموا اعتقادهم على الكذب والخطأ وعلى اتباع الشيطان، وهم يعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بدليل على صحة كفرهم وشركهم وإنما هو طلب لتعجيزهم وإظهار بطلان ما هم عليه لأنه لا يقدر لأحد أن يأتي ببرهان بين على جواز عبادة غير الله تعالى.
في القرآن آيات أخرى ورد فيها مثل هذا الطلب التعجيزي من المشركين منها:
(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) الأنعام)
وقوله سبحانه (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (4) الأحقاف)
وإن لم يأتوا ببرهان بيّن على عبادتهم غير الله تعالى فإنهم سيكونون حينئذ ظالمين كاذبين (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء أنه له شريك له في عبادته فإن ذلك أعظم الظلم (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (32) الزمر) وقال سبحانه (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان: 13].
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه يا ذا الجلال والإكرام
في رحاب سورة
د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1436 هـ
الحلقة 3 – في رحاب سورة الكهف
تقديم الإعلامي محمد خلف
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
يعرض مساء الأحد الساعة 9 ليلا بتوقيت مكة المكرمة ويعاد الإثنين الساعة 11.30 ظهرًا.
مميزات السورة
المسلمون يقرأون سورة الكهف باستمرار طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم “من قرأ الأوائل من سورة الكهف…” الحديث فيه ثلاث روايات بلفظ: الأوائل، الأواخر أو اي عشر آيات.
قرآءة السورة سنة ثابتة، لماذا سورة الكهف بالذات ولماذا قرآءتها يوم الجمعة بالذات؟ القرآن كله عظيم إلا أن سورة الكهف لها ميزة خاصة من بين سور القرآن وميزتها الكبرى أنها جمعت قصصا لم يرد في القرآن كله ولم تكرر وما ورد من قصة موسى عليه السلام مثلا في سورة الكهف لم يرد في سورة أخرى. ومن مميزات القصص التي وردت في سورة الكهف أنها غريبة تتميز بالغرابة، قصة أهل الكهف، قصة صاحب الجنتين مع صاحبه فيها شيء من الغرابة ولم تتكرر، قصة ذي القرنين مع القوم الذين أتى إليهم وطلبوا منه أن يبني لهم السد حتى يحول بينهم وبين يأجوج ومأجوج غريبة، قصة موسى مع العبد الصالح فيها غرابة، تتميز بسرد قصص غريب لأهداف معينة.
هي سورة عظيمة وهي سورة مكية تدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك وتدعو إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولها سبب زول وهي أن المشركين في مكة عندما ضاقوا ذرعا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدته الجديدة احتاروا في أمره يتكلم بكلام عالي وكانوا متحرجين وكانوا في شك من أمرهم
مناسبة السورة: ما ورد من سؤال المشركين بإيعاز من اليهود ليسألوه عن أمور ثلاثة
قال لهم سأجيبكم ثقة منه بأن الله سبحانه وتعالى سيوحي إليه ولم يقل إن شاء الله فأبطأ عليه الوحي تعليما له صلى الله عليه وسلم وتربية لأمته ثم جاءت سورة الكهف ونزل بها جبريل يشيعها سبعون ألف ملك لعظمتها وجاءت في ثناياها (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) فلها مناسبة خاصة وهي تتضمن أحداثًا غريبة وعجيبة.
وردت في هذه السورة إحابتان عن سؤالين والسؤال الثالث وردت في سورة الإسراء التي ضمّنها الله تعالى الإجابة عن سؤال الروح ولعل هذا من أسرار ترتيب سورة الإسراء قبل سورة الكهف.
سورة الكهف ليست كسورة الرحمن من حيث عدد الآيات لذا سنخصص لها حلقتين. نستعرض جزءا من القصص التي وردت في السورة.
هذه السورة ورد فيها أثر عن النبي حول حفظ عشر آيات من أولها أو من آخرها والأولى أن يحفها كلها وثواب حفظها أنها تقي بين فتنة المسيح الدجال فما الرابط بينهما؟
فتنة المسيح الدجال هي فتنة نسأل الله تعالى أن يقينا منها لأن القصص الذي ورد في سورة الكهف هو قصص يتعلق بفتن وذكر حلول لها من قصة الفتية الذين آمنوا وفروا من قومهم المشركين فرارا من دينهم، وقيض الله لهؤلاء برحمته كل كهفا يعيشون فيه وكلبا لحراستهم وقصة الجنتين فيها فتنة المال وماذا يفسد الناس إلا فتنة المال مع غرور صاحب الجنتين وكبريائه وتجبره وفي ختام القصة ذكر الله تعالى (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46)) زينة الحياة الدنيا لا مبادئ الحياة الدنيا، المال زينة فاستفيدوا منه، لو أحسنا تربية البنين وأحسنا استخدام المال فنعم المال الصالح للرجل الصالح، جاءت قصة صاحب الجنتين لتقي المسلمين من فتنة المال، قصة موسى مع العبد الصالح تتحدث عن فتنة العلم. الفتنة الرابعة فتنة الأخذ بالأسباب في قصة الملك الصالح ذي القرنين مكّنه الله ومع ذلك لم يغتر ونجا من الفتن (قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95)) وأخذ بكل الأسباب وكان مؤمنا بالغيب وقصته جميلة من أهم ثمراتها الإيمان بالغيب (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾) الحضارة الغربية اليوم فيها الكثير من الأخذ بالأسباب لكن الافتتان بالأسباب إلى درجة تأليها خطأ.
مثل هذه القصص التي فيها فتن تعلم الإنسان كيفية النجاة منها.
ورد في آخر سورة الكهف (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾) وهذه قريبة من فتنة الأسباب.
ارتباط سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم
الارتباط موجود بين سور القرآن كلها، وهذا الترتيب العظيم مقصود وورود الإجابة عن سؤال الروح في سورة الإسراء يزيد من ارتباط السورتين، سورة الإسراء تتحدث عن إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحدث عن بني إسرائيل، معجزة الإسراء معجزة عظيمة، معجزة جسدية ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، بجسده وروحه الإسراء خلدته سورة الإسراء والمعراج خلدته سورة النجم، معجزة عظيمة الله تعالى أسرى بنبيه وتوقف الزمن ولهذا تقتضي التسبيح والسورة الوحيدة التي بدأها الله بـ(سبحان). (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ 1) (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1)الكهف) الأولى معجزة كونية وأثبتت صدق النبي صلى الله عليه وسلم والثانية معجزة قرآنية. (عبده) و(عبده) تناسق وانسجام مقصود. في ختام سورة الإسراء (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾) الله أكبر (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) سبحان الله، الله أكبر – الحمد لله، المسلم لا يتوقف دائما يشد الرحال حتى إذا انتهى من الجنة والناس يقرأ الفاتحة ويستحب عندما تنتهي من ختم المصحف أن تبدأ من جديد الحال المرتحل.
ربطت سورة الإسراء وسورة الكهف بين الباقيات الصالحات وتثبيتا لهذا المعنى جاء في سورة الكهف (والباقيات الصالحات ) أما سورة الإسراء فتضمنت التسبيح (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ) (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾) (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾) (قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا) (وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾) فيها تسبيح كثير وبعد التسبيح يأتي التحميد في سورة الكهف.
سورة الكهف مع سورة مريم، سورة الكهف بدأت (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾) وبدأت قصة أهل الكهف (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾) سؤال استفهامي إنكاري، ليس هذا هو العجب، ما هو العجب؟ كأن الله يقول لمحمد أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم هم العجب العجاب؟ لا، العجب (كهيعص ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ مريم) وولادة عيسى من أم دون أب وولادة يحيى من زكريا على كبر، تحدث عيسى في المهد صبيا، هذا العجب العجاب ذكرها الغرناطي في تناسق سور القرآن. وقيل ليس هذا العجب إنما العجب ما في السموات والأرض.
السياق اللفظي لسورة الكهف
كل سورة لها ثوبها الخاص، سورة الكهف لها ثوبها خاص بحيث لو سمعتها تُقرأ تجزم أنها سورة الكهف. سورة الكهف فيها ألفاظ خاصة كررت بطريقة حكيمة (أحكمت آياته) مثال: عندما أفاق الفتية من الكهف (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19)) نوع من الفضة، (فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا) قال أزكى ولم يقل أفضل أو أطيب أو ألذ طعاما لماذا اختار (ازكى)؟ أدق لفظ في محله ولكنه ينظر إلى نهاية السورة (قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ) نفسًا طيبة طاهرة بريئة، هذا تجانس لفظي، (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾). الألفاظ منتقاة بدقة.
عندما تقرأ في السورة (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾) ما معنى على آثارهم؟ نقول فلان يمشي على أثر فلان، وهنا بمعنى لعلك باخع نفسك لأجلهم ولكن اختار (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ) وفي قصة موسى مع فتاه (فَارْتَدَّا عَلَى آَثَارِهِمَا قَصَصًا) ما قال فارتدا راجعين، عائدين فتكرار اللفظ (آثار) مقصود في السورة. وهذا من رد العجز على الصدر لما يؤتى بكلمة في النهاية جيء بها في البداية.
(إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ) ركنوا ولجأوا، اعتصموا وفي نهاية السورة في قصة موسى مع الرجل الصالح والفتى (قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ) لم يقل ذهبنا، استرحنا، لجأنا لكن أوينا أدق في المعنى. حتى الفتية لما تحدثوا فيما بينهم (فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ) تكررت اللفظ ثلاث مرات وليس في سورة الإسراء وسورة مريم هذا اللفظ، لكل سورة ألفاظها، هذه مفاتيح لقرآءة القرآن لنتذوق هذا الاتساق، الذوق اللفظي لسورة الكهف لا ينتهي.
هل هناك مناسبة بين مطلع السورة وختامها
البداية حديث عن الكتاب (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ) وآخر آية (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾) كلمات ربي هي القرآن، وفي وسطها (وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾) خير التفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بالعلم اللغوي الصحيح.
في سورة الكهف تحدث الله عز وجلّ عن القرآن بكونه كتابا (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ) القرآن له اسمان علمان: القرآن والكتاب، القرآن لكونه يُقرأ والكتاب لكونه يُكتب. في هذا الإتساق لوحظ التناسب في السورة مع كتاب الأعمال (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾) في هذا السياق الكتاب أولى من القرآن وهذا من التناسق، هنا كتاب القرآن وهنا كتاب الأعمال.
في سورة الإسراء ورد الحديث عن القرآن وتكرر 11 مرة في السورة (إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ) (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ) (وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآَنِ وَحْدَهُ) (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ) (وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ) (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ) (وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ) لم يذكر الكتاب ولا يوجد سورة أخرى ورد فيها لفظ القرآن 11 مرة، سورة البقرة أطول سور القرآن ورد فيها لفظ القرآن مرة واحدة (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) ولهما حكمة، هو شهر قرآءة وأنزل القرآن في رمضان، سورة البقرة لها شخصية، لها ملامح. ذكر في بداية سورة البقرة الكتاب (ذلك الكتاب) أما في آية شهر رمضان وردت لفظ القرآن لأنه شهر القرآءة للقرآن.
وقفة مع بعض آيات السورة
قال تعالى في سورة الكهف (قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾) وقال في سورة الإسراء (إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾) فلماذا قيل هنا أجرا حسنا وهنا أجرا كبيرا؟
القرآن الكريم دائما فيه اتساق لفظي. سورة الكهف بنيت على مادة الحسن (لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) تكرر لفظ الحسن بشيء من التفصيل (لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) (وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا) (وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا) (فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى) حسن أن يقول (أجرا حسنا) في سورة الكهف.
في القرآن أجر حسن وأجر عظيم وأجر حسن وأجر كبير وكلها تخضع للسياق. في سورة الإسراء (إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾) وتكرر لفظ كبيرا في سورة الإسراء (وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا) (وَلَلْآَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا) (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) (أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) (فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا) (إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا) (وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا) ولما تحدث عن الوالدين قال (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا) ست مرات وردت كلمة (كبيرا) في السورة فناسب أن يقول (أجرا كبيرا).
في سورة النساء نجد أجرا عظيما لأن لفظ عظيما تكرر في السورة، سورة النساء لها اتساق. لكل مقام مقال لكل شخصية ثوبها ولكل سورة ألفاظ تتناسق معها.
لماذا جاء الفعل (يبشر) منصوبا؟
لأنه جاء معطوفا على (لينذرَ) (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ) اللام لام التعليل. أما في آية الإسراء (يبشرُ) فعل مضارع مرفوع.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا) لينذر من؟ الجواب معروف من السياق، الفعل ينذر يتطلب مفعولين بمعنى: لينذر المشركين بأسًا أو لينذر الكافرين بأسًا. هو ذكر مفعولا وطوى مفعولا، عرفنا أن المقصود المشركين أو الكافرين مما جاء في البشارة بعده النذارة (ويبشر المؤمنين) تدل على أنه ينذر الكافرين.
(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾) فعل (حسب) من الأيقونات اللفظية المستعملة في هذه السورة، قال (حسبت) ولم يقل ظننت، فما الفرق بين الحسبان والظنّ؟ الظن الذي يظن ظنا يأخذ بالاحتمالين يرجح أحدهما، أما لما يكون هناك احتمال واحد في الذهن يستخدم حسب.
حسب وظنّ وخال وزعم أخوات لكن بينها فروق.
هل في اللغة مترادفات؟ الأرجح أن كل لفظ له خاصية.
يذكر في السورة (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) (ويحسبون أنهم يحسنون صنعا) القارئ ينبغي أن يقرأ ويتدبر السورة ويتلمس الألفاظ التي تكررت في السورة والتي اختيرت بحكمة تتناسب مع السياق.
حينما سأل الله تعالى هذا السؤال الاستفهامي في الآية (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾) لإبطال سؤال اليهود والمشركين وجوابه جاء في سورة مريم وفي غيرها من السور لكن بالدرجة الأولى الله تعالى فنّد مزاعم اليهود بأن الذي سيجيب عن هذه الأسئلة هو النبي وكان الأولى بهم أن يقولوا وجدناه مكتوبا عندنا في التوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن عنادهم جعلهم ينصبون مكيدة للنبي صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله منها وأعانه وثبته.
فائدة لغوية: ما معنى الرقيم؟ الرقيم اختلف في معناها، قال ابن عباس: وقفت عند أربع كلمات ما معنى حنانا، غسلين، الرقيم؟ القول الذي يرجحه العلماء أن الرقيم من المرقوم يقال إن الملك الذي بحث عن الفتية قال كم كان عددهم؟ فدوّن ذلك في رقيم. وورد في تفسير فتح الغيب للرازي والكشاف أن الرقيم أي أصحاب الكتاب.
(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾) ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا، خير الدعاء ما ورد في القرآن. (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ادع بهذا الدعاء في الطواف لأنه دعاء ورد في سياق آيات الحج.
السر العجيب بهذا الدعاء في الحلقة القادمة.
في رحاب سورة
د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1436 هـ
الحلقة 4 – في رحاب سورة الكهف – 2
تقديم الإعلامي محمد خلف
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
يعرض مساء الأحد الساعة 9 ليلا بتوقيت مكة المكرمة ويعاد الإثنين الساعة 11.30 ظهرًا.
سر الدعاء في سورة الكهف:
لهذا الدعاء الذي ورد في سورة الكهف (رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا) سر من الأسرار.
لا بد أن ندعوا بأدعية القرآن الكريم لأن فيها أسرار عرفناها أو لم نعرفها ما بثها الله في قرآنه العظيم إلا لأن لها أسرار وكذلك ندعوا بأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم.
العلماء قالوا استجاب الله دعاء هؤلاء الفتية فقيض لهم كهفا عظيما وجعله مناسبا لعيشهم زمنا طويلا ليمكثوا فيه فترة طويلة، فتية يمكثون هذه الفترة نائمين ولا يصيبهم شيء حفظهم الله جلّ جلاله وكلأهم ورعاهم وجعل الشمس تزاور إذا طلعت عليهم وقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وجعل كلبهم باسط ذراعيه يحرسهم وهذا كله رحمة واحدة من رحمات الله تعالى. دعاؤهم كان عظيما إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى علّمه رسوله صلى الله عليه وسلم (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾) استفد من قصة أهل الكهف وردد نفس الدعاء وقل عسى أن يهديني رب لأقرب من هذا رشدا (وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا) دعاء عظيم علمه الله تعالى للفتية فاستجاب لهم وعلمه للرسول صلى الله عليه وسلم
هذا الدعاء فيه شيئان اثنان: فيه رحمة وفيه رشدًا. رشدًا علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال (وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا) وموسى عليه السلام (قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾) اطلب علما راشدا نافعا مباركا. الكلمة رشدا مصدرها رُشد، رُشد ورشدا وردا في سورة الكهف فخط السورة مبني على الرشد حتى لما قال (وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا) لم ترد في القرآن كله إلا في هذا الموضع وردت وليّ ولا شفيع، وليّ ولا نصير، وليّ ولا واق، وليّ ولا حميم، أما وليًا مرشدا (مرشدا اسم فاعل من رشدا) فلم ترد إلا فيها لأنها مبنية على الرشد. مثلا ورد في سورة الرعد (مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ) [الرعد: 37] تناسب ذكرها في السورة مع ورود قول الله تعالى (لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٣٤﴾) فكل كلمة تتناسب مع سياق السورة التي وردت فيها.
(فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)
(وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا)
(وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا)
(قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾)
الخط الثاني هو الرحمة الفتية طلبوا من الله رحمة فقيّض لهم رحمات. الرجل الصالح قال (فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾) رحمة مع علم لدنّي، هذا مقصود. لذلك أهل الكهف أعطاهم الله رحمة واحدة والعبد الصالح أعطاه رحمة وعلما من لدنه وذو القرنين لما بنى السد وأقامه (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي) لما نصب لهم ذلك السد المنيع لم يقل هذا من فضل ربي أم من نعم الله عليّ وإنما قال (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي) لأن سورة الكهف مبنية على الرحمة والغلام الذي قتله العبد الصالح قال (فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾) الرحمة مقصودة في قصص السورة وهي خط من خطوط السورة والرشاد والرشد خط من خطوط السورة أيضًا. وكذلك حسن في السورة أيضًا (أجرا حسنا).
(رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً)
(فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ)
(وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ)
(فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا)
(فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾)
(وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ)
(قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي)
قصة الكهف سميت السورة باسمها في دلالة على هذه القصة التي وردت فيها وربما تكون من أعجب وأعظم القصص في السورة (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ) الرقيم كلمة اختلف فيها كثيرا وتوقف عندها حبر الأمة ابن عباس. (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ) ما دلالة كلمة الفتية؟
سماهم في البداية (أصحاب الكهف) (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ) هذا سؤال بلاغي، إظهار في محل الإضمار. المقتضى اللغوي أن يقال “أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أووا إلى الكهف”، كأن نقول جاءني الأستاذ فلان ودرس وعرض عليّ، لا يكرر المسند إليه. لو ترك وقا:ل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أووا إلى الكهف يتساءل السامع هل كانوا شبابا؟ هل كانوا شيوخا كبارا؟ ما شأنهم؟ إظهار بدل إضمار ليبين حقيقتهم (إذ أوى الفتية) فهم فتية وهم أصحاب الكهف فأتى الله باللفظين ليبين حقيقتهم.
ما مدة لبثهم في الكهف؟
أرجح أن هذا ليس هو العدد، اختلف في عدد الفتية (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ) الله جلّ جلاله يعلم كم عددهم لكنه لم يذكر عددهم بالتفصيل والقصص القرآني لا يهتم بالأعداد ولا الأسماء ولا المكان ولا الزمان فإذا اهتم بها القارئ ذهب المراد من القصة، فالقصة في القرآن تساق للعبرة والموعظة (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) لو قال القرآن كان عددهم ثلاثة لقال القرشيون نحن ورد في كتبنا خمسة ولو قال ستة لقالوا ورد في قصصنا سبعة، يعني الله جل ثناؤه لم يعطهم فرصة للتكذيب فقال (ما يعلمهم إلا قليل) ابن عباس قال: وأنا من القليل إن شاء الله لأنه أوتي فهمًا في القرآن. فالقرآن لم يحدد عددهم. بعد بضعة آيات قال (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾) هذا فيها اعجاز علمي أن 300 سنة شمسية تساوي 309 سنة قمرية. (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا) هل هذا هو الزمن؟ لا، لأنه علينا أن نقدر فعلًا هنا ويقولون لبثوا كما قال في البداية (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وهنا يقدّر فعل ويقولون لبثوا في كهفهم، لماذا نضمر؟ لأن الجواب في الآية (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا) الله أعلم بما لبثوا ولو كانت المدة 309 سنين هي المدة المرادة فلماذا قال الله تعالى بعدها (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا)؟ لو قال (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) على وجه التقرير لما كان هناك جدوى من قول (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا) فهذه الواو (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ) واو عاطفة في فعل محذوف يدل عليه الكلام السابق. (مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها) هي أكلها دائم وظلّها دائم، من أين عرفنا أن ظلها دائم؟ من أكلها دائم، ما دام في السياق ما يدل نحذف. أعظم بيان بيان القرآن. عودنا القرآن أن علينا أن نقدر كلمات فلماذا لا نقدر هنا؟ والآية اللاحقة تدل على هذا التفسير. بعض العلماء يميل إلى أنهم لبثوا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا وأنا أظن أنه مرجوح بالدليل الذي ذكرته وهذا ذكره الإمام قتاده في تفسير الزمخشري في الكشاف فأنا أرجح للأدلة اللغوية.
قصة صاحب الجنتين:
(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾)
هذه القصة هي من القصص الركن في هذه السورة لم ترد في غيرها في القرآن (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آَتَتْ) آتت لم يقل آتتا لأننا عندما نستخدم (كلتا) يأتي الفعل مفرد. (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا) ولم تنقص منه شيئا، ترددت كلمة (ظلم)
(وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا) قال العلماء نظرا لخصب هاتين الجنتين آتت أكلها قبل النهر، فالنهرللجماليات ولمزيد من الاحتياط (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا) زيادة في الاحتياط المائي وزيادة في المنظر. تخيل جنتان من أعناب وزروع وبينهما نهر. الرجل اغتر بماله واغتر بجنتيه ويا ليته توقف عند (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾) لكنه استرسل واستبعد الساعة (وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً) ثم غرور زائد عن كل لزوم (وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا) هو يريد الجنتين في الدنيا والجنتين في الآخرة بدون عمل. فهذه فتنة المال. أما صاحبه الذي كان يحاوره كان رجلا مؤمنا عاقلًا فذكره بحاله وبأصله (أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾) كيف تقلّب في صلب أبيه وأمه وكان المقتضى والأولى أن يقول (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) سورة الكهف علمتنا أننا إذا أردنا الهداية والرشاد علمتنا الدعاء العظيم في قصة فتية الكهف (رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10)الكهف) وهذه القصة علمتنا أن نقول (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) عندما يرزقنا الله تعالى، المال غير ممنوع في الإسلام “نعم المال الصالح للرجل الصالح” فمن أراد المال فعليه أن يقول ما شاء الله ومن أراد الصحة فعليه بدعاء أيوب (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83)الأنبياء) وومن أراد أن يفرج الله كربه فعليه بدعاء يونس (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)الأنبياء) ومن خاف من قوم من سلطان يقول (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)آل عمران) ومن خاف من مكر العباد يقول (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44)غافر) أدعية كثيرة في القرآن الكريم.
(إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39)الكهف) حين تراني أنا أقل منك مالا وولدا ما زلت أنا أفوض أمري إلى الله (فعسى ربي) شرطية، (فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40)الكهف) إن ترني شرطية، هذه القصة لا بد لكل مسلم إذا قرأها أن يخشى من فتنة المال ويتعوذ من فتنة المال.
مقدمة السورة دائمًا توحي بمضمونها، (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) قضية الكتاب ثم قضية الشرك (لينذر أجرا حسنا وينذر ولدا) المشركون، لما تكلم عن الشرك جاء بقصة أهل الكهف تنفي الشرك وتثبت التوحيد وانتصر لأهل الكهف وعظّم شأنهم وذكر قصتهم.
بعد ذلك قال (وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾) مواساة لمحمد صلى الله عليه وسلم لعلك مهلك نفسك لأجل الكافرين، (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) هذه الآية جاء تفصيلها في الآية (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) كل ديباجة لها تفصيلها. ثم قال (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾) تفصيلها في قصة صاحب الجنتين.
السورة القرآنية سبقت جميع البحوث العلمية، سورة الرحمن بدأت (الرحمن) ثم فصلت الآلآء، سورة الكهف ذكرت الديباجة ثم التفصيل، ذكرت في المقدمة الموضوع جملة ثم تفصله، قصة صاحب الجنتين تفصيل لقوله تعالى (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾) الأولى من رزقه الله أن يقول ما شاء الله ويزداد بهذا المال قوة ويعبد الله سبحانه وتعالى.
الدليل القاطع على أن هذه القصة هي تفصيل هذه الآية بعدها قال (إن ترني أنا أقل صعيدا زلقا غورا) انظر إلى لفظ صعيدا زلقا يشير إلى زميله صعيدا جرزا. الصعيد هو الأرض الخالية، اختار الله عز وجلّ من الألفاظ في البداية (إنا جعلنا من على الأرض زينة صعيدا جرزا) أما الثانية فقال (صعيدا جرزا) نفس المعنى بمعنى خالية جرداء، لو شاء الله ما ترك لك شيئا. فإعادة اللفظ بذاته رابط بين المقدمة والقصة.
(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42)الكهف) فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ الذي يقلب كفيه هو الخاسر النادم الذي خسر خسرانا مبينا إما يقلب كفيه أو يعض على يديه. كان يمكن وصفه أنه فأصبح نادمًا على ما أنفق فيها لكن عوضا عن التعبير بالعملية الذهنية جاء بالعملية الحركية (فأصبح يقلب كفيه) حركة يدوية كناية عن الندم والخسران، في اللغة العربية لغة الجسم في القرآن شيء عظيم (عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ 119 آل عمران) (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29)الإسراء) (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27)الفرقان) (وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12)السجده) (فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51)الإسراء) لغة الجسم في القرآن شيء عجيب ألفت فيها كتابا سميته بلاغة النظم في لغة الجسم في القرآن الكريم هي رسالة دكتوراة. ثمة في القرآن 35 مصطلحًا للعين (خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4)الملك) (وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10)الأحزاب) (يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37)النور) (وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ (47)الأعراف) (سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا 15 الحجر)
أفصح على هذه الندامة ولم يكتفي بالإشارة بيديه (فأصبح يقلب ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا) وما جاءت سورة الكهف إلا لتنفي الإشراك، السورة تؤكد قضية التوحيد وتنفي الشرك فجعل هذا الخسران الذي وقع فيه نتيجة الشرك بالله والاعتداد والغرور. الشرك لا يعني فقط عبادة غير الله سبحانه وتعالى وإنما الكفر بنعمة الله وأشرك بالله المال وأنكر القيامة وأنكر البعث فهذا شرك وقال (وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36)الكهف) في موضع آخر في سورة فصلت قال (ولئن رجعت إلى ربي) وهنا قال (رددت) المفسرون قالوا رجع بمعنى رد. قال في آية الكهف (ولئن رددت) لأنه في قصة ذو القرنين قال (ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87)الكهف) وهذا من الاتساق في القرآن وحتى في قصة موسى مع فتاه قال (فَارْتَدَّا عَلَى آَثَارِهِمَا قَصَصًا (64)) بينما في سورة فصلت (وَلَئِنْ رُجِعْتُ (50)) قال فيها (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44)الزمر) هذه مفاتيح فقط ليهتم القارئ بالتدبر.
ورد بعدها مباشرة (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45)) الحديث ما زال متسقا حول الجنة وحول الماء الذي يفتن إلى أن يقول (المال والبنون).
(واضرب لهم مثل ) هذا مثل والقرآن مليء بالأمثال ذكر هنا بالتحديد بعد قصة صاحب الجنتين ليقوي القصة ويسمى في البلاغة تشبيه تمثيلي، التشبيه العادي نقول فلان يشبه الأسد أو تشبيه بلاغي أحمد أسد، حذفنا الأداة وحذفنا وجه الشبه، أما التشبيه التمثيلي فهو نوع من أنواع التشبيه يكون فيه وجه الشبه منتزعا من متعدد (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء) لو قال (واضرب لهم الحياة الدنيا كماء) لا يتضح المعنى، (واضرب أنزلناه من السماء الرياح ) وجه الشبه منتزع من كل هذا المتعدد والتشبيه التمثيلي هو تشبيه صورة بصورة وفي سورة يونس مثل قريب من هذا المثل ( فاختلط به نبات الأرض أتاها أمرنا) المثل في سورة الكهف أوضح وآية سورة يونس لها شخصيتها. في سورة الكهف ضرب الله مثلا للحياة الدنيا بالدورة النباتية: ماء أنزلناه من السماء، اختلط به نبات الأرض، أصبح هشيما تذروه الرايح (التبن) طوى أطوارا كثيرة لم يفصل فيها وإنما ذكر الطور الأول والأخير لإفادة اضمحلال الدنيا وزوالها وهذا هو المراد بالمثل هذه الدنيا لا تدوم ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا، ولو دامت لدامت لقارون وفرعون. الله تعالى يريد أن يصف لنا اضمحلال الدنيا وزوالها فضرب لها هذا التشبيه التمثيلي. ويؤكد المعنى ما ورد في الآية التي تليها (المال والبنون زينة الباقيات الصالحات ) هذا تصحيح للقيم، في الآية السابقة ضرب لنا الصورة وهنا كلام صريح جدا، المال والبنون زينة وليست قيمة، تصريح وليست مبدأ وليست آلهة تعبد. والباقيات الصالحات إما أنها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) رمز للعبادات جميع العبادات هي الباقيات الصالحات بما فيها هذه الكلمات الطيبة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم غراس الجنة.
ثم وردت في سورة الكهف قصة إبليس ورفضه السجود (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50))وهي قصة تكررت في القرآن في أكثر من موضع وإن كان ورودها في هذه السورة يختلف عن ورودها في السور الأخرى. (وإذ قلنا بدلا) ففسق عن أمر ربه كان لإبليس أعبد من الملائكة وهو ليس منهم (كان من الجن) فسق بمعنى خرج وابتعد كما تفسق الرطبة وخرج عن أمر ربه بالسجود لآدم وفي آية أخرى قال (واستكبر) الجديد في هذه الاية أنها بينت نسبه (إبليس من الجن وليس من الملائكة كان مطيعا ولكن لما رد الأمر على الآمر وانشغل بما لديه وتكبر على آدم فسق عن أمر ربه كانت عاقبته خسرانا وطرده ربه من الجنة.
وبعدها قال (أفتتخذونه وذريته أولياء ) لا ينبغي أن تشركوا به وتتخذوا ذريته أولياء كما اتخذ المشركون في عهد أصحاب الكهف اتخذوا من دون الله ولدا، هذا التناسق (قالوا اتخذ الله ولدا)وهذا كلام خطأ وهنا قال (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني) لا ينبغي (أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء) أتى بقصة إبليس وإبائه للسجود وذكر كيف أننا لا ينبغي أن نتخذه وذريته أولياء وفي النهاية أعطتنا الخلاصة (أفتتخذونه وذريته..)
قصة موسى مع العبد الصالح
هذه القصة لم ترد في القرآن إلا في سورة الكهف لغرابها وجمعها لكل غريب مع أن قصة موسى أكثر القصص دورانا وتكرارا في القرآن
الأرجح عند بعض العلماء أن العبد الصالح نبي وليس رسولا إلى جهة معينة والأولى أن نكتفي بالتعبير القرآني (العبد الصالح) وورد في السنة تسميته الخضر.
الله تبارك وتعالى علّمه من لدنه علما وأراد تبارك وتعالى أن يعلم موسى درسا عظيما وقصته مع العبد الصالح تقينا من فتنة العلم والاغترار به، المفترض أن نأخذ العلم نأخذه وسيلة لنتقرب إلى الله ونعبده لكن لا نغتر به، نطلب المال لكن لا نغتر به
هذا الرجل الصالح علمه الله علما لدنيا أما موسى عليه السلام فعلمه شرعي أنزل الله عليه التوراة. والعلم الشرعي هو العلم وفق الأحكام، علم محمد صلى الله عليه وسلم علم شرعي هو القرآن وفق الظاهر أما العلم اللدني فهو علم غيبي خصّ الله هذا الرجل الصالح به وهو مشتق من لدن الله، هو من علم الغيب، لكن التصرفات فيه لا تكون وفق الظاهر، كليم الله أنزل الله عليه التوراة وكلمه واصطفاه ولكن الله اصطفى هذا الرجل الصالح بعلم غيبي فتصرفاته وفق هذا العلم الغيبي وموسى كان يتصرف وفق العلم الشرعي، ركبوا في السفينة كان يفترض أن يقول لهم جزاكم الله خيرا لكنه خرق السفينة، أصحاب السفينة أكرموهما.
(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60)) كان مع موسى فتى، البحرين منطقة معينة حددها الله له، حقبا فترة طويلة من الزمن من الحِقب. (فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61)) لا بد من اتخذا الزاد واتخاذ الأسباب. لما قال حوتا يقصد به الزاد بشكل عام وكان فيه نوع من السمك (فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آَتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63)) هذه الإشارة التي أرشد الله تعالى موسى أن المكان الذي تفقد فيه الحوت سوف تجد الرجل الصالح. الأمر منتظر ولكن الفتى أنساه الشيطان، اتساق بين نسيان الفتى ونسيان محمد صلى الله عليه وسلم (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)) هنا لم يذكر الشيطان تأدبا
لقاء موسى بالرجل الصالح (فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66)) أدب الحوار وأدب النبوة موسى عليه كان أعلم الناس في وقته ولكن الله بعثه إلى هذا الرجل الصالح الذي آتاه الله رحمة من لدنه وعلما من لدنه وهو كليم الله اصطفاه (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (39)طه) شيء عظيم ولم يكلم الله تعالى أحدا سواه وهو يقول (هل أتبعك رشدا) ومع هذا قمة الأدب أدب الطالب مع المعلم (هل أتبعك ) ألطف أسلوب ما قال له علّمني أو أريد أن أتعلم وقال (مما علمت) من بعض ما عندك من العلم ولم يرهقع ويقول أعطني كل المعلومات التي عندك، أدب العلم وأدب الطالب مع العلماء هو ما نستفيده من هذه القصة. (رشدا) علما نافعا.
الأستاذ من حقه أن يشترط (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68)) كان صادقا فقال أنت لديك علم لم يعلمني الله إياه وأنا لدي علم لم يعلمك الله إياه. قال موسى (قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69)) ثقة طالب العلم الذي لديه جرأة وثقة بنفسه ولديه جلد وصبر على التحمل. العلم يرسخ بالملازمة ما قال علمني وإنما قال أتبعك: لا بد أن أتبعك وأمشي في ركابك، يمكن للعلماء أن يستنبطوا من قصة موسى مع العبد الصالح آداب العلم وطالب العلم في كلام موسى في أدبه ولطفه مع الرجل الصالح في جواب الرجل الصالح ولكن موسى كان رجلا ذا ثقة بنفسه. (قال ستجدني صابرا) موسى استفاد من درس محمد صلى الله عليه وسلم وقال (ستجدني إن شاء الله) محمد صلى الله عليه وسلم لما أجاب مشركي قريش ما قال إن شاء الله
خوطبت الأمة بشخص نبيها الأمة تخاطب بشخص النبي (يا ايها النبي) خطاب لللنبي لكنه للأمة من بعده وهناك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم
اشترط عليه (قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70)) من حق الأستاذ أن يشترط على طالب العلم.
(فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71)) خرقها من غير سابق إنذار وما فعل أهل السفينة شيئا وفي عرف موسى وعرف الناس جميعا هذا خطأ، أما في عرف الرجل الصالح قال (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72))
(فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74)) غلام صغير قتله، في السفينة نسي موسى أما هنا لم ينسى وإنما غضب موسى غضبة قوية (لقد جئت شيئا نكرا) منكرا فظيعا، فأكد (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75))
هنا قال (ألم أقل لك) هنا القضية وجّه له الحديث المباشر وقبلها قال (ألم أقل إنك لن تستطيع) وقال مرة إمرا ومرة نكرا
القصة كلها درس في الآداب والأخلاق بين المعلم والطالب.
في رحاب سورة
د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1436 هـ
الحلقة 4 – في رحاب سورة الكهف – 3
تقديم الإعلامي محمد خلف
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
يعرض مساء الأحد الساعة 9 ليلا بتوقيت مكة المكرمة ويعاد الإثنين الساعة 11.30 ظهرًا.
قصة موسى مع الخضر
قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح الذي اسمه الخضر كما ورد في السنن قصة مثالية تضرب مثلًا لطلاب العلم ومعلمي العلم حتى يستفيدوا من كثير من المبادئ التي فيها في طلبهم للعلم، سئل موسى عليه السلام من أعلم أهل الأرض؟ قال انا (ليس كبرا منه لكنه لم يعلم أحدا أعلم منه وهو كان رسولا ونبيا وكليم الله) ذهب موسى للقاء الرجل الصالح عند مجمع البحرين وأعطاه الله علامة وهو انفلات الحوت والقصة مليئة بالقيم كيف اصطحب فتاه وكيف كان رفيقا به ونسي الفتى أن يخبر موسى أن الحوت ضاع منه وهذا أدب من الغلام (قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ) فارتدا على آثراهما إلى أن وصلا إلى ذلك المكان ووجدا الرجل الصالح وهنا تبدأ رحلة العلم والقصة تبرز كيف كان موسى قمة في الأدب وهو رسول من أولي العزم ومع ذلك قال للرجل الصالح (قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66)) سؤال يفيد العرض بألطف أساليب: أتبعك إذا شئت، تعلمني ممنا علمت (من) تفيد التبعيض أي من بعض علمك والرجل الصالح انطلاقا مما لديه من علم لدني غيبي لا يعرفه موسى قال له اشفاقا عليه (قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67)) جملة خبرية تقريرية مؤكدة بتوكيدين (إنّ ولا النافية) و(صبرا) نكرة في سياق النفي تفيد العموم لا تستطيع أيّ صبر، وهذا ليس انقاصا من شأن موسى ولكنه كان يعرف أنه يتصرف تصرفات غير مقبولة لدى عامة الناس (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68)) أنت تتصرف وفق علم شرعي وأنا لدي علم آخر فردّ عليه موسى (قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69)) لم يقل له سأصبر وإنما ستجدني إن شاء الله صابرا هذا الأسلوب أثبت في بيان صفة جلادة الصبر وهمة موسى، الأحرى بطالب العلم أن يبين همته لأستاذه (ولا أعصي لك امرا) أحرى بطلاب العلم أن لا يعصوا معلميهم.
( قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70)) هذا الشرط (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71)) حتى إذا ركبا في السفينة (إذا) تعني أن مجرد ركوبهما خرقها، إذا هنا ليست شرطية وإنما ظرفية تفيد الزمن ومفرّغة من الشرطية يقول أحد المفسرين كأنه ركب فقط ليخرقها كأنه مسيّر مبعوث خصيصًا لكي يخرقها. سؤال استفهام إنكاري (أخرقتها ) أنكر عليه لكن بحدود المعقول. إمرا يعني فظيع شنيع شديد أما نكرا فهو أشد من إمرا. فأجابه العبد الصالح (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) )(بدون لك) هذا نوع من المعاتبة واللوم لأنه يعلم أن بشرية موسى وبحكم كونه نبيا ورسولا الأنبياء لا يسكتون عن شيء يرونه خطأ وموسى يرى خرق السفينة خطأ فالسفينة كان الأولى أن يشكروا أهلها، بعد ذلك (قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73)) قال صلى الله عليه وسلم معلقا: كانت الأولى من موسى نسيانا (نسي الشرط مع العبد الصالح).
ثم (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74)) هذا أفظع وهذا كلام من موسى متعمّد ما تحمل أن يسكت عن هذا النكر، قتل نفس زكية بغير نفس بدون ذنب بدون جريرة وفي قرآءة نفس زاكية هذا منكر فظيع لا يقبله دين وكل ذي ضمير إذا رأى منكرا فظيعا لا يسكت فمن باب أولى الأنبياء فالثانية كان اعتراض موسى عن عمد وقصد.
(قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75)) (لك) لمزيد من التنبيه له، (لك) هي متعلق الفعل (قال) يفيد التأكيد الجملة كلها فيها مؤكدات (استفهام ولك وإنّ ولن النافية أداة جزم) وزادها تلويما وتوجيه الخطاب المباشر لموسى (لك) قلت لك أنت فاشترط موسى مرة أخرى الأولى كان نسيانا والثانية عمدا والثالثة شرطا كما قال صلى الله عليه وسلم
(فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77)) التفكير المنطقي البشري أن القرية يطعموهما والعبد الصالح يتصرف عن وحي (استطعما أهلها) إظهار بدل الاضمار كان المقتضى اللغوي حتى إذا أتيا أهل قرية استطعماهم لكن قال استطعما أهلها للتشنيع، قرية كاملة لم يرد أحد أن يطعمهم هذا تشنيع كانوا بخلاء إلى درجة لكن الله وجه موسى أن يسأل هذا السؤال ووجه العبد الصالح كيف يتصرف.
هنا قال العبد الصالح (قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78)) لم يذكر العبد الصالح لموسى سبب تصرفاته وإنما تركها للأخير. هو من البداية يعرف أن موسى لن يستطيع صبرا لكنه مشى معه درجات معينة ثم أعطاه المحصّلة والنتيجة آتية.
يبدأ يفسر الأحداث التي استنكرها موسى قصة السفينة فالغلام فالجدار.( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (82)) الذي نستنبطه أن الأستاذ صبر والمعلم صبر إلى النهاية ثم بدأ يحوصل ويلخص وهذه من تقنيات التعليم:
اللغة العربية تقتضي أن تقول أما السفينة الصحيحة (أَمَّا السَّفِينَةُ) صفة محذوفة (الصحيحة) أما السفينة الصحيحة دلنا على هذا الوصف قوله تعالى (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا) السبب أن هناك ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبًا فخرقها حتى لا تقع في عينه وهذا ارتكب أهون الشرّين وأقل الضررين هو تصرف تصرفا منطقيا لكن موسى لم يكن يعلم الملابسات
(وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا) بوحي من الله لو عاش ذلك الغلام نظرا لانحرافه كان سيسلك طريقا سيئة جدا ولأن والديه كانا على درجة من الصلاح فأُلهم الرجل الصالح لهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
في السفينة قال أردت أن أعيبها نسب الفعل لنفسه لأنه عيب وفيه سوء ومضرة ولكن تأدبا قال أردت أن أعيبها نسب الضرر ونسب العيب لنفسه، في قصة الغلام قال (أردنا) العبد الصالح قتل الغلام من العبد الصالحين وإبداله من الله تعالى فجاء الفعل (فأردنا) أراد أن يبدلهما منه وأما في الجدار أراد ربك لأنه خير محض، وهذه الظاهرة في كل القرآن، إبراهيم قال في سورة الشعراء (إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80)) المرض بإذن الله (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)آل عمران) بيده كل شيء الخير والشر لكن تأدبا مع الله لا نقول بيدك الشر، الخير يسند إلى الله والشر لا يسند إليه في القرآن كله.
(قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا) ثم قال بعد أن أتم تفسير الأحداث (مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا) الصعوبة لموسى كانت في البداية احتاج إلى استطاعة، أتى بالكلمة بصيغتها الكلمة (لم تستطع) وأما لما انتهت القصص ووضحت المشكلة خفّت الدهشة والعجب (تسطع) الأمر الخفيف يؤتى له بالصيغة الأخ، ذو القرنين لما بنى السد لوم الذين طلبوا منه ذلك حماية من يأجود ومأجوج لقال (فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97)) ما اسطاعوا أن يعلوه والنقب أصعب فاستعمل الصيغة الأخف وحذف التا لأن العمل أخف واستعمل الصيغة الكاملة للفعل الأصعب.
لماذا تم اختيار هذه الأحداث فقط في قصة موسى؟ خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار؟
ورد في السنة ليته صبر لرأينا من تصرفات العبد الصالح أكثر من ذلك. المتأمل في هذه الأحداث يجد أن الله تبارك وتعالى أعطى موسى دروسا من حياته، كف تتعجب من خرق الرجل الصالح السفينة ولم تتعجب من أمك لما وضعتك في التابوت ورمتك في اليم، أين المصلحة هنا؟! أعطاه أحداثًا مماثلة لأحداث مر بها في حياته، أنت تتعجب من الرجل الصالح الموحى إليه، تتعجب من قتله الغلام وأنت (فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ 15 القصص) لم يكن يقصد أن يقتله فأنت تستنكر من الرجل الصالح أن يقتل وأنت صدر منك ذلك، هذا قضاء وقدر. وتستنكر إقامة الجدار ولم يأخذ مالا وأنت أحسنت للفتاتين وسقيت لهما ولم تطلب أجرا (رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24)القصص) والجدار كان لغلامين وكان أبوهما صالحا، فلماذا تتعجب من ذلك؟ الفتاتان كان أبوهما صالحًا، والغلامين اليتيمين كان أبوهما صالحا، هذا تناسق في الأحداث. وهبه الله أحداثا تعلمه من سيرته فما أحرى كل إنسان أن يتذكر وأن ينظر في نفسه وجسمه وحياته فإن ثمة أسرارا عجيبة.
قصة ذي القرنين
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (83)) ويبدأ بسرد قصة القرنين (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85)) ذو القرنين كما ورد في التفسير رجل صالح، ثمة اشياء استنبطها المفسرون من القرآن وثمة أشياء ذكرت في التاريخ لا نستطيع أن نجزم بالأحداث التاريخية لا ننفيها لكن نحتاج إلى إثبات وسند لذلك البعض يقول أن ذو القرنين هو الاسكندر المقدوني وهذا غير صحيح، نحن نستنبط صفاته من القرآن كان رجلا صالحا (قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86)) وقال له لما طلبوا منه أن يبني السد (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94)) كان ملكا ذا قوة كان رجلا مؤمنا كان مهندسا معماريا جبارا ونسب الفضل لله سبحانه وتعالى وهذا دلالة على صلاحه وكان مؤمنا بالغيب (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98)) كان رجلا مؤمنا صالحا طوافا في مشارق الأرض ومغاربها وكان كلما ذهب إلى قوم حاول أن يساعد ويحل لهم المشاكل.
مر على قوم في مغرب الشمس وقوم في مطلع الشمس. (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ 86) عين حمئة بمعنى عين ماؤها وطينها مختلط، الحمئة الطين المختلط بالماء. بلغ أقصى مكان بعده تغرب الشمس وبعض العلماء يحدد المناطق وقد قرأت عددا من التفاسير ولكن لا أميل إلى تحديد المنطقة لأن هذا في علم الغيب.
(وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86)) هؤلاء القوم كانوا على الكفر، كانوا على فساد في الرأي، هذه الآية تدل على فساد أمرهم والله سبحانه وتعالى خيّره إما أن تعذبهم وتسـتأصلهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا، (قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (89)) هنا نستنبط من الآيات، كانوا على فساد في العقيدة وظلم فيما بينهم والدليل على ذلك (إما أن تعذب حسنا) حتى أن العلماء شبهوا هذا الكلام بقول الله سبحانه وتعالى لرسوله (إما منا وإما فداء) تمنّ عليهم أو تفتدي الأسرى. وهنا قال (أما من ظلم) بمعنى أشرك وكفر (وأما من آمن الحسنى) (من آمن) تدل على أن الظلم تعني الشرك، ورد في القرآن (إن الشرك لظلم عظيم) لدينا شاهدان: (إن الشرك لظلم عظيم) ومن سياق الآية (أما من ظلم – وأما من آمن) الذي يعذبه الله عذابا نكرا هو الكافر، الذي يظلم ويتوب ولقي الله وهو مؤمن فيحاسبه الله على الظلم أما الذي يعذبه الله عذابًا نكرا هو الكافر بدليل ما بعدها (وأما من آمن الحسنى يسرا) من آمن مقابل من أشرك (ظلم). الاية تشير أنه اختار الاحتمال الثاني لم يعذبهم بدليل أنه قال (أما من ظلم فسوف نعذبه) سوف معناه أعطاهم مهلة ليدعوهم ويعلّمهم فإن التزموا كان خيرا، (فسوف) دليل أنه دعاهم فلو استمروا على الكفر والظلم فيعذبهم وأما من آمن فله جزاء الحسنى وفي رواية ورش (فجزاء الحسنى).
(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (89) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90)) يعني كانوا في أقصى المشرق بعضهم يقول ناحية الصين، كوريا. (لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90)) ليس لديهم شيء يقيهم ويسترهم من الشمس لا أشجار ولا جبل ولا شيء. (كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (91)) لم يذكر قصة هؤلاء القوم لأنه في علم الغيب لكن المقصود من الآية أن مملكته كانت من مطلع الشمس إلى مغربها وأنه كان طوافًا وأينما ذهب كان يحاول الإصلاح وهذا هو الملك الصالح العادل كان يدعو إلى الله ويبذر بذور الخير والإيمان ويُصلح.
(حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93)) إما أن لغتهم كانت غير مفهومة لا يستبينها ولا يفهم من كلامهم وهم لا يفهمون حتى كلام الترجمان لأن الملوك قديما كانوا يمشون بالتراجم لكن هؤلاء القوم كانوا في أقصة الأماكن وكانت لديهم لغة يتعاملون بها فيما بينهم لا يكادون يفقهون أية لغة أخرى، والمعنى الثاني لا يكادون يفقهون قولا كانوا من البلادة ومن الجهالة ومن الغباء بحيث كانوا لا يفقهون أي كلام يوجه إليهم. ومع ذلك لما استأنسوا بوجود هذا الملك الصالح طلبوا منه أن يضع سدا فاصلا بينهم وبين يأجوج ومأجوج.
كيف يخاطبون ذا القرنين وهم لا يكادون يفقهون قولا؟ لا أحد أن يفسر هذا لأنه في علم الغيب لكن المهم أنهم تمكنوا من إيصال المعلومة هذا بتعبير القرآن الكريم. عندما تقرأ في قصة موسى أو في قصة مويم هل أولئك القوم تكلموا بتلك الفصاحة؟ إنما الله تعالى بلسان القرآن، بالبيان القرآني عبر عما كانوا يفعلون وهم استطاعوا أن يوصلوا الفكرة لذي القرنين ولا نعلم كيف.
(قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94))
من يأجوج ومأجوج؟
هؤلاء قوم يفسدون في الأرض ولا يصلحون منذ قديم الزمان وجاء ذكرهم في موضعين منها موضع سورة الكهف وكانوا يؤذون أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا فاستنجدوا بذي القرنين أن يجعل لهم حلا ولأن ذو القرنين كان رجلا موفقا ذا علم وحكمة فقال (قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95)) سخّر العمال من عندهم استطاع أن يضع سدا عظيما بينهم وبين يأجوج ومأجوج. وذكر يأجوج ومأجوج في سورة الأنبياء (حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96)الأنبياء)
بعضهم فسرها أنهم ليسوا قوما بعضهم قال يأجوج ومأجود رجل ورجل آخر فهما اثنان والبعض يقول أنهما نوع من الأمراض ليسوا بشرا، أمراض يأخذوها من الفعل ماج وآج التي تصيب، هذا كلام مما قاله العقلانيون الذين يريدون أن يفسروا كل شيء غيبي في القرآن بالعقل حتى يظهروا أمام الغرب وأمام كل العقلاء بأن في القرآن كلام منطقي، والحقيقة أن أن القرآن كله منطقي نعم لكن ثمة غيبيات لا بد أن نؤمن بها والإيمان بالغيب أول صفة من صفات المؤمنين (الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)) نحن نؤمن أن القرآن فيه غيب نؤمن بالجنة ونؤمن بالنار هذه حقائق. لذلك هؤلاء العقلانيون تأثر بهم الشيخ محمد عبده في تفسيره المنار مثلا يقول (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3)) يفسرها بأنه أصابهم نوع من الأمراض كالجدري. لا، قالوا لا يعقل أن طائرا يستطيع أن يحمل حجارة من سجيل ولا يحترق. لكن في المشيئة الإلهية كل شيء وارد (تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4)) (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74)الحجر) (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58)النمل) الغيبيات لا بد من الإيمان بها بما تحتمله اللغة العربية. وأنا قرأت عددا من التفاسير في الموضوع: هم قوم من علامات الساعة الكبرى لكثرتهم لا نستطيع أن نجزم لأنه يكون نوع من التخرص. ثمة آراء ونقف عند ما وقف عليه القرآن.
سؤال: نحن في القرن الحادي والعشرين والأقمار الاصطناعية تحيط بنا من كل جانب ألا تستطيع أن ترصد هؤلاء القوم بهذه الكثرة؟ ألا تستطيع أن ترصد السد الذي هو من النحاس والحديد؟
الجواب أن الأقمار الاصطناعية ما استطاعت بعد أن تحيط بالأرض من كل شبر، من كم سنة اكتشفوا سفينة نوح في جبل الأكراد ذات ألواح ودسر وجدوا تلك السفينة عن طريق الدسر (جبل الجودي) هذا الاكتشاف يحقق عظمة القرآن الكريم، وجدوا ألواحا خشبية متحفرة ووجدوا الدسر المسامير الكبيرة. ستأتي هذه الأقمار وستجد الردم لكن أين؟ على أي عمق؟
(يا معشر الجن تنفذوا من أقطار السموات والأرض) الأرض قطرها 12723 كلم كم استطاع العقل البشري والناسا أن تحفر في الأرض؟ أقصى شي وصلوا إليه في الحفر 17 كيلومتر بنسبة 0,2 من قطر الأرض! العلم البشري الآن بسيط جدا بما في هذه الكرة الأرضية والسموات ممكن عندما يتطور العلم أن يجدوا سد يأجوج ومأجوج.
سؤال: بعض أهل العلم المجتهدين اجتهدوا وأخذوا بعض القرآن حددوا المنطقة التي يزعمون أن الردم فيها فوجدوا أن هناك جبلان وبينهما ردم مغطى بالثلوج فحفروا ووجدوا نحاسا وحديدا أسفل الثلج، هل يمكن أن يكون هو؟
ممكن وليس لدينا أدلة قاطعة، لكن اين القوم الذين وراءه؟ هذا في علم الغيب وعندما يأتي وعد ربي كما قال ذو القرنين جعله دكاء وكان وعد ربي حقا سيقع ذلك..
نحن نؤمن بما جاء في القرآن أنه سيقع (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ) نحن مطالبون أن نؤمن بما ورد في القرآن من الغيبيات ونؤمن بما يتحقق بالعلم
سورة الكهف ثمة تقنتيان لغويتنا بارزتان هو جزء من شخصية السورة اللغوية
ظهور التمييز: التمييز في اللغة العربية الذي يميز ما قبله، يفسر إبهامًا قبله مثلا محمد أحسنهم خلقا، كثر التمييز في سورة الكهف بشكل لافت لأنها بنيت على كثير من الغرابة فجاء التمييز بشكل لافت (كبرت كلمة) (أيهم أحسن عملا) (أحصى أمد) (ولملئت رعبا) (أزكى طعاما) (لأقرب من هذا رشدا) (ساءت مرتفقا) (حسنت مرتفقا) (أكثر مالا وولدا وأعز نفرا) (أقل منك مالا) (خير ثوابا) (خير عقبا) (خير ثوابا وخير أملا) يمكننا الجزم أن التمييز أيقونة لغوية في سورة الكفف ولكل سورة تقنيات بارزة.
أيقونة أخرى أو لباس للسورة فسورة الكهف من بدايتها إلى نهايتها جاءت حافلة بالتقديم والتأخير بدرجة لافتة، في كل القرآن نجد تقديم وتأخير لكن في السورة موجود بشكل كبير (أن لهم أجرا حسنا) أجرا حسنا لهم (ما لهم به من علم) ما لهم من علم به، ما (فلعلك إن لم يؤمنوا بهذا الحيث اسفا) (كانوا من آياتنا عجبا) (ربنا آتنا من لدنك رحمة) (من دونه إلها) (ينشر لكم ربكم) (لوليلت منهم فرارا) فرارا منهم، أحصيت 91 جملة فيها تقديم وتأخير. السورة هي مبنية بهذا القالب الصوتي اللغوي لأن فاصلتها لكن البناء اللغوي التقديم والتأخير له أغراض بلاغية: للإختصاص، للإهتمام، لإبراز شيء، للحصر. شخصية السورة مبنية على التقديم والتأخير وكل سورة في القرآن لها خصوصية. لا يوجد سورة في القرآن وجد فيها التقديم والتأخير بمثل هذه الكثرة فسورة الكهف كثرة لافتة. في الجملة العربية الفعل والفاعل والمفعول به ولأجله ، هذا الترتيب موجود واستنبطه العلماء من لغة العرب وثمة ما يؤخر وحقه التقديم. نقول درس محمد القصيدة لكن لما نقول القصيدة درس محمد، فالتقديم يكون إما للإبراز للاهتمام للحصر، ثمة أغراض للتقديم. كل تقديم له معنى وفي سورة الكهف التقديم والتأخير كأنه صار أصلا فيها. وهذه التقنية لها صور أخرى ففي سورة الرحمن تكرار( فبأي آلآء ربكما تكذبان) تكرر 31 مرة هذه خصيصتها، في سورة القمر معظمها على صيغة مفتعل: (محتضر، مستقر، مزدجر مستمر، منهمر، منتشر، محتضر، مستطر، مقتدر، ) إذن الله يفعل ما يشاء في لغة القرآن ونحن نبرز هذه الظواهر.
رابط بداية السورة وختامها:
سورة الكهف (الحمد لله ) بداية بذكر الكتاب وهو القرآن ونعمة القرآن وآخر آية (لو كان البحر مددا) كلمات ربي أوسع من القرآن، كل شيء يعلمه الله جل ثناؤه وهو قادر على أن يقوله فهو كلمة وكلمات الله لا تنتهي، كلمات ربي نستطيع أن نسقطها على القرآن فالقرآن مبني بطريقة عجيبة، في أول السورة (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1)) في وسط السورة (وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27)) تدرج من الكتاب إلى الكلمات وفي الختام ذكر الكلمات يقصد القرآن ويقصد الكلمات التي لا تنتهي.
رد العجز على الصدر (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)) وأهل الكهف قالوا (هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15)) وأول السورة (وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5))
(قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109)) لا يظنن ظانّ أن كلمات الله تنتهي لأنه ربطها بالمداد فلا تنتهي كلمات ربي ولو نفد البحر، الآية على فرض كلمة (قبل) ليس معناه ستنفد ولكن من باب الافتراض. لأن كلمات الله هي علم الله اللانهائي ومشيئته مطلقة علم الله لا ينتهي ولتقريب الفكرة للبشر قال لو انتهت البحار ما انتهت كلمات الله من باب التقريب أما كلمات الله لا تنتهي (لو كان البحر مدادا)