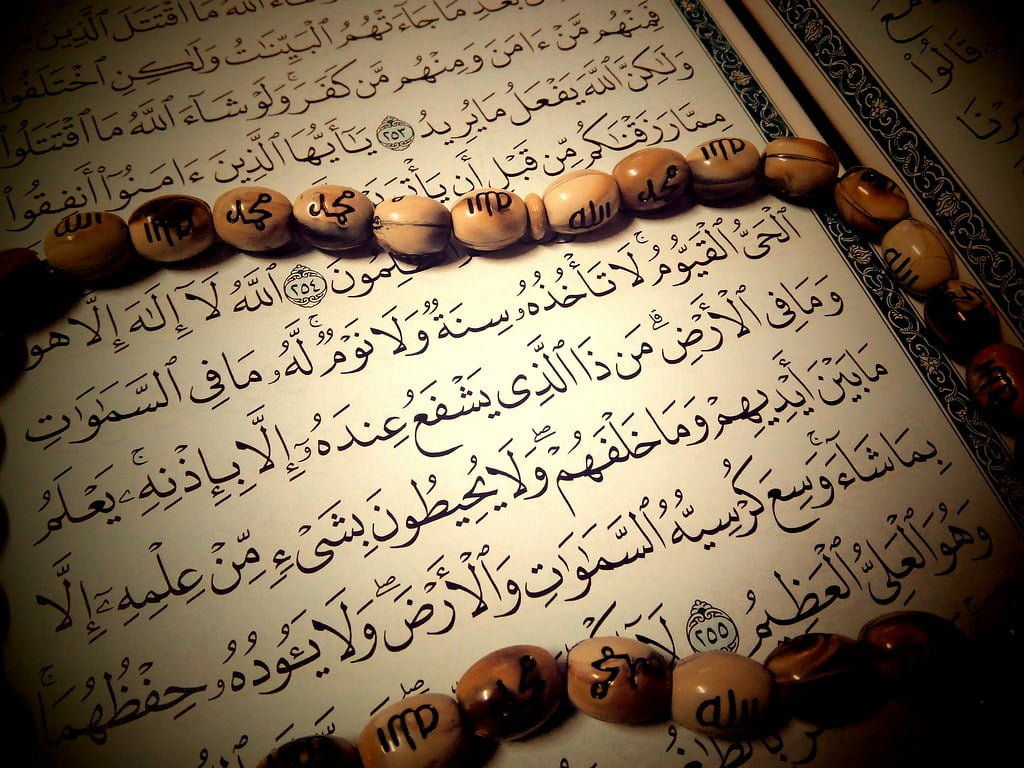سورة النور سورة مدنية تهتم بالآداب الاجتماعية عامة وآداب البيوت خاصة, وقد وجّهت المسلمين إلى أسس الحياة الفاضلة الكريمة بما فيها من توجيهات رشيدة وآداب سامية تحفظ المسلم ومجتمعه وتصون حرمته وتحافظ عليه من عوامل التفكك الداخلي والانهيار الخلقي الذي يدمّر الأمم. وقد نزلت فيها آيات تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها بعد حادثة الإفك (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ(11) وكل الآيات التي سبقتها إنما كانت مقدمة لتبرءتها. ثم يأتي التعقيب في (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ(12) وفيها توجيه للمسلمين بإحسان الظنّ بإخوانهم المسلمين وبأنفسهم وأن يبتعدوا عن سوء الظن بالمؤمنين، وشددت على أهمية إظهار البيّنة (لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ(13) ويأتي الوعظ الإلهي في الآية 17 (يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ). فالسورة بشكل عام هي لحماية أعراض الناس وهي بحقّ سورة الآداب الاجتماعية.
تبدأ السورة بآية شديدة جداً (سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(1) وفيها تنبيه للمسلمين لأن السورة فيها أحكام وآداب هي قوام المجتمع الإسلامي القويم.
تنتقل الآيات إلى عقوبة الزناة(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ(2)، والأصل في الدين الرأفة والرحمة أما في أحوال الزناة فالأمر يحتاج إلى الشدة والقسوة وإلا فسد المجتمع جرّاء التساهل في تطبيق شرع الله وحماية حدوده، لذا جاءت الآيات تدل على القسوة وعلى كشف الزناة . لكن يجب أن نفهم الدلالة من هذه الآية، فالله تعالى يأمرنا بأن نطبق هذه العقوبة بعد أن نستكمل بعض الضمانات لحماية المجتمع التي تتحدث عنها بالتفصيل الآيات التالية في السورة. والملاحظ في هذه السورة تقديم الزانية على الزاني وكما يقول الدكتور أحمد الكبيسي في هذا التقديم أن سببه هو المرأة التي تقع عليها مسؤولية الزنا فلو أرادت وقَع الزنا وإن لم ترد لم يقع فبيدها المنع والقبول، وهذا على عكس عقوبة السرقة (والسارق والسارقة) فهنا قدم السارق لأن طبيعة الرجل هو الذي يسعى في الرزق على أهله فهو الذي يكون معرضاً لفعل هذه الجريمة هذا والله أعلم.
ضمانات لحماية المجتمع:
1.الاستئذان:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(27) تعلمنا الآيات ضرورة الاستئذان لدخول البيوت وحتى داخل البيت الواحد للأطفال والخدم في ساعات الراحة التي قد يكون الأب والأم في خلوة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(58) ومن آداب الإسلام أن لا يدخل الأبناء على والديهم بدون استئذان.
2. غضّ البصر وحفظ الفرج:(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(30) وهذا توجيه للرجال والنساء معاً فهم جميعاً مطالبون بغض البصر.
3.الحجاب:(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(31).
4.تسهيل تزويج الشباب(وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(32) وتسهيل هذا الزواج لحماية الشباب الذي بلغ سن الزواج وبالتالي حماية المجتمع كاملاً.
5. منع البغاء:(وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(33).
6.منع إشاعة الفواحش بإظهار خطورة انتشارها:(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(19) و(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(24). فلقد لعن الله تعالى الذين يشيعون الفاحشة أو يرمون المحصنات وحذرهم من عذابه في الدنيا والآخرة.
نعود للآيات الأولى في حدّ الزنى ونرى أنه لا تطبيق لهذا الحدّ إلا إذا تحققت هذه الضمانات الاجتماعية أولاً وبعدها لوحدثت حادثة زنا لا يقام الحد حتى يشهد أربع شهود, ومن غير الشهود لا يطبق الحدّ فكأن إقامة الحد مستحيلة وكأنما في هذا توكيد على أن الله تعالى يحب الستر ولا يفضح إلا من جهر بالفاحشة, ولنا أن نتخيل أي إنسان يزني أمام أربع شهود إلا إذا كان فاجراً مجاهراً عندها هذا هو الذي يقام عليه الحدّ حتى لا يفسد المجتمع بفجوره وتجرئه على الله وعلى أعراض الناس في مجتمعه. فلو كان قد وقع في معصية ولم يكن له إلا ثلاث شهود لا يقام عليه الحد ويجب عليه التوبة والاستغفار, ولهذا جاءت في السورة آيات التوبة والمغفرة . (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ(10)و(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(5) و (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(14) و(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ(20).
حد القذف: حذّرنا الله تعالى في هذه السورة من قذف المحصنات وبيّن لنا العقوبة التي تقع على هؤلاء وهي لعنة الله وعذابه في الدنيا والآخرة.
آية النور: هذه الآية التي سميّت السورة باسمها فيها من الإعجاز ما توقف عنده الكثير من العلماء. ووجودها في سورة النور هو بتدبير وبحكمة من الله تعالى، فلو طبّق المجتمع الإسلامي الضمانات التي أوردتها الآيات في السورة لشعّ النور في المجتمع ولخرج الناس من الظلمات إلى النور، وشرع الله تعالى هو النور الذي يضيء المجتمع, ولذا تكررت في السورة (آيات مبيّنات وآيات بيّنات) 9 مرّات لأن هذه الآيات وما فيها من منهج تبيّن للناس طريقهم والنور من خصائصه أن يبيّن ويَظهر ويكشف. هذا النور الذي ينير المجتمع الإسلامي إنما مصدره (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(35)، وينزل هذا النور في المساجد (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ(36) وينزل على (رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ(37) والذي لا يسير على شرع الله يكون حاله كما في الآية (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ(39) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ(40).
وسميّت سورة النور لما فيها من إشعاعات النور الربًاني بتشريع الأحكام والآداب والفضائل الإنسانية التي هي قبس من نور الله على عباده وفيض من فيوضات رحمته.وتشبيه النور بمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريّ يوقد من شجرة مباركة، هذا التشبيه كأنه يدلّ على أن النور حتى نحافظ عليه مضيئاً يجب أن نحيطه بما يحفظه والفتيل الذي به نشعل النور إنما هو الآية الأولى في السورة هذه الآية الشديدة التي تحرك الناس لإضاءة مصباح مجتماعاتهم الصالحة بتحقيق الضمانات الأخلاقية حتى يبقى النور مشعّاً.
ذكر في أولها حدّ الزاني والقاذف (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)) (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)) وفي آخرها قال (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) ذكر في أول السورة قسماً من الذين يخالفون عن أمر الله (الزانية والزاني والقاذف) من قذف المحصنة والحد من الزاني والزانية وقال:(وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) يعني عذاب أليم، أولئك خالفوا عن أمره فأصابهم عذاب أليم، تصيبهم فتنة وعذاب اليم وكلاهما حصل (في حديث الإفك). (أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64)) ما فعلوا وأنكروا واحد قال لم أفعل كذا الذي يرمي الزوجة وهي تنكر أو العكس أو القاذف ربنا سيعلمهم بما عملوا (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64)). إذن مرتبطة بالعذاب الأليم والفتنة وإخبارهم بما فعلوا وإيضاح الأمر على حقيقته بما أضمر كل واحد منهم.
أول أمر نذكره أن أول سورة النور مرتبطة بأول سورة المؤمنون، هاتان السورتان مرتبطتان في الأوائل والأواخر. قال تعالى في أول سورة المؤمنون: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)) وبدأ بالذين لم يحفظوا فروجهم في سورة النور (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)) هذه البداية. وقال في أواخر المؤمنون: (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118)) وفي أول النور قال:(سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1))، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو – سورة أنزلناها، مَن الذي ينزل الأحكام ويفرضها ويأمر بإقامة الحدود؟ الملك الحق. الملك الحق هو الذي يأمر ويفرض, حتى عندنا في القوانين الملك هو الذي يفرض السلطة. فإذن سورة أنزلناها وفرضناها هذه أنزلها الملك الحق (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117)) هو الذي أنزل وفرض الأحكام، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى في أواخر سورة المؤمنون ذكر عذاب الكافرين (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105)), وفي بداية النور ذكر عذاب من استحق العذاب من المسلمين في الدنيا والآخرة حينما ذكر حد الزاني والزانية (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) ثم الإفك والقذف (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)) عذاب الكافر في الدنيا وعذاب العاصي من المسلمين في الدنيا والآخرة.
في آخر سورة النور قال:(أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64)) وفي أوائل الفرقان: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2)) ألا إن لله ما في السموات والأرض الذي له ملك السموات والأرض يعني له ملكهما وما فيهما.
سؤال: قد يقول قائل أنه ربما يكون في هذا تكرار؟ هذا ليس تكراراً أولاً ثم إن هذا أمر عقيدة يركزها ويركز ظواهرها، في أواخر النور قال:(لله ما في السموات والأرض) له ما فيهما وفي الفرقان (له ملك السموات والأرض) له ملكهما فقد تملك شيئاً لكن لا تملك ما فيه فقد تملك داراً ويستأجرها منك أحد فأنت تملك الدار لكنك لا تملك ما فيها وليس بالضرورة أن تملك داراً وتملك ما فيها كونه يملك السموات والأرض ليس بالضرورة أنه يملك ما فيهما ولذلك أكد القرآن أنه له ملك السموات والأرض وله ما فيهما ولا يكتفي بإطلاق الملك فقط بأنه يملك السموات والأرض حتى في حياتنا نملك الظرف ولا نملك المظروف ونملك المظروف ولا نملك الظرف، إذن هو ذكر أمرين: ذكر له ملك السموات والأرض وذكر لله ما في السموات والأرض الأمران مختلفان فله ملكهما وله ما فيهما.
في آخر النور قال:(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) هذا إنذار وفي أول الفرقان (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1)). وفي آخر النور قال (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64)) وفي أول الفرقان (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2)) الذي يخلق كل شيء ويقدره هو بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم وخلق كل شيء فقدره تقديراً.
سورة النور
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (2)) لاحظ كيف تقدّم ذِكْرُ المؤنث على المذكر في هذه الآية إذ ذكر البيان القرآني الزانية قبل الزاني على خلاف كثير من التشريعات الإلهية في القرآن الكريم. وذلك لأن المرأة هي الباعث على زنى الرجل بما تقوم به من إغراء ومقدّمات من شأنها إيقاع الرجل في شباك الخطيئة. أما لو منعت المرأة نفسها وصانت فرجها لما وجد الرجل إليها سبيلا.
(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)) تأمل كيف فرض رب العزة شهود جماعة من المسلمين لعذاب من يُقام عليهما حدُّ الزنا وذلك لتحقيق إقامة الحدّ والحذر من التساهل فيه. وحتى لا يكون ذلك مدعاة لاستخفاف المسلمين به. وأما الغرض الأسمى من حضور جماعة من المؤمنين فهو أن يتّعِظ الحاضرون ويرتدعوا عن إتيان ما يوجِب الحدّ.
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (4)) تبصَّر في مدلول هذه الآية التي تشير إلى أن يكون الشهداء أربعة غير الذي رمى، فما الغاية من هذا العدد وقد وجب وجود شاهدين لا أربعة في تعاملات أخرى؟ ذلك حتى لا تكون إقامة الحد بفِرية من متواطئين على الكذب لغاية في أنفسهم ضد من يرمونهم. ثم لتعذر اجتماع أربعة من الشهود إلى جانب القاذف في مشاهدة حادثة الزنى. وإذا تمّ ذلك فإنه يعني أن هناك مجاهرة من الزُناة وبذلك حقّ عليهم الحدّ حفاظاً على المجتمع وطهارته وأمنه.
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ (6)) انظر كيف أُعفي الزوج من إحضار أربعة شهود واكتُفي منه بأَيمان أربعة. وذلك لأن الزوج بما عنده من الغيرة يأنف من الإتيان بأربعة رجال ليشهدوا على زوجه وهي على هذه الحالة من التلبّس بالزنا لما في ذلك من تشنيع لها وفضحٍ لعِرضه قبل عِرضها.
(إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ (11)) لاحظ كيف جاء لفظ (عُصْبَةٌ) نكِرة مع أن الذين أشاعوا حادثة الإفك أُناس معروفون. وما ذاك إلا لتقليل شانهم وتحقير قولهم وإثبات كونهم فئة نكِرة لا يُعبأ بهم. ثم أعقبه ذلك وقال (مِّنكُمْ) ليدل على أنهم من المسلمين وأن ظلمهم أشد من صدوره من الكافرين والمشركين.
(إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (11)) انظر كيف عطف البيان الإلهي الجملة الإسمية (بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) على الجملة الفعلية (لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم) ولم يعطف مفرداً على مفرد فيقول لا تسحبوه شراً لكم بل خيراً لكم. وذلك لأن الجملة الإسمية تدل على الثبات والدوام والاستمرار مما يعني أنه خير متواصل. ولو عطف مفرداً على مفرد لأفاد خيراً آنياً مؤقتاً في هذه الحادثة.
(لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)) تأمل هذه الصياغة الموحية فلم يكتف تعالى بقوله “فأولئك الكاذبون” بل قال (فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) وذلك للمبالغة في كذبهم وشناعته وعِظَم إثمهم عند الله سبحانه وكأن غيرهم لا يُعدّ كاذباً لهول ما جاؤوا به من الإفك.
(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14)) تبصَّر كيف استعمل ربنا (أَفَضْتُمْ) ولم يقل “لمسّكم فيما تحدثتم فيه عذاب عظيم”. وذلك لأن الإفاضة صبّ الماء في الإناء والإكثار منه وخروجه من جوانبه. وهذا ما حصل منهم فعلاً فهم لم يتحدثوا فقط بل أسرفوا في الحديث وأشاعوه وتزيّدوا فيه حتى بلغ حدّاً لا يُحتمل.
(وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16)) لاحظ هذه الجملة الاعتراضية (سُبْحَانَكَ) التي توجَّه فيها الخطاب إلى الله عز وجل وذلك للإشارة أن الغاضب الأكبر من إشاعة الفواحش والإفك والبهتان هو الله سبحانه. فهو الأَوْلى بأن يُتوَجه إليه بالتوبة من الذين مسّهم الإفك.
(وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (22)) تأمل هذه الصيغة (أَلَا تُحِبُّونَ) فهي لم تُستعمل لمجرد الاستفهان وإنما أُريد منه الحضّ على العفو والصفح والحثّ على التسامح بما يضمن مغفرة الله عز وجل فهو غفر رحيم فكيف بالبشر؟!
(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)) من المعروف أن أعضاء الجسد كلها تشهد على صاحبها يوم القيامة فلِمَ خصّ الله عز وجل هذه الأعضاء هنا دون غيرها؟ ذلك لأن الذين جاؤوا بالإفك استعملوا هذه الأعضاء خاصة فنطقوا بألسنتهم بالزور والبهتان وأشاروا بايديهم إلى من طعنوا في طهارتها ونزاهتها أي السيدة عائشة رضي الله عنها ومشوا بأرجلهم لمجالس القوم وتواديهم إشاعة الخبر ونشر حديث الإفك.
(يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25)) لك أن تتسائل لِمَ وصف الله عز وجل ذاته بالمصدر (الْحَقُّ)؟ ذلك لأن الوصف بالمصدر يدل على ثبات الصفة في الموصوف كأن تقول: هذا رجل عدْلٌ. مما يعني أن ذاته سبحانه وتعالى متحققة بما لا يتطرق إليه العدم. وأنه صاحب حق وعدل من شأنه إثبات الحقيقة بعد شيوع الإفك والبهتان.
(أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)) لاحظ أن الله تعالى لم يقل “أولئك مبرأون من الإفك” بل قال (أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ) وذلك ليشير إلى أن ما زعموا لا يعدو أن يكون قولاً غير مطابق للواقع ولا يمُتُّ إلى الحقيقة بصلة ولا حاجة للاكتراث به والاهتمام بمضمونه.
(لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ (29)) انظر كيف قال تعالى (بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ) ولم يقل “بيوتاً غير مأهولة” وذلك ليدل على أن المراد من قوله (غَيْرَ مَسْكُونَةٍ) ليس خلوّها من السكان. فبيوت الأشخاص والأُسر لا يجوز دخولها بغير إذن سواء وُجد فيها أصحابها أم لم يوجدوا. إنما المراد أنها معدّة للسكن الدائم المتعارف عليه كالخانات والفنادق مما لا حاجة لأخذ الإذن بدخولها. فقاطنوها يعلمون بدخول القاصي والداني إليها. فهم على استعداد دائم من دخول أي شخص إليهم فلا حاجة في الاستئذان منهم.
(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30)) لِمَ قال ربنا (يَغُضُّوا) ولم يقل “يصرفوا” في قوله (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)؟ ذلك لأن غضّ البصر هو صرف البصر عن التحديق وعدم تثبيت النظر مع حياء وخجل. ثم أعقبه بقوله (مِنْ أَبْصَارِهِمْ) لأن النظرة الأولى مسموح بها وما بعدها منهيٌ عنه. وهذا ما وضّحه النبي صلى الله عليه وسلم لعليّ كرّم الله وجهه “لا تُتبع النظرة النظرو فإنما لك الأولى وليست الثانية” ولذا وجب الغضُّ من الأبصار ما كان تالياً.
(وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (33)) انظر إلى هذه الجملة (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) والتي يظن البعض أنها من قبيل الإطناب. وأن قوله تعالى (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء) يفي بغرض النهي وذلك لأن إكراه الفتيات على البغاء يدل على إباءٍ منهن واعتراض وهذا الإباء قد يكون لسبب أو لآخر لكن الأبشع والأشنع أن تجبر الفتيات على ارتكاب الفاحشة مع إرادتهن التحصن والعفة والطهارة. ففي ذلك تشنيع بهؤلاء المكرهين وتصوير لتكالبهم على الدنيا وأمرهم بالفواحش مقابل مال قليل وعَرَض ٍزائل.
(اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (35)) تأمل كيف قال رب العزة والجلال (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ) ولم يقل “نوره كمشكاة”. وذلك حتى لا يتوهم البعض تشخيص الذات الإلهية بشيء من المحسوسات. فهم ليس بجسم ولا عرض فلا شبيه ولا مثيل له سبحانه وتعالى. ولذلك أعقب القول بعدد من التشبيهات التمثيلية المتراكبة فقال (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ) وذلك حتى لا يُتوصل إلى صورة مشخصة للذات الإلهية. فهذا مما لا يمكن تصوره أو حصره في تخيّل أو تشبيه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.
(نُّورٌ عَلَى نُورٍ (35)) قد تتساءل عن سبب هذه الزيادة في قوله (نُّورٌ عَلَى نُورٍ) مع أنه ذكر قبلها ما يدل على ذلك كما رأينا عند قوله (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ)؟ ذلك ليدل على الغاية من كل هذه التشبيهات التمثيلية. فليس الغرض منها التشخيص والتصوير إنما هو توضيح هيئة هذا النور مما لا حدّ له. فالمصباح في مشكاة أشد إضاءة وإذا كان في زجاجة صافية تضاعف نوره وإذا كان زيته نقياً كان أشد إسراجاً.
(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ (36)) تبصَّر كيف قال تعالى (أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ) ولم يقل “أمر الله أن تُرفع” لأن الله عز وجل لم يأمر أهل التوراة والإنجيل باتخاذ الأديرة والصوامع والبيَع. لكنهم أحدثوها للاستعانة بها عند الانقطاع للعبادة. ولم ينههم الله تعالى عنها فدخلت في قسم المباح مما أذن الله فيه لعدم نهيه عنه.
(رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ (37)) لعلك تتساءل عن سبب تخصيص الرجال دون النساء في هذه الآية. ذلك لأن الرهبان والنُسّاك كانوا رجالاً. فانقطاعهم عن البشر واعتكافهم في صوامع وبِيَع بعيدة عن تجمعات الناس أمرٌ لا تقوى عليه النساء ولم تجترئن على فعله. ثم أعقبه بقوله (لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ) ليؤكد ذلك المعنى فهو ما اختص به الرجال دون النساء في تلك الأزمنة.
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء (39)) لاحظ تشبيه المعقول بالمحسوس. فقد شبّه البيان القرآني أعمال الكفار مما ليس محسوساً أو مشاهداً بالسراب في أرض منبسطة وهو مما يُدرَك ويُشاهَد وذلك لتقريب الحالة إلى الأذهان ومحاولة تصويرها وتشخيصها ليتم فهمها واستيعابها وتكون بذلك أقرب إلى الواقع وأوضح في التصور والإدراك.
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ (43)) لِمَ عدَل ربنا سبحانه عن قوله “يسوق سحاباً” إلى قوله (يُزْجِي سَحَابًا)؟ ذلك لأن الغاية هنا هي الحديث عن منشأ السحاب وليس عن تسييره من مكان لآخر. ثم إن الفعل (يُزْجِي) يدل على دنو السحاب وانضمامه مع بعضه وبذلك يصير كثيفاً متراكباً مكتنزاً بالماء مُصدراً البرق والرعد أثناء التحامه.
(وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ (45)) تأمل كيف استعملت (من) لغير العاقل عند قوله تعالى (مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ) (مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ) وذلك لأن المشي أكثر ما يُطلق على بني البشر. وقد استعمل المشي لهذه الكائنات كلها فلزم من ذلك تغليب ضمير العقلاء عليها. ولم يبدأ في ترتيبه بـ (مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ) وهم البشر المعنيون بالمشي لأن ترتيب الأجناس هنا ليس لغرض تمييز جنس على آخر بل لإظهار قدرة الله عز وجل وعظمته. فالزاحف على بطنه دون ظهور أعضاء المشي أعجب ممن يمشي على رجلين ومن يمشي على رجلين أعجب ممن يمشي على أربع. فبدأ بأكثرها تعقيداً وصولاً إلى أبسطها صورة.
(وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (48)) إن من عادة المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخاصموا أن يحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتداعوا إلى الأخذ برأيه وحُكمه. فلِمَ قيل (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) مع أنهم دعوا إلى النبي الكريم وحده؟ ذلك لأن حُكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف شرع الله عز وجل ولا يكون إلا عن وحي وإلهام. لذلك أعقبه بقوله (لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يُصدر حُكمه من شرع الله تبارك وتعالى.
(أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ (50)) لحظ كيف جاءت الجملة الأولى (أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ) إسمية ثم جاء بعدها جمل فعلية. وذلك لأن الجملة الإسمية تدل على الثبات والتمكن. فالمرض في قلوبهم متأصّل ولم يدخلها إيمان قوي مع يقين. ثم أعقبها بجمل فعلية ليدل على الحدوث والتجدد. فقد حصل لهم الإرتياب لأن قلوبهم مريضة لم يدخلها إيمان راسخ.
(قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54)) إن الخطاب في أول الآية شمل طاعة الله عز وجل ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فلِمَ قال هنا (وَإِن تُطِيعُوهُ) ولم يقل “وإن تطيعوهما”؟ ذلك إثبات أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن كونها طاعة لله سبحانه وتعالى. فمن أطاع النبي الكريم وقصد في ذلك وجه الله تعالى لم يكن في طاعته خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى في كل أوامره ونواهيه.
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ (55)) لاحظ كيف قيّد رب العزة والجلال استخلاف المؤمنين الصالحين في الأرض. وذلك ليدل على أن سطوتهم وجبروتهم لن تقتصر على الأمكنة التي يسكنونها من الأرض بل ستشمل كل أرجاء المعمورة بطريقة أو بأخرى. فيمكن أن يحكموها ويمكن أن تكون لهم صولة وجولة بين بقية الأمم والشعوب التي ستسعى عندئذ إلى مسالمتهم ومراضاتهم وبذلك يتم استخلافهم في الأرض كلها.
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ (55)) قد يتوهم البعض أن الله عز وجل لم يكن قد مكّن للمؤمنين دينهم بعد وأن ذلك سيتم لهم بعد إيمانهم وصلاحهم وليس هذا هو المقصود. وليس المراد من التمكين التثبيت والترسيخ بل الغرض منه الشيوع والانتشار. فعندما ينتشر دين الإسلام بين الأمم والشعوب ويكثر متّبعوه يصبح كالشيء الراسخ الثابت الذي لا يُخشى زواله. ولذلك أضاف الجين إلى أولئك المؤمنين الصالحين فقال (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ) لزيادة تشريفهم وإعلاء شأنهم.
(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (61)) تأمل كيف رخّص الله تعالى لهؤلاء ممن أصيبوا بعاهات تعذرهم. لكن لم يعدّها مباشرة فيقول “ليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج” بل عدّها كلٌ على حِدة فقال (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) وذلك لأن أعذراهم متفاوتة باختلاف أسبابها. لذلك فالحرج مرفوع عن كلٍ منهم بحسب مرضه وعذره. فيرخّص للأعمى فيما يشترط فيه البصر وللأعرج فيما يشترط فيه المشي أو الركض وللمريض بحسب مرضه وما يمكا أن يسقطه عنه من التكليف. وبدأ بالأعمى لأنه أشدهم عذراً.
(وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ (61)) لاحظ كيف عطف ربنا قوله (أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ) على قوله (مِن بُيُوتِكُمْ) ولم يذكر “بيوت أولادكم” وذلك لأن بيوت الأبناء متاحة للآباء أو مما يدخل في ملكيتهم يصورة أو بأخرى لقوله صلى الله عليه وسلم “أنت ومالك لأبيك”. فلزِِم من ذلك عدم ذكر بيوت الأبناء مما هو معلوم حكمه بالضرورة وليست بيوت الآباء والأمهات من قبيل ذلك. ولا يجوز للأبناء التصرف فيها إلا بإذن الوالدين أو أحدهما.
(قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا (63)) انظر إلى كلمة (يَتَسَلَّلُونَ) كم تعبِّر عن مضمونها. فالتسلل هو الإنسلال من صُرّة. أي الخروج بخفية خروجاً كأنه سلّ شيئاً من شيء. ويقال تسلل أي تكلّف الإنسلال مثل ما يقال تدخّل إذا تكلّف إدخال نفسه. ولذلك قال عنهم (يَتَسَلَّلُونَ) ولم يقل “ينسلون” ليصور شدة تكلفهم الخروج دون أن يشعر بهم أحد وأنّى لهم ذلك.
(وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64)) هل يريد الله تعالى أن يخبر المسيئين بما اقترفوا وحَسْب حتى قال (فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا)؟ أراد بـ(فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا) مجازاتهم وعقابهم جرّاء أعمالهم. فالإخبار إن لم يعقبه عقاب لا جدوى تُرجى منه
مقدمة عامة في رحاب السورة:
سورة الأنعام واحدة من السبع الطوال وواحدة من السور الخمس المفتتحة بالحمد وأول سورة مكية طويلة في ترتيب المصحف
ومن خصائصها أنها نزلت جملة واحدة شيّعها سبعون ألف ملك ذلك أن مقصدها العام يتعلق بالتوحيد عقيدة والتوحيد تطبيقا وهما لا ينفصلان عن بعضهما ولا يصح أحدهما بغير الآخر فالتوحيد كلٌ لا يتجزأ وهذا الذي تدعو إليه آيات السورة “عقيدة التوحيد وأدلته ومقتضياته” لخّصتها خاتمتها بأوجز عبارة وأبلغ بيان:
(قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (165) الأنعام)
السورة دعوة إلى قوام الدين كله وقوام الفرد والأسرة والمجتمع والأمة والإنسانية جمعاء لخصتها آيات الوصايا العشر التي افتتحت بالتوحيد الاعتقادي وأتبعته بالتوحيد العملي التطبيقي (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153))
ولخصتها أيضا محاورة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه فقد تسلّح بالتوحيد الاعتيادي (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض) فأرّقه أن يتخذ قومه أصناما آلهة فتدرّج معهم بأدلة الحق حتى أعلن برآءته من الشرك وأعلن توحيده العملي (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين)
سورة الأنعام كما وصفها د. صلاح الخالدي رحمه الله سورة “تعليمية تربوية حركية جهادية” تعلم المسلمين الحق وتعرّفهم بالله الحق – وقد تكرر لفظ الحق فيها ١١مرة – وتربيهم عليه وتدعوهم إلى الحركة به وتحثهم على الجهاد به وتأمرهم بتحدي الباطل ومواجهته بالحق وإقامة الحجة والبراهين والأدلة العقلية التي لا تقبل الشك ولا يرفضها إلا جاهل!
(فقد كذبوا بالحق لما جاءهم)
(وكذّب به قومك وهو الحق)
(إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين)
(ثم ردوا إلى مولاهم الحق ألا له الحكم..)
(وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق)
(قوله الحق وله الملك)
(والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزّل من ربك بالحق)
سورة تشحن القلب بالإيمان والتوحيد الخالص لله عزوجل من خلال ما تعرضه من أسماء الله الحسنى وصفاته وعظمته في الخلق وتحكمه في الكون وقدرته فلا رب ولا إله سواه ولا شريك له. وحين يتعرف العبد على الله ربه لا يسعه إلا عبادته وحده (ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل)
والعبد الذي امتلأ قلبه بالتوحيد وأدلته البينة مطالبٌ أن يدعو للتوحيد مقتديا بهدي أنبياء الله ورسله (فبهداهم اقتده) كما عرضته السورة من خلال نموذج إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم.
وتسمية السورة “الأنعام” له ارتباط وثيق بمقصدها تمثل نعم الله الكثيرة الظاهرة في الأنعام التي أحلّها الله عز وجل للناس تُذبح بذكر اسم الله عليها توحيدا لله خالقها ومسخِّرها لهم وهم ينتفعون بكل شيء فيها حلالا طيبا: لحمها وشحمها ولبنها وجلدها وصوفها وعظمها ورَوْثها وهي وسيلة للانتقال وحمل المتاع وغيره كثير.
فارتبط التوحيد الاعتقادي بالتوحيد التطبيقي والتحليل والتحريم، وقد تكرر ذكر الأنعام في السورة ٦مرات.
فتتاحها بالحمد يتناسب مع ما ورد فيها من النعم
🏷ابتداء بنعمة الخلق والإيجاد (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض)
🏷ثم نعمة الإمداد بما سخّره الله تعالى في الكون لحياة الإنسان (خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو…) (فالق الحب والنوى) (فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا) (وهو الذي أنزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء…) (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات…) (ومن الأنعام حمولة وفرشا)
🏷ثم نعمة الهداية إلى صراط الله المستقيم من خلال رسله وكتبه التي فيها بصائر تنير سبيل السالكين (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه) (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده) (وهديناهم إلى صراط مستقيم) (فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة) (قد جاءكم بصائر من ربكم..)
🏷ثم نعمة الاستخلاف في الأرض (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض)
🏷ثم نعمة المعاد للحشر والحساب حيث توفى كل نفس ما عملت بالعدل والحق الذي قامت عليه السموات والأرض (ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون)
وسور الحمد كلها: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر يبرز فيها التوحيد الاعتقادي والتوحيد العملي ونعم الله تعالى على الخلق بشكل واضح فلنُعِد قرآءتها بتدبر باحثين عن هذه المعاني.
📮المتدبر لسورة الأنعام يقرأ رسالتها التي تدعوه إليها فيربط التوحيد بالنعم وبالعمل وبالآخرة:
(قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16))
📮”كن إنعاميا ولا تكن أنعاميا”
النعم كالأدلة والبراهين والحجج أنزلها الله تعالى على الناس ليبتليهم ما هم فاعلون بها؟ فكُن عبدا حامدا لله تعالى على إنعامه عليك بتوحيده أولاً بقلبك وعقلك وعقيدتك ثم اشكره على نعمة التوحيد عبادة وعملا في سائر أمور حياتك ودلّ الخلق على الله وحذار أن تكون كالأنعام أو أضل تأكل وتشرب من نعمه وتعيش في أرضه ثم تتبع كل ناعق يدعوك لترعى في حقول شبهاته وباطله!
هذه مقدمة لسورة الأنعام العظيمة وسيأتي الحديث عن الأعمال التي تدعو إليها السورة ووقوفنا يوم القيامة بين يدي الله للحساب.
هذا والله أعلم.
✍️ سمر الأرناؤوط
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد الأول
الآيات 1-3
سورة الأنعام اسمها رمز للإنعام من الله عز وجل على عباده، والإنعام يستوجب شكر المنعم وشكر المنعم يكون بتوحيده والالتزام بشرعه وحكمه فهو الذي خلق السموات والأرض وهو الذي خلق الخلق وهو مالك وملك السموات والأرض وهو العليم بالسرائر والظواهر لا يخفى عليه شيء، كمال الخلق وكمال القدرة وكمال العلم، هو الله لا إله إلا هو سبحانه فالحمد لله…
أطلق عين بصيرتك وانظر لترى أدلة وبراهين وآيات عظمته وقدرته وعلمه وحكمه في ملكوته ليعود إليك البصر قائلا: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين…
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد الأول
الآيات 1-3
معاني الحمد
سورة الأنعام واحدة من خمس سور افتتحت بالحمد في القرآن الكريم وكل سورة منها افتتحت بحمد الله عز وجل على ما يناسب مقصدها ومحاورها ومواضيعها:
🌴فسورة الفاتحة كمال الحمد لله تعالى على ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلا.
🌴وسورة الأنعام كمال الحمد لله على كمال الخلق وطلاقة القدرة وكمال العلم وعلى أدلة وبراهين ذلك في آيات الكون وآيات القرآن.
🌴سورة الكهف كمال الحمد لله على إنزال الكتاب على عبده ليكون قيما على حياة العباد يعتصمون به للثبات في مواجهة الفتن ويأوون إلى كهفه ليجدوا الأمان والهدى والرشد.
🌴سورة سبأ كمال الحمد لله على ملكه لما في السموات وما في الأرض وعلى ملكه للدنيا والآخرة وعلى علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة علمه بالغيب وعلمه بالشهادة..
🌴سورة فاطر كمال الحمد لله على طلاقة قدرته في الخلق وعلى سعة رزقه ورحمته بالخلق وعلى تنوع خلقه وعظيم تدبيره لكونه وعلى كمال علمه بالغيب وبذات الصدور وعلى غناه عن خلقه وعلى حلمه بعد علمه وإمهاله خلقه لعلهم يؤمنوا..
هذا والله أعلم
الورد الأول
الآيات ١-٣
#للحفاظ
(الحمد لله) افتتحت بها ٥ سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر
(الحمد لله الذي) اشتركت فيها سورة الأنعام والكهف وسبأ
(الحمد لله رب العالمين) انفردت الفاتحة بهذا الافتتاح
(الحمد لله فاطر..) انفردت بها سورة فاطر.
💡تكرر فعل خلق في المقطع مرتين: خلق – خلقكم الأولى في خلق السموات والأرض والثانية في خلق الناس
💡تكرر فعل (يعلم) مرتين في المقطع:
يعلم سركم وجهركم – ويعلم ما تكسبون
💡تكرر ذكر السموات والأرض مرتين:
الأولى: السموات والأرض (عطفت الأرض على السموات)
الثانية في السموات وفي الأرض (بتكرار حرف الجر “في” الذي يفيد الظرفية)
💡تكرر لفظ “أجل” في المقطع مرتين:
أجلا – وأجل مسمى
الأولى تدل على الموت والثانية تدل على يوم البعث.
(أجل مسمى) ورد في القرآن في ٢٠ موضعا اثنان منها في سورة الأنعام
وكلمة (أجل) وردت في السورة ٥ مرات: أجلا – أجل مسمى (٢)- أجلنا – أجّلت
💡تكرر حرف العطف (ثم) ٣ مرات في المقطع:
يدل على التوبيخ في موضعين وكأن الله تعالى يوبّخ المشركين أبعدما تبين لكم أدلة قدرة الله في الخلق تعدلون وتمترون؟!
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
ثم أنتم تمترون
💡وموضع (ثم قضى أجلا) تدل على الترتيب والتراخي وكأنها تشير إلى مدة حياة الإنسان من خلقه إلى أن يحين أجله الذي قضاه الله تعالى.
💡أفعال الله عز وجل في المقطع:
خلق – جعل – قضى – يعلم
💡أسماء الله الحسنى في المقطع:
الله – رب
💡الجمع والإفراد
وردت السموات والظلمات بصيغة الجمع
وردت الأرض والنور بصيغة الإفراد
(خلقكم من طين)
الخلق من طين ورد في القرآن في ٧مواضع:
في الأنعام الآية ٢ (هو الذي خلقكم من طين)
في الأعراف الآية ١٢ (وخلقته من طين)
في المؤمنون الآية ١٢ (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) وحيدة في القرآن بلفظ سلالة
في السجدة الآية ٧ (وبدأ خلق الإنسان من طين)
في الصافات الآية ١١ (إنا خلقناهم من طين لازب) وحيدة في القرآن بوصف الطين ب “لازب”
في ص الآية ٧١ و٧٦ (إني خالق بشرا من طين) (وخلقته من طين)
💡تكرر ضمير الشأن “هو” في المقطع مرتين بداية آية:
(هو الذي خلقكم)
(وهو الله في السموات وفي الأرض)
فكأن الآية الأولى هي البداية وكل الآيات التي بعدها في السورة المفتتحة ب(وهو) معطوفة عليها.
ويتكرر الضمير “هو” في السورة ٣٢ مرة وهذا يدل على أسلوب التقرير الذي هو من خصائص سورة الأنعام كما يدل الفعل (قل) الذي تكرر فيها ٤٢ مرة على أسلوب التلقين وهما أسلوبان عظيما في محاجّة المعاندين المشركين وأمثالهم.
💡التعبير بصيغة الفعل المضارع (يعدلون- تمترون) يدل على التجدد والحدوث فكأن هذا ديدنهم مع براهين الحق يشكّون فيها.
💡تقديم الظلمات على النار لأن الظلام هو الأصل والنور طارئ
وارتبطت الظلمات والنور مع السموات والأرض لأنهما يحدثان من تأثير الكواكب في السموات على الأرض بحركة الشمس والقمر.
والظلمات والنور تشيران أيضا إلى ظلمات الشرك والكفر المتعددة التي يبددها نور الحق والتوحيد.
(كفروا بربهم) هم يؤمنوا بالله الخالق كما ورد في مواضع أخرى (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) لكنهم لجحودهم نعمة الخلق كفروا بربهم الذي خلقهم وخلق لهم الكون وسخّره لهم فما أشنع صنيعهم وكان الأولى أن يشكروا الله على إنعامه لا أن يكفروا به!!
هذا والله أعلم
الورد الأول
الآيات ١-٣
أسرة سور التوحيد:
سورة الأنعام سورة التوحيد الطولى
سورة الإخلاص سورة التوحيد القُصرى
سورة الزمر سورة التوحيد الوسطى.
والسور الثلاث مرتبطة بسورة الفاتحة التي تعّرف العباد برب العباد ليوحّدوه ويقرّوا له بالعبادة والاستعانة (إياك نعبد وإياك نستعين)
فإن حاجّك أحد في ربك فتلك سورة الأنعام تسلّحك بالأدلة والبراهين والآيات البينات الدالة على توحيد الله عز وجل المستحق للعبادة وحده فهو الله الخالق الرب الحكيم العليم المالك للسموات والأرض وما فيهن ومن فيهن. وهي سورة التوحيد الخالص لله في الاعتقاد وفي ما يتبعه من السلوك والعمل.
وإن أردت التعريف بالله عز وجل بما اختصّ به سبحانه من صفات فتلك سورة الإخلاص تنفرد بالتعريف بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهي سورة التوحيد الخالص لله في الاعتقاد والأسماء والصفات.
وإن أردت التعريف بالله عز وجل من خلال إخلاص التوحيد والعبودية له فتلك سورة الزمر توضح لك طريق التوحيد بمعرفة سبل النجاة في الدنيا والآخرة لسلوكها ومعرفة سبل الخسران لتجنبها.. وهي سورة التوحيد الخالص لله في السلوك عبادة وصدقا وتعاملا وعملا بالمنهج.
هذا والله أعلم
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد الثاني
الآيات ٤-٦
بعد المقدمة وبيان بعض الآيات التي تستوجب شكر الله عز وجل يأتي بيان حال الكافرين المعاندين مع الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته وإحاطة علمه وتناقشهم وتحذرهم:
-إعراض عن الآيات
-تكذيب بالحق رغم أدلته وبراهينه
-استهزاء
-عدم اتعاظ بمصائر الأمم السابقة المكذبة الهالكة.
فجاءت آيات المقطع:
-تهددهم وتتوعدهم على تكذيبهم بالحق (فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون)
-تعظهم بالدعوة للتفكّر بمصائر المكذبين قبلهم وتحذّرهم من أن يصيبهم العذاب كما أصاب من قبلهم (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن..)
-تحذرهم من استدراج الله لهم بالنعم كما استُدرج مَنْ قبلهم (وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تختهم)
وتهددهم بعاقبة ذنوبهم: الإهلاك (فأهلكناهم بذنوبهم) والاستبدال (وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين)
كم يظلم الناس أنفسهم باستكبارهم وتكذيبهم للحق وبراهينه الساطعة واستهزائهم بآياته الواضحة! يختارون بأنفسهم طريق هلاكهم!!
ولو أنهم كانوا من أهل البصائر والتفكر لرأوا الآيات وعقلوها فقادتهم إلى توحيد الله فأنقذوا أنفسهم من العذاب والهلاك.
شرط التمكين الحقيقي في الأرض: التوحيد فمن انحرف عنه انحرف عن شرط الاستخلاف وعرّض نفسه للإهلاك والاستبدال.
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
تأتيهم – يأتيهم
تكرر (من) ٦مرات: من آية- من آيات – من قبلهم – من قرن – من تحتهم – من بعدهم.
أهلكنا – فأهلكناهم
مكنّاهم – نمكّن
أفعال الله عز وجل في المقطع مما يتناسب مع مقصد توحيد الله:
أهلكنا – مكّناهم – نمكّن – وأرسلنا – وجعلنا – فأهلكناهم – وأنشأنا
تحول الخطاب من الخطاب المباشر في ختام المقطع السابق (يعلم سرّكم وجهركم) إلى الغيبة (وما تأتيهم من آية) تهوينا لشأنهم على قبيح صنائعهم.
#لطائف_وفرائد
(وجعلنا الأنهار) لم ترد إلا في سورة الأنعام أما باقي القرآن ففيه تسخير الأنهار أو جريانها.
وهي تتناسب مع ورود الفعل جعل في بداية السورة (وجعل الظلمات والنور)
(فأهلكناهم بذنوبهم) وردت في القرآن مرتين في سورة الأنعام وفي سورة الأنفال الآية ٥٤.
(كم أهلكنا من قبلهم من قرن) وردت في موضعين في القرآن:
في الأنعام وفي سورة ص الآية ٣
ووردت في السجدة الآية ٢٦ بلفظ القرون بصيغة الجمع (كم أهلكنا من قبلهم من القرون)
(وأرسلنا السماء مدرارا) من آيات الله في السموات
(وجعلنا الأنهار) من آيات الله في الأرض.
(من آيات ربهم) التعبير بلفظ ربهم يتناسب مع بداية السورة (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون)
تكرر الفعل (جعل) في السورة ١٩ مرة
وتكرر فعل (خلق) في السورة ٦ مرات
وتكرر فهل (أنشأ) في السورة ٤ مرات
#متشابه
في الأنعام: (وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين)
وفي الشعراء (وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين)
في الأنعام (فقد كذبوا بالحق إذ جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون) فيها تفصيل وذكر الحق يناسب ورود آيات وأدلة الحق.
وفي الشعراء (فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون) فيها إيجاز يناسب أسلوب السورة.
هذا والله أعلم
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد الثالث
الآيات ٧-١١
سبب كفر الكافرين ليس مرتبطا بقلة الآيات وإنما مرتبط بهم هم فهم يعرضون عنها عنادا واستهزاء وتكذيبا ولو أنهم لمسوا الآيات بأيديهم ورأوا بأعينهم حق اليقين لظلوا على إعراضهم ولأطلقوا الحجج الباطلة:
فيقولوا عن الآيات سحر
ويستهزئوا بالرسل..
وبعد تفنيد حال الكافرين المكذبين يأتي تلقين الحجة للرد عليهم وتحذيرهم من عاقبة استهزائهم وعاقبة تكذيبهم.
وهذا أسلوب السورة:
-تقرير الآيات الدالة على وحدانية الله (هو)
-حال المكذبين معها
-تلقين الحجّة (قل)
في المقطع وما سبقه من بداية السورة بيان لبعض سنن الله عز وجل الكونية:
-سنّة إرسال الرسل والكتب والآيات وإقامة الحجة
-سنة إرسال الرسل من جنس المرسل إليهم
-سنّة الإمهال للمكذبين
-سنة الاستبدال
-سنّة إهلاك المكذبين بعد مجيء الآيات
-سنّة عقوبة المستهزئين وعقوبة المكذبين
-سنة السير في الأرض للاتعاظ والتفكر
-سنة أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله
#تدبر
(ولو نزّلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين)
[كتابا، قرطاس، فلمسوه بأيديهم] أشد الكفر أن تعاين الحق وتراه عين اليقين وحق اليقين فتُعرض عنه وتكفر به!
ونحن نحتاج أن نتدبر حالنا مع هذه الآية: القرآن بين أيدينا في المصاحف نقرأها بأعيننا ونلمسه بأيدينا فماذا نقول؟! قد لا نقول “إن هذا إلا سحر مبين” وإنما يوجد من بيننا من يقول: نهجره والله غفور رحيم!! “لا وقت لدينا لقرآءته” “القرآن يتكلم عن زمن مضى وأقوام مضوا ولا يناسب عصرنا” وغيره وغيره من الردود التي يندى لها الجبين!!
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
(نزّلنا – أُنزل – أنزلنا) ورد الفعل بالتضعيف بصيغة الماضي وورد مبنيا لما لم يسمى فاعله وورد مخففا بصيغة المضارع. والفعل يوحي بمصدر التنزيل.
وكذلك يدل عليه تكرار حرف الجر (عليك – عليه – عليهم)
(لقال – وقالوا – قل) تكرار يدل على المحاورة والمحاجّة.
(ملك – ملكا – ملكا)
تسمية الأشياء بمسمياتها وتكرار ذكرها أسلوب في المحاججة.
(الذين كفروا – الذين سخروا) من أساليب القرآن إظهار الفعل الذي يبرز صفة المتحدَّث عنهم وعاقبته، الكفر دفعهم لإلقاء الشبهات (إن هذا إلا سحر مبين) وسخريتهم واستهزاؤهم كانت سببا في هلاكهم.
(ولو نزّلنا – ولو أنزلنا – ولو جعلناه) تكرار (لو)
(ولو جعلناه ملكا – لجعلناه رجلا) الجعل فيه صيرورة من حال إلى حال فلو جعل الله الرسول ملكا لجعله رجلا لأنه الرسول لا بد أن يكون من جنس المرسل إليهم وبلسانهم أيضا ليكون أدعى للقبول.
التعبير بلفظ (قرطاس) من فرائد السورة لم يتكرر في غيرها. ورد مرتان فيها: مرة بالإفراد (قرطاس) ومرة بالجمع (قراطيس)
والقرطاس: رَقٌّ ينبسط ممتدًّا يُخْرق بسهم أو يُؤَثَّر فيه بما يشبه ذلك وهو الكتابة بقلم له سن دقيق يرسم فيه. وقد نشأت الكتابة نقشًا في الحجارة، وخَدْشًا في الطين، ورسمًا على العُسُب إلخ. {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ} [الأنعام: 7]، {تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ} [الأنعام: 91] أي صُحفًا. [المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم]
ولعل التعبير بلفظ (قرطاس) يتناسب مع ما في السورة من الآيات البينات التي بها تقام الحجة على كل مكذّب معاند!
(ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون)
٣ سور في القرآن افتتحت ب(ولقد استهزئ برسل من قبلك)
مرتان آية متطابقة في سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء آية ٤١
واختلفت آية سورة الرعد ٣٢ في ختامها (ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب)
(قل سيروا في الأرض “ثم” انظروا كيف كان عاقبة المكذبين)
من انفرادات سورة الأنعام مجيء “ثم” وباقي المواضع وردت بالفاء (فانظروا) في ٣ مواضع:
النمل ٦٩
العنكبوت ٢٠
الروم ٤٢
والتعبير بحرف العطف “ثم” يدل على أن السير المأمور به في الأرض سير يأخذ زمنا للاتعاظ والاعتبار والتفكر في الآيات المبثوثة ليس مجرد سير سريع عابر في الأرض لا يُرجى من ورائه فائدة!
وقد تكرر استعمال “ثم” في المقطع مرتين:
(ثم لا يُنظرون – ثم انظروا)
(استهزئ – سخروا – يستهزئون)
الفرق بين السخرية والاستهزاء:
🔹معنى السخرية الاستهانة والتحقير، والتنبيه على العيوب والنقائص، على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل، وقد يكون بالإشارة والإيماء.
🔸الاستهزاء هو: ارتياد الهزء من غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله.
ويُفرّق بين السخرية والاستهزاء باعتبار الدافع لكلٍّ منهما؛ فإن كان الدافع للقيام به مذلّة الطرف الآخر فهو سخريةٌ؛ لأن الأصل في التسخير هو التذليل، وإن كان الدافع له مجرّد التقليل من شأن الطرف المقابل فهو الاستهزاء.
هذا والله أعلم
الورد الرابع والخامس
الآيات 12 – 16
بعد ختام المقطع السابق بأول تلقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجج من خلال الالتفات إلى الماضي والاتعاظ بمصير الأقوام والأمم المكذبة السابقة وعاقبتهم انتقلت الآيات للمزيد من أدلة الوحدانية من خلال أسئلة تقريرية تحمل في طياتها الإجابات حتى لو يُجب السائل.
فمن بداية السورة وآياتها تقدّم أدلة كمال قدرة الله تعالى في الخلق والعلم وإحكامه للكون ويأتي الاستدلال في هذا المقطع بما سبق تقريره:
فبعد (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض) يأتي السؤال: قل لمن ما في السموات والأرض؟ لا شك أن الإجابة (الله)
ومن أعظم التعريف بالله الخالق أنه (كتب على نفسه الرحمة) على عظمته وقدرته وسعة علمه وإحكامه للكون بمن فيه وما فيه فقد كتب على نفسه الرحمة والمتأمل في الآيات السابقة كلها يتجلى له صور الرحمة الإلهية العظيمة:
فبرحمته سبحانه خلق السموات والأرض
وبرحمته جعل الظلمات والنور
وبرحمته خلق البشر من طين
وبرحمته قضى آجال الخلق
وبرحمته قضى أجلا مسمى يجمع فيه الخلق جميعا يوم القيامة
وبرحمته يعلم السر والجهر ويستر ويُمهل
وبرحمته أنزل الآيات بيّنة هادية للخلق
وبرحمته مكّن لبعض خلقه في الأرض
وبرحمته أرسل السماء عليهم مدرارا
وبرحمته جعل الأنهار تجري من تحتهم
وبرحمته بالمؤمنين أهلك المكذبين وجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم ليتعظوا ويؤمنوا
وبرحمته شرع التوبة ليتوب الخلق
وبرحمته استبدل الكافرين المكذبين
وبرحمته أرسل الرسل
وبرحمته دافع عن رسله من استهزاء المستهزئين
وبرحمته جعل الأرض مكان سير واعتبار
وبرحمته جعل القيامة يوما للجزاء والحساب
وبرحمته جعل الليل والنهار
وبرحمته فطر السموات والأرض
وبرحمته رزق الخلق وأطعمهم
وبرحمته يصرف العذاب عمن أسلم وجهه له ولم يشرك به أحدا
فالحمد لله على رحمة الله التي كتبها سبحانه على نفسه..
إله رحمن رحيم حليم على خلقه لطيف بهم سميع لهم عليم بحالهم خلقهم ورزقهم وهداهم أيُتخذ من دونه أولياء؟!
لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الفضل والمنّة.
#للحفاظ
تكرر في الآيات:
أسلوب التلقين باستخدام الفعل (قل) 5 مرات، افتتحت بها 3 آيات في المقطع وتكررت مرتين في آيتين:
قل لمن ما في السموات والأرض؟
قل لله
قل أغير الله أتخذ وليّا
قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
قل “إني أُمرت” أن أكون أول من أسلم – قل “إني أخاف” إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
دليل تكليف النبي صلى الله عليه وسلم (أُمرتُ) ودليل أمانته صلى الله عليه وسلم في التبليغ ودليل بشريته خوفه من معصية ربه ومن عذابه يوم القيامة.
من أسلم وجهه لله ولم يشرك به أحدا خاف من معصيته ليقينه بأن ربه سيحاسبه.
ليجمعنّكم إلى “يوم: القيامة – عذاب “يوم” عظيم – من يُصرف عنه “يومئذ”
تذكير مكثّف بالآخرة وما فيها من الحشر والحساب والجزاء.
كتب على نفسه “الرحمة” – من يُصرف عنه يومئذ فقد “رحمه”
من رحمة الله تعالى أن يصرف عن عباده المؤمنين العذاب يوم القيامة وذلك الفوز المبين.
قل لمن ما في السموات والأرض – فاطر السموات والأرض
يُطعم ولا يُطعم
صفات الإله الحق لا يحتاج ما يحتاجه المخلوقين من طعام وشراب (وهو الذي يطعمني ويسقين) أما الآلهة المزعومة فيقدّم لها القرابين والطعام من عابديها فيا لها من آلهة تحتاج من يُطعمها!
(الذين خسروا أنفسهم) تكرر أسلوب التعبير باسم الموصول وصلته في السورة منذ بدايتها: الذين كفروا، بالذين سخروا، الذين خسروا. إظهار المعصية التي استحقوا بها الإهلاك والعقوبة.
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون خسروا أنفسهم يوم القيامة باختيارهم الكفر على الإيمان– يقابلهم الذي يخافون إن عصوا ربهم عذاب يوم عظيم فهؤلاء يُصرف عنهم العذاب ويكونوا من الفائزين فوزا مبينا لا من الخاسرين.
(وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم) السكون يعقب الحركة وكلاهما دليل على وجود الخالق الذي خلق الليل والنهار وجعل الليل سكنا والنهار معاشا وهو السميع لكل موجود سواء كان ساكنا أو متحركا عليم لا يخفى عليه شيء في كونه كله. وفي الآية تحذير غير مباشر للخلق بأن يتقوا الله السميع العليم في سرهم وجهرهم في سكونهم وحركتهم في ليلهم ونهارهم فإنهم سيُجمعون يوم القيامة ويحاسَبون.
(“وهو” السميع العليم) – (“وهو” يُطعم ولا يطعم) أسلوب التقرير باستخدام الضمير (هو)
(فاطر السموات والأرض) تكررت في القرآن 6 مرات: في الأنعام 11، يوسف 101، إبراهيم 10، فاطر 1، الزمر 46، الشورى 11.
(ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه)
(لا ريب فيه) ورد في القرآن 14 مرة في سياق الحديث :
عن الكتاب (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)
وعن يوم القيامة (فكيف إذا جمعناهم ليوم القيامة لا ريب فيه) (وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه)
وعن الأجل (وجعل لهم أجلا لا ريب فيه)
وعن الساعة (وأن الساعة لا ريب فيها)
(قل أغير الله أتخذ وليا) انفردت بها سورة الأنعام
(ولا تكونن من المشركين) وردت في القرآن في 3 مواضع: في الأنعام 14، يونس 10 (وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين)، القصص 87 (وادعُ إلى ربك ولا تكونن من المشركين)
(ليجمعنّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) وردت في القرآن في موضعين: في النساء 87 (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) وفي الأنعام 12 (كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه)
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد السادس والسابع
الآيات 17 – 24
#للحفاظ
(وإن يمسسك الله بضرّ – وإن يمسسك بخير) تكرر فعل المسّ
(وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو) تكررت في القرآن في افتتاح آيتين: في سورة يونس 107 وفي سورة الأنعام 17 [بين سورة الأنعام ويونس أكثر من موضع متشابه]
في الأنعام ورد فعل المسّ مع الخير وورد في سورة يونس (وإن يُرِدكَ بخير فلا رادّ لفضله)
ختام آية الأنعام (وهو على كل شيء قدير) تناسب سياق السورة في سوق الأدلة على عظيم قدرة الله تعالى وكمال علمه، يكشف الضر ويجلب الخير بقدرته سبحانه.
وختام آية يونس يتناسب مع ما ورد فيها من تكرار لفظ فضل (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إن الله لذو فضل على الناس، فلا رادّ لفضله).
(وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير)
لم يرد اسم القاهر في القرآن إلا مرتين في سورة الأنعام في الآية 18 وفي الآية 61 (وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة..)
(وهو الحكيم الخبير) وردت في القرآن في 3مواضع، إثنان في الأنعام في هذه الآية 18 وفي الآية 73 (وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير) وفي سورة سبأ الآية 1 (الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير)
ووردت صيغة (حكيم خبير) مرة واحدة في الآية الأولى من سورة هود (من لدن حكيم خبير).
الفعل (قل) تكرر 4 مرات في آية واحدة في هذا المقطع (“قل” أي شيء أكبر شهادة “قل” الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى “قل” لا أشهد “قل” إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون)
وتكرر في الآية لفظ شهد ومشتقاته 4 مرات أيضاً: شهادة، شهيد، لتشهدون، أشهد. وقد تكرر لفظ شهد ومشتقاته في السورة 11 مرة.
(الله شهيد بيني وبينكم) وحيدة في القرآن في سورة الأنعام.
تكرر في المقطع لفظ “شرك” ومشتقاته 4 مرات من مجموع 28 في السورة: تشركون، أشركوا، شركاؤكم، مشركين.
(إنما هو إله واحد) وردت في موضعين اثنين في القرآن فقط: الأنعام 19 والنحل 51 (لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون)
(بريء مما تشركون) وردت في 3 مواضع في القرآن، اثنان منها في سورة الأنعام 19 (“وإنني” بريء مما تشركون) و78 (:إني” بريء مما تشركون) وفي سورة هود 54 (واشهدوا أني بريء مما تشركون)
تكرر لفظ “كذب” في المقطع 3مرات: كذبا، كذّب، كذبوا. وتكرر لفظ “كذب” ومشتقاته في السورة 20 مرة.
(أظلم – الظالمون) تكرر في السورة لفظ “ظلم” ومشتقاته 17 مرة. وهو يتناسب مع تكرار لفظ الشرك ولفظ الكذب.
(الذين آتيناهم الكتاب “يعرفونه” كما “يعرفون” أبناءهم) وردت في القرآن في موضعين اثنين فقط: في سورة البقرة 146 وفي الأنعام 20 مع اختلاف ختام الآيتين.
(الذين خسروا أنفسهم فهو لا يؤمنون) تكرر هذا الختم للآية مرتين في سورة الأنعام في الآية 12 وفي الآية 20.
(الذين خسروا أنفسهم) وردت في القرآن في 7 مواضع من بينها موضعي سورة الأنعام مع اختلاف في ختام الآيات يتناسب مع كل موضع [الأنعام 12 و20، الأعراف 9، هود 21، المؤمنون 103، الزمر 1 والشورى 4]
(ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا) افتتحت بها آيتان في القرآن كله: الأنعام 22 (“ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا” أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون) ويونس 28 (“ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا” مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون)
(ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذّب بآياته) وحيدة في القرآن ابتدأت بحرف العطف الواو ووردت مرتين بالفاء (فمن أظلم) في سورة الأعراف 37 ويونس 17.
(ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا) وردت في القرآن في 4 مواضع مفتتحة بالواو: الأنعام 21 و93 وهود 18 والعنكبوت 68
ووردت بالفاء (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) في 4 مواضع: الأنعام 144، الأعراف 37، يونس 17، الكهف 15.
(إنه لا يفلح الظالمون) وردت في القرآن في 4 مواضع اثنان منها في سورة الأنعام: 21 و135 وفي سورة يوسف 23 وسورة القصص 37.
ومناسبة تكرارها في سورة الأنعام كثرة الحديث فيها عن الشرك والمشركين ومعلوم أن الشرك ظلم عظيم (إن الشرك لظلم عظيم) (ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما) ولذلك ناسب أيضا ختام الآية 24 (وضل عنهم ما كانوا يفترون)
القسم (والله ربنا) لم يرد في القرآن إلا في سورة الأنعام 23.
(كذبوا على أنفسهم) لم ترد إلا في سورة الأنعام 24.
(وضلّ عنهم ما كانوا يفترون) ختمت بها 6آيات في القرآن: الأنعام 24، الأعراف 3، يونس 30، هود 21، النحل 87، القصص 75.
#لطائف
لفظ (القرآن) لم يرد في السورة على طولها إلا مرة واحدة.
ولفظ “الكتاب” تكرر في السورة 9 مرات.
#تأملات_قرآنية
في المقطع السابق من بداية السورة إلى الآية 17 تجلّت مظاهر وآثار رحمة الله عز وجل كما ذكرنا في التعليق على المقطع السابق فكانت الآيات مفصّلة لقوله تعالى (كتب على نفسه الرحمة)
وفي المقطع الحالي المفتتح بقول الله تعالى (وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير) والآيات التي تليه سوف يأتي التفصيل عن آثار قهره عز وجل وحكمته وعلمه.
ومن آثار اسمه القاهر إقامة الحجة على المشركين وتهديدهم بيوم الحساب يوم يحشرهم الله جميعا ويفضح كذبهم وافتراءهم ومزاعمهم وظلمهم لأنفسهم بالشرك واتخاذ آلهة من دون الله.
ومن آثار اسمه القاهر واسمه الخبير فضح مزاعمهم في الدنيا وافتراءاتهم وإخفاءهم ما في كتبهم من بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصفه وتكذيبهم بالآيات الواضحات.
ومن آثار اسمه الحكيم إرسال الرسل والكتب إنذارا للناس وبلاغا لهم ليؤمنوا بالله ويوحّدوه فيفلحوا في الدنيا والآخرة.
#تدبر
(وضلّ عنهم ما كانوا يفترون) التعبير بـ(ما) لغير العاقل تحقيرا للشركاء الذين اتخذهم الكافرون آلهة وأولياء من دون الله بزعمهم أنهم يشفعون لهم أو ينفعونهم، أين ما كانوا يفترون؟!!
في المقطع السابق (كتب على نفسه الرحمة ليجمعنّكم إلى يوم القيامة) بشارة ونذارة، بشارة للمؤمنين برحمة الله تعالى ونذارة للمشركين عسى أن يثوبوا ويتوبوا لتنالهم رحمة الله قبل فوات الأوان.
وفي المقطع الحالي (ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون) تهديد للمشركين الذين خسروا أنفسهم فلو يؤمنوا وافتروا على الله الكذب وكذبوا بآياته واستمروا بالكذب حتى يوم الحساب (والله ربنا ما كنا مشركين) أيّ ظلم للنفس أكبر من أن يقسم هؤلاء كاذبين وقد رأوا الآخرة بأم أعينهم؟!!
(ثم لم تكن فتنتهم) التعبير بـ(ثم) من خصائص أسلوب سورة الأنعام فقد تكرر فيها 21مرة من مجموع 338 مرة في القرآن كله تسبقها سورة البقرة التي تكرر فيها (3م) 28 مرة.
والتعبير بـ(ثم) الدالة على الترتيب والتراخي يوحي بأنهم يوم الحساب وبعد أن سُئلوا عن شركائهم لم يجيبوا مباشرة وكأنهم أخذوا وقتا للبحث عن حجة يحتجون بها أو مبرر لشركهم فلم يجدوا بعد ذلك القوت غير الحلِف الكاذب!!
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد الثامن والتاسع
الآيات 25 – 32
#للحفاظ
(ولو ترى إذ وقِفوا على النار) – (ولو ترى إذ وقِفوا على ربهم)
وقوفان: أحدهما على شفير النار والآخر بين يدي الله سبحانه وتعالى
وفي الوقوف الأول تمنّوا (يا ليتنا نردّ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين)
وفي الوقوف الثاني تحسّروا (يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها)
تكرر في المقطع فعل القول بمشتقاته وذلك ليتناسب مع مشهد الحوارات يوم القيامة بين الله تعالى والمشركين:
يقول – فقالوا – وقالوا – قال – قالوا – قال – قالوا.
تكرر فعل كذّب ومشتقاته: ولا نكذّب – وإنهم لكاذبون – الذي كذّبوا
(ليتنا نردّ ولا نكذّب): أمنية المكذبين يوم القيامة
(وإنهم لكاذبون): فضحهم وتوصيف حالهم
(قد خسر الذين كذّبوا): خسارتهم يوم القيامة بسبب كذبهم
تكرر لفظ الربوبية: ربنا – ربهم – ربنا –
تكرر: نردّ – ولو رُدّوا
حتى إذا جاؤوك – حتى إذا جاءتهم الساعة
(حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة) وحيدة في سورة الأنعام وفي باقي المواضع: تأتينا الساعة، أتتكم – تأتيهم. والفرق بين جاء وأتى أن المجيء فيه مشقة والإتيان أيسر.
(ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) [الأنعام: 30]
تتشابه مع آية سورة الأحقاف (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)
(يا حسرتنا) فريدة في سورة الأنعام ووردت في غيرها (يا حسرة على العباد) [يس: 30] و(يا حسرتا) [الزمر: 56]
(لعب ولهو) وردت في القرآن بهذا الترتيب في 3 مواضع: آية سورة الأنعام (32)، محمد (36)، الحديد (20).
(وللدار الآخرة خير) لم ترد بهذه الصيغة إلا في سورة الأنعام.
(ألا ساء ما يزرون) وردت في موضعين في القرآن في آية الأنعام وفي سورة النحل (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) [النحل: 25]
افتتحت آيات المقطع بالحديث عن بعض الجوارح (قلوبهم، آذانهم، اللسان (من قوله يجادلونك، وختم المقطع بـ(أفلا تعقلون) إذ ما نفع وسائل الإدراك إن لم تقد العقل للإقرار بعظمة الخالق والقلب ليؤمن به؟!
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد العاشر
الآيات 33 – 35
#للحفاظ
(“قد” نعلم) – (“ولقد” كُذّبت رسل) – (“ولقد” جاءك من نبأ المرسلين) “قد” تفيد التحقيق
“أتاهم” نصرنا – “جاءك” من نبأ المرسلين – “فتأتيهم” بآية
(قد نعلم) تكررت في القرآن في 3 مواضع كلها في سياق تسلية النبي صلى الله عليه وسلم
في الأنعام (قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون) انفردت بصيغة (قد نعلم)
في الحجر الآية 97 (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون) بإضافة الواو واللام (ولقد نعلم)
في النحل الآية 103 (ولقد نعلم أنما يقولون إنما يعلمه بشر) بإضافة الواو واللام (ولقد نعلم)
(بآيات الله يجحدون) وردت في موضعين في القرأن:
في الأنعام 35 (ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)
وفي سورة غافر الآية 63 (كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون)
(كُذّبت رسل من قبلك) وردت في موضعين في القرآن بصيغة التأنيث (كُذّبت)
في الأنعام (ولقد “كُذّبت رسل من قبلك”)
وفي فاطر الآية 4 (وإن يكذبوك فقد “كُذبت رسل من قبلك” وإلى الله ترجع الأمور)
ووردت بصيغة المذكّر (كُذّب) في سورة آل عمران 184 (فإن كذبوك فقد كُذّب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير)
(أتاهم نصرنا) انفردت آية سورة الأنعام بالفعل “أتاهم” مع النصر
وفي يوسف 110 (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا فنجّي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين) التعبير بالفعل جاء مع النصر
وكذلك في سورة النصر (إذا جاء نصر الله والفتح) وفي العنكبوت 10 (ولئن جاء نصر من ربك ليقولنّ إنا كنا معكم..)
(لا مبدّل لكلمات الله) انفردت آية الأنعام 36 بذكر اسم الجلالة (الله)
بينما وردت في سورة الأنعام 115 (..لا مبدّل لكلماته)
وفي سورة الكهف 24 (..لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا)
(وإن كان كبُر عليك إعراضهم) في سورة الأنعام في سيااق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
في يونس 71 (يا قوم إن كان كبر عليك مقامي وتذكيري) على لسان نوح عليه السلام مخاطبا قومه.
في غافر 3 (كبُر مقتا عند الله)
في الشورى 13 (كبُر على المشركين ما تدعوهم إليه)
في الصف 3 (كبُر مقتا عن الله أن تقولوا ما لا تفعلون)
(ولو شاء الله) وردت 3 مرات في سورة الأنعام من مجموع 11 مرة في القرآن كله
في الأنعام 36 (ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى)
في الأنعام 107 (ولو شاء الله ما أشركوا)
في الأنعام 137 (ولو شاء الله ما فعلوه)
(من الجاهلين) وردت في 4 مواضع في القرآن
في البقرة 67 (قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) على لسان موسى عليه السلام مخاطبا قومه
في الأنعام 36 (ولا تكونن من الجاهلين) خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم
في هود 46 (إني أعظك أن تكون من الجاهلين) خطاب من الله عز وجل لنوح عليه السلام حين سأل ربه إنجاء ابنه
في يوسف 33 (وأكن من الجاهلين) على لسان يوسف سائلا ربه أن يصرف عنه كيد النسوة.
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
تأملات تدبرية في الآيات 25 – 35
من إعجاز القرآن الكريم حديثه عن القيامة ومشاهدها والحوارات التي تدور بين الخلق فيها: حواراتهم مع الله عز وجل، حواراتهم فيما بينهم أتباعا ومتبوعين، حوارات مع الملائكة. لا يمكن لأي مخلوق أن يصف لك بالتفصيل ماذا سيقول بعد ساعة أو بعد يوم أو أكثر أو أقل قد يستعد إنسان لإلقاء محاضرة بعد يوم أو يومين أو شهر ثم حين يأتي موعد المحاضرة تجده يغيّر في كلامه ولا يقول ما كان قد أعدّه حرفيا! لكن الله عز وجل بعلمه الغيب يقيم على الناس الحجة ويذكر لهم ما سيقولونه بالحرف وهذا من آثار قهره سبحانه فوق عباده! والله من تفكر في هذه المسالة وحدها آمن بالله وآمن بالغيب دون تردد، فكيف قرأ مشركو العرب هذه الآيات ولم تتحرك قلوبهم؟!
إن القلوب إذا أُغلقت وغلظت وقست أحاطتها الظلمات من كل جانب فما عاد لشعاع النور أن يخترق تلك الجدران! انظر لحال المشركين الكافرين المكذبين المعاندين جاءهم الرسول بالآيات البيّنات “القرآن” وهو أعظم آية جاءهم بعلم اليقين فلم يؤمنوا ثم في مشهد وقوفهم على النار رأوها بأعينهم عين اليقين فلم يؤمنوا واستمروا على تحايلهم وكذبهم ثم لما وُقِفوا بين يدي ربهم وقيل لهم ذوقوا العذاب وهو حق اليقين تحسّروا!! ألا ما أشد ظلمهم لأنفسهم وخسارتهم وجهلهم! ولو أنهم أعملوا عقولهم واستمعوا للآيات لآمنوا لكنهم تعلّقوا بالدنيا الفانية على حساب الآخرة الباقية واستبعدوا البعث وكذّبوا به وكأنهم مخلّدون في الدنيا! أما فكّر هؤلاء بمن سبقهم أين هم؟ هل خُلّدوا؟
الآيات 33 – 35 رسالة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لست بدعا من الرسل فكل رسول قد تعرض إلى نوع من الأذى والسخرية والتكذيب والاستهزاء والطرد ومحاولات القتل ورسالة لكل داعية من بعده أن الهداية بيد الله تعالى وحده لو شاء أن يهدي الناس جميعا لهداهم فهو القاهر فوق عباده لكن سنّته في الخلق هي سنّة الاختلاف اقتضت أن يكون فيهم المهتدي وفيهم الضالّ وفيهم المنافق وفيهم المؤمن وفيهم الكافر ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على ملّة واحدة. فلا تذهب نفسك حسرات على من لم يهتدي، قم بإبلاغ رسالة ربك ودع أمر الهداية له وحده ولا تحزن من تكذيب الناس ولا من استهزائهم فهؤلاء مشكلتهم ليست مع شخص الداعية وإنما مع تصديق الرسالة لأنهم لا يريدون أن يلزموا أنفسهم باتّباع المنهج الإلهي فجحدوا بالرسالة فما أشد خسارتهم وظلمهم لأنفسهم وجهلهم!!
الآيات فيها تقريع لكل كافر مكذّب بآيات الله وبرسله ولا يؤمن بلقاء الله عز وجل وفيها توبيخ لهم وتهديد بما سيلاقونه من العذاب والعاقل من اتعّظ فتاب وأناب قبل أن تقوم قيامته بالموت أولا ثم القيامة الكبرى التي لا ريب فيها آتية لا محالة لن يفلت منها أحد!
(وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون) “أفلا تعقلون” سؤال يختصر كل الكلام عن الفرق بين الدنيا والآخرة سؤال يحرّك العقول لتعلم الحق وتحرك القلوب لتتعظ قبل أن تعاين العذاب وتذوقه!
(لا مبدّل لكلمات الله) هو الحق سبحانه كلامه حق ورسله حق وآياته حق والساعة حق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق وسننه في كونه ماضية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول فاللهم ارزقنا إيمانا بك لا يتزعزع وخشية من لقائك وحسابك يقودنا لتقواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 11
الآيات 36-39
#للحفاظ
تكرر في المقطع الحديث عن الحشر والبعث والرجوع إلى الله عز وجل:
(والموتى يبعثهم الله ثم إليه يُرجعون) الموت، البعث، ثم الرجوع إلى الله
(ثم إلى ربهم يُحشرون) الحشر
في الآية 36 (ثم إليه يُرجعون) لم يذكر اسم الجلالة “الله” أو “الرب” لأنه سبقها (يبعثهم الله)
وفي الآية 38 أظهر اسم “الرب” لعدم وروده فيما سبق (ثم إلى ربهم يُحشرون)
وعبّر عن الرجوع والحشر بصيغة الفعل المبني لما لم يسمّى فاعله (يُرجَعون) (يُحشّرون)
3 آيات في المقطع تفتتح بحرف الواو: (وقالوا – وما من دابة – والذين كذّبوا)
(وقالوا لولا نُزّل عليه آية من ربه) اقتراح جديد من المشركين إضافة لما اقترحوه سابقا في السورة (وقالوا لولا أُنزل عليه ملك)
(وقالوا لولا نُزّل) وردت في موضعين في القرآن: في الأنعام 36 وفي الزخرف 31 (وقالوا لولا نزّل هذا القرآن)
ووردت (لولا نُزِّل) في 4مواضع في القرآن: موضعا الأنعام والزخرف والفرقان32 وفي سورة محمد وردت بصيغة (لولا نزّلت)
تكرر في المقطع: نُزِّل – ينزِّل
(وما من دابة في الأرض) وردت في القرآن في موضعين: الآية 38 سورة الأنعام والآية 6 في سورة هود.
(ما فرّطنا) وردت في القرآن في موضعين في سورة الأنعام:
في الآية 31 على لسان أهل النار (قالوا يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها)
وفي الآية 38 كلام الله عز وجل (ما فرّطنا في الكتاب من شيء)
(ولكن أكثرهم لا يعلمون)
وردت في 9مواضع في القرآن: الأنعام37، الأعراف 131، الأنفال34، يونس55، القصص: 13 و57، الزمر 49، الدخان39 والطور17
(والذين كذّبوا بآياتنا) وردت في 5مواضع في القرآن: الأنعام 39 و49، الأعراف: 36 و147 و182
(في الظلمات) تكررت في سورة الأنعام في موضعين: الآية 39 والآية 122 ولعل في هذا مناسبة لما افتتحت به السورة (وجعل الظلمات والنور)
وورد لفظ (الظلمات) في 13 موضعا في القرآن
(من يشأ الله يضلله) (ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم)
المشيئة لله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهذا من آثار اسمه القاهر ولو شاء الله لجمع الناس على الهدى لكن سنّة الله تعالى في الخلق أن يكون منهم الضالّ والمهتدي.
(صمٌ وبكم) لم ترد في القرآن معطوفة بالواو إلا في الآية 39 من سورة الأنعام وفي باقي المواضع (صمٌ بكمٌ عُمي) وهما موضعان في سورة البقرة (18، 171)
(صراط مستقيم) وردت في سورة الأنعام 3مرات من مجموع 29 مرة في القرآن كله. ووردت بصيغة “صراط مستقيم” 23مرة و”الصراط المستقيم” مرتان و”صراطا مستقيما” 4 مرات
#تدبر
في المقطع آثار لاسم الله القاهر سبحانه فقد قهر الخلق بالموت والبعث والحشر
غريب أمر المشركين! لماذا يصرّون على طلب الآيات وهم لا يؤمنون بها؟! ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، إنما هو العنَت ومحاولة التحدي والتعجيز لرسول الله صلى الله عليه وسلم! وجهلٌ بعظمة الله عز وجل ما قدروه حق قدره فظنّوا أن بإمكانهم أن يقترحوا ما يشاؤون وأن الله جل جلاله يجيبهم لما أرادوه هم ورغبوا به! أما علموا أن الله هو القاهر فوق عباده لا يكون إلا ما أراده هو سبحانه فهو الحكيم الخبير وهو العليم وهو القادر على أن ينزّل من الآيات ما شاء على من يشاء وقد آتى كل رسول ما شاء من الآيات التي تناسب أقوامهم واختار للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الآية البيّنة الباقية إلى يوم الدين في حين كل الآيات السابقة كعصا موسى وفلق البحر وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى كلها آيات رآها أهل زمانها ثم صارت قَصصا تروى للأجيال التالية..
ولو أن هؤلاء ساروا في الأرض سير عبرة واتعاظ كما أمرهم الله لعلموا أن سنّة الله عز وجل في الأمم أن من طلب آية فأنزلها الله عليهم ثم كفروا بها فقد استحقوا الهلاك!؟
ولو أن هؤلاء نظروا في ما حولهم في الأرض وفي السماء لو نظروا إلى الطير ذاك المخلوق الصغير كيف يطير ويحلّق في السماء بجناحين من ريش يقبضها ويصفّها بمشيئة الله الخالق، أليس هذا الطير آية؟! لو فتحوا أبصارهم وأسماعهم وتفكروا لرأوا الآيات الدالة على الخالق سبحانه شاخصة أمامهم تقول: للكون ربٌ فاعبدوه (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) الله خالقها وخالقكم ابتداء وإليه يحشركم جميعا.
(والموتى) (صُمٌ وبكمٌ في الظلمات) من لم يستجب للحق وآياته البينات فهو في عداد الموتى إذ أنهم عطّلوا وسائل الإدراك التي أعطاهم الله عز وجل إياها ليستدلوا بها عليه فيؤمنوا به لكنهم ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا كالأنعام بل هم أضل، لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها فأيّ حياة يعيش هؤلاء؟! ألا ما أجهلهم!!
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 12
الآيات 40-45
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
(“أتاكم” عذاب الله) – (“أتتكم” الساعة)
(أغير الله “تدعون”) – (بل إياه “تدعون”) – (فيكشف ما “تدعون” إليه)
(وتنسون) – (فلما نسوا)
(يتضرعون) – (تضرّعوا)
(“فأخذناهم” بالبأساء والضراء) – (“أخذناهم” بغتة)
افتتح المقطع بـ(قل)
3 آيات في المقطع افتتحت بحرف الفاء (فلولا جاءهم) – (فما نسوا) – (فقُطع دابر القوم..)
(حتى إذا فرحوا) تكرر منذ بداية السورة صيغة “حتى إذا” 3مرات: (حتى إذا جاؤك يجادلونك) (حتى إذا أتتهم الساعة بغتة) (حتى إذا فرحوا)
(أغير الله) وردت في سورة الأنعام 3مرات من مجموع 4 مرات في القرآن كله، وردت في الأنعام: 14، 40، 164 وفي الأعراف 140 كلها مسبوقة بالفعل (قل) إلا الآية 40 (أغير الله)
(فأخذناهم بالبأساء والضراء) “بالبأساء والضراء” وردت في القرآن في موضعين: في الأنعام 42 وفي الأعراف 94 (إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء)
(إذ جاءهم بأسنا) وردت في القرآن في موضعين: الأنعام 43 والأعراف 5 (فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا)
(ولكن قست قلوبهم) “قست قلوبهم” وردت في القرآن في موضعين: الأنعام 43 والحديد 16 (فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم)
(وزين لهم الشيطان) وردت في 3 مواضع في القرآن: الأنعام 43 (وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) وفي النمل 24 والعنكبوت 38 (وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل)
(ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) وردت في موضعين في القرآن: في الأنعام 42 وفي النحل 63 (تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك)
(فتحنا عليهم) وردت في القرآن في 4 مواضع: الأنعام 44 (فتحنا عليهم أبواب كل شيء) وفي الأعراف 96 (لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) وفي الحجر 14 (ولو فتحنا عليهم بابا من السماء) وفي المؤمنون 77 (ولو فتحت عليهم بابا ذا عذاب شديد)
(أخذناهم بغتة) وردت في موضعين في القرآن: في الأنعام 44 وفي الأعراف 95 (فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون)
(فإذا هم مبلسون) انفردت بها سورة الأنعام
(فقطع دابر القوم) انفردت بها سورة الأنعام
(والحمد لله رب العالمين) وردت في موضعين في القرآن: الأنعام 45 والصافات 182
#تأملات
افتتح المقطع بتلقين النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يوجهه للكافرين ويقيم عليهم الحجة في أن الله عز وجل هو المتصرف في خلقه بما يشاء القاهر فوق عباده وهو الله لا إله إلا هو ومن مظاهر توحيده وقهره أن الكافرين يلجأون إلى الله وحده مستغيثين من العذاب ينسون من كانوا يدّعون أنهم شركاء وتتجه فطرتهم إلى الله خالقهم.
وفي المقطع تقرير لبعض سنن الله عز وجل في الخلق منها:
سنة إرسال الرسل للأقوام فإن لم يستجيبوا لهم يبتليهم الله تعالى بالبأساء والضراء من فقر وضيق عيش وأمراض وأسقام من أجل أن يرجعوا إلى الله ويتضرعوا له.
فإن لم يتضرعوا ويرجعوا لقسوة قلوبهم وتزيين الشيطان لهم فإنه تجري عليهم سنة أخرى من سنن الله تعالى ألا وهي سنة الاستدراج والإملاء فيفتح الله تعالى عليهم أبواب الدنيا من الجاه والرزق حتى إذا فرحوا بهذا العطاء أخذهم الله تعالى بغتة وهذا من آثار اسمه القاهر فيصبحوا آيسين من كل خير.
ومن سنن الله تعالى في الخلق إهلاك القوم الذين ظلموا هلاك استئصال تام (فقطع دابر القوم الذين ظلموا) وهذا أيضا من مظاهر قهره عز وجل للمكذبين الكافرين.
وختم المقطع بـ(والحمد لله رب العالمين) الحمد لله على إهلاك الظالمين والحمد لله على شفاء صدور قوم مؤمنين والحمد لله على إنزال الآيات التي أخبر بها عباده بمصير الأمم السابقة ليتعظوا ويتوبوا قبل فوات الأوان ولا يحلّ عليهم العذاب كما حلّ على من سبقهم. والحمد لله الذي طهّر الأرض من الظالمين المفسدين.
القرآن يعلمنا أن نحمد الله عز وجل بعد إهلاك الظالمين كما أمر نوحا عليه السلام بعد إغراق الكافرين من قومه (وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين)
اشتمل المقطع على بعض أفعال الله عز وجل وردت كلها بضمير التعظيم (نا): (ولقد أرسلنا – فأخذناهم – فتحنا عليهم – أخذناهم) (بأسنا) لإيقاع المهابة من الله عز وجل في القلوب ما عدا موضع واحد جاء بالإفراد (فيكشف) في الآية (بل إياه تدعون فيكشف) إياه بالإفراد ويكشف بالإفراد ذلك لأنه سبحانه وحده من يلجأ إليه الكافرون ساعة الشدة والعذاب وهو وحده سبحانه الذي يكشف ما يدعون إليه إن شاء. وهذا يتناسب مع دعوة السورة لتوحيد الله عز وجل (أغير الله تدعون) (بل إياه تدعون) (فيكشف) (إن شاء).
(فقطع دابر القوم الذين ظلموا) التعبير باسم الموصول وصلته (الذين ظلموا) لبيان العلّة من استحقاقهم للهلاك وقطع دابرهم وهو: الظلم. وقد تكرر هذا الأسلوب في السورة 37 مرة كما ورد من بداية السورة: (الذين كفروا – الذين خسروا – الذين سخروا – الذين آتيناهم الكتاب – الذين كذّبوا بلقاء الله– الذين يسمعون – الذين كذبوا بآياتنا)
#تدبر:
إن رجوع الإنسان إلى الله عز وجل ساعة الشدة وافتقاره إليه ولجوؤه متضرعا إليه بالدعاء لهو دليل حقيقي على الإيمان به إلهًا وربًا وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها لكنها تنطمس حين تقسو القلوب وتستكبر وتظن أن بإمكانها الاستغناء عن ربها!
(فيكشف ما تدعون إليه إن شاء) فالمشيئة له وحده في إجابة الدعاء إن شاء كشف ما يدعون إليه وإن لم يشأ لم يكشف، وقد سبق في السورة أن المشيئة له وحده في كشف الضر (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) وأن المشيئة له وحده في الهداية (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) (من يشأ يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم).
قاعدة قرآنية: (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) وفي الحديث: “إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج”.
الاستدراج قد يكون لفرد وقد يكون لأمّة وقد يكون لقوم وقد يكون لدولة فليحذر الإنسان سخط الله عز وجل وليحاسب نفسه فقد يكون ذنبه ومعصيته سببا في استدراج مجتمعه وأمّته فيحق عليها العذاب.
(فقطع دابر القوم الذين ظلموا) من غير الله عز وجل القاهر فوق عباده الحكيم الخبير قادر على قطع دابر القوم الذين ظلموا؟! لا إله إلا هو سبحانه.
(فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون) من أسباب عدم التضرع إلى الله عز وجل: قسوة القلوب وتزيين الشيطان للأعمال فيُعجب الإنسان بعمله ولو كان سيئا قبيحا فيزداد قسوة وعتوا وضلالا وعُجبا يحول بينه وبين التضرع إلى الله ربه.
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 13
الآيات 46-50
#للحفاظ
3 آيات في المقطع افتتحت بالفعل (قل) إثنتان منها تبعه فعل الرؤية:
قل أرأيتم – قل أرأيتكم – قل لا أقول لكم
وآيتان افتتحت بحرف الواو: (وما نرسل المرسلين – والذين كذبوا بآياتنا)
تكررت أفعال الرؤية في المقطع:
(أرأيتم – أرأيتكم – انظر) وفيه أيضا أداة الرؤية: (أبصاركم) وهذا من خصائص سورة الأنعام فهي سورة التعريف بالله تعالى الخالق من خلال الآيات الكونية ولذلك تكررت فيها ألفاظ الرؤية والنظر والمشاهدة التي بها ترى هذه الآيات في الكون. ففيها (بصر) (نظر) (رأى) (شاهد) 41 مرة.
تكررت (إن) الشرطية: (إن أخذ الله سمعكم..) (إن أتاكم عذاب الله)
في المقطع 4 استفهامات لإثارة الذهن وتحريك العقول والقلوب للتفكّر:
(قل أرأيتم – من إله غير الله يأتيكم به – أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله – هل يُهلك إلا القوم الظالمون)
تكرر استعمال الفاء: (فمن آمن وأصلح – فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)
(كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون) اربط فاء يصرّف بفاء يصدفون
تذكّر أن في سورة الأنعام يكثر استعمال (ثمّ) فناسب ختم الآية (ثم هم يصدفون)
تكرار ضمير الفصل (هم): (ثم هم يصدفون) (ولا هم يحزنون)
تكرر العذاب في موضعين: (إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة) (يمسّهم العذاب بما كانوا يفسقون) في الآية الأولى مضافا إلى اسم الجلالة ليوقع المهابة والخوف في قلوب الظالمين المكذبين وفي الثانية جاء بالتعريف (العذاب) وكأنه العذاب المعروف الذي خصّه الله بالقوم الفاسقين والله أعلم.
(إن أخذ الله سمعكم) انفردت بها سورة الأنعام
(وختم على قلوبكم) انفردت بها سورة الأنعام وقد ورد الختم على القلوب في القرآن بصيغ أخرى: (ختم الله على قلوبهم)[البقرة:7]، (فإن يشأ الله يختم على قلبك) [الشورى: 24]، (وختم على سمعه وقلبه)[الجاثية: 23]
(بغتة أو جهرة) انفردت بها سورة الأنعام
تكرر لفظ (بغتة) وحده في القرآن في 13 موضعا 3 منها في سورة الأنعام (الآيات: 31، 44، 47) وعادة ما يأتي مع الساعة أو العذاب
وتكرر لفظ (جهرة) في 3 مواضع في القرآن: البقرة 55، النساء 153 كلاهما في سياق رؤية الله والأنعام 47 اقترنت ب(بغتة) في سياق عذاب الله.
(فمن آمن وأصلح) انفردت بها سورة الأنعام.
(فمن آمن وأصلح) الإيمان عكسه الكفر والتكذيب بآيات الله فناسب يعدها (والذين كذّبوا بآياتنا)
(فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) تكررت في القرآن الكريم في 5مواضع: البقرة 38، المائدة 69، الأنعام 48، الأعراف 35، الأحقاف 13.
(هل يُهلك إلا القوم الظالمون) انفردت بها سورة الأنعام
(بما كانوا يفسقون) وردت في القرآن في 5مواضع: في البقرة 59، الأنعام 49 والأعراف 163 و165 والعنكبوت 34
(قل لا أقول لكم) – (ولا أقول لكم)
(قل) تكرر في المقطع 4مرات، اثنتان منها في الآية 50 نهاية المقطع.
(خزائن الله) وردت في القرآن في موضعين اثنين فقط: في الأنعام الآية 50 (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك) وفي سورة هود الآية 31 على لسان نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه (ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك..) بزيادة (قل) و (لكم) في آية الأنعام.
(إن أتّبع إلا ما يوحى إليّ) وردت في 3مواضع في القرآن: في الأنعام الآية 50 وفي يونس 15 وفي الأحقاف 9.
(قل هل يستوي الأعمى والبصير) وردت في القرآن في موضعين: الأنعام الآية 50 والرعد 16
#تأملات
#تدبر
من بداية السورة تكرر الحديث عن وسائل الإدراك التي أعطاها الله تعالى للإنسان ليهتدي بها إليه:
(ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها)
(إنما يستجيب الذين يسمعون)
(والذين كذّبوا بآياتنا صمٌ وبكمٌ في الظلمات)
(ولكن قست قلوبهم)
(قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم)
(قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون)
(يمسّهم العذاب بما كانوا يفسقون) من بداية السورة والآيات تبيّن سبب عقوبة وهلاك الأقوام حتى لا يقول قائل لماذا أهلك الله هؤلاء الأقوام وعذّبهم؟ فسنّة الله تعالى أن يُمهِل الأقوام فإذا أصروا على التكذيب حقّ عليهم العذاب والهلاك. (فقطع دابر القوم الذين ظلموا) (فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) (فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون) (ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين)
السورة منذ بدايتها تعرض الأدلة الدامغة على أن الله تعالى هو القاهر فوق عباده وهو القادر على كل شيء وهو خالق كل شيء ويملك التصرف فيه كيف شاء وختم هذا المقطع بتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إثبات بشريته فلا هو يملك خزائن الله ولا هو يعلم الغيب ولا هو ملك إنما هو بشر يتّبع ما أوحاه الله تعالى إليه فهو رسول من رسل الله الذين أرسلهم مبشرين ومنذرين. وفي هذا رد حاسم على كل من يطلب من النبي المعجزات أو تأخير العذاب عنهم أو تقديمه لا ليؤمنوا إنما تعنّتا منهم واتّباعا لشهواتهم ورغباتهم وشتّان بين من يتّبع رغباته وبين من يتّبع ما أوحي إليه من ربه!.
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 14
الآيات 51 – 55
#للحفاظ
افتتحت آيات المقطع بأمر للنبي صلى الله عليه وسلم (وأنذر به) تلاه نهيٌ (ولا تطرد الذين يدعون ربهم)
وفي المقطع آيتان افتتحت بـ(وكذلك) وقد تكرر لفظ (كذلك) في السورة 13مرة من مجموع 124 مرة في القرآن.
تكرر في المقطع:
فعل الطرد: ولا تطرد – فتطردهم
(الذين يخافون – الذين يدعون – الذين يؤمنون) وذكرنا أكثر من مرة أن من خصائص سورة الأنعام الأسلوبية التعبير بصيغة اسم الموصول (الذي) وصِلته.
(كتب ربكم على نفسه “الرحمة”) – (فأنه غفور “رحيم”)
(ما عليك من حسابهم من شيء) (وما من حسابك عليهم من شيء)
اسم “الربّ”: (يحشروا إلى ربهم) – (يدعون ربهم) – (كتب ربكم على نفسه الرحمة)
(الذين يؤمنون بآياتنا) (نفصل الآيات)
الأفعال في حق المؤمنين وردت بصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار: (يخافون – يتقون – يدعون ربهم – يريدون وجهه – يؤمنون)
(ليقولوا) – (فقُل)
(“وأنذِر به”) لم ترد هذه الصيغة إلا في سورة الأنعام وتتناسب مع سبق في سياق الإنذار (وأوحي إليّ هذا القرآن “لأنذركم به”) الضمير (به) عائد على القرآن بينما ورد في مواضع أخرى في القرآن إطلاق الإنذار دون ذكر المنذَر به (وأنذر عشيرتك الأقربين) (وأنذر الناس) (وأنذرهم يوم الحسرة) (وأنذرهم يوم الآزفة)
(يخافون أن يحشروا إلى ربهم) لم ترد إلا في سورة الأنعام، ورد في سورة النحل (يخافون ربهم).
(وليّ ولا شفيع) ورد في القرآن في 3مواضع، اثنان منها في سورة الأنعام (الآية 51 و70) والثالث في سورة السجدة الآية4 (ما لكم من دونه من وليّ ولا شفيع أفلا تتذكرون)
(لعلهم يتقون) وردت في القرآن في 6موضع إثنان منها في سورة الأنعام (الآية 51 والآية 69) وفي البقرة 187 والأعراف 164 وطه 113 والزمر 28.
(ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والهشي يريدون وجهه) انفردت بها سورة الأنعام وآية سورة الكهف تشبهها إلا أنها افتتحت بأمر لا بنهي (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه)
(بالغداة والعشي) لم يرد هذا التعبير إلا في سورة الأنعام 52 والكهف 28
(فتكون من الظالمين) انفردت بها سورة الأنعام
(وكذلك فتنّا) لم ترد هذه الصيغة إلا في سورة الأنعام ووردت في مواضع أخرى صيغة (ولقد فتنا – قد فتنا) في العنكبوت وص والدخان
(أليس الله بأعلم بالشاكرين) انفردت بها سورة الأنعام.
(سلامٌ عليكم) وردت في 6مواضع في القرآن: في الأنعام 54 وفي الأعراف 46، الرعد 24، النحل 32، القصص 55، والزمر 73
(كذلك نفصّل الآيات) وردت في القرآن في 5 مواضع: الأنعام 55، الأعراف 32 و174، يونس 24، الروم 28
(ولتستبين سبيل المجرمين) انفردت بها سورة الأنعام.
احتوت السورة على:
أسلوب الأمر (وأنذر به)
أسلوب النهي (ولا تطرد الذين يدعون ربهم)
أسلوب الشرط وجوابه (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) (أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم)
أسلوب الترغيب (من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم)
أسلوب الخبر (وكذلك فتنا بعضهم ببعض) (وكذلك نفصل الآيات)
أسلوب الاستفهام (أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا) (أليس الله بأعلم بالشاكرين)
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#تأملات_ وتدبر
تحول السياق من الحديث من بداية السورة عن المشركين الخاسرين الظالمين إلى الحديث عن المؤمنين الذين استجابوا لدعوة رسل الله واتّبعوهم وهو توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده يرسّخ قاعدة التعامل مع المدعويين الضعفاء والفقراء وهي القاعدة الأسمى في احترام حقوق الإنسان والابتعاد عن العصبيات والتصنيفات الجاهلية للبشر وهذا المعنى اشتركت فيه سورة الأنعام (ولا تطرد الذين يدعون ربهم) وسورة الكهف (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم)
آفة بعض البشر الاستكبار والاستعلاء على خلق الله الضعفاء والفقراء (أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا) مشكلتهم أنهم يرون أنفسهم أحقّ بكل خير من غيرهم، أهم يقسمون رحمة ربهم؟! تارة يقترحون على الله عز وجل على من ينزل رسالته، وتارة يعترضون على اختيار الله لرسله وتارة يعترضون على مكانة المؤمنين الاجتماعية والمادية! أنسي هؤلاء أن الله عز وجل هو الحكيم الخبير وهو العليم بخلقه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون؟!. هذه الآفة ما زالت للأسف موجودة في مجتمعاتنا وهي آفة قلوب قست فعميت عن الحق أحسنوا الظن بأنفسهم وأساؤوا الظن بربّهم وبالمؤمنين الضعفاء الفقراء من خلقه!
يعلّمنا المقطع أن الإنذار طريق التقوى (وأنذر – لعلهم يتقون)
ويعلّمنا أن الدعاة إلى الله عليهم أن يعطوا المستجيبين لدعوة الله حقوقهم فلا ينصرفوا عنهم إلى أهل الدنيا مهما ضعف شأن المستجيبين وعلا شأن أهل الدنيا المعاندين.
ويعلمنا أن العباد خطاؤون وخير الخطائين التوابون والله عز وجل يقبل التوبة بل كتبها على نفسه سبحانه رحمة بعباده ووضع شروطا للتوبة لمن عمل السوء بجهالة: توبة وإصلاح لما أفسد بمعصيته ووعد الله عز وجل بالمغفرة لأنه هو الغفور الرحيم.
ويعلّمنا أن سبيل المجرمين هو الاستعلاء والترفع على أهل الإيمان وفي المقابل فإن سبيل المؤمنين هو التواضع لأهل الإيمان، والقرآن الكريم يوضّح السبيلين حتى لا تكون للناس على الله حجّة بعد الرسل (وهديناه النجدين) والعاقل من سلك سبيل المؤمنين وأعرض عن سبيل المجرمين.
(وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فأنه غفور رحيم)
تشريف للمؤمنين بوصفهم (الذين يؤمنون بآياتنا)
تكريم لهم بالسلام (سلامٌ عليكم) تكريم يمنحهم الأمن والسلام من ربهم
تشريف بالإضافة (ربكم)
بشارة بالرحمة (كتب ربكم على نفسه الرحمة)
إعذار (من عمل منكم سوءا بجهالة)
رحمة بفتح باب التوبة (ثم تاب من بعده)
بيان لطريق التوبة المقبولة (ثم تاب من بعده وأصلح)
ترغيب بالتوبة باختيار اسمين من أسماء الجمال لله عز وجل (فأنه غفور رحيم)
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 15
الآيات 56 – 58
#للحفاظ
#تأملات_وتدبر
آيات المقطع كلها تبدأ بفعل الأمر (قلّ) تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم للرد على شبهات المشركين المكذبين وتكرر (قل) 4مرات في المقطع.
الله عز وجل يرسم خارطة طريق للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الدعاة إلى الله للتعامل مع شبهات المشركين كما حكم الله تعالى الحكيم الخبير العليم وهي تثبت بشرية الرسول وتحدد صلاحياته وتؤكد أن الله تعالى وحده المتحكم بها:
(“قل” إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله “قل” لا أتّبع أهواءكم) الكل منهيٌّ عن عبادة غير الله عز وجل، الأنبياء أولًا وكل من تبعهم ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين. الطريق الصحيح يبدأ من إعلان التوحيد وعدم اتّباع الهوى والشبهات والضلال.
(“قل” إني على بينة من ربي) الدعوة إلى الله والاتّباع لا يكون عن جهل وإنما عن علم وحقائق وأدلّة وبيّنات وكل هذا البيان هو في القرآن المبين الذي أنزله الله تعالى على رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم. والدعاة إلى الله موقنون واثقون من البيّات التي جاءتهم من ربهم.
(“قل” لو عندي ما تستعجلون به) صلاحيات النبي صلى الله عليه وسلم محدودة فهو ليس بيده تقديم ولا تأخير العذاب ولا إيقاعه بأحد من البشر فهذا بيد الله تعالى وحده لا يتحكم فيه نبي ولا رسول ولا ملَك.
(لا أتّبع أهواءكم قد ضللت) انفردت بها سورة الأنعام
(وما أنا من المهتدين) تكرر ذكر الهدى ومشتقاته في السورة 20مرة ولعل هذا يتناسب مع كثرة براهين وأدلة السورة التي يُهتدى بها إلى توحيد الله عز وجل ويبتعد بها عن الضلال وسبيل المجرمين.
(ما “عندي ما تستعجلون به”) – (قل لو أن “عندي ما تستعجلون به”)
(على بيّنة من ربي) وردت في القرآن في 4مرات إحداها في الأنعام 57 على لسان النبي صلى الله عليه وسلم و3منها في سورة هود: الآيات 28، 63 و88 على لسان نوح وصالح وشعيب عليهم السلام جميعا.
(إن الحكم إلا لله يقصّ الحقّ وهو خير الفاصلين)
(إن الحكم إلا لله) وردت في 3مواضع في القرآن: في الأنعام 57 وفي يوسف الآية 40 و67
(يقصّ الحق) انفردت بها سورة الأنعام
(وهو خير الفاصلين) انفردت بها سورة الأنعام ومن اللافت تكرر فعل (فصل) ومشتقاته في السورة في 7 مواضع: نفصّل، فصّلنا، مفصّلا، فصّل، الفاصلين،
(والله أعلم بالظالمين) وفي المقطع السابق (أليس الله بأعلم بالشاكرين) علم الله عز وجل يشمل الجميع: الشاكرين والظالمين لا يخفى عليه شيء من أمرهم لا في سرّهم ولا في جهرهم.
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 16 و17
الآيات 59 – 67
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
العلم: (لا يعلمها إلا هو – ويعلم ما في البر والبحر– وما تسقط من ورقة إلا يعلمها – ويعلم ما جرحتم بالنهار)
ظلمات: (ظلمات الأرض – ظلمات البر والبحر)
وهو: (وهو الذي يتوفاكم بالليل – وهو القاهر فوق عباده – وهو أسرع الحاسبين – وهو الحق) (هو القادر)
قل: (قل من ينجّيكم – قل الله ينجّيكم – قل هو القادر – قل لست عليكم بوكيل)
التوفية: (وهو الذي يتوفاكم – توفّته رسلنا)
ثمّ: تكررت في المقطع 4 مرات 3 منها في آية واحدة (الآية 60) (ثم يبعثكم – ثم إليه مرجعكم – ثم ينبئكم)
الإنجاء: (من ينجّيكم – لئن أنجانا – قل الله ينجّيكم)
الحق: (مولاهم الحق – وهو الحق)
(ثم يبعثكم فيه– ويرسل عليكم حفظة – يبعث عليكم عذابا) البعث فيه شدّة أكثر من الإرسال وقد ورد في سياق البعث يوم القيامة وسياق العذاب المادي (من فوقكم أو من تحت أرجلكم) والعذاب المعنوي (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) أما الإرسال فورد في سياق إرسال الملائكة الحفظة.
إنفرادات في السورة:
(مفاتح الغيب) – (وما تسقط من ورقة) – (ظلمات الأرض)
(حفّظة) (لا يفرّطون)
(وهو أسرع الحاسبين)
(حى إذا جاء أحدكم الموت) – (توفّته رسلنا)
(ثم أنتم تشركون)
(قل هو القادر)
(لعلهم يفقهون)
(لست عليكم بوكيل)
(لكل نبأ مستقر) (وسوف تعلمون)
متشابهات:
(إلا في كتاب مبين) وردت في القرآن في 4 مواضع: الأنعام 59، يونس 61، النمل 75 وسبأ3
(يتوفاكم) وردت في القرآن في 4مواضع 3 منها بنسبة الفعل إلى الله تعالى: في الأنعام 60 (وهو الذي يتوفاكم بالليل) في يونس 104 (ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم)، في النحل 70 (والله خلقكم ثم يتوفاكم) وبنسبة الفعل لملك الموت في السجدة 11 (قل يتوفاكم ملك الموت)
(مولاهم الحق) وردت في موضعين في القرآن: الأنعام 62 ويونس 30
(وهو القاهر فوق عباده) انفردت بها سورة الأنعام في موضعين: الأنعام 18 و61
(ظلمات البر والبحر) تكررت في القرآن في 3 مواضع: إثنان في الأنعام: 63 و97 وفي النمل 63
(تضرّعا وخفية) تكررت في موضعين في القرآن: في الأنعام 63 وفي الأعراف 55
(لنكونن من الشاكرين) تكررت في القرآن في 3 مواضع: الأنعام 63، الأعراف 189 ويونس 22.
(نصرّف الآيات) وردت في 4مواضع في القرآن 3 منها في الأنعام: 46، 65، 105 وفي الأعراف 58
(انظر كيف نصرّف الآيات) انفردت بهما سورة الأنعام في الآيتين: 46 و55
(وهو الحق) تكررت في القرآن في 3 مواضع: البقرة 91، الأنعام 66، محمد 2
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 16 و17
الآيات 59 – 67
#تأملات_وتدبر
بعد أن بيّن المقطع السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم له صلاحيات محددة محدودة يأخذنا هذا المقطع في جولة بديعة مع البراهين والأدلة البيّنة عى تفرّد الله عز وجل بالعلم والقدرة المطلقتين، ويبرز فيه من مظاهر اسم الله القاهر ما ينبغي أن يؤمن به المعاندون المشركون إلا أنهم يظلمون أنفسهم باستكبارهم عن رؤية آيات ودلائل الحق التي صرّفها الله تعالى من حولهم وفي أنفسهم لكنهم لا يفقهون! بل ويتجرأون على تكذيب الحقّ لكن سيأتي اليوم الذي يدركون فيه فداحة تكذيبهم وعاقبة كفرهم وجحودهم!
ويتنوع الأسلوب في آيات المقطع بين التهديد والوعيد وبيان القدرة الإلهية في الكون وفي النوم والتوفّي والموت والبعث والحساب والعذاب ومنّة الله تعالى على عباده بإنجائهم في ساعة الشدّة في مقابل جحودهم وإعراضهم عن الله بعد الإنجاء!
- من آيات ومظاهر قدرة الله تعالى وعلمه المحيط في الكون:
عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
يعلم ما في البر والبحر (أطلق عنان مخيلتك في سعة دلالة (ما))
ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا يمكن لعقل بشري أن يستوعب قدرة الله تعالى في معرفة كل ورقة تسقط من كل شجرة في أي بقعة من الأرض!
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، كمال علم الله وطلاقة قدرته سبحانه!
- ومن مظاهر قدرة الله تعالى في ما يتعلق بالبشر:
التوفية بالليل (نعمة النوم)
علمه بما يعمله البشر في النهار وفي الليل
بعثه إياهم في الأجل الذي قضاه أزلًا سبحانه
رجوعهم إليه يوم القيامة ثم إنبائهم بما عملوا ثم حسابهم ولا يظلم ربك أحدا
إرسال الملائكة الحفظة التي تحفظ العباد وتكتب أعمالهم ومنهم الملائكة الموكلة بنزع أرواحهم
إنجاء الخلق من ظلمات البر والبحر ومن كل شدّة يتضرعون بها إلى الله لكشفها عنهم
طلاقة قدرته في عذاب المشركين المعاندين عذابا ماديا أو معنويا بالتفرّق والتشرذم.
كيف لعاقل أن لا يؤمن بالله عز وجل بعد كل هذه البراهين على عظمتع وقدرته وتحكمه في كونه ومخلوقاته؟! كيف يكذّب بالحق عبدٌ مملوك هو كالهباءة في ملك الله عز وجل؟!
يختم المقطع ببيان أن ما على الرسول إلا بلاغ الآيات وليس هو وكيل على العباد إنما أمرهم لله وعليه بالصبر فلكل نبأ مستقر.
(وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) مفاتح الغيب خمسة ذكرت في ختام سورة لقمان (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ لقمان).
(تدعونه تضرّعا وخفية) من مظاهر قهر الله للمشركين أنه يُلجئهم إليه وحده حين الشدة رغم أنوفهم لا يجدون من يتضرعون إليه إلا الله عز وجل. حين يحيط الرعب بالعبد ويستولي الخوف والجزع على مجامع قلبه تصرخ فطرته السليمة متضرعة إلى الله ربها لإنجائها! لماذا إذن نعاند الفطرة السليمة وهي تقودنا إلى الله؟! أيّ داء أصاب القلوب حتى غطّى بذور الخير فيها فعميت عن فطرتها؟!
(لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين) جُبلت النفوس البشرية حين تتعرض للشدائد أن تلجأ لربها طوعا واضطرارا لكن هذا الحال لا يلبث أن يزول والوعود المؤكّدة لا تلبث أن تُنكث بعد ان يكشف الله عز وجل عنها الشدة والكرب تعود لتنطمس من جديد وبدل الشكر يحلّ الجحود والشرك (ثم أنتم تشركون).
(قل من ينجّيكم من ظلمات البر والبحر) استفهام تقرير وإنكار وتوبيخ لهم على سوء معتقدهم باعتمادهم على الأصنام فالله عز وجل هو وحده المنجي من الكروب والشدائد.
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 18
الآيات 68 – 70
#للحفاظ
آيات المقطع الثلاث افتتحت بحرف الواو: (وإذا رأيت – وما على الذين – وذرِ الذين)
تكرر فيه:
(يخوضون – يخوضوا)
(الذكرى – ذكرى – وذكّر)
(تبسل – أبسلوا) لم تتكرر في غير سورة الأنعام
(بما كسبت – بما كسبوا)
تكرار اسم الموصول كما سبق في آيات السورة من بدايتها: (الذين يخوضون – الذين يتّقون – الذين اتخذوا – الذين أُبسلوا)
(وإن تعدِل – كل عدل) العدل هنا بمعنى الفداء.
(وما على الذين يتقون – لعلهم يتقون)
#متشابه
(وإذا رأيت) افتتحت بها 3 آيات في القرآن، اثنان بصيغة (رأيت) في الأنعام 68 وفي الإنسان 20 (وإذا رأيت ثمّ رأيت) وبصيغة (أرأيتهم) في المنافقون 4
(الذين يخوضون) انفردت بها سورة الأنعام
(حتى يخوضوا في حديث غيره) وردت في موضعين في القرآن: في الأنعام 68 وفي النساء 140
وورد الخوض مقترنا باللعب في موضعين في القرآن آية متطابقة تماما (فذرهم يخوضوا ويلبعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) في الزخرف 83 والمعارج 42.
وسيأتي في المقطع في الآية 70 حديث عن اللعب بعد الحديث عن الخوض في الآية 68
(فأعرض عنهم) وردت في القرآن في 4 مواضع: النساء 63 (فأعرض عنهم وعظهم) و81 (فأعرض عنهم وتوكل على الله)، الأنعام 68 (فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) والسجدة 30 (فأعرض عنهم وانتظر)
(الذكرى) معرّفة وردت في 6مواضع في القرآن: الأنعام 68، الدخان 13، الذاريات 55، عبس 4، الأعلى 9، الفجر 23.
(ذكرى) نكرة وردت في 5 مواضع في القرآن: الأنعام 69 و90، هود 114، ص46، المدّثر 31
(وما على الذين يتقون “من حسابهم من شيء”) سبق ووردت في الآية 52 (ما عليك “من حسابهم من شيء”)
(لعلهم يتقون) وردت ختام 6 آيات في القرآن: البقرة 187، الأنعام 51 و69، الأعراف 164، طه 113، الزمر 28.
(وَذَرْ) انفردت بها سورة الأنعام بصيغة الإفراد، ووردت في 4 مواضع بصيغة الجمع (وذروا)
(اتخذوا دينهم) وردت في موضعين في القرآن: في الأنعام 70 وفي الأعراف 51 (الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا)
(لعبا ولهوا) اللعب واللهو سبق ورودهما بنفس الترتيب في الآية 32 في السورة (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو)
(وغرّتهم الحياة الدنيا) وردت في 3مواضع في القرآن اثنان منها في الأنعام: الآية 70 و130 وفي الأعراف 51 (الذين اتخذوا دينا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا)
(ولي ولا شفيع) تكررت في السورة في الآية 51 (ليس لهم من دونه وليّ ولا شفيع) وفي الآية 70 (ليس لها من دون الله وليّ ولا شفيع) وفي السجدة 4 (ما لكم من دونه من وليّ ولا شفيع) بإضافة (من) قبل (وليّ)
(بما كسبت) وردت في القرآن في 8مواضع و(بما كسبوا) وردت في 5مواضع في القرآن
(لا يؤخذ منها) وردت في الأنعام 70 (وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) بتقديم “عدل” وفي البقرة 48 بزيادة الواو وتأخير “عدل” (ولا يؤخذ منها عدل)
(لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون) وردت في موضعين في القرآن ختام آيتين: الأنعام 70 ويونس 4
#تأملات_ وتدبر
يستمر في هذا المقطع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال توجيهات لصيانة إيمان المؤمنين وصيانة مجالسهم من المستهزئين فكان التوجيه بالإعراض عن المستهزئين العابثين المكذبين الخائضين في دين الله وآياته حتى يغيّروا الحديث ولا يجالسوهم فلا يليق بمؤمن أن يجلس معهم فمن نسي فعليه بترك المجلس أول ما يذكر. ولهذا التوجيه في الإعراض عنهم فوائد:
-فهو تنبيه للخائضين وتذكرة لهم علّهم يتوقفوا
-فإن لم يتوقفوا فهو إقامة للحجّة عليهم
-وذكرى للمؤمنين بواجبهم نحو آيات الله ودينهم ورسولهم.
– وصيانة لمجالس المؤمنين من أن يتسلل إليها مثل هؤلاء المشككين المستهزئين فيتزعزع إيمان المؤمنين أو تثار الشكوك في قلوبهم تجاه دينهم خاصة إن كان في إيمانهم ضعف. ولهذا أمرنا أن نجالس الصالحين فمجالستهم تزيد التقوى لأنهم يعظّمون القرآن ويعتصمون به ويتّبعون ما فيه فيزدادوا إيمانا بالله عز وجل.
إن كان المكذبين المستهزئين قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا لأنهم لا يتقون الله عز وجل ولا يحسبون للآخرة حسابا فإن المؤمنين أعمارهم وأوقاتهم أثمن من أن يضيّعوها مع هؤلاء المضيّعين العابثين فالدنيا سرعان ما تنقضي ويحين وقت الحساب فريق المؤمنين في الجنة وفريق المستهزئين الكافرين يحبس في جهنم ليس لهم ولي ولا شفيع من دون الله ولا يؤخذ منهم فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا وعذابهم أليم بسبب كفرهم وإعراضهم عن الآيات والبراهين البيّنات التي جاءهم بها رسول الله المبلّغ عن ربه!
الآيات بين أيدينا تذكرة وحجّة فماذا نحن فاعلون؟!
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 19
الآيات 71 – 73
#للحفاظ
#متشابه
يبدأ المقطع بكلمة (قل) وتكررت مرتين (قل أندعوا – قل إن هدى الله) وورد لفظ القول بصيغة: (ويوم يقول) (قوله الحق)
(أندعوا من دون الله) لم ترد بهذه الصيغة إلا في سورة الأنعام وقد ورد في الآية 56 (تدعون من دون الله) و في الآية 108 (يدعون من دون الله)
(من دون الله) وردت في القرآن في 70 موضعا، 4 منها في الأنعام.
الدعاء: (قل أندعوا – يدعون من دون الله)
الهدى: (هدانا الله – إلى الهدى – إن هدى الله – هو الهدى)
الحق: (خلق السموات والأرض بالحق – قوله الحق)
ضمير الفصل “هو”: (هو الهدى – وهو الذي إليه تحشرون – وهو الذي خلق السموات والأرض – وهو الحكيم الخبير)
اسم الجلالة: تكرر في الآية الأولى من المقطع 3 مرات (من دون الله – هدانا الله – هدى الله)
(إن هدى الله هو الهدى) وردت في موضعين في القرآن: البقرة 120 والأنعام 71
(لرب العالمين) وردت في 4 مواضع في القرآن: في البقرة 131 (أسلمت لرب العالمين)، الأنعام 71 (وأمرنا لنسلم لرب العالمين)، غافر 66 (وأمرتُ أن أُسلم لرب العالمين) وفي المطففين 6 (يوم يقوم الناس لرب العالمين).
(إليه تحشرون) وردت في 7مواضع في القرآن: (الذي إليه تحشرون) 3 مرات، (وإليه تحشرون) مرتان، (أنكم إليه تحشرون) مرة، (وأنه إليه تحشرون) مرة.
(واتقوه) ورد مقترنا بـ(أقيموا الصلاة) في موضعين: في الأنعام 72 بتقديم (واقيموا الصلاة) وفي الروم 31 بتقديم (واتقوه)
(واتقوه) وردت في 4مواضع في القرآن: الأنعام 72، العنكبوت16، الروم 31 ونوح 3.
(وهو الذي خلق السموات والأرض) وردت في موضعين في القرآن: في الأنعام 73 وفي هود 7.
(بالحق) وردت في 75 موضعا في القرآن منها 5 في سورة الأنعام، وتكرر لفظ الحق في سورة الأنعام وحدها: 10 مرات.
يوم: (ويوم يقول – يوم ينفخ في الصور)
(كن فيكون) وردت في 8 مواضع في القرآن
(يوم ينفخ في الصور) وردت 4مرات في القرآن: الأنعام 73، طه 102، النمل 87 بزيادة الواو (ويوم ينفخ في الصور)، النبأ 18
(عالم الغيب والشهادة) وردت في 12 موضعا في القرآن أولها الأنعام 73 وآخرها سورة الجمعة 8.
(وهو الحكيم الخبير) وردت في 3مواضع في القرآن، اثنان منها في الأنعام 18 و73 وآية سبأ 1 وورد (وهو الحكيم العليم) مرة واحدة في الزخرف 84.
#انفرادات
(أندعوا من دون الله)
(ما لا ينفعنا ولا يضرنا)
(ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله)
(استهوته الشياطين في الأرض)
(حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى)
(لنسلم لرب العالمين) بصيغة الجمع
(وأن أقيموا الصلاة)
(وهو الذي إليه تحشرون)
(ويوم يقول كن فيكون)
(قوله الحق)
(وله الملك)
#تأملات_وتدبر
ما زالت الآيات تلقّن الرسول صلى الله عليه وسلم الردود بالموعظة والحوار على المشركين الذين يحاولون ارتداد بعض المسلمين عن دينهم فجاء الرد تيئيسا للمشركين من فتنة المؤمنين وتثبيتا للمؤمنين. يبين لهم أن من يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره هو كمن استهواه الشيطان فحمله على اتّباعه على غير هدى وترك اتّباع هدى الله عز وجل وهو الهدى الحقيقي. كيف لمن هداه الله وأمره أن يُسلم له وهو رب العالمين أن يترك الحق ويتبع الضلال؟!
في الآية 71 تكرر فعل (قل) مرتين ولكل منهما رسالة:
(قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا) إعلان التبرؤ من الشرك
(قل إن هدى الله هو الهدى) تقرير أن الهدى الحق هو هدى الله وما سواه ضلال وباطل.
الآية 71 ترسم مشهدا تصويريا للمؤمن يتنازعه طرفان: طرف الشيطان وأتباعه يريدون أن يبعدوه عن طريق الهدى وطرف إخوانه المؤمنين يتمسكون به ليثبتوه على الهدى وعلى قدر إيمان العبد يكون ثباته ولا يجعل الله عز وجل للشيطان عليه سبيلا.
هدى الله عز وجل هو الاستسلام لرب العالمين وعبادته وذكر أعظمها وأول ما يحاسب عليه العبد (وأقيموا الصلاة) وتقوى الله (واتقوه) لماذا؟! لأنه (وهو الذي إليه تحشرون) يحشرهم ليحاسبهم ويجزيهم على إيمانهم وعبادتهم وعملهم.
وعلى عادة القرآن كثيرا ما يقرن بين الأمر بتقوى الله وعبادته مع بيان استحقاقه لذلك فذكر بعدها (وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير) أفلا يستحق أن يُعبد إله هذه بعض صفاته؟! سبحانه هو أهل التقوى وأهل العبادة وأهل الاستسلام لأمره وطاعته يقينا بعظيم قدرته وملكه في الدنيا والآخرة وعلمه وحكمته.
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 20
الآيات 74 – 79
محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
(فلما) افتتحت بـها 3 آيات (فلما جنّ عليه الليل – فلما رأى القمر بازغا – فلما رأى الشمس بازغة)
فعل الرؤية: تكرر 5مرات (إني أراك – وكذلك نُري – رأى كوكبا – فلما رأى القمر – فلما رأى الشمس)
فعل القول: 7مرات (وإذ قال إبرهيم – قال هذا ربي (3مرات) – قال لا أحب الآفلين – قال لئن لم يهدني ربي – قال يا قوم إني بريء مما تشركون)
(هذا ربي) تكرر في المقطع 3 مرات
الأفول: (فلما أفل) مرتين بصيغة المذكّر مع الكوكب والقمر ومرة بصيغة المؤنث مع الشمس (فلما أفلت) – (لا أحب الآفلين)
(إنّي): 3مرات: (إني أراك وقومك – إني بريء مما تشركون – إنّي وجهت وجهي)
قوم: 3مرات (إني أراك وقومك – من القوم الضالين – قال يا قوم)
(السموات والأرض) مرتان: (ملكوت السموات والأرض – للذي فطر السموات والأرض)
بازغ: مرتان (القمر بازغا – الشمس بازغة)
الشرك: مرتان (بريء مما تشركون – وما أنا من المشركين) وورد (أتتخذ أصناما آلهة) ويعني الشرك.
ضلال: (في ضلال مبين – لأكونن من القوم الضالين)
#متشابه
(ملكوت السموات والأرض) وردت مرتين في القرآن: في الأنعام 75 (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض) وفي الأعراف 185 (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض)
ووردت (ملكوت كل شيء) في موضعين: المؤمنون 88 (قل من بيده ملكوت كل شيء) وفي يس 83 (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء)
(في ضلال مبين) وردت في القرآن 18 مرة إحداها في الأنعام 74
(بريء مما تشركون) وردت 3مرات، إثنان منها في الأنعام: 19(وإنني بريء مما تشركون) و78 (يا قوم إني بريء مما تشركون) ومرة في هود 54 (واشهدوا أني بريء مما تشركون)
ووردت (بريء مما تعملون) في يونس41 والشعراء 216 و (بريء مما تجرمون) في هود 35.
(وما أنا من المشركين) وردت في موضعين في القرآن ختام آية: الأنعام 79 ويوسف 108
(حنيفا) وردت 10 مرات في القرآن اثنان منها في الأنعام: الآية 79 و161
#انفرادات
(لأبيه آزر) لم يرد اسم آزر إلا في سورة الأنعام
(أتتخذ أصناما لآلهة)
(من الموقنين)
(أفل) من انفرادات السورة
(لئن لم يهدني ربي)
(القوم الضالين)
(إني وجهت وجهي)
(فطر السموات والأرض)
#تأملات_وتدبر
تنتقل الآيات للحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام ومحاجّته لأبيه وقومه في قضية الشرك بالله واتخاذ الأصنام آلهة من دونه وذلك من خلال تقديم الأدلة والبراهين الدامغة على أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو المستحق للعبادة وحده.
وفي اختيار قصة إبراهيم تحديدا بعد الحديث عن معاندة مشركي قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إياهم لتوحيد الله تعالى تثبيتا لقلب النبي ومواساة له فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام واجه أباه وقومه الذين لم يؤمنوا رغم الأدلة وأنت أيها النبي لا تبتئس بإعراض قومك وإن أعرض أقرب الناس إليك فلك في إبراهيم أسوة حسنة دعا أباه فلم يؤمن!
سياق قصة إبراهيم في السورة يأتي بعد آيات من التقرير بعظمة الله تعالى وكمال قدرته وسعة علمه وإحاطته بكونه فيغلب عليه طابع القوة في الحِجاج وسوق الأدلة الحاسمة التي يواجه بها المدعويين بكل شجاعة وجرأة وثبات على الحق وهكذا ينبغي أن يكون الداعية ما دامت أدلة الحق بين يديه فلا يخشى في الحق لومة لائم ولا يساوم عليه ولو أقرب الناس.
قصة إبراهيم في السورة تعلمنا أن الإنسان وإن كان يعيش في بيئة غير مؤمنة، بيئة مشركة إلا أن هذا لا يمنعه من الصدع بالحق والمواجهة بالحق بشجاعة طالما الإسلام هو العقيدة الراسخة في قلبه لا يتزحزح عنها أبدا، ونحن اليوم في عصر صار للشرك صورا أخرى فقد لا يكون بيننا من يتخذ صنما إلها ولكن أليس بيننا من صار يتخذ المال أو السلطة أو الجاه أو الشهرة أو الشهوات أو غيرها آلهة تعلّق بها تعلقا شديدا فبذل كل شيء في سبيلها حتى أضحى عبدا مملوكا لها؟!
ماذا كان سلاح إبراهيم عليه السلام الذي واجه به أباه وقومه؟ أراه الله ملكوت السموات والأرض فصار يقرأ كل شيء في الكون دليلا على وحدانية الله تعالى خاضع لله وحده ولهذا نحن مأمورون بعبادة التفكر في الكون وفي أنفسنا لنرى دلائل الحق فنخضع لخالقها. فإذا كان الكون كله يخضع لله فأيّ سلطة يملكها صنم أو بشر عليك؟!
وحين تستعرض الأدلة والبراهين بحق وبيقين فإنها تقودك إلى أن تقول كما قال إبراهيم عليه السلام معلنا البرآءة من الشرك وأهله (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين). وبعد تقديم الأدلة إن لم يقتنع المدعوون فلا جدوى من استمرار النقاش.
قد أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا مبينا كل آية فيه دليل وبرهان وما علينا إلا أن نحسن اختيار الآيات التي ندعو بها غيرنا تماما كما أحسن إبراهيم عليه السلام في محاجّة قومه بما يناسبهم وتنزّل معهم في الخطاب وتدرج به خطوة خطوة مقيما الحجة عليهم ومبينا لهم سفههم بعبادة أصنام لا تملك من أمرها شيئا!
(وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر) مباشرة دون نداء التودد كما ورد في سور أخرى (يا أبت) فسياق السورة يستدعي الحسم في مسألة التوحيد والأدلة عليه هي الأولوية لإقامة الحجة على المدعويين.
(لا أحب الآفلين) كل ما يأفل لا بد وأنه خاضع لمن يتحكم به وهو أحق بالعبادة من مخلوق متغيّر لا يملك من أمره شيئا!
(لا أحبّ) ولم يقل لا أعبد لأن العبودية الحقة منبعها محبة من تعبده وكيف لا تحبه وهو الذي خلقك وخلق الكون كله وسخّره لك؟! وكأني بإبراهيم عليه السلام حريص على أن يجنّب لسانه مجرد التلفظ بكلمة العبودية المنسوبة لغير الله تعالى!
(لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين) الهداية بيد الله تعالى وحده وكل من لم يهده الله فهو ضالّ لأنه أعمى بصيرته عن رؤية دلائل الحق وآياته البينات فما عاد يفكّر بمنطق وما عاد يتأمل ويتفكّر فلا يلومنّ إلا نفسه!
إبراهيم عليه السلام كان موحّدا في بيئة الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم كان موحّدا لله في بيئة الشرك وكما وجّه إبراهيم وجهه للذي فطر السموات والأرض فأكرمه الله تعالى برفع قواعد البيت الذي يتوجه إليه كل مسلم موحّد في الأرض فإن الله تعالى سيكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بتوجيه القبلة لبيت الله الحرام رمز التوحيد وسيعود إلى فاتحا يحطم الأصنام في مكة كما حطّمها إبراهيم متحديا قومه ويعلن طهارة المكان من الشرك ورموزه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 21
الآيات 80-83
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
الحِجاج: ( وحاجّه قومه – أتخاجّونّي في الله – وتلك حجتنا)
الشرك: (ما تشركون به – ما أشركتم – أنكم أشركتم بالله)
الأمن والإيمان (فأيّ الفريقين أحق بالأمن – الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم – أولئك لهم الأمن)
توسط الإيمان بين السؤال والإجابة فكأن الإيمان الخالص من أي شائبة شرك هو سبيل الأمن في الدنيا وفي الآخرة، المؤمن أحق بالأمن وله الأمن والأمان والهداية من ربهم..
الخوف: (ولا أخاف – وكيف أخاف – ولا تخافون)
الهدى: (وقد هدانِ – وهم مهتدون)
القوم: (وحاجّه قومه – آتيناها إبراهيم على قومه)
شيء: ( إلا أن يشاء ربي شيئا – وسع ربي كل شيء علما)
شاء: (إلا أن يشاء ربي شيئا – نرفع درجات من نشاء)
أسماء الله الحسنى في المقطع:
اسم الجلالة الله: (أتحاجوني في الله – أشركتم بالله)
رب: (إلا أن يشاء ربي – وسع ربي كل شيء علما – إن ربك)
حكيم عليم (إن ربك حكيم عليم)
الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى:
الهداية (وقد هدان)
المشيئة (إلا أن يشاء ربي)
العلم (وسع ربي كل شيء علما)
التنزيل (ما لم ينزّل به عليكم سلطانا)
إيتاء الحجة (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم)
الرفع (نرفع درجات من نشاء)
آيتان من آيات المقطع افتتحت بحرف الواو (وحاجّه قومه) (وكيف أخاف)
#انفرادات
(وقد هدان) بصيغة المفرد ووردت في إبراهيم ١٢ بصيغة الجمع (وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا)
(ولا أخاف) (ولا تخافون) (وكيف أخاف) لم ترد إلا في الأنعام
(وسع ربي كل شيء علما)
(إلا أن يشاء ربي) وفي باقي المواضع وعددها ٧ (إلا أن يشاء الله) الأنعام ١١١، الأعراف ٨٩، يوسف ٧٦، الكهف ٢٤، المدثر ٥٦، الإنسان ٣٠، التكوير ٢٩
(ما لم ينزّل به عليكم سلطانا) بإضافة (عليكم) وفي باقي المواضع (ما لم ينزّل به سلطانا) في آل عمران ١٥١، الأعراف ٣٣ والحج ٧١.
(يلبسوا) انفردت بها سورة الأنعام في الآية ٨٢ (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) و١٣٧ (وليلبسوا عليهم دينهم)
(إن ربك حكيم عليم) بإضافة (ربك) وردت في موضعين في الأنعام: ٨٣ و١٢٨ وقدّم فيها
“حكيم” على “عليم” وفي باقي المواضع (إنه حكيم عليم) بالضمير فقط (إنه) في الأنعام ١٣٩ والحجر ٢٥ والنمل ٦ (من لدن حكيم عليم)
#متشابه
(أفلا تتذكرون) ختمت بها ٣ آيات في القرآن: الأنعام ٨٠، السجدة ٤، غافر ٥٨
(إن كنتم تعلمون) وردت في ١٠ مواضع في القرآن، في البقرة ١٨٤ و٢٨٠، الأنعام ٨١، التوبة ٤١، النحل ٩٥، المؤمنون ٨٤ و٨٨، العنكبوت ١٦، الصف ١١ والجمعة ٩.
(الذين آمنوا) افتتحت بها ٧ آيات في القرآن: النساء ٧٦، الأنعام ٨٢، التوبة ٢٠، يونس ٦٣، الرعد ٢٨ و ٢٩، الزخرف ٦٩
(وهم مهتدون) ختمت بها آيتان في القرآن: الأنعام ٨٢ و يس ٢١ (اتّبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون)
(نرفع درجات من نشاء) وردت في موضعين في القرآن في الأنعام ٨٣ ويوسف ٧٦ (نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم)
هذا والله أعلم
✍️ سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 22
الآيات 84 – 90
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
الهدى ومشتقاته 7مرات: (كلّا هدينا – ونوحًا هدينا من قبل – وهديناهم إلى صراط مستقيم – ذلك هدى الله يهدي به من يشاء – أولئك الذين هدى الله – فبهداهم اقتده)
(كلّ): 3مرات اثنان منها بالنصب وواحدة بالضمّ (كُلّا هدينا – كلٌ من الصالحين – وكُلّا فضلنا)
تكرر صيغة اسم الفاعل: المحسنين – الصالحين – العالمين (مرتان) – بكافرين
ذرية: (ومن ذرّيته – وذريّاتهم وإخوانهم)
#انفرادات
(وكلٌ من الصالحين)
(وكُلّا فضّلنا على العالمين)
(ولو أشركوا)
(لحبط عنهم)
(وهديناهم إلى صراط مستقيم)
(يهدي به من يشاء “من عباده”) بإضافة “من عباده”
(أولئك الذين آتيناهم الكتاب)
(فقد وكّلنا بها)
(أولئك الذين هدى الله)
(فبهداهم اقتده)
(إن هي إلا ذكرى للعالمين)
#متشابه
(وهبنا له) وردت في 8مواضع في القرآن، 3 منها (ووهبنا له إسحق ويعقوب) في الأنعام84، الأنبياء72 والعنكبوت7 وفي مريم49 (وهبناله إسحق ويعقوب). و3 منها (ووهبنا له) في مريم53، الأنبياء90 وص43 وواحدة بصيغة الجمع (ووهبنا لهم) في مريم50
(وكذلك نجزي المحسنين) وردت في 3مواضع: الأنعام84 ويوسف22 والقصص14، واللافت أن في الترتيب المذكور في الآية ورد يوسف قبل موسى بنفس ترتيب السور يوسف قبل القصص.
(من الصالحين) وردت في 11 موضعا في القرآن: آل عمران 39 و114، الأنعام85، التوبة75، الأنبياء 75 و86، القصص27، الصافات110 و112، المنافقون10 والقلم50.
(إلى صراط مستقيم) وردت في 12 موضعا في القرآن
(ذلك هدى الله) وردت في موضعين في القرآن: الأنعام88 والزمر23
(يهدي به من يشاء) وردت في موضعين في القرآن: الأنعام88 والزمر23
(هدى الله) وردت في 5مواضع في القرآن: البقرة120، آل عمران73، الأنعام71 و88، الزمر23
(الذين آتيناهم الكتاب) وردت في 5مواضع: البقرة121 و14، الأنعام20 و89، القصص52
(لا أسألكم عليه أجرا) وردت في 3 مواضع في القرآن: الأنعام90، هود51 والشورى23
(ما كانوا يعملون) وردت في 31 موضعا في القرآن، 5منها في سورة الأنعام: الآيات43، 88، 108، 122 و127
#تأملات_وتدبر
من خصائص هذا المقطع وخصائص سورة الأنعام ذكر اسم 18 نبيّ وكأني بالترتيب يتبع في الغالب ترتيب المذكورين في الآية (ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم) فإبراهيم ذكر في آخر المقطع السابق (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم) ثم بعده ذكر ابناه: إسحق ويعقوب. ثم ذكر نوح عليه السلام ثم من ذريته: داوود وسليمان (أب وابنه) ثم أيوب ويوسف، ثم موسى وهارون (أخوان)، ثم زكريا ويحيى وعيسى (أب وابنه، ثم ابن الخالة) وبعده إلياس، ثم إسماعيل واليسع وختم بيونس ولوط عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. البداية مع إبراهيم والختام مع لوط وهو ابن أخيه وكلاهما هاجر إلى ربه.
وكأن ختام كل مجموعة من الأسماء تذكر الصفة التي عليها تم اجتباؤهم: المحسنين، الصالحين، فضّلنا على العالمين.
المقطع يرشدنا أن الهداية بيد الله عز وجل وأن الاصطفاء للأنبياء والمرسلين هو من عند الله تعالى وأنهم قد آتاهم الله تعالى الكتاب والحكمة والنبوة وعليهم أن يؤمنوا بالله وحده لا يشركوا به شيئا وإلا حبطت أعمالهم فالشرك محبط للعمل لا يشفع الاصطفاء والنبوة وحاشا لأنبياء الله أن يُشركوا وإنما الآيات تذكّر العالمين بخطورة الشرك بالله عز وجل.
الأنبياء والرسل إخوان في الرسالة والإيمان بهم واجب وهم مبلّغون عن ربهم لا يطلبون من المدعويين أجرا على دعوتهم وإنما أجرهم عند الله ربهم الذي اجتباهم واصطفاهم للنبوة وهداهم (أولئك الذين هدى الله) والمطلوب من المدعويين اتّباع نبيهم صلى الله عليه وسلم بما أمره الله تعالى به (فبهداهم اقتده) الاقتداء لا يكون بالأشخاص وإنما بهداهم لأنهم سائرون على الصراط المستقيم الذي هداهم الله تعالى إليه.
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
إضافة مستفادة من كتاب التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم – د. عبد العظيم المطعني بتصرف يسير
(وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾)
في المقطع 4 أساليب استفهامية:
أتحاجّوني – أفلا تتذكرون – وكيف أخاف – فأيّ الفريقين
(أتحاجوني) استفهام يراد منه الإنكار، إنكار الواقع منهم فعلًا وهو الجدال الفارغ في شؤون المعبود الحق وهو الله تعالى. وهذا الإنكار يتبعه الزجر
(أفلا تتذكرون) استفهام يراد به إنكار عدم التذكّر والتوبيخ عليه ويتبعه التوبيخ والحثّ على التذكر
(وكيف أخاف) استفهام يراد به إنكار الوقوع أي لا أخاف أصناكم لا الآن ولا بعد الآن، ويتبعه التسفيه
(فأيّ الفريقين) استفهام يراد به الإلجاء للجواب الصحيح ويتبعه الاستعطاف.
(وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) تكرار لفظ (ربي) إظهارا لكمال الإنابة والتفويض.
(تحاجّوني) إيثار صيغة المضارع تصوير لتوالي جدالهم وبيان لحرصهم على الباطل.
وإيثار صيغة المضارع في (ولا أخاف) إشارة إلى توالي عدم الخوف من آلهتهم.
(ما تشركون به) عدم التصريح بلفظ “الأصنام أو آلهتهم” تحقيرا لها فهي أقل من أن تُذكر وتعريض بهم أنهم أشركوا به زورا وبهتانا.
(أفلا تتذكرون) إيثار التذكر على التفكّر – ما قال أفلا تتفكرون – للإيذان بأن الكمال القدسي ظاهر يكفي مجرد التذكر لمعرفته وحضوره في القلب، أما التفكر فلما كان موضوعه استجلاء الحقائق التي فيها خفاء أو عمل فكر عميق فلم يصحّ أن يكون فاصلة لهذه الآية.
(ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطانا)
تقديم (به) على (عليكم) إعلام بعموم النفي أي أن الله تعالى لم ينزّل به سلطان قطّ لا عليهم ولا على غيرهم. ولو قيل: ما لم ينزل عليكم به سلطانا لجاز أن يكون قد نزّل ذلك السلطان على غيرهم ولكان لهم عذر في الإشراك.
(فأيّ الفريقين أحق بالأمن) هذا الأسلوب يسميه علماء البلاغة “الكلام المُنصِف” وهو فن من فنون أساليب الدعوة فيها حكمة بليغة وتليين للنفوس واستمالة للقلوب إلى الحق والصواب ثم الاهتداء إلى سواء السبيل.
(إن كنتم تعلمون) تهييج وإلهاب المشاعر يساعدهم على التغلب على العناد والميل إلى سماع صوت الدعاة والمصلحين.
وحذف مفعول (تعلمون) لقصد التعميم أي كل ما يُستطاع من معلوم نافع، أو القصد تحقق العلم في نفسه أي إذا كنتم علماء.
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 23
الآيات 91-92
مقطع جديد في بيان أن الوحي حقّ أنزله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور على رسوله خاتم موكب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يهدي به الناس إلى صراط مستقيم.
#للحفاظ
المقطع آيتان فقط افتتحتا بحرف الواو (وما قدروا الله حق قدره) (وهذا كتاب أنزلناه)
(قدروا – قدره)
فعل القول: “قل” مرتان (قل من أنزل الكتاب) (قل الله ثم ذرهم..) (وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء)
الإنزال: (ما أنزل الله على بشر من شيء – من أنزل الكتاب – وهذا كتاب أنزلناه)
اسم الجلالة تكرر في الآية الأولى 3 مرات (وما قدروا الله حق قدره – ما أنزل الله على بشر من شيء – قل الله)
يؤمنون: (الذين يؤمنون بالآخرة – يؤمنون به)
وصفان لكتاب موسى وللقرآن: كتاب موسى (نورا وهدى لناس) والقرآن (مبارك مصدّق الذي بين يديه)
ختمت الآيتان بفعل مضارع (يلعبون – يحافظون) يفيد التجدد والاستمرار، المذكبون مستمرون في خوضهم ولعبهم والمؤمنون مستمرون في المحافظة على صلاتهم.
المقطع فيه ثنائيات ولعل ذلك يتناسب مع الفريقين المذكورين في آية سابقة (أيّ الفريقين أحق بالأمن): فريق الذين لا يؤمنون أن الله تعالى أنزل شيئا على بشر وفريق المؤمنين بالآخرة المؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم.
#متشابه
(وما قدروا الله حق قدره) وردت في 3مواضع في القرآن، اثنان منها بالواو (وما) الأنعام 91، الحج 74 والزمر 67 بدون الواو (ما قدروا الله حق قدره)، مع اختلاف في نهايات الآيات كلٌ يتناسب مع محور السورة وسياقها العام.
(نورا وهدى) تقديم النور على الهدى وفي باقي المواضع قدّم الهدى على النور (هدى ونور)
(ما أنزل الله على بشر من شيء) في الأنعام ووردت (ما أنزل الرحمن من شيء) في سورة يس15 ووردت (ما نزّل الله من شيء) في سورة الملك9
(تجعلونه قراطيس) بصيغة الجمع وورد قرطاس بصيغة المفرد في الأنعام7 ولم ترد الكلمة في غيرها.
(كتاب أنزلناه مبارك) تكررت في سورة الأنعام في موضعين: الآية92 و155
(ولتنذر أم القرى ومن حولها) وردت في موضعين في القرآن: الأنعام 92 والشورى 7
(يؤمنون بالآخرة) وردت في 12 موضعا في القرآن، 3 منها في سورة الأنعام 92، 113 و150.
(يؤمنون به) وردت في 8مواضع في القرآن: البقرة 121، الأنعام92، هود17، الحجر13،
الشعراء 201، العنكبوت47، غافر7، الشورى18.
(على صلاتهم يحافظون) وردت في موضعين في القرآن: الأنعام 92 والمعارج 34.
(وهذا) افتتح به 3 آيات في سورة الأنعام: (وهذا كتاب أنزلناه)، الأنعام12 (وهذا صراط ربك مستقيما)، الأنعام155 (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه). وافتتح به الآية50 من سورة الأنبياء (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) والآية 3 من سورة التين (وهذا البلد الأمين)
#انفرادات
(ما أنزل الله على بشر من شيء)
(الكتاب الذي جاء به موسى)
(نورا وهدى للناس)
(تجعلونه قراطيس)
(وهم على صلاتهم يحافظون)
#تأملات_ وتدبر
(تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا) (وعُلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم)
قيل الأولى خطاب لليهود فهذا عملهم: جعل التوراة قراطيس، إبداء شيء منها وإخفاء أشياء بحسب ما يناسب أهواءهم.
والثانية خطاب لمشركي العرب لم يكن لهم ولا لآبائهم علم قبل نزول القرآن.
(وما قدروا الله حق قدره) ومن أمثلة عدم تقديرهم لله عز وجل حق قدره قولتهم الشنيعة (ما أنزل الله على بشر من شيء) بل هي جريمة قولية نكراء من هؤلاء الجاهلين الخائضين العابثين اللاهين!
(في خوضهم يلعبون) ليس مجرد لهو عابر وإنما هم في الخوض كمن هو غارق في بحر لجّي إشارة لشدة انغماسهم في اللعب الذي لا جدوى منه ولا يقوم به إلا الأطفال عن غير فهم ولا إدراك!
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
t.me/islamiyyatchannel
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 24
الآيات 93 – 94
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
الوحي: (أو قال أوحيَ إليّ ولم يوح إليه شيء)
أنزل: (ومن قال سأُنزِل) – (مثل ما أنزَل الله)
الظلم: (ومن أظلم ) (ولو ترى إذ الظالمون)
كنتم: (بما كنتم تقولون على الله غير الحق) (وكنتم عن آياته تستكبرون) (وضل عنكم ما كنتم تزعمون)
الزعم: (الذين زعمتم) (وضل عنكم ما كنتم تزعمون)
فعل القول: (أو قال أوحي إليّ) (ومن قال سأُنزل مثل ما أنزل الله) (بما كنتم تقولون على الله غير الحق)
الأيتان في المقطع افتتحتا بحرف الواو (ومن أظلمُ) – (ولقد جئتمونا فرادى)
#متشابه
(ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا) وردت في القرآن في 4مواضع، إثنان منها في الأنعام بداية آية: 21 و93، وفي هود 18 والعنكبوت 68.
ووردت بصيغة (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) في 4مواضع إثنان منها بداية آية: الأعراف 37 ويونس 17 واثنان منها ختام آية: الأنعام 144 والكهف 15
ووردت بصيغة (فمن أظلم ممن) في 6 مواضع منها ما ذكر سابقا إضافة إلى (فمن أظلم ممن كذّب بآيات الله) الأنعام157 والزمر 32( فمن أظلم ممن كذب على الله وكذّب بالصدق)
وورد بصيغة (ومن أظلم ممن) في 9مواضع منها ما ذكر سابقا إضافة إلى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله) البقرة114، (ومن أظلم ممن كتم شهادة) البقرة 140، (ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات رب) الكهف 57، (ومن أظلم ممن ذكّر بآيات ربه) السجدة 22
(ولو ترى إذ الظالمون) وردت في موضعين: الأنعام 93 (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت) وسبأ 31 (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم)
(غير الحق) وردت في 12 موضعا في القرآن، 3 منها بصيغة (غير الحق) إحداها في الأنعام 93 (بما كنتم تقولون على الله غير الحق) وباقي المواضع (بغير الحق)
(فرادى) وردت مرتين في القرآن: في الأنعام 94 (ولقد جئتمونا فرادى) وفي سبأ 4 (أن تقوموا للناس مثنى وفرادى)
(اليوم تجزون) وردت في 3مواضع في القرآن، إثنان منها (اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم) في الأنعام 93 والأحقاف 20 (فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون..) بإضافة الفاء “فاليوم” وموضع الجاثية 28 (اليوم تجزون ما كنتم تعملون)
(عذاب الهون) ورد في موضعين في القرآن الأنعام 93 والأحقاف 20 وورد معرّفا (العذاب الهون) في فصّلت 17 (صاعقة العذاب الهون.
(كنتم تزعمون) وردت في 4 مواضع إثنان في الأنعام: 22 و94 وإثنان في القصص 2 و74
#انفرادات
(في غمرات الموت)
(والملائكة باسطو أيديهم)
(أخرجوا أنفسكم)
(عن آياته تستكبرون)
(جئتمونا فرادى)
(وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم)
(وراء ظهوركم)
(تقطّع بينكم)
(وضلّ عنكم ما كنتم تزعمون)
#تأملات_وتدبر
(ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا..)
الآية تعدد 3 نماذج من الكفر:
افتراء الكذب على الله (افترى على الله كذبا) وقدّم في الآية لأنه أشنع أنواع الكفر.
ادّعاء النبوة بادّعاء تلقي الوحي (أو قال أوحي إليّ ولو يوحى إليه شيء) وهو نوع من افتراء الكذب على الله.
ادّعاء القدرة على الإتيان بمثل القرآن (ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله)
وصدّرت الآية باستفهام يُنكر وينفي هذه الصور كلها (ومن أظلم) لا أحد أظلم من هذا الذي يدّعي هذا الكلام!
(ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت) مشهد مخيف مهول وكأن الظالمين ساعة الاحتضار يغمرهم الموت غمرا فتشتد وطأته عليهم
(أخرجوا أنفسكم) يا من كنتم تدّعون القدرة وتستكبرون وتستهزئون، إن كانت لكم قدرة فأخرجوا أنفسكم مما أنتم فيه! ما أهونكم على الله وما أشد حشرتكم وقد أيقنتم أنكم لا تملكون لأنفسكم شيئا ولا من كنتم تدّعون أنهم آلهة يملكون لكم شيئا!
التعبير بصيغة المضارع في (تجزون) (تقولون) (تستكبرون) (تقطّع) (تزعمون) لاستحضار المشهد وكأنه ماثل أمام الأعين ليكون أثره أوقع في الأنفس.
(ولقد جئتمونا فرادى..) هذه الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن قلب وذهن أي إنسان، جاء إلى الدنيا فردا وسيعود إلى خالقه فردا لكنه يعود حاملا كل ما كسب واكتسب في عمره فيحاسبه الله تعالى ولن يجد أحدا ليحمل عنه ولا ليلقي عليه اللوم ولا يحمّله مسؤولية ما جناه على نفسه!
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 25 و26
الآيات 95 – 103
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
(وهو الذي) افتتحت به 3 آيات متتالية (وهو الذي جعل لكم النجوم) (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة) (وهو الذي أنزل من السماء ماء)
(وهو) 7 مرات (وهو الذي) 3مرات، (وهو بكل شيء عليم) (وهو على كل شيء وكيل) (وهو يدرك الأبصار) (وهو اللطيف الخبير)
(قد فصّلنا) مرتان: (قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) (قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون)
(لقوم) 3مرات: (لقوم يعلمون – لقوم يفقهون – لقوم يؤمنون)
(الآيات) 3مرات (قد فصلنا الآيات) مرتان، (إن في ذلكم لآيات)
(فالق) مرتان، (فالق الحب والنوى – فالق الإصباح) وقد انفردت سورة الأنعام بهذا اللفظ (فالق)
(أنّى) مرتان: (فأنّى تؤفكون) (أنّى يكون له ولد)
(جعل) مرتان: (وهو الذي جعل لكم النجوم) (وجعلوا لله شركاء الجنّ)
(أخرج) 5مرات: (يُخرج الحي من الميت – مخرج الميت من الحيّ – فأخرجنا به نبات كل شيء – فأخرجنا منه خضرا – نخرج منه حبّا متراكبا)
(خلق) 3مرات: (وخلقهم) (وخلق كل شيء) (خالق كل شيء)
(كل شيء) 5مرات: (نبات كل شيء – وخلق كل شيء – وهو بكل شيء عليم – خالق كل شيء – وهو على كل شيء وكيل)
(الحيّ) مرتان – (الميت) مرتان
(الأبصار) والإدراك مرتان: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)
(ذلكم) مرتان: (إن في ذلكم لآيات – ذلكم الله ربكم)
(علم) 3مرات: (ذلك تقدير العزيز العليم – بغير علم – وهو بكل شيء عليم)
#انفرادات
(ومخرج الميت من الحيّ) انفردت بها سورة الأنعام وفي غيرها (ويخرج الميت من الحي) في يونس 31 والروم19
(ذلكم الله) انفردت الأنعام95 بصيغة (ذلكم الله) ووردت في غيرها (ذلكم الله ربكم) (ذلكم الله ربي)
(وجعل الليل) ووردت بدون الواو منفردة في الفرقان62 (وهو الذي جعل الليل) وباقي المواضع (جعل لكم الليل) يونس 67، الفرقان47، القصص73، غافر61
(وجعل لكم النجوم)
(والشمس والقمر حسبانا)
(أنشأكم من نفس واحدة) وفي باقي المواضع (خلقكم من نفس واحدة) في النساء 1، الأعراف 189، الزمر 6
(لقوم يفقهون) لم ترد في غيرها أبدا
(فأخرجنا منه) وفي باقي المواضع (فأخرجنا به) في الأنعام 99، الأعراف 57، طه 53، فاطر27.
(خضِرا) (متراكبا) (مشتبها)
(إن في ذلكم لآيات) وفي باقي المواضع (إن في ذلك لآيات) في يونس67، الرعد3 و4، إبراهيم6، الحجر75، النحل 12و79، طه 54و128، المؤمنون 30، النمل 86، العنكبوت24، الروم21 و22 و23 و24 و37، لقمان 31، السجدة26، سبأ 19، الزمر 42 و52، الشورى33 والجاثية14.
(سبحانه وتعالى عما يصفون) وفي الإسراء موضع منفرد (سبحانه وتعالى عما يقولون) وفي باقي المواضع (سبحانه وتعالى عما يشركون) في يونس 18، النحل1، الروم 40، الزمر 67.
(شركاء الجن)
(وخلقهم)
(وخرقوا له بنين وبنات)
(أنّى يكون له ولد) (ولم تكن له صاحبة)
#متشابه
(فالق الحب والنوى) (فالق الإصباح)
(يُخرج الحي من الميت) وردت في 3مواضع: الأنعام 95، يونس 31 والروم19
(ذلكم الله) وردت في القرآن في 9مواضع، انفردت الأنعام95 بصيغة (ذلكم الله) ووردت بصيغة (ذلكم الله ربكم) في الأنعام 102 ويونس3 و 32(فذلكم الله ربكم) وفاطر13 والزمر6 وغافر62 و64 وانفردت سورة الشورى 10 (ذلكم الله ربي)
(فأنّى تؤفكون) وردت ختام آية في 4مواضع: في الأنعام 95، يونس 34، فاطر3 وغافر62
(ذلك تقدير العزيز العليم) وردت في 3مواضع: الأنعام 96، يونس 38 وفصلت 12
(ظلمات البر والبحر) وردت في 3مواضع اثنان منها في الأنعام:63 و97 وفي النمل 63
(النجوم) وردت في 9مواضع في القرآن
(لقوم يعلمون) وردت في 8مواضع إثنان منها في الأنعام:97 و105، وفي البقرة 230، الأعراف32، التوبة11، يونس5، النمل 52، فصلت3.
(وغير متشابه) وردت في الأنعام مرتين: 99 و 141
(لآيات لقوم يؤمنون) وردت في 6مواضع : الأنعام 99، النحل79، النمل86، العنكبوت24، الروم37، الزمر52، ووردت (لقوم يؤمنون) وردت في 13 موضعا منها الأنعام 99
(وجعلوا لله) وردت في 4مواضع في القرآن اثنان منها في الأنعام 100 و136، الرعد33،إبراهيم30.
(بغير علم) وردت في 11 موضعا في القرآن، 5منها في الأنعام: 100 و108 و119 و140 و144، وفي النحل25، والحج3 و8، وفي الروم29، لقمان6 و20، الفتح 25
(بديع السموات والأرض) وردت في موضعين فقط: في البقرة 117 والأنعام 101
(صاحبة) وردت في موضعين فقط: في الأنعام 101، والجنّ 3 (ما اتخذ صاحبة ولا ولدا)
(وخلق كل شيء) وردت في موضعين: الأنعام 101 والفرقان 2
(وهو بكل شيء عليم) وردت في 3مواضع: البقرة29، الأنعام101 والحديد3
(لا إله إلا هو) وردت في 29 موضعا في القرآن، اثنان منها في الأنعام 101 و 106
(خالق كل شيء) وردت في 4مواضع: الأنعام102، الرعد16، الزمر62، غافر62
(وهو على كل شيء وكيل) وردت مرتان فقط في الأنعام 102 والزمر62 ووردت (وهو على شيء قدير) 7مرات (وهو على كل شيء شهيد) مرة واحدة فقط في سبأ47.
(وهو اللطيف الخبير) وردت في موضعين فقط: في الأنعام 104 وفي الملك14
(فاعبدوه) وردت في 5مواضع: آل عمران51، الأنعام 102، يونس 3، مريم 36، الزخرف 64.
#تأملات_وتدبر
هذا المقطع اشتمل على مقدمة القسم الثاني من السورة والذي يتحدث عن مظاهر قدرة الله عز وجل وأدلة توحيد الألوهية والربوبية بالخلق والتسخير.
من الآية 95 إلى 99: تعريف بالله عز وجل وما فعله للإنسان من خلق وتسخير.
آيات الله تعالى في الخلق: (فالق الحب والنوى) (يخرج الحي من الميت)
وفي الكون (فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا) (وهو الذي جعل لكم النجوم)
وفي الأنفس (وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة)
وفي الماء (وهو الذي أنزل من السماء ماء)
وفي الإنبات (فأخرجنا به نبات كل شيء..)
ثم موقف الكافرين (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون) الله عز وجل خلق الخلق جميعا إنسهم وجنّهم فكيف يجعل هؤلاء الكافرون لله شركاء من الجن الذين خلقهم؟! هو خلقهم وهم اختلقوا كذبا وافتراء وبهتانا ونسبوا لله بنات كالملائكة وبنين كعيسى ابن مريم وما هذا الاختلاق إلا جهل وضلالة!
ثم تأتي الآيات من 101 إلى 103 تقيم الحجة على الكافرين وتبين مظاهر عظمة الله تعالى وقدرته. وتأمل في تكرار (كل شيء) ليتضح هذا المعنى دون الحاجة لإعمال فكر ولا طول تأمل: فالله عز وجل خلق كل شيء، فالكون كله بما في من أجناس ومخلوقات على أنواعها يدخل تحت (كل شيء) وهو سبحانه بكل شيء عليم وهو خالق كل شيء وهو على شيء وكيل، وقد سبق بيان تفصيل أنه خلق كل شيء في الكون في السموات وما فيهن والأرض وما فيها من النبات والزروع وفي الأنفس وسبق سعة علمه بكل شيء ألا يستحق إله هذه بعض صفاته أن يُعبد ولا يُشرك به شيئا؟!
(لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) ليست هذه إلا لله عز وجل وحده سبحانه هو اللطيف الخبير.
#فائدة_من_كتاب
(بديع السموات والأرض) إيثار (بديع) في هذه الآية وفي نظيرتها في سورة البقرة 117 على (خالق) لأن بديع صفة مشبّهة باسم الفاعل فالوصف بها متمكن أمكن لا ينقطع. [من كتاب التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم – دز عبد العزيم المطعني]
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 27
الآيات 104 – 107
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
(قد جاءكم بصائر من ربكم)– (فمن أبصر فلنفسه) وعكس الإبصار العمى (ومن عميَ فعليها)
حفيظ: (وما أنا عليكم بحفيظ) – (وما جعلناك عليهم حفيظا)
ربّ: (بصائر من ربكم) (اتّبع ما أوحي إليك من ربك)
ما: (وما أنا عليكم بحفيظ) (اتّبع ما أوحي إليك) (ولو شاء الله ما أشركوا) (وما جعلناك) (وما أنت عليهم بوكيل)
على: (فعليها) (عليكم) (عليهم) مرتان
آيتان في المقطع افتتحت بالواو (وكذلك نصرّف الآيات) (ولو شاء الله)
#انفرادات
(قد جاءكم بصائر من ربكم)
(وكذلك نصرّف الآيات) وفي غيرها بدون واو (كذلك نصرّف الآيات) الأعراف 58
(وليقولوا درست )
(ولنبّينه لقوم يعلمون)
(اتّبِع ما أوحي إليك) وفي غيرها (واتّبِع ما يوحى إليك) يونس 109 والأحزاب 2
(وما جعلناك عليهم حفيظا) منفردة في الأنعام وفي غيرها (فما أرسلناك عليهم حفيظا) النساء 80 والشورى 48
#متشابه
(بصائر من ربكم) وردت في موضعين: الأنعام 104 والأعراف 203 ووردن كلمة (بصائر) في الإسراء 102 ووردت (بصائر للناس) في القصص 43 والجاثية 20
(فلنفسه) وردت في 4مواضع في القرآن: الأنعام 104 (فمن أبصر فلنفسه)، الزمر 21 (فمن اهتدى فلنفسه)، فصلت 46 والجاثية 15 (من عمل صالحا فلنفسه)
(فعليها) وردت في 3مواضع: في الأنعام 104 (ومن عميَ فعليها) وفي فصلت 46 والجاثية 15 (ومن أساء فعليها) أما في الزمر 41 (ومن ضل فإنما يضل “عليها”) بدون الفاء
(وما أنا عليكم بحفيظ) وردت مرتان في القرآن: الأنعام 104 وهود 86
(نصرّف الآيات) وردت في 4 مواضع في القرآن، 3 منها في الأنعام: 46، 65، 105 وفي الأعراف 58
(ما أوحي إليك) 3مرات: في الأنعام 106 (اتبع ما أوحي إليك) وفي الكهف27 (واتل ما أوحي إليك) وفي العنكبوت 45 (اتل ما أوحي إليك) ووردت في الأنعام 145 (قل لا أجد فيما أوحيَ إليّ)
(لا إله إلا هو) وردت 29 مرة منها مرتان في الأنعام102 و106
(وأعرض عن المشركين) وردت مرتان في الأنعام 106 وفي الحجر 94
(ولو شاء الله) وردت 11 مرة في القرآن، 3 منها في الأنعام: 35، 107، 135 (لهداهم، ما أشركوا، ما فعلوه) وورد في الأنعام 112 (ولو شاء ربك)
(وما أنت عليهم بوكيل) وردت 3 مرات: الأنعام 107، الزمر 41، الشورى 6
#تأملات_وتدبر
في المقطع تقرير لحقيقة أن الله عز وجل كما اختص الله تعالى إبراهيم بأن أراه ملكوت السموات والأرض ليكون من الموقنين،أعطى البشر أيضًا البصائر ليبصروا بها آياته المبثوثة في الكون وفي الأنفس والتي سبق ذكر تفصيلها في المقطع السابق وكذلك في آيات القرآن البيّنات التي تدعو للنظر والتأمل والتفكر في أدلة وبراهين التوحيد الواضحة. كم نحتاج أن نفتح بصائرنا وأبصارنا وأسماعنا لرؤية الحق وسماع الحق وقبول الحق بيقين إبراهيم عليه السلام وكوكبة الأنبياء من بعده إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم.
وتقرر الآيات حقيقة أن الإنسان إن أبصر الحق فإنما فائدة ذلك تعود عليه وحده وإن أعمى بصيرته عنه فلا يلومن إلا نفسه!
لكن الكافرين يصرّون على شبهاتهم وهاهم من جديد يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب الذي جاء يدعوهم به ليس وحيا وإنما نتيجة دراسة ومدارسة فيأتي التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن إعراض المشركين من سنن الله تعالى في كونه ولو شاء لهدى الناس جميعا كما سبق وورد في السورة (ولو شاء الله لهدى الناس جميعا) المؤمنون يؤمنون بأن ما أنزل إليه وحي من ربه والكافرون يختلقون الشبهات! ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتّبع ما أوحي إليه ويعرض عن أمثال هؤلاء المشركين بالعفو والصفح وتحمل الأذى منهم فإنما هو مبلّغ عن ربه لا يملك هدايتهم ولا هو حفيظ عليهم ولا وكيل.
#فائدة_تفسيرية
في القرآءات
(وليقولوا درست) فيها 3 قرآءات
دَرَسْتَ – دارستَ – دَرَسَتْ
الأولى معناها واضح والثانية من المدارسة والثالثة معناها: مضت هذه الآيات وانتهت وانمحت وتقادمت وهي من باب الأساطير
وكلٌ من الأقوال الثلاثة تسمعه من الكافرين في عصرنا، الأول والثاني يقوله أهل الكتاب والثالث يقوله الملاحدة: إن الدين كله مرحلة من مراحل الحياة البشرية انتهت وانقضت.
(الأساس في التفسير – سعيد حوّى)
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 28
الآيات 108-110
#للحفاظ
آيات المقطع الثلاث تبدأ بحرف الواو (ولا تسبّوا – وأقسموا بالله – ونقلّب)
تكرر في المقطع:
(ولا تسبّوا – فيسبّوا)
(عملهم – يعملون)
ليؤمننّ – يؤمنون – كما لم يؤمنوا
آية – الآيات
جاءتهم – جاءت
(يدعون من دون الله – وأقسموا بالله – إنما الآيات عند الله)
#انفرادات
(إلى ربهم مرجعهم فينبّئهم) وفي غيرها (فننبئّهم) في لقمان 23
(إلى ربهم مرجعهم) وفي غيرها (إلى ربكم مرجعكم)
#متشابه
(بغير علم) وردت 12 مرة في القرآن، خمس منها في سورة الأنعام وحدها: 100، 108، 119، 140، 144
(من دون الله) وردت في الأنعام 4مرات في الآيات: 56، 70، 71، 108 وردت كلها في سياق الدعوة من دون الله ما عدا الآية 70 (ليس لها من دون الله وليّ ولا شفيع)
(لكل أمة) وردت 6مرات في القرآن: الأنعام 108، الأعراف 34، يونس 47 و49، الحج 34 و67
(ثم إلى ربهم) وردت مرتان في الأنعام: 38 و108
(مرجعهم) تكررت 5 مرات: الأنعام 108، يونس 46 و70، لقمان 23 والصافات 68
(بما كانوا يعملون) وردت في 10 مواضع في القرآن، إثنان منها في الأنعام 108 و127
(وأقسموا بالله جهد أيمانهم) وردت في 4مواضع في القرآن: الأنعام 109، النحل38، النور 52 وفاطر 42
(قل إنما الآيات عند الله) وردت مرتان: في الأنعام 109 والعنكبوت 50
(أول مرة) وردت في 9مواضع في القرآن إثنان منها في الأنعام: 94 و109
(أول) وردت في سورة الأنعام في 4 مواضع(أن أكون أول من أسلم (14))، (كما خلقناكم أول مرة (94))، كما لم يؤمنوا به أول مرة (110)) وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين (163))
(في طغيانهم يعمهون) وردت خمس مرات في القرآن: البقرة 15، الأنعام 110، الأعراف 186، يونس 11، المؤمنون 75.
#تأملات_وتدبر
آيات المقطع مع الآيتين في نهاية المقطع السابق من قوله تعالى (اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين) في بيان كذب دعاوى المشركين وكيفية التعامل معهم.
نهي المؤمنين عن سب المشركين أدبٌ قرآني عالٍ يرتقي بالمؤمنين في أخلاقهم وتعاملهم مع المشرك فالأصل في التعامل بُغض فعلهم وهو الشرك لا بغض ذواتهم فماذا ينفع المؤمن إن شتم مشركًا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن يسب أحدنا أباه بسبّه أبا أحد آخر فإن سب مشرك قد يتسبب في سبّه لله عز وجل وهذا لا يليق! ولا يمكن لمسلم أن يسمح لنفسه أن يكون سببا في ذلك! والدعاء على المشركين كما نسمع من بعض الخطباء على المنابر يدخل في السباب والشتم ويعترض إن ردّوا على ذلك بشتم الدين وأبناء الدين وقد يتطور الأمر لشتم النبي صلى الله عليه وسلم وشتم الله عز وجل؟! أين نحن من مهمة الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن وإلانة القول للمشركين المعاندين؟!
القرآن العظيم هذّب ألسنتنا من سبّ أو شتم المشركين فما بال أقوام من المسلمين أطلقوا ألسنتهم بشدة على إخوانهم المسلمين فمن المؤسف أن نرى ونسمع من صار السبّ والشتم على لسانه سهلا يسيرا يشتم هذا ويسبّ ذاك بدون سبب وكأنه صار محط كلامه لا يهتز له جفن! وقد وصل الأمر في بعض الحالات أن تجد مسلما يسبّ الله عز وجل والعياذ بالله!!
(كذلك زيّنا لكل أمة عملهم) عادة التزيين أن يكون من الشيطان (وزين لهم الشيطان أعمالهم) أما في آية سورة الأنعام فنسب التزيين إلى الله تعالى، الله عز وجل أقام عليهم الحجج وأمهلهم فلم يؤمنوا واختاروا سبل الشيطان فحال بينهم وبين قلوبهم وهذه سنة من سنن الله تعالى في خلقه.
(وأقسموا بالله جهد أيمانهم) حين لا يجد المشرك المعاند حجة منطقية يدافع بها عن كفره يلجأ إلى الأيمان والحلف بأنه إذا جاءته آية كما طلب سيؤمن لكن الله تعالى عليم بما في صدره وما خفي من شركه فلا يجيب طلبه لأنه إن جاءت الآية ولم يؤمن بها استحق الهلاك وهذه سنة أخرى من سنن الله تعالى في الكون.
وأيّ آية يطلبها المشركون أعظم من القرآن؟! إنه الآية الخالدة التي لا تزول بموت النبي صلى الله عليه وسلم، هي الآية الباقية الخالدة إلى قيام الساعة!
في الآية تحذير: لا يمكن لأحد أن يفصّل دينا على هواه، ولا أن يطلب آيات توافقه، الدين منهج كامل عليه أن يأخذه كله لأن الذي شرعه حكيم عليم.
نسمع اليوم من أبناء جلدتنا من يطلب التجديد في الخطاب القرآني وحذف آيات وإضافة آيات تتناسب مع احتياجات العصر حتى وصل لمرحلة التشكيك في الآيات! وهؤلاء ما اختلفوا كثيرا عمن طلب آيات على هواه ليؤمن!
#فائدة
(وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها لو جاءت لا يؤمنون)
تضمنت الآية:
دعوى المشركين (لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها)
الرد على الدعوى (قل إنما الآيات عند الله)
التعقيب على الدعوى (وما يُشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون)
وتضمنت الآية أسلوبا بديعا في تحول الخطاب:
افتتحت بالحديث عن المشركين بضمير الغائب (وأقسموا، لئن جاءتهم، ليؤمنن بها)
ثم تحول الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتلقينه بالرد عليهم (قل إنما الآيات عند الله)
ثم تحول الخطاب إلى جماعة المؤمنين (وما يُشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون)
(وأقسموا بالله “جهد أيمانهم”) ليس مجرد قسم عادي فقد بالغ القرآن في وصفه إشارة إلى حرصهم الشديد على إقناع النبي والمسلمين بأنهم صادقون في دعواهم!
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 28 و29
الآيات 111-113 والآيات 114 – 117
#للحفاظ
آيات المقطع كلها تبدأ بحرف الواو: (ولو أننا نزلنا إليهم الكتاب – وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا – ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة)
(ولكن أكثرهم يجهلون) “يجهلون” لم ترد إلا في الأنعام ولعل في هذا مناسبة لما في السورة من الحديث عن العلم والجهل ضد العلم.
تكرر في المقطع:
العلم: يعلمون العليم – أعلم (مرتان)
أنزل إليكم – منزّل من ربك
يضلّونك – أضلّ
كلمة ربك – لا مبدل لكلماته
أنزل إليكم الكتاب – آتيناهم الكتاب
#انفرادات
(نزّلنا إليهم) منفردة في الأنعام وفي غيرها (نزّلنا إلى) أو نزّلنا بدون حرف جر
(وكلمهم الموتى)
(وحشرنا عليهم)
(قُبُلا)
(ما كانوا ليؤمنوا) وفي غيرها (وما كانوا) في يونس13، (فما كانوا) في الأعراف 101 ويونس 74
(شياطين الإنس والجن) لم ترد إلا في الأنعام وفي غيرها وردت “الشياطين” أو “شيطاينهم”
(زخرف القول)
(ولكن أكثرهم يجهلون) في الأنعام وفي غيرها (ولكن أكثرهم لا يعلمون)
(ولتصغى إليه)
(فذرهم وما يفترون)
(وليقترفوا ما هم مقترفون)
(وهو الذي أنزل إليكم الكتاب)
(صدقا وعدلا)
(أكثر من في الأرض)
(أعلم من يضل عن سبيله) وفي غيرها (أعلم بمن ضلّ)
#متشابه
(ولو أننا نزّلنا) تكررت (ولو) في سورة الأنعام 6مرات: (الآيات 7 (ولو نزّلنا عليك كتابا)، 9 (ولو جعلناه ملكا)، 27 (ولو ترى إذ وقفوا على النار)، 30 (ولو تر إذ وقفوا على ربهم)، 107 (ولو شاء الله ما أشركوا)، 111 (ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة..))
(الموتى) وردت في الأنعام مرتين: (والموتى يبعثهم الله) (وكلمهم الموتى) وورد (الموتى) في القرآن إما عن إخراج الموتى أو بعث الموتى ووردت مرة في الرعد (أو كُلّم به الموتى)
(وحشرنا عليهم) في الأنعام 111 وفي الكهف (وحشرناهم)
وغالب ورود فعل الحشر في القرآن بصيغة المضارع (نحشرهم، يحشرون، تحشرون، يحشرهم، لنحشرنهم، نحشر، يُحشر، نحشره،) وورد بصيغة الماضي (حشرت، وحُشر، حشرتني) وبصيغة فعل الأمر (احشروا) والمصدر (حشرُ) (الحشر)
(إلا أن يشاء الله) وردت 7مرات في القرآن: الأنعام 111، الأعراف 89، يونس 7، الكهف24، المدثر 56، الإنسن 30، التكوير 29
(ولكن أكثرهم) وردت 12 مرة في القرآن: انفردت الأنعام بـ(ولكن أكثرهم يجهلون)، (ولكن أكثرهم لا يعلمون) وردت في الأنعام 37، الأعراف 131، الأنفال 34، يونس 55، القصص 13 و57، الزمر 49. (ولكن أكثرهم لا يشكرون) مرتان في يونس 60 والنمل 73.
(وكذلك) افتتحت بها 8 آيات في سورة الأنعام وحدها: الآيات 53،55،75، 105، 112، 123، 129، و137
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا) وردت مرتان في القرآن: الأنعام 112 والفرقان 31
(زخرف) وردت في 4 مواضع: الأنعام 112 (زخرف القول)، يونس 42 (الأرض زخرفها)، الإسراء 93 (بيت من زخرف)، الزخرف 35 (وزخرفا)
(غرورا) وردت في 5مواضع: النساء 120، الأنعام 112، الإسراء 6، الأحزاب 12، فاطر 40.
(يفترون) تكررت في السورة في 4مواضع: (وضل عنهم ما كانوا يفترون (24))، (فذرهم وما يفترون (112))، (وما يفترون (137))، (سيجزيهم بما كانوا يفترون (138)
(ولو شاء ربك) وردت 3 مرات في الأنعام 112 (ختام آية) وفي يونس99 وهود 118 بداية آية.
(ربك/ربكم) وردت 23مرة في الأنعام/ (ربك) بالإفراد 16 مرة و(ربكم) بالجمع 7مرات
(ما فعلوه) وردت 3مرات: في النساء 66، الأنعام 112 والأنعام 137
(فذرهم) وردت في 6مواضع: الأنعام 112 و137، المؤمنون54، الزخرف83، الطور45، المعارج42
(الذين لا يؤمنون بالآخرة) وردت في 10 مواضع، 2 منها في الأنعام 113 و150 والذين لا يؤمنون) بإضافة الواو
(أفغير الله) 3مرات، الأنعام 114، النحل 52 والزمر 64 (مسبوقة بـ(قل))
(الكتاب) تكرر في سورة الأنعام 9مرات، إنزال الكتاب وإيتاء الكتاب.
(بالحق) وردت في القرآن 75 مرة منها 5 في الأنعام: الآيات 5، 30، 73، 114، 151
(فلا تكونن من الممترين) وردت 3مرات: في البقرة 147، الأنعام 114، يونس 94 ووردت في آل عمران 60 (ولا تكن من الممترين)
(وتمت كلمة ربك) 3مرات: الأنعام 115، الأعراف 137، هود 119
(لا مبدّل لكلماته) مرتان: الأنعام 115 والكهف 27
(وهو السميع العليم) وردت مرات، اثنان منها في الأنعام: 13 و115، وفي البقرة 137، الأنبياء 4، العنكبوت 5 و60
(إن يتّبعون إلا الظنّ) 4مرات: الأنعام 116، يونس 66، النجم 23 و28
(إن ربك هو أعلم) 5مرات: الأنعام 117 و119، النحل 125، النجم 30 والقلم 7
(عن سبيله) وردت في 8مواضع في القرآن وتكررت في الأنعام 117 و151
(وهو أعلم بالمهتدين) 4مرات: الأنعام 117، النحل 125، القصص 56، القلم 7
#تأملات_وتدبر
تستمر الآيات في إبطال دعاوى المشركين الذي يطلبون آية حتى يؤمنوا، سبق وطلبوا آية (وقالوا لولا نُزّل عليه آية من ربه) فجاءهم الرد من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم (قل إن الله قادر على أن ينزّل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون) ختمت الآية بنفي العلم عن أكثرهم هم لا يتأملون في آيات الله حولهم فما الفائدة في إنزال ما طلبوه؟!
(وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها) والله تعالى يعلم أنهم لا يؤمنون!
ثم تأتي الآية في هذا المقطع (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) الملائكة كلهم وليس آية واحدة، (وكلمهم الموتى) آية أخرى (وحشرنا عليهم كل شيء قُبُلا) قُبُلا أي قبيلة قبيلة، لو نزّل الله تعالى كل هذه الآيات ما كانوا ليؤمنوا لأن الإيمان متعلق بمشيئة الله تعالى، وختمت الآية هنا (ولكن أكثرهم يجهلون) وكأن الجهل فطريٌ متأصل فيهم فالجاهل هو الذي يعرض عن الآيات ولا يؤمن بها!
والجهل عدو العلم (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) وتأتي الوصية الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم (فذرهم وما يفترون)
(ولو شاء الله) تأتي في سياق عظيم تجرؤ المشركين على مقام الإلهية
(ولو شاء ربك) تأتي في سياق الرأفة والرحمة الربانية بالنبي صلى الله عليه وسلم
(ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون)
(لتصغى) بمعنى تميل ميلا قويا تُعرِض به
قال أبو حيان: هذه الجُمل على غاية الفصاحة؛ لأنه أولا يكون الخداع فيكون الميل فيكون الرضى فيكون فعل الاقتراف.
الله تعالى أنزل الكتاب بالحق ومفصلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ولا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فلا ينبغي لعاقل أن يشك في ذلك ومن فعل فإنما ضلّ عن سبيل الله باتباع الظنون لكن الله تعالى يعلم الضالّ من المهتدي.
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 30
الآيات 118 – 121
بيان أحكام الأطعمة والذبائح
#للحفاظ
4 آيات افتتحت الأولى بحرف الفاء (فكلوا) وثلاث بحرف الواو (وما لكم ألا تأكلوا) (وذروا ظاهر الإثم وباطنه) (ولا تأكلوا)
وختمت 3 آيات في المقطع باسم الفاعل (مؤمنين – بالمعتدين – لمشركون) وآية ختمت بصيغة الفعل (يقترفون)
تكرر في المقطع:
الأكل: (فكلوا – ألا تأكلوا – لا تأكلوا)
(مما ذكر اسم الله عليه) مرتان (مما لم يذكر اسم الله عليه) مرة
العلم: (بغير علم – هو أعلم)
الإثم: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه) (إن الذين يكسبون الإثم)
خطاب بصيغة الجمع (فكلوا – كنتم – مؤمنين– لكم – تأكلوا – لكم – عليكم – اضطررتم – وذروا – ولا تأكلوا – ليجادلوكم – أطعتموهم – إنكم لمشركون)
وردت إنّ المشددة 5مرات: (وإنّ كثيرا ليضلون) (إنّ ربك هو أعلم بالمعتدين) (إن الذين يكسبون الإثم) (وإنّه لفسق) – (إنكم لمشركون)
ووردت إن المخففة مرتان: (إن كنتم مؤمنين) (وإن أطعتموهم)
#انفرادات
(إن كنتم بآياته مؤمنين)
(وقد “فصّل” لكم) سورة الأنعام وقد تكرر فيها كلمة “فصل” ومشتقاتها.
(اضطررتم) انفردت سورة الأنعام بهذه الصيغة وفي باقي المواضع (اضطر) ومنها في الأنعام 145 (فمن اضطر) وفي البقرة 126 (أضطره)
(وإن كثيرا ليضلّون بأهوائهم)
(بالمعتدين) بإضافة الباء انفردت بها الأنعام وفي غيرها (المعتدين) بدون باء في 4مواضع: (لا يحب المعتدين) في البقرة 190، المائدة 87، الأعراف 55 وفي يونس 74 (عاقبة المعتدين)
(وذروا) مفتتح آية لم ترد إلا في الأنعام 120 وفي غيرها وسط آية في 3 مواضع: البقرة 278، الأعراف 180 والجمعة 9
(ظاهر الإثم وباطنه)، أما “الإثم” وحده ورد في 13 موضعا في القرآن.
(يكسبون الإثم) بصيغة الجمع وفي غيرها (يكسب إثما) بالإفراد في النساء 111 وورد الإثم مقترنا بالسيئة أو بالخطيئة في غيرهما.
(بما كانوا يقترفون) وانفردت الأنعام بـ(وليقترفوا ما هم مقترفون) وفي التوبة (أموال اقترفتموها)
(وإنه لفسق)
(وإنّ الشياطين) وردت الشياطين معرّفة بالألف واللام في 14 موضعا إثنان منها في الأنعام 71 و121 ووردت نكرة “شياطين” في الأنعام 112 وفي البقرة 14 (شياطينهم)
(إنكم لمشركون)
#متشابه
(اسم الله) ورد في 9مواضع في القرآن في سورة المائدة مرة وفي الأنعام 4 وفي الحج 4 وارتبطت كلها بالذكر:
(ذُكِر اسم الله عليه) لم ترد إلا في سورة الأنعام الآيات 118، 119 وفي الآية 121 بصيغة (يُذكَر)
ووردت بصيغة: واذكروا/ ليذكروا/ لا يذكرون/ فاذكروا/ يُذكر فيها
(وإن كثيرا) وردت في القرآن في 7مواضع كلها متبوعة بحرف الجرّ (من) “من الناس، من الأحبار، منهم” إلا آية الأنعام اتبعت بفعل (وإن كثيرا ليضلّون بأهوائهم)
#تأملات_وتدبر
بعد الأدلة والحجج والبراهين الدامغة على عظمة الله تعالى وتوحيده تأتي آيات هذا المقطع لبيان أحكامه عز وجل في الذبائح والأطعمة فالأحكام مرتبطة بالعقيدة ارتباطا وثيقا، وكلما كانت عقيدة الإنسان راسخة كان إذعانه لأحكام الله تعالى أسرع.
والآيات توضح الفرق الشاسع بين أحكام الله تعالى العليم الحكيم العزيز الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وبين أهواء الضالين المضلّين الجاهلين!
آيات المقطع تميزت بأسلوب بديع:
- أمر إباحة بالأكل (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين)
- حضّ على الأكل مما ذكر اسم الله عليه بأسلوب الاستفهام الذي غرضه العتاب والإنكار اللطيف ليحثّهم على الإذعان والطاعة (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه) ما قال “لماذا لا تأكلوا”، أو “لمَ لا تأكلوا” لأن فيهما شدة.
- أمرٌ فيه تهديد مؤكد للمبالغة: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون)
- نهيٌ صريح وتهديد مؤكّد للمبالغة (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)
(وإن كثيرا ليضلّون بأهوائهم بغير علم إن الله هو أعلم بالمعتدين)
ثلاثية المعتدين على أحكام الله تعالى: إضلال، هوى ، وجهل.
(وقد فصّل لكم ما حُرّم عليكم)
فصّل “لكم” النفع عائد لكم إذا التزمتم الأكل مما أحلّ الله
حرّم “عليكم” ضرر الأكل مما حرّم الله يقع عليكم، “عليكم” ترسم صورة حمل ثقيل على ظهر من يأكل مما حرّم الله ينوء بحمله!
المقطع حافل بالتوكيد كيف لا وهو يتحدث عن حكم الله تعالى فيما أحلّ وحرّم من الأطعمة!
(وإنّ كثيرا ليضلّون بأهوائهم بغير علم إنّ ربك هو أعلم بالمعتدين)
الآية مليئة بالتوكيدات للمبالغة في تحذير المؤمنين من هؤلاء المضلّين المتّبعين أهواءهم
التوكيد بإنّ المشددة واستعمال (كثيرا) واللام في (ليضلّون) وصيغة المضارع في (يضلّون) وذكر سبب إضلالهم: اتباع الهوى والجهل
وفي المقابل فإن التوكيد في ختام الآية تثبيت لقلوب المؤمنين فالله تعالى هو أعلم بالمعتدين. جاء التعبير بـ(إنّ) المشددة وضمير الفصل (هو) والجملة الاسمية (أعلم بالمعتدين) وتقديم (ربك) للحصر فهو سبحانه وحده العليم بهم.
(وذروا ظاهر الإثم وباطنه) العليم سبحانه مطّلع على الظواهر والبواطن لا يخفى عليه شيء!
(وإنّه لفسق) توكيد للمبالغة أن اكتساب الإثم بعدم الالتزام بحكم الله فسقٌ وأيّ فسق! الفسق خروج عن أحكام الله التي ارتضاها لعباده.
(فكلوا مما ذكر اسم الله عليه)
ذكر اسم الله على الذبائح ليس مجرد كلمة تقال ولكنه إعلان لربوبية الله عز وجل وتفرّده بالأحكام وإظهار لعبودية العبد لربّه واذعانه لأحكامه.
وفي التسمية تذكير للعبد بنعم ربه عليه أن أحلّ له الذبائح وجعل الحلال كثيرا وما حرّم قليلا وهو 11 صنفا كما ذكرت آية المائدة (حرّمت عليكم الميتة والدم…) فيحمد الله ربه على ما سخّره له أولا من الأنعام ثم ما أحله له ثم ما رزقه إياه ليكون طعاما حلالا طيبا.
(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) “مما” أصلها “من ما” فيها معنى التبعيض فالمذبوح لا يؤكل منه إلا اللحم أما الجلد والعظم فلا يؤكل.
(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) وقد سبق في السورة الحديث عن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وسيأتي لاحقا في السورة حديث عن الشياطين أيضًا فأحكام الله تعالى وشرعه مسرحٌ للشياطين يحاولون خداع المؤمنين فيه واستدراجهم لعدم الطاعة لله فيما أمر به ونهى عنه.
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 31
الآيات 122 – 127
دعوة للتفكّر في آيات الله الدالة على قدرته سبحانه وتعالى لتحقيق التوحيد والإخلاص له.
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
كل آيات المقطع ختمت بصيغة فعل (يعملون – لا يشعرون – يمكرون – لا يؤمنون – يذّكّرون – يعملون)
وختام أول آية وآخر آية في المقطع (يعملون)
جعل: 4مرات (وجعلنا له نورا) (وكذلك جعلنا) (حيث يجعل رسالته) (كذلك يجعل الله)
كذلك: 3مرات: مرتان في ختام آية بدون واو (كذلك زُيّن للكافرين) (كذلك يجعل الله الرجس) وبالواو في مفتتح آية 123 (وكذلك جعلنا في كل قرية)
اسم الجلالة (الله) 5مرات واسم (الرب) مرتان
المكر: 3مرات (ليمكروا فيها) (وما يمكرون إلا بأنفسهم) (بما كانوا يمكرون)
صيغة (ما كانوا) 3مرات: (ما كانوا يعملون) (بما كانوا يمكرون) (بما كانوا يعملون)
(مجرميها) (أجرموا)
(حتى نؤتى) (مثل ما أوتي)
(عند الله) (عند ربهم)
(لن نؤمن) (لا يؤمنون)
(ما): ما كانوا – وما يمكرون – وما يشعرون – ما أوتي – بما كانوا (مرتان)
(فمن يُرد – ومن يُرد)
(يشرح صدره) – (يجعل صدره ضيّقا)
وفي المقطع مقابلات عديدة:
ميتا، فأحييناه – نورا، الظلمات – يهديه، يضلّه – يشرح صدره، بجعل صدره ضيقا حرجا.
#انفرادات
(أومن كان) في الأنعام فقط وفي غيرها (أفمن كان)
(يمشي به)
(زُيّن للكافرين) في الأنعام فقط وفي غيرها (زُيّن للذين كفروا)
(أكابر مجرميها) – (ليمكروا فيها)
(وما يمكرون) وفي الأنفال (ويمكرون)
(لن نؤمن حتى)
(رُسل الله) في الأنعام فقط وفي غيرها (رسل ربنا) أو (رسل ربك)
(صغار)
(وعذاب شديد بما كان يمكرون)
(وعذاب شديد) بإضافة الواو وفي غيرها (عذاب شديد) غالبها مسبوق بـ(لهم)
(يشرح صدره) فقط في الأنعام وفي غيرها بإضافة كلمة بين الشرح والصدر (شرح الله صدره) (ألم نشرح بك صدرك) (من شرح بالكفر صدرا) (اشرح لي صدري)
(يصّعّد) بالتضعيف لم ترد إلا في الأنعام وورد (إليه يصعد الكلم الطيب) فاطر 10
(يجعل الله الرجس)
(على الذين لا يؤمنون)
(صراط ربك مستقيما) في الأنعام فقط وفي غيرها (صراط مستقيم) وفي الحجر 41 (قال هذا صراط عليّ مستقيم)
#متشابه
(ليس بخارج منها) (بخارج) وردت في الأنعام بصيغة المفرد وبصيغة الجمع مرتين في البقرة 167 (وما هم بخارجين من النار) وفي المائدة 37 (وما هم بخارجين منها)
(ما كانوا يعملون) وردت في 18 موضعا في القرآن، 3 منها في الأنعام: الآية 43 (وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون)، الآية 88 (لحبط عنهم ما كانوا يعملون) والآية 122 (زُين للكافرين ما كانوا يعملون)
(وجعلنا له) وردت في موضعين في القرآن: الأنعام 122 والإسراء 18 (جعلنا له جهنم)
(في كل قرية) وردت مرتان في القرآن: الأنعام 123 والفرقان 51 (ولو شئنا بعثنا في كل قرية نذيرا)
(وما يشعرون) وردت 6مرات في القرآن، اثنان منها في الأنعام: الآية 26 (وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون) والآية 123 (وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون) ووردت في البقرة 9 وآل عمران 69 ، النحل 21 والنمل 65.
(جاءتهم آية) وردت في الأنعام مرتين: الآية 109 (لئن جاءتهم آية) وفي الآية 124 (وإذا جاءتهم آية)
(الله أعلم حيث يجعل رسالته) تكرر العلم في سورة الأنعام 31 مرة
(أعلم) تكرر 6مرات في السورة (أليس الله بأعلم بالشاكرين، والله أعلم بالظالمين، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، الله أعلم حيث يجعل رسالته)
(رسالته) وردت في موضعين في القرآن: المائدة 67 (وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته) والأنعام 124 (الله أعلم حيث يجعل رسالته)
(الرجس) وردت في 4 مواضع في القرآن، مع الجعل في الأنعام 125 (يجعل الله الرجس) وفي يونس 100 (ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون)، وفي الحج 30 (واجتنبوا الرجس من الأوثان) وفي الأحزاب 33 (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت)
صراط مستقيم: ورد في سورة الأنعام 4مرات: الآية 39 (ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم)، الآية 87 (وهديناهم إلى صراط مستقيم)، الآية 161 (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) والآية 126 (هذا صراط ربك مستقيما)
(قد فصّلنا الآيات لقوم) وردت فقط في الأنعام 3مرات: الآية 97 (قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون)، في الآية 98 (قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) وفي الآية 126 (قد فصلنا الآيات لقوم يذّكرون)
(دار السلام) وردت في موضعين في القرآن: الأنعام 127 (لهم دار السلام عند ربهم) وفي يونس 25 (والله يدعو إلى دار السلام)
(عند ربهم) وردت في 19 موضعا في القرآن واحدة في الأنعام 127
(وهو وليّهم) في الحديث عن الله تعالى في الأنعام 127 وفي الحديث عن الشيطان في النحل 63 (فزيّن لهم الشيطان أعمالهم فهو وليّهم) ووردت في آل عمران 122 (والله وليّهما)
#تأملات_وتدبر
(أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس)
شبّه الكافر بالميت لأنه مات عهده مع الله عز وجل وخرج من دائرة الاستخلاف وفرّط بالأمانة الإلهية (تفسير سورة الأنعام أ. د. طه جابر العلواني)
(أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس) مقابل من سبق ذكرهم في المقطع السابق (وإن كثيرا منهم ليضلّون بأهوائهم بغير علم) الوحي نور والضلال والكفر والجهل ظلمات بعضها فوق بعض!
في الآية بيان فضل الله عز وجل على كل من كان ميتا فأحياه الله بنور الوحي فالحمد لله على عظيم فضله.
لا يستوي ميت معدوم النفع مع حيّ يمشي بالنور في الناس يضيء لهم الطريق!
التعبير بصيغة المضارع في (يمشي به في الناس) إشارة إلى التجدد والحدوث، المشي في الناس بنور الوحي هو الدعوة ولا يفتر الداعية عن دعوته!
(وجعلنا له نورا يمشي به في الناس) (له) وكأن تقديم (له) تخصيص يوحي بأن لكل حيّ نورا خاصا به وحده.
(وكذلك زُيّن للكافرين ما كانوا يعملون) حين تفسد الفطرة وتفسق فما أسهل أن يزيّن لها سوء عملها فتراه حسنا وترى النافع ضارا والضرّ نافعا!
الكفر من الظلمات، والموت هو الضلال والنور هو العلم والإحياء هو الإيمان
(وكذلك جعلنا لكل قرية أكابر مترفيها ليمكروا فيها) من سنن الله تعالى في الكون أن الترف والفسق قرينان (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) الترف والفسق قرينان!
(وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله) نقضوا دعواهم السابقة بأنفسهم، هم قالوا من قبل بل وأقسموا جهد أيمانهم (لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها)
(سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون)
استكبارهم استحقوا عليه الذلّ والصغار
ومكرهم استحقوا عليه عذابا شديدا
الله أعلم حيث يجعل رسالته والله أعلم من يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلال فيضلّه.
الضالّون يسلكون سبل الشياطين أما المهتدون فيسلكون صراط ربهم المستقيم يحقق لهم السلامة من الشرك والسلامة من الضلال والسلامة من اتّباع الأهواء ومن الاستكبار على دين الله وآياته وأحكامه وعلى ذلك يكافئهم الله تعالى بدار السلام (لهم دار السلام عند ربهم) فما أعظمه من جزاء: دار السلام وأعظم منه العندية (عند ربهم)
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 33
الآيات 128 – 131
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
(يا معشر الجنّ) (يا معشر الجنّ والإنس)
(استكثرتم من الإنس) (أولياؤهم من الإنس) (يا معشر الجن والإنس)
في الآية الأخيرة من المقطع السابق (هو وليّهم بما كانوا يعملون) وفي بداية المقطع التالي (وقال أولياؤهم) (وكذلك نولّي)
(استمتع بعضنا ببعض) (وكذلك نولّي بعض الظالمين بعضا)
(وكذلك نولّي) (ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى وأهلها غافلون)
(بلغنا أجلنا) (الذي أجّلت لنا)
(ويوم يحشرهم) (يومكم هذا)
(شهدنا على أنفسنا) (وشهدوا على أنفسهم)
(وقال أولياؤهم) (قال النار مثواكم) (قالوا شهدنا على أنفسنا)
(“ربنا” استمتع بعضنا ببعض) (إن “ربك” حكيم عليم) (ذلك أن لم يكن “ربك”)
(بما “كانوا” يكسبون) (أنهم “كانوا” كافرين)
#انفرادات
(قال النار مثواكم)
(خالدين فيها إلا ما شاء الله) وفي غيرها (خالدين فيها ما دامت السموات والأرض) في هود 107 و108 فقط
(وأهلها غافلون)
#متشابه
(ويوم “يحشرهم” جميعا) بياء الغائب وردت مرتان في القرآن: الأنعام 128 (ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجنّ) وسبأ 40 (ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة)
وردت في الأنعام 22 (ويوم “نحشرهم” جميعا) بنون المتكلم وفي يونس 28 (ويوم “نحشرهم” جميعا ثم نقول للذين آشركوا)
(إلا ما شاء الله) وردت 4مرات في القرآن: الأنعام 128، الأعراف 188، يونس 49، الأعلى
(إن ربك حكيم عليم) فقط في الأنعام: 83 و128
(يا معشر الجن والإنس) وردت في الأنعام 130 وفي الرحمن 33 (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا..)
(ألم يأتكم رسل منكم) وردت مرتان في القرآن: الأنعام 130 (يقصّون عليكم) والزمر 71 (يتلون عليكم)
(رسل منكم يقصون عليكم) وردت في الأنعام 130 (ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي) وفي الأعراف 35 (إما يأتينّكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي)
(يقصّون عليكم) ورد فعل (قصّ) مرتان في الأنعام: 57 و130 وورد في الأعراف35 و202، وورد في النمل (إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل..)
(وغرّتهم الحياة الدنيا) وردت في 3 مواضع: الأنعام70 (وغرتهم الحياة الدنيا أن تبسل نفس…) وفي الأنعام 130 والأعراف 51 (وغرتهم الحياة الحياة فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا)
(أنهم كانوا كافرين) وردت في موضعين: الأنعام 130 والأعراف 37
(ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم) في الأنعام 130 وفي هو 117 (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) وفي القصص 59 (وما كنا مهلكي القرى وأهلها ظالمون)
(مهلك القرى): في الأنعام 131 (ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى وأهلها غافلون) والقصص 59 (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا)
#تأملات_وتدبر
(يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض..) العلاقة بين الجن والإنس لا تتعدى الوسوسة والتزيين وليس للجنّ أيّ سلطان أو تأثير على الإنس وهذا باعتراف إبليس في خطبته يوم القيامة (وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) وقد أدخل بعض المسلمين أنفسهم في متاهة من هذا الباب وادّعوا ما لم يرد فيه! فالقرلآن قصر العلاقة بينهما بأنهم يروننا من حيث لا نراهم (إنه يراكم وقبيله من حيث لا تورنهم)[الأعراف: 27] وأن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول غرورا كما ورد في آية الأنعام.
(قال النار مثواكم خالدين فيها) قضوا أعمارهم معرضين مستهزئين بالدعوة ورسولها فاستحقوا الخلود في النار لا يتوقف عنهم عذابها!
(يا معشر الجن والإنس) نداء تخويف وترهيب
(ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويتذرونكم لقاء يومكم هذا) سؤال تقرير غرضه التوبيخ والتقريع والتحسير
(يقًّصون عليكم) التعبير بالفعل (يقصّون) يناسب وروده في السورة الآية 57 (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) ويدل على أن الرسل بلّغت ما أنزل الله بكل أمانة ودقة كما يقصّ الأثر لإقامة الحجّة على المشركين المعرضين عن قبول الرسالة.
النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي أرسل إلى الجن والأنس جميعا (وكان النَّبي يبعث إلى قومه خاصة، وبُعثتُ إلى النَّاس عامَّة)
رسالة عيسى ليست رسالة عامة ومايقوم به النصارى المنصّرين باطل وضد دينهم فالنصرانية واليهودية دين خاص لبني إسرائيل وليس دينا عاما
(وغرتهم الحياة الدنيا) علّة ضلالهم أنهم اغتروا بالحياة الدنيا
(يقصّون عليكم) في الدنيا الرسل كانوا يقصّون عليهم آيات الله فأعرضوا ولم يؤمنوا ويوم القيامة هؤلاء المعرضين يشهدون على أنفسهم أنهم كانوا كافرين والتعبير بالجملة الإسمية (إنهم كانوا كافرين) تأكيد على ثبوت صفة الكفر فيهم!
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد 34
الآيات 132 – 135
#للحفاظ
4 آيات في المقطع افتتحت الأولى والثانية بالواو (ولكلٍ درجات) (وربك الغني ذو الرحمة) والآية الأخيرة افتتحت بـ(قل)
ختمت الآية الأولى بفعل (يعملون) وختمت الآيات الأخرى بـ(آخرين، بمعجزين، الظالمون)
تكرر التعبير بصيغة الفعل المضارع في المقطع: (يعملون، يشأ، يذهبكم، ويستخلف، يشاء، توعدون، تعلمون، تكون) وهي تدل على التجدد والحدوث ولاستحضار الصورة واقعا للعبرة.
#انفرادات
(وما ربك بغافل عما يعملون) وفي غيرها (وما ربك بغافل عما تعملون) في هود 123 والنمل 93
(إن يشأ يُذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء)، في النساء133 (إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بـآخرين) (وإن يشأ يذهبكم ويأت بـخلق جديد) في إبراهيم 19 وفاطر16
(من بعدكم)
(كما أنشأكم من)
(فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار) وفي غيرها (فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم) هود 39، (سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب) هود 93
#متشابه
(ولكلٍ درجات مما عملوا) وردت في موضعين: الأنعام 132 والأحقاف 19 وكلاهما بداية آية.
الأنعام 130 (وربك الغني ذو الرحمة) وفي الكهف 58 (وربك الغفور ذو الرحمة)
(ويستخلف من بعدكم ما يشاء) في الأنعام 130 وفي هود 57 (ويستخلف ربي قوما غيركم)
(أنشأكم) وردت 5مرات: في الأنعام 98 (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة) و في الأنعام 132 (كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين) ووردت في هود 61 (وهو أنشأكم من الأرض) وفي النجم 32 (إذ أنشأكم من الأرض) وفي الملك 23 (وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة)
(قوم آخرين) في المائدة 41 (سماعون لقوم آخرين) وفي الأنعام 132 (من ذرية قوم آخرين)
(إن ما توعدون لآت) في الأنعام 133 وفي غيرها: ((إنما توعدون لصادق) الذرايات 5 و (إنما توعدون لواقع) المرسلات 7. ووردت (ما توعدون) في الأنبياء 109، المؤمنون 36، ص 53، ق 32، الذاريات 22 والجنّ 25.
(لآت) مرتان في القرآن: في الأنعام 134 (إنما توعدون لآت) وفي العنكبوت 5 (فإن أجل الله لآت) وفي باقي المواضع (لآتية) في الحديث عن الساعة (الساعة لآتية) في الحجر 85 وغافر 59.
(وما أنتم بمعجزين) وردت في 5 مواضع في القرآن: أولها الأنعام 134، يونس 53، هود 33، كلها خواتيم آية ووردت بداية آية في العنكبوت 22 والشورى 31
(قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن يعامل فسوف تعلمون) في الأنعام 135 والزمر 39 آية متطابقة تماما، ووردت في هود 93 (ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون) وفي هود 121 (قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون)
(من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون) في الأنعام 135 و (ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون) في القصص 37.
(إنه لا يفلح الظالمون) وردت في 4 مواضع في القرآن: الأنعام 21 و135، يوسف 23، القصص 37.
#تأملات_وتدبر
(وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ) أيّ من أهل الخير وفي الجنَّة، وأيضاً تَدُلّ بدلالة المخالفة على الدَّرَكات
(وربك الغني ذو الرحمة) العجب كل العجب ممن يتكبَّر ويَظُنّ أنه يستغني عن الله وهو الغني سبحانه! (تدبر)
(وما أنتم بِمُعْجِزِينَ) أي وما أنتم بِخَارجين عن حُكمِ الله، ولا عن سيطرته ولا عن قوَّته ولن تُعجزون الله هَرَبا
(اعملوا على مكانتكم) ما دمتم مكذبين افعلوا ما تشاءون وسترون العاقبة وهذا غايةُ ما يكون من التَّهديد.
(إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) هَذه قاعدةٌ من قواعد القرآن العظيمة. فالظَّالِم نفى الله عنه الفَلاح في الدُّنيا والآخرة، ولابُدّ أن يَخسر في الدُّنيا والآخرة
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد
الآيات 136 – 140
ضلالات المشركين وتجرؤهم على تحكيم أنفسهم من دون الله في بيان الحلال والحرام
#للحفاظ
بداية المقطع (وجعلوا لله ) وهو الموضع الثاني في السورة الذي يفتتح بها بعد الآية 100 (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم)
تكرر في المقطع:
الأنعام: (من الحرث والأنعام، هذه أنعام، وأنعام حرّمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، ما في بطون هذه الأنعام) تكرر لفظ الأنعام 3مرات في الآية 138 وحدها.
حرث: (من الحرث والأنعام، هذه أنعام وحرثٌ حجرٌ)
شركاء: (لشركائنا، لشركائهم، إلى شركائهم، شركاؤهم، فهم فيه شركاء)
فعل القول: (فقالوا هذا لله بزعمهم، وقالوا هذه أنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام)
اسم الإشارة (هذا) بالتذكير والتأنيث: (هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، هذه أنعام وحرث حجر، في بطون هذه الأنعام)
بزعمهم: (وقالوا هذا لله بزعمهم – لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم)
سيجزيهم: (سيجزيهم بما كانوا يفترون) (سيجزيهم وصفهم)
افتراء: (يفترون – افتراء عليه – يفترون – افتراء على الله)
(ما): (مما ذرأ – فما كان لشركائهم – وما كان لله – ما فعلوه – وما يفترون – بما كانوا يفترون – ما في بطون – ما رزقهم الله – وما كانوا مهتدين)
كانوا: (كانوا يفترون – كانوا مهتدين)
(حُرّمت ظهورها – ومحرّمٌ على أزواجنا – وحرّموا ما رزقهم الله)
(قتل أولادهم – الذين قتلوا أولادهم)
#انفرادات
(مما ذرأ لكم)
(وكذلك زَيّن) وفي غير هذا الموضع الفعل مبني لما لم يسمى فاعله (وكذلك زُيّن)
(حُرِّمت ظهورها) وفي غير الأنعام (حُرِّمت عليكم)، في النساء 23 (حُرّمت عليكم أمهاتكم) وفي المائدة 3 (حُرّمت عليكم الميتة…)
(سيجزيهم) لم ترد إلا في الأنعام في آيتين متتاليتين 138 و139 (سيجزيهم بما كانوا يفترون) (سيجزيهم وصفهم) وورد فيها (سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا) في الأنعام 157، وفي غيرها وردت بصيغة: سيجزي، يجزي، يُجزى، تُجزى
(قتلوا أولادهم) في هذا الموضع في الأنعام ووردت (ولا تقتلوا أولادكم) في الأنعام 151 وفي الإسراء 31
(سفها بغير علم)
(حرّموا ما رزقهم الله)
(افتراء على الله) وفي غيرها (يفترون على الله) (افترى على الله)
#متشابه
(وجعلوا لله) في الأنعام 110 وفي الأنعام 136 وفي الرعد 33 وفي إبراهيم 30 كلها بداية آية ما عدا آية الرعد
(ذرأ) في موضعين: الأنعام 136 (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث) وفي النحل 13 (وما ذرأ لكم)
(فذرهم وما يفترون) وردت في الأنعام ختام آية مرتان: الآية 112 و137
(فذرهم) في 6 مواضع في القرآن، ختام آية في موضعي الأنعام وبداية آية في 4 مواضع: المؤمنون 54 (فذرهم في غمرتهم حتى حين)، الزخرف 83 (فذرهم يخوضوا ويلعبوا)، الطور 4 (فذرهم حتى يلاقو) والمعارج 42 (فذرهم يخوضوا ويلعبوا)
(ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون) ذكر اسم الجلالة يتناسب مع وروده قبلها وبعدها (وجعلوا لله، لا يصل إلى الله، وما كان لله، لا يذكرون اسم الله، رزقهم الله، افتراء على الله)
ووردت في الآية 112 (ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون) ذكر اسم الرب يتناسب مع وروده في الآيات قبلها وبعدها (ذلكم الله ربكم، بصئر من ربكم، أوحي إليك من ربك، ثم إلى ربهم مرجعهم، منزّل من ربك، وتمت كلمة ربك، إن ربك هو أعلم..)
(خالصة) وردت في مواضع: في البقرة 94، الأنعام 139، الأعراف 32، الأحزاب 50، ص 46
(ميتة) في الأنعام 139 (وإن يكن ميتة) وفي الأنعام 145 (إلا أن يكون ميتة) ووردت (الميتة) بالتعريف في سياق التحريم في البقرة 173 والمائدة 3 والنحل 115 ووردت في يس في اوصف الأرض (وآية لهم الأرض الميتة)
(حكيم عليم) في كل مواضع سورة الأنعام تقدّم حكيم على عليم وهي 3 مواضع: 83، 128، و139 وفي آية الحجر 25 والنمل 6 وباقي المواضع يتقدم عليم على حكيم.
(قد خسر الذين) وردت في 3 مواضع في القرآن، إثنان بداية آية في الأنعام 31 (قد خسر الذين كذّبوا بلقاء الآخرة) والأنعام 140 (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) وموضع سورة يونس ختام آية 45 (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين)
(قد ضلّوا) وردت في 4 مواضع: في النساء 167، المائدة 77، الأنعام 140، الأعراف 149
(وما كانوا مهتدين) وردت في 3 مواضع في القرآن: البقرة 16، الأنعام 140 ويونس 45.
#تأملات_وتدبر
آيات المقطع تبين سفاهة وضلال المشركين في أحكامهم التي أتوا بها فيما يتعلق بالأطعمة والذبائح، أحكام غير منطقية وجائرة ولا تخضع لأسس صحيحة إنما هي مجرد أهواء ومنافع لفئات دون فئات! ولو قارناها بالأحكام الواردة في سورة المائدة والأحكام التي وردت في سورة الأنعام لتبين فيما لا يقبل الشكّ أن الحكم لله تعالى وحده فهو الحكيم العليم العدل وهو المالك الحقيقي للأنعام وهو وحده الذي يحق له أن يحدد الحلال منها والحرام لكن أنّى لعقول لا تقدر الله حق قدره أن تنصاع لأحكامه وهي لم تؤمن ولم تستجب لتوحيده؟!
حين تفسد العقول وتضل القلوب لا عجب إن جارت الأحكام! وعجبا لمستخلَف في الأرض يتجاوز حدوده مع مالكه ومالك الأنعام وخالقها فيخصص له نصيبا جائرا ثم يسترده منه إن شاء (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ساء ما يحكمون)!!
ومن انحرافات أمثال هؤلاء أنهم يحرّضون بالآباء على قتل الأولاد وجعلهم قرابين لآلهتهم المزعومة “القرابين البشرية” وهذا من وسوسة وتزيين شياطين الإنس والجن لهم! والبعض توحي لهم شياطينهم بقتل أولادهم خشية إملاق وسيأتي النهي عن هذا في الوصايا العشر في ختام السورة. وتأتي التوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده بترك هؤلاء السفهاء وافتراءاتهم (فذرهم وما يفترون)
(قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين) آية لخّصت حكم الله فيهم وبيّنت خسارتهم وافتراءهم على الله الكذب وأكّدت ضلالهم وبعدهم عن الهداية، فما أشد خسارتهم لو كانوا يعلمون!!
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد
الآيات 141 – 147
النعم بأصناف الزروع والحرث والأنعام التي خلقها الله تعالى للناس وأحلّها لهم
#للحفاظ
في المقطع 4 آيات مفتتحة بالواو (وهو الذي أنشأ، ومن الأنعام حمولة وفرشا، ومن الإبل اثنين، وعلى الذين هادوا حرّمنا)
وفيه آية افتتحت بـ(قل)
اختتمت 4 آيات بصيغة اسم الفاعلين للدلالة على ثبوت هذه الصفات في الفاعلين (المسرفين، صادقين، الظالمين، لصادقون)
واختتمت آية في المقطع بأسماء الله الحسنى (فإن ربك غفور رحيم)
واختتمت آية بوصف عداوة الشيطان (إنه لكم عدو مبين)
يبين أن اتباع خطوات الشيطان يقود إلى التجرؤ على التحليل والتحريم وفق الأهواء بينما اتباع منهج الله تعالى يقود إلى الالتزام بحكمه في التحليل والتحريم وفي كل أمر فالحكم له وحده وعلى العباد السمع والطاعة.
تكرر في المقطع:
معروشات – غير معروشات
ثمره – إذا أثمر
مختلفا أُكُله – كلوا من ثمره – كلوا مما رزقكم الله
لا تسرفوا – المسرفين
اثنين تكررت 4 مرات
الأنثيين تكررت 4 مرات
آلذكرين: مرتان
البقر: مرتان
صادقين – لصادقون
فمن أظلم – الظالمين
(أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين) مرتان
حّرم – حرّم – محرّما – حرّمنا – حرّمنا
غير معروشات – غير متشابه – بغير علم – لغير الله
بعلم – بغير علم
يهدي – هادوا
(قل آلذكرين – قل آلذكرين – قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرما)
(أو): أو دما مسفوحا – أو لحم خنزير – أو فسقا – أو الحوايا – أو ما اختلط بعظم
كنتم: ( إن كنتم صادقين – أم كنتم شهداء)
(أم): (أم الانثيين ) مرتان – (أمّا): (أما اشتملت) مرتان،
(ما): (كلوا مما رزقكم – في ما أوحي – إلا ما حملت ظهورهما – أو ما اختلط بعظم)
(إنّ) المشددة: (إنه لا يحب المسرفين – إنه لكم عدو مبين – إن الله لا يهدي القوم الظالمين – فإنّه رجس – فإنّ ربك غفور رحيم – وإنّا لصادقون)
#انفرادات
(كلوا من ثمره) في الأنعام وفي غيرها (ليأكلوا من ثمره) يس35، (كلوا من رزقه، كلوا من طيبات، من الطيبات، من رزق ربكم، مما في الأرض)
(وآتوا حقه) في الأنعام وفي غيرها (وآتوا الزكاة، وآتوا اليتامى، وآتوا النساء)
(مختلفا أُكله) في الأنعام وفي غيرها (مختلفا ألوانه)
(فإنّ ربك غفور رحيم) في الأنعام وفي غيرها (فإن الله غفور رحيم)
(وصّاكم الله) في الأنعام وفي غيرها (يوصيكم الله) في النساء 11
(ليضِلّ الناس) في الأنعام وفي غيرها (ليضلّ عن سبيل الله) في الحج 9 ولقمان 6، (ليضل عن سبيله) الزمر 8، (ليضلّ قوما) التوبة 11
(ذو رحمة واسعة)
(ولا يُردّ بأسه) في الأنعام وفي غيرها (ولا يُردّ بأسنا) يوسف 110
#متشابه
(وهو الذي أنشأ) وردت مرتان: في الأنعام 141 وفي المؤمنون 78 (وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة)
(والزيتون والرمان) الأنعام 99 و141
(لا تسرفوا – إنه لا يحب المسرفين) وردت مرتان: الأنعام 141 والأعراف 31
(ولا تتبعوا خطوات الشيطان) وردت في 3 مواضع، اثنان في البقرة 168 و208 وفي الأنعام 142، اثنان في سياق الأكل الحلال الطيب وواحدة في سياق الدخول في الإسلام كافة. ووردت (لا تتبعوا خطوات الشيطان) بدون واو في النور 21.
(إنه لكم عدو مبين) وردت 5مرات: البقرة 168 و208، الأنعام 142، يس 60، الزمر 62
(إن كنتم صادقين) وردت في 28 موضعا في القرآن، اثنان منها في الأنعام 40 و143
(أم كنتم شهداء) مرتان: في البقرة 133 وفي الأنعام 144
(فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) 4مرات، الأنعام 144، الأعراف 37، يونس 17 والكهف 75
(بغير علم) وردت 12 مرة في القرآن، 5 منها في الأنعام: 100، 108، 119، 140، 144
(إن الله لا يهدي القوم الظالمين) وردت 4مرات: المائدة 51، الأنعام 144، القصص 50، الأحقاف 10
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) وردت 3 مرات: في البقرة 173 (وحيدة تأتي بعدها “فلا إثم عليه”) الأنعام 145، النحل 115
(ذلك جزيناهم) مرتان: الأنعام 146 (ببغيهم)، سبأ 17 (بما كفروا)
(القوم المجرمين) 4مرات: الأنعام 147، يونس 13، يوسف 110، الأحقاف 25
(وإنا لصادقون) 4مرات: الأنعام 146، يوسف 82، الحجر 64، النمل 49
(فإن كذبوك) مرتان: آل عمران 184 والأنعام 146
(عن القوم المجرمين) مرتان: الأنعام 147، يوسف 110
#تأملات_وتدبر
افتتح المقطع بامتنان الله تعالى على الناس بما خلقه لهم من الزروع والحرث والأنعام وما أحلّه لهم منها وهو كثير مقابل ما حرّمه عليهم. والإنسان حرّم بعضها بغير علم وما علم أن كل من حرّم ما أحلّه الله فهو كافر لأنه مكذّب بالله وبما حكم به وشرع.
التحريم إنما يثبت بوحي الله عز وجل وبشرعه لا بهوى النفس، سواء ما جاء في القرآن من آيات أو ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
بيان الواجب في ما أُحلّ من الزروع والحرث:
- الأكل من ثمره إذا أثمر
- إيتاء حقه يوم حصاده
- عدم الإسراف
في المقطع أوامر ونواهي:
الأوامر:
- كلوا من ثمره إذا أثمر
- وآتوا حقه يوم حصاده
- كلوا مما رزقكم الله
- نبئوني بعلم
- فقل ربكم ذو رحمة واسعة
النواهي:
- ولا تسرفوا
- ولا تتبعوا خطوات الشيطان
ذكر في المقطع نموذج لمن يتبع خطوات الشيطان فيحلل ويحرّم على هواه ولا يلتزم بأحكام الله عز وجل الذي له وحده الحكم. ومن مخالفات بعض الأقوام في التحليل والتحريم ما يفعله الهندوس من تحريم ذبح البقر وأكل لحمه وما فعله العرب في الجاهلية من تحريم بعض ذكور وبعض إناث الأنعام وهناك طوائف تحرّم لحم الإبل وغيرها.
وفي المقطع بيان لما أحلّه الله عز وجل وحرّمه في القرآن وبيان ما أحلّه وحرّمه في التوراة وقد شدد على الذين هادوا من قوم موسى عقوبة لهم على بغيهم ومخالفتهم لا لضرر فيما حرّمه عليهم.
من جرأة المشركين على شرع الله عز وجل وحكمه في الحلال والحرام أنهم يدّعون أن ما حرّموه هم على أنفسهم إنما هو بأمر الله، وهذا أشد الكذب والافتراء فهل جاءهم وحي مباشر بذلك أنهم لا يؤمنون بنبي الله ولا بآياته؟!
(فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يُردّ بأسه عن القوم المجرمين)
(ذلك جزيناهم ببغيهم) من عدل الله عز وجل حين يذكر في القرآن العقاب يذكر العلّة والسبب سبحانه أن يعاقب أو يُهلك أحد بدون سبب! وهؤلاء الذين يتجرأون على حكم الله تعالى قد بغوا فاستحقوا العذاب.
ذو رحمة واسعة لا يعني ترك المجرمين بلا عقوبة، يمهلهم برحمته لكن إذا أصروا على عنادهم وكفرهم وإعراضهم فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر بسبب إجرامهم. فإذا حقّ عليهم العذاب فإنه لا يمنعه عنهم أحد ولا يردّ حكمه عليهم أحد.
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد
الآيات 148 – 150
حجة الله البالغة وعلمه في مقابل ظنون وأوهام وجهل المشركين وادّعاءاتهم الباطلة.
#للحفاظ
آيات المقطع افتتحت بفعل القول، اثنان منها بصيغة الأمر: قُل) وواحدة بصيغة المضارع (سيقول) وورد (قل) في وسط إحدى آياته
تكرر في المقطع
(قل) 3 مرات (قل هل عندكم – قل فلله الحجة البالغة – قل هلّم شركاءكم) وورد (سيقول الذين أشركوا)
الشرك: (أشركوا – أشركنا)
(شهداءكم – يشهدون – شهدوا – لا تشهد)
(كذلك كذّب – الذين كذّبوا بآياتنا)
(ولا حرّمنا – أن الله حرّم هذا)
إن تتّبعون إلا الظنّ – ولا تتّبع أهواءهم
إن المخففة: إن تتّبعون – إن أنتم إلا تخرصون – فإن شهدوا
اسم الجلالة، 3مرات: ولو شاء الله – قل فلله الحجة – أن الله حرّم هذا/ وورد اسم الربّ مرة واحدة (بربهم يعدلون)
#انفرادات / #متشابه
(إن أنتم إلا تخرصون) بضمير المخاطب وفي باقي المواضع (إن هم إلا يخرصون) بضمير الغائب وردت في الأنعام 116، يونس 66 والزخرف 20
(قل فلله الحجّة البالغة)
(فلو شاء) وفي باقي المواضع (لو شاء) في 5 مواضع أحدها في الأنعام 148 – (ولو شاء) في 16 موضع منها 4 مواضع في الأنعام: 35، 107، 112، 137
#تأملات_وتدبر
فوائد وهدايات من محاضرة ( الوصايا العشر المحكمات ) الشيخ خالد السبت
مقدمة
1- نزلت سورة الأنعام جملة واحدة في مكة .
2- موضوعات السور المكية : تقرير قضية التوحيد والإيمان بالله تعالى ، وانفراد الله بالتشريع، وتقرير الإيمان باليوم الآخر ، وهي القضايا التي يشغب حولها المشركون .
3- جاءت هذه الوصايا العشر في ثنايا هذه السورة ، حينما رد الله عليهم ، وبيّن جهالات هؤلاء في التحريم والتحليل .
4- هذه الوصايا العشر جاءت في ثلاث آيات
5- قيل لها المحكمات ؛ باعتبار أنها أصول يرجع لها غيرها، وهي ام تُنسخ ، ولا يتطرق لها النسخ ، لأن النسخ لا يتطرق للأصول الكبار
6- ذكر أهل العلم أن هذه الوصايا العشر المحكمات هي في شرائع جميع الأنبياء ، ومما اتفق عليه الرسل في شرائعهم
7- جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ” من سره أن يقرأ وصية محمد (رسول الله ﷺ ) التي عليها خاتمه ، فليقرأ هذه الآيات ( قل تعالوا أتلُ ما حرّم عليكم ربكم ) إلى قوله ( لعلكم تتقون )”
الآية الأولى :
﴿قُل تَعالَوا أَتلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيكُم أَلّا تُشرِكوا بِهِ شَيئًا وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا وَلا تَقتُلوا أَولادَكُم مِن إِملاقٍ نَحنُ نَرزُقُكُم وَإِيّاهُم وَلا تَقرَبُوا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وَما بَطَنَ وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَقِّ ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلونَ﴾ [الأنعام: ١٥١]
8- اشتملت أول آية على خمس وصايا
9- {قل تعالوا } :السورة مكية ، فالخطاب لجميع الناس، ويدخل فيهم المشركون
10- {قل تعالوا }
هذا الأمر موجه للنبي ﷺ باعتبار أنه المبلغ عن ربه ، وهذا دليل على أن الرسول ﷺ عبد لله ، يمتثل أمره ، وينقاد له كل الانقياد ، وليس مشرعا من عند نفسه ، بل يوحى إليه
11- في قوله {تعالوا } عدة معان ٍ:
فهو يدعى به من كان بعيدا ، فلما كان هؤلاء في حال من البعد لأنهم على الإشراك ، كأنهم في ناحية بعيدة عن الهدى
12- يؤخذ منها أن الهداية إنما تأتي لمن أقبل عليها ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) ، أي كان له قلب وقاد ، وألقى السمع ، فهو يقصد الاستماع مع حضور القلب، أما الذين يعرضون وينأون بأنفسهم فقد أصم الله أسماعهم ، وأعمى أبصارهم ، وجعل على قلوبهم أكنة وأقفالا ، فلا يصل إليها من الهدى شيء
13- أيضا تدل على الارتفاع والعلو ، فمن يأتي للهدى يصعد ويرتفع ، فإذا كان الإنسان متبعا لهوى نفسه والشيطان ، فإنه ينسفل ، لذلك قال الله تعالى ( قد أفلح من زكاها ) فالزكاء فيه معنى النماء ، ( وقد خاب من دساها ) فالدّسّ والتدسية يدل على هبوط وانخفاض وضعة ، وهكذا تفعل الذنوب والآثام والجرائم والشرك تدسّ صاحبها ، فمن أراد أن يرتقي ويعلو ويسمو ، فإن عليه أن يقبل على هذا الهدى الكامل .
14- {أتلُ } التلاوة هنا بمعنى القراءة ، لأن القارئ يتبع الألفاظ ، وهي في مواضع أخرى تكون بمعنى التلاوة والاتباع { واتلُ ما أوحي إليك من كتاب ربك }
15- لاحظ في هذه الآية ( أتل ما حرم ربكم عليكم ) وفي دعاء إبراهيم عليه السلام ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ) فذكر التلاوة أولا ، لأنها أول درجة ومرحلة وممارسة ، التلاوة التي يحصل بها البلاغ .
16- الوصية تقال لما يكون من الأمر والنهي المؤكد .
17- (أتل ما حرم ربكم ) ينبغي على الإنسان أن يقبل على كتاب الله فيتلوه ، ويكون له ورد في يومه وليلته لا يفرط فيه
18- ينبغي على الدعاة أن يتلوا على الناس كتاب الله تعالى ويبينوا لهم ما حرم عليهم وما شرع
19- تأمل التعبير بقوله ( ربكم ) ذكر اسم الرب في غاية المناسبة ، لأن من معانيه الذي يتصرف بخلقه ، فيأمر وينهى ويشرع ، ويحلل ويحرم . وهم يقرون بالربوبية ، فكان إلزاما لهم بما وراء ذلك من الانقياد لكونه هو المشرع وحده
،المعبود وحده دون سواه
20- التعبير بقوله ( حرم ربكم عليكم ) قال بعض أهل العلم : لما قُصد به الذين يعبثون بالتحريم والتحليل ، ويشركون به غيره ، جاء في هذا السياق ( حرم ربكم ) ، وفي سورة الإسراء كان المقصود أهل الإيمان فجاء التعبير بقوله ( وقضى ربك ) أي حكم ووصى .
هذه الوصايا العشر في سورة الأنعام كلها من قبيل المنهيات ، إلا الوصية الثانية ( وبالوالدين إحسانا ) والأخيرة ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه )
الوصية الاولى :
21- تأمل بداية الوصايا ( ألا تشركوا به شيئا ) : بدأ بقضية التوحيد لأنها أصل الأصول ، وعليها مدار الفلاح ، وكل ما يذكر بعدها فهو متفرع عنها
22- جاء الحديث عن التوحيد بالنهي عن الشرك ، وهذا يستلزم الأمر بضده وهو توحيد الله تعالى ، بينما جاء الأمر بالتوحيد في وصايا سورة الإسراء صريحا ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )
23- {ألا تشركوا به شيئا } شيئا : نكرة في سياق النهي ، تدل على العموم ، أي لا تشركوا به شركا قليلا أو كثيرا ، ويدخل فيه كل أنواع الشرك : الأكبر والأصغر والخفي ، وشرك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات
24- إذا كان التوحيد من أهم المهمات وأول المطالب وأول دعوة الرسل ، فينبغي أن يكون هو الأول فيما يوجه للناس ، وما يُدعون إليه
الوصية الثانية :
25- {وبالوالدين إحسانا }
لم يقل لا تعقوا الوالدين ، كما في الوصايا ، فجاء بصيغة الأمر لا النهي ، وهذا له دلالة والله أعلم لأنه وضع في موضع الأمر للمبالغة ، وللدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما لا يكفي ، بل لابد من كف الأذى بأنواعه وإن قلّ، مع البر والحفظ وامتثال الأمر
{إحسانا } عبر بالمصدر وأطلقه ، فلم يقل إحسانا بالقول أو الفعل أو المال ، ليشمل كل أنواع الإحسان . فيدل على كمال الإحسان وأنه إحسان عظيم .
26- الأمر بالإحسان للوالدين يستلزم ترك الإساءة لهما ، فصار ذلك بدلالة اللزوم
جاء الأمر بالإحسان للوالدين بعد التوحيد ، وهذا يتكرر في القرآن ، فالله هو الذي أوجدنا من عدم ، والوالدان هما سبب الوجود في هذه الحياة ، وهذا الحق متقرر ثابت وإن كان الأبوان غاية التقصير
27- {وبالوالدين إحسانا } عداه بحرف الباء ، وقد يعدّى بإلى ، والتعدية بالباء أبلغ ، وكأن ذلك الإحسان قد تغلغل في نفسه ، وكان أعمق وألصق ، فلم يكتف أن يوصل الإحسان إليهما .
الوصية الثالثة :
{ولا تقتلوا أولادكم من إملاق }
28- لما ذكر ﷻ حق الله ثم حق الوالدين ، ذكر حق الأقرب إلى الإنسان وهم أولاده
29- هذا النهي يفيد التحريم ، وجاء بعده فعل مضارع ، فهذا التركيب يفيد العموم ، أي لا يحل قتلهم بحال من الأحوال
30- الأولاد لفظ يشمل الذكور والإناث ، والمعروف أن العرب كانوا يقتلون الإناث
31- ذكر علة القتل { من إملاق } ، وهو الفقر ، يقال :أملق أي افتقر ، كأنه لم يبقَ معه إلا الملقات وهي الصخور والحجارة الملساء التي ليس فيها شيء
32- الله تعالى ذكر العلة وهي الفقر ، والمعروف أن العرب كانوا يقتلون بناتهم خشية العار ، فهل هناك منافاة ؟
الجواب لا ، لأنهم كانوا يقتلون بناتهم خشية أن تفتقر فتضطر بسبب الفقر أن تبيع عرضها ، وتواقع الفاحشة، وهي غيرة جاهلية مذمومة
33- لما كان سبب القتل { من إملاق } أي فقر واقع ، قدم الله ﷻ رزق الآباء { نحن نرزقكم وإياهم } وفي سورة الإسراء لما كان الفقر متوقعا { خشية إملاق } إذا كثر الأولاد ، قدم رزق الأولاد { نحن نرزقهم وإياكم }
وقد أخذ منه بعض أهل العلم أن الأبناء يكونون سببا للرزق
34- لما كان الخطاب في الآية للجميع ، ويدخل فيه الكفار ، دل ذلك على أن رزق الله لا يخلو منه أحد ، فالكفار تنالهم أرزاق الله عز وجل {وما بكم من نعمة فمن الله }
35- ذكر قتل الأولاد على وجه الخصوص لانه من أشنع الذنوب
36- في {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق } ، بمفهوم المخالفة : هل يقال إذا كان قتلهم من غير إملاق فإن ذلك سائغ ؟ الجواب : لا
فهذا من المواضع التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة ، فإن الآيات إذا نزلت على وفاق واقع معين ، فإن مفهوم المخالفة لا يكون حجة
مثل ذلك { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا } فلا يجوز إكراههن إن كن يردن البغاء
الوصية الرابعة
{ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن }
37- الفواحش جمع فاحشة وهي الذنب العظيم ، وما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي
38- قيل الفواحش : الزنا
ما ظهر منها : الإعلان به ، وما بطن : الإسرار
وقيل
ما ظهر : الخمر ونكاح المحرمات ، وما بطن : الزنا
وقيل
ما ظهر : الخمر وما بطن : الزنا
وقيل عام في الفواحش المعلنة وما كان سرا
وقيل : ما ظهر من أفعال الجوارح ، وما بطن : من أفعال القلوب
وقيل : ما ظهر : البغاء ، وما بطن : اتخاذ الخلان
39- {ولا تقربوا } النهي للتحريم ، وهذا التركيب مع لا الناهية يفيد العموم ، والعموم يتوجه لأربعة أمور : عموم الأفراد، وعموم الأحوال ، وعموم الأمكنة ، وعموم الأزمنة
40- {ولا تقربوا } لم يقل : لا تأتوا أو تمارسوا ، فالنهي عن القربان يدل على المباعدة ، فهو نهي عن كل ذريعة توصل إليه
فما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وتركه واجب
41- قوله { ما ظهر منها } قد يحترز الإنسان من مقارفة الفواحش الظاهرة ، إما خوفا من الناس أو حياء منهم ، أو من أجل سمعة الأسرة والعائلة، أو خوفا على منصب ، ونحو ذلك ، لكنه يفعله سرا ، فهنا تربية إيمانية عميقة
42- {وما بطن } فيه دعوة لتطهير الباطن من كل الآفات ، كالرياء والسمعة ، وحب الظهور والشهرة ، والتوكل على غير الله ، وسوء الظن بالله
كل الأشياء المذكورة في الآية هي من الموبقات
الوصية الخامسة :
{ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق }
43- هذا أيضا نهي يدل على التحريم ، والتركيب يدل على العموم ، فلا يحل قتل نفس أي نفس ، على أي حال ، في أي زمان ، وأي مكان ، إلا ما استثناه الله ﷻ
قتل النفس داخل في عموم الفواحش ، فهو من الذنوب العظام ، وإنما خص لشناعته وشدته
44- {إلا بالحق } فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة
45- ملاحظة : المنهيات التي تميل لها النفس وتدخل فيها الأهواء والشهوات ، يأتي النهي عنها بتعبير { ولا تقربوا }
أما غيرها فالنهي فيه مباشرة { ولا تقتلوا }
46- {ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون } أي يكون سببا للعقل ، فمن خالف ذلك فهو سفيه
47- قاعدة : الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ، فدل ذلك على أن من راعى حدود الله عز وجل ، فهذا أتم وأكمل في عقله ، وبحسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله عز وجل ومراعاة حدوده
48- كلمة (لعل) في القرآن هي للتعليل ، إلا في موضع واحد { وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون } أي كأنكم تخلدون
الآية الثانية
﴿وَلا تَقرَبوا مالَ اليَتيمِ إِلّا بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ حَتّى يَبلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوفُوا الكَيلَ وَالميزانَ بِالقِسطِ لا نُكَلِّفُ نَفسًا إِلّا وُسعَها وَإِذا قُلتُم فَاعدِلوا وَلَو كانَ ذا قُربى وَبِعَهدِ اللَّهِ أَوفوا ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ﴾ [الأنعام: ١٥٢]
الوصية السادسة
{ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }
49- هذا نهي للتحريم ،، ولا الناهية مع الفعل المضارع تتوجه للعموم : عموم الأفراد والأحوال والأمكنة والأزمنة
50- {ولا تقربوا } جاء النهي بعدم القربان ، لأن ما فيه طمع جاء النهي عن قربانه ، فإذا كان النهي عن مجرد القربان فهو أبلغ ، وهذا يدل على رعاية وعناية الشارع بالضعفاء ، وسعة رحمته ، فلا يكون اليتامى عرضة لذوي النفوس الدنيئة
51- {إلا بالتي هي أحسن } مقال ” إلا بالحسن ” ليشمل ذلك الناحيتين الدنيوية والشرعية ، فما كان فيه تثمير للمال مع محرم أو شبهة فإنه يترك ويلجأ للحلال
52- في الآية دلالة على عناية الشارع باليتيم ، ومن ثمّ فإنه لا يلي مال اليتيم من كان ضعيفا سواء كان الضعف في العقل والتفكير ، أو كان الضعف في القدرات باعتلاله ومرضه ، أو ضعف في الوازع الديني
الوصية السابعة
{وأوفوا الكيل والميزان بالقسط}
53- الوفاء بمعنى التكميل ، وقد يدل على معنى الزيادة ، وهذا يدل على النهي عن ضده ، وهو النقص
54- المكاييل والموازين هي التي يكون بها قوام حياة الناس ومعايشهم ، فإذا حدث التطفيف فإن ذلك ترتفع معه الثقة في التعاملات ، ويكون سببا لتعريض مصالح الناس للضياع والبخس ، ويؤثر في مروءات الناس
55- {لا نكلف نفسا إلا وسعها}
هذه الشريعة ليس فيها تكليف بما لا يطاق ، فالله دفع عن هذه الأمة الآصار والأغلال ، وهذا يدل على سعة الشريعة ورحمة الله بالخلق ، وأنه كلفهم بما يطيقون ، فينبغي للعبد أن يبادر بالقيام بشرائع الدين ، وألا يستثقل ذلك ، فقد كلفه الله أمورا تدخل في وسعه ، وما كان خارجا عن وسعه فهو معفوّ عنه
الوصية الثامنة
{وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى }
56- هذا الأمر للوجوب ، وليس من التفضل والإحسان للناس
57- إذا ذكر الله العدل في الأقوال ، كان العدل في الأفعال والمزاولات من باب أولى
58- {ولو كان ذا قربى } لو يقال عنها وصليّة ، تفيد المبالغة في الحال التي من شأنها أن يظن السامع عدم شمول الحكم إياها ، لاختصاصها من بين الأحوال
الوصية التاسعة
{وبعهد الله أوفوا }
59- أي بوصية الله التي أوصاكم بها ، وهي أن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه ، وأن يعملوا بكتابه ،، وسنة رسوله
60- هذا الوفاء بالعهد يشمل جميع ما عهده الله لعباده ، ويدخل فيه ما يقع بين الناس من عهود فهم مأمورون بحفظها ،وكذلك ما أوجبه الإنسان على نفسه من النذور
الآية الثالثة
﴿وَأَنَّ هذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّبِعوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبيلِهِ ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقونَ﴾
[الأنعام: ١٥٣]
الوصية العاشرة
61- صفة المستقيم للصراط هي صفة كاشفة وليست مقيدة ، لأن الصراط في اللغة لا يقال إلا لما كان مستقيما
62- أضاف الله ﷻ الصراط إلى نفسه ( صراطي ) لأنه هو الذي رسمها وشرّعها
المستقيم : هو القويم الذي لا اعوجاج فيه ، وهو دين الإسلام واتباع الكتاب والسنة
63- { وأن هذا صراطي } فهو صراط واحد ، فالطريق الموصل لله واحد ، وهي التي شرعها ، فلا يجوز للإنسان أن يبتدع لنفسه طريقا يعبد الله بها ، أما السبل فجاءت مجموعة
64- {فاتبعوه} هذا الأمر للوجوب ، فلا نجاة لهم بغيره
65- {ولا تتبعوا السبل } هذا النهي للتحريم ، فيدخل فيه الأديان والملل غير الإسلام
66- {فتفرق بكم } التعبير بالفاء يدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وعلى التعقيب المباشر ، وعلى التعليل ، فمن شأن اتباع هذه السبل أن تؤدي بمتبعها إلى التفرق عن سبيل الله ، والنأي عنه والانحراف والضلال
67- {لعلكم تتقون } أي من أجل أن تتقوا ، وإذا فسرت بالترجي فيكون ذلك بمعنى ” من فعل ذلك وبذل جهدا لعله يكون من المتقين ” ، فكيف لمن لم يرفع به رأسا أن يرجو أن يكون متقيا
ما سبب ختم الوصايا العشر المحكمات في سورة الأنعام بقوله { لعلكم تعقلون } ( لعلكم تذكرون ) { لعلكم تتقون } ؟
68- {لعلكم تتقون } علل بعض أهل العلم هذا الختم لأن الحديث عن الصراط المستقيم ، فيشمل الشريعة كاملة ( الأوامر والنواهي ) ، فإذا اتبعها السالك صار متقيا
69- وقيل :
الآية الأولى اشتملت على أمور عظيمة ، والوصية فيها أبلغ من غيرها ، فختم بأشرف ما في الإنسان وهو عقله { لعلكم تعقلون } ، والآية الثانية اشتملت على أربع وصايا يقبح ارتكابها ، والوصية بها تجري مجرى الوعظ والزجر ، فختمها بـ {لعلكم تذكرون } ، والآية الثالثة عن الصراط المستقيم واتباعه وترك ما يخالفه ، فختمت بالتقوى التي هي ملاك العمل وخير الزاد
70- وقيل : الآية الأولى اشتملت على خمس أمور ظاهرة يدركها العقل ، ويدرك قبحها ، ويدل عليها النقل ، فختمت بقوله ( لعلكم تعقلون ) ، أما القضايا الأربعة في الآية الثانية فهي قضايا غامضة ، لا بد لها من الاجتهاد والفكر ، حتى يقف المرء على موضع الاعتدال فيها ، فهي تؤثر في الأهواء والشهوات والغرائز ، وهذه تعمي وتصمّ ، فاتبعت بترجي التذكر ، لأن من تذكر أبصر ، فعقل وامتنع
ولما كانت هذه الوصايا العشر مما اتفقت عليه الشرائع ، ولم تنسخ في ملة من الملل ، وأن من أخذ بها كان سالكا للصراط المستقيم ، عقّب ذلك بقوله ( لعلكم تتقون )
71- وأسهل من ذلك وأوضح أن يكون ذلك على سبيل التدرج ، فالإنسان يعقل أولا عن الله ، ثم يحصل له التذكر ، فإذا حصل له التذكر اتقى الله في نفسه ، فجاءت متدرجة حسب الوقوع
72- كل الآيات ختمت بتكرار {ذلكم وصاكم به } تأكيدا للوصية ، وتجديدا للعهد
(منقول من موقع مثاني القرآن)
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد
الآيات 150- 154
آيات الوصايا العشر
#للحفاظ
#انفرادات و #متشابه
(ولا تقربوا الفواحش) وفي باقي المواضع: (ولا تقربوا مال اليتيم) في موضعين: الأنعام 152 والإسراء 34 (ولا تقربوا الزنا) موضع واحد في الإسراء 33
(ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وفي الأعراف 33 (قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن)
(ولا تتّبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا) وفي باقي المواضع: (ولا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون) في الجاثية 18 / (ولا تتبع أهواءهم) في المائدة 48، 49 وفي الشورى 15
(تعالوا أتلُ) وفي باقي المواضع: (تعالوا إلى) / (تعالوا ندعُ) / (تعالوا قاتلوا) / (تعالوا يستغفر لكم)
(من إملاق) وفي غيرها (خشية إملاق) في الإسراء 31
(ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق) في موضعين: الأنعام 151 والإسراء 33
(ذلكم وصّاكم به) انفردت بها سورة الأنعام في 3 آيات متتالية: 151، 152، 153
(وإذا قلتم فاعدلوا) انفردت بها سورة الأنعام
(ولو كان ذا قربى) وردت في 3 مواضع: المائدة 106، الأنعام 152، فاطر 18
(وبعهد الله أوفوا) انفردت آية سورة الأنعام بتقديم (بعهد الله) على الفعل (أوفوا) وفي النحل 91 (وأوفوا بعهد الله)
(وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) منفردة في الأنعام وفي الأعراف 85 (وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم) وفي هود 85 (أوفوا المكيال والميزان بالقسط) سبقها (ولا تنقصوا المكيال والميزان)
(لا نكلف نفسا إلا وسعها) في 3 مواضع: الأنعام 152، الأعراف 42، المؤمنون 62
(هذا صراطي مستقيما) انفردت بها آية سورة الأنعام بإضافة الصراط إلى ضمير المتكلم (صراطي) وفي الأنعام 126 (وهذا صراط ربك مستقيما)
(فتفرّق بكم عن سبيله) وفي باقي المواضع (يضلّ عن سبيله، ليُضلوا، ضلّ، ليُضِلّ، فصدّوا عن سبيله) ووردت (عن سبيله) في 8 مواضع في القرآن: الأنعام 117، 153، التوبة 9، إبراهيم 30، النحل 12، الزمر 8، النجم 30، القمر 7
(إلا بالتي هي أحسن) 3 مواضع: الأنعام 152، الإسراء 34، العنكبوت 46
(حتى يبلغ أشده) موضعان: الأنعام 152 والإسراء 34
#تأملات_وتدبر
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد
الآيات 154 – 159
#للحفاظ
تكرر في المقطع:
الكتاب (ثم آتينا موسى الكتاب – وهذا كتاب أنزلناه – إنما أُنزل الكتاب – لو أنا أنزل علينا الكتاب)
(أن تقولوا – أو تقولوا – قل انتظروا )
(وهدى ورحمة) تكررت مرتان
هدى: (هدى ورحمة – لكنا أهدى منهم – هدى ورحمة)
صدف: (وصدف عنها – الذين يصدفون – بما كانوا يصدفون)
كنا وكانوا: (وإن كنا عن دراستهم لغافلين – لكنّا أهدى منهم – بما كانوا يصدفون – وكانوا شيعا – بما كانوا يفعلون)
(تأتيهم الملائكة – يأتي ربك – يأتي بعض آيات ربك (مرتان))
(هل ينظرون – فانتظروا – إنا منتظرون)
(لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون – لا ينفع نفسا إيمانها – لم تكن آمنت من قبل – أو كسبت في إيمانها خيرا)
(بلقاء ربهم – بينة من ربكم – يأتي ربك – بعض آيات ربك (مرتان))
#انفرادات و #متشابه
(ثم آتينا موسى الكتاب) في الأنعام وفي غيرها (وإذ آتينا/ ولقد آتينا / وآتينا موسى الكتاب) ولعل هذا لكثرة ورود (ثم) في سورة الأنعام وردت 18 مرة
(واتقوا الله لعلكم ترحمون) في الأنعام وفي غيرها (واتقوا يوما/ واتقوا الله/ واتقوا النار/ واتقوه/واتقوا فتنة/ واتقوا الذي)
(جاءكم بينة من ربكم) بتذكير الفعل “جاءكم” في الأنعام وفي غيرها (جاءتكم بينة من ربكم) بالتأنيث
(هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك) في الأنعام وفي غيرها (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك) في النحل 33
(هل ينظرون إلا) وردت في 7 مواضع في القرآن: 5مرات (البقرة 210، الأنعام 158، الأعراف 53، النحل 33، الزخرف 66) بداية آية وبصيغة (فهل ينظرون إلا) مرتان: مرة بداية آية في سورة محمد 18 ومرة وسط آية فاطر 43
(قل انتظروا) في الأنعام وفي غيرها (فانتظروا / وانتظروا) وهذا يتناسب مع تكرر (قل) في السورة
(بما كانوا يفعلون) وردت مرتان: الأنعام 159 وهود 36 (فلا تبتئس بما كانوا يفعلون)
(إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا) في الأنعام وفي غيرها (من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) الروم 32
(إنما أمرهم إلى الله) لم ترد في غير سورة الأنعام
#تأملات_وتدبر
بعد أن أثنى الله تعالى على القرآن (وهذا كتاب مبارك أنزلناه) وأمر باتباعه وتقوى الله (فاتبعوه واتقوا لعلكم تُرحمون) ناسب أن يثني على التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام فكل الكتب من عند الله عز وجل والرسل هو الذي اصطفاهم وأرسلهم للأمم والرسل وتبلّغ رسالة الله عز وجل للخلق وهي رسالة مفادها: توحيد الله وعبادته. فكما أن القرآن مبارك فإن التوراة هدى ورحمة وفيها تفصيل كل شيء.
(لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون) الكتب المنزلة من الله عز وجل تدعو الخلق للإيمان بالآخرة فهي الدار الباقية ودار الجزاء على ما قدموا في الدار الفانية.
أثبتت الآيات الحجة على مشركي العرب فإنهم قد يعترضوا أنهم ليسوا أهل كتاب وأنهم لا علم لهم بالتوراة التي أنزلت على موسى فهم أميّون وبنو إسرائيل كانوا أهل كتاب، أو أنهم سيقولون لو أُنزل علينا كتاب لكنا أهدى من بني إسرائيل! ولكنهم في الحالين مدّعون لا حقيقة لكلامهم، فهم أهل الفصاحة والبلاغة وقد أُنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الكلام ولم يحتاجوا للإيمان به أن يتعلموا علوما لا يعرفونها، فهم ليسوا أميين في فهم اللغة العربية وفصاحتها وحسن بيانها بدليل أنهم لم يسألوا عن معنى كلمة واحدة في القرآن أشكلت عليهم! لكن الإنسان هو الإنسان إن كان مستكبرا عن قبول الحق معاندا لأجل العناد فقط فإن حججه كلها واهية! هؤلاء يظلمون أنفسهم أشد الظلم لإعراضهم عن آيات الله!
فماذا ينتظر هؤلاء ليؤمنوا؟ أن يروا بأعينهم علامات القيامة؟! ألا يعلمون أنه لن ينفعهم إيمانهم وقتئذ؟!
إن سلوك سبيل الله هو الهدى وهو الموصل للفوز في الدنيا وفي الآخرة أما سلوك أي سبيل غيره فإن عاقبته في الدنيا تفرّق وتشرذم واختلاف وفي الآخرة عذاب.
وسيأتي في المقطع التالي نموذج لمن اتبع الصراط المستقيم وهو إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أُمر باتّباعه.
فوائد من كتاب التفسير البلاغي للاستفهام – د. عبد العظيم المطعني:
(قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة) تنكير بينة وهدى ورحمة للتعظيم.
وتقديم بينة على هدى ورحمة لأنها الأصل فيهما
وتأخير رحمة على هدى لأنها من ثماره
وإضافتها إلى ربكم للترغيب والتفخيم
وإضافة (رب) إلى ضمير المخاطبين للتلطف في الخطاب واستمالة مشاعر المخاطَبين.
(وصدف عنها) هطف هذا الفعل (صدف) على (كذّب) للتشنيع والتغليظ لأن الجمع بين التكذيب بآيات الله والإعراض عنها من أقبح الآثام أو هو أقبحها.
(سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا..) إيثار المضارع والاستغناء به (يصدفون) عن التكذيب “يكذّبون” لأن الإعراض عن آيات الله يستلزم التكذيب بها ولاستحضار صورة الإعراض في الذهن لأنه ديدنهم.
(هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك)
استعملت (هل) بدل الهمزة في الإنكار لتحقيق ما بعدها من صور الترقّب والانتظار.
وإيثار التعبير بالفعل (ينظرون) على “ينتظرون” وهو المراد لتشبيه انتظارهم المعنوي لوقوع ما هُدّدوا به بالنظر الحسّي للإيذان بأن ما هُدّدوا به واقع لا محالة وكأنهم ينظرون إليه بالعين الباصرة قبل وقوعه.
(أو يأتيَ ربك) إسناد الإتيان إلى (ربك) مجازٌ عن عذابه وسرّه البلاغي: التهويل والتفظيع من شأن المنذَر به.
#يتدارسونه
#سورة_الأنعام
الورد الأخير
الآيات 160 – 165
ختام السورة تلخيص لموضوعاتها: إثبات الألوهية والرسالة ودحض دعاوى المشركين.
واشتمل المقطع على عدد من آيات التوحيد ففيه:
(ملة إبراهيم حنيفا) (وما كان من المشركين) (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له) (قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء) (ثم إلى ربكم مرجعكم)
#للحفاظ
في المقطع 3 آيات افتتحت بـ(قل): (قل إنني هداني ربي – قل إن صلاتي ونسكي – قل أغير الله أبغي ربا)
(من جاء بالحسنة – ومن جاء بالسيئة)
(أمثالها – مثلها)
(ربي – رب العالمين – أبغي ربّا – وهو رب كل شيء – إلى ربكم مرجعكم – إن ربك سريع العقاب)
(إنّني هداني ربي – قل إنّ صلاتي – إنّ ربك – وإنّه لغفور رحيم)
ضمير المخاطب: (ربكم – مرجعكم – فينبئكم – بما كنتم – جعلكم – رفع بعضكم – ليبلوكم – في ما آتاكم “كلها بالجمع” – إن ربّك “بالمفرد”)
#انفرادات و #متشابه
(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وفي غيرها (من جاء بالحسنة فله خير منها) في النمل 89 والقصص 84
(قل إنني هداني ربي) لم ترد إلا في الأنعام وفي غيرها (وهداه إلى صراط مستقيم) في النحل 121
(رب كل شيء) لم ترد إلا في الأنعام
(لا شريك له) لم ترد إلا في الأنعام
(وبذلك أُمرت) لم ترد إلا في الأنعام وورد فيها (قل إني أُمرت أن أكون أول من أسلم) وفي غيرها (وأُمرت أن أكون من المسلمين) في يونس 72 (وأُمرت أن أكون من المؤمنين) في يونس 104، (إنما أُمرت أن أعبد الله) في الرعد 36، (إنما أُمرت أن أعبد رب هذه البلدة) في النمل 91، (قل إني أُمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) في الزمر 11 (وأُمرت أن أكون من المسلمين) الزمر 12، (وأُمرت أن أُسلم لرب العالمين) غافر 66، (فاستقم كما أُمرت) الشورى 15.
(خلائف الأرض) في الأنعام وفي غيرها (خلائف في الأرض) في يونس 14 و 73 وفاطر 39
(سريع العقاب) في الأنعام بدون اللام وفي الأعراف 167 بإثبات اللام (لسريع العقاب)
(قل أغير الله) في الأنعام 14 و 164 كلاهما بداية آية. وورد في الأنعام 40 (أغير الله) وورد في الأنعام 114 (أفغير الله أبتغي حكما) وورد فيها (من إله غير الله) 46، (أو فسقا أُهلّ لغير الله به) 145
(غير الله) وردت هذه الصيغة في القرآن 17 منها، 6 منها في الأنعام وحدها وهي مناسبة تماما لما في السورة من حديث عن التوحيد ونبذ الشرك.
(ليبلوكم في ما آتاكم) وردت مرتان: في المائدة 48 والأنعام 165
(وإنه لغفور رحيم) وردت مرتان: في الأنعام 165 وفي الأعراف 167
(غفور رحيم) ختمت بها 3 آيات في سورة الأنعام: (فأنه غفور رحيم) 54، (فإن ربك غفور رحيم) 145، (وإنه لغفور رحيم) 165
#تأملات_وتدبر
تختم السورة بخاتمة بديعة رائعة في رسالة واضحة بيّنة وضوح البراهين والأدلة التي جاءت بها آيات السورة منذ بدايتها:
الرسالة: “التوحيد عقيدةٌ يتبعها عمل”
في المقطع:
ملخص قانون الجزاء الإلهي القائم على فضل الله وإحسانه: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يُظلمون) العدل يقتضي أن تكون الحسنة بمثلها لكن الإحسان والفضل يجعلها عشر أمثالها وقد تزيد عن ذلك إلى سبعمائة أو أكثر.
التوحيد العقدي: (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين)
التوحيد العملي: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)
إقامة الحجة على من يعيش في أنعام الله وفضله ثم يبتغي رب غيره (قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء) وفي الآية توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية.
كمال العدل الإلهي: المسؤولية فردية (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)
إثبات البعث والحساب والفصل بين الناس (ثم إلى ربكم مرجعكم فينبكم بما كنتم فيه تختلفون)
سنّة من سنن الله عز وجل (ورفع بعضكم فوق بعض درجات) فيها الإيمان بالقضاء والقدر وأن الاختلاف بين الخلق اختلاف تكامل لا اختلاف تنافر ونقص، ولا عمارة للأرض إلا بهذا الاختلاف ورفع البعض فوق البعض الآخر وجعل البعض للبعض سخريا.
مهمة البشر في الأرض (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) (ليبلوكم في ما آتاكم) من عهد الاستخلاف إلى الجزاء والحساب: ابتلاء واختبار.
ختام السورة بالترهيب والترغيب (إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم) والتوكيد في الترغيب أكثر منه في الترهيب، إن ربك سريع العقاب لمن أعرض عن آياته وكفر بها وغفور رحيم لمن آمن به ووحّده واتقاه واتّبع الكتاب الذي أنزله وسلك صراط الأنبياء القدوة المستقيم وقام بشكر أنعام الله وإنعامه. والتوكيد في الترغيب (وإنّه لغفور رحيم) يناسب تكرار الرحمة في السورة.
(إن ربك سريع العقاب) تناسب ما في السورة (إن ما توعدون لآتٍ) وكل ما هو آتِ قريب.
افتتحت السورة بالحمد لله واختتمت باسم الله رحيم والرحمة تشع من آيات السورة (قل لله كتب على نفسه الرحمة) (كتب ربكم على نفسه الرحمة) (وربك الغني ذو الرحمة)
(قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين)
إبراهيم عليه السلام هو ذلك الفتى الذي حطّم الأصنام التي كان يعبدها قومه هو الذي رفع قواعد البيت الذي يتجه إليه المسلمون في صلاتهم أينما كانوا، هو الذي دعا ربه بعد فراغه من رفع قواعد البيت (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) فاستجاب الله تعالى دعاءه وبعث رسوله الخاتم على ملة أبيه إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين (قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين) هذا هو الصراط المستقيم الذي هداه ربه تعالى إليه، (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه)
افتتحت السورة (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذي كفروا بربهم يعدلون) إشارة إلى جعل الكفار لله ندّا
وختمت (أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء) إنكار شديد لمن يجعل لله ندّا، كيف يمكن لمخلوق أن يعدل عن الإيمان بربه ودلائل توحيده تملأ السموات والأرض؟!
(ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) “ثم” تحمل في طياتها عمر الإنسان على الأرض مهما طال فإنه سيرجع إلى ربه لا محالة.
والفاء في (فينبئكم) بعد الرجوع مباشرة يكون الحساب للخلق جميعا.
(قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء) افتتاح هذه الآية بفعل الأمر (قُل) إشارة إلى أهمية المقول وضرورة تبليغه فهو رسالة من رب العالمين إلى الخلق عبر نبيه صلى الله عليه وسلم.
سورة الأنعام حُقّ لها أن تفتتح بالحمد لله كيف لا وهي السورة التي سفّهت الكفر بالله وسفّهت صنيع أهله وفضحت كل مظاهره من خلال بيان أدلة التوحيد الباهرة وبراهينه الساطعة في خلق الله تعالى وفي أحكامه وتشريعاته وفيما أحلّ وفيما حرّم وفي كتابه الذين أنزله وفي أنبيائه الذين أرسل وفي صراطه المستقيم الذي أوضح وبيّن، فحريٌ بمن عرف الله عز وجل من خلال آيات سورة الأنعام أن يؤمن به ويتقيه ويوحّده ولا يعدل به أحدا ولا يُشرك في حكمه شيئا ولا يتعدّى أحكامه ولا يتجرأ على الإتيان بأحكام من عنده تبعا لهواه!
فالحمد لله على نعمة أن الله عز وجل هو رب العالمين
والحمد لله على نعمة التوحيد والإيمان بالله إلها وربًا وخالقا
والحمد لله على نعمة إرسال الأنبياء ونعمة إنزال الكتب وإنزال القرآن
والحمد لله على نعمه على البشرية كلها: نعمه المادية ونعمة المعنوية
والحمد لله على نعمة يوم القيامة ونعمة عدله وفضله وإحسانه
والحمد لله على نعمة الهداية إلى صراطه المستقيم على خطى أنبيائه ورسله
والحمد لله على إنعامه وأنعامه فهو المتفضل ابتداء بالخلق والتدبير والمتفضل انتهاء بالحساب والجزاء والمتفضل بالعفو والمغفرة والرحمة.
هذا والله أعلم
سمر الأرناؤوط
قناة إسلاميات
تمت الاستعانة بفضل الله تعالى بالمصادر التالية:
الأساس في التفسير – سعيد حوى، المجلد الثاني، تفسير سورة الأنعام
تفسير سورة الأنعام، أ. د. طه جابر العلواني رحمه الله
التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم، د. عبد العظيم المطعني
نسق السورة وموضوعها باختصار
إبراز رائق رقراق لبديع صنع الله وثناء عليه بأسمائه وصفاته يورث في القلب تعظيما ومهابة
ثم هجوم كاسح على هؤلاء الذين انتكست فطرتهم وعميت أبصارهم وطمست بصائرهم حين قابلوا كل هذا الجلال بالكفر والنكران
ونجد آية محورية في السورة تبين هذا المعنى بجلاء (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ( 104))
ونلاحظ أن أسلوب الهجوم في هذه السورة على الكافرين الجاحدين أشد من كثير من السور الأخرى التي تكلم الله فيها عن هذه القضية وذلك لبشاعة الجرم عند مقارنته بوضوح الآيات الكونية وإبهارها فنجد الأسلوب في الشق الهجومي يتميز بخصائص منها :
- أسلوب الاستفهام الاستنكاري ومثاله ” أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى “
- أسلوب اللوم والعتاب ومثاله ” فلولا إذ جاهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم
- أسلوب التهديد والوعيد ” فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ” “وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ “
- أسلوب التسفيه والتقليل من شأن هؤلاء الكفرة المجرمين “فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ”
- أسلوب قطع الطمع عن هؤلاء المغرضين “بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ”
والمرتان الوحيدتان بين دفتي المصحف اللتان ذكر فيهما صفة القاهر فوق عباده في هذه السورة العظيمة
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِير
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ
فالسورة بكل ما فيها من إثبات لعظمة الله وجلال شأنه تقهر أي قلب سليم وتجعله يسلم بالعبودية للأعز الأكرم جل وعلا وتقهر كذلك المعاندين الجاحدين بالهجوم الكاسح الذي لا هوادة فيه على من استهان بمقام الله سبحانه وتعالى، وفيها الآية الجامعة التي تبين مقصدا من أهم مقاصد الشريعة يظهر في السورة بجلاء (وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ )
#رمضان_١٤٤٢
#وقفات_تدبرية
#الجزء_١٩
في سورة النور وعد من الله تعالى للمؤمنين الذين يطيعون الله عزوجل ويطيعون رسوله بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون (51) ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون (52) وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون (53) قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين (54) وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (55) النور)
والاستخلاف والتمكين يحتاجان إلى منهج بيّن واضح وإلى دعاة يبلّغونه بإخلاص وأمانة وإلى مقومات ووسائل للدعوة، فجاءت مجموعة من السور المكية عددها ٨ بدءا من سورة الفرقان إلى سورة السجدة تضع القواعد للاستخلاف والتمكين.
ضيف البرنامج في حلقته رقم (118) يوم الجمعة 24 رمضان 1431هـ هو فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن صالح الحميد، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم .
وموضوع الحلقة هو :
– علوم سورة النور .
– الإجابة عن أسئلة المشاهدين حول الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم .
————————-
سورة النور
إسم السورة ووقت نزولها
د. حسن: سورة النور هي من السور المدنية وهي سورة تطاول نزولها بحيث تكاد تكون اشتملت الفترة المدنية كلها فنزلت فيها آيات في أول العهد المدني ونزلت فيها آيات في آخر العهد المدني بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في السنة التاسعة وما بين ذلك وهي سورة مدنية بلا خلاف وبلا استثناء وإسمها سورة النور ويكاد يكون هذا الإسم هو الإسم الوحيد لهذه السورة وربما كان هذا الإسم اللامع العظيم سورة النور المأخوذ من قوله تعالى (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (35)) كان حقيقًا أن يكون إسمًا وحيدًا لهذه السورة.
د. عبد الرحمن: وما اشتملت عليه كله يؤيد هذا للتسمية. أشرت إلى تسميتها أنها وحيدة وهذا يدل على أنه إسم توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم وأشرت أنها نزلت في المدينة. نأتي إلى الموضوع الثالث وهو محور السورة، موضوعها الأساسي عن ماذا تتحدث؟
محور السورة
د. حسن: سورة النور تكاد تجسد حقيقة السور المدنية بالمعنى الاجتماعي للمجتمع المسلم فهذه السورة تكاد تمتاز بأنها سورة العلاقات الاجتماعية أو كما قال القرطبي رحمه الله هي سورة سيقت لبيان أحكام العفاف والستر وهذه الأحكام أحكام العفاف والستر بكل تفاصيلها بدءًا بالحديث عن الزنا والقذف وما تلا ذلك من الاستئذان بأحكامه وتفصيلاته والحديث عن التزويج والحديث عن المنافقين والحديث عن الاستئذان مرة أخرى بصيغة أخرى والأكل والمعاشرة وغض البصر هي وحدة موضوعية قوية جدًا حتى بالمعنى العصري الدقيق للموحدة الموضوعية للقضايا. وفيها قضية توسطت السورة تقريبًا وهي الحديث عن نور الله عز وجل الذي ملأ السموات والأرض نوره في ذاته ونوره في دينه وشرعه وهديه وكيف وقف الناس منه مواقف ذكرها الله بصورة عجيبة تبين أن الأمر كما قال سبحانه (يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء (35))
د. عبد الرحمن: قرأت أن عمر رضي الله عنه كان يحث على تعليم هذه السورة للنساء خاصة ما دلالة هذا؟
د. حسن: عمر رضي الله عنه كان فقيها كان يكتب إلى المسلمين في الكوفة وغيرها أن علّموا أو حفّظوا نساءكم سورة النور وفي لفظ آخر أشار إلى سورة النساء وسورة النور. وذلك إذا تأملت القرآن الكريم وجدت سورًا بعينها فيها غناء وثراء في القضية الاجتماعية سورة النور سورة الأحزاب سورة الحجرات سورة النساء لكن سورة النور بالذات هي سورة تتعلق بالقضية الاجتماعية بالصميم العفاف والستر الذي هو أهم قضية وعلاجها يحتاج إلى ثقافة مشتركة بين الرجل والمرأة بل حتى الطفل وللأطفال لهم حديث ولهم آداب في العلاقة الاجتماعية في بيوتهم وأهاليهم شيء لا يكاد يتخيله من لم يقرأ ويتأمل ولا يظن أحد أن القرآن فيه مثل هذا التوجيه الاجتماعي
د. عبد الرحمن: دعنا ندخل في التفاصيل الآن، في أول السورة بدء سورة النور قوله سبحانه وتعالى (سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1)) لا توجد سورة في القرآن بدأت بمثل هذا البيان يعني مدح السورة والنص أنها سورة بينة أنزلها الله.
د. حسن: هذا من عجيب مطالع السور أن يبدأ بإسم السورة ويمدحها ويثني عليها أن فيها آيات بينات وأن الله سبحانه وتعالى فصلها وبينها ثم بعد ذلك شرع في الأحكام مباشرة، بعد ذلك قال (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (2)) ثم انتقل إلى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ (4)) (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ (6)) (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ (11)) وتسلسلت القضايا حتى نهاية السورة فقط هناك التعليقات والتعقيبات على هذه القضايا الاجتماعية بالتأكيد المرة بعد المرة (أنزلناها وفرضناها) بحيث يؤخذ الأمر بجد وليس الأمر على التراخي (سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) حتى لا يظن أحد أن الأمر ملتبس أو أنه يحتاج إلى تفسير صعب أو أنه من المتشابه (سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) للعلّة (لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ثم يتكرر هذا التوجيه (وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (34))
د. عبد الرحمن: ما هو سر تكرار صفة البيان بينات ومبينات؟
د. حسن: السر لأنها قضية كما قال عمر علّموها نساءكم حفظوها نساءكم وعادة أطياف المجتمع أولو العلم وأولو الفقه هم أقل الناس لكن مثل هذه الأحكام تولى الله تعالى بيانها وتكفل بها بحيث لا يحتاج الناس إلى متخصص في السؤال، الله عز وجل يقول (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30)) (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (31)) الأمر يسير وسهل وواضح أحكام تتعلق بذوات الأشخاص لا تتعلق بالحكومة أو تتعلق بالمؤسسة السياسية العامة بحيث لا يكون أفراد الناس مخاطب بل الكل مخاطب ولذلك جاءت (بينات) بخلاف أو على عكس بعض الأحكام التي يحتاج إليها فئة ولا يحتاج إليها المجتمع إلا في القليل النادر
د. عبد الرحمن: والعجيب أنه بالرغم من التأكيد على صفة البيان التي جاءت في هذه السورة في قضايا الحجاب وقضايا الاستئذان وقضايا النظر وقضايا الحدودو فيما يتعلق بحدود القذف والزنا وما يتعلق بها إلا أن أصحاب الأهواء يثيرون الشبهات حولها ويتعاملون مع الموضوع وكأنه ملتبس ويثيرون الخلاف فيه مع أنها آيات واضحة ليس فيها لبس
د. حسن: بل إنهم سبحان الله يأتون إلى أوضح الواضحات فيردونه جملة وهذا من أخطر الأمور، عندما يكون الأمر ملتبسًا يكون هناك باب لأهل الأهواء (فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ (7) آل عمران) لكن ما بالك بالأمر الواضح البين؟ وخاصة في مسألة الإفك؟ في مسألة الإفك الأمر واضح وبيّن وفي مسألة الحجاب أيضًا الأمر واضح بيّن من حيث النظر إلى المقاصد العظيمة للدين والمبينة بالتفصيل في هذه السورة أن القصد هو العفاف والستر وكل شيء يفضي إلى ذلك فهو من مقاصد السورة وهو من الواضحات البينات وكل أمر إذا آل اجتماعيًا إلى ضد ذلك كرفع الحجاب أو التخفف منه، المبالغة في الزينة، إخراج بعض ما هو من الزينة منها والإذن للمرأة أن تكون فيه بين الأجانب كل ذلك إذا تأملنا مقاصد السورة نقول إنه من الأمور المنهي عنها لأن هذه السورة جاءت للعفاف والستر، غض البصر من الطرفين (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) هذه كلها لها معاني وإذا كنا لا نتعامل مع المآلات وننظر إلى المآلات فمعنى هذا أننا نبحث عن المتشابه لكن في مسألة الإفك الأمر مختلف تمامًا ولذلك لم يقع في الإفك الذي حمل كِبره هو رأس المنافقين
د. عبد الرحمن: لعلنا نخص قصة الإفك إن شاء الله بوقفة. لكن لفت نظري فعلًا كثرة الإثارة الآن لأمور في قضايا تبرج المرأة أو جواز خروجها كاشفة الوجه ومتجملة وأن هذا ليس فيه حرج مع وضوح هذه المعاني في هذه السورة وأن القرآن واضح بمنعها وقطع الأمر في شأنها ورفع الخلاف فيها وأنه يجب على المرأة أن لا ترى الرجال ويجب على الرجل أن لا يرى المرأة وأن هذا هو الأسلم لقلوبهم كما قال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) الأحزاب) فكيف بغيرهم؟
د. حسن: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (30)) لماذا يغضوا من أبصارهم؟ المقصود أن يغضوا أبصارهم عن المحارم وإلا لو كان الأمر لقال الله عز وجل يغمضوا أعينهم لكن تُرِك للإنسان ما لا بد منه في حياته لكن إذا كان في مقابل الطرف الآخر غضوا من أبصاركم والنساء (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (31)) يحفظن فروجهن في الطرفين، وحفظ الفروج هو حفظ لما قد يفضي إلى الوقيعة من هذا الطرف لذاك والله تعالى قد فطر كل طرف على الميل للطرف الآخر لتستقيم الحياة وهذا الميل الفطري جعل الله تعالى له مسارات ومسالك وجعل حدود وحواجز بين الطرفين ولذلك لو تأملنا في الآيات الأخرى في السور الأخرى وضممناها إلى هذه لوجدنا أن الأمر بالحجاب الذي هو تغطية الوجه وتغطية الرأس والستر وعدم الخروج بالزينة ولذلك الفقهاء كانوا مجمعين على أن ستر الوجه سُنّة حتى الذين يقولون بجوازه أنه ليس محرّمًا يقولون إن ستره أولى بالمرأة وقول الله عز وجل في هذه السورة (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ (60)) ما دام رفع الجناح عن القواعد من النساء فغيرهنّ عليه جناح وححتى لو وضعن ثيابهن وهن كبيرات قد يئسن وأصبحن لا يلتفت إليهن (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) لأنه صيانه المجتمع والمصلحة العامة مقدمة على مزاج امرأة أو مزاج رجل، هوى شاب أو هوى فتاة، مصلحة المجتمع مقدّمة على هؤلاء.
د. عبد الرحمن: في أول السورة في قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (2)) هذه الآيات تتحدث عن حد الزنى في جانب البكر لو تحدثنا عن هذا وأين ورد الحديث عن الرجم؟
د. حسن: حد الزنا كان أمره عامًا في أول الإسلام كما جاء في آية النساء ثم بعد ذلك جاء حكمه واضحًا في هذه السورة وهذا في الزانيين إذا كانا غير محصنين يعني بِكر مائة جلدة والتغريب الذي جاء في السُنة ثم حكم الزانية والزاني المحصنين إذا كانا محصنيين هو الرجم حتى الموت وقد ثبت ذلك بالسُنّة القولية والفعلية ورجم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يرجموا من وقعوا في ذلك وثبت ذلك بالقرآن بالقرآءة المنسوخة الثابتة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك ومن الألفاظ التي وردت في هذه القرآءة (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة) وكان إجماع بين المسلمين لا خلاف بينهم أن هذا حدّ الزاني غير المحصن وذاك حد الزاني المحصّن.
د. عبد الرحمن: كان عمر يقول لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لأثبت الآية في سورة الأحزاب (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم) هذا من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه
د. حسن: وإذا تأملنا الآيات من أول السورة حتى الآيات السادسة والعشرين هي في الحقيقة كلها حديث عن حادثة الإفك الكبيرة مقدماتها وما جرى بعدها.
د. عبد الرحمن: تحدثت السورة عن الزنا ثم تحدثت عن القذف ثم عن الإفك ما الرابط بين هذه الحوادث؟
د. حسن: الرابط بينها هو أن بعضها آخذ برقاب بعض وبعضها سبب لبعض. فالقذف هو إتهام طرف لطرف أنه وقع في هذه الفاحشة والقذف لفظ عام لكن في هذه السورة يتجه إلى الزنا وحتى القذف قذف عام وقذف وهو اللعان بين الزوج وزوجته ولذلك أغلق هذا الباب حماية لكل طرف من الطرف الآخر. الزنا هو الفعلة المنكرة والقذف هو رمي بها والإفك هو قذف بها.
د. عبد الرحمن: نعود لسورة النور، في قصة الإفك التي وقعت لأمنا عائشة رضي الله عنها الكثير من الناس يقرأوا هذه القصة ويظن أنها تاريخ مضى وانقضى ولا يعلم أن هناك أناس يجددونها إلى اليوم وقبل أربع أو خمس أيام عقد مؤتمر للإحتفال بموت عائشة رضي الله عنها ويقول الذين يقومون بهذا أن هذا عيد منسي ينبغي أن نحتفل بموت عائشة رضي الله عنها من قِبَل هؤلاء الرافضة قبّحهم الله. فأريد أن تتوقف عند هذا الموضوع (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ (11))
د. حسن: وهذا في حقيقة الأمر أقل ما يجب علينا نحو أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبيها الصديق ورسول هذه الأمة زوج الصديقة وحبيب الله عز وجل وأعظم رسله هذه الحادثة هي في الواقع جاءت في هذه السورة مفصّلة وهي تاج على رأس عائشة رضي الله عنها وهي ملحمة من المحنة التي كان يمر بها المجتمع المسلم في ذلك الوقت.
د. عبد الرحمن: ليتك توضح لنا باختصار شديد ما هي القصة بالضبط.
د. حسن: في غزوة بني المصطلق في أواخر السنة الثالثة أو أوائل السنة الرابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلًا وراجعًا من غزوة بني الصمطلق وفي أثناء الطريق باتوا في مكان معين فعائشة رضي الله عنها بعد أن أُذِّن برحيل الجيش خرجت كما تخرد النساء والرجال لقضاء شؤونهم بعيدًا عن المعسكر فذهبت فلما رجعت افتقدت عِقدها فرجعت تطلبه رجعت على خطاها تطلب عقدها فطال بها الأمر وجدت عقدها بعد بحث احتبست عليه فلما رجعت وإذا بالمعسكر والناس قد رحلوا والصحابة رضي الله تعالى عنهم المكلفون بحمل هودجها وكانت خفيفة فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها غير موجودة فيه وشد على بعيرها ومضى الركب وكان النبي صلى الله عليه وسلم عادة ما يجعل خلف المعسكر بعيدًا من يرقب العدو لئلا يغير أحد على المعسكر وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه كان هو ذلك الرجل وكان من خيار الصحابة وكان من خيار الرجال ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أمينه على مؤخرة الجيش فلما ذهبوا شيئًا جاء صفوان ليلحق بهم وركب ناقته فلما مر من مكان الجيش لمح سوادًا فإذا هي عائشة وكان يعرفها قبل أن يفرض الحجاب فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون! عائشة أم المؤمنين؟! فنزل عن راحلته وأناخ ناقته وأركبها وصار يقود الراحلة هو يمشي وهي راكبة حتى لحق بالجيش بعدما تعالى النهار من الغد فلما جاء إليهم كان الناس على ما عهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين مصدّقين إلا المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال كلمة خبيثة قبيحة -لا أريد أن أقولها – لكنه اتهام لهما أن بعضهما وقع في بعض وسار هذا الكلام ووقع فيه بعض ضعاف النفوس من المسلمين لأمر يريده الله عز وجل، سرى هذا الأمر ولم يبلغ الأمر عائشة إلا بعد فترة، الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات لبيان هذه الحادثة الشنيعة
د. عبد الرحمن: أظن بعد شهر من وقوعها نزلت الآيات
د. حسن: بعدما جلجل الأمر ووقع في نفس أبي بكر رضي الله عنه وحزن وهجر عائشة وعائشة أصابها ما أصابها من الهمّ كيف وقد قيل؟! بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآيات والعجيب أن هذه الايات في موضوعها من أوضح الآيات لم يترك الله عز وجل شاردة ولا واردة في هذا الأمر إلا بيّنها (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ (11)) سماه إفك والإفك هو أشد الكذب، مقلوب عندما تقول هذه طاولة مأفوكة يعني مقلوبة (وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) النجم) المؤتفكة مقلوبة لأنه قلب عاليها سافلها. (عُصْبَةٌ مِّنكُمْ) يعني شرذمة قِلّة لا تأبهوا بهم، (منكم) وإن كان من المنافقين لأن المنافقين كانوا محسوبين على المجتمع ولذلك عبد الله بن أبي كان من ضمن الجيش الذي يمشي وشأنه يتتبع الأثرات والبحث عن الزلات. (لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) ولذلك الله سبحانه وتعالى بدأ هذا القول قبل أن يفصل الحكم فيه لتطمين النفوس ابتداء هذا الأمر وقع لكن لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، ولم يكتف بالنفي بل جاء بالإثبات، لماذا؟ عائشة رضي الله عنها بعد الإفك أعظم وأشرف منها قبل الإفك كما كان يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ذلك التلبيس أعظم منه ومريم عليها السلام كانت بعد أن امتحنها الله تعالى بتلك الولادة وذلك الوليد غير الطبيعي وما جرى في ظن الناس كانت أعظم مكانة منها قبل أن يكون لها ما كان. ولذلك الله تبارك وتعالى أراد أن يرفع مقام عائشة في ذلك ومقام أبيها وهو أيضًا رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا اتهام في عرضه فأنزل الله تبارك وتعالى هذه البراءة بهضا التفصيل (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)) ففضح المنافقين ورفع شأن المؤمنين وتاب على الذين وقع منهم ذلك من المؤمنين كمسطح وحسان رضي الله عنهم وكان حسان يدخل على عائشة بعد ذلك ويعتذر، وأنزل فيهم أحكامًا، التوبة تجبّ ما قبلها والرفق بين المنافق والمؤمن أن المؤمن يتوب فيتوب الله عليه وأنزل الله فيها آيات حتى قال ابن عباس ما هذه بأولى بركاتكم يا آل أبي بكر، يحدث لكم شيء فينزل الله أحكامًا تنفعنا وتبين أمور ديننا. (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) إنتهى فُرِغ منه الذي هو عبد الله بن أبي الذي عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن صلّى عليه. بعد ذلك جاءت الآيات بالتفصيل وهو خطاب للمجتمع المسلم خاصة في ذلك الوقت (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (12)) ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيراً، عائشة من المؤمنين بل هي أشرف المؤمنين، (بأنفسهم) ببعضهم، (خيرًا) ولذلك الإنسان إذا كان غالبه الخير وغالبه الصلاح الأصل فيه السلامة فالواجب هو ظن الخير به حتى يثبت العكس والدفاع عن عرضه وليس العكس، الله عز وجل وهو العالم قال (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ) يقول بعضهم لبعض هذا لا يكون هذا إفك مبين. (لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء (13)) هلا للتحضيض، (فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)) وإذا وصف الله أحد بالكذب انتهى، الله عز وجل هو الذي مدحه زين وذمّه شين، لما قال عز وجل (نعم العبد) فعلًا نعم العبد ولما قال (فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) هم الكاذبون. (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) وهذا شأن الخبر أحيانًا يتشوفه اللسان (وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ) والقول بالأفواه عادة هو القول غير المدروس القول الذي لا أساس له الذي جاء مباشرة ودون روية (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)) وهذه كلها دروس، كل واحدة منها درس لي ولك وللمجتمع، الكلام ظاهره سهل لكن حقيقته يورد الإنسان النار وجرح اللسان كجرح اليد بل هو أعظم (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ). ويأتي بعد ذلك التعقيب العجيب (وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16)) اختيار هذا التعبير (مَّا يَكُونُ لَنَا) الله عز وجل قال مثل هذا السياق في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام (وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ (116) المائدة) في الأمر العظيم قال (ما يكون لي أن) وهاهنا (قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ) يعني هذا مستهجن مستفظع كما لو رأى الإنسان ريبة عظيمة فيقال يا فلان تعالى شوف فيقول لا، هذا القرب منه وباء والقرب منه تهمة (قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) وهذه الأوصاف كلها التي اجتمعت بهتان، إفك، إفك مبين وهذه صادرة من الله، هذا ليس رأي المؤمنين، وليس رأي أبو بكر ولا عائشة ولا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قول الله عز وجل للمؤمنين ثم بعد ذلك يأتي الأمر الرهيب (يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (17)) (أبدا) هذه لنفي المستقبل لا تعودوا لهذا الأمر لا في شأن عائشة تعيدونه وتكررونه وتحيونه وتبعثونه ولا في شأن أحد من المؤمنين بغير بيّنة وحجّة ظاهرة (يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) والإمام مالك رحمه الله قال كلمة عجيبة “من سب أبا بكر وعمر فإنه يؤدّب ومن سبّ عائشة يقتل” لأنه كذّب بالقرآن صراحة، الله عز وجل أثنى على الصحابة عمومًا والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه وقال عن أبي بكر وعمر أنهما في الجنة لكن عائشة جاء الأمر ببراءتها صراحة جاء الأمر بحفظ عرضها ولم يترك ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قذفها فهو كافر ولذلك الله عز وجل عاد إلى الموضوع مرة أخرى، طبعًا تكلم عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وذمهم لمجرد الحب فكيف بالممارسة والدعوة والإسناد؟!. بعد ذلك قال الله عز وجل (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)) وعائشة هذه كلها فيها خصال غافلة محصنة زوج نبي الله صلى الله عليه وسلم غافلة لا يخطر ببالها ما اتهمت به (أوتزني الحرة؟) فكيف بعائشة رضي الله عنها؟! وهي الصديقة بنت الصديق. (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25)) وبعد ذلك تأتي تزكية ليس فقط لعائشة وإنما لأمهات المؤمنين كلهن وهي قاعدة (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ) هذا فريق وهذه مجموعة وهذا مجتمع، نزلنا منزلًا بليل فنزل الأخيار على الأخيار والأشرار على الأشرار، (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ). بعد ذلك قال (أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) هذا التبرئة لو لم تكن بهذه الفصاحة والصراحة والتفصيل كان الحق أن تبرّأ عائشة لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم هناك أمور أخرى ينبغي أن نتذكرها، الله عز وجل قال في أول السورة (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) وإن كانت عائشة رضي الله عنها وحاشاها زنت على قول المتقديمن والمتأخرين من الأفّاكين فلماذا لم يحدّها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! هل كان خائفًا؟ هل كان راجيًا؟ وهو الذي كان يقيم العدل! وإذا كانت زانية على قول الأفّاكين وحاشاها فهل يبقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة له ويموت وهو بين سحرها ونحرها وتكون زوجته في الجنة؟! ويقول له الله تعالى في سورة الأحزاب (وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ (52)) أمر إلهي بتثبيت هؤلاء الزوجات لا يزاد منهن ولا ينقص. ولو كانت رضي الله تعالى عنها زانية فكيف يُقِرّ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، كيف يقرّه على الزنا وكيف يقره على عدم إقامة الحد ولذلك من وقع فيها فواضح أن بينه وبين الإيمان كما بين عائشة رضي الله عنها وبين الإفك.
سؤال الحلقة
جاء حَبْر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من القرآن. فما هي هذه الآية ؟
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة النور – 1
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
إجابة على أسئلة المشاهدين:
سؤال من الأخ بلقاسم: في سورة الأعراف يقول الله تعالى (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾) ونجد نفس الآية في سورة فصلت (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾) لماذا الأولى نكرة والثانية معرفة؟
د. المستغانمي: هذا سؤال وجيه في المتشابه اللفظي قوله تبارك وتعالى (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾) في سورة الأعراف والتعبير ذاته يتكرر في سورة فصلت (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾) هو يسأل عن التنكير والتعريف والاختلاف في هذا التذييل. عندما ندرس سياق سورة الأعراف كان الحديث عن الآلهة المزعومة، عن الأصنام التي لا تسمع ولا تضر ولا تنفع ولا تتحرك حتى إن السياق يتحدث عنهم يقول (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾) هذه الأصنام، تنظر ولا تبصر. في سياق الحديث يعبدون ما ينحتون من أصنام وتماثيل جاء (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) نزغ وهمز من الشيطان فاستعذ بالله ولما جاء ذكر الله (إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) جلّ جلاله لأن السياق الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك فلم يقتضي السياق مزيدًا من التوكيد فجاءت صفة الله (إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). لكن في سياق سورة فصلت كان الحديث عن الإنس والجن وهم يسمعون ويبصرون يقول (وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾) إلى أن يقول (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾) فالجن والإنس من صفاتهم السمع ومن صفاتهم البصر، بما معناه الشبهة قائمة فلما جاء يتحدث عن الله جاء بأسلوب جازم (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) وإلجأ إليه (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الجن والإنس يسمعون لكن الله هو السميع العليم كأنه نفى عنهم السمع البسيط، سمع الله لا يجارى ليس كمثله شيء أوتي بضمير الفصل (هو) للتأكيد فمن الضروي مع إنه هو السميع العليم كأنه يقول إنه هو السميع العليم لا آلهتكم المزعومة بينما لم يقتضي في سورة الأعراف ذلك وهذا الكلام أخذته من كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي.
سؤال من د. شهاب الجبوري: ما الفرق بين قوله تعالى في سورة التوبة (يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ) [التوبة: 94] وقوله (سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ) [التوبة: 95] ما دلالة استخدام رجعتم وانقلبتم؟ وهل يتغير المعنى إذا وضعنا كلمة مكان الأخرى؟
د. المستغانمي: المتشابه اللفظي هو الذي يستوقف الناس الذين يتدبرون. في اللغة العربية قد لا يتغير كثيرا هو من المتقاربات اللفظية رجع إلى أهله وانقلب إلى أهله لكن في القرآن لا يجوز، من المؤكد – سواء عرفنا أم لم نعرف- أنا بحثت في الموضوع نقول رجع إلى المكان الذي منه انطلق ونقول انقلب، الرجوع والانقلاب يتقاربان لكن القرآن استعمل الانقلاب لإفادة مزيد من السرعة، هذا الذي يمكنني أن اضيفه للسائل الكريم. لما نقول انقلب فيه سرعة وانقلب يرجع إلى دينه السابق يعني يرتد. لها معنيان إذن في القرآن: انقلبت هذا الأمر فانقلب يعني مطاوع، انقلب على عقبيه بمعنى ارتد، أما (إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ) إذا رجعتم إليهم، فيها نوع من السرعة، لماذا؟ استقراء الآيات في القرآن (أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ) [آل عمران: 144] يتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم (انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ) هنا بمعنى ارتددتم ولكن فيها سرعة الانقلاب (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُم فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) آل عمران) ولو قلنا فترجعوا خاسرين المعنى قريب لكن فيها انقلاب وفيها سرعة (فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ) [آل عمران: 174] أي فرجعوا محملين بفضل من الله مصحوبين بفضل من الله وفيها نوع من السرعة، السحرة لما آمنوا في مجمع فرعون قال (فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) الأعراف) أذلاء، انقلبوا بمعنى سرعة تحوّلهم وتنفيذ الأمر، هم أنفسهم قالوا (إنا إلى ربنا منقلبون) بمعنى راجعون، (وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) يوسف) إذا رجعوا لكن فيها سرعة لما يذهبوا ويجدوا بضاعهم يعودون، هذه التي تفيد لكني لم أقف على تفريق بين المفسرين,
المقدم: لكن في القرآن الكريم لا يجوز أن نستعمل كلمة مكان الأخرى.
سورة النور
المقدم: نتحدث عن العلاقة بين السورة وبين سابقتها ولاحقتها، هل هناك علاقة تجعلها في هذا الترتيب باعتبار أن الترتيب توقيفي؟
د. المستغانمي: سورة النور سورة مدنية بين مكيات، كلها مدنية باتفاق العلماء، لما نأتي من الحجر، فالنحل، فالإسراء، الكهف، مريم، الأنبياء، الحج بعضها مكي وبعضها مدني، إلى المؤمنون مكية ثم نعود إلى القرآن المكي مع الفرقان والشعراء والنمل فهي سورة وضعها عجيب. من بين ما لاحظه العلماء عندما تحدث الله سبحانه وتعالى من بداية سورة المؤمنون (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ المؤمنون) هذه إشارة إلى ما سيأتي، كيف يحفظون فروجهم (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)؟ جاءت سورة النور تفصّل وتنظم العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة الاجتماعية حتى إن أحد العلماء الإمام أبو زهرة الأزهري إمام عظيم قال هي سورة النور وقال لو سميت سورة الأسرة لكانت التسمية دقيقة لما تحدثت فيه عن الفرد وتحدثت عن الأسرة وتحدثت عن المجتمع، فهي تنظم الأسرة والمجتمع. (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) جاءت سورة النور تفصل كيفية حفظ الفروج وكيفية الارتفاع بالمجتمع والارتقاء به إلى درجة السمو الأخلاقي، غض البصر (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) هنا أمر محذوف: قل للمؤمنين غُضوا يغضوا من أبصارهم، البعض يظن (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) جواب الطلب، هذا خطا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فسيغضون، أصل الكلام قل للمؤمنات يغضضن فيغضضن، جواب الطلب المحذوف. عندما يقول (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) الدعوة للتزويج، عندما ينهى المرأة عن إبداء زينتها لمن لا يحلّ لها (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) المحارم الذين يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم بزينتها العادية. سورة النور ميثاق دقيق ومبين ومفصل للفرد المسلم وللأسرة المسلمة وللمجتمع المسلم وكيف ينبغي لهذا المجتمع وهذه الأُسر أن تعبد الله على نور وبصيرة. وفي آخر الآيات في سورة المؤمنون (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾ المؤمنون) ومن رحمة الله بنا أن أنزل سورة النور ليعيش المجتمع تحت نور الله وفي رعابة الله وتحت هداياته بينما المجتمعات التي لا تمتلك القرآن تعيش في ظلام.
المقدم: الإشارة التي تربط سورة النور بسورة المؤمنون هي ما ذكرت في بداية سورة المؤمنين (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)
د. المستغانمي: فتأتي سورة النور تفصّل هذا الكلام.
المقدم: بعدها تأتي الفرقان فهل ثمة علاقة بينها وبين الفرقان؟
د. المستغانمي: آخر سورة النور (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) تعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام سورة النور، الله سبحانه وتعالى أدّب المؤمنين وأدّب المنافقين الذين جافوا الطبع السليم في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في السورة (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾) أدّبهم الله في السورة ثم في النهاية (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) جاءت سورة الفرقان تُعلي وتنوّه بشأن هذا النبي العظيم من بدايتها إلى نهايتها (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ الفرقان) فهو عبده ومن أعظم صفات الرسول ومن أعظم صفات أيّ إنسان أنه عبد وبدأت تفصل في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فثمّة علاقة وطيدة إلا أن سورة النور سورة مدنية عالجت المجتمع ومطلعها مطلع عجيب لأن عنصر الأخلاق وعنصر التربية الأسرية شيء عظيم فالسور المكية تحدثت عن الاعتقاد الصحيح، جاءت سورة النور ترتفع بالأخلاق وترتفع بالتربية.
المقدم: لماذا سميت بسورة النور؟
د. المستغانمي: من أعظم آياتها قول الله تبارك وتعالى (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) سميت نسبة لهذه الآية العظيمة ثم جاء تمثيل لنوره (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ) هذا تشبيه تمثيلي منتزع من متعدد بحيث تمثيل لنوره هكذا فما بالك بنوره الحقيقي؟! والله هو النور جلّ جلاله ومنه يكتسب المؤمن نور الهداية، نور التوفيق، نور العمل الصالح أما المشركون وصف أعمالهم (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ) ووصف أعمالهم (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ) الكفار يعيشون في ظلام، ظلام الاعتقاد، ظلام الأعمال، أما المؤمن يستنير بنور الله، تقابل (ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) ولما يتحدث عن المؤمن (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) نحن نكتسب النور من نور الله سبحانه وتعالى وهل ثمّة نور أكثر من هذه الإرشادات والتوضيحات والآيات البينات من أول السورة إلى آخر السورة؟!
المقدم: هل وردت لفظة النور مطردة في السورة؟
د. المستغانمي: نعم وردت (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) ووردت الظلمات، تقابل بين نور الله وبين ظلمات الاعتقاد وظلمات أعمال الكافرين إلى أن قال (نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ).
المقدم: ما هو المحور العام الذي تتحدث عنه السورة؟
د. المستغانمي: سورة النور هي سورة النور نسبة إلى نور الله وهي تنير الطريق والدرب أمام كل مسلم حتى إن كثيرا من السابقين يقولون ليت النساء – وأنا أقول ليت الرجال والنساء – يقرأون سورة النور لأنها فعلًا تعلم المجتمع المسلم كيف يمشي، تعلّم الأسرة كيف تنبني، فهي محورها العام: تربية الأسرة المسلمة، لو صح لنا أن نعطيها عنوانًا – طبعًا الله سبحانه وتعالى أعطاها اسم النور – تهدي القلوب وتهدي النفوس وتزكي الأخلاق لكن كمحور عام هي سورة الأسرة المسلمة. سورة النور تبني المجتمع من أوله إلى آخره ولكن بدايتها صعبة بعض الشيء! بعدما قال (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾) أول حُكم (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) قد يقرأ إنسان يأتي من دين آخر أو يحب وله فضول أن يتعلم الإسلام يقرأ (الزاني والزانية) يقول هذا دين يبدأ بتطبيق الحدود بالجلد! سورة النور لها هندسة عجيبة
المقدم: حتى بدايتها ليست مطردة في القرآن أن يبدأ (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا)
د. المستغانمي: لا يوجد إلا هذه، هذا لا يعني أن السور الأخرى ليست سورًا ولكن هذا مطلع فريد! القرآن يتصف ويتسم ببراعة المطلع وروعة المقطع، هذه براعة مطلع عجيبة، تخيل أنت أعرابي تُحسن اللغة تسمع (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا) ما هي هذه السورة؟ نكرة موصوفة والنكرة عندما توصف وتخصص ترتقي إلى أن تكون معرفة “ولا يجوز الابتدا بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة” لكن هنا مخصصة بالأوصاف (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا) الوصف الأول (وَفَرَضْنَاهَا) (وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) لماذا يا رب؟ (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) رجاء أن تتذكروا أنتم، أحد المفسرين يقول (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) بحكم صفة كأنه يقول أنزلنا فيها آيات بينات مذكّرات (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) هي جملة رجاء تنقلب إلى صفة للسورة آيات مبينات مذكّرات رجاء التذكير لك كأنه يقول مذكرّات. ثم قال (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) هذا حكم وحدّ من حدود الإسلام، نقول لمن يريد أن يشوّه الإسلام: كم حدًّا في القرآن؟ معدودة، خمسة، ستة: حد الحرابة، حد الزنا، حد السرقة، حدّ القتل، حد القذف، حد شارب الخمر. كم آية في القرآن؟ ستة آلاف ومئتين ما يصل إلى الواحد بالألف! لكن هل القرآن سبّاق إلى تطبيق الحدود؟ نقول لا، بدأت السورة بالزجر عن هذه الفاحشة المهينة الفاحشة التي إذا انتشرت في المجتمع يصبح وباء وهو الزنا (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ)، حتى لا نقع في الزنى كل سورة النور جاءت تشرّع حتى لا نقع في الزنا. إذن أتى بالحُكم أولا ثم أتى بالوسائل الوقائية: غض البصر وقاية، عدم اتباع خطوات الشيطان، إبداء المرأة محاسنها لمن لا يحلّ لها وقاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا غض المرأة بصرها وقاية من الخطأ
المقدم: وهذا كله جاء بعد أن ذكر الحكم والحدّ وكيف يتم التعامل مع الموضوع ثم فصّل في كل ما يُبعد عن هذه الفاحشة.
د. المستغانمي: هذا هو البناء الهندسي للسورة، بناء عجيب! أتت بحكم الزنا، أتت بحكم القذف وهو لا يجوز وقذف المحصنات كبيرة من الكبائر (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ)، (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) في حق عائشة رضي الله عنها والإفك أكذب الكذب وأكذب البهتان وهو أشد من الزور لأن الإفك هو الكذب العجيب، الكذب الذي يقلب الحق باطلًا والباطل حقًا. من أين أتي بكلمة الإفك؟ يأفِك يعني يقلب وسميت قرى قوم لوط المؤتفكات لأنه قلب عاليها سافلها، الإفك هو قلب الحقائق وهو مثل الزور لكن العلماء في اللغة يقولون: أكذب الكذب هو الإفك. فأتى بالحكم أولًا ثم حتى لا يقع المسلم – أنا أريد أن أصور رحمة الإسلام وسماحة الإسلام أنه ليس سبّاقًا إلى التطبيق “ادرأوا الحدود بالشبهات” لا يتم تطبيق حدّ الزنا إلا إذا رأى أربعة شهود الفعل جهارا نهارا، هل هذا يتم إلا لمن جاهر بالحرام؟! إلا لمن كان الزنا دأبه؟! هذا إنسان مجاهر يستحق تطبيق الحد، هذا ينشر الفساد (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾.). كيف بنيت السورة؟ أتى بالحكم ثم أتى بجميع الوسائل أتى وسائل غض البصر، أتى بوسائل عدم اتباع الشيطان والاختلاط، غض البصر في حق المرأة، أمر بالتزويج (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ)، أمر بعدم دفع الفتيات المملوكات للبغاء (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) والبغاء هو الزنا بعِوَض، علّم الناس الاستئذان كيف تدخل البيوت (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) تستأنسوا وليس تستأذنوا معناه تستأذن وإذا أذن لك واستأنست بأن صاحب البيت يأذن لك بمزاجه وعن طواعية فادخل، علم الاستئذان للكبار والصغار (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) (و وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) هذه آداب. والمرأة العجوز؟ ورد (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) ما تركت سورة النور شاردة ولا ورادة في العلاقة بين الرجل والمرأة إلا قنّنتها.
المقدم: حتى الذين لا يجدون النكاح يستعفّون
د. المستغانمي: عليهم أن يستعففوا ويغنيهم الله من فضله. فبيّنت السورة كل شيء فأحرى بمن طبق هذه الآداب أن لا يقع في الزنا. إذن تطبيق حدّ الزنا لا يقع بسهولة، وضع الحكم وأتى بسياج من الأحكام وسور من الآداب يجعل المسلم لا يقع فيه أبدًا.
المقدم: إذا تتبع كل هذه المسائل فلن يقع فيها بإذن الله وإذا وقع فيها فحريٌ أن يُقام عليه الحدّ
د. المستغانمي: لأنه مجاهر تجاوز جميع الآيات التي وردت في سورة النور.
المقدم: هذا المحور العام، هل هناك محاور أخرى؟
د. المستغانمي: المحور العام التربية لكن لها خصائص جميلة جدًا، خصائص لفظية وخصائص معنوية. أولًا وأنا أبحث في سورة النور كل سورة شخصية تنطق بها، سورة المؤمنون قسّمها الله سبحانه وتعالى من البداية: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾) ثم قال (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾) (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾) ينتهي شوط أو جولة فتبدأ جولة ثانية (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ) التقسيم لفظي منها وفيها. سورة النور قسمها الباري بطريقة هندسية عظيمة وهي: الآيات البيّنات، من البداية (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) أي واضحات جليّات، اثم بدأت لجولة الأولى تحدثت عن حدّ الزنا (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) ثم بعد ذلك الناس تتجرأ وتقذف (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) ثم بعد ذلك هب أن رجلًا وجد مع زوجه زنا لا يستطيع أن يُحضر الشهود (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) هذه خصوصية، تخفيف على الأزواج والزوجات، هذه خصوصية البيوت تختلف عن الآية السابقة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) هذه زوجة فإذا رماها يحلف أربع مرات (الملاعنة) بعد ذلك أتى بحادثة فظيعة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حادثة الإفك وفيها اتهام ورمي لأم المؤمنين وأحرى بالمؤمنين أن لا يقولوا هذا الكلام، لما انتهت هذه الآيات (يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ) في البداية قال (آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ)، انتهت الجولة الأولى قال (وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ). ثم يأتي الحديث عن وسائل الوقاية مثل: ضرورة تجنب وسائل الإغراء (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)، ضرورة تجنب الشيطان (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ)، الأمر بغض البصر للنساء والرجال (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)، النهي عن إبداء الزينة لغير المحارم، الأمر بالتزويج، بعد ذلك قال (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ) مبيّنات (لم يقل بينات) خطوة أعلى وأعظم تبيّن ما سبق.
المقدم: وردت آية لا أدري كيف نجعلها في سياق الحديث؟ قال الله تعالى (وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾) ثم ذكر خطوات الشيطان ثم ذكر (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾) هذا الموضوع ليس متعلقا بما سبق!
د. المستغانمي: هذا يتعلق بحادثة الإفك مسطح بن أثاثة الذي كانت له صلة قرابة مع أبي بكر الصديق وتكلم في عائشة وكان حريًا به ألا يتكلم ومنع عنه أبو بكر الصدقة فقال الله تعالى (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ) أبو بكر (أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا) فسورة بدأت بحد عظيم الإسلام ولكن رقّت إلى العفو والصفح، إذن الإسلام ليس مخيفًا كما يتصوره الآخرون، فيه حدود عند الضرورة وفيه دعوة إلى العفو والصفح.
المقدم: إذن يختم هذا الموضوع (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾) (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)
د. المستغانمي: بدأ موضوعا جديدًا.
المقدم: قال الله تعالى في بداية السورة (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾) وبدأ يفصل هذه الآيات البينات فذكرها بعد ختام الموضوع الأول ثم ذكرها بعد ختام الموضوع الثاني والآن دخل في الموضوع الثالث بعد أن قال (آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ) قال (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)
د. المستغانمي: هو مرتبط، الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يقول وما يفعل، بدأ بآيات حول الزنا تقنين للأسرة المسلمة التي لا ينبغي أن تقع في ذلك ثم ختم (كذلك أنزلنا آيات بينات) ثم بدأ بوسائل الوقاية ثم ختمها (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ) ترقي في الاستعمال، مرة قال بينات ومرة قال مبينات اسم فاعل من بيّن (وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) الآن عاد السياق إلى (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وجاء مثل تشبيهي لنور الله (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ). بعد ذلك انتقل إلى أعمال الكافرين (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً) أعمالهم تذهب أدراج الرياح (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ) لماذا كل هذا التشبيه؟ لأنهم يعيشون في ظلام الاعتقاد وفي ظلام الجاهلية. ولما انتهى منهم قال (لَقَدْ أَنْزَلْنَا آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾) انتهت حلقة من الحديث عن الله والحديث تقليب الليل والنهار (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ) فيها آيات كونية تدل على وحدانية الله (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ). ثم جاء حديث عن المنافقين بعد (لَقَدْ أَنْزَلْنَا آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ) (وَيَقُولُونَ) من هم؟ الحديث عن المنافقين لكن لم يذكرهم لأنه إذا كان الكلام معهودًا لا داعي لذكره (وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾) بدأ حديث عن أهل النفاق وكيف أنهم أساؤوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجافوا الطبع الحسن واللائق في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما أدبهم وتحدث عن المسلمين وعن المؤمنين (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) تحدث عنهم ثم عاد إلى الاستئذان قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) الجمل سابقة اعترضية يعني انقطع عن الموضوع ثم يعود إليه وهذا ديدن القرآن يتخوّلنا بالنصح، يتكلم عن موضوع ثم يذهب بك كالخطيب المفوّه المصقع البليغ يتكلم عن موضوع، يخرج إلى قصة، يعود إلى الموضوع،- ولله المثل الأعلى – عاد إلى الاستئذان (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾) (كذلك) مثل ذلك البيان السابق، تكلمنا (كذلك) في سورة الزخرف يعني لو أننا بحثنا عن شيء واضح لا نجد أوضح من الآيات السابقة، فمثل ذلك البيان يبين الله لكم الآيات. عاد إلى الحديث عن استئذان الأطفال (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) قال (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) بعد ذلك عاد إلى النساء القواعد، العجائز (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) شرط غير متبرجات بزينة، هذه المرأة الكبيرة إذا كشفت شيئًا من ساعدها، هذه أم، جدّة، توقّر وتحترم في المجتمع المسلم. بعد ذلك (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ثم ذكر المؤمنين (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) وختمت بروعة المقطع.
الذي أريد أن أقوله أن الذي فصّل هذه السورة وجعلها أبوابًا هو قوله تعالى (يبين الآيات) هل ثمّة سورة أخرى مثلها؟ أنا شخصيًا لم أقف عليها لكن لكل سورة هندسة بنائية وهذه هندستها “البيان”، لماذا البيان؟ لأننا في سورة تشريع ومن حق التشريع أن يُبين للأمة. لو ذهبنا إلى سورة المرسلات (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بناؤها حول (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)، سورة القمر (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) ذلك طابعها وتلك شخصيتها. فهندسة سورة النور مبنية على الإيضاح والبيان والتجلية فما أعظم هذا البيان! وهي مقسّمة.
من خصائصها ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض الخصائص اللفظية التي جاءت متكررة من بينها: أداة (لولا) تفيد شيئين في اللغة العربية: (لولا) حرف امتناع لوجود عندما تكون شرطية و (لولا) تستعمل أداة حضّ وتلهيف إذا جاء بعدها الفعل الماضي (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ) هذه ليست امتناع لوجود، كأنه يقول: هلّا إذا سمعتموه، تحضيض. فبالمعنيين أتت (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ) هذه امتناع لوجود لأنه ورد بعدها اسم وهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره (موجود) “لولا فضل الله عليكم موجود” ، (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ) (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) لما اتهموا عائشة بالافتراء، بالإفك، هلّا جاؤوا بأربعة شهاداء، فهنا تفيد التحضيض. (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾) (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ﴿١٢﴾) هلّا إذ سمعتموه قلتم وأصل الكلام: لولا قلتم أنّى يكون هذا إذ سمعتموه، يفترض أول ما تسمع تقول لا ينبغي أن نقول هذا الكلام! (وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾) النظم: لولا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا إذ سمعتموه، الظرف من حقه أن يؤخر لكن قُدّم لأن المفترض أن لا تنتظر ثانية، يتكلمون في عرض عائشة وتنتنظر؟!. إذن السورة من خصائصها اللفظية تكرار (لولا) (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا) لا يوجد هذا الحضور المكثف لـ(لولا) في سورة المؤمنين، هذه السورة مبنية على شاكلة وعلى طريقة معينة وتلك مبنية على طريقة معينة، في سورة المؤمنون (قد) و(لقد) وهذا لا ينفي أن تأتي (قد) هنا لكن أتكلم عن الأيقونات اللفظية البارزة في السورة، لما تسمع قارئ يكرر (لولا) تعرف أنها سورة النور لأنه من خصائصها.
(العذاب العظيم) سورة التشريع تهز المؤمن (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) عبد الله بن أبيّ والذين اتبعوه (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾) هذا الوصف لم يكرر جزافًا، نحن أمام قضية خطيرة قضية تربية الأسرة المسلمة على العفاف والطهر والابتعاد عن الزنا فنجد هذا التعبير (عظيم) المكثّف في السورة.
أيضًا شيء عجيب وأنا أبحث في السورة في عدد من التفاسير وجدت ذكرًا لله تعالى في سورة النور، عندما تقرأ قرآءة مجردة لا يستوقفك، البحث يجعلك تكتشف. وصف الله ذاته العلية في سورة النور من بين الأوصاف والأسماء الحسنى البارز ومحور السورة العظيم (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وفي السورة وصف الله عز وجلّ ذاته العلية بـ(فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) (وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ) (أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ) (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) مليئة، ومما وجدت فيها (وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) حضور مكثف لأسماء حسنى كثيرة وهي صفات لله تعالى لكن يميزها أنها على الرغم من أنها جاءت تنهى عن أشياء جاءت فيها(سريع الحساب) مرة واحدة وجاءت فيها (غفور رحيم) أربع مرات، في القرآن كاملا وردت 71 مرة في سورة النور وردت (غفور رحيم) أربع مرات، وردت رؤوف، تواب، هل هذا يرجح كفّة العذاب والعقاب أم يرجح كفّة المغفرة؟ طبعًأ المغفرة، يشجعنا على أن نتوب لا على أن يعاقبنا جلّ جلاله، قضية جلية جدًا.
شيء آخر أردت أن ألفت إليه في خصائص السورة اللفظية أيضًا أتت فيها نداءات المؤمنين وإن كانت النداءات موجودة في سور أخرى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ففيها خصائص لفظية وفيها تأكيد (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا) (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ) فيها تأكيد لبعض الأحكام وكلها أحكام من بدايتها لنهايتها وثمّة خصائص أخرى قد نتطرق لبعض منها أثناء تفصيلها.
المقدم: هذه البداية لم يبدأ الله سبحانه وتعالى بها أي سورة مع العلم بأن كل سور القرآن أنزلها الله سبحانه وتعالى لكن لماذا يخصص هذه السورة فيقول (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا) وهو الذي أنزل سواها وفرض سواها، ويكرر فيها لفظ الإنزال (أنزلنا) فهل في ذلك إشارة أو دلالة معينة؟
د. المستغانمي: طبعًا، أولًا مطلع فريد من نوعه في القرآن كله، هذه لدينا مجموعة ألم، مجموعة حم، مجموعة سور متشابهة المطالع لكن هذه السورة فريدة من نوعها
المقدم: تذكرني بمطلع سورة التوبة (برآءة) ليس مطردًا هذا الاستهلال.
د. المستغانمي: هناك عدة سور بدأت ببدايات تحتلف لكن هذه (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا) أليست السورة الأخرى منزلة؟ بلى، لكن هذه خصوصية العائلة، خصوصية الأسرة كأني بالقرآن يقول الجانب الأخلاقي التربوي الأسري مهم جدًا فإذا كانت السور السابقة تحدثت عن الاعتقاد وأولته عناية فائقة في عدد وجملة من السور فهي سورة فرضت تكاليف اشتدت التكاليف إلى حد إقامة الحدود (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) ورقّت وشفّت إلى درجة (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا) هذا تكليف وهذا تكليف، فيها أنواع التكاليف: غض البصر، الأمر بعدم إظهار الزينة، بعدم الاختلاط، حتى الأكل نظمته (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا) نظّمت حتى طريق الأكل، فهي فيها التكاليف، هذه التكاليف إذا ما طبقها الفرد المسلم أولًا والأسرة المسلمة أنتجت لنا مجتمعًا ودولة نظيفة نقية طاهرة. فللخصوصية والتنويه كرر (وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ). (لعلكم تذكرون) ما معنى تذكّرون؟ هل سبق تعليمه لنا؟ نعم، كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة السليمة تقول لك ابتعد عن الزنا، هي تذكير بالفطرة السليمة (لعلكم تذكرون) فمطلع فريد أراه ويراه غيري من أصحاب التفسير بأنه ينوّه بالتكليفات لكن ننبّه على أنها ليس تكليفات للزجر ولكن لبناء الضمير المسلم، الضمير الذي لا ينظر إلى العورات، الضمير الذي لا يدخل البيوت حتى يستأذن، الضمير الذي لا يتتبع خطوات الشيطان كأني أرى الشيطان يمشي وهو يتتبع خطواته، صورة رهيبة! (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ)، ثم الضمير الذي يهتدي بنور الله في وسط السورة فرأينا محورها ورأينا ما يتفرع حولها من آيات وأحكام وإذا ما فصلنا في كل آية سنجدها تعود إلى شجرتها العظيمة.
المقدم: هل السورة في مجملها لها مناسبة نزول؟ هل حدث أمر وخاصة ورود حادثة الإفك فيها لها علاقة؟
د. المستغانمي: لها علاقة، السورة مدنية نزلت في العهد المدني نزلت بعد آية الزنا في السنة الثانية للهجرة بداية السنة الثانية للهجرة علماء الفقه والتفسير يقولون نزلت أواخر السنة الأولى وبداية الثانية، كلها؟ لا، نزلت منجمة تنجيمًأ عجيباً، مناسبات! القرآن يتنزل حسب الوقائع نزولًا وحسب الحكمة ترتيبًا. آية الزنا نزلت في بداية السنة الثانية أو نهاية السنة الأولى في حادثة لما كان أحد الصحابة أبو مرثد الغنوي كان يذهب ويأتي بأسرى المسلمين في مكة فجاءته واحدة من البغايا القدامى تسمى عناق فقالت تعالى وبِت عندنا فقال لها إن الله حرّم الزنا فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أأنكح عناق؟ فلم يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه فنزلت الآية (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) هذا دأب الفاسدين، دأب أصحاب الفواحش أما أنت يا صحابي يا جليل لا ينبغي لك أن تنزل وتسفّ إلى هذه الدرجة!. ثم جاءت آية القذف بعد ذلك جاءت (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) هذه نزلت في حادثة الإفك التي حصلت بعد غزوة المصطلق في السنة الرابعة للهجرة (آية نزلت في السنة الرابعة وضعها هنا)، آية الملاعنة الذي يرى زوجته تزني وقعت بعد غزوة تبوك السنة التاسعة للهجرة لما رأى أحد الصحابة وجاء يشتكي عند الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) وضعها الله أمام آية الإفك، بناء عجيب! آية الزنى، آية الذين يرمون المحصنات، ثم آية رمي الأزواج التي نزلت في السنة التاسعة، الملاعنة ثم عاد إلى آية الإفك التي نزلت في السنة الرابعة، ما هذا التنجيم! وما هذا الترتيب! إذن نزل حسب الوقائع تنزيلًا لكن في الأولى عندما نقرأ نقرأ آية (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) ونقرأ آية الملاعنة تتناسب معها ثم عادت إلى قصة تطبيقية من حياة رسول الله (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) كأنه مثال لما تحدث عنه سابقًا، فترتيبها عجيب وسنذكرها في حينها بإذن الله.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الثانية مباشرة (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) في غير القرآن ربما يقول القائل الزانية والزاني اجلدوا، لماذا هذه الفاء؟ قد يقول الفاء زائدة لكن في القرآن لا شيء زائد.
د. المستغانمي: تسأل عن نظم الآية ونظم الآية هذه عجيب، الزانية والزاني، سيبويه يقول: هذا مبتدأ وخبره محذوف: فيم يُتلى عليكم خبر الزانية والزاني، الزانية والزاني فيم يتلى عليكم. (فاجلدوا) هذه جواب شرط محذوف، كأنه يقول الزانية والزاني إن أردتم حكمهما فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. بعض العلماء أصحاب الإعراب يقولوا (فاجلدوا) هذا خبر (الزانية) لكن هذا مستبعد. عندما ندقق – وأنا ارتحت إلى هذا الرأي – سيبويه يقول: “فيم يتلى عليكم الزانية والزاني” مبتدأ وخبر (فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) هذا جواب شرط محذوف وهذا ديدن القرآن عندما تأتي الفاء التفريعية الواقعة في جواب الشرط بعد المبتدأ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) المائدة) كأنه يقول السارق والسارقة إن أردتم أن تعرفوا الحكم اللازم لهما فاقطعوا أيديهما، (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (16) النساء) اللذان يأتيان الفاحشة في سورة النساء، إن أردتم حكم اللذان يأتيان الفاحشة فاذوهما، كان الإيذاء ثم جاءت آية الجلد. إذن التركيب الزانية والزاني تقدير الكلام: التي تزني والذي يزني لأن اسم الفاعل يعوّض الفعل المضارع، كأنه جلّ جلاله يقول: التي تزني والذي يزني إن أردتم الحكم فيهما فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.
المقدم: لماذا بدأ بالزانية؟
د. المستغانمي: هذا كلام طويل أوجزه لك، علماء التفسير وقفوا، الإمام الشوكاني والإمام ابن كثير، هذا تقديم بارز لماذا الزانية بينما في السارق والسارقة (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) الرجل أقدر على السرقة بقوته يتجرأ على السرقة والعياذ بالله، المجرمون السرّاق، أكثر السارقين هم من الرجال قد تخوّل له نفسه بما لديه من عضلات وشطارة أما في نظافة المجتمع والزنا من المتسبب الأول؟ هذا رأي العلماء – قد توافقه وقد تختلف- المرأة هي التي توقع بتبرجها وسفورها وابتذالها وتزيّنها لو أن المرأة لم تمكّن هذا الرجل لا يستطيع. فسبب المرأة في الزنا أكثر من سبب الرجل، لكن هل هذا يعفي الرجل؟ كل واحد لو شاء لقال: الزانية والزاني فاجلدوهما، لو جاءت فاجلدوهما (هما) تعود عليهما، أيهما أولى بالعقاب؟ كلاهما أولى بالعقاب (فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) الزانية هي التي تتسبب رقم واحد، لأن المرأة إذا لم تتزين ولم تغري ذلك الرجل الذي في قلبه مرض لا يقع هذا لا يعني أن الرجال برآء لكن الحكم جاء للإثنين نسأل الله العافية في هذا المجال.
ي رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة النور – 2
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
المقدم: تحدثنا عن سورة النور ومحورها العام وشرعنا في الحديث عن مطلعها لماذا جاء مختلفًا عن مطالع السور الأخرى ونذكّر بالمحور العام للسورة وأهم الموضوعات التي وردت قبل أن نواصل الحديث ونحن لا زلنا في بداية السورة.
د. المستغانمي: سورة النور هي سورة مدنية محورها العام الذي تعالجه وتبنيه هو الأسرة المسلمة فإننا لو طبقنا ما فيها من أحكام لأنتجنا بتوفيق الله تعالى أسرة عفيفة طاهرة وبالتالي يتكون لدينا مجتمع مسلم طاهر، فالمحور العام هو محور تربية الأسرة المسلمة، عنوانها سورة النور نظرًا لاحتوائها على أعظم آية وهي (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (35) النور) تلتف حول هذا الموضوع موضوع الأسرة مواضيع تخدم هذا الموضع، حرم الله سبحانه وتعالى الزنا وذكر الحد الذي قد يراه البعض قاسياً (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (2)) وذكر (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ) معناه فيه شيء من القسوة قد تحدث رد فعل عند بعض الناس لكن إذا تأملنا وتدبرنا في هذه السورة العظيمة من بدايتها إلى نهايتها نجد آدابا وأحكاما إذا ما طبقها الفرد المسلم فإنها تقيه من الوقوع في الحرام يعني كل ما في السورة كما أسلفنا وسائل وقائية تمنع من الوقوع في فاحشة الزنا وبالتالي لا يقع في الزنا فذكر (لا تقربوا)، وشرع لنا الاستئذان، شرع لنا غض البصر للرجال وللنساء شرع لنا تزويج الأيامى، كل ما فيها يلتف حول محورها، حتى آداب الاستئذان تؤدي إلى هذا الغرض، لها مواضيع كلها تدور حول الأسرة ويتوسطها آية النور. أوضح وأنا أشاهد إعادة الحلقة الماضية لعل بعض المشاهدين قد يهم ويقع في فهم خطأ في فهم آية النور التي سافصل فيها القول (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) من هذا المنبر الإعلامي أصحح للجميع بأن (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) نحن كمسلمين ننتمي إلى أهل السنة والجماعة العقيدة السليمة الصحيحة نثبت لله ما أثبت جلّ جلاله لنفسه نقول الله نور من أسمائه الحسنى النور، هذا النور لا يستطيع أحد إدراكه (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) الشورى) (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) الإخلاص) الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لا بد أن نؤمن بأن الله نور السماوات والأرض واسمه النور، الجزء الثاني من الآية (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ) هذا شيء آخر، أنا قلت هو تشبيه بعضهم يقول تمثيلي، وبعضهم قال مركّب، لكن (مَثَلُ نُورِهِ) نور الله بمعنى بذاته؟ لا (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) صفة ذاتية نثبتها ولا نتحدث فيها أكثر لأن النور ليس حسيًا.
المقدم: الآية شبّهت تشبيها متكامل الأركان: فيها أداة التشبيه ووالمشبه والمشبّه به فالله سبحانه وتعالى قال (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ) (الهاء) هنا تعود على الله سبحانه وتعالى (كمشكاة).
د. المستغانمي: لكن أيّ نور يقصد؟ نقف عند ما وقف عليه العلماء الإمام الطبري وابن كثير والبغوي وابن القيم أجمعوا أن الجزء الثاني يتعلق بما بثه من النور (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) المائدة) ما الذي جاء من الله؟ الوحي، (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174) النساء) وهو القرآن، (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) المائدة) نور معنوي الذي جاء بالقرآن نور الهداية نثبته ولا نناقش. إذاً التشبيه وقع يقرب للمسلمين وللقراء النور المعنوي الذي يوجد في القرآن نور الإسلام نور الهداية نور محمد صلى الله عليه وسلم أما المتعلق بنور الله نثبته ولا نناقشه هذا الذي أحببت أن أثبته في البداية وسأفصله إن شاء الله.
المقدم: محورها الأساسي هو معالجة الأسرة المسلمة هذا لا يعني بأنه ليس فيها موضوعات أخرى تكون قريبة من المحور العام. تحدثنا عن مطلع السورة وقلنا مطلع فريد (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا (1)) أليست كل السور أنزلها وفرضها الله سبحانه وتعالى وتحدثنا بشيء من التفصيل في هذا الأمر، ثم تحدثنا لماذا قال تعالى (الزانية والزاني) قدّم الزانية على الزاني، ولكن في الآية الثانية (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (2)) موضوع التعاطف والرأفة قد يرى البعض قساوة هذا المشهد أو يأوله أن هذا المشهد قاسي والرأفة والتعاطف مسألة داخلية وبالتالي نحن لا نملك التعاطف من عدمه، الإنسان يتأثر لا يملك أن لا نتأثر فلماذا ينهانا الله سبحانه وتعالى عن شيء لا نملكه؟
د. المستغانمي: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) النهي عن أمر شعوري لأنك عندما ترى منظراً تتأثر لا إراديًا، في الحقيقة الرأفة الداخلية لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها لكن الرأفة في مثل هذا الموضع لو أخذتنا سوف تجعلنا لا نقيم الحدّ، هل هذه الرأفة محمودة أم مذمومة؟ مذمومة والرأفة التي تؤدي إلى تعطيل حكم الله رأفة تقودك إلى ما لا يحمد عقباه، ولذلك النهي ليس عام أن لا نرأف ولكن النهي هو أن نسعي إلى عدم تطبيق الحد فكأنه قال فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخروا ولا تتوانوا في تطبيق الحد من باب العاطفة (لا تأخذكم بهما رأفة) كناية عن التقصير في الحد، ما هي الكناية كما تعرف؟ الكناية هو كلام يطلق ويراد به لازم معناه في الفعل ما يستلزمه، هذه الرأفة إذا استلزمت عدم إقامة الحد فهي رأفة مذمومة لا تنجينا من أمر الله يوم القيامة.
المقدم: الله سبحانه وتعالى قال: (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ) لماذا لم يقل تؤمنون بالله ورسوله أو غيرها؟
د. المستغانمي: له ارتباط بما سبق عندما قال (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ)، لو فرضاً أخذت القاضي أو الحاكم الرأفة ولم يطبق في الحقيقة هذه الرأفة مذمومة قد تقود إلى عدم تطبيق حكم الله الذي ارتضاه وشرعه تؤدي إلى الإضرار بذلك الإنسان يوم القيامة (اليوم الآخر)، كأنه يقول إن لم تقيموا الحد في الدنيا سيقام عليه الحد في الآخرة، فهذه رأفة مذمومة إذا أدت إلى التأجيل، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم الحد، لأن ذلك سينجي الزاني يوم القيامة، هنا كأنه يقول هذا التطبيق لشرع الله ينجي الإنسان يوم القيامة.
المقدم: لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يدعو إلى التشهير لكن لما قال (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)؟
د. المستغانمي: بعض العلماء قالوا من عشرة إلى أربعين وبعضهم يقول أقل ولم تتفق أقوال العلماء، وطائفة في المصطلح اللغوي طائفة من طفا يطفو، (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ) طائفة تطفو على السطح، مجموعة بارزة من المؤمنين عدد أقل من عشرة والطائفة أقل من الفريق، الفريق الذي يفرّق الجمع، الإنسانية فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير أما الطائفة فعدد قليل بالنسبة للفرقة بدليل (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) التوبة) الطائفة عدد أقل لدينا عصبة ولدينا جماعة في اللغة العربية، لكن هنا سؤالك (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ) ليس من قبيل التشهير إنما أجاب عنه الفقهاء تطبيق الحدود في الإسلام يكون جابرا وزاجرا، جابراً للجاني لأن الذي يقام عليه الحد ويرضى بذلك التطبيق فإنه يتطهر يجبر ما فعل ويزجر غيره، فالحدود جوابر وجوازر هذا كلام الفقهاء.
المقدم: في الآية السابقة قال (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (1)) وفي الآية التي تليها قال (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً (3)) بدأ بالزاني هنا فما دلالته؟
د. المستغانمي: كما قلنا في الحلقة الماضية بدأ بالزانية كما قال المفسرون وكل ذي عقل يقول هذا الكلام لولا أن المرأة تتزين وتبتذل وتمكن ذلك الرجل الذي في قلبه مرض ما تمكن من الزنا الإثنان مسؤولان الزاني والزانية لكن جناية المرأة أنها مكنت ودعت وأغرت أما الآية الثانية بدأ بالزاني لأنه هو الذي يتزوج وعقد الزواج الرجل هو الذي يطلب، ثانياً للآية قصة ففي السنة الثانية للهجرة على ما يذكره المفسرون صحابي جليل يسمى مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان مسلماً وكان يذهب إلى مكة المكرمة ليفتدي أسرى المسلمين وكان رجلا صالحا وعندما يجد أسيراً يتفق مع أهله أو يحلّ قيده خفية ويأتي به إلى المسلمين في المدينة كان يفعل ذلك مراراً فذات مرة عاد إلى مكة في ليلة مقمرة كما يقول أهل السيرة فجاءته امرأة كانت خليلة له قبل الإسلام، فقالت: مرثد؟ فقال: نعم، قالت: تعال بت عندنا كذا، قال: لقد حرّم الله الزنا، فقامت ونادت أهل الحي تؤلبهم عليه فتبعه ثمانية من الرجال كادوا أن يبطشوا به لولا أنه نجا بفضل الله تعالى ثم عاد وأتى بذلك السجين ليلا وفك أسره ثم أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبين تلك المرأة في الجاهلية عاطفة في الجاهلية فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أأنكح عناق؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب بعد ذلك جاءه جبريل من فوق السبع الطباق (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وعدد من علماء الحديث، هذه الآية في الحقيقة ملبسة نوعا ما عندما تقول (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً)، هل نعتبرها آية تشريع أم آية إخبار؟ العلماء توقفوا لو قلنا آية إخبار تخبرنا أن الزاني لا يتزوج إلا زانية وفي الواقع نجد عكس هذا قد نجد إنسانًا مسلماً تقياً نقياً رأي إمرأة تتمرغ في حمأة الزنى أراد أن ينجيها مما هي فيه وبالتالي يتزوجها ويخلصها مما هي فيه إذاً الواقع قد يثبت عكس ذلك وينجيها ويحسن إسلامها، وقد نجد العكس إمرأة فيها خير تتزوج إنساناً كان معروفاً بالزنى غير معقول هذا المعنى، المعنى الثاني قد يقول أحد نزلت تشريعا، الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكحها إلا زاني السؤال المطروح وهل القرآن يشرّع للزناة؟ السؤال ملبس، توقف العلماء وقالوا الآية نزلت تعالج واقعة بعينها وانطلق منها الإسلام إلى تحريم الذي ديدنه الزنا والتي ديدنها الزنا، يعني المسلم النظيف العفيف لا تسمح أخلاقه ولا يتدنى لأن يتزوج بامرأة دأبها الزنا هذا هو المقصود، لكن لو أنها تابت وأراد أن يخلصها له ذلك. العلماء قالوا هذا المقطع (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) تمهيد للتشريع ما هو التشريع (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) إذاً نزلت من أجل واقعة معينة تقودنا وتمهدنا إلى تحريم الزنا وتحريم الزواج من الزانيات لأنه يعالج واقعة معينة.
المقدم: عندما يقول الله سبحانه وتعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)) شيء آخر غير الزنا لكن أعتقد أن له علاقة بالموضوع السابق فما الرابط بين الزنا ورمي المحصنات؟
د. المستغانمي: اسلفنا في أول الحلقة أن الله تبارك وتعالى حرَّم الزنا وبين حده للأعزب طبعاً والسنة أتت بالرجم والتطبيق للمحصن المتزوج وذكرت سورة النور الوسائل الوقائية، غض البصر، تسهيل الزواج، الاستئذان، عدم إبداء المرأة زينتها، وهذه وسيلة وقائية لمجرد إنسان يمشي في مؤسسة في مدرسة رأى امرأة واقفة تتحدث مع رجل يتهمها بالزنا؟! لا يجوز، الإسلام جفف منابع الإتهام.
المقدم: حتى لو رآها في موضع شبهة حتى لو رأها في موضع يشتهر عنه ممارسة هذه الجريمة هذا لا يدعوه أن يتهمها بالزنى.
د. المستغانمي: إلا إذا أتى بأربعة شهود رأوا الجرم رأوا الفعلة الشنعاء، كما قلت في بداية الحلقة بعضهم يرى أن حد الزنا فيه نوع من القسوة والله الإسلام لا يثبت هذا الحد إلا إذا رأى أربعة مع الرآئي الأول يرون الفعلة الجريمة الشنعاء، هل يثبت هذا بسهولة؟! إلا إذا كان هذا الفاعل مجاهراً حاقداً على الإسلام إنسان لا مبالي لا خلق له أبداً، إنسان غير واعي الإسلام الحدود بالشبهات ويقنن إلى تجفيف المنابع (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) الطاهرات العفيفات والمحصنة هي التي دخلت بعقد شرعي ويحصّنها زوجها، والمحصن هو الرجل الذي دخل بعقد شرعي صحيح مع امرأة فهو محصن.
المقدم: لماذا قال الله سبحانه وتعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) ولم يذكر رمي المحصنين؟
د. المستغانمي: أيضاً هذا الحديث تحدث عنه العلماء لما جاءت الآية (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) حرّم الله رمي المحصنات وقذفهن بهذه الفاحشة دون رؤية صحيحة مع الشهود هل معنى ذلك التقنين والتشريع للرجال ضد النساء فقط لا كل ما يفهم من صريح الآية نفهم العكس بالقياس: واللواتي الذين يرمين الرجال المحصنين من غير شهداءأيضاً يطبق عليها الحد، جاءت الآية على الغالب للرجال والقرآن يخاطب كثيراً على الغالب يقول (يا أيها الذين آمنوا) أين نجد (يا أيتها المؤمنات) كل اللواتي آمن يدخلن في هذا التغليب.
المقدم: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) فيه شيء من التشديد على أنه ليس من حق أي إنسان أن يتهم حتى وإن رأى ولكن كما ذكرت يجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء.
د. المستغانمي: سدا للذرائع، في الشريعة الإسلامية كما تعرف عندنا مصادر التشريع: القرآن والسنة والاجماع والقياس ومذهب الصحابي وشرع من قبله مختلف فيها ومن بينها باب سد الذرائع هنا تدخل هذه الآية لو رأى فعل الزنا الحقيقي ولكن ليس معه شهداء لا يتكلم حتى لا تشيع الفاحشة هذا هو المطلوب، ليس معنى ذلك يقر لكن لا يذهب لإقامة الشهادة حتى لا يجلد في ظهره، وبالتالي يجفف الإسلام المنابع، لو أن إنسانًا رأى فعل الزنا الحقيقي ولكن ليس لديه أربعة شهداء لا يستطيع أن يشهد وإلا المجتمع يتفسخ ويتميع وينتشر فيه هذا الكلام.
المقدم: هو لا يستطيع أن يشهد ولا يحق له أن يتحدث بهذه كذلك.
د المستغانمي: ويدعو لهم بالتوبة لكن لو كان عنده أربعة شهداء شهدوا الفعلو النكراء تطبق الحدود.
المقدم: معنى هذا أن إنساناً رأى هذه الجريمة وهو واحد أو إثنان يعني ليس عددهم أربعة كما ذكرت الآية فبالتالي يصمتون كأن لم يروا.
د. المستغانمي: سداً للذريعة وتنظيفاً للمجتمع وارتقاءً به وسمواً بالمجتمع، ألم تلاحظ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) كنت أتوقع منك سؤال بماذا يرمونهن؟ بالحجر؟ لا، والذين يرمون المحصنات بفعلة الزنا لكنه لم يذكرها، (ولم يأتوا بأربعة شهداء) على الزنا، أين كل المتعلقات؟ محذوفة ليسمو بالمجتمع.
المقدم: ولماذا ذكر هذا الفعل قال (يرمون) ولم يقل يتهمون؟
د. المستغانمي: الحقيقة (يتهمون) لكن الرمي يريد أن يشنّع الفعل أنت لم تتهمها أنت رميتها كأنه رماها بحجر وهذا مقصود في التعبير القرآني لذلك يسمى رمي المحصنات ويسمى قذف المحصنات، فإياك، أنت لا تتكلم ولا تتهم أنت ترمي وكلمتك إما سينصرها الله بأربعة شهداء وإما تأتي ضدك ويطبق عليك حد رمي المحصنات وبالتالي ينظف المجتمع.
المقدم: ولماذا ربط هذا الأمر بعدم قبول الشهادة لهم كذلك؟
د. المستغانمي: لأن هذا الإنسان تساهل واستهان في أداء الشهادة كان من المفترض إذا كان مسلماً وسامعاً لسورة النور وقرأ سورة النور كان ينبغي أن يتريث إذا كان لديه شهداء يتكلم إذا لم يكن لديه شهداء حتى لو رأى، ناس يظنون الظن السيء، فإنسان رأى فلانة خارجة من بيت فرضاً مع فلان فيذهب ظنه إلى الظن السيء مباشرة هذا إنسان تساهل في الشهادة فكان جزاؤه أن حرم من الشهادة في المستقبل (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) (أبداً) تفيد الزمن (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (هم) تؤدي إلى الحصر، كأنه حصر الفسق فيهم كأن غيره ليس بفاسق، لما قال (أولئك الفاسقون) لا نستطيع أن نقول حصر حقيقي، معنى الحصر الحقيقي أن الذي يشرب الخمر ليس بفاسق، هذا يسمى حصر وقصر للمبالغة كأنه هو الفاسق لا غيره لكن هذا حصر للمبالغة وليس من باب الحقيقة وعلماء البلاغة فصلوا في ذلك.
المقدم: الله سبحانه وتعالى في الآية الخامسة يستثني إستثناء عجيب (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) تابوا من ماذا؟ هل تابوا من الزنا أو تابوا من رمي المحصنات؟
د. المستغانمي: هذه في آية الذين يرمون المحصنات. عندنا ثلاث عناصر في الآية: رموا المحصنات، لا تقبلوا لهم شهادة، أولئك هم الفاسقون جاء بعدها (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ما يأتي بعد الاستثناء يتعلق بالرمي أو بالشهادة أو بالفسق، هنا قال (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لكن حتى ولو تاب يقام عليه الحد أو لا يقام؟ يقام عليه الحدّ لا نعطّل الآية، الأولى لما قال (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) هذا استثناء من الجملة الثانية إلا الذين تابوا وحسن إيمانهم وحسن عملهم الصالح وأخلصوا هنا تقبل شهادتهم ويخرجون من دائرة الفسق، ولكن لا يستثنون من الحدّ وهذا قول واحد لجميع العلماء، واحد رمى وثبت رميه ويقول والله تبت توبة نصوحة حتى لو تاب وحسن إسلامه على قاضي المسلمين أن يطبق الحد، لكن الاستثناء من الجملة الثانية والثالثة تقبل شهادته في المستقبل ويخرج من دائرة الفاسقين بإذن الله (وأصلحوا) اصلحوا أنفسهم، أصلحوا أعمالهم أصلحوا صلتهم بالله..
المقدم: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) ثم استثنى الله تعالى من قبول الشهادة ومن الفاسقين الذين تابوا وعملوا الصالحات أما إقامة الحد فيجب أن يقام، ثم جاء إلى رمي من نوع آخر (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) هذه المرة ليس لعامة المسلمين وإنما للزوجة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) والآيات تأتي في هذا الأمر، هذه الآيات يسميها الفقهاء آية الملاعنة البعض قد يرى فيها شيئا من التشديد والشدة حتى أكثر من الآية التي قبلها؟
د. المستغانمي: لأنه الآن وصل الأمر من بقية الناس إلى بيتك، يتعلق بعرضك، في المجتمع يأتي واحد بأربعة شهداء يشهد، لكن لو جاء أحدهم لا سمح الله ووجد في بيته الفاحشة من أين يأتي بالشهداء؟ هنا لو كلّف الله جميع المسلمين بهذه الآية لكلّفهم عنتًا سبحانه وتعالى عن ذلك، ولذلك الآية فيها سبب نزول واضح يجمع المسلمون تقريباً عليه، وقع سبب نزولها بعد غزوة تبوك في السنة التاسعة وسورة النور نزلت في نهاية السنة الأولى وبداية الثانية، من بداية السنة الثانية إلى السنة التاسعة أكثر من سبع سنوات وهي تتنزل منجمًا، لو كان ترتيب القرآن وفق رأي محمد صلى الله عليه وسلم لكانت آية الملاعنة في آخر السورة لكنها تقريبا الآية الرابعة أو الخامسة لكنها حسب الوقائع تنزيلا وحسب الحكمة ترتيباً مادام الأمر يتعلق برمي المحصنات إذاً يتناسق معه الأمر لو تعلق بالأزواج فأتت بعدها. سبب نزولها أن رجلا يسمى عويمر العجلاني كان من الصحابة رضوان الله عليهم عاد مرة إلى بيته ووجد الزنا في بيته في المجتمع يحص لكنه كان رجلاً شهماً وقوياً وملتزماً بأوامر القرآن فأتى إلى ابن عم له عاصم بن عدي وقال له إسأل لي رسوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلاً وجد مع زوجه كذا وكذا أيقتله فتقتلونه به؟ أم ماذا يفعل؟ حتى أن سعد بن عبادة الصحابي الجليل قال كلمة مشهورة في التاريخ قال لو أني وجدت مع امرأتي رجلاً لقتلته بالسيف غير مسفح أي غير مشفق عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم علق بعد ذلك على هذا الكلام وسأذكره، هذا الصحابي عويمر العجلاني قال لابن عمه اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله فساله فقال يا رسول الله لو أني وجدت مع امرأتي رجلاً كذا وكذا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم طهور عظيم مشفق لا يجيب عن أشياء فرضية، فعاد في المساء فقال ما وراءك؟ قال له ذلك الصحابي لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال والله لا أنتهي حتى أسأله كان جاداً لانه رأي غيرة الأزواج محبة الأزواج تمنع أن يتهم رجل زوجه غير معقول إذا كانت المرأة مسلمة طاهرة في بيت قائم على الدين شرع من الخلق، فذهب إلى رسول الله قال يا رسول الله أرأيت إن كان رجل رأى من زوجه كذا وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه فقال لقد أنزل الله بك وبصاحبتك قرآناً اذهب وأتى بها، ذهب وأتى بزوجته وتلا الرسول صلى الله عليه وسلم الآية (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ) الإسلام ليس فيه عنت فيه رحمة هذه رخصة للأزواج هنا اعتبر الله شهادة الرجل تعادل أربع شهادات، أن تقسم وتشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين واللعنة هي الطرد من رحمة الله. والعكس أنت إذا كنت تكذبين في ما اتهمك به عليك أن تشهدي أشهد بالله إنه لكاذب بما رماني به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وهذا تشريع عظيم وحصلت لما حلف الرجل وكان مستيقناً ونزل القرآن في شأنه فقيل لها عند الشهادة الخامسة بعد ما قال (وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) فقيل لها اتق الله، يعني دائما القاضي أو الحاكم يذكر أنت مقبلة على عذاب جهنم، قالت والله لن أفضح قومي أبداً، وحلفت المرأة، عندما تحلف المرأة وتبطل حلفه قال القرآن (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ) عذاب الدنيا، أنظر إلى روعة التعبير القرآني لم يقل (ويدرأ عنها الحد) وإنما قال يدرأ عنها العذاب، العذاب الأخروي أن تشهد ، القياس اللغوي يفترض (ويدرأ عنها الحد في الدنيا) لكنه ذكّرها هذا الحدّ يجبر العذاب يوم القيامة فسمى الحد عذاباً، نفس الشيء في الزناة لما يطبق عليهم الحد (وليشهد حدهما أم عذابها؟) (وليشهد عذابهما) كانه يقول إذا طبق الحد في الدنيا كفاهم العذاب يوم القيامة إذاً هنا قال (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) وهذه تسمى آية الملاعنة والتفريق نوع من أنواع الطلاق بالملاعنة.
المقدم: آية عجيبة أن يصل الإنسان أن يلعن نفسه والمرأة توجب غضب الله عليها!. في الآية أسرار كثيرة، استعمل الرمي للدلالة على قوة الفعل (يرمون)، بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الزنا وحدّ الزنا ثم ذكر رمي المحصنات بالزنا ورمي الأزواج صحيح للزنا حد لكن رمي المحصنات شديد ورمي الأزواج ليس باليسير، ليس الزنا فقط يؤاخذ عليه وإنما الرمي كذلك يؤاخذ عليه في الإسلام بشكل واضح جداً.
د. المستغانمي: صحيح هذا المعنى الزنا كبيرة من الكبائر وفاحشة، رمي المحصنات كبيرة ورمي الأزواج إذا كان معتدياً ظالماً كبيرة عظمى ولذلك يفرق بينهما بالملاعنة، وانظر لماذا تسمى بآية الملاعنة كما قال (والخامسة) أي الشهادة الخامسة (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) علماء طرحوا هذا السؤال يوماً (لماذا اللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة؟) المفسرون ذكروا هذا قالوا هو إن كان صادقاً لا شيء عليه لكن إذا كان كاذباً استوجب بحلفه هذا أن يُبعدها من المجتمع، إمرأة فارقت زوجها بالملاعنة من يتزوجها؟ في الحقيقة تسبب في طردها من المجتمع ونبذها ولعنها فكان جزاؤه من جنس العمل الطرد من رحمة الله. هي لو كانت صادقة تكذبه ولو كانت كاذبة، فالله، اي البداية أغضبت زوجها غضباً شديدا دعاه إلى أن يلجأ إلى حاكم المسلمين يقول له طبق عليها أغضبته غضباً شديداً فأيما امرأة أغضبت زوجها الإسلام يبني الأسر،هنا بما أنها أغضبت زوجها غضباً شديداً فكان الجزاء (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فكان الجزاء من جنس العمل، وأنا أقرأ هذه الآية كنت أطالع القرآن مبني بتناسق بشكل عجيب سنأتي إليها إن شاء الله، حتى الألفاظ مبينية من جنس الألفاظ وأنا أقرأ في سورة الهمزة (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الهمزة) من هو الهمزة؟ الذي يهمز الناس ويلمزهم ويطعنهم فعلة شنعاء، في النهاية (لينبذن في الحطمة) اختار لهم من أنواع النار (الحطمة) على وزن فعلة همزة لمزة حطمة على وزن (فُعلة) ولم ترد في القرآن إلا هنا ليس الجزاء من جنس العمل فقط حتى اللفظة نفسها من جنسها.
المقدم: وأنا أستمع لسورة النور استوقفني أمر الآن وصلنا إليه، نحن نعرف في اللغة العربية لفظ (لولا) أداة امتناع لوجود، وخبرها يحذف وجوباً ولكن مبتدؤها موجود وهنا (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) في غير القرآن كأن في الآية محذوف فكأن المبتدأ غير موجود؟!
د. المستغانمي: المبتدأ موجود (فضل الله) لولا أداة امتناع لوجود، لولا رحمة الله لهلكنا، امتنع هلاكنا لوجود رحمة الله. (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) لأهلكهم وحاق بكم ما حاق من المصائب، الخبر محذوف وجوبا، لولا فضل الله موجود لمسكم من العذاب ما مسكم في هذا المجتمع، عندما تلحقكم مثل هذه القضايا، لولا فضل الله في هذا التشريع لتمرغ المجتمع في حمأة الفواحش، لولا فضل الله عليكم لكان الجاني يزداد في الزنا وأن الله تواب لماذا قال هنا تواب؟ لأنه يتوب حتى على الزاني وستر عليه كأنه يقول لولا فضل الله موجود ولولا رحمته ولولا رأفته وتوبته موجودة لمسكم ولهلكتم وبالتالي يهلك الزاني. الجواب يجوز ذكره ويجوز حذفه (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أحيانا موجود وأحيانا غير موجود..
المقدم: ندخل في موضوع جديد، كلما يختتم موضوعا يذكر بالآيات والسورة فيها موضوعات كثيرة (ويبين لكم الآيات) (والله عليم حكيم) (ولقد أنزلنا إليكم)
د. المستغانمي: هي فواصل تقطع الموضوعات وتفصلها وتقسمها.
المقدم: لا زلنا في موضوعات فيها خيط يربطها، الآن نأتي إلى حادثة الإفك وحادثة الإفك فيها رمي بالزنا ورمي من؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الأمر يتصاعد: رمي المحصنات ثم الأزواج من المحصنات ثم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
د. المستغانمي: هذا يسمى الترقي في الأسلوب القرآني: الزنا، رمي المحصنات، رمي الأزواج، رمي سيد البشر في بيته حتى وصف الجنة يبدأ ب (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ) (أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) ترقي إلى أن يقول (وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) أرقى أنواع اللذة النفسية التي يجدها، الترقي في آيات الرحمة في آيات العذاب في الوصف شيء عظيم.
المقدم: نأتي إلى حادثة الإفك التي هزت المجتمع.
د. المستغانمي: حادثة الإفك حادثة تطبيقية للقرآن النظري وحتى لا يمثل بعائلة معينة هذا الأمر شنيع ابتليت به أعظم عائلة وأشد المؤمنين بلاءً الأنبياء، وهل ثمة ابتلاء أن يقال لأعظم نبي إن زوجك خانتك في بيته وهي بريئة عائشة الرزان الحصان العفيفة النقية ترمى وهي بنت أبي بكر الصديق وزوج النبي أشرف خلق الله، الحادثة وقعت في السنة الرابعة بعد غزوة بني المصطلق وكانت عائشة صغيرة السن يومها وبعد انتهاء الغزوة وعودة القافلة كانت في هودجها وتفقدت عقداً لها فذهبت تطلبه فلما عادت لم تجد القافلة والذين كانوا يقودون هودجها ظنوا أنها موجودة فلما لم تجدهم قالت لا حول ولا قوة إلا بالله وجلست سيذكرونني ويأتون، بعد وقت معين جاء صحابي جليل اسمه صفوان بن المعطل رجل من بيني سليم فوجدها وكان يعرفها قبل الحجاب فلما رأى وجهها تعرف عليها قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وأناخ ناقته وأتى بها ولحق بهم صباحاً والرجل طاهر وعائشة أطهر بمجرد ما رأى أكبر المنافقينهو عبد الله بن أبي بن سلولأطلق مقولته الشنعاء (والله لا نجت منه ولا نجاه منها) ورددتها الألسنة ولاكتها وبعض القرآئن لماذا تأخرت ولماذا جئت معه، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وأبو بكر بشر المسلمون والناس لا يعلمون الغيب وهذا من تلبيس إبليس، هنا ابتلي المسلمون والمجتمع المسلم في المدينة بهذه الحادثة ولكن الخير في هذه الحادثة كثير نزلت عشر آيات (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وبدأت الخيرات وطهرها الله من فوق السبه الطباق وعظم بيت الرسول وفضح المنافقين الخيرات التي استفادها المسلمون حادثة عجيبة يكفي نزول عشر آيات عظيمة. عائشة الطاهرة ويحق لها أن تفخر على النساء فقالت: لقد أعطيت تسعاً لم تعطهن امرأة قالت: نزل جبريل بصورتي في راحته عندما أمره الله أن يتزوجها قالت ولقد تزوجني بكرا ولم يتزوج بكراً غيري ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري وفي حديث (بين سحري ونحري) وقالت: وقد قبر في بيتي وحفته الملائكة في بيتي ولقد كان ينزل عليه الوحي وأنا في لحافه وأنا بنت خليفته وصديقه وأنا طيبة خلقت لطيب ولقد نزل عذري من السماء. فهل بعد هذا تكريم لمثل هذه المرأة العظيمة، حادثة الإفك عظيمة والفوائد منها جميلة جداً.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة النور – 3
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
المقدم: الحديث لا زال متواصلًا في سورة النور من القرآن الكريم وتحدثنا حول محورها العام وحول أهم الموضوعات التي فيها وتحدثنا حول خصائصها اللفظية وبعض الصفات التي وردت فيها إلى أن بدأنا نتحدث عن آياتها بالتفصيل ووصلنا إلى حادثة الإفك لم يتسع الوقت في الحلقة الماضية للتفصيل فيها. قلنا في الحلقة الماضية أن حادثة الإفك رغم الشر الذي فيها إلا أن فيها خيرًا كثيرًا وهذا ما توقفنا عنده ولنتحدث عن حادثة الإفك، ولنتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾[النور: 11] ولماذا قال: ﴿عُصْبَةٌ﴾ ولماذا قال: ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾، وبعد ذلك سوف نسأل عن الذي تولى كبره من هو هذا الذي تولى كبره؟!
د. المستغانمي: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما تفضلت حادثة الإفك حادثة استوقفت المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الغليان والفوران في المجتمع المدني كيف يتم هذا، وتحدثت الألسن عن هذه الأكذوبة العظيمة، وعن هذا البهتان العظيم الذي افتراه المنافقون عن عائشة رضي الله عنها. فسميت بحادثة الإفك حتى أصبحت كلمة (الإفك) علماً بالغلبة على هذه الحادثة، فلما نقول: الإفك هو الكذب وهو أشد الكذب، وقلنا بأن أفك بمعنى: قلب الحق باطلاً والباطل حقاً، هو الكذب الذي يقلب الحقائق، ومنه سميت قرى قوم لوط: ﴿الْمُؤْتَفِكَاتُ﴾ القرى التي جعل الله عاليها سافلها فقلبها، قرى سدوم. فهنا (الإفك) هو قلب الحقائق، وورد في القرآن ﴿أَفَّاكٍ﴾ يعني كذّاب (معتدٍ أثيم) وعندما يقول: ﴿أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ في القرآن معناها أنّى يصرفون عن الحقيقة، أنى يعدلون عنها.
ملخص الحادثة بإيجاز: بعد غزوة بني المصطلق كما قلنا: عائشة رضي الله عنها التمست عقداً لها فقدته فعادت لأخذه أو لتتلمسه ولما رجعت جدت أن الجيش قد رجع قافلاً، وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله وسيذكرونني وبقيت في مكانها. جاء فجأة رجل كان دائماً يتفقد آثار المسلمين ممن يتتبعهم، فإذا نسوا شيئاً فقدوا شيئاً أسقطوا شيئاً، هذا من الاحتياطات اللازمة، فكان هو صفوان بن المعطِّل رجل أمين وصادق فلما رأى عائشة رضي الله عنها استرجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ لها الجمل وأتى بها إلى القافلة. طبعاً أدركوهم بعد وقت معين، فهنا اختلقت الألسن وليست العقول يعني بدون تفكير، واختلق المنافقون كلاماً خطيراً والذي تولى كبر القضية هو المنافق الكبير: عبد الله بن أبي بن سلول.
المقدم: ما معنى تولى كبره؟
د. المستغانمي: تولى كبره يعني الذي أخذ حصة الأسد من هذه المصيبة العظيمة، وأصبح يشيعها بين الناس ويدينها ويؤكد، وقال مقولته المشهورة: والله لا نجت منه ولا نجا منها.
المقدم: الهاء هنا تعود على من؟ ﴿تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾؟
د. المستغانمي: كبر الإفك كبر هذا الافتراء: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ حتى إن العلماء قالوا: بمجرد ما قال: له عذاب عظيم معناه: لا يتوب إشارة إلى أنه سيموت على هذا، وكيف يتوب وهو كان أكبر المنافقين النفاق العقائدي، وليس السلوكي العملي، ممكن واحد ينسى قد يعد ويخلف هذه خصلة من النفاق العملي. أما هؤلاء المنافقون العقائديون فهم يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام.
المقدم: هؤلاء من قال الله فيهم: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾.
د. المستغانمي: ولما قال: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ قال العلماء: فيه إشارة إلى عدم توبته، أما بعض المسلمين تحدث حسان بن ثابت يعني مثلما تقول: راجت عليهم الأحدوثة ومرت عليهم كان بعض منهم ساذجاً مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم انطلت عليهم المسألة طبعاً يقول بعض المفسرين: نظراً لغيرتها على أختها يعني كانت عائشة ضرة كما يقولون لزينب، المهم انطلت عليهم وتاب الله عليهم، ماذا قال الله في القرآن: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ يعني يحاسبون حسب ما اكتسبوا ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ عظيم بمعنى خاص.
المقدم: هذا خلاف هؤلاء؟
د. المستغانمي: خلاف هؤلاء، إذاً انطلت الفكرة على كثير من المنافقين، وبعض المسلمين البسطاء رددوا الكلمة دون تفكر ودون تروّي.
المقدم: وبعض المسلمين من كبار الصحابة وقتها ربما لم تنطلي عليهم المسألة كأنهم اتخذوا مواقف تجاهها مثل: أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني تصرف تصرفات لا شك من غيرته على ابنته وكذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه منع الصدقة ممن تحدث في هذه القضية، ولامه النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم.
د. المستغانمي: نزل القرآن في مسطح ابن أثابة كان ابن خالته وكان مهاجراً وكان فقير الحال كان ينفق عليه فيما قبل، فطبعاً من لا يأخذه الغيرة ومن لا تحركه.
المقدم: طبعاً يتحدث في عرضي وأنا أنفق عليه؟!
د. المستغانمي: فقوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾[النور: 11] بداية عظيمة بداية استئنافية لقصة حادثة حقيقية بدأت بـ (إن) المؤكدة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ لم يقل (إن الذين كذبوا) ﴿جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ هذا التعبير دائماً المسافر الغريب يأتي بأخبار غريبة المسافرون يأتون بأخبار غريبة منها الصحيح ومنها غير الصحيح، كأن القرآن يقول: إن الذين جاؤوا بهذا الخبر الغريب وهو الإفك ولم يقل: إن الذين كذبوا على عائشة، لا لا، هو أصبح الإفك علماً بالغلبة على هذه الحادثة المكذوبة المفتراة المختلقة.
المقدم: لماذا قال: (جاءوا بالإفك) ولم يقل (أتوا بالإفك)؟
د. المستغانمي: لأنه شيء عظيم، وقلنا هنا: (جاء) دائماً تستعمل في الأمور الشديدة العظيمة كما تذكر جاءوا بالإفك عصبة منكم عصبة من العلماء من يقول: أقل من العشرة وبعضهم يقول: من عشرة، أقل من الفريق بالتأكيد عصبة، وبعضهم يقول: من العشرة إلى الأربعين، ضبط هذه الكلمات في اللغة العربية نقول: عصبة ونقول: جماعة ونقول: فريق، ثلّة، ونقول: طائفة، ما شاء الله القرآن استعملها كلها بطرق حكيمة. ﴿عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ أنا تستوقفني كلمة: (منكم) يعني حتى ولو تكلموا انطلت عليهم الفكرة لكن هم من المؤمنين.
المقدم: هل (منكم) لبيان الجنس، وإلا للتبعيض؟
د. المستغانمي: لبيان أنهم منكم يعني: من جنس المسلمين، وأيضاً ثمة من المنافقين من تحدث يعني قصدي (منكم) كانوا من المؤمنين.
المقدم: يعني ليسوا من المشركين ليسوا من كفار قريش؟
د. المستغانمي: من هذا المجتمع المسلم الذي يستمع كل يوم إلى الوحي وإلى الرسول، ومع ذلك انطلت عليهم الكلمة بعدما روّج لها المنافقون، بدليل الآيات التي ستأتي بعد: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ مجتمع. إذاً أقول (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم) من الاقتضاء اللغوي في غير القرآن لو قال: لا تحسبوه شراً لكم بل خيراً لكم، (بل) تعطف وتبطل: بل للإضراب والإبطال: (لا تحسبوه شراً بل خيراً) تأتي معطوفة القرآن ما قال؟ قال: ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ جملة جديدة اسمية مبتدأ وخبر لإفادة التوكيد لإفادة مدى العظمة والخير في هذا الحدث، طبعاً ظاهره محنةٌ، وباطنه منحةٌ كما يقول العلماء. ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أولاً: لكل منهم ما اكتسب من الإثم وهذا يتحمل، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم عبد الله بن أُبي بن سلول وغيره. ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾* ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ سوف تقول: ما الخير فيه؟ الخير فيه أنه ابتلى الأمة المسلمة محصها وأظهر المنافقين منها، الخير فيه: أنزل براءة عائشة رضي الله عنها من فوق السماء، وأنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة، قالت: ولقد نزل عذري من السماء. الخير فيه: الفتنة عمل تطبيقي للآيات التي قالت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ دائماً العمل التطبيقي يثبت الفكرة.
المقدم: هذه الحادثة جزء مما تحدث عنه القرآن قبل قليل جزء من رمي المحصنات جزء من رمي الأزواج، وهذا جزء من الرمي.
د. المستغانمي: وكانت الحادثة العملية في أعظم بيت، بيت النبوة، يعني لماذا مثلتم بكذا وكذا؟ لا، التمثيل الواقعي الحقيقي ذاق شدته وبلاءه محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجه تخيل عائشة رضي الله عنها مرّ عليها ثلاثون يوماً وليلة عانت الويلات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مغاضباً لا يعاديها ولا يقاطعها قضية صعبة ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب – وهنا الفائدة وهو لا يعلمه- لو كان يعلم الغيب لاتخذ الموقف من أول لحظة، لو كان القرآن – استغفر الله- مفترى مكذوباً كان سيكتب آية يوم ويريحنا بدل ثلاثين يوم، القرآن من عند الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، والخيرات كثيرة توالت وكانت عملاً تطبيقياً وبرّأ الله البيت النبوي إلى أن جاءت الآيات: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ﴾ ليس (بريئون) (مبرأون) اسم مفعول مستخلصون مصطفون من عند لله سبحانه وتعالى، فكانت النتائج كلها رائعة.
المقدم: كأنه هنا إشارة إلى أن هذا يحدث وهذا يحصل في المجتمع إذا كان قد حصل في بيت النبوة فربما يحصل في كل البيوت، ومن اتهم كذلك ليس بغريب على المجتمع الإسلامي، لذلك قال الله سبحانه وتعالى (منكم) أي من مجتمعكم من المسلمين أنفسهم، ومن المنافقين الذين هم في مجتمع المسلمين كذلك. وهذا كأن فيه تمهيد أو ربما ختام لما مرّ علينا سابقاً بأن في المجتمع كذلك من يرمي المحصنات، وفي المجتمع من يرمي الأزواج، وفي المجتمع كذلك من يقوم بفاحشة الزنا التي لا بد أن يكون الحد فيها رادعاً كما ذكر القرآن ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾.
هنا الله سبحانه وتعالى قال: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ أريد أن أفهم معنى هذه الآية، ثم نشاهد هنا (لولا) وهذه (لولا) بخلاف (لولا) الذي تحدثنا عنها قبل آيات: (لولا فضل الله) تلك تعني الوجود وهذه؟
د. المستغانمي: هذه تحضيضية تحض.
المقدم: تحضيضية وكنا قد تحدثنا عنها سابقاً في إحدى الحلقات، لكن السؤال هنا: الآيات كرر فيها (لولا) بشكل مستطرد: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾، ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ﴾، ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ﴾، ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ مرة أخرى، فهذه كذلك يجب أن نتحدث عنها.
د. المستغانمي: لعلك تذكر في أول حلقة قلت: لكل سورة صبغة لكل سورة شخصية، هذه من بين الأيقونات اللفظية المستعملة بطريقة حكيمة أقول: إلهية حكيمة (لولا) وفي أشياء أخرى سأوقفك عليها إن شاء الله. ولعل المشاهد الكريم والذين يتلون بتدبر سيجدون ما لا نجد، فـ (لولا) أولاً في اللغة العربية تأتي بوجهين:
- تأتي بامتناع لوجود، تسمى (لولا الامتناعية).
- وتأتي للتحضيض الحثّ مع الحضّ.
المقدم: وتلك يجب أن يكون لها جواب، الأولى لما تكون امتناعية يجب أن يكون لها جواب يقال: جواب لولا، أما هذه فلا، هذه تحثّ.
د. المستغانمي: لولا الامتناعية التي لها جواب قد يكون الجواب مذكوراً وقد يحذف مثلاً: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ﴾ ذكر الجواب. وأحياناً: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ لعاقبكم ولأهلككم ما يذكر، فعندما يحذف جواب (لولا) ويحذف جواب (لو) ليجعل العاقل يذهب كل مذهب في تصور ذلك الجواب، إثراء للمعاني, فهنا (لولا) أيقونة لفظية مستعملة بطريقة عجيبة، الله حضّهم على استعمال العقل: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ معناها الحرفي: هلّا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً؟! كان المفترض وكان الأولى إذا سمعتم مثل هذا الخبر الشنيع المفترى المكذوب الذي ليس وراءه دليل أن يظن بعضكم ببعض خيراً، وانظر هنا التعبير أصل (لولا التحضيضية) الفعل يجيء وراءها مباشرة: (لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً إذ سمعوا الخبر) هذا هو المفروض.
المقدم: سبحان الله! فيها تقديم وتأخير؟
د. المستغانمي: التقديم قدّم الظرف لماذا؟ ليقول لهم ولنا: (لولا إذ سمعتموه مباشرة) تسمع مثل هذا الخبر أن تكذبه، تقول هذا إفك، وتقول: من هذا مؤمن مؤمنة؟ إذاً لا ينبغي أن أصدّق مثل هذا.
﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ في عدول التعبير ما هو العدول؟ ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ خطاب لمن؟ للمؤمنين، ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ المفترض يكون: (ظننتم بأنفسكم خيراً) ولكن ما قال كذا، ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ﴾ هذا يسمى إظهار بدل إضمار، لماذا إظهار بدل الإضمار؟ كأنه يقول: لولا إذ سمعتموه كانت خصلة الإيمان التي تجمع بين المجتمع وبين روابط هذا المجتمع تمنع من هذا القول، ظنّ المؤمنون والمؤمنات بغيرهم؟ لا، (بأنفسهم) أنت عندما تتكلم عن عرض عائشة تتكلم عن نفسك، عندما تتكلم عن عرض جارك تتكلم عن نفسك، المقتضى وأقول لك ما جاء عليه القرآن، يعني الحديث عن جارك هو حديث عن نفسك لذلك قال: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ هذا على شاكلة قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أنت تلمز نفسك وإلا تلمز آخر؟ أنت تلمز أفراداً آخرين، ولكنك عندما تلمزهم فأنت تلمز نفسك.
المقدم: وهذا على شاكلة الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم: بأنه لا يسب الرجل أباه، قالوا: كيف يسب الرجل أباه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه.
د. المستغانمي: حديث صحيح ما شاء الله واستدلال دقيق جداً. ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ والظن مثل الشك المنافقون دخلتهم الشكوك، لكن الظن أنك تظن خيراً بالمسلمين. (لولا) هنا تحضيضية وما جاء أحياناً امتناعية، وأحياناً تحضيضية.
المقدم: (ظن) أحياناً تأتي من باب الظن، وأحياناً تأتي من باب اليقين؟
د. المستغانمي: في سياق آخر نعم، وهنا من باب الظن الظن الحقيقي.
المقدم: ﴿وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ واضح جليّ
د. المستغانمي: وانظر إلى إفكٌ مبين بعد قليل سيقول: (هذا بهتان عظيم) لكن مبين أيضاً ركز معي هنا الأيقونات اللفظية في سورة الشريع البيان: (آيات مبينات) (يبين الله لكم الآيات) (إفك مبين) (ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات) يعني كثُرت الإبانة والتبيين أنا أقول لك شيئاً: أولاً: نحن في سورة تشريع والتشريع حقه البيان. وثانيًا نحن في سورة النور، والنور هو البيان. يتناسق الاستعمال بدليل في آية التي سوف نصل إليها: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ وفي سور أخرى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ ويسكت، هنا المبين مطلوبة لأنها سورة البيان.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾. هنا يتحدث ويذكرنا بما طلبه سابقاً من أربعة شهداء، (جاءوا عليه) على من؟ على الإفك؟ على هذه الحادثة؟.
د. المستغانمي: لولا جاءوا عليه على هذا الإفك المفترض بأربعة شهداء هو أحد المفسرين قال: بنو إسرائيل لم تجف أقدامهم من البحر الأحمر قطعوا مع موسى أنجاهم الله من فرعون وأغرق فرعون في اليم، وأنجاهم الله أحد المفسرين يقول: وكانت أقدامهم مبللة لم تجف بعد، ومروا على أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. أنا تذكرت وأنا أقرأ هذه الآية هؤلاء لم تمر عليهم ثلاث أربع آيات: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ نسي المسلمون ونسي الذين خاضوا وخاضوا في عرض من؟ في أطهر امرأة في التاريخ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ هنا تعريف المسند والمسند إليه والإتيان بـ (هم) ضمير الفصل هذا أسلوب حصر وقصر، لكن الحصر والقصر لدينا نوعان:
حصر حقيقي، وحصر إضافي، أو قصر إضافي، هنا من ضمن القصر الإضافي، لأنه لما قال: ﴿فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ كأنه لا كاذب في الوجود غيرهم، هناك غيرهم يكذبون لكنه حصر من باب القصر الإضافي لتشنيع ما فعلوا من كذب، واضح كأن غيرهم بالنسبة لهم لا يعتبر كاذبًا.
المقدم: هنا (لولا) هذه التحضيضية؟
د. المستغانمي: التحضيضية التي تحض.
المقدم: ما فيها تقديم وتأخير هنا: (لولا جاءوا عليه)؟
د. المستغانمي: هذه جاءت على الأصل.
المقدم: لكن التي بعدها: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ هنا هذه (لولا) امتناع لوجود: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ وكل الأركان موجودة: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا﴾ طبعاً الخبر محذوف وجوباً موجود في الدنيا والآخرة: ﴿وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ هنا ذكر العذاب العظيم.
د. المستغانمي: هذا واحد. ثانياً هنا ذكر الجواب: ﴿لَمَسَّكُمْ﴾ كما تفضلت لولا المتناعية يكثر ارتباط أو اقتران جوابها بـ(اللام) لولا كذا لفعل كذا.
المقدم: دائماً وإلا اضطراراً؟
د. المستغانمي: يقول: يكثر وغالباً لام المؤكدة هذه: ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ عذاب عظيم لولا رحمة الله موجودة إلى غير ذلك. لكن هنا ﴿أَفَضْتُمْ فِيهِ﴾ ما معنى (أفضتم فيه) استطردتم بكثرة الإفاضة دائماً تقول: أفاض الكأس زاد عن حده، لو قلنا: ملأ الكأس ملأه أفاضه بمعنى: صبه فيه إلى أن سال الماء من فوق ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ بكثرة، فالإفاضة دائماً فيها كثرة، هنا قال لمسكم فيما أكثرتم فيه من الحديث عذاب عظيم وكان الأولى أن يتعقل المسلمون في هذه الحادثة وأن يترووا، والدليل ما يأتي بعد ذلك ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾.
المقدم: هنا الإنسان يتلقى بإذنه أو بقلبه أو بعقله، لكن لا يتلقى بلسانه، بل يقول: بلسانه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾؟
د. المستغانمي: هذه كل العلماء وقفوا عندها ولكل رأيه التلقي كما تفضلت يكون بالسمع والذهن عندما يسمع يفكر ويعقل، ويوازن ويقارن، أنت تتلقى الأخبار بالأذان، ثم العقل يفكر، هم للأسف الشديد ما تلقوا هذه الإفك المبين بعقولهم، ولا بقلوبهم
المقدم: يعني كأنهم مباشرة حينما وصلهم لاكوه؟
د. المستغانمي: لاكوه ولفظوه وأخبروا به غيرهم، وأذاعوه، كأنهم تلقوه بالألسنة، يعني شبه الخبر، الصورة البلاغية: شبه الخبر بإنسان غريب يأتي وأنت تتلقاه بالأحضان هم تلقوا الخبر بالألسنة وتهيئوا له، بمجرد ما سمعوه لاكته الألسنة ولفظته، لم يعوه ولم يفكروا فيه، ولم يوازنوه، لا بد قبل أن تتكلم أن تفكر فهم لم يستعملوا مثقال أثارة من العقل.
المقدم: حتى أحياناً سبحان الله ربما يستمع الإنسان إلى خبر فلا يعقله، فيلوكه أو يكرره أو ينشره، القرآن هنا لم يقل: استمعوه بآذانهم، بل كأنه حتى لأن البعض ربما يستمع بالأذن ولا يكرر حتى لو لم يعقل لا يكرر، هذا مباشرة كرر ونشر.
د. المستغانمي: هذا يسميه البلاغيون استعارة بالأيلولة بمعنى: استمعوه بآذانهم، في الحقيقة استمعوه بألسنتهم التي آل الأمر للتكلّم بها، فهم ما فكروا أبداً، هذا رقم واحد، استعارة بالأيلولة، أو مجاز بالإيلولة. إذ تلقونه أصلها (إذ تتلقونه) لكن السرعة القرآني خفف التاء لتصوير السرعة، كانوا مستعجلين حديث خطير أتعرف ماذا وقع اليوم في المجتمع؟! الكل يتكلم مؤمنون وغيرهم، طبعاً بين مصدّق ومكذّب معظمهم كذبوا، لكن الذين صدقوا وانطلت عليهم عدد. ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ منطقي لو قال: وتقولوا نعرف أنهم قالوا بماذا؟ بالأفواه وبالألسن، وهنا لماذا لم يقل (وتقولون بألسنتكم)؟ أولاً: كان المفروض (وتقولون) لم يقل: وتقولوا بألسنتكم، بل قال: (بأفواهكم) يعني بملء أفواهكم، وإن كنتم تكررون كلاماً لا معنى له، لا صفة له إلا أنه قول يقال، فكأنه يقول: قلتم كلاماً لا معنى له، لا عقلانية فيه لا منطق يزنه، وهذا المقصود.
المقدم: وهنا إشارة حتى أعتقد في علم التجويد هنا حكم أحد الإدغامات ربما إدغام متماثلين أو متجانسين لأن الذال والتاء نفس المخرج، فبالتالي تدغم، هذه ربما فيها كذلك فيها إشارة إلى السرعة؟
د. المستغانمي: هذه عند القارئ حمزة، حمزة الكوفي: (إتلقونه) وعند غيره التاء عند الذال لها نفس المخرج. أما نحن في قراءتنا في حفص: (إذ تلقونه بألسنتكم).
المقدم: سبحان الله! فهذا فيه سبحان الله إشارة إلى السرعة كما ذكرت.
﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾.
د. المستغانمي: هذا تكرير لتوكيد الفعلة الشنعاء العظيمة التي افتراها المنافقون وانطلت على بعض المسلمين.
المقدم: هنا إذ هذه ظرفية.
د. المستغانمي: ظرف زمان مبهم.
المقدم: ثم يقول: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ﴾ هذه (لولا) كذلك التي هي التحضيضية تحضه. ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ فيها تقديم وتأخير كذلك.
د. المستغانمي: وهي تحض وتوبخ يعني المعاني الثانية تسمى المعاني الثانوية التي تستنتج، هو الآن يعني يحضهم يكرمهم؟! لا، يحضهم ويوبخهم على ما صنعوه.
المقدم: كما في الاستفهام هناك استفهام استنكاري، وهناك استفهام.. وهكذا. ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾.يعني كأن فيها تقديم وتأخير: (ولولا قلتم ما يكون لنا هذا إذ سمعتموه).
د. المستغانمي: إذ سمعتموه تقديم الظرف للعناية يريد القرآن أن يقول لهم: (كان الأولى أن تبادروا) كلمة (أن تبادروا) جاءت بالتقديم والتأخير.
المقدم: قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ ثم قال: ﴿وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ ثم كنّى عن الإفك بالضمير قالوا جاءوا عليه (لا تحسبوه) الهاء: هنا فيه إشارة إلى الإفك. لكن هنا قال: ﴿هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾.
د. المستغانمي: وأنت قلت في المرة الماضية الفرق بين الإفك والبهتان: الإفك في الكذب هو أقوى شيء. والفرق بينهما: أن الإفك تقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، فهو من أشد الكذب. البهتان: وهو كذب وهو أن تلقى المخاطب بشيء يبهته بمعنى لا يكاد يصدق ما يسمع، يدهشه، يحتار من الحيرة والدهشة والبهتان، ومنه: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ ما معنى (بهت)؟ يعني اندهش تعجب فهي ليست التصوير ببهتان عظيم نستطيع أن نقول: فيه نوع من الترقي ووصف من زاوية أخرى.
المقدم: يعني هذا كذب فيه دهشة
د. المستغانمي: يدهش كل مؤمن لا يُعقل وليس بمنطق سليم، كل ذي أثارة من إيمان يعرف طهارة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف طهارة عائشة رضي الله عنها، ويعرف أن الطيور على أشكالها تقع ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ ما كان لكم أن تقولوا مثل هذا الكلام. فهو مرة وصفه بـ (إفك مبين) ومرة قال: (بهتان عظيم).
في القرآن لم يصف الله تعالى البهتان العظيم إلا شيئين اثنين: حادثة الإفك، والذين قالوا عن مريم بهتان عظيم، وأيضاً قالوا عنها في عرضها وبغت وأتت بهذا الولد، فعبّر عنه ببهتان عظيم غير هذا يقول بهتان أو شيء من هذا.
﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ هذا أشد أنواع النفي أنت تقول لي: هل ستفعل كذا، لا أفعل كذا (لا) النافية (لن أفعل) أشد توكيدا (لست أفعل هذا) أشد توكيداً (ما يكون لي أن أفعل هذا) أبداً لن يحصل أبدًا، جحود وأسلوب جحود، وهذا في القرآن ما يكون أبداً يعني هذا أشد أنواع النفي، حتى إن عيسى عليه السلام يوم القيامة عندما يوقفه الله يقول: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ موقف صعب. قال ﴿قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾.
المقدم: أشد أنواع النفي
د. المستغانمي: طبعاً عيسى هنا في مكان لا يحسد عليه أشد المواقف: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ﴾؟ هنا نفى بأشد الأنواع هنا قال القرآن للمسلمين للمؤمنين: (هلا إذ سمعتموه) بمعنى: (لولا) نحن استعملناها (هلا) للتحضيض قلتم ما يكون أبداً أن ننطق بمثل هذا الكلام البيّن الكذب.
المقدم: يعني هو هنا كررها بكل التعابير في البداية قال: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ يعني قالوا لم ينفوا وإنما قالوا قرروا العكس، ولكن هنا يقول: لا، نفوا بأشد أنواع النفي.
الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ الله سبحانه وتعالى ينصحهم ويعظهم، لكن الموعظة والوعظ يجب أن يكون لئلا يعودوا لمثله؟
د. المستغانمي: أنت تقصد: (يعظكم أن تعودوا لمثله) كأنه ينصحكم أن تعودوا؟
المقدم: هذه (أن) ماذا تعني؟
د. المستغانمي: (أن) أداة نصب (أن تعودوا لمثله) هنا يعظكم أن تعودوا ليس المقصود يعظكم لتعودوا لا، تكلمنا عن تقنية التضمين في القرآن أن يضمن فعلاً لمعنى فعلٍ آخر للإيجاز والبلاغة، هنا يعظكم محذراً إياكم أن تعودوا، كأنه قال: (يعظكم ويحذركم) أن تعودوا وليس يعظكم لكي تعودوا، هو ينهاهم، إذاً السياق يجعلنا لا نفهم المعنى الثاني.
إذاً: (يعظكم) أنت تقصد يعظك بكذا أنا أعظك بأن تصلي المفترض: (يعظكم) بعدم العودة لئلا تعودوا، أو ألا تعودوا، لكن القرآن أرقى في الأسلوب فضمّن فعلاً بمعنى فعلٍ آخر ستقول لي ما دليل التضمين؟ لأن السياق ينهى عن الكذب وعن الإفك، إذاً قال: (يعظكم محذراً إياكم أن تعودوا لمثله) وأبداً تفيد النفي القاطع في المستقبل. المقدم: تفيد النفي القاطع في المستقبل فمعناها: ألا تعودوا لمثله أبداً.
د. المستغانمي: أو قل: (ويحذركم) تضمين السياق خلنا نفهم نحذركم.
المقدم: إن كنتم مؤمنين وربطها بالإيمان؟
د. المستغانمي: ربطها بالإيمان هنا (إن) شرطية وجوابها محذوف كأنه يقول: (إن كنتم مؤمنين فلا تعودوا).
**********
المقدم: انتهينا من حادثة الإفك تقريباً أقول: لأننا كما أسلفنا سابقاً هناك خواتيم للمواضيع، وهذه الخواتيم نعرفها حينما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ فكلما ينهي موضوعًا يقول الله سبحانه وتعالى بما يشبه هذه الآية: ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ فيعني كأننا انتهينا من آية من الآيات.
د. المستغانمي هو صحيح انتهى الحديث المباشر، لكن ستأتي توابع خلال الآيات تعالج لها علاقة بالموضوع من بعيد وتعالج أشياء عميقة.
المقدم: والدليل على ذلك الآية التي تلتها مباشرة، حينما قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾ والفاحشة تخرج مما تحدثنا عنه سابقاً سواءً الزنا، أو رمي المحصنات، أو رمي الأزواج،أو الذين جاءوا بالإفك هذه كلها ممن يحب أن تشيع بين المسلمين، فهذه من الفواحش التي الله سبحانه وتعالى يتحدث عنها في الآيات القادمات.
يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.
هنا ذكر وقال: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ﴾ بشكل واضح.
د. المستغانمي: في الدنيا والآخرة لأن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وأن تنتشر وأن تذاع هي في الحقيقة: إن الذين يحبون أن تنتشر أو أن تشيع أخبار الفاحشة، هنا نستطيع أن نقدر يعني: المعنى الذي قلته مقصود أيضاً يحبون أن ينتشر الزنا من الذي يحبون؟ المنافقون والمشركون إلى غير ذلك، وهذا وجه صحيح. لكن أيضاً نستطيع أن نحمل الكلام على إذاعة الأخبار وإشاعتها: إن الذين يحبون أن تنتشر وأن تشيع أخبار الفاحشة بغير علم هؤلاء لهم عذاب أليم؛ لأنهم لم يستعملوا العقل وأذاعوه وأشاعوه بدون حق.
المقدم: أنا أشرت هنا بأن الله سبحانه وتعالى قال بشكل صريح: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ﴾ على اعتبار أننا تحدثنا في الحلقة الماضية وقلنا حينما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ قلنا: هذا العذاب الدنيوي وليس العذاب الأخروي. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ هنا قال: (رؤوف رحيم) قبلها قال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ لماذا قال هناك: (تواب حكيم) وهنا قال: (رؤوف رحيم)؟
د. المستغانمي: صحيح هذا تحدث فيه العلماء السابقون أيضاً يعني ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل أنا بحثت في القضية جميل جداً هو التناسق بين التدليل كأن الآية كلها جاءت تدليلًا لما سبق، ففي البداية لما قال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ أين أتت؟ أتت بعد جريمة الزنا والعياذ بالله، وبعد كبيرة رمي المحصنات ورمي الأزواج ولولا فضل الله موجودٌ، ولولا فضل الله الذي شرع لكم كي تدرأوا الحدود بالشبهات، وكي تطبقوا على الزناة هذه الحدود، ولولا أن الله تواب بمعنى:يقبل التوبة ممن تاب وحكيم في هذه التشريعات لهلكتم، جواب (لولا) كله محذوف: لولا فضل الله تفضل منه وتشريع منه ورحمة منه جل جلاله ولولا أنه تواب شرع التوبة لكل من يخطئ لأن الذي يخطئ في المجتمع الإسلامي لو أن الله لم يتب عليه سيزداد جرماً ويزداد انحرافاً، لكن فتح باب التوبة يجعل المجتمع في أمان، هذه رحمة أم لا؟ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ كأنه يقول: وأنه فتح التوبة لحكمة منه جل جلاله لهلك المجتمع، أنا أعطيك تقديري أنا، غيري يقدر: لمسكم، لأهلككم الله، للحق بكم التكالب، لك أن تقدر ما تشاء، أصلاً هو محذوف للتقدير.
الثانية بعد حادثة الإفك قال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ رأفة بالأمة الخبر جلل، والأمر خطير جداً اتهام زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لولا رأفة ورحمة من الله لأهلك جميع الذين تكلموا، هنا تدخلت رحمة الله، وتدخلت رأفة الله، وليس التوبة، التوبة رغب من يريد أن يتوب، هنا لولا رحمة خاصة والرأفة: هي رحمة خاصة عوض أن يقول: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ ولولا رأفة الله صاغ الرأفة في اسمه العظيم الرؤوف، لولا الرأفة والرحمة لمسكم ما مسكم من خلال إفاضتكم في الحديث الإفك الذي ليس له أصل. والله أعلم.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾.أولاً: ما مناسبة هذه الآية بما قبلها؟ ثانياً: لماذا قال: (لا تتبعوا) الإنسان يتبع الخطوات التي يراها، أنا أتبع خطوات شخص يمشي أمامي، والأعرابي قال: الخطوة تدير على المسير، لكن الشيطان ليس له خطوات لا نرى خطواته فكيف نتبعها؟
د. المستغانمي: جوابًأ عن سؤالك الأول: ما المناسبة؟ المناسبة: كل ما سبق ما الذي جعلهم أقول بتعبيري الخاص يتمرغون في حمأة الإفك إلا الشيطان، (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) الذي يستعمل عقله المفكر المسلم النقي الطاهر لا ينبغي أن تنطلي مثل هذه الأفكار، فكل ما سبق سواءٌ الزنا، سواء رمي المحصنات، الإنسان يوسوس للإنسان زوجتي اليوم خرجت دخلت ، الذين تحدثوا في الإفك كلهم وسوس لهم الشيطان، وإذا كنت تذكر في حلقة من حلقات سورة المؤمنين تحدثنا بأنه دائماً لما يأتي كلمة الشيطان الوسوسة، أما إبليس فالسياق يتحدث عن الكِبر وعن الاستكبار وعن الكفر، ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ كأن الله يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان التي دلّاكم بها فيما سبق، وتحدثتم في الإفك أوقعكم دلاهما بغرور، لا تتبعوا الخطوات، طبعاً الشيطان لا يأتيك مباشرة افعل كذا، لا تصلي كذا، يأتيك بخطوات، فهنا جواباً عن سؤالك الثاني: الشيطان لا نرى خطواته، لكن نتّبع الأفكار التي يبثّها، هنا في الحقيقة تشبيه محسوس بمعقول، الناس كل البشرية لها صورة للشيطان في أذهانها، اذهب عند المسلمين عند اليهود عند النصارى عند المجوس للشيطان صورة مشوهة مخيفة يأمر بكل الشرور ونحن لم نره. هنا شبه الحالة المحسوسة بحالة معقولة معروفة ذهنيًا فقال: ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ كأن الشيطان يمشي بخطوات وللأسف الذي يتبع أمر الشيطان يتبع خطواته حذو القذة بالقذة حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. فلا تتبع خطوات الشيطان ولا تتمادوا في اتباع الوساوس التي يزينها في قلوبكم. بعدها ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ النهاية: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ﴾ المفروض دائماً في أسلوب الشرط: (إن تجتهد تنجح) أقصد من كلامي يتحدث عن نفس الموضوع: يعني الشرط مرتبط بالجواب في نفس الموضوع، هنا نقول: (ومن يتبع خطوات الشيطان) يتكلم مع إنسان (فإنه يأمر) من الذي يأمر؟ الشيطان تجاوزًا في النحو نقول: (فإنه يأمر) جواب، لكن هو ليس الجواب هو دليل الجواب: (ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يقع في الفحشاء لأن الشيطان يأمر بالفحشاء) هذا هو التحليل الصحيح للغة، لذلك هذا دليل الجواب: ومن يتبع خطوات الشيطان لا محالة يقع في الفحشاء والمنكر، لماذا؟ نقول: لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
المقدم: وردت متلازمة كثيرة هذه (الفحشاء والمنكر) في أكثر من آية ربما ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ فما الفرق بينهما؟
د. المستغانمي: في القرآن كلمة (الفحشاء) تعني الزنا الدرجة الأولى، الفحشاء أو الفاحشة من نفس الجنس اللغوي يعنى بها الزنا وما رادفه من أشياء ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾. فالفاحشة: هي عمل قوم لوط – والعياذ بالله- الزنا أو اللواط أو السحاق أو ما شابه العمل في الفحشاء، لكن لغوياً (فحشاء) بمعنى شيء ازداد عن كل الحدود فحش بمعنى: فات أو تجاوز كل الحدود. أما المنكر: هو ما ينكره الشرع ما ينكره الذوق السليم، ما ينكره المجتمع العرف، هذا المنكر، فهو يقرن بينهما كثيراً الشيطان يأمرك بأن تتجاوز كل الحدود فيما يخص العلاقة بين المرأة والرجل وفيما يخص الأعراف.
المقدم: كثيراً يذكر الله سبحانه وتعالى بفضله علينا –جل جلاله- أو بفضله على المؤمنين: أقصد في هذه الآيات: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ كثير يذكر هذا الأمر؟
د. المستغانمي: آخر الآية ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ يذكرهم بهذه النعمة العظيمة نحن لا نعرف نعمة فضل الله علينا حتى نبتلى لا نعرف نعمة الصحة.
المقدم: ما المقصود: (ما زكا)؟
د. المستغانمي: ما طهر، يعني ما طهرت نفسية أي واحد فيكم لولا فضل الله عليكم بهذا التشريع العظيم ما زكا، ما طهر. انظر إلى كلمة التزكية بمعنى: الطهارة.
المقدم: القصد: لماذا ذكر الزكاة هنا أو الطهارة هنا وربطها بالفحشاء والمنكر؟
د. المستغانمي: تزكية النفس ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ وقد خاب من رماها في وحلة من أوحال الشرك وأوحال الكفر. زكى نفسه تزكية طهرها من كل الأدران من الشرك ومن النفاق، ومن الفواحش هذه التزكية الحقيقية. وتأتي التزكية بمعنى: الافتخار: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ هنا قال: لولا فضل الله عليكم بهذه التشريعات العظيمة وبهذه الآداب ما زكى منكم من أحدٍ أبداً، أي: ما زكى من أحد تستغرق كل جنس البشرية.
المقدم: لكن سؤالي كان: أنت ذكرت بأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ ذكر تواب رحيم لمناسبتها لما ذكر قبلها، وذكرت: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ لمناسبتها لما قبلها، هنا لماذا ذكر: (ما زكا منكم من أحدٍ) لماذا تفضل الله علينا بالتزكية؟
د. المستغانمي: لأن المجتمعات دائماً تتمرغ في أوحال الفواحش والمنكرات لا يخلو إنسان من نظرٍ من كذا فالتزكية هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى عن طريق التشريع، يعني لولا فضل الله عليكم كان ذاعت الكلمات السيئة والأفعال السيئة والشنيعة، ما الذي يمنع المجتمع المسلم؟ عندما الله يزكيه بفضله بشرعه بالآداب التي سنّها الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند الأيقونة اللفظية (زكا) التي تسأل عنها: (ما زكى منكم) أي: ما طهر نفسياً وما طهر اجتماعياً.
المقدم: قال: (ما زكَى) ولم يقل: (ما زكَّى)؟
د. المستغانمي: في قراءة: (ما زكَّى منكم من أحدٍ) ما زكَّى هو الله، فإذا قلنا: (ما زكى منكم من أحد) صارت (من أحد) فاعل مجرور لفظاً مرفوع محلاً كأنه يقول: ما زكى أحدٌ. لو قرأناها: (ما زكَّى منكم أحداً) صارت مفعول به إذاً قراءتان متكاملتان. المادة اللغوية التزكية بعد قليل يقول: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ إلى أن يقول: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ في الآيات التي سنصل إليها: غض البصر يؤدي إلى زكاة النفس، ﴿أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ ذلك أزكى أيضاً، إذاً مراعاة لفظية رائعة في التناسق.
المقدم: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.
د. المستغانمي: ما معنى (أزكى لهم)؟ أطهر، لماذا لم يقل: (أطهر)؟ لأنه قبل قال: (ما زكى منكم من أحد) ثمة تناسق في استعمال الكلمات.
المقدم: حتى قال: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾؟
د. المستغانمي: هذا يخرج من مشكاة واحدة: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ أطهر أفضل أخير جميل، لكن القرآن يخرج من مشكاة لغوية عظيمة يا سبحان الله!
المقدم: لماذا ختم الآية بالسمع والعلم وقال: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾؟
د. المستغانمي: هذا للتذييل تذييل جميل انظر الآية فيها لفتات بلاغية كثيرة. أولاً: (والله سميعٌ عليم) تذييل هذا التذييل فيه وعدٌ ووعيد، وعدٌ بمعنى: خير، ووعيد فيه تشديد، من سمع خبراً مثل الإفك وانطلى عليه الله سميع عليم جل جلاله وعليم بما صنع، بردّة فعله، إذاً الله سميع عليم من باب الوعيد. من سمع مثل هذا الإفك المفترى نقول: لا، لا ينبغي هذا الكلام ولا ينبغي أن يقال في امرأة، وظنّ بالمؤمنين خيراً فله أجرٌ عظيم، والله سميع عليم، سميع عليم تذييل يتناسب مع النفوس السابقة كانت في جانب الخير أو في جانب الشر، فنقول: هو تذييل يفيد الوعد والوعيد.
المقدم: كما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ هم يسجلوا ما تقوله من خير أو من شر، فلم يقل خيراً أو شر، قال: ما يلفظ من قولٍ.
د. المستغانمي: ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ لماذا هذا التكرير؟ القياس اللغوي في غير القرآن؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبعها، أو ومن يتبع خطواته، هو لا، أظهر كلمتين وأعاد ذكر الكلمتين لزيادة التنفير من جميع الخطوات.
المقدم: هنا الفعل جاء بالتضعيف: (لا تتبعوا) (ومن يتبع).
د. المستغانمي: لأنك تتكلف لم يقل: (لا تتبعوا) فيه تكلف (تتّبعوا) غير (تتبعوا) فيه تشديد على النفس أنت لا تستطيع الإنسان الزاني لا يستطيع إلا إذا تكلف أشياء وأشياء، وهو الذي قاد نفسه إلى اتباع خطوات الشيطان وبحرص منه.
المقدم: يعني حينما يخرج هذا الذي يقصد الزنا والعياذ بالله فهو قد بيّت النية وخرج قاصداً الزنا وربما يكون قد تكلف أو دفع مالاً، وربما سافر لغرض هذا الأمر، وربما، فهو يتبع.
د. المستغانمي: يتبع ويتكلف ويعلم ما يفعل، لذلك: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) ما قال ومن يتبعه، لا، (ومن يتبع خطوات الشيطان) زيادة الإظهار بدل الإضمار لمزيد التشنيع من هذه الفعلة والتنفير منها، فأنت لا تتبع ملكاً إنما تتبع خطوات الشيطان.
المقدم: سوف نأتي للآيات التي تليها نحن توقفنا عند الآية الحادية والعشرين: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ﴾ وهذه قلنا: نزلت في أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة النور – 4
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
المقدم: توقفنا في الحلقة الماضية حول الآية التي نزلت في الصحاب الجليل أبي بكر الصديق حينما منع الصدقة من أحد من خاض في حادثة الإفك، ولذلك جاء موقع هذه الآية بعد هذه الحادثة، وفي ذات الصورة، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ ابن خالته. إذا لم يكن من أولو القربى معناها ما في إشكال أن يمنع الصدقة منه؟ ﴿وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ جميلة هذه الآية صراحة، وكل القرآن جميل، لكن ما معنى (لا يأتل)؟
د. المستغانمي: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية نزلت تعقيباً على أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي أخذ موقفاً من ابن خالته مسطح بن أثاثة. أولاً: مسطح كان ابن خالته، وكان فقيراً من المساكين وكان من المهاجرين، كل هذه الأوصاف تنطبق عليه، أنا أعجبني أحد المسلمين قال: والله! لو كانت صفة واحدة لكفت، فما بالك بـ (أولو القربى والمساكين والمهاجرين)؟! وما تحدثت عن قريب ومسكين ومهاجر القرآن يخاطب الجميع، صح هي نزلت في الحقيقة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تلك المناسبة، لكن هنا نقول: لا يأتل أهل الفضل وأهل الإحسان وأهل السعة من المال أن يتصدقوا وأن يساعدوا، إذا الآية نزلت في أبي بكر الصديق عندما نفقته هذا كل إنسان منطقي يفعل ذلك، واحد من قرابة أبي بكر يتحدث في عرض ابنته المطهرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه تلك النفقة حتى علم أنه تاب، لكن ظل واجداً في نفسه، فنزل القرآن يطهره، ويحض وينصح ويفتح الأبواب.
﴿وَلَا يَأْتَلِ﴾ بمعنى: لا يحلف الايتلاء ولا يتألى أي: ولا يحلف من التألي ومن الايتلاء، ودائماً الحلف عندما يكون في حالة النفي نسميه هكذا: (ولا يأتل) ليست يأتل بالإيجاب إنما بالسلب، القسم والحلف يكون بالإيجاب عادة، أما الايتلاء يكون بالنفي: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ أن يتربصوا يعني يقول: لن يقرب زوجته ويحلف بالنفي الحلف بالنفي يكون من هذه الصيغة. ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ أي: ولا يحلف أولوا الفضل، الفضل هنا الكمال.
المقدم: ما معنى أولو؟
د. المستغانمي: (أولو) (وعالمون) (عليون) (وأهلون) هذه ملحقة بالجمع المذكر السالم، يعني هو قال: ولا يأل أصحاب الفضل أولو الألباب يعني: أهل الألباب أصحاب الألباب وهنا استعملها استعمالًا جميلًا. ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ﴾ الفضل المقصود به هنا الفضل المعنوي الكمال النفسي أصحاب الخصال العظيمة. وقد تعني (أولوا الفضل): الزيادة مثلما تقول: أنا لدي فضل من المال، لكن هنا لا يقصد به الزيادة، لماذا؟ الكلمة التي بعدها: ﴿أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ السعة تنطبق على كثرة المال والفضل على فضل الأخلاق، فضل القيم، فضل المبادئ يعني: كأنه يقول: ولا يأتل الكبار منكم، العظماء الفضلاء والسعة اليسار، المال الواسع (لينفق كل ذي سعة من سعته) لأن (الواو) تقتضي المغايرة: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾.
المقدم: يعني هو يقسم ألا يؤتي أولي القربى، فلماذا هنا قال: (أن يؤتوا)؟
د. المستغانمي: دائماً التقدير (ولا يأتل) ناوين عدم الإيتاء، لا بد من التقدير حتى يستقيم من الناحية اللغوية، مثل: ﴿يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا﴾، ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ﴾ يعني: لا يحلف على عدم الإيتاء: ﴿أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ثلاث صفات، كان مسطح من أولي القرابة، والإسلام يحثنا وينصحنا أن نصل الأقارب صلة الرحم، وكان من المساكين وكان من كبار المهاجرين القدامى، واحدة من الصفات الثلاث تقتضي أيضاً أن يحسن إليه أبو بكر الصديق وأن لا يمنع عنه الصدقة. ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أمره بالعفو: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ والفرق بين العفو والصفح: أن العفو: أن تتجاوز عن خطئه، لكن ممكن أن تلومه، تلومه أنت تجاوزته، يعني تلومه وتعفو عنه، وهذا هو العفو.
الصفح: هو أن تتجاوز عنه ولن تلومه أن تريه صفحة بيضاء، الله عز وجلّ قال للرسول قال: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ فالصفح: درجة أعلى من العفو، والمغفرة أعلى من العفو والصفح (أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ) كأنه قال: (اغفروا) كأنه يقول: وما هو أفضل عندي ولكن أنصحكم بأن تتخلقوا به، كأنه يقول: وليعفوا وليصفحوا وليغفروا. (وليغفروا) جاءت مبطنة من قول الله تعالى ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ما معنى المغفرة؟ هي: أن تعفو وأن تصفح وأن تسقط حقك نهائياً تستر الذنب. معنى المغفرة: ستر غفر الذنب ستره، وأسقط حقه، وهذه لله سبحانه وتعالى ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ لكن أيضاً ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ المغفرة ممكن لإنسان أن يزعجك أن يسيء إليك، فأنت يمكنك أن تعفو عنه، لكن تعاتبه، العفو زائد عدم المعاتبة أصبحت في درجة الصفح، عفو وصفح وأسقطت كل حقك فأنت قد غفرت.
(وليعفوا وليصفحوا) (وليغفروا مبطنة) والأسلوب الذي أتى بعدها ﴿أَلَا تُحِبُّونَ﴾ (ألا) أداة عرض أسلوب استفهامي تشوّق: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلى نعم أحب أن يغفر الله لي، فرجع وأعاد النفقة على مسطح. تحضيض وجوابها دائماً يأتي ببلى، قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، فحضه على الغفران وعلى إعادته. لكن تركها الله سبحانه وتعالى أو القرآن مبطنة لتأتي آية أخرى في سورة التغابن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ هنا أتى بـ (تغفروا) لأن القضية تتعلق بالأزواج والأولاد، هنا ذكرها الله بصراحة: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾ ومع ذلك إن تعفو تتجاوز، وأن تصفح: لا تلم، وتغفر وتستر وتستر هذا من عائلتك، ابنك مثلما تقول أخطأ خطأ كبيرًا لو أن الآية لم تأت بهذا الأسلوب كانت العائلات والأسر في المحاكم، تسقط حقك أنت في عائلتك تسقط.
في جانب الأسري الذي في قرابة أكثر قال: ﴿وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا﴾ أبو بكر مع مسطح بعيد عن هذا فقال: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ لكن لم يقل: وليغفروا، وإنما بطّن وأشار إليه الأسلوب القرآني لذلك ثمة وليغفروا مبطنة: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾.
المقدم: والتذييل جميل كذلك: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
د. المستغانمي: فاتصفوا بصفات الله سبحانه وتعالى. عندما تقرأ التذييل دائماً الله تواب حكيم فتب إليه، رؤوف رحيم، تتصف بالرحمة، وهنا يتصف بالمغفرة كبشر، والله أعلم.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يأتي بموضوع الرمي مرة أخرى رمي المحصنات، مع أنه ذكره في أول السورة: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾. هنا قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ هناك ذكر تشريع دنيوي كيف نتعامل مع هذه المسألة، هل معنى هذا بأنه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات عذابهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يعني لا نأتي بالشهادة أو لا نعمل بالأربع الشهداء كما جاء؟
د. المستغانمي: الأول: تشريع للجميع للأمة: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الحد كذا كذا، فاجلدوهم ثمانين جلدة. هنا الآية التي وردت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ﴾ جاءت تعقيباً على رمي عائشة على حادثة الإفك هذه من البقايا والتوابع التي تفضل عائشة وترفع مكانتها فتعقيباً على حادثة الإفك جاءت هذه الآية، وهي جاءت في أبشع صور التشديد والوعيد: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ ما معنى المحصنات؟ المتزوجات الطاهرات يقصد بها عائشة وأمثالها. ويقصد بقوله: ﴿الْغَافِلَاتِ﴾ عن ما قيل فيهن، امرأة خارجة في سبيل الله في معركة مجاهدة بمعنى: غافلة عن ذلك الفعل هي لم تفعل، يعني: كأنه كناية عن عدم الفعل، لأن الذي عمل شيئاً لا يكون غافلا عنه يعرف بأنه يوماً ما فعل، لكن هي غافلة؛ لأنها لم تفعل شيئاً، هذا هو المقصود بالدرجة الأولى. أما الذين تكلموا فسامحهم الله! ﴿الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ صفة الإيمان تمنعكم أن تخوضوا في عرض عائشة وغير عائشة من المؤمنات. إذاً استوجبوا اللعنة في الدنيا والآخرة الطرد من المجتمع، والطرد من رحمة الله يوم القيامة، هذه آية جمعت أشد أنواع العذاب الدنيوي والأخروي، والوعيد، يعني حتى في حق المشركين لم يأت هذا الوعيد ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ طبعاً ينطبق على سيد المنافقين وأمثاله.
﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لمن تولى كبر هذه العملية ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾.هذا وعيد شديد جاء في حق الذين اختلقوا الإفك المبين والبهتان العظيم في حق البيت النبوي.
المقصود بقوله: ﴿يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ﴾ يوفيهم جزاءهم الدين هو الجزاء ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ هنا يوفيهم دينهم كأنه سيحاسبهم حساباً دقيقاً، يعني كما تدين تدان، تحاسب يوفيهم دينهم الحق لا يظلمهم، وتكررت هنا كلمة المبين، والله هو الحق كما قال: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ هذا التذييل. فانظروا: يوفيهم دينهم الحق معناه: جزاؤهم الحق ليس معنى كل هذا الشيء زيادة لا، لا تفهم الزيادة، ما اقترفوا وما أتت به ألسنتهم وما أذاعوه شيء عظيم سيحاسبهم على الشيء العظيم.
المقدم: ربما يستقيم في غير القرآن أن يقول الإنسان: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ﴾ لأن الجرم الذي قاموا به هو من خلال الحديث من خلال الاتهام بالإفك، لكن أن يقول: ﴿وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ أليس في ذلك إشارة لكل الجرم التي مضت من الزنا والمسائل الأخرى؟ لأن الزنا فيه فعل أيدي وفيه فعل كذلك أرجل، لأنه يسعى الإنسان للزنا ويتبع خطوات الشيطان؟
د. المستغانمي: هو من الممكن هذا المعنى؛ وارد، لأنهم استعملوا جوارحهم الذين زنوا إلى غير ذلك لكن أيضاً حتى في حادثة الإفك: يوم تشهد عليهم ألسنتهم التي تكلمت، وأيديهم التي لمزت وهمزت، فالهمز واللمز يكون بالأيدي والطعن، وكانوا يشيرون، وأرجلهم التي كانت تمشي بالإفك يذهبون إلى البيوت من بيت إلى بيت يذيعون هذا الخبر المنكر، ويسعون بنشر الفاحشة، ولذلك جاء من الأعضاء من أعضاء الجسم ما يعذّب؛ لأنهم كانوا يشاركون بألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ولو انطبق هذا الكلام على السابقين ممن فعلوا الزنا بأيديهم وأرجلهم لما كان ذلك بعيداً. وليس فقط الأرجل والأيدي التي تشهد بل كل الجوارح ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ إذاً كثير من الأعضاء تشهد، لكن يأتي في كل سياق ما يتناسب هذا الذي أفهمه.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ لماذا قدم الخبيثات على الخبيثين، وكنا قد أشرنا سابقاً على موضوع الزنا، وتحدثنا أن الله سبحانه وتعالى قدم الزانيات، فلماذا قدم هنا الخبيثات للخبيثين، وهل هذا تشريع؟ هل هذا كما ذكرنا سابقاً بأن الزاني لا يأخذ إلا زانية؟
د. المستغانمي: هذا ليس تشريعاً، هذا تعليق أو دعني أقول: تذييل لما سبق، القرآن يقول للمجتمع المسلم: ضعوا في أذهانكم أنه لا يلتقي في بيت النبوة الطاهر إلا طاهرة مطهرة، والأولى أنكم تفكرون بهذا المنطق السليم: الخبيثات مستحقات للخبيثين معدّات هذه اللام تسمى لام الاستحقاق، والطيور على أشكالها تقع، والخبيثات للخبيثين والإطناب هنا: والخبيثون للخبيثات، الأولى تكفي، ولكن هنا إطناب للتفصيل الموضوع خطير. أنتم عندما ترون امرأة –والعياذ بالله- زانية فاعلم أنها تشاكل غيرها ممن هي مرتبطة به، هذه من كان الزنا ديدنها، وكان عادة لها، فبدأ بالخبيثات؛ لأنهم تحدّثوا في الأعراض، فكان الأولى أن يُبعد التهمة عن بيت النبوة، فقال: المنطق السليم يقول: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، هذا إطناب لتأكيد هذا المعنى. وجاء الآن ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ عائشة رضي الله عنها المطهّرة لمحمد الطاهر أطهر البشر في الدنيا، والطيبون للطيبات لتثبيت هذا المعنى.
لماذا بدأ بالخبيثات لماذا لم يعكس ممكن تقول: (الطيبات للطيبين وبعدين الخبيثات) لا، نحن في نهايتهم طبعاً في القرآن تحليلي الخاص قال: (والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأون مما يقولون) أولئك: هم محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، وصفوان بن المعطل، والمجتمع الطاهر مبرأ مما يقول المنافقون حتى تكون هذه النهاية وهذا التذييل بدأ بالخبيثات وانتهى منهم، وأتى بالطيبات للطيبين وقال: أولئك في تميزهم في صفائهم في نقائهم مبرأون مما يقولون من الإفك، لكن هو لم يقل: مما أولئك مبرءون من الإفك، لا، مما يقولون، هو مجرد قول لا أساس لا صحة له، فعبر عن الإفك والكذب بالقول. أولئك مبرأون مما يقولون من قول لا حقيقة له في الواقع، وانظر إلى الصيغة لم يقل: أولئك بريئون، قال: (أولئك مبرّأون) براءة شهادة من اللهّ شيء عجيب، لذلك عائشة كانت تفخر تقول: ونزل عذري من السماء أي: برأها الله من السماء.
المقدم: ما علاقة الرزق بهذا الموضوع، الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾؟
د. المستغانمي: هذه في الجنة في الآخرة يعني: لهم مغفرة يوم يلقون الله، أولاً: برأهم في الدنيا ليس لهم شيء، وفي يوم القيامة يلقاهم الله بالمغفرة والرزق الكريم. عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: في سورة الأحزاب ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ * ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ إلى أن يقول عن نساء النبي: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾. لذلك الإمام الطيبي عالم جليل شرح الكشاف عنده حاشية تسمى فتوح الغيب عن الكشاف 17 مجلد طبعت في جائزة دبي القرآن الكريم حاشية بلاغية، وأنا أنصح المسلمين بقراءتها. فيقول عن أستاذه بهاء الدين يقول: قرأت بخطه -لا ندري مدى صحة السند- لكن في مرض موت عائشة رضي الله عنها وهي في تحتضر جاءها الصحابي الجليل ابن عم رسول الله ابن عباس رضي الله عنه في زيارتها كانت لا تستقبل الناس فقالوا لها: هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ائذنوا له، فلما دخل قال: كيف تجدينك؟ قالت: أجدني أخاف مما أقدم عليه لحظات الموت! – وهي أم المؤمنين الطاهرة المطهرة – ماذا قال لها ابن عباس؟ قال: أبشري والله لا تقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم، فعائشة في لحظات الاحتضار قالت: أهو خبر أنبأك به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنبأني به القرآن الكريم، وقرأ لها وقالت: اتلوا عليّ قال: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ كأنها لم تقرأها من قبل، ففوجئت وأغمي عليها قال: ما بها؟ قالت: أغمي عليها فرحاً بما تلوت عليها. فنساء النبي لهن مغفرة وفي الجنة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ولهن.
المقدم: ثم بعد ذلك نأتي إلى موضوع آخر وهو قضية الاستئذان ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾. ما علاقة هذا الأمر بالمحور العام للصورة نقول: هي تخاطب المجتمع والأسرة المسلمة، فما علاقتها أو كيف يدخل الاستئذان في موضوع الأسرة؟
د. المستغانمي: لما تحدثنا وقلنا: المحور الأساسي لسورة النور هو تربية ضمير الأسرة المسلمة، تربية آداب الأسرة المسلمة، ومن آداب الأسرة أننا نعلم أبناءنا الصغار والكبار والجميع نعلمهم الاستئذان القرآن علمنا الاستئذان: (يا أيها الذين آمنوا) خطاب للمؤمنين، ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾ والاستئناس كما ذكرنا أصلها حتى تستأذنوا، لكن لفظ الاستئناس فيه تلطّف وفيه أخذ بالحيطة والحذر أي: حتى تستأذنوا وتقول: السلام عليكم أنا فلان أأدخل؟ كما ورد في السنة.
وعندما تستأنس ولا تستوحش، وتظن وتتأكد أن أهل البيت مقبلون على الالتقاء بك، ويرحّبون بك ادخل.
المقدم: طبعاً تستأنس هنا من الصيغ التي تسمى صيغ الاستفعال الذي هي الطلب فكأنك تطلب الأنس وتتأكد من أن الطرف الثاني يريد أن يستقبلك لا مجاملة بل تستأنس له.. هم يقولون: الذي يطرق الباب ويأتي للزيارة يكن مستوحشاً فإذا أذن له واطمأن يدخل. من الناحية البلاغية هنا: هذا يسمى في البلاغة: الإرداف، وهو أصله من الترادف، وهي وسيلة تقنية يعبر بكلمة أو بفعلٍ أو بكلمة باسم، بدل كلمة لكن لماذا نأتي بهذه بدل هذه؟ تعطي معناها وتعطي أشياء أخرى. فالإرداف وسيلة لغوية بلاغية يعبر عن نفس المعنى الثاني، ولكن يعطي معاني ثانوية، هنا كأنه يقول: (لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا فإن اطمأننتم واستأنستم) لفظ الاستئناس يعطي المعنى الثاني، فادخل لو قال: حتى تسأذنوا، لكن لم تطمأن بعد فأعطى معنىً جديداً.
المقدم: هو ورد الاستئذان في موضع آخر؟
د. المستغانمي: ورد. أنا فقط أعطيك الفكرة الإرداف شيء جميل أعطيك مثال في سورة هود: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ﴾ قضي الأمر، انتهى، الطوفان أغرق من أغرق، ونجا من نجا، هذا يسمى إرداف، كان الأولى في غير القرآن: (يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وهلك من هلك ونجا من نجا).عوض أن يقول هلك من هلك ونجا من نجل قال (وقضي الأمر) فقضي الأمر إرداف عبر عن نجاة من نجا وإهلاك من هلك مع إيجاز شديد يتناسق مع الصورة، الإرداف شيء عجيب في القرآن.
وكما قال أيضاً: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ هنا لا قال: (الذين أحسنوا بالحسنى) ولكن القياس اللغوي يقتضي: (قل يجزي الذين أساءوا بالسوءى) أساءوا يدخلهم جهنم، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذا قياس لغوي، القرآن يفوق القياس اللغوي، وهذا يسمى إرداف، عبّر عن السوء بالذين عملوا لأكثر من شيء:
أولاً: الله تعالى عندما أحد يعمل سيئة يعطيه سيئة واحدة. لو قال: (ليجزي الذين أساءوا بالسوءى) هذا اسم تفضيل كأنه يجازيهم بأسوأ، والله عز وجل لا يجازي بالأسوأ، فهو لا يتماشى مع عدل الله وفضله جل في علاه. السيئة بسيئة. أما الحسنة فبعشر.
الثاني: لو قال: (ليجزي الذين أساءوا بالسيئة) الله لا ينسب لذاته السيئة لا يعطي السيئة هو قال: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ من جنس عملهم، إذاً بما عملوا إرداف عبّر عن المعنى بزيادات، فبلاغة القرآن شيء عجيب. وهنا قال: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾ لو قال: (تستأذنوا) عادي ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾ إرداف أتى بمعاني أخرى.
المقدم: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا﴾ فعلين مختلفين؟
د. المستغانمي: نعم فعليك أن تستأذن أدخل؟ أنا فلان، وتسلم، قال العلماء: الاستئذان واجب والسلام مستحب، وإن كان رد السلام واجب. ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ذلك الاستئذان وذلك التسليم خير لكم لعلكم تذكرون.
المقدم: يتواصل الحديث عن الاستئذان ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا﴾ حتى لو هيأ لكم أو استطعتم دخولها فلا تدخلوها، ﴿حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾. هنا الإشارة التي تحدثت عنها ما قال كما قال قبل قليل (ذلك خير لكم) هنا ما قال: (ذلك خير لكم) بل قال هنا: ﴿أَزْكَى لَكُمْ﴾؟
د. المستغانمي: لأن التزكية تدخل في المشاهدة تزكية النفوس القرآن يسمو بالقلوب وبالعقول وبالأعين أنت تدخل بيتًا، لماذا أمرنا الله بالاستئذان والاستئناف؟ حتى لا نباغت الناس في بيوتهم، وحتى لا نفاجئهم فنرى ما لا يحسن رؤيته من عورات للبيوت، فللبيوت أسرار، وفيها عورات لا بد أن تستر، فأزكى وأنقى، لأنه لما يقول: (خير لكم) بشكل عام.
المقدم: ربما يعتقد المعتقد بأنه حينما يقال: للإنسان (ارجع) يكون هذا ليس حسناً له أو مقبولاً في الذوق، لكن الله سبحانه وتعالى هو أزكى لا نعلم ذلك لكن هو أزكى لنا.
د. المستغانمي: والقرآن يعلمنا الصراحة الطيبة المهذبة نحن إذا ذهبت وقلت: يا فلان! أنا قادم إلى عندك لو قال لك زميلك أو من أقربائك: والله أنا اليوم منشغل وأطلب منك أن تزورني في يوم ما، والله الكثير قد يأخذ في قلبه، لكن هو أزكى للقلب والقرآن علمنا أن نكون صرحاء في لباقة.
﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ لكن إن لم تجدوها فيها أحدا فلا تدخلوها حتى لا يظن يقول: والله نهانا الله عن الدخول حتى لا نرى العورات ولا نرى كذا، إذا كان أهلها ليسوا فيها يجوز لي الدخول، لا، للبيوت أسرار حتى ولو كان أهلها غير موجودين.
المقدم: هذا الموضوع أو هذه الآداب قد لا تنطبق على البيوت المهجورة التي ليس فيها أحد، ليس لم يأتي الجواب منها أو لم نجد أحداً فيها لا، وإنما هي غير مسكونة كما قال الله سبحانه وتعالى، فهنا يقول: (ليس عليكم جناح)؟
د. المستغانمي: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ كلمة (فيها متاع لكم) حلّت لنا المشكلة، ما هي البيوت غير المسكونة؟ ليست شرطا أن تكون بيوت للسكن، يعني الآن الفنادق، بيوت العامة، غرف التجارة، أو أسواق التجارة بيوت غير مسكونة، دار البلدية، دار البريد، الخانات التي كان يتوقف عندها المسافرون، فكل بيتٍ فيه متاع ومصلحة دار كهرباء فيه متاع لنا فيه غرض، هو هذا الذي يقف عنده المفسرون البيوت المسكونة هي التي فيها أهلها، البيوت غير المسكونة هي التي فيها منفعة للجميع، هنا يجوز لنا أن ندخل، ولذلك لما تروح للمستشفى تطرق الباب وتظل عند الباب الإسلام ما شرع هذا! إنما هذه بيوت عامة، كأنه يقول عامة، وجاءت الأوقات وأصبحت المدنية الآن فيها كثير من المؤسسات والمصالح التي ندخلها بغير استئذان تدخل تستأذن عند الغرفة للمكتب، أو الغرفة في الفندق، أما إذا دخلت فندق عام، تدخل دار بلدية تدخل عند كاتب لا بد أن تدق عند الباب واستأذن.
المقدم: وهنا العرف هو المقياس.
د. المستغانمي: جزاك الله خير. هذا الذي نقصد.
المقدم: هذا التعبير يستعمل كثيراً في القرآن: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ لماذا هذا التعبير؟
د. المستغانمي: يعني ليس عليكم حرج، لرفع الحرج، ليس عليكم جناح، ليس عليكم مشقة، ليس عليكم إثم، الناس يتحرجون يقول: والله لا أدخل أي غرفة أي جهة حتى استأذن، ثمة محلات قد يجد الإنسان حرجاً وقد يتحرّج داخل نفسه بإثم، فالقرآن يقول: (ليس عليكم جناح) فالجناح هو الحرج، هو اللمم الخفيف، الذنب الخفيف، يوماً سنجيب على السؤال الذي قال: ما الفرق بين الذنوب والخطايا والإثم والحرج، حتى لا نذهب بعيداً عن السورة، وإلا فيها تفصيل سأعطيك إياها إن شاء الله.
المقدم: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾.
د. المستغانمي: انظر إلى هذا التذييل لو تدخل بغرض التجسس الله يعلم ما تبدي وما تخفي، لو تدخل إلى بيوت غير مسكونة لكن بأهداف أخرى الله يعلم، لك فيها مآرب أخرى لا تطلع الناس عليها فالله يعلم. وانظر ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ تبدون وما تكتمون، لم يقل: والله يعلم ما تعلنون، في سور أخرى تعلنون وتسرون، هنا تبدون وتكتمون، لماذا؟ لأن السورة فيها ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ فيها الإبداء، فيها الإظهار، الإعلان صحيح والله يعلم ما تعلنون. هذا من التناسق اللفظي في السورة.
المقدم: هنا بعد ذلك نأتي إلى قضية أعتقد بأنها ليست بعيدة عن محور السورة وعن القصص الأخرى وعن المواضيع الأخرى: قضية غض البصر، وهذه كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾. فنأتي الآن إلى موضوع آخر له كذلك علاقة بمحور السورة.
د. المستغانمي: نحن قلنا: شرع الله سبحانه وتعالى حد الزنا ثم أعطانا وسائل وقائية حتى لا يقع المسلم في هذه الفاحشة العظيمة: من بين الوسائل الوقائية قبل قليل: الاستئذان وسيلة، لا تدخلوا البيوت حتى تستأذن، وهذا يقيك من شرور ومن رؤية أشياء قد لا تُرضى، وربما توصلك إلى ما يحمد عقباه، وهي خطوة من خطوات الشيطان. والآن القرآن أتى بموضوع خطير في المجتمع: وهو غض البصر، وهذا موضوع خطير جداً لو أن المسلمين غضوا أبصارهم ما انتشرت الفواحش التي نراها: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ ذكرنا سابقا هذا فعل محذوف فعل الأمر: قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم فسوف يغضون من أبصارهم، (يغضوا) جواب طلب محذوف؛ لأنه لا يستقيم المعنى لو قلنا: (قل للمؤمنين (يغضوا) جواب قل، يغضوا ليس جواب قل، يغضوا جواب أمر: (غضوا). (وقل للمؤمنات اغضضن جواب يغضضن) هذا فقط للتوضيح. ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾.
المقدم: هنا سؤال: أولاً: لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ وثانياً: لماذا قال: (يغضوا من أبصارهم) ولم يقل: (يحفظوا من فروجهم) قال: يحفظوا فروجهم مباشرة؟
د. المستغانمي: لأن العملية في غض البصر فيها نسب تتفاوت أما في حفظ الفرج فلا يوجد نِسب. أولاً: لماذا أمر بغض البصر؟ لأن غض البصر أو رؤية المحرمات تقود إلى الزنا، لأن البصر بريد الزنا، هكذا يقول الفقهاء. لكن أنت سؤالك صحيح: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (من) للتجزئة والتبعيض، فالقرآن ما طلب منا أن نمشي ونحن مكبون على وجوهنا، لا بد أن ترفع رأسك وأن تمشي باحترام، لكن إذا رأيت شيئاً لا يناسب غض من بصرك وكبّ رأسك، والغض: هو الخفض.
المقدم: يعني الإسلام لم يأمرنا بأن نمشي مكبلين الأعين؟
د. المستغانمي: يكون غير منطقي لذلك أنا أقول ملحوظة من فوق هذا المنبر الإسلامي: عندما ترى بعض الناس الذين يتجاوزون العرف ويمشي مكباً على وجهه بشكل مضطرد يريد أن يبين مدى التزامه بالشرع، فالإسلام ما طلب منك ذلك، الإسلام يأمر أبناءه أن يمشوا وهم مرفوعو الرؤوس، لكن في وقار وباحترام، وإذا رأوا شيئاً يغضوا من أبصارهم، هذه هي الاستقامة المنطقية المجتمعية التي جاء بها الإسلام. أما حفظ الفرج: لو قال: (ويحفظوا من فروجهم) جزء من فروجهم لا، بل حفظ نهائي لفروجهم لا يوجد نسبة هنا إما تحفظ وإما لا تحفظ.
المقدم: لذلك –سبحان الله- ورد في السنة ولا أعرف صحة الحديث: بأنه النظرة الأولى لك والثانية عليك. فبالتالي أنت يفترض أنك تمشي بشكل مستقيم فإن رأيت ما يؤذيك فاغضض بصرك، وهذا هو الأدب. يقول تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ ربما يقول قائل: الرجل يغض بصره من أجل ألا يقع في الحرام، لكن المرأة عن ما تغض بصرها؟
د. المستغانمي: أيضاً لأجل ذلك حتى لا يعتقد هذا الاعتقاد الذي تفضلت به أتت الآية: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾، وإلا في العادة يمشي على التكثير والتغليب: (يا أيها الذين آمنوا) في القرآن كله خطاب للرجال والنساء حتى لا تعتقد النسوة بأن هذا الخطاب خاص بالرجال، لأن الرجال كثيرًا ما يقع منهم ذلك، لا، جاء الخطاب موجهاً للنساء إذاً: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ المرأة المسلمة الحيية العفيفة أيضاً لا تحدق بشدة للرجال ولا تنظر إلى أشياء منكرة في الدنيا، فهي مطالبة ومخاطبة كما خوطب الرجل، ولذلك ورد في السنة عندما زار عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى كانت أم سلمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحدة معها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تفرقا فقالتا: إنه أعمى، فقال: أفعمويان أنتما؟! إذاً غص البصر يطالب به الرجل، وتطالب به المرأة.
المقدم: لكن عدم إبداء الزينة مقتصر على المرأة؛ لأنه لا يعقل بأن الرجل يثير المرأة بزينته.
د. المستغانمي: نعم الرجل عادي، لذلك جاءت: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ ما قال: ولا يبدون زينتهم،
المقدم: وإن كان بعد ذلك جاء التشريع وهذه الآية من الآيات التي فيها توضيح بعلاقة كيف يجب أن تكون العلاقة في الأسرة، فذكر: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ما المقصود ما ظهر منها؟
د. المستغانمي: المقصود به: الوجه والكفان عند جميع العلماء باتفاق تقريباً عند القول الراجح: الوجه والكفان هو ما ظهر من زينة المرأة. بعضهم يقول: (ما ظهر منها) ما ظهر من شكل المرأة وجسمها، لكن الأدلة تسوغ هذا المعنى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ من تنتقب بنقاب فلها ذلك إذا كانت المرأة جميلة وتخشى على نفسها الفتنة فلها ذلك. لكن هل نقول: هذا من الفريضة؟ لا، اختلاف كبير بين العلماء لا نريد أن ندخل فيه. لكن ما ظهر منها ما تظهره في صلاتها وفي حجها: وهو الوجه والكفان.
المقدم: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّْ﴾؟
د. المستغانمي: الخمار هو الثوب الذي تضعه المرأة على شعرها وعلى عنقها وعلى جيبها والجيب هو فتحة الصدر وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليس على وجوههن، فالقرآن دقيق المسلم يتعنت في فهم القرآن القرآن واضح فقال: وليضربن بخمرهن على الجيوب بمعنى: يشددن الخمار على الجيب حتى لا يظهر العنق، والجيد، والنحر، ولا يظهر العقد ولا تظهر الرقبة إلى غير ذلك.
المقدم: ثم قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الذي هم الأزواج: ﴿أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ آباء الأزواج ﴿أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ يعني: إذا كان أزواجهم متزوجون من نساء أخريات ولهم أبناء فيجوز أن يعيشوا معهم ويظهرون زينتهن أمامهن.
المقدم: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ نوضح للمشاهد الكريم: أن الزينة في القرآن تطلق على ما تتزين به المرأة، يعني الحلي والخضاب مثلاً، الكحل، لا تبدي المرأة من زينتها العقد، الخلخال في الرجل، هذا نوع من الزينة، لكن الأمر في الحقيقة: أنا لو أتيتك بمثال: العقد هذا من زينة المرأة العقد لم يكن في الخارج، هل نهى القرآن أن نرى العقد في غير جسم المرأة؟ لا، الأمر في الحقيقة ليس يتعلق بالحلي، بأماكن الحلي، بالحلي مزيّنة لجيد المرأة، لشعر المرأة، الأماكن الأقراط مثلاً أنت لو نظرت إلى قرط المرأة هل في ذلك حرام؟ لا، يحرم الشيء بذاته، فقال العلماء: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ جاء النهي عن إبداء الزينة، فمن باب أولى مواضع الزينة لا تكشف، مواضع الزينة التي هي: الرقبة، الشعر، السيقان، العضد.. إلى غير ذلك.
المقدم: حتى وإن جاءت بائعة من البائعات في محل الذهب أو محل الزينة وعرضت مثلاً بكفها أو حملت بيديها فهذه لم تعرض الزينة، فهذه لم تعرض زينتها ولا جيبها ولا شعرها. ﴿أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ﴾ لماذا لم يقل: (أبناء إخوانهن)؟
د. المستغانمي: هنا طبعاً أبناء بنين وبنون جمع ابن، وأبناء اجمع ابن، تعامل مثلما تقول: ملحق بجمع المذكر السالم، لكن أبناء جمع ابن، لكن أبناء على وزن أفعال جمع تكسير يفيد القلة، أفعال وأفعِلة وفُعَلَة هذه جمع قلة، فهنا بعد قليل: ﴿أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾ نعيد الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾ كم للمرأة من ابن؟ هذا ابنها، بس كم لها من ولد؟ خمسة ستة عشرة ليس مائة! ﴿أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ كم له من ولد هذا الرجل الذي تزوج بها وأتى بربيب مثلما نقول. ﴿أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾ بني إخوانهن بالعادة المرأة عندها خمسة أخوة أو ستة فكل واحد عنده عشرة فرضاً هنا لكثرة العدد غيّر الأسلوب من أبناء إلى بنين، لماذا؟ ديدن القرآن يقول: ﴿بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ كذلك: ﴿يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ فالقرآن عودنا ديدن القرآن في التعبير أن يستعمل بني وبنو في الكثرة، فهنا قال العلماء: أبناء للقلة أما بني أخواتهن وبني إخوانهن يمكن واحد عنده سبعة إخوة أو أخوات فكل واحد عنده سبعة ثمانية، فهنا عدل عن أبناء إلى بنين. بحثت في الموضوع و ذهبنا إلى سورة الأحزاب سورة الأحزاب تتكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كم أزواج النبي؟ عدد معين بالنسبة للمسلمين وللأمة، فلما تحدث عن أزواج النبي قال: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ لماذا؟ عائشة كم لها من أخ؟ عدد بسيط، فأتى بأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن، العدد محصور. بينما لما يكون الحديث هنا عن الأمة الإسلامية فأتى: (بني إخوانهن أو بني أخواتهن).
﴿بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ النساء هؤلاء المذكورين أو نساء المؤمنين يجوز الوجهان، لو قال: (أو النساء) بشكل عام جائز لأن نساء المؤمنين يجوز لهن أن يرين زينة المؤمنات. كأن القرآن يقول: (أو أبنائهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو النساء) بشكل عام، لكن قال: (أو نسائهن) نظراً لتناسق الإيقاع، هذه تسمى آية الضمائر خمسة وعشرين ضمير قال ابن العربي الإمام المالكي الذي فسر القرآن، فمراعاة لروعة الإحكام والتناسق قال: (أو نسائهن) وإلا كل النساء يجوز لها أن ترى بعضها البعض. بعض العلماء رأى معنى آخر قال: (أو نساء المؤمنات) نعم غير نساء المشركات، وكأن الأمر فيه سعة.
قال تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ من الرجال يجوز إبداء زينتهن، لأنه يعتبر ابن البيت شريطة إذا رأوا منه شيئاً أو شيء يمكن أن يمنع.
المقدم: لكن هذا لا ينطبق على الخدم في زماننا؟
د. المستغانمي: لا أراه ينطبق والله أعلم ويسأل الفقهاء.
المقدم: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾؟
د. المستغانمي: غير أولي الحاجة، والتابعين: لا يوجد بيت يخلو من تابعين يعني بعض الناس الكبار الذين يمرون على البيت الذي يحتاج إلى الصدقة ودائماً يعتاد يأتي من بيوت أناس يدخلون، اعتادت العائلة عليه، لكن بشرط غير أولي الإربة غير أولي الشهوة للنساء، الحاجة النفسية والجنسية، فإذا لاحظت العائلة أن ثمة إنساناً دائماً يعتاد من كبار الرجال من غير أولي الإربة والحاجة وقد اعتاد، مسكيناً كانوا يتعطفون عليه ويكرمونه، هذا يجوز.
﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ لماذا كل هذه الاستثناءات؟! هؤلاء الآباء والأبناء طبعاً المرأة تتحرج من أن دائمًأ ألا تكشف ساقها أو شيء من ذراعها أو من ساعدها أو من شعرها فرفع الحرج؛ لأن هؤلاء الأقارب يدخلون كثيراً على النساء، وهذا من رحمة الدين الإسلامي.
المقدم: طبعاً هم لم ينتهوا بعد ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ﴾ لماذا لم يقل: (أطفال)؟
د. المستغانمي: هنا المقصود به جنس الطفل: أو الطفل الذين لم يظهروا، هو بين لك بأنني أقصد جنس الطفل الذي لم يعي بعد كخمس سنين ست سنين ولم يبلغ، الذين لم يظهروا ولم يطّلعوا على عورات النساء، لا يفرقون بين الطويلة والقصيرة والجميلة والذميمة وغير ذلك
المقدم: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.
د. المستغانمي: ما أحوج المسلمين أن يتوبوا في مثل هذه العلاقات بين الرجال والنساء، العملية تتطلب دائماً توبة ولو كنا مؤمنين.
المقدم: جزاك الله خير فضيلة الشيخ! استفدنا كثيراً في هذه الحلقة كما الحلقات الماضية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بما قلت وأن ينفع الجميع بما قلت، وأن يفقهنا في كتابه جل في علاه سبحانه هو القادر على أن يفهمنا إن شاء الله الكثير من خلال هذا البرنامج وهذا ما يسعى إليه البرنامج إن شاء الله من أجل أن يفهم الناس ما الذي يذكر في القرآن من أسرار عظيمة.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة النور – 5
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
المقدم: في الحلقة الماضية توقفنا في منتصف سورة النور تقريبًا والحديث لا يزال متواصلًا عن سورة النور والتي موضوعها الرئيسي الأسرة المسلمة والمحافظة على الأسرة المسلمة ونبذ كل ما يخل بتكوين هذه الأسرة الذي من خلاله يخل المجتمع الإسلامي كذلك فالأسرة هي اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع لذلك جاءت هذه السورة التي لو شئنا أن نسميها في غير القرآن لسميناها سورة الأسرة المسلمة. وهذا كذلك لا يخالف بأن فيها بعض الموضوعات التي لها علاقة بموضوعها الرئيسي. لا زال الحديث متواصلًا عن الحديث للمؤمنين والمؤمنات فيما يتعلق بالاستئذان والنكاح والآن نأتي إلى قضية جديدة بعد أن قال الله سبحانه وتعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ النور) ما المقصود بقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ من هم الأيامى؟ ولماذا يكون التزويج للصالحين؟ وهل غير الصالحين لا يزوَجون في المجتمع الإسلامي؟
د. المستغانمي: سورة النور هي سورة الأسرة المسلمة كيف تبني الأسرة وإذا ما بنيت الأسرة المسلمة على صلاح وعلى سداد وعلى قاعدة صلبة من الإيمان والعفاف والطهر فإن ذلك ينصب في تكوين مجتمع مسلم. كما سبق أن تحدثنا عن آيات الزنا التي جاء فيها حد الزنا وجاءت بعدها الآيات تنهى عن القذف وعن الرمي رمي المحصنات ورمي الأزواج ثم جاءت الآيات التي حثت المؤمنين على غض البصر وحثت المؤمنات على غض البصر وحثت المؤمنات على عدم إبداء زينتهن إلا لمن هم من أقاربها وفصّلت والآيات التي تحدثت عن الاستئذان للبالغين لأنه ستأتي الآيات عن الاستئذان الخاصة بالأطفال. وهنا جاء موضع أمر الله جلّ جلاله لأولياء الأمور للناس أن يزوجوا الأيامى (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) أي سهّلوا تزويج الأيامى. الأيامى جمع أيّم والأيّم كل من لا زوج له من رجل أو امرأة، بعض العلماء مثل بعض اللغويين يقولون الأيّم هي المرأة التي لا زوج لها بدليل أن الأيم لا تأخذ التاء امرأة أيّم مثل امرأة حائض وامرأة طالق وامرأة أيّم وبعض المفسرين الآخر الذي جرى عليه المفسرون يقول رجل أيّم وامرأة أيّم كلاهما لا زوج له لكن عرف وشاع أن الأيم هي المرأة التي لا زوج لها ولكن لكن لا تكون بكرًا بمعنى إما من طلاق أو من موت الرجل. الأيامى أصلها أيائم، وردت في الحديث. (أنكحوا) بمعنى زوجوا والمعنى المبطّن: سهّلوا عملية التزويج، ونحن في سورة النور التي تأمر بتسهيل عملية الزواج اتقاء وقوع الناس رجلا ونساء في جريمة الزنا فمن هذا الباب لا بد أن نفهم. بعض العلماء قالوا للوجوب وبعضهم قال إذا كان الرجل أو المرأة عفيفة تستطيع أن تتحكم في ذاتها فالأمر للندب وهذا أمر يعود للفقهاء .الذي نقوله (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) أي سهلوا عملية التزويج. وهنا الحديث عن الأيامى المرأة الحرة بدليل الآية التي بعدها (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) خصصت معنى الأيامى فقط للحرائر، الصالحين من عبادكم من المماليك الأرقّاء الذين يعملون عندكم قديما كان ملك اليمين موجودًا والجواري اللواتي عبر عنهم بالفتيات في بيوت المسلمين فقال (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى) أي زوجوا بناتكم الحرائر وأيّ امرأة قلّ مهرها كثرت بركتها فالإسلام يسهّل عملية التزويج. بعد ذلك قال (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ) من الأرقاء ومن الجواري الصالحين منهم. كلمة الصلاح توقف عندها العلماء قالوا
- الصالحين بمعنى الأعفّاء والعفائف بمعنى الطاهرين الملتزمين بالدين.
- الرأي الثاني: والصالحين للزواج عندهم قدرة وقابلية للزواج على طريقة “من استطاع منكم الباءة فليتزوج”
إذن كلمة الصالحين لها معنيان، السؤال الذي قد ينشأ وأنكحوا الصالحين من عبادكم الذين فيهم الصلاح، هل غير الصالحين لا يُسهّل لهم عملية النكاح والزواج؟ لا، في الحقيقة كثير من الناس ربما يتباطأ من أولياء الأمور الذي عنده عبد مملوك يقول عبد صالح نقي يقرأ القرآن هذا أولى أن تسهل له الزواج حتى لا يقع في العنت والذي يكون غير صالحًا هذا من باب أولى هذا مفهوم الفحوى، من باب أولى إذا كان عندك عبد أو جارية إن كانوا صالحين فمن باب أولى غيرهم، هذا المعنى الذي يحل الإشكال. بعض المفسرين وقع في الإشكال وبعضهم حلّ الإشكال. إذن (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ) حاولوا المساهمة في تسهيل الزواج، إذن فحوى الآية غير المنطوق: أن غير الصالحين أولى بالتزويج.
المقدم: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) لماذا تحدث عن الفقر في عملية الزواج؟
د. المستغانمي: لأن كثيرا من أولياء الأمور الرجل الذي في بيته مماليك يتخوّف من المصاريف، قال الله سبحانه وتعالى للأسر، للرجال والنساء يخشون إن أتت المملوكة بأولاد أن تزداد المصاريف والله سبحانه وتعالى يقول إن يكونوا فقراء فسوف يغنيهم، رزقهم سوف يأتي معهم ومع أولادهم فلا تحمل عنت الفقر على طريقة قوله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) أو (من إملاق) إن يكونوا فقراء وعد من الله جلّ جلاله سيسهل لكم ولهم عملية الرزق فالرزق من عند الله سبحانه وتعالى.
المقدم: لا تنطبق هذه المسألة حتى على الأيامى لأن كل من يفكر في الزواج يفكر في قضية المصاريف
د. المستغانمي: قال العلماء تنطبق.
المقدم: فمعناها لا تفكروا في قضية المصاريف والفقر كما في قوله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)
د. المستغانمي: وفي الحديث: ثلاثة على الله أن يعينهم ومنهم الناكح المتعفف الله عز وجلّ يعينه، والغازي في سبيل الله كما ورد في الحديث.
المقدم: الكلمات التي تدل على الزواج كثيرة منها الزواج والنكاح والإحصان كلها وردت في القرآن فلماذا استعمل النكاح هنا؟
د. المستغانمي: دائمًا في القرآن كلمة النكاح يعني التزويج، بمعنى عقد الزواج (وأنكحوا الأيامى) (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) أي فتزوجوا، والإحصان أيضًا مقصود به من كان محصنًا أو محصنة.
المقدم: ما دلالة ختم الآية بالسعة حين قال (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)؟
د, المسغانمي: الله الواسع جلّ جلاله هذا اسم من أسماء الله الحسنى. الله الواسع مطلق في العلم، واسع العطاء، واسع الرحمة ويعطي حسب حكمته وعلمه (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) واحد يقول زوّجت ابنتي ولكن ما جاءهم مال لا، الله واسع العطاء واسع الفضل والنعم عليم يضع ما يشاء ويعطي ما يشاء وفق علمه وحكمته هذا التذييل ليرينا أن القضاء والقدر بيده يرزق من يشاء “إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله” الله العليم فأنت أسنِد الأمر لصاحب الأمر.
المقدم: الربط ما بين النكاح والسعة في المال يأتي في الآيات التي بعدها قال تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) ما المقصود بـ(يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)؟
د. المستغانمي: (وليستعفف) الذي وجد وانطلق الله جلّ جلاله سيساعده والذي لم يجد مؤونة هذا الزواج من الأحرار والحرائر فليستعفف بمعنى فليطلب العافا وهذه مبالغة في طلب العفة عن طريق الصوم، عن طريق تلاوة القرآن، فليلتزم بقوانين الشرع وآداب أخلاق الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغنيه جلّ جلاله. ثلاثة على الله أن يعينهم الناكح المتعفف أي المتزوج الذي يريد العفاف. على هذه الشاكلة الآية تعد كل من له نية حسنة في الصلاح لكي يتزوج فإن الله سوف يغنيه وسوف يفتح له أبواب الرزق.
المقدم: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ) ما العلاقة بين هذه المسألة وما بين الآية التي قبلها؟
د.المستغانمي: قبل قليل قال (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) عبّر عن الأرقّاء الذكور (عبادكم) وعن الجواري (وإمائكم) ممكن أحد يقول هؤلاء فقراء، وعد الله أنه سوف يغنيهم، العبد لا يخرج عن طاعة سيده وما نده مال وهو تحت مظلة البيت فقال (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ) العبد حتى في الجاهلية قبل الإسلام يقول لسيده أنا أريد أن أكاتبك بمعنى يطلب منه عقد مكاتبة أن تعطيني حريتي مقابل عوض كذا ويكون العوض منجّما أعمل وأرد لك هذا العوض فرضًا حريتي مقابل عشرة آلآف درهم وأعطيك ألفًا بعد كل شهرين ويتكاتبان يكتب بينهما كاتب، هذه تسمى عملية المكاتبة تدخل في تسهيل عملية الزواج أًيضًا (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) إن علمتم أن مقصودهم صحيح ونيّتهم صحيحة سيوفون بهذا الأمر وأنهم يريدون الصلاح فعلًا وليس إن علمتم أنهم يريدون الإباق ومجرد الهروب، إن علمتم الصلاح وإرادتهم الخير. فالمكاتبة هي عقد بين المالك والعبد مقابل عِوَض معين ويكون منجمًا وهذا معروف في الفقه الإسلامي وهذه وسيلة من وسائل تجفيف الرقّ، محاربة الرقّ. كثير من الناس يقولون الإسلام فيه (وما ملكت أيمانكم) نقول كانت موجودة لكن لا الإسلام ولا غير الإسلام يحرر العبيد بلحظة، بآية، لو حرر العبيد بآية وخرج عشرات الآلآف من العبيد ومن الجواري لا أسرة لا بيت لا مال ستنشأ مشكلة أخرى أكبر مما كانت فالقرآن جفف المنابع وهذه وسيلة من وسائل تجفيف المنابع (فَكَاتِبُوهُمْ) وقعت في قتل خطأ: تحرير رقبة، ظاهرت من زوجتك: تحرير رقبة الذي يظاهر من زوجته ويقول أنت عليّ كظهر أمي يحرر رقبة، هذه وسائل إلى أن جفّت منابع العبيد واختفت وهذه حكمة إلهية في علم الاجتماع.
المقدم: اختفت شيئا فشيئا بدون أن تسبب أي مشكلة اجتماعية في المجتمع. قال الله سبحانه وتعالى (وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ) أي ساعدوهم، فيه حثّ كذلك على مساعدتهم.
د. المستغانمي: وهذا شيء عظيم من المالك أن يتفضل بمساعدة العبد المملوك ويصنع له مستقبلا.
المقدم: ما العلاقة بين هذا الأمر وبين ما يلي (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) هل كانوا بالفعل يُكرهون الفتيات على البغاء؟ والفتيات هنا مقصود بها الجواري
د. المستغانمي: في الجاهلية كانو يفعلون. الله تعالى يرفع الأسلوب فقال (فَتَيَاتِكُمْ) والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا عبدي وأمتي وقل فتاي وفتاتي” وهذا من احترام الإنسانية وكلمة فتاة تطلق على أي فتى، ابنك فتى. وكأن هذه بمثابة ابنتك. بعض الجاهليين كانوا يُكرهون الجواري على البغاء والبغاء هي عملية زنا بمقابل، الزنا قد يكون طواعية بين اثنين ولكن البغاء بمقابل أموال وهذه كانت موجودة في الجاهلية. إذن يقال في مجتمع المدينة المنورة كانت بعض الجواري لعبد الله بن أبي بن سلول سيد المنافقين الذي تولى كبره تكلم في حديث الإفك، كانت لديه جواري معاذة، ستٌ من الجواري جئن واشتكينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية التي تحرم الزنا فجاء القرآن عامًا ليس له فقط وإنما للجميع (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) نزلت على الغالب لأنها حالة وقعت وجئن لكن لو لم تريد تحصنًا هي لا تسأل عن الحكم. (إن) شرطية لكن نزلت على الغالب الواقع في المجتمع الفقهاء الأصوليون يقولون ليس لها مفهوم مخالفة بمعنى إن لم يردن تحصنًا فأكرهوهن، لا، هذا غير مطلوب لكن الآية وصفت حالة واقعة فقال (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) الله أعلم بنواياهنّ لكن لو لم يكنّ يردن التحصن ما جئن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكين. قال بعدها (لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) لتبتغوا مالًا، كان الرجل منهم يقدّم الجواري
المقدم: ما قال مالًا وإنما عرض الحياة الدنيا
د. المستغانمي: لأنه عارض وسوف يذهب، كل مال الدنيا عرضٌ زائل
المقدم: كأنه يذكرنا نا بزوال هذا المال
د. المستغانمي: فيه إشارة للزوال وهذا من الإرداف عوض أن يقول: لتبتغوا مالًا عارضا فعبّر بالمرادف وهو إرداف ليفيد معاني جديدة
المقدم: وقبلها بقليل قال (وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ)
د. المستغانمي: لو جاء هنا بلفظ آخر قد يقول ما المطلوب مني؟ أعطاه الشيء الواضح: آتوهم من مال الله الذي آتاكم فكما تفضل عليكم تفضلوا عليهم.
المقدم: نأتي بعدها لمسألة قد يحار البعض فيها (وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) غفور رحيم لمن؟ ربما يقول البعض في غير القرآن كان يمكن أن يقول شديد العقاب لمن يكرهوهن.
د. المستغانمي: ومن يكرهنّ فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، غفور لمن؟ لدينا في هذه العملية جانبان: جانب المُكرِهين وجانب المُكرَهات النساء، الله غفور للمكرهات وليس للمكرهين. لو قال: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور للمكرهين، تناقض الكلام قال (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ) فكيف ينهى عن شيء ويقول إن الله غفور رحيم؟! إذن المغفرة والرحمة للفتيات المكرَهات ما عندها قوة، حتى إن عبد الله بن مسعود كان يقرأ هكذا وإن كانت قرآءته تعتبر شاذة لم يقرأ بها القرّاء العشرة، كان يقرأ: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهنّ (يضيف كلمة لهنّ) هذه قرآءة بالتفسير، يستأنس بها في الشرح.
المقدم: لا يقرأ بها في الصلاة. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ) هي مبيِنات أو مبيَنات؟
د. المستغانمي: القرآءتان صحيحتان، في قرآءتنا في حفص عن عاصم مبيِنات بكسر الياء ومبيَّنات بفتح الياء، اسم فاعل واسم مفعول وكلاهما قرآءة سبعية صحيحة، فهي توضح غيرها وهي في ذاتها مبيَّنة واضحة.
المقدم: هنا (وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) ما المقصود بـ(وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا)؟
د. المستغانمي: هنا الآيات المبيِّنات والمبيَّنات الواضحات وصفها الله تعالى بثلاث صفات: بأنها مبيِّنة ومبيَّنة وبأنها تنبئنا عن مثل الذين من قبلنا وبأنها موعظة. الآيات السابقات التي تحدثت عن حادثة الإفك، من التي رميت بالإفك؟ عائشة المطهرة سيدة عظيمة زوجة رسول عظيم، من مثلها عندما رمي يوسف عليه السلام في التاريخ الإسلامي اتهمته امرأة العزيز حتى برأه الله وشهد شاهد من أهلها على برآءته، ومريم عليها السلام اتهمت (لقد جئت شيئا فريّا) ورموها بالبهتان العظيم وبرّأها الله، فما مثل عائشة التي اتهمت بهذه الفرية العظيمة الشنيعة التي لا أصل لها مثلها مثل من سبقها من الأنبياء ومن النساء اللواتي كُرّمن مثل مريم. وموعظة للمتقين، القرآن كله وعظ، والموعظة وهي أن تتخول المخاطب بكلام رقيق يستجيشه ويستميله إلى أن تصل به إلى ما تريد فأنت تعظه، هذا غير النهي. الوعظ هو أن تحرك مكامن الوجدان حتى يتأثر والقرآن كله مواعظ.
المقدم: لماذا قال (وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) أليس الأولى أن يكون موعظة لغير المتقين؟
د. المستغانمي: في القرآن هدى للناس، هدى للمتقين، هذا بيان للناس. القرآن وضحه الله سبحانه وتعالى للناس للعالمين ولكن الخطاب هنا للمجتمع المسلم فأراد الله تعالى أن يرقى بالمجتمع المسلم إلى درجة التقوى ونحن في كل الآيات تأمر بالتقوى، كأنه يمدحهم ويثني عليهم ويأمرهم أن يسموا إلى درجة التقوى.
المقدم: نأتي إلى الآية العظيمة (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾) ما موقع هذه الآية في السورة؟ ما علاقتها بمحور السورة؟ محور السورة الأسرة المسلمة وهنا لا يوجد حديث عن الأسرة المسلمة حديث عن ذات الله سبحانه وتعالى وهناك صورة جميلة مجازية؟
د. المستغانمي: هي المحور بمعنى الله أساس كل الأنوار وهو أصل الهدايات حتى إن الإمام الطبري يقول (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) أي هادي السموات والأرض، الإمام الطبري وابن كثير هم من علماء أهل السنة. يقولون الله نور ويثبتون ذاته العلية ما أثبت لنفسه. (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ) نقول ما قال به علماؤنا الكبار ولا نتجاوز في التحليل إلى أن نشِطّ أو ننزلق، نحن نقول بما قال به أهل السنة والجماعة ونحن من أهل السنة، ثمّة معتزلة، ثمّة شيعة، لهم آراؤهم. نحن نقول الرأي السديد ولا ننزلق وهو نثبت لله ما أثبت لذاته في الأسماء والصفات فالله نور، ما هذا النور؟ ما شكله؟ لا نمثّل ولا نجسّم الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة حتى إن ابن تيمية قال: الله نور في ذاته، الله نور في آياته، الله نور في صفاته، هذا كلام شيخ الإسلام في دقائق التفسير وتبعه تلميذه ابن القيم الله نور نثبت ما أثبت لذاته. نأتي للشق الثاني (مَثَلُ نُورِهِ) ليس المقصود نور الله بمعنى ذاته، قال الطبري: مثل الهداية التي يقذفها في القلوب، مثل القرآن الذي جعله ينير الطريق أمام الناس، مثل الوحي، المعرفة.
المقدم: لماذا قلنا في النور الأول بأنه نور ذات الله جل في علاه وفي النور الثاني هو نور الهداية؟
د. المستغانمي: لأن الأول مسند إلى الذات العلية (الله نور) مبتدأ وخبر. فأثبت لنفسه أنه نور، ما نوع النور؟ لا يستطيع أحد من الخلق أن يحدده أن يشبهه أن يمثّله، نقف عند الآية ونثبت له صفة النور وهو اسم من أسمائه الحسنى. أما الثاني فهو وضحه جلّ جلاله لأنه قال (يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ) نور القرآن وورد في القرآن (قد أنزلنا إليكم نورا مبينا) النور هو القرآن ينير الطريق (قد جاءكم من الله نور) النور محمد صلى الله عليه وسلم فكلمة النور لها عدة معاني.
المقدم: القرآن يفسر بالقرآن
د. المستغانمي: نور الهداية نور التقوى نور معرفة الوحي التي جاءت تنير طريق المسلمين المؤمنين بدليل أن الكافرين يعيشون في ظلمات (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ) الكافر يعيش في ظلام الجهل، ظلام الشرك، فالنور المقصود نور الهداية نور المعرفة، نور القرآن.
المقدم: نحن نبطل كل من قال مثل نور الله المتمثل في هذه المشكاة فيها مصباح
د. المستغانمي: هذه ليست تمثيلا لكلمة النور (الخبر) إنما نثبت أن الله نور أما الثانية تشبيه تمثيلي لنور الهداية. ما موقع الآية من السورة؟ السورة كلها هداية، كلها بيان (كذلك يبين) (آيات مبينات)، فنور الهداية اكتسبه المؤمنون من نور الوحي من نور القرآن إذن هي أصل بيان كل أحكام الأسرة. هل نجد هذا الميثاق وهذا الدستور الخاص بآداب المرأة المسلمة والأسرة المسلمة في أيّ قانون من قوانين البشر؟ يأمر غض البصر ويأمر المرأة بغض الطرف ويأمر بالعفاف ويسهل عملية التزويج ويأمر المرأة بإبداء زينتها لطوائف معينة، فيه قوانين دقيقة هذه لا توجد في جهة أخرى كل شيء مباح وبالتالي يقعون في حمأة الفواحش التي ما أنزل الله بها من سلطان!
المقدم: (الله نور) قلت هذا نور الله سبحانه وتعالى والثانية (مثل نوره) قلتم تشبيه تمثيلي، ما المقصود بالتشبيه التمثيلي؟ وهناك تشبيه مجازي وتشبيه بليغ وضمني
د. المستغانمي: التشبيه التمثيلي هو نوع من أنواع التشبيه والبلاغيون يقولون هو أرقى أنواع التشبيه. مثلا في اللغة العربية عندما نشبّه نقول أحمد كالأسد في الشجاعة، لو قلنا أحمد أسدٌ هذا تشبيه بليغ، إذا حذفنا وجه الشبه وأداة التشبيه يكون تشبيهًأ بليغًا. لو قلنا أحمد كالأسد في الشجاعة، هذا تشبيه تام الأركان. أبو فراس الحمداني يتكلم عن نفسه يقول:
سيذكرني قومي إذا جدّ جِدّهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
هذا تشبيه ضمني هو ما قال أنا بدر وإنما قال “وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر” شبّه نفسه بالبدر وسيذكره قومه يومًأ ما عندما تدلهمّ الخطوب. التشبيه التمثيلي أرقى لأنه تشبيه هيئة بهيئة، تشبيه حالة بحالة ويكون وجه الشبه ليس في كلمة وإنما يكون منتزعا من متعدد، أحد الشعراء الكبار يقول:
وأصبحتُ من ليلى الغداةَ (ليل كانت تعده بالوصل فيقول أصبحت من وعدها التي دائما تسوّف ولا ينال منه شيئا هذه حالة واقعية)
وأصبحتُ من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع
حالة جميلة، هو شبّه وعود ليلى وعدم تطبيقها لوعدها وعدم مبالاتها والحالة النفسية التي عاشها كإنسان قابض على الماء لو قال قابض على الماء وسكت لما اكتمل التشبيه ولكنه قال كقابض على الماء خانته فروج الأصابع، هذا تشبيه تمثيلي. القرآن مليء بالتشبيه التمثيلي، عندما وصف القرآن اليهود (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) [الجمعة: 5] لو قال كمثل حمار وسكت لا يتضح التشبيه ولو قال كمثل الحمار يحمل لا يكتمل التشبيه يحمل أحجارا لا يكتمل، ولكنه قال (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) إذن مثل اليهود الذي حملوا التوراة ثم لم يعملوا بمقتضاها ولم يتدبروها ولم يطبّقوها كمثل الحمار يصفهم بالبلادة والحمار يحمل كتبا وأسفارًا – لا أثقالًا – ولا ينتفع به، فكل هذه التقنيات تساعد على الإيضاح, وهنا مثل نور الهداية والعرفان ومثل نور القرآن الذي يعطيه الله للمؤمنين كمثل مشكاة المشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري هنا لدينا متعدد مثّل الله به نور الهداية ونور العرفان.
———-فاصل————-
المقدم: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾) لنقف عند مفردات هذه الآية: ما المشكاة؟ ما المصباح؟ كيف تمثيل هذه الآية؟
د. المستغانمي: هو كلام دقيق ولا بد أن نقف وقفة حذر في وصف هذا التشبيه التمثيلي. أولًا التشبيه التمثيلي لنور الهداية في قلوب المؤمنين. مثل نور الهداية في قلوب المسلمين نور القرآن الذي ينور قلوبنا جميعًا إن شاء الله كمشكاة والمشكاة هي كوّة في حائط غير نافذة إذا كانت نافذة تسمى النافذة في حائط التي تُرى من الجهتين أما الكوة فهي نصف دائرية في حائط ويقولون مشكاة كلمة حبشية استخدمها العرب وعرّبها العرب. (فِيهَا مِصْبَاحٌ) المصباح معروف مصباح الإنارة كان من زجاج أو غيره، أيّ شيء ينير المصباح مهما كان شكله هو أداة الإنارة والإصباح لأن صيغة مِفعال في اللغة اسم آلة مثل مفتاح وسيلة الفتح، مصباح وسيلة الإصباح والإنارة، منشار وسيلة النشر. (كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ) أيهما أهم المشكاة أم المصباح؟ المصباح لا شك. لو كان التشبيه بسيطًا لقال مثل نور الهداية كمصباح لأن المصباح هو الذي ينير، لكن الله تعالى لا يريد هذا التشبيه البسيط وإنما يعطينا الصورة الكلية حتى تتخيل كوة منحصرة فيها مصباح أشعته لا تتشت وتنشتر، في كوّة هذه الكوة تعكس شدة الإنارة. (كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ) مصباح نكرة هنا، (الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ) قد تسأل لماذا قال (فيها مصباح المصباح) وكان يمكن في غير القرآن أن يقال كمشكاة فيها مصباح في زجاجة؟ كرر المصباح لأن هذا في البلاغة تشابه الأطراف: يشوقك: كمشكاة فيها مصباح، العربي اللغوي يسأل: أي نوع من المصباح؟ المصباح المذكور في زجاجة، أي نوع هذه الزجاجة؟ الزجاجة كأنها كوكب دريّ يُترك السامع يتفاعل. إذن عندما تأتي بكلمة نكرة ثم تأتي بها معرفة هذه تشابه الأطراف، هذه بلاغة، قمة البلاغة!. إذن كمشكاة فيها مصباح معيّن، أداة إصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة نكرة، العرب عرفوا الزجاج والإغريق عرفوا الزجاج قديمًا ونحن نعرفه الآن. الزجاجة كأنها كوكب دريّ الكواكب عندما ينعكس عليها ضياء الشمس تنير، هذا تشبيه عادي ضمن التشبيه الكلي. الزجاجة كأنها كوكب دري هذا تشبيه عادي دخل ضمن التشبيه التمثيلي المركّب وسأعطيك فائدته: الزجاجة كأنها كوكب دريّ من الدُر المشعّ وبعض القُراء قرأها (دِرّيء) فِعّيل من درأ يدرأ الظلام بمعنى يلاشي الظلام يدفع الظلام ويبعده، قرآءة صحيحة ولكن القرآءة المشهورة عندنا حفص (دُريّ) من الدر الذي يلمع ويسطع. وهذه الصيغة دري ولُجيّ هذه الصيغ قليلة في الاستعمال ووردت في سورة النور وهي من أيقونات السورة. (كوكب دريّ) هذا الكوكب الدري يأتي بمادة الإيقاد الزيت، المصباح يحتاج لمادة إيقاد والعرب كانوا يوقدون المصابيح بالزيت لكن أيّ نوع من الزيت؟ من شجرة مباركة قال العلماء هي شجرة الزيتون هي مباركة قال صلى الله عليه وسلم: كلوا منه وادّهنوا. وفيه فوائد عجيبة وزيته المعتصر منه يفيد الجسم فوائد غذائية وطبية وصحية وفي الوقود النار أصفى ما تكون عندما تكون من الزيت الجيد. هنا قال (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ) ما زلنا في نفس السياق لو شاء لقال يوقد من زيتونة، لكن القرآن سماها من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. أبهم في البداية ثم فصّل، الإبهام ثم التفصيل تقنية تجذب الناس (كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ) المصباح يوقد من شجرة أنت تتساءل أية شجرة؟ مباركة لشيئين: لما فيها من فوائد البركة ولأنها من شجرات البلاد المباركة الشام وأول ما جاء الزيتون وأنبته الله في بلاد الشام وفي سيناء كما ذكرنا في سورة المؤمنين، في سيناء كلم الله موسى وهي شجرة مباركة وبلاد الشام قال الله فيها (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: 71]. مباركة زيتونة هذا نوعها، لا شرقية ولا غريبة. أصل الشجرة من نوع أشجار الزيتون، لا شرقية ولا غريبة هنا خاض فيها العلماء ليست موجودة في الشرق مباشرة للشمس وليست غربية تحتجب عنها الشمس إذن هي شجرة في مكان وسط، هي شجرة في الوسط تتعرض للشمس صباح ومساء وهذا أصفى لزيتها وأجود له. في اللغة عندما نجد بين كلمتين متعاكستين (لا ولا) فإننا نقصد الوسط (لا شرقية ولا غربية) (لا فارض ولا بكر) وسط بين ذلك (لا إله هؤلاء ولا إلى هؤلاء) لما تجد كلمتين متضادتين في المعنى يقصد الوسط حتى إن صاحبة حديث أم زرع لما وصفت زوجها أبا زرع قالت: زوجي كليل تهامة لا حرّ ولا قرّ بمعنى مزاجه وسط. وهنا لا شرقية ولا غربية يعني هي وسط وذلك أجود لنوعية الزيتون وأصفى لزيتها. تخيل هذا التصوير لهذا المصباح: جمع لهذا المصباح كل وسائل الإنارة والإشعاع والإصباح: (مشكاة) تحصر الضوء، لو قال في غرفة الشمس مضيئة لكن ضوؤها ينتشر في الكون هو أراد جلّ جلاله أن يعبّر عن شدة الإضاءة في مكان منحصر، يكون في قلب المؤمن. المشكاة تضم هذا المصباح في زجاجة هذه الزجاجة شفافة هذه الزجاجة كأنها كوكب، هذا المصباح يوقد من شجرة مباركة زيتها أصيل من بلاد الشام أو تكون معرضة لأشعة الشمس صباحًا ومساءً وذلك أصفى لزيتها، والعرب كانوا يعرفون ذلك.
(يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ) الزيت مضيء. كأنه يقول: يكاد زيتها يضيء سواء مسته النار أو لم تمسسه النار (ولو لم تمسسه نار) دلت على الجملة المحذوفة، بلاغة! هذا حذف في القرآن، يكاد زيتها يضيء سواء مسته النار أو لم تمسسه نار. ثم قال (نُورٌ عَلَى نُورٍ) نور مضاعف نور المشكاة نور المصباح نور الزجاجة نور صفاء الزيت كيف يكون هذا النور؟ الله تعالى عبر عنه قائلًا (نُورٌ عَلَى نُورٍ) نور مضاعف
المقدم: (نُورٌ عَلَى نُورٍ) ما المقصود بالنور الأول والنور الثاني؟
د. المستغانمي: نور مضاعف، انتقلنا إلى نور القرآن نور على نور، لما تأتيك سورة البقرة هي نور سورة آل عمران نور في قلوب المؤمنين، يشبّه نور القرآن في قلوب المؤمنين.
المقدم: ألا يحتمل أن يكون المقصود بـ(نُورٌ عَلَى نُورٍ) نور الله الذي بدأ فيه في الخبر الأول (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ثم (عَلَى نُورٍ) نور الهداية؟
د. الستغانمي: كله وارد وهذه الآية محتمِلة ولذلك تكلم فيها العلماء في مئات الصفحات. مثّل الله نور الهداية في القلوب نور معرفة الوحي شجرة الوحي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام أمين السماء إلى أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم هي تنير القلوب وتهديها بدليل (يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) هذا مثل لنور الإسلام، نور القرآن الذي يقرأ القرآن يعيش في النور والدليل ما سوف يأتينا من أن الكفار يعيشون في الظلام ظلام الشرك ظلام الإلحاد ما عنده وازع، حتى عندما ينام لا يعرف، أسلمت لمن؟ أنت تذهب للنوم تصلي العشاء وتقول ربي أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، أما إنسان لا دين له إلى من يلجأ؟! هذا إنسان يعيش في ظلام الشرك، والإلحاد لذلك الآية تمثّل نور الهداية والله أعلم.
المقدم: التشبيه التمثيلي لا يقف تتوالى صور كثيرة في الآيات التي تلي فيقول في الآية التي بعدها (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾) لماذا قال (فِي بُيُوتٍ)؟ بدأ بشبه جملة جار ومجرور، عادة يبدأ بالاسم مبتدأ أو خبر قبل المبتدأ أو جملة فعلية لكن هنا شبه جملة جار ومجرور فهل في ذلك دلالة؟
د. المستغانمي: في كل ذلك دلالة سواء عرفنا أم لم نعرف، في كل القرآن الكريم، هنا الآية بدأت (فِي بُيُوتٍ) وسورة قريش السورة بدأت بجار ومجرور (لإيلاف قريش) ولا توجد سورة غيرها بدأت بجار ومجرور. هنا يشير ويعلمنا جميعًا السورة التي قبل سورة قريش هي سورة الفيل، لماذا فعل ربك ما فعل وأهلك أصحاب الفيل؟ لإيلاف قريش. لكي تألف قريش رحلتي الشتاء والصيف فعل الله ما فعل بأبرهة ومن معه إذن بدأت سورة قريش بالجار والمجرور لتبين شدة ارتباط سورة قريش بسورة الفيل حتى إن بعض العلماء عدّوها تتمة لها. وهنا (فِي بُيُوتٍ) تتعلق بماذا؟ الراجح عند العلماء (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا) يسبح لله فيها رجال، (فِي بُيُوتٍ) البيوت هنا يقصد بها المساجد (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) الله جلّ جلاله أمر أن يذكر اسمه في كل مكان لكن (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ) أنها المساجد وهذا قول المفسرين، بيوت الله فالجار والمجرور متعلقة بالفعل المتأخر (يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ) كأنه يقول: يسبح رجال في بيوت فيها (فيها) الثانية مؤكدة للأولى، هذا المعنى الأول. لماذا بدأها (فِي بُيُوتٍ) كان من الممكن أن يقال: يسبح لله في بيوت، أتت على هذا النسق لأنها تحتمل أشياء والقرآن فيه إشعاع بالإعجاز. (فِي بُيُوتٍ) وأنا أميل إلى هذا الرأي تتعلق بالتشبيه التمثيلي كمشكاة فيها مصباح المصباح أين يوقد؟ في بيوت، أين يوجد نور الهداية؟ أين يشع نور القرآن؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت متعلقة بالتشبيه التمثيلي. الكوة تقع في بيت من بيوت الله، تكون في منزل جميلة ولكن في بيت من بيوت الله تكون أجمل وأكثر إشعاعًا لذلك القرآن كلام للأذكياء وللحكماء وللمتدبرين كمشكاة تقع في حائط هذا الحائط يقع في بيت من بيوت الله فيه مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريّ يوقد في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا قمة تشبيه النور الذي يصدر من القرآن من المساجد.
المقدم: نعود في الحلقة القادمة للحديث عن هذه الآية (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾)
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة النور – 6
تفريغ سمر الأرناؤوط – موقع إسلاميات حصريًا
المقدم: توقفنا عند قول الله تعالى في الآية (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾) لماذا بدأت الآية بالجار والمجرور (في بيوت)؟ وما المقصود بـ(رجال) ولماذا وصفهم بهذا الوصف؟
د. المستغانمي: (في بيوت) جار ومجرور متعلق بشيء، العلماء قالوا إما متعلق بما بعده وهو: يسبح لله رجال في بيوت أذن الله أن ترفع، ومعظم العلماء حسب البحث أن البيون هنا هي المساجد والرأي الثاني بعض العلماء يرجحون أن يكون الجار والمجرور متعلق بالمشكاة التي فيها مصباح، كأن التشبيه التمثيلي ما زالت توابعه مسمرة: المصباح يوقد في بيوت أذن الله أن ترفع وبالتالي نور الهداية يجنيه المسلمون من بيوت الله. أعطيك بعض الأدلة على أن البيوت هي المساجد، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف والسنّة مثل القرآن في التشريع: “ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفّتهم الملائكة..” (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ) ما هي البيوت التي أذن الله أن تُرفع؟ نذهب إلى سورة البقرة قال تعالى (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) [البقرة: 127]. ما معنى (أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ)؟ أذن الله أن تُبنى وتُرفع، لو قال تُبنى تبني مترًا أو مترين يكفي لكن قال (أن تُرفع) تعظيم المساجد شيء عظيم برفعها حتى تزيين المساجد هذا يدخل ضمن تعظيم شعائر الله عندما نرفع بنيانها ونعتني بها نرفع شعائر الله، المسلم ينبغي أن يرتقي إلى قمم الإسلام الشامخة فهنا (أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ) يذكّرني بقول الله تعالى (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ) إذ يبني ويرفع. لكن لو قال يبني لا تسد مسد يرفع لكن يرفع تسد مسدّ يبني ويرفع.
المقدم: البعض يقول هذا إشارة أن الأساس كان موجودًا فجاء إبراهيم وابته فرفعا البناء على هذا الأساس الموجود
د. المستغانمي: نعم هذه رواية صحيحة لكن سؤالي لم يقل “وإذ يبني إبراهيم” إشارة إلى البناء فالرفع وهنا قال (َذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ)
المقدم: هل يأذن الله للناس برفع بيوت الناس؟
د. المستغانمي: المفسرون يقولون أذِن يعني أمر. أولًا قال (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ) لم يقل (أمر) وفي التفاسير أذن بمعنى أمر والإذن من تقنيات السورة ونحن في سورة الاستئذان، من نفس العائلة المعجمية قال (أذن الله). ثانيًا عبّر عن المساجد بالبيوت وفي كل القرآن (مساجد) لأنه ورد ذكر البيوت في السورة وهذه سورة البيوت ولا يوجد سورة ورد فيها (بيوت) مثل سورة النور (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ) (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ) في آية الطعام قال (وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) هذا رحاب سورة النور، في سورة النور يحلو ويستقيم ومن الحكمة الربانية أن تسمى المساجد (بيوت)، في غيرها (وأن المساجد لله) في سورة البقرة (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) [البقرة: 114] لأن سورة البقرة فيها الحديث عن المساجد (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) وعن السجود أما في سورة النور فالحديث عن البيوت.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول (يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ ﴿٣٦﴾ رجال) الغداة أول النهار والآصال العشيّ نهاية النهار من بعد العصر. لماذا قال رجال؟
د. المستغانمي: (رجال) نكرة تنطبق على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتنطبق على كل من يعمرون مساجد الله لو قال الرجال يقصد بهم الصحاة فقط، فكلمة (رجال) وصفهم أنهم رجال لا تلهيهم التجارة ولا الأموال عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهؤلاء يتصفون بأنهم (يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) تتقلب فيه القلوب والأبصار هذا اليوم كناية عن الخوف والفزع يوم القيامة، يخافون ذلك اليوم العظيم، لا تشخص الأبصار، تتقلب فيه القلوب والأبصار.
(يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ ﴿٣٦﴾ رجال) يسبحون في المساجد وفي البيوت يكثرون من التسبيح والتهليل والذكر. (لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ) التجارة أن يتّجر الإنسان، التجارة بيع وشراء يربي أموالهم بالبيع والتجارة هذا التاجر قد يربح وقد يخسر ولكن استوقفني الوصف (لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ) لم يقل شراء، التاجر يربح عندما يبيع، صفقة البيع يكسب مالا فمن باب أولى أن الشراء لا يهمهم، هؤلاء الصحابة أو اي أناس لا تلههم تجارة، هذه عامة، لو كنت تشتري شيئا وسمعت الأذان تقول أشتري بعد الصلاة لكن لو كنت بائعًا محترفًا والصفقة فيها مربح والزبون عندك والأذان يؤذن، البيع أكثر من عقل التجار يجلب لهم الأرباح لذلك إذا كان البيع لا يلهيهم فمن باب أولى لا يلهيهم الشراء. فالقرآن يبني الكلمات بحيث تفيد ثراء المعنى.
(رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) ذكر الله القرآن (إنا نحن نزلنا الذكر)، التسبيح والتحميد والنهليل كلها ذكر.
المقدم: لماذا خصص الصلاة والزكاة وعادة ما تأتي مقترنتين ولم يتحدث عن الحج أو الصوم
د. المستغانمي: لأنه يتحدث عن المساجد، وأقرب الأشياء للمساجد الصلاة، المساجد بنيت الصلاة، لذلك هذه البيوت يسبح لله فيها ويعظّمه وينزهه رجال لا تلهيهم أموالهم (تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ)، عبّر عن الأموال بالتجارة والبيع وعبّر عن ذكر الله ووضّح شيئا من ذكر الله (الصلاة)
المقدم: خصّ الزكاة بالذكر لأنه ذكر في الآية مسائل مالية (تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ)
د. المستغانمي: لا تلهيهم عن إقام الصلاة وإذا كانت لديهم أموال يؤدون زكاتها والذي يحدوهم لهذا أنهم يخافون يومًا (يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) (يومًا) نكرة، يومًا شديدًا عسيرًا (يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) كناية عن شدة الفزع والخوف، لم يقل (تشخص فيه الأبصار) مع أنها وردت في مواضع أخرى، قال (تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) تتقلب وتدور من شدة الفزع. هنا ذكر تتقلب القلوب هذه حركة جسدية والأبصار تدور من شدة الخوف في الدنيا والآخرة. بعد قليل عندما يذكر الأدلة الكونية يقول (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) النهار يعقب الليل والليل يعقب النهار، في مواضع أخرى عبّر (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) و(يكوّر النهار على الليل) وهنا عبّر (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)، تجاذب الألفاظ: تتقلب القلوب والأبصار – يقلّب الله الليل والنهار.
المقدم: (لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾) ماذا تفيد هذه اللام؟
د. المستغانمي: لام التعليل ليجزيهم الله، يفعلون كل ما فعلوا لكي يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق رزق القرآن رزق التقوى رزق المال لذي ينتهي عن التجارة وقت الصلاة هذا الله يرزقه بغير حساب.
المقدم: هنا الجزاء ليس من جنس العمل بل يجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وبعدها والله يرزق من يشاء بغير حساب.
المقدم: الآية بعدها فيها صورة غريبة تتحدث عن الذي كفروا أعمالهم كسراب (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾)
د. المستغانمي: هذا تشبيه تمثيلي ليس تشبيها عاديا، لو قال أعمالهم كسراب فهذا تشبيه عادي لكن قال (أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا) تصوير الخيبة والخيبة لا تصوّر في كلمة. لو قال أعمال الكافرين كسراب، قبل قليل تحدث عن أعمال المؤمنين وهنا التناسب يأتي بالبشارة ويأتي بالإنذار يأتي بأعمال المؤمنين ويأتي بأعمال الكافرين عندما تحدث عن أعمال المؤمنين وأنه يجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله كأن سائلا يسأل وما أعمال الكافرين؟ هناك إنسان كافر يبني المستشفيات وأنا كثيرون لهم عطاءات كبيرة لكنهم يجحدون وجود الإله ويجحدون لا إله إلا الله فقال (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ) وهذا يذكرنا بقوله تعالى (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾ الفرقانا) معناه كل ما عملواه هباء وهنا (كسراب). السراب في اللغة العربية عندما نكون في الصحراء في قافلة أو في سيارة وفي الجو الحار الشديد تأتي الرطوبة فترتفع فوق الرمال هي ظاهرة طبيعية تراها العين لكنها غير موجودة، المفسرون ذكروا هي عبارة عن رطوبة تعلو الرمال فيراها الماشي في الصحراء ولشدة تلهفه على الماء وهو ظمآن (يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ) ما قال يحسبه الإنسان، أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء يحسبه أي يظنّه الظمآن ما قال يحسبه الرآئي لكن الرائي للماء عطشان فازداد تشوقه للماء، أين يكمن السراب؟ (بقيعة)
المقدم: (يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً) يحسب من الأفعال التي تأخذ مفعولين يعني يحسب السرابَ ماءً
د. المستغانمي: القيعة هي المكان المنبسط (القاع) تشبيه تمثيلي ينتزع من متعدد (كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ) وثلّث (يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً) لم يقل يحسب الإنسان الماشي في الصحراء، الإنسان الذي يمشي في الصحراء يتلهف إلى الماء كما يتلهف الكافر يوم القيامة إلى عمل ينفعه فعندما يأتيه (وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ) بعد التمثيل جئنا إلى الواقع. أولًا قال (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ) يهمنا هنا الأعمال، ما قال “وأعمال الذين كفروا” ولكن لعنصر التشويق في التعبير قال (والذين كفروا) يتشوق السامع ويتساءل: ما شأنهم؟ ما بالهم؟ عن ماذا سيتكلم؟ عن اعتقادهم؟ عن زناهم؟ لا، عن أعمالهم. (الذين كفروا) عامة، ثم جاء يفصّل كأن السائل يتشوق لمعرفة ماذا يخبر عنهم، والذين كفروا أعمالهم بقيعة يحسبه الظمآن الماشي نحوه حتى إذا وصله المفترض أنه لا شيء ولكن هنا انقلب التعبير من التمثيل إلى الحقيقة (حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ) انتقلنا إل يوم القيامة (فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ) على الشر لأنه كان كافرًا. هذا الإنسان الذي حسب السراب ماء عوض أن يجد الماء الذي يطفئ عطشه وجد عدوًا يريد أن يقتله ويأخذه فهنا انقلب التعبير من التمثيل إلى الحقيقة يوم القيامة (وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ) أعطاه الله حسابه لم يزده فوفاه حسابه الحقيقي الذي يستحقه (وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ). هنا تشبيه تمثيلي لخيبة الكافرين الشديدة يوم القيامة، كثير من الكافرين ينفقون بالملايين ويظنون أنهم يفعلون خيرا كثيرا هم ينالون جزاءهم في الدنيا لأنهم لم يعترفوا بأن الله هو الآمر وكل عمل خير لا بد أن تؤمن وتوحّد وأن تنتظر الجزاء يوم القيامة فالذين عملوا عملا ولم يصحب ذلك العمل ولم يصحب عملهم إيمان صحيح وعقيدة صحيحة فأعمالهم تذهب أدراج الرياح (فجعلناه هباء منثورا) هم عملوا خيرا يجنونه في الدنيا نسمع كثيرًا أكبر الأغنياء الذين لهم صيت وصولجان وعاشوا (كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ الإسراء)
المقدم: نأتي لصورة أخرى (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ) الكاف للتشبيه، نفس الموضوع ولكن صورة أخرى
د. المستغانمي: (أو) تفيد التخيير: كذا أو كذا، وهي حرف عطف كأنه يقول أعمال الكافرين كسراب إن كنت من أهل الصحراء أعطيك مثال (كسراب بقيعة) وإن كنت من أهل البحر أعطيك مثال (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ) يعطي أعمال الكافرين ويبين أنها لا تفيد
المقدم: وهذا لأهمية الموضوع فالمعلم عندما يشرح للطلاب يعطيهم المثال بعد المثال حتى يوصلهم إلى الذي يريد.
د. المستغانمي: في سورة البقرة يتكلم عن أعمال المنفقين (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ البقرة) إن شئت شبههم بهذا أو بهذا، (أو) للتخيير في الوصف للقارئ والمتدبر. القرآن يشع بالإعجاز! كيف شبههم؟ أعمال الكافرين كسراب وفي سورة إبراهيم (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾ إبراهيم) السؤال لماذا هنا قال كسراب وفي سورة إبراهيم (كرماد)؟ السراب يتناسب مع الإبصار مع النور في سورة النور، السراب تراه بالعين وسيرد في السورة في الآيات بعدها (لأولي الأبصار) أما الرماد فيتناسب مع النار وسورة إبراهيم ورد فيها كثير من مفردات النار (مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾) كثير من مفردات النار وقاموسها في سورة إبراهيم، وردت جهنم مرتين والنار مرتين وقطران والصديد والرماد، كلمات تتجاذب، ففي سورة إبراهيم قال (كرماد) وفي سورة النور (كسراب) وهذا من إحكام اللفظ القرآني فوصف الأعمال بالسراب في سورة النور أوقع وأحسن وأجمل.
المقدم: (أَوْ كَظُلُمَاتٍ) والظلمات له علاقة بالإبصار كذلك
د. المستغانمي: شبّه أعمالهم بما يتناسق مع جو السورة. إذن (أَوْ كَظُلُمَاتٍ) ليس ظلمة، (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ) عميق، اللجة عمق الماء في البحر، لجيّ أمواجه تتلاطم هناك المحيطات تكون عميقة إلى عشرة كيلومتر وفي المحيطات تتراكم الأمواج، ظلمة الموج الأول وظلمة الموج الثاني وفوقه السحاب والسحاب يحجب ضوء الشمس، ظلمات بعضها فوق بعض. إذن عندنا ظلمة الأمواج الباطنية وظلمة الأمواج السحاب كل هذا يغشي ويمنع ويحجب الأنوار من الشمس فيكون الظلام في المحيطات مغطشًا (إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا) أحيانا في شدة الظلام في الليل يمكن أن تخرج يدك تراها لكن هنا ظلام ليس معه إشعاع نور أبدًا. بعد أن وصف الظلمات ظلمة الموج فوقه ظلمة السحاب قال إذا أخرج يده ولم يقل ” لم يرها” قال (لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا) لم يقارب رؤيتها، (كاد) تفيد التقريب، من أفعال المقاربة لو قال إذا أخرج يده لم يرها، تعبير جميل لم يقارب رؤيتها هو كثير البعد أن يرى كأنه يقول من المستحيل (لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا) لم يكد المنفية لم يقارب رؤية يده إضافة إلى التجانس في السورة
المقدم: في شأن الظلمة قال (إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا) وفي شأن الإبصار والنور قال (يكاد زيتها يضيء)
د. المستغانمي: عندما عبّر عن إضاءة نور الله الذي بدون زيت بدون إيقاد يكاد يضيء عبّر عن شدة الإضاءة في نور الهداية والقرآن والإسلام عبّر عن شدة ظلام الجهل والشرك بأنه (لم يكد) وانظر إلى التناسق بين يكاد يضيء وبين لا يكاد يراها وقال فيما بعد (يكاد سنا برقه). في سورة النور: يكاد سنا برقه، يكاد يضيء، لم يكد يرها والسورة قبلها لم نرى فيها كاد، إذن القصد والحكمة في استعمال ألفاظ خاصة في ثوب خاص حكمة القرآن في التعبير وإعطاء كل سورة ثوبها التي تتميز به.
المقدم: (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)
د. المستغانمي: هذه خلاصة كل ما سبق، إذا لم يرزقك الله نورا وإذا لم ينر قلبك بالقرآن والإسلام فما لك من نور، من لم يجعل الله له نور الهداية فإنه سوف يعيش في الظلام الدامس. المنطق اللفظي: ومن لم يجعل الله نورا فسوف يعيش في الظلام لكنه قال (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) نحن في سورة النور فسوّغ التعبير بالنور حتى مع الذي لم يجعل الله له نورًا. هو يتكلم عن الذي لم ينر طريقه، في غير القرآن: ومن لم يجعل الله له نورًا فهو في ظلام، قال (فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) رجّح التعبير بالأنوار ومفاها أفضل من أن يتحدث عن الظلام، هذه خلاصة التشبيه التمثيلي العظيم مع أعمال الكافرين. إذن حسن بعد وصف أعمال المؤمنين التي تستضيء بنور القرآن ونور الهداية والوحي ووصف بعد ذلك ضياع أعمال المشركين شبهها بالسراب وشبهها بالظلمات وهي كلها لا تنفع ولا تجدي فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا. (فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) (ما) نافية ينفي عنه جنس النور، ليس لهم من النور شيء (فما له من نور) وجاءت نكرة ومنفية يعني أبدا لن يصل إلى قلوبهم شيء من النور.
———فاصل———–
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾) ما علاقة هذه الآية بمحور السورة والحديث هنا عن تسبيح الله تعالى وعبادته؟
د. المستغانمي: العلاقة أن ما قبلها تحدث الله عن أعمال المؤمنين وكيف أنهم يسبحون لله سبحانه وتعالى وهذا هو الأصل الأصل أن الكل يسبح لله لأن الله تعالى خلقنا لنعبده (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ الذاريات) (يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ ﴿٣٦﴾ رجال) إذن عندما تحدث عن المؤمنين الذين يسبحون لله ويعبدون ويقيمون الصلاة ذكر التسبيح، ذكر بعد ذلك أعمال الكافرين الذين تذهب أعمالهم أدراج الرياح ولا ينتفعون بها لأنهم لا يسبّحون ولا يؤمنون وكان الأولى بهم أن يفعلوا ذلك وهنا انتقل إلى أن يقول للكافرين انظروا إلى الخلق انظروا إلى السموات وإلى الأرض والطير كلها تسبح وهي غير عاقلة وكان الأولى أن تهتدوا بنور القرآن وبنور الهداية. (من) للعاقل و(ما) تفيد العاقل وغير العاقل. (من) يتحدث عن العاقل وأيضًا الطير.
المقدم: (من) تستعمل للعاقل لماذا استعملها هنا للطير؟
د. المستغانمي: للتغليب، الطير جنس آخر. تأتي على الجميع. (من) اسم موصول يفيد العاقل في الأغلب و(ما) تفيد العاقل ولغير العاقل (من في السموات) تنطبق على العقلاء: الملائكة وغيرهم لا نجزم (وما من دابة في السماء) نحن لا نستطيع ما ننفي بل نثبت ما أثبته القرآن وليس لدينا من الأدلة. وجه الارتباط أن المؤمنين يسبحون لله، أن المشركين والكافرين أعرضوا عن الإيمان وعن التسبيح، هنا فتح الله بابًا واسعًا (ألم تر) يا محمد الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون علمية، هذا كلام العلماء والمفسرين يمكن أن تكون (ألم تر) رؤية عينية نرى الطير صافات الطير تسبح بحمد الله بأصواتها وبصفّها ويمكن أن تكون (ألم تر) رؤية قلبية (ألم تر) ألم تعلم (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) عامة كل شيء حيوانات أشجار كل شيء يسبح (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) كل الجماد كل الحيوانات كل المخلوقات تسبح ولكن كثيرا من الناس لا يسبحون. الآية تقول (ألم تر) والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتّى خطابه ألم تر أيها المفكر أيها العالم، أيها المثقف، أيها المشرك، الكافر، أن الكون كله يسبح؟ (وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ) تصفّها، هذه جملة جديدة، جنس الطير، (الطير) الألف واللام تفيد الجنس، بعض العلماء قال هي ليست في السموات وليست في الأرض وإنما بينها فلذلك ذكرها، هي تطير، ذكر أنواعا من المخلوقات التي تسبح والكواكب تسبّح والشمس تسبح وهنا قال (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وفي سورة الحج قال (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) [الحج: 18] لأن الحديث فيها عن السجود وفيها سجدتان وفي هذه السورة سبق الحديث عن التسبيح (يسبح له فيها بالغدو والآصال) فناسب ذكر التسبيح. والمخلوقات تسبّح وتسجد لكن البيان القرآن يختار الأنسب مع كل سورة.
(كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) (كلٌ) تعود على كل المخلوقات، من الذي علم صلاته وتسبيحه؟ لها معنيان: كل جنس قد علم صلاته وتسبيحه وكل قد علم الله صلاته وتسبيحه، القرآن حمّال، ما دام الجملة تحتمل قال العلماء كلٌ من الأجناس السابقة علم صلاته وتسبيحه وكلٌ قد علم الله صلاته وتسبيحه. (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) وأضاف (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) القياس كان يقول: ألم تر أن الله يسبح له – كلٌ قد علم تسبيحه” لكنه قال (صَلَاتَهُ) لأن الصلاة تعود على العقلاء بالدرجة الأولى والتسبيح عام لكل المخلوقات الصلاة دعاء والدعاء يكون للعاقل والتعقيب (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) لم يقل بما يعملون لأن يفعلون عامة، الشمس تفعل والطير يفعل والشجرة تفعل لكن العمل خاص بالإنسان، العمل خاص بالعاقل والفعل عام. الفعل عام والعمل هو للتأثير وهو خاص والصنع أخص لم يقل عليم بما صنعون بينما في غض البصر قال (صنع الله) لأن الإنسان يحذق في البصر، ما أجلّ هذا الكلام!
المقدم: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾) ما المقصود بالآية؟
د. المستغانمي: ما زلنا مع التنبيه إلى دلائل الوحدانية ودلائل الخلق وعظمة الخلق وعظمة صنع الخلق (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾) كثيرا في القرآن (لله ملك السموات والأرض) هنا إنسان يملك قلما، بيتا، سيارة، (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾) هذه آية عجيبة نمر عليها مرة يقول (لله ما في السموات والأرض) يملك ما في السموات والأرض والعلم الآن عن طريق التلسكوب وجدوا ملايير المجوم والكواكب والنجوم فتطامن أيها الإنسان، هذا ملك ربك! ماذا نملك نحن من الدنيا؟! لا نملك حتى النفس الذي نتنفسه ومع ذلك يتلطف الله بنا وينعم!
(ألم تر) الحديث ما زال موجهًا للرؤية (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا) ألم تر أيها المخاطب أن الله يزجي سحابا والإزجاء هو سوق السحاب والرؤية هنا تتسق مع النور وقد تكون بصرية أو علمية. (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي) يزجي أي يسوق السحاب عن طريق تسخير الرياح التي تدفع السحاب وعندما تأتي قطع تتآلف يجعله ركامًا وثمة سحاب موجب وسالب عندما تلتقي يحدث البرق بعد الركام يأتي البرق والودق هذه الآية محملة بعناصر كونية عجيبة، طبيعة فيها سحاب يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ركاما أي متراكما والركم في اللغة العربية هو الجميع والتجميع بحيث يتراكم نقول يتراكم ونقول سحاب مركوم، سحاب مركوم بمعنى اسم مفعول وفي سورة الطور قال (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ الطور) (ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ) الودق هو المطر جاء التعبير عن المطر بالودق في سورتين في سورة النور وفي سورة الروم (اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ الروم) لا أستطيع أن أقول لماذا الودق دون المطر؟ لماذا؟ سأبحث شخصيا عنها لكن عندما تحدث عن نوعين من أنواع السحاب ذكر الودق: ذكر الله هنا السحاب الركامي. الذين يدرسون الجو وعلم الأرصاد الجوية يفرّقون بين أنواع السحاب، ذكر الله هنا نوعين عظيمين ينقسم إليها السحاب: السحاب الركامي الجبلي تراه يتراكم كالجبال أحيانا يتراكم عشرات الكيلومترات والذين يسافرون بالطائرة يرون السحاب الركامي. ولدينا في الحياة السحاب البساطي (فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ) في سورة الروم. ذكر الله كلمة الودق مع السحاب الركامي والسحاب البساطي لماذا؟ تحتاج إلى بحث.
(مِنْ خِلَالِهِ) الخلال هنا الثقوب، خلال جمع خلل، جبال جمع جبل في اللغة العربية، ترى الودق يخرج من فتوقه الصغيرة وينزل من السماء من جبال من برد كأنه يقول وينزل من السماء ليس منها كلها وإنما من جبال فيها، من الغيوم التي تأخذ أشكال الجبال من برد فيصيب به من يشاء. ينزل ماذا؟ ينزل بردًا من جبال فيها برد. وأثبت العلماء المتخصصون في علم الطبيعة والسحاب أن البرد لا ينزل إلا من السحاب الركامي لأنه يتكون في مرتفعات، السحاب يتكون من بخار وعندما يكون البخار في طبقات الجو قد يتراكم وينزل الماء فورا ويذوب وكلما ارتفع تكون البرد لأنه كلما ازداد الارتفاع ازدادت البروةد, العلماء يقولون أن البرد لا ينزل إلا من السحب الركامية وأما السحب البساطية لا ينزل منها برد! من علّم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو لم يخرج من مكة ولم تتجاوز قدمه غار حراء وهذا أكبر دليل أن القرآن من عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف السحب الركامية ولا البساطية وعاش في صحراء كلها حرارة وأتى بكلمات دقيقة عجيبة، إنه القرآن (قل نزله الذي يعلم السر )
المقدم: ما مناسبة قوله تعالى (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ)؟
د. المستغانمي: البرق يحدث مع السحاب الركامي عندما يحدث لمعانًا – هكذا قرأتها في التفسير – هو البرق يكاد يأخذ الأبصار، هو البرق ظاهرة كونية عجيبة يحدثها الله سبحانه وتعالى أولًا لأشياء علمية أنا لا أستطيع أن أشرحها وأيضًا للإخافة وردت في سورة البقرة (يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا) هذا في المثل الذي ضربه للمنافقين فعبّر أنهم يعيشون في الظلام عندما يأتي البرق أنار الله طريقهم وإذا ذهب البرق يعيشون في الظلام انغمسوا في الظلام، مثل للمنافقين. وهنا قال (سَنَا بَرْقِهِ) السنى الضوء، سنى (بالألف المقصورة) الضوء، السناء (بالهمزة) بمعنى الرفعة والسمو، (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ) يعني ضوء برقه (يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) لشدة الإضاءة، وفي سورة البقرة لا يوجد سنا (يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) سورة النور أولى أن يذكر فيها سنا، لأن سنى هي الضوء والنور يتلاءم، سورة النور جمع فيها كل الكلمات التي تفيد الإنارة والإصباح: المشكاة، المصباح، كوكب، دري، يضيء، قاموس! ظلمات معاكسة للنور. في سورة النور قال (يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) أما في سورة البقرة تحدث عن المنافقين (يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) قال يخطف لأن الحديث عن المنافقين الخطف يتناسب مع سلب النور من المنافقين وأما في سورة النور فظاهرة كونية عجيبة يشرحها القرآن في سورة النور فخخفها على المؤمنين وهو يتحدث عن ظاهرة قرآنية عجيبة قال يذهب (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ).
(يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾) عبرة لأولي الأبصار ولأولي البصائر، انظر إلى التناسق والإيقاع! بينما عندما تحدث عن المنافقين قال (يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) لم يقل يخطف الأبصار وإنما قال أبصارهم هم، عندما تحدث عن قوم قال أبصارهم ولم يقل الأبصار وهنا جنس الأبصار تستفيد من والضياء (يكاد يذهب) وهو لا يذهبها بإذن الله إلا لمن شاء جلّ جلاله.
المقدم: ذكر الله الليل والنهار وتقلب الليل والنهار ولم يقل يولج الليل في النهار والمفردات الأخرى التي وردت في القرآن نقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة النور – 7
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
المقدم: توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾) وذكرنا أنه ورد في مواضع أخرى (يولج الليل) (يكور النهار) وفي يس قال (نسلخ منه النهار) فما دلالة قوله تعالى هنا (يقلب الليل والنهار) وهل في ذلك علاقة بمحور السورة؟
د. المستغانمي: الآن انتقلنا من التشريعات المتعلقة بالأسرة المسلمة إلى توجيه الناس إلى دلائل القدرة ودلائل الخلق كيف أن الله سبحانه وتعالى تفرّد بالخلق وأعطانا أدلة خلق السموات والأرض، يزجي السحاب، تقليب الليل والنهار ليس شيئا بسيطا وهو دليل على كروية الأرض القرآن لم يقل الأرض كرة لو قال أنها كرة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والناس يمشون على أرض مسطحة لما تقبلوا هذا الكلام (يقلب الليل والنهار) يجعل الليل والنهار يتعاقبان على نفس المنطقة وهذا يدل على أن الأرض كرة فالجهة المقابلة للشمس يكون فيها نهار والجهة الأخرى يكون فيها ليل فعندما يقلبهما ويتعاقبان دليل على كروية الأرض ودورانها والآن جاء العلم الحديث عن طريق الأقمار الصناعية يرون الأرض كروية ما في ذلك شك وهذا إثبات علمي. (يقلب الليل) التقليب التجاذب اللفظي في سورة النور قال تعالى (يخافون يوما تتقلب فيه ) تتغير ونخاف وتخشع ويصيبها من الفزع ما يصيبها وما سمي القلب قلبًا إلا لتقلبه وفي الحديث “القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. (يقلّب) فعل مضارع والفعل المضارع كما يقول النحاة يفيد التجدد والاستمرار وعملية تقليب الليل والنهار مستمرة إذن ينفعها الفعل المضارع. (إن في ذلك) في تقليب الليل والنهار أو فيما سبق، يجوز الوجهان. إن في كل ما سبق من الأدلة لعبرة لأولي الأبصار والعقول إن في ذلك التقليب السابق لعبرة لأولي الأبصار. لو قال في غير القرآن إن في تقليب الليل والنهار لعبرة لأولي الأبصار لخصصها ولم يفد الاستمرارية، الله عز وجلّ هنا غيّر الأسلوب قال (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾) لو قال إن في ذلك التقليب يتكلم عن التقليب لكن ليس فيها الاستمرارية التي يفيدها الفعل المضارع. هذا الذي يفيده البناء، نظم القرآن يفيد معاني جديدة كلما تأملت فيه.
المقدم: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾) الله سبحانه وتعالى هنا تحدّث عن ممَ خلق الله سبحانه وتعالى كل دابة ما المقصود بالدابة؟ ولماذا خصص (منهم من يمشي على بطنه)؟ وهل هناك ما يمشي على بطنه؟ أو يزحف على بطنه؟ وقال يمشي على رجلين ويمشي على أربع ولكن هناك من يمشي على عشرات الأقدام ودقائق الأقدام الصغيرة التي قد لا نراها فلماذا خصص هذا الأمر؟
د. المستغانمي: هنا غيّر الأسلوب (والله خلق) لم يقل: يخلق كل دابة كما قال (يقلب الليل والنهار). تغيرات في الأسلوب (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾)) لأولي الأبصار والعقول والبصائر وهنا لم يقل يخلق وإنما بدأ جملة جديدة استئنافية لإظهار عظمة الله في المخلوقات (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ) كل ما يدبّ على الأرض سواء يمشي على قدمين، يزحف على بطن، على أربعة أرجل على أكثر من ذلك، لماذا ذكر فقط على رجلين، على بطن، على أربعة أرجل؟ هو ذكر الغالب الذي نراه، عبّر للناس وهو يخاطب العرب في عهد قريش بما يعرفون هم يعرفون الزاحفة ويعرفون الإنسان الذي يمشي على رجلين ويعرفون الحيوانات التي تمشي على أربع ولو قال لهم ثمة من يمشي على أكثر لقالوا أين هذا؟! هو سبحانه خاطبهم بما يعرفون ولكن الآية لم تحصر لو قال: “إنما خلق” لحصر وهنا لا يوجد لا حصر ولا قصر، قال (والله خلق) أسلوب يصف أن الله خلق كل دابة من ماء، (ماء) نكرة، من أيّ نوع من الماء؟ الماء أنواع وتتغير خصائص النطفة بتغيّر الحيوانات، إذن هي نكرة. منهم من يمشي على بطنه، في الحقيقة منهم من يزحف، اللغة العربية تقول يزحف على البطن وتسمى الزواحف وهي أنواع شتى لكن (منهم) تنطبق على العقلاء، لما أراد وعبّر عن العقلاء وغلّب جاء بكل ما يتصف به العقلاء والعقلاء لا يزحفون فلما قال (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ) المقتضى: من يزحف لكن بما أن (منهم) اقتضت يمشي للمشاكلة وللمحافظة على التناسق (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ) (منهم) للعقلاء والحيوانات تمشي على أربع فبما أنه غلّب العقلاء غلّب الفعل (يمشي) على يزحف ليناسب. وبدأ بالبطن لأنها الأصعب، المشي على رجلين أسهل، المشي على أربع أسهل بدأ بالأصعب لأن الأصعب والأشق يدل على القدرة، من جعله يزحف على بطنه ولا يوجد له أقدام؟! نحن نتكلم بالمنطق العقلي أما في عظمة الله لا يعجزه شيء الذي أمشاه على رجلية يمشيه على رأسه، حتى أنه لما قيل (يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما) فقالوا كيف يمشي على وجهه؟ قال الذي أمشاه على رجليه يمشيه على وجهه والله على كل شيء قدير. لذلك هنا الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا وينبهنا إلى مخلوقاته (منهم من يمشي على بطنه) بمعنى يزحف (ومنهم من يمشي على رجلين) وهو الإنسان (ومنهم من يمشي على أربع) وهي الحيوانات، في كل هذه المخلوقات أسرار عجيبة الله يوجههنا إليها والعلم الحديث أثبت أن كل دابة خلقها الله من ماء.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى (لَقَدْ أَنْزَلْنَا آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾) أيّ آيات هذه؟
د. المستغانمي: السابقة، (لقد أنزلنا آيات مبينات) كل ما سبق من أدلة الكون، من أدلة الخلق، من أدلة السحاب، خلق الدواب.
المقدم: هنا قال (آيات مبينات) بينما قبل آية النور قال (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾) فلماذا ذكر (إليكم) هنا ولم يذكرها هناك؟
د. المستغانمي: قبيل آية النور جاء التعليق عن الأحكام السابقة التي تتحدث عن التشريع: تشريع حد الزنا، حدّ القذف، حدّ الرمي، غضّ البصر، كل الآيات التي سبقت آية النور كانت تتعلق بالتشريع للأسرة وأنزل الله هذا التشريع (إليكم) أيها المسلمون إذن الحديث خاص وموجه للمسلمين وللمؤمنين: لقد أنزلنا إليكم أيها المسلمون وشرّعت لكم. أما التعليق هنا جاء بعد آيات الكون، وآيات الكون لكل البشر وليست فقط للمؤمنين، لكل من يعقل، لقد أنزلنا آيات مبينات في خلق السموات، في السحاب هنا الآيات آيات كونية. قد تقول (أنزلنا) أنزلنا في القرآن تستعمل للإنزال الحقيقي (أنزلنا الحديد فيه بأس شديد) إنزل من السماء، هنا آيات كونية، وليست أنزلنا فقط بمعنى آيات تتلى ففي القرآن (أنزلنا لكم من الأنعام) الثوب اللفظي لسورة النور اقتضى (أنزلنا) وهي آيات أيضًا منزلة من الله ولكن أيضًا آيات كونية تدعونا إلى التنبه وإلى التأمل في خلق الله فإذن هي ليست موجهة لنا فقط وإنما للخلق فحذفت (إليكم).
المقدم: (وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾) من الذين يقولون؟
د. المستغانمي: المنافقون الذي كانوا يعيشون في فترة نزول سورة النور. قلنا في أول حلقة في سورة النور أن الفواصل اللغوية لسورة النور هي (آيات بينات) بمجرد ما تأتي (آيات بينات) انتقلنا إلى باب آخر، نحن الآن مع باب المنافقين.
المقدم: (وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾)
د. المستغانمي: هذه الآية تتحدث عن المنافقين، والمفسرون يقولون (ويقولون) تعود على المنافقين لم يذكر أهل النفاق باللفظ أو بالتصريح لكن حالهم لا يخفى على الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي ولا يخفى على قارئ القرآن الكريم. من الذين كانوا إذا جاؤوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا دعوا إلى الحكم عند الرسول يفرّ,ن؟! إذا دعوا إلى الله والرسول ليحكم بينهم إذا فريق منهم بعرضون؟! هم المنافقون. كأن القرآن جرّدهم من الاعتقاد لم يقل “ويعتقدون قائلين” وإنما قال (ويقولون) مجرد كلام! الله وصمهم ووسمهم بأنهم يقولون كلامًا تقوله الألسنة (آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا) أطعنا من؟ أطعنا الله والرسول ولكن لم يذكر المفعول به لأنه واضح من السياق. (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) من الذين عهدهم وديدنهم أن يتولوا دائمًا؟ المنافقون، ويُعرضون عن محمد صلى الله عليه وسلم. (ثم يتولى فريق منهم) أنصفهم لم يعمم، ليس كلهم كانوا يتولون لكن يتولون إذا سمعوا الوحي والقرآن وهم معرضون ثم بعد ذلك وصفهم بالصفة (وما أولئك بالمؤمنين) هذه آكد، وصفهم بالجملة الاسمية (ما) النافية (أولئك) اسم إشارة ميّزهم حتى لا يختلطوا بالمؤمنين (وما أولئك بالمؤمنين) لم يقل وما أولئك بمن آمن، ليسوا من جنس المؤمنين، نفاهم أن يكونوا من دائرة المؤمنين، وما قال أولئك بمؤمنين، وما قال وما أولئك بالذين آمنوا لأن الجملة الاسمية أشد في وصمهم ووصفهم بعدم الإيمان.
(وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾) ليحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. المفسرون يذكرون سبب نزول الآية أن أحد المنافقين اختصم مع يهودي من اليهود حول قضية معينة فذلك اليهودي كان محقًا فقال لنحتكم إلى رسول الله وهو كان يهوديًا ويعرف أن محمدا يحكم بالحق فأبى ذلك المنافق في البداية ثم وافق فلما ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بالعدل وأعطى الحق لليهودي لأن القضية ظاهرة لم يرض المنافق بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نذهب إلى كعب بن الأشرف يهودي من كبار اليهود، اليهودي رفض أن يذهب إلى اليهودي كعب بن الأشرف وقال لا، محمد حكم بيننا. وهما يتكلمان تساوق بهما الحديث إلى عمر بن الخطاب – الرواية يذكرها المفسرون كالقرطبي وابن كثير وغيرهم- يقولون ذهبا إلى عمر بن الخطاب، اليهودي قال له ذهبنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحم بيننا وحكم لي، فتحقق عمر بن الخطاب وقال أصحيح حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لليهودي؟ فأجاب المنافق نعم وأردنا أن نحتكم إلى غيره. فقال عمر بن الخطاب مكانكما، على رسلكما، فذهب عمر وأتى بسيفه فضرب المنافق فقتله وقال: هذا حكم عمر فيمن لم يرض بحكم رسول الله. ولذلك قال العلماء سمّاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق بسبب هذه الواقعة وإن كان في سندها شيء من الكلام. لكن الواقعة حدثت واليهود لا يرضون لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان معهم الحق وعلموا أن القضية في صالحهم وثمّة من الأدلة ما يبررون به أحقيتهم يذهبون إلى رسول الله لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وأنه يحكم بالحق والعدل يأتوا إليه مذعنين طائعين منقادين.
وجاء بعدها (أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾) ما أعظم هذه الاستفهامات!. القرآن الآن انتقل بتركيز البيان القرآني لفضح الطائفة بالأسلوب الإنشائي الذي يحرّك النفوس (أفي قلوبهم مرض) هنا جملة إسمية (أفي) استفهام، ثم قال (أم ارتابوا) جملة فعلية، لم يقل أم في قلوبهم ريب. (أفي قلوبهم مرض) تشير إلى سورة البقرة (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) إذن المرض متعشش مترسّخ متجذر. (أم ارتابوا) جملة فعلية فعل ماضي: آمنوا ثم ارتابوا دخلتهم شكوك في حق الإسلام وفي أحقية محمد صلى الله عليه وسلم وفي عظمة القرآن. التدرّج (أم ارتابوا) (أم يخافون) جملة فعلية بالفعل المضارع (أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ) أن يحيف يعني أن يظلم في المسألة من الحيف وهو الظلم في الحكومة، الظلم في المسألة، كل هذا الكلام ينطبق عليهم في الحقيقة: هم في قلوبهم مرض، في قلوبهم الريب ارتابوا هم يخافون بينهم وهذا خوف غير مبرر وهنا جاءت الآية اللازمة (بل) للإضراب ولتثبيت ما سبق (بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ) حقًا وصدقًا وفعلًا (أولئك) مبتدأ (الظالمون) خير، (هم الظالمون) قصر عليهم الظلم وكأن غيرهم غير ظالم، هذا قصر إضافي وصفهم بالظلم مبالغة. لم ينفِ عنهم المرض في قلوبهم ولا شيئا مما ذكر في الآية وإنما هذا إضراب انتقالي. (بل) تفيد الإضراب قد يكون إضرابا انتقاليا أو إبطاليًا، هنا إضراب انتقالي ما أبطل ما قبله وتدرج معهم. (أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا) (أم) هذه المنقطعة تفيد الإضراب بمعنى تتضمن استفهامًا بداخلها (أم أفي قلوبهم) كأنه يقول أفي قلوبهم مرض بل هل ارتابوا؟ أو أرتابوا؟ بل أيخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. انتقل الأسلوب (بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ). لماذا غيّر ما بين (أم) و(بل) وكلاهما يفيد الإضراب في هذا السياق؟ لأن (بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ) لم يشأ الله أن يجعل القضية عن طريق سؤال، هنا وصفهم بالسؤال والاستفهام وهنا أثبتهم بأسلوب تقريري ووصمهم بالظلم العظيم (بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ) كأنه يقول لا غيرهم، هناك غيرهم ظالمين هنا ليس حصرًا حقيقيًا وإنما قصر للمبالغة.
المقدم: الله عز وجلّ يقول (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾) لماذا قدّم (إنما كان قول المؤمنين)؟ فيها تقديم وتأخير، تقديم الخبر (قولَ) أين اسم كان؟
د. المستغانمي: اسم (كان) يأتي بعد (أن) اسم كان في هذه الجملة المصدر المأوّل المنسبك من (أن والفعل المضارع بعدها) نقول: أن والمصدر المأوّل غير الصريح الذي ينسبك من (أن) والفعل المضارع بعدها في محل رفع خبر (كان) ولكن تم تأخيره بسبب: (إنما كان قولَ المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) اسم كان: (أن يقولوا سمعنا وأطعنا) هو اسم (كان) وقول خبر (كان) وقدّم الخبر لشيئين اثنين:
الشيء الأول أنه لا تُجمع في اللغة العربية بين أداتين، صحيح (كان) فعل ولكن هي أداة ناسخة نقول فعل ناسخ لها عمل (الناقصة والناسخة) لها عمل. لو جئنا باسمها مباشرة بعدها يصير الكلام: “كان أن يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا” فصارت (كان وأنّ) أداتان اجتمعتا، العرب لا يقولون هكذا وهذا إجباري إلزامي في اللغة إذا اجتمعت أداتان يفرّق بين الثانية. (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾) لو كان المصدر صريحًا يجوز أن يأتي اسمها بعدها مباشرة.
ثانيًا: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ) جملة (إذا دعوا إلى الله ورسوله) هذه قيد، (كان قول المؤمنين) كانت مقولتهم حين يُدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما سبب المجيء؟ السياق يتحدث عن المنافقين فما جدوى الحديث عن المؤمنين هنا؟ كأن القرآن يقول: لما كان المنافقون يُعرضون عن حكم الله ورسوله بينما المؤمنون الصادقون يسمعون كلام الله ورسوله بضدّها تتميز الأشياء، لما تكلم عن المنافقين وأنهم يعرضون عن حكم الله ورسوله تهيأ المقام لذكر المؤمنين الصادقين الذين يحتكمون إلى الله ورسوله.
المقدم: تكررت قضية الحكم في السورة (إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) وفي الآية التي قبلها (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) وفي بداية السورة أحكام
د. المستغانمي: كلها أحكام، سورة بيان سورة تشريع سورة إصدار أحكام سورة تجمع الأمة وتجمع الأسرة وترشدها سورة الطاعة وستجد في السورة ذكر الطاعة كثيرًا (أطيعوا الله) (أطيعوا الرسول) (طاعة معروفة) وهل تحتاج الأحكام إلا إلى الطاعة، تكرر لفظ الطاعة كثيرًا في سورة النور دلالة أو إيماء إلى المسلمين لكي يطيعوا الله ورسوله وهذه من الثوب اللفظي للسورة، قضية الطاعة والنور والبيان والأحكام.
————-فاصل——————-
المقدم: من الثوب اللفظي لسورة النور “الطاعة” (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾) نتوقف عند الآيتين.
د. المستغانمي: الآية الأولى هي تعليق على ما سبق عندما تحدث عن المؤمنين الصادقين المخلصين أنهم كانوا يقولون سمعنا وأطعنا، عندما قال (إنما كان قول المؤمنين) هذا أسلوب حصر لكن هنا لا ينبغي أن يُفهم بأنه لا بد كل مؤمن يقول “سمعنا وأطعنا” فقط لو قلت “لبيك يا رب” بالمرادف يجوز، ليس المقصد اللفظتان فقط :سمعنا وأطعنا” وإلا لا يكون مؤمنا ولكن هذه عادة العرب يقولون: سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا لكن لو قلت حاضر، لبيك يا رب، كلها طاعة، كلها ألفاظ تؤدي المعنى. ثم جاء التعليق (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ) في قرآءة حفص و(يتقِه) وهي مسألة صوتية تحدث عنها بعض العلماء (فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) ترقّي في الأسلوب قال قبلها (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المفلحون اسم فاعل من أفلح، (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أتت على نفس التركيب (بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ) بما أنه وصف المنافقين بأنهم (أولئك هم الظالمون) وصف المؤمنين بما يضادّ ذلك قال (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ترقّى الآن (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) من يجمع بين طاعة الله ورسوله وزاد (وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ) زاد الخشية والتقوى هنا لا بد من الترقي (فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ)، كلنا مفلحون أما الفائز فقد أخذ النتيجة وقصب السبق فهو فائز كما قال في فريق المؤمنين (إن جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون) في سورة المؤمنين. الآية التي بعدها (وأقسموا) المنافقون، السياق مسوق للمنافقين ولكن تحدث عن المؤمنين ليبين الخلل الكبير عند المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون وإذا دعوا إلى الله ورسوله لا يحتكمون بينما المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا كأنها جملة اعتراضية تحدث عن صدق المؤمنين وطاعتهم ثم عاد إلى المنافقين (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) وأقسموا هم، واو الجماعة تعود على المنافقين. (جهد أيمانهم) يقسمون جاهدين، كلمة (جهد) في الإعراب اللغوي فيها قولان:
إما نقول هي حال وأقسموا بالله جاهدين
أو مفعول مطلق للفعل يجهدون جَهدا.
هكذا قال المفسرون وكلاهما يؤدي إلى ما بهم من توكيد “يكاد المريب يقول خذوني” لأنهم يعرفون أنهم مقصرون في حق الله ورسوله وقالوا لهم لماذا لا تحتكمون لحكم الله وتفرون من حكم الله؟ قالوا: والله لئن أمرتنا لنخرجن، يخرجنّ إلى ماذا؟ إلى القتال. كأنهم يقولون يا محمد لو أمرتنا بالقتال لخرجنا فما بالك نحتكم إليك؟!! هذا شيء بسيط! ويجتهدون في ذلك ويقسمون على ذلك وردّ عليهم القرآن (طاعة معروفة) هذه ضُربت مثلًا كأنه يقول طاعتكم طاعة معروفة، نحن نعرف طاعتكم. طاعة معروفة تميل إلى النفي كأنه يقول طاعتكم طاعة معروفة معروف كذبها معروف انتفاؤها معروف وهنها فضربت مثلا وهذه في القرآن كثير (فصبر جميل) يعقوب عليه السلام يقول فصبر جميل أي فصبري صبر جميل. وهنا (طاعة معروفة) طاعتكم معروفة، هنا تهكم بهم، أسلوب تهكمي.
المقدم: ولا زال الحديث عن الطاعة
د. المستغانمي: لأنها سورة تأمر وتنهى فالأحرى بالمؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله. تكرر في السورة لفظ الطاعة كثيرا (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾) وكررها حتى لا يُظن أننا نطيع الرسول فقط فيم جاء في القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شرّع شيئا ولم يأتي ذلك الأمر في القرآن فهو من روح الإسلام فطاعة الرسول واجبة ولو أتى بشيء لم يذكر في القرآن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وأرانا كيف نحج خطوة خطوة، لم تذكر المناسك بدقة في القرآن لكن طاعة الرسول واجبة فيما شرّع طاعة الرسول واجبة وهو صلى الله عليه وسلم لن يخرج عن روح الإسلام فالله بعثه ليبين القرآن.
والحديث لا زال متواصلا عن المنافقين (فإن تولوا) تفهم بمعنيين:
- فإن تولوا هم تعود على المنافقين
- أو (وإن تتولوا أنتم) والتاء محذوفة للتخفيف فعل مضارع محذوف التاء وكثيرا ما تحذف التاء في القرآن (ولا تفرقوا أصلها ولا تتفرقوا) (تلقونه أصلها تتلقونه) التخفيف موجود.
(قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾) فإن تولوا أنتم أيها المنافقون بما أن الخطاب إليهم تحذف التاء لأنه معروف، وإذا حملناها كأن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الالتفاف قال: وإن تولوا هم المنافقون في الماضي فإنه عليه صلى الله عليه وسلم ما حُمّل، حُمّل بأمانة التبليغ (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)، فإنما عليه أمانة التبليغ التي حمّله الله إياها وعليكم ما حمّلتم من أمانة التكليف والتطبيق، الآية تقول فإن تتولوا أنتم فهو يتحمل التبليغ وكفى ليس عليكم بمسيطر ولا يرغمكم على الإيمان وأن تكونوا مخلصين وعليكم ما حمّلتم كما حمّل اليهود (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها) حمِّلوا التكاليف حمّلوا الطاعة والأوْلى بكم أيها المنافقون (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) في آية أخرى (إن على الرسول إلا البلاغ) ووردت (البلاغ المبين) في سورة أخرى فيها الإبانة وهنا في سورة البيان والتبيين فما على الرسول إلا البلاغ المبين.
المقدم: ما مناسبة الحديث عن وعد الله سبحانه وتعالى حين قال (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾) ربما دخلنا موضوعًا جديدًا قضية الاستخلاف والتمكين، هل هناك مناسبة لهذه الآية؟
د. المستغانمي: موضوع جديد بالنسبة لنا ونحن نقرأ في القرن الحالي لكن المسلمين الذين كانوا يعيشون في الخوف الشديد في المدينة المنورة تتكالب عليهم القبائل ويتخطفونهم حتى إن أحد الصحابة وكانوا يصلّون في الحديد -بمعنى في السلاح- قال يا رسول الله: ألا يأتي يوم –هكذا ورد في السيرة وورد في أسباب النزول – نرتاح فيه ونأمن ونصلي فيه بدون حديد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تغبرون أي لا تمكثون إلا ايام وسوف يصلي أحدكم محتبيًا صلاة بدون سلاح. فجاء هذا الوعد العظيم.
مناسبة الآية لما قبلها لأن المنافقين كانوا يدسّون السموم للمسلمين وكان اليهود يناصرون المنافقين والمجتمع المسلم الذي تنشئه سورة النور كان يعيش في الخوف: غزوات: أحد، المصطلق، الأحزاب، نزلت سورة النور منجمة في القرآن المدني فجاءت هذه الآية تفتح شعاع الأمل (وعد الله) ووعده حق لا يتخلف (وعد الله الذين آمنوا منكم) هم كانوا خائفين، كلمة (منكم) تنطبق على المؤمنين جميعا وكلمة (منكم) تخفف وتعطي أملًا للصحابة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات هذه تطمئنهم أكثر (ليستخلفنهم في الأرض) بشرى عظيمة وجاء نصر الله واستخلف المؤمنين وفتحوا تبوك وخيبر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوسعت رقعة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين وليمكنن لهم في الأرض (نون التوكيد الثقيلة) في كل هذه الكلمات، قوة إلهية (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا) كانوا خائفين، ما قال ليؤمِّننكم، لا، هم كانوا يعيشون في خوف، هذا الخوف سيذهب ويزول وهذا وعد لا يتخلف من الله.
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) (منكم) جاءت بين آمنوا وبين عملوا الصالحات، في سورة الفتح بعدما استقرت الأمور وفتحت مكة واطمأن المسلمون (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) [الفتح: 29] أخّرها لأن صار الأمر وفتحت مكة واطمأن المسلمون. كانوا يحتاجون إلى تقديم (منكم) في آية سورة النور حتى يطمئنوا أكثر فأكثر العرب تقدّم من الكلام ما هم ببيانه أعنى فقدّمها لكثير من الطمأنة.
المقدم: (يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا)
د. المستغانمي: (يعبدونني) جملة مضارع حال كونهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا حال كونهم يؤسسون دولة تقوم على الحق والعبادة.
المقدم: عبادة الله بشكل مطمئن وبراحة لا فيها خوف ولا تنغيص ولا فيها عذاب لكن بعد هذا كله من يشرك بالله ويكفر بالله يتحمل المسؤولية.
د. المستغانمي: يعبدونني بمعناها الشامل، نحن الآن في عبادة، نحن نشرح القرآن، العمل، التعليم، الطب، كل عبادة بمفهوها الشامل فالإسلام يأمر بالعبادة بمفهومها الشامل والمجتمع المسلم لا بد أن يعبد الله وأن لا يشرك به شيئا.
المقدم: يستمر الحديث عن العبادة (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾)
د. المستغانمي: هذه وسائل النصر ووسائل التمكين حتى إن بعض المفسرين قال هي شرطية بمعنى سيستخلفهم جلّ جلاله وليمكننّ لهم دينهم وليبدلنّهم من بعد خوفهم أمنًا شريطة أن يعبدوني عبادة بدون شرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، شرط مقتبس ومفهوم من المضمون العام لكن الإعراب يفضّل أن تُعرب في محل نصب (حال).
المقدم: (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾) ما مناسبة هذه الآية؟
د. المستغانمي: زيادة تطمين عندما رأوا المشركين كانت لديهم قوة وشوكة وسلاح وتمكين مؤقت لا تحسبن الذين كفروا معجزين لن يعجزوا الله ولن يعاجزوه لكن الله تبارك وتعالى يترك القدر يمشي بأسباب من البشر.
المقدم: ندخل إلى موضوع فتح سابقًا ثم فصل بينه وبين تتمته بفاصل كبير ثم عاد وهو قضية الاستئذان. هنا يتحدث مرة أخرى عن الاستئذان (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾) لماذا لم يأتي والسورة نزلت منجّمة ترتيب هذا الموضوع مع السابق ولا شك أن هذا هو الأصح
د. المستغانمي: ما فعل الله جلّ جلاله هو الأصح وترتيب نظم القرآن أعظم ترتيب (كتاب أحكمت آيات ثم فصلت) إحكام، تفصيل، نظم عجيب، هي صحيح آيات عن الاستئذان – هذا في البلاغة من باب رد العجز على الصدر وهذا ديدن القرآن ليس هنا فقط ورد كثيرا في القرآن يبدأ بموضوع يناقشه يبلوره يوضحه ثم ينتقل إلى موضوع آخر يجلّيه ثم يعود إلى الموضوع الأول حتى لا يُنسى – هذه تقنية بلاغية رائعة. ثم ما جاء في هذا الموضوع (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) هذا كلام فيه تتمة لمضمون الأول لو جاءت مباشرة بعدها لا يكون وقعها وقع الدواء. القرآن نزل منجمًا حسب الوقائع: لما نزل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾) صاروا يستأذنون لكن الذين ملكت أيمانهم دخلوا في الإذن السابق حتى أصبح الواحد منهم يدخل في أوقات حرجة يقول السلام عليكم ويدخل وقيل الرواية وقعت لإحدى النساء وقيل وقعت لعمر جاء رجل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وكان من خدمه فاستأذنه استئذانا بسيطا وكان عمر في حالة لا يريد أن يراه عليها الناس فقال عمر تمنيت لو أن الله تعالى منع عنا آباءنا وأبناءنا وخدمنا في مثل هذه الأوقات فوافقت رأيه. وفي رواية أخرى أن امرأة دخل عليها أحد خدمها من المشمولين بالإذن وكانت مخففة من ثيابها وقبل أن تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية تجيب المجتمع المسلم، مجتمع تتقلب أنظاره إلى السماء والوحي يتنزل رقراقًا يعالج، نحن عندنا الآن بدون مرض وتكون الثلاجة مليئة بأنواع الأدوية لكن عندما يقع المرض نتطلع إلى الدواء فنذهب ونبحث عن الدواء الدقيق. لو جاءت في الموضع الأول لكانت قضية فكرية نظرية لم تقع وقد لا تقع، لكن لما ترك القرآن المجال ووقعت جاء الدواء (ثلاث عورات) ولكن هذه (ليستأذنكم) لام الأمر (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ) الفجر ووقت القيلولة وبعد صلاة العشاء، ما قال ثلاث أوقات أو يؤكدها (ثلاث مرات) وإنما قال ثلاث عورات، هي نفسها. تكلمنا عن العورة التي لا تبديها المرأة أو الرجل العورة من عَوَر من العار وهو النقص، قال العلماء اللغويون: عورة الإنسان هو ما يلحقه عار إذا كشفه، إذا كشف الإنسان عضوًا في جسمه ولحقته المذمّة فهي عورة. كل ما تخشى أن يلحقك من إظهاره مذمة فهو عار. فقال (ثلاث عورات) ثلاث أوقات عار أن يرى الإنسان كان ولدًا كان بالغًا كان خدما هذه أوقات يتخفف المسلم والمسلمة من الملابس وقت النوم في الليل قبل الفجر ووقت القيلولة يتخفف يلبس ثيابًا تتناسب مع الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء يتخفف، إذن ثلاث أوقات هي مظنّة للتخفيف من الثياب فالأوْلى الاستئذان أكثر وأكثر.
في غير هذه الأوقات وقبل هذه الأوقات (طوافون) يطوف بعضكم على بعض، الولد والخدم الذي يكثر دخوله في غير وقت الظهيرة وفي غير قبل صلاة الفجر وفي غير بعد صلاة العشاء طوافون عليكم أما لو في كل لحظة استأذن يتحرّج الولد أو الأم فلذلك في غير هذه الأوقات (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) أنتم تطوفون عليهم وهم يطوفون عليكم لأن الإنسان يكون لابسًا ثيابه العادية والمرأة تكون لابسة ثيابها العادية.
(وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾) كما يستأذن الكبار البالغون التي ذكرت في الآية السابقة وجّه الله لهم الخطاب (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) الآن ألحق الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، إذا بلغوا الحلم يلحقون بهم (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾) عندما يبلغ الأطفال ينطبق عليهم ما ينطبق على البالغين.
لكن هنا نكتة لغوية في الآية السابقة قال (ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ) قال (الآيات) معرفة بالألف واللام والآية الثانية (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ) (آياته) بدون الألف واللام، هنا توقف العلماء: الآيات التي هي قبل في التشريع عندما أوضح الأوقات بدقة لا تقبل النقاش قال (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ) واضحة ليس فيها جدال فقال (الآيات) الواضحة بالألف واللام. أما الثانية لما جاء عن بلوغ الأطفال الحلم متى يبلغ الأطفال الحلم؟ تختلف وقضية مختلف فيها يعلمها الله تعالى، قال (آياته) التي هو يعلمها وأضافها إلى ذاته العليم الحكيم وجعلها نكرة مضافة إليه والفقهاء اجتهدوا جزاهم الله خيرا في تحديد وقت البلوغ.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة النور – 8
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
المقدم: نحن في هذه الحلقة وهي آخر حلقات البرنامج ما قبل رمضان، نحاول أن نتم سورة النور من أجل أن نلج سورة الفرقان، والفرقان هو القرآن الذي أنزله في رمضان، فمن المناسب أن تكون أولى حلقات البرنامج في رمضان إن شاء الله في سورة الفرقان.
الإجابة عن بعض أسئلة المشاهدين:
سؤال من الأخ ماء العينين دحمود: يقول الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ لماذا يقدم الله تعالى السجود على القيام والقيام ربما يكون أشمل؟ إذاً لماذا قدم (سُجداً وقياماً)؟ ولماذا جاء (سُجداً) بهذه الصيغة (فُعَّلاً) ولم يقل (ساجدين) و (قائمين)؟
د. المستغانمي: وقف المفسرون عند تقديم كلمة (سُجداً) على القيام، والقيام في الصلاة قبل السجود، ولكن ثمة دائماً اعتبارات في التركيب اللغوي القرآني وفي التركيب العربي ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ * ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ طبعاً يبيتون لربهم قياماً وسُجداً هو في تفكيره المنطقي وفي تفكيرنا أن القيام قبل السجود.
أولاً: التقديم هنا لعدة اعتبارات:
الاعتبار الأول: أن السجود في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، من أعظم أفعال الصلاة السجود، طبعاً القيام شيء عظيم ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ولكن عندما تسجد تفتح باب الدعاء، الله فتح أمامك أبواب الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
المقدم: وإن كان الصلاة تحسب بالركعات وليس بالسجدات؟
د. المستغانمي: جميل جداً صحيح. في كل ركعة معها سجدتان فالسجود يعني فيه خضوع والركوع أيضاً فيه خضوع، لكن السجود فيه طمأنينة وخضوع وخوف وتبتل وانقطاع أنت أمام الخالق، ويكفيك قوله تبارك وتعالى في نهاية سورة اقرأ ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ وخير ما يكون السجود ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ فالسجود شيء عظيم جداً. هذا رقم واحد، وهذا لا يبخس القيام حقه.
ثانياً: للإيقاع الصوتي للآيات: سُجداً وقياماً كل آيات عباد الرحمن تنتهي بهذه الميم الفاصلة القرآنية، الله عز وجلّ يراعي المعنى ثم الإيقاع، فالإيقاع لا يأتي على حساب المعنى، لكن مرعي، بعض الناس يقول لك: لا، كل القرآن فواصل وإيقاع صوتي عجيب، وإلا كيف تأثر العرب بهذا الكلام الجزل العظيم الذي له إيقاع يهز الوجدان؟! ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ * ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ * ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾. من المؤكد أن مراعاة المعنى موجود، لكن أيضاً الإيقاع وهذا التأثير الصوتي، ولذلك وثمة أسرار قد لا نعلمها.
أما قضية (سُجداً) على وزن (فُعلاً) سُجد جمع تكسير يفيد كثرة السجود، بينما عندما تحدثنا سابقا عن القيام نقول: هو قائم وهم قيام، والقيام الفعلي كلمة الجمع: (قياماً) هو الجمع الفعلي لـ (قائم) أما (قائم) (قائمون) هنا يتلبس بأمرٍ آخر مثلاً نقول: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ لما تقوم بأمر آخر، أما القيام الحقيقي فجمعه قيام، أما نقول: هؤلاء قائمون بأماناتهم.
المقدم: القيام الحقيقي المقصود فيه هيئة قيام الرجل أو المرأة قيام بني آدم، هذا يسمى قياماً، فنقول: (هم قيام) حقيقيون بينما نقول: (هم قائمون) أو يقومون بأمرٍ هم قائمون بالمسؤولية هم قائمون بشهاداتهم وليس القيام الحقيقي، قائمون بعمل ما أو قائمون بمسؤولياتهم. أما (سُجداً) على وزن (فُعلا) فتفيد كثرة السجود.
سؤال من الأخت سمر الأرناووط جزاها الله خير تقول: ورد في سورة الدخان: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ * ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ في سورة الذاريات ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ وفي الطور ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ وفي المرسلات ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾ فما دلالات هذا الاختلاف؟
د. المستغانمي: بارك الله فيك سؤال وجيه جداً وهو يخدم البرنامج بمعنى الكلمة لأنه من رحاب كل سورة، وفي الحقيقة أنا تدبرت هذا الكلام وكنت قد كتبت فيه شيئاً:
أما في سورة الدخان: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ * ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ لماذا قال في (مقام أمين)؟ أولاً: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ هذه واردة في كثير من آيات القرآن، وما جاء على الأصل لا يُسأل عنه، نقول: لماذا وردت ﴿ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾ و ﴿فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ في سورة الدخان عندما كان التعليق حول القوم الذين أهلكهم الله عندما قال: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ * ﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾* ﴿وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾ لما تحدث عن الذين ظلموا وكانوا في جنات وعيون أرضية في الأرض، ومقام كريم كانوا في سعة من المال والرزق، مقام كريم، ﴿وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾ لكن لأنهم لم يشكروا هذه النعمة ولم يوحدوا الخالق ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آَخَرِينَ﴾. لما جاء مقام ذكر المؤمنين في الجنات يوم القيامة ذكرهم بطريقة أفضل ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ أولئك كانوا في مقام كريم، لم يكونوا في مقام أمين، ما جدوى أن يكون لديك في الدنيا أموال، ولكن لا تأمن زوالها، فلذلك رد عليهم القرآن بطريقة حكيمة ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ عند الله ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ فلماذا قال ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾؟ سأختصر.
في سورة الذاريات أنا أرى بتوفيق الله جاءت على الأصل: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ * ﴿آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ إذا ذهبنا إلى الطور بعدها مباشرة ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ لماذا في الذاريات (وعيون) وهنا (جنات ونعيم)؟ أقول (في جنات وعيون) ترددت كثيراً فهي الأصل تقريباً حسب استقراء القرآن بينما لما قال: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ لأن النعيم جاء ذكره بالتفصيل في سورة الطور، اقرأ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ * ﴿فَاكِهِينَ بِمَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ * ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ * ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ جاء ذكر النعيم وكل الجزاء في الجنة نعيم، وفي الدنيا قلنا: متاع، مهما آتانا الله في الدنيا وكنا في بحبوحة هو متاع ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ في الجنة نعيم، لذلك هذه الألفاظ يستعملها الله بدقة. لما ذكرت تفاصيل النعيم في الطور فقال ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ * ﴿فَاكِهِينَ بِمَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ إلى أن يقول: ﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾* ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ﴾ * ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ﴾. هذا هو النعيم..
الآن نأتي إلى سورة المرسلات باختصار قال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾ ما الذي جعل السياق القرآني أو البيان القرآني يقول (ظلال)؟ في كل الجنات فيها ظلال عندما يقول ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ ويقول ﴿ظِلًّا ظَلِيلًا﴾، لكن القرآن يستعمل ما يتناسق مع السورة ففي سورة المرسلات كما تعرف وتعرف السائلة جزاها الله خير، يتحدث القرآن عن ظلّ الكافرين يقول: ﴿انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ * ﴿لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ لما تحدث عن أهل النار بأنهم يكونون في ظلٍ ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، تهكّم، جاء بأن المتقين في ظلال حقيقي، سورة المرسلات يقول قبلها: ﴿انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ * ﴿انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ * ﴿لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ * ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾ وهل في جهنم ظل؟! هو أسلوب تهكم لهم ظل لكن من لهب!!. أما المؤمنون الحقيقون في ظلال وعيون ولله في القرآن أسرار نسأل الله أن يعلمنا.
سؤال من الأخت سمر الأرناؤوط: لم ترد سورة الغابرين في القرآن كله إلا لامرأة لوط عليها السلام، فما اللمسة البيانية في هذا الاستخدام للفظ الغابرين لها تحديداً ما قيل مثلاً من الهالكين؟ ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ في الأعراف.، وفي سورة الحجر: ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾، في الشعراء ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ﴾ وهي المقصودة، ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ وهذه في النمل، وكذلك العنكبوت وردت مرتين، والصافات: ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ﴾.
د. المستغانمي: صحيح هذه ملحوظة دقيقة جداً وجزاها الله خير على هذا السؤال الوجيه في المتشابه اللفظي هو في الحقيقة: (إلا امرأته كانت من الغابرين أو قدرناها من الغابرين) ليس معنى الغابرين بمعنى الهالكين مباشرة، هي هنا التبس الأمر، الغابرين من غَبَر بمعنى: إما مكث بقي أو زال، كلمة غبر في اللغة العربية من الأضداد (إلا امرأته كانت من الباقين) والذين بقوا بعدما خرج لوط وأهله أهلكهم الله فمعناها ينطبق عليهم المعنين لذلك هي سألت لماذا جاءت كلمة الغابرين فقط في قصة لوط؟ نظراً للمعنى المعجمي كلمة أنت تذكر في حلقة (سورة النور) عندما سأل ذلك الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إلى متى نحن نظل خائفين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تغبرون إلا قليلاً أي: لا تمكثون ولا تبقون إلا قليلاً حتى يأمن كله واحد… كلمة (غبر) بمعنى: بقي. (إلا امرأته كانت من الغابرين) أي: من الباقين لوط بما أمرهم؟ أمرهم بالخروج، والله تعالى أمره قال: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ * إلا امرأته التفتت وبقيت، فكانت من الباقين بمعنى: كانت من المهلكين.
المقدم: لو قال: (من المهلكين) لحق عليها الهلاك فقط لكن لما قال (من الغابرين) حق عليها الهلاك والبقاء.
د. المستغانمي: بقيت مع المهلكين في بيوتهم، فلذلك الغابرين هي خصوصية لتناسب أكثر.
سؤال من الأخت أم نذير من عدن تقول: لماذا في سورة النور كانت عقوبة الزنا الجلد، وليس الرجم، كما ورد في سورة النور، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على امرأة زنت بالرجم، ولم تذكر عقوبة الرمي في القرآن كاملاً؟
د. المستغانمي: السؤال يتعلق بسورة النور التي نحن في نهايتها إن شاء الله وفعلاً آية النور الثانية: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ الجلد جاء عاماً، لكن عندما زنت تلك المرأة المحصنة المتزوجة والرجل ماعز والغامدية وأقرا بالذنب يعني: وتابا، طبعاً الزاني المحصن تم رجمه بالسُنّة بمعنى: الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك، لأن المحصن غير الأعزب، فالذي لم يعرف ما معنى الزواج القرآن ودين الإسلام يخفف عنه، وهذه من سماحة الإسلام وسهولة الإسلام، بينما المحصن هو إنسان تزوج ويعرف حقيقة الإسلام وحقيقة الزواج وحدود الناس، لكن العقوبة وردت في السنة، والسنة مكملة وهي بيان للقرآن الكريم، وثاني مصادر التشريع.
ثانياً: ورد هناك في الآثار والأخبار أن الصحابة كانوا يقرأون: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فقيل: هذه كانت آية ثم نسخت لفظاً وبقيت حكماً. ومن معاني ذلك: أن الله تعالى لم يشأ جل جلاله: هذا رؤيا الحديث: (الشيخ والشيخة إذا زنيا –بمعنى: الكبير في السن- فارجموهما البتة) فأثبتت حكماً ونُسخت لفظاً، ولو صح هذا الحديث ورواته، فالله ينزه القرآن أو يسمو بالقرآن أن يذكر هذه الحالة: امرأة عجوز وكبير في السن، فليس من المعقول أن يتورط إنسان كبير في السن وامرأة عجوز بمثل هذه، وورد ذلك في السنة. لكن السؤال المطروح: كم تم رجم من إنسان؟ أعداد لا تفوق أصابع اليد، ممكن في السيرة وردت في وقت الرسول حادثة، وفي عهد الخلفاء –ولست جازماً- مرة أو اثنين، يعني لكن لماذا؟ لأن المجتمعات كانت تطبق سورة النور.
المقدم: وحتى نبين المسألة ما حدث في السيرة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا فيه دروساً كثيرة، جاءت المرأة فقالت: طهّرني يا رسول الله! فردّها، فجاءته فردّها، أربع مرات إلى أن أقام عليها الحد، فهذا يدللنا على أن الأصل في الإسلام ليس قيام الحد، أو إقامة الحد.
د. المستغانمي: نعم الأصل ليس إقامة الحد، والأصل درء الحدود بالشبهات، لكن إذا أقر وأقر وثبت ذلك هو الضمير المسلم كان يقظاً، فلذلك ورد في السنة وجمهور العلماء يقولون به.
سؤال: آخر سورة الإسراء: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ﴾ أتمنى من سيادتكم توضيح وتفسير سياق هذه الآية؟
د. المستغانمي: هذه الآية هي آخر آية في سورة الإسراء ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ الله أكبر! فهي آخر آية تنزّه الله جل جلاله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أنت يا محمد! الله يلقنه: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً، طبعاً هو لم يلد ولم يتخذ ولداً في سورة الإخلاص: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ هذه الولادة الحقيقية، قد يقول قائل من المشركين والكافرين: لم يلد لكن اتخذ ولداً بالتبني، هكذا يقولون النصارى. ولم يكن له شريك في الملك ملك السماوات والأرض، لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك، لذلك هل سمعنا أحداً يدّعي أنه يملك المشتري والمريخ؟ لم يكن له شريك في الملك، أكملت الآية كل الأنواع ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ﴾ لم يكن له ولي نصير ينصره من الذل، الله عزيز (من الذل) (من) هنا حرف جر ينصره من الذل، الله عزيز الجانب هو عزيز هو القوي، فليس له نصير أولي ينصره من ذلٍ، ينصره من شيء حاق به، الله هو الذي ينصر هو العزيز هو الغالب هكذا الآية، فنزه الله تعالى في ذاته، نزّهه من الشريك نزّهه من الولد، نزّهه من النصير، هل الله محتاج من ينصره؟ هذه هي المعنى، ولم يكن له ولي ينصره ويعز الله، فالله في غنى عن ذلك. وانظر إلى تناسق هذه النهاية مع بداية سورة الإسراء: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى﴾ تنزه الله تعالى وآخرها ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ سبحانه وتعالى.
———–فاصل————-
المقدم: نواصل الحديث الآن في سورة النور وتقريبا نحن في الجزء الأخير منها. توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ نقف عند هذه الآية وخاصة أننا تحدثنا في الآيات التي قبلها عن موضوع الاستئذان، لا زال الحديث هنا ليس في الاستئذان وإنما متعلق به.
د. المستغانمي: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قوله تبارك وتعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أولاً: (قواعد) جمع: قاعد. والقاعد: هي المرأة التي قعدت عن الحيض وقعدت عن الولادة كبر سنها فهي قاعد، وليس المقصود أنها غير مستطيعة للحركة من كِبَر، ولو كان ذلك مقصوداً لقلنا: هي قاعدة بالتاء والرجل قاعد، هذه (قواعد) لفظ مخصص للنساء، كما نقول: امرأة حائض وامرأة طالق، وامرأة حامل، ومرضع بدون تاء، (وامرأة قاعد) أي: هي قاعد عن الحيض، يئست من الحيض، أو انتهت مرحلة الحيض لديها، وامرأة قاعد عن الولادة وهي بلغت من الكبر لا أقول عتياً بلغت مبلغاً كبيرا، فهؤلاء القواعد رخص الله لهن أن يخففن شيئاً من الجلباب
المقدم: ما المقصود بالتخفيف والترخيص؟
د. المستغانمي: الترخيص امرأة عجوز عمرها سبعون أو عمرها ثمانون أو تسعون هل يعاملها المجتمع كما يعامل امرأة شابه في العشرين؟!.
المقدم: سؤالي: الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ﴾ ما المقصود بهذه الثياب؟
د. المستغانمي: الثياب التي من فوق، المرأة طبعاً لها ثياب تلبس ثوبين أو ثلاثة داخلية وتلبس الحجاب الخارجي، فهذا الحجاب الخارجي لا جناح عليها أن تضعه فإذا تبين شيء من سواعدها من ذراعها من سيقانها فلا مانع حتى شيء من شعر المرأة العجوز لا مانع، وشيء من جيدها من رقبتها هذا هو المقصود، أن تخفف شيئاً إذا خففت فلا مانع غير متبرجة بزينة، هذا قيد، فإذا كانت في الستين وقد تكون جميلة وقد تتزينن لا، القرآن لم يشرع لها، والإسلام لا يجيز لها أن تضع شيئاً من ثيابها. أما إذا كانت امرأة عجوزاً فالله أرحم، ودين الإسلام أرحم بهؤلاء العجائز التي يراها كل واحد أماً له، فلا يعني ينوي شراً، ولا ينظر إلى شيء فيها، فإذاً هذا تخصيص. في بداية السور أنت الآن من حقك ومن حق السائل أن يسأل يقول: لماذا جاءت الآية هنا؟
في بداية السورة نهت عن الزنا، وأعطت حد الزنا، وبدأت أعطت الوسائل الوقائية، من بين الوسائل الوقائية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ لما جاءت في الآيات الأصلية التشريعية: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾ ثم أخذنا القرآن في جولة مع المنافقين مع آية النور عاد الآن للتخصيص: خفّف الحكم على القواعد من النساء.. الآيات في الأخير كأنها تخفف وتخصص ما سبق، فهذه خصصتها، إذاً غير متبرجات بزينة. بعد ذلك قال ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ هنا أفضل حتى ولو كانت كبيرة السن ذات وقار واحترام ولو ظلت مرتدية خمارها فذلك أفضل لها، يعني لا تخفف لكن من شاءت وخففت فلا جناح عليها.
المقدم: وهذه كالآية التي في سورة البقرة التي تتعلق بالصيام ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.
د. المستغانمي: الذين يطيقونه بمشقة الذين يستطيعون الصيام بمشقة هنا له الرخصة: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وهناك: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ إشارة تلميحية أنها لو حافظت على حجابها وجميع مستلزمات حجابها أفضل، لو تخففت في سواعدها فذلك لا يضرها.
المقدم: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ هل هذا التذييل له علاقة؟
د. المستغانمي: طبعاً سميعٌ جل سمعه جل جلاله عليم بكل الدقائق وذكر السمع بالتحديد -على حسب فهمي- لأن ما يقال الله يسمع كل شيء فمن باب التذييل كأنه تحريك لما أقول لك: يا فلان! افعل كذا وكذا، أو لا تفعل كذا وكذا، والله سميع عليم، كأنه يقول: إنني معكما أسمع وأرى، والله يلاحظ ويرى ويراقب وأعلم بالنوايا، أنا وأنت يخفى علينا كل شيء وهو لا يخفى عليه شيء من نوايا المرأة أو العجوز أو القاعد.
المقدم: هنا كذلك نريد تسليط الضوء على المعنى الإجمالي للآية وهي من الآيات الطويلة في الحقيقة يعني أكثر من نصف صفحة تقريباً: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾ والموضوع متعلق في الأكل في البيوت؟
د. المستغانمي: الآية أولاً: ما زالت الآية تخصص وتخفف ما سبق وهنا تخفيف أيضاً: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَائِكُمْ﴾.
المقدم: ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ واضحة ليس على الإنسان حرج أن يأكل من بيته، فلماذا تُذكر؟
د. المستغانمي: جميل سأشرحها أنا معك وهذه لفتت انتباه المفسرين وأنا شخصياً لفتتني. ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ سأعطيك شيئاً بسيطاً في تفسير هذه الآية: المفسرون والإمام القرطبي والإمام ابن كثير والشوكاني وغيرهم يذكرون أن الذين كانوا يذهبون إلى الغزوات يخلفون وراءهم هؤلاء الضعفاء المرضى الذين لا يستطيعون الجهاد سواءٌ كان أعمى أو كان مريضاً، أو قاعداً، وهؤلاء عندما سمعوا الآيات في سورة النور وغيرها كانوا يتحرّجون المجاهدون يتركون عندهم مفاتيح بيوتهم أو يخلّفونهم فيظلون في البيوت لكن يتحرجون يأكلون أو لا يأكلون؟ فجاء قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾ إثم ولا جناح. ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ إلى غير ذلك، لماذا جاءت هي هنا بالذات؟ هي رفعت الحرج عن هذه الشريحة الاجتماعية الضعيفة، وجاء مع: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ بمعنى ذلك: نوّه عن ضرورة مساعدتهم وإذا أكلوا معكم.
المقدم: هل معنى ذلك أن ساوى هذه الأصناف بنفس الإنسان؟ أي: أنه جعل الإنسان الأعرج والمريض في مقام الشخص نفسه أن يأكل من بيته؟
د. المستغانمي طبعاً في الإسلام تكاتف المسلمين وتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم فأنت إذا جاءك إنسان مريض أو أعرج وفتحت بابك فمن باب أولى الإسلام يحث على ذلك، وكانوا عندما يأكلون مع الأعمى قد يتحرجون يقول: هو أعمى لا يرى أخاف ألا أنصفه، لا، ليس هناك حرج، الإسلام يرفع الحرج ويسهل العملية، إذاً ليس عليهم أن يأكلوا في بيوت المسلمين أو بيوت غيرهم.
ثانياً: عندما كانوا يخلفونهم في الغزوات كانوا يتحرجون فنزلت ونفت الحرج عنهم إطلاقاً.
الآن السؤال ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ نحن من الطبيعي أن نأكل من بيوتنا ولسنا بحاجة إلى تشريع، إذاً هنا التمس المفسرون المخارج أو دعني أقول: أوّلوها، فمن بين التأويلات قال: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي: بيوت أبنائكم لأن ابنك هو ملك لك عندما اشتكى ذلك الرجل قال: (أنت ومالك لأبيك)، وبعدها “خير ما يأكل الإنسان من كسب يده وابنه من كسبه” ورد هذا في الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قالوا: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم لأنه لم يذكر الأبناء ذكر الآباء والأعمام والأخوال والخالات، السؤال مطروح: هل نأكل من جميع البيوت ولا نأكل من بيوت أبنائنا؟ لا، لذلك فأبنائنا بيوتهم هي بيوت لنا.
أحد المفسرين الذي هو شيخ الأزهر السابق الطنطاوي رحمه الله سيد محمد الطنطاوي يقول في التفسير الوسيط يقول فكرة رائعة يقول: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، والأصل أن نأكل من بيوتنا، لكن جيء بها ليقيس الأكل من بيوتنا مع صلاحية الأكل من جميع البيوت، كأنه يقول: في ذات المرتبة للتساوي بين المنازل فأنت كما تأكل في بيتك ولا حرج فلا حرج أن تأكل من بيت آبائك وأمهاتك أو أعمامك هو أتى بهذه الفكرة أنا في الحقيقة راقت لي وأعجبتني.
المقدم: لماذا ذكر هنا الصديق في قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾.
د. المستغانمي: أولاً: (أو بيوت) ثلاثة عشر مرة ذكرت في سورة النور فما أحرى أن تسمى المساجد بيوتًا كما قلنا فيها: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ وقلنا: هذه سورة البيوت كيف تحترم وكيف تسلِّم على البيوت.
ثانياً: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ والله إنسان وكلك فوضك أن ترعى بيته أو تحافظ على رزقه وأنت في هذا البيت لا تأكل ولا تشرب كيف تعيش؟ ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ أي: ما وكل إليكم أن تخدموه وأن تحافظوا عليه فلا جناح أن تأكل بما يرضي الله. قال: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ وبالإفراد، هذه الوحيدة ما قال: (أصدقائكم) لماذا؟ أحد المفسرين يقول: لقلة الصديق في الحياة، وكما قيل:
ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل
فلقلّة الصديق ولذلك في آية أخرى تقول: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ * ﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ لكثرة الشافعين ولقلة الصديق الناريون الجهنميون استنجدوا، ولما استنجدوا استنجدوا بالشافعين الذين يشفعون لهم، أو الصديق، الصديق: هو من يصدق في مودته وهو قليل، وقد يكون ثمة أسرار أخرى نحن لا نعلمها.
﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ طبعاً كانوا يتحرّجون نأكل في جماعة أو نكون منفردين، فالإسلام مسهل دين يسر أكلتم في جماعة كثرة البركة، أكلتم منفردين ما شاء الله! إذاً ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾.
بعدها مباشرة: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا﴾ لماذا الإعادة هنا؟ هو قال في الأول ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا) وهنا أعاد قال ﴿فَسَلِّمُوا﴾ لماذا؟ حتى لا نتوانا ونتكاسل تقول: هذا والله بيت عمتي وبيت خالتي أدخل ولا أسلّم، يعني: أعرفهم، لا، آداب الإسلام لا بد أن نحافظ عليها، إذا قال: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أنت لا تسلّم على الآخرين أنت تسلّم على نفسك بمعنى: ليس شرط أن تقول: السلام علينا تسلّم السلام عليكم، هذا السلام إذا وجد أناساً فأنت تسلم عليهم، وفي الوقت نفسه أنت تسلم على نفسك لأنه سيعود عليك.
المقدم: وهذا دائماً ديدن الإسلام دائماً يدعو إلى السلام بالتلفظ وبالمعاملة. يعني إذا كان الأموات شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليهم (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون).
د. المستغانمي: فما بالك الأحياء؟ وكذلك (أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام) فإفشاء السلام أمر محبب في الإسلام، وكما قلت لك: لماذا كررها؟ لأنه قال في البداية: (سلموا) في سورة النور ثم كررها حتى لا يتوانى الناس ببيوت الصديق ببيوت الخالة ببيوت العمّة، فتقول: هذا بيت أخي أدخل، جيد، بيت أخيك نعم لكن سلم، فإن السلام يعود عليك، ووصفه ﴿تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ تحية إلهية ربانية مفروضة من عند الله أو منزّلة من عند الله محثوثاً عليها من عند الله مباركة، أنا أعجبتني كلمة (مباركة) وانظر ﴿شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ وانظر إلى تجاذب الألفاظ في السورة ذاتها، واذهب إلى سورة أخرى قد لا تجد كلمة مباركة.
المقدم: إلى أن يأتي قوله سبحانه وتعالى ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.
د. المستغانمي: هنا قال: الآيات بالألف واللام؛ لأنه فصلها: (بيوت آبائكم بيوت أمهاتكم بيوت إخوانكم) فصلها فجاء بالتعريف.
المقدم: إلى أن قال سبحانه وتعالى في نهاية السورة: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ﴾ كذلك في الاستئذان حتى في المغادرة.
د. المستغانمي: في بداية السورة كان الاستئذان للدخول إلى البيوت، الآن الخروج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
المقدم: يعني ما يصح أننا نجلس في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نذهب مغادرين من دون استئذان.
د. المستغانمي: من دون استئذان ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ المنافقون والعياذ بالله يتسللون خلسة لواذًا يتسللون حتى لا يراهم، الله تبارك وتعالى يراهم، ولذلك انظر الذي يعجبك في عظمة هذا البناء القرآني والهندسة البنائية للقرآن: ما الذي دعا إلى اختيار هذا الاستئذان استئذان المؤمنين والمنافقين من الرسول في نهاية السورة؟ لأن السورة فيها استئذان، لكن الآخر: إذا كان استئذان على البيوت فهؤلاء المنافقون كانوا لا يستئذنون في الجهاد، أو كانوا يتسللون فقال: إنما المؤمنون الحقيقيون الأصليون المخلصون الذين يستئذنون الرسول ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ على أمر عظيم ﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾. جمال التعبير: جعل الله أعاد التعبير مرتين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ الأمر الجامع الأمر المهم الذي يهم الأمة أمر صلاة أمر جهاد أمر استشارة. قال: ﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ ثم عكس قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ جعل المسند إليه مسندًا، والمسند إليه مسند، يعني: جعل المبتدأ خبر، وبعدين جبر الخبر مبتدأ والمبتدأ خبر: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ من هم؟ حصرهم في الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، (الذين آمنوا بالله ورسوله) كلها خبر المؤمنون (إنما) كافة ومكفوفة (المؤمنون) مبتدأ (ما) تكفّ (إنّ) عن عملها، ويسمى الذي بعدها مبتدأ تكفّ عن العمل بدليل أنها جاءت مرفوعة بالواو. فكل الاسم الموصول وما بعده خبر المؤمنون، ثم عكس قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الخبر جعله مبتدأ والمبتدأ جعله خبر، عمر هو الفاروق ثم قال: الفاروق هو عمر.
المقدم: ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾
د. المستغانمي: لو قال: فإذا استأذنوك فأذن لهم يدخل المنافقون فيه، لكن القرآن يقول: فأذن لمن شئت منهم، الرسول صلى الله عليه وسلم حرٌ ويرى مصلحة المسلمين ويأذن للصادقين وإن شاء ألا يأذن لا يأذن فخيّره الله، ولماذا يستغفر لهم؟ إشارة إلى تفضيلهم لمصالحهم الشخصية على الأمر الجامع غير محمول، فإن كان لحق بهم شيء من اللمم من مخالفة الأولى فاستغفر لهم حتى ولو كانوا مؤمنين.
المقدم: هنا ذكر الاستئذان في الخروج والمغادرة ونحن نغادر سورة النور.
د. المستغانمي: وهذا من جماليات التناسق.
المقدم: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ نأتي إلى آخر آية: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.
د. المستغانمي: طبعاً هذا كله باختصار سريع وثمة نكت رائعة، لكن الوقت يداهمنا هي في الحقيقة: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ جاءت بعد الاستئذان في أمر جامع عندما يدعوك الرسول أيها المؤمن في الأمة الإسلامية لا تجعل دعاءه إياك ومنادته لك كمناداة بعضكم لبعض كمناداة، يعني إذا دعاكم الرسول فأجيبوه.
المعنى الثاني: لا تجعلوا دعاء الرسول كمناداته أنا أقول: يا أستاذ محمد يا محمد لكن لا تقول لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أو يا ابن عبد المطلب لا، بل يا رسول الله، يا نبي الله، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضاً لها معنيان.
آخر آية: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ هذه خلاصة السورة إن الله تعالى ينبئكم يوم القيامة بما عملتم ومن بين ما كلّفكم به أحكام سورة النور والله بكل شيء عليم، فهي خلاصة تحرك وجدان المسلمين وتحرك قلوبهم للانتفاع بما نزل فيها من أحكام وببذل الجهد والوسع لتطبيق ما فيها.