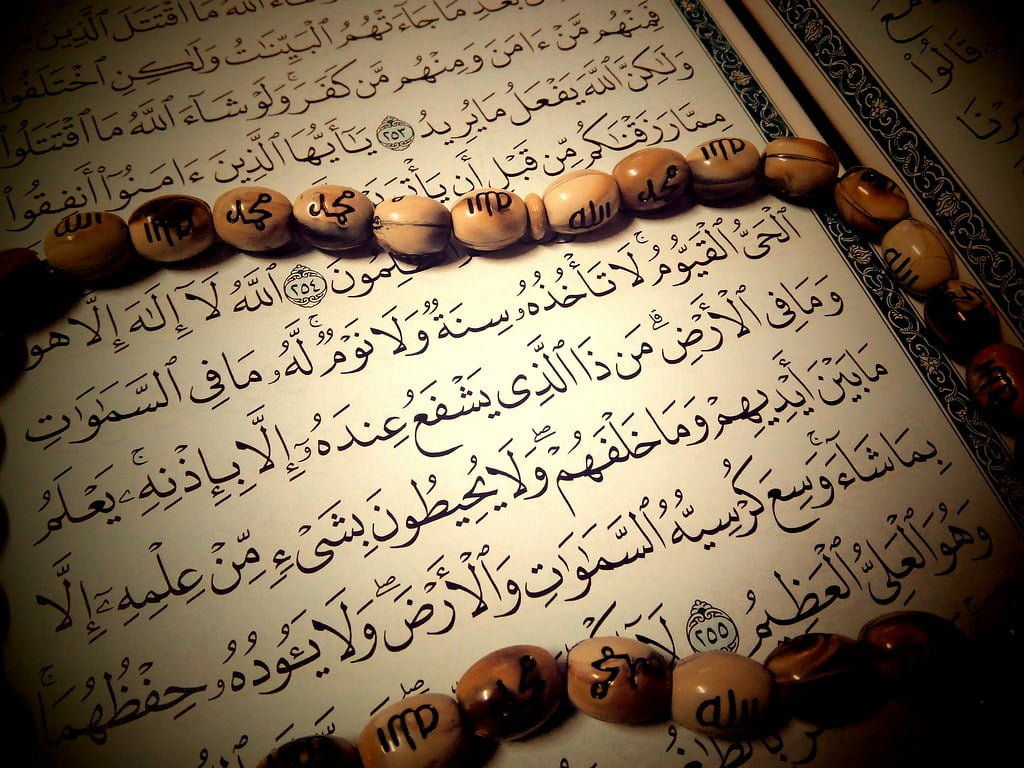سورة المؤمنون من السور المكية وهي تعرض من اسمها صفات المؤمنين وتشرح مصير من لا يسير على هذه الصفات, فعلينا أن نتوقف عند هذه الصفات ونحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله تعالى, ونرى أي نوع من المؤمنين نحن وكم من الصفات المذكورة في الآيات نتحلى بها وكم من الصفات ما زلنا نحتاج لأن نكتسبها.
صفات المؤمنين: ابتدأت الآيات بذكر صفات المؤمنين العامة: من آية 1 إلى آية 9(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ)
جزاء المؤمنين: ثم تنتقل الآيات للتذكير بجزاء من تحلى بهذه الصفات (أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) آية 10 و11.
تاريخ المؤمنين عبر الأجيال: تعرض السورة تاريخ المؤمنين عبر الأجيال،
صفات إضافية للمؤمنين: ثم تستكمل الآيات صفات إضافية لمؤمنين من درجة أعلى في الآيات من 57 إلى 61 (إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ *وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ *وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ), هذه صفات راقية وخاصّة بمؤمنين حقا.
ختام السورة: الدعاء. تختم الآيات بالدعاء (وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ(118)) والدعاء ضروري لأن المؤمنين لا بد وأن يقعوا في أخطاء ولا يغفر هذه الأخطاء إلا الدعاء الصادق الخالص لله تعالى الذي يغفر الذنوب.
والملاحظ في سور القرآن الكريم أن الثلث الأول من القرآن (من سورة البقرة إلى التوبة) تحدثت الآيات والسور عن معالم المنهج الذي شرّعه الله تعالى للمستخلفين في الأرض وهذا المنهج صعب لذا فتح في نهاية هذا الثلث باب التوبة؛ لأن كل من يريد تطبيق المنهج يحتاج إلى التوبة الدائمة. ثم يأتي الثلث الثاني تتحدث الآيات عن طرق إصلاح المسلمين المستخلفين في الأرض. فلو جمعنا كل هذه المفاهيم نحصل على إنسان متكامل ومعدّ خير إعداد ليكون المستخلف في الأرض والأخطاء واردة وحاصلة لا محالة لذا يأتي الدعاء والاستغفار الذي لا غنى لإنسان عنه.
قال تعالى في أولها (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)) وفي آخرها قال (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117)) غير المؤمنين لا يفلح فهذه مرتبطة. وقال في أولها (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12)) وفي آخرها (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115)) وكأن الله تعالى يقول كل هذه المراحل التي مرت على خلق الإنسان ليست عبثاً. ولو وضعت في سياقها لكان هناك ترابط وتناسب ولا بد من هذه الخواتيم ولا ينبغي أن تكون إلا بهذا الشكل.
نحن الآن مع تناسب خواتيم آيات السور ابتداء بين سورة الحج والمؤمنون السورتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون، قال في خواتيم سورة الحج (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)) هكذا خاطب الذين آمنوا وقال (فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)) إذن (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وقال في أول سورة المؤمنون (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)) لعلكم تفلحون – قد أفلح المؤمنون، (الذين هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4)). (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) قد أفلح المؤمنون الذين فعلوا هذه وكأن المؤمنون قد استجابوا لهذه النداءات من الله سبحانه وتعالى.
أول أمر نذكره أن أول سورة النور مرتبطة بأول سورة المؤمنون، هاتان السورتان مرتبطتان في الأوائل والأواخر. قال في أول سورة المؤمنون (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)) وبدأ بالذين لم يحفظوا فروجهم في سورة النور (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)) هذه البداية. وقال في أواخر المؤمنون (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118)) وفي أول النور قال (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1))، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو – سورة أنزلناها، هو من الذي ينزل الأحكام ويفرضها ويأمر بإقامة الحدود؟ الملك الحق. الملك الحق هو الذي يأمر ويفرض حتى عندنا في القوانين الملك هو الذي يرفض السلطة. فإذن سورة أنزلناها وفرضناها هذه أنزلنها الملك الحق (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117)) هو الذي أنزل وفرض الأحكام، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى في أواخر سورة المؤمنون ذكر عذاب الكافرين (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105)) وفي بداية النور ذكر عذاب من استحق العذاب من المسلمين في الدنيا والآخرة حينما ذكر حد الزاني والزانية (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) ثم الإفك والقذف (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)) عذاب الكافر في الدنيا وعذاب العاصي من المسلمين في الدنيا والآخرة.
أول عشر آيات من سورة المؤمنون
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عليه الصلاة والسلام: “أُنزل عليّ اليوم عشر آيات ما أقامهنّ مسلم إلا دخل الجنة” التي هي (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)) لا بد أن ننتبه أنك لو خشعت في جزء من صلاتك تكون من الخاشعين على تفاوت في الفضل، لو خشعت بلحظة بركعة من الركعات بسجود بركوع أما أن تنشغل من ساعة ما تقول الله أكبر إلى أن تسلِّم هذا شيء آخر هذا إسقاط فرض، أما الصلاة الفاضلة (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ). (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3)) كلام السفه والكلام الذي لا يعني وفيه غيبة ونميمة ومجالس الترف التي لا تنضبط إبعد عنها (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) القصص) (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ). (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4)) هذه ليست زكاة المال إنما زكاة النفس، لأن زكاة المال لا تفرّق عن الصلاة (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) جمع الله الزكاة والصلاة دائمًا، هذه فرّق الله بينهما بآية، هناك يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة، زكاة نفسه، نفسه زاكية من الخطايا والذنوب والغيبة والنميمة والطمع نفسه زاكية طيبة الرائحة. (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)) وحفظ الفروج من كل ما قد يوصلك إلى الجريمة الكبرى وهي الزنا، مقدماتها. إذا حفظت نفسك والحافظ الذي يحفظ الشيء من خارجه وحفظ الفروج أن لا تقترب من مواطن الريب التي قد توصلك إلى الجريمة الكبرى. (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8)) كل ما تؤتمن عليه من وظيفة ومال وعلم وحكم وكل عهد تعاهد الناس أنت تحفظه وتراعيه. (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9)) هناك فرق بين الصلاة الدائمة والحفاظ على الصلاة. أن تحافظ على الصلاة تحافظ عليها مما يسقطها فالغيبة تسقط العبادة تنسخها (أُولَـئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (22) آل عمران) “إن العبد ليأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال وقد أخذ قسطًا من الليل ثم لا يجد عند الله منها شيئًا قالوا بِمَ يا رب؟ قال باللقمة الحرام يقذفها في جوفه”. إذن يداوم على الصلاة في مكان الدوام الرسمي في المسجد، يحافظ عليها من أن تحبط. تأمل هذه الصفات جيدًا وحاول أن تفعلها هل تعلم بأن هذه المجموعة لا يفعلها إلا أولو العزم إذا اجتمعت في إنسان فليعلم أنه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. نحن نتكلم عن دخول الجنة وهذا ليس دخول الجنة هذا من عِلية القوم من السابقين السابقين، من الذين يعاشرون النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه أقربهم منه مجلسًا يوم القيامة كل ملك له جُلّاسه وكل أمير له جُلّاسه، هؤلاء يوم القيامة من جُلّاس النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى. لو تعلمون الأحاديث كيف أحيطت هذه العشرة لما نزلت سمع النبي صلى الله عليه وسلم دويًا كدوي النحل سمعوا لها أصواتًا وسمعوا لها أزيزًا كأزيز النحل فلما استيقظ النبي فرحًا ومثقلًا ودعا الله رأسًا: اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأرضنا وارض عنا زدنا ولا تنقصنا، دعاء طويل، قال أُنزل عليّ اليوم عشر آيات ما فعلهن مسلم إلا دخل الجنة. فتأمل في سورة المؤمنون واحفظ هذه العشرة وحاول أن تفعلها جميعًا لعلك تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تأمل بها وإذا فعلتها كلها فاعلم أنك خرجت من مجتمعك من جماعتك ومن أقرانك والتحقت بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم الفئة الأرستقراطية العالية في الجنة ملوك الجنة فتأمل لعل الله تعالى يوفقك وليس ذلك على الله بعيد وأي واحد منا لعل الله يوفقه فتجتمع فيه هذه الصفات والله تعالى هو المعين (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (17) الحجرات) لعل الله يمنّ عليك أن يعينك عليها وليس هذا على الله ببعيد وليس بمستحيل وليس بصعب كثير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مقاصد السور
د. محمد عبد العزيز الخضيري
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
سورة الحج والمؤمنون
حديثنا في هذا المجلس حول سورتي الحج والمؤمنون، أما سورة الحج فهي السورة الوحيدة في القرآن التي سميت بركن من أركان الإسلام ولا يكاد يُعرف لهذه السورة اسم غير هذا الاسم. وهذه السورة مليئة بالعجائب كما يقول علماء علوم القرآن فهي سورة أشبه سورة من السور المدنية بالسور المكية، هي سورة مدنية أشبه ما تكون بالسور المكية وقد اختلف فيها هل هي مدنية أو مكية. وهذه السورة يها ليلي ونهاري وسفريّ وحضري وهذا لا يكاد يوجد في كثير من سور القرآن. وهي سورة إذا قرأتها أشكل عليك أمرها هل هي من السور المكية أو من السور المدنية بسبب ما طرحته من قضايا وموضوعات فهي تؤصل للعقيدة وتؤسس للتوحيد وتدعو إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وتنافح عن دين الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي الوقت ذاته يأتي فيها تفاضيل الحج والهدي والذبائح لله عز وجلّ وذكر الجهاد في سبيل الله ومن عجائب هذه السورة الكريمة أنه اجتمع فيها سجودان وهذا لم يحدث في سورة أخرى غيرها بل قال العلماء إن السجود الثاني فيها هو آخر سجود نزل في القرآن الكريم، تأمل أول سجود هو قول الله عز وجلّ (كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾ العلق) وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يوم لم يكن معه أحد من أهل الإيمان وآخر خطاب بالسجود في آخر هذه السورة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ).
هذه السورة الكريمة افتتحت بافتتاحية أيضًا عجيبة وهي قوله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) ولم يشاركها في هذه الافتتاحية إلا سورة النساء ومن العجائب في هذا أن سورة النساء قال الله فيها (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ النساء) فأشارت إلى بداية الدنيا وهذه السورة افتتحت ببداية الآخرة وتلك في النصف الأول من القرآن وهذه في النصف الثاني من القرآن. قال الله في هذه (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ) هنا سؤال: ما مناسبة الحج للقيامة؟ فنقول ما هناك عبادة تقرّب لك القيامة مثل الحج. مشهد القيامة تراه بصورة مصغرة وأنت في عرفة وعندما ينزل الناس إلى مزدلفة وعندما يستيقظ الناس في الصباح ثم ينصرفون إلى منى هذا المشهد لو رأيته من علو لرأيت مشهدًا مصغرًا ليوم القيامة ولذلك جاء الحديث هنا عن يوم القيامة يصور لك حال الناس في ذلك اليوم. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾) فهو يوم مهول، يوم عظيم، يوم فيه من الرعب والهول شيء لا يقادر قدره حتى إن المرأة مع شدة حنانها وتعلقها برضيعها تفلته في ذلك اليوم منصرفة عنه غير مبالية به، وهذا يؤكد أن هذا المشهد ليس هو مشهد قيام الساعة الي يكون بعد البعث وإنما قيام الساعة الذي قبل صعق الناس أو قبل فناء العالم، المشهد هذا هو في آخر الدنيا وليس بعد بعث الناس من قبورهم لأن القيامة تطلق على هذا وتطلق على ذاك. ولاحظوا التعبير (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ) ما الفرق بين المرضع والمضرعة؟ المرضع هي التي اتصفت بالإرضاع هي الآن في حال تصلح فيه أن تكون مرضع، أما المرضعة فهي المرأة التي أرضعت بالفعل، قد ألقمت ثديها صبيها وهذا أشد في كونها قد انشغلت عنه وألقته من شدة الهول الذي نزل عليها. (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) إذن هناك علاقة بين الحج وبين يوم القيامة وهناك علاقة أيضًا بين الحج والجهاد فليس هناك عبادة تشبه الحج مثل الجهاد ولذلك نلاحظ أن الجهاد اقترن بالحج في هذه السورة واقترن بالحج في سورة البقرة قال الله عز وجلّ (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ البقرة) ثم قال بعدها (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: 196] جاءت بعد ذكر الجهاد لأن الحج أقرب شيء إلى الجهاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة.
هذه السورة الكريمة تحدثت عن خلق الإنسان ودلائل البعث وموقف المكذبين بشكل عام ومجادلتهم وبيان موقفهم من الحق وانقسام الناس في هذه القضية (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ﴿٣﴾) (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨﴾) (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ). وتحدثت أيضًا عن التوحيد الذي يعتبر الحج معلمًا ظاهرًا من معالمه وتطبيقًا واضحًا من تطبيقاته الجليّة ولذلك في أول آية من آيات الحج يقول الله فيها (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: 196] فيقرنه بالإخلاص وفي آية فرضية الحج في سورة آل عمران يقول الله فيها (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) [آل عمران: 97] بدأ بالإخلاص قبل أي شيء آخر وهنا جاء التركيز على أمر الإخلاص وعلى أمر إفراد الله بالعبادة في هذه السورة بشكل ظاهر وبيّن.
وابتدأ أمر الحج بقول الله عز وجلّ (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) يأتوك راجلين على أقدامهم وعلى كل ضامر أي بعير قد ضمر من الهزال من طول السفر (يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾) ثم قال الله (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾) ثم ضرب مثلًا للشرك (حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾). ثم يقول الله عز وجلّ (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ) وإياكم أن تذكروا عليها غير اسم الله (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا) لن يصل إلى الله لا لحمها ولا دمها (وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) الذي يصله سبحانه وتعالى منكم تقواكم لله عز وجلّ (كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) ثم قال مبيّنًا أنه الآن سيقدم مقدمة في وجوب الجهاد وهذه أول آية في الجهاد (أُذِنَ) مما يدل على أن الجهاد كان محرّمًا (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) هذه أول آية شُرع فيها الجهاد في الإسلام (وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ).
ثم استمرت السورة في ذكر قضايا هؤلاء المشركين ومجادلتهم وتهديدهم حتى وصلت في آخرها إلى قول الله عز وجلّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩﴿٧٧﴾) والملاحظ أنه يعبّر عن بعض أركان الإسلام ببعض أركانه، ما قال يا أيها الذين آمنوا صلّوا بل قال اركعوا واسجدوا للدلالة على أن هذا الذي عُبّر به عن الكل أنه ركن في تلك العبادة فالركوع من أركان الصلاة والسجود من أركان الصلاة ولا يتصور صلاة بلا ركوع ولا سجود فاستدل العلماء بهذا على ركنية الركوع والسجود. وقال هنا (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) كل خير يكون نافعًا لعباد الله ويراد به وجه الله افعلوه، لأجل ماذا يا ربنا؟ لعلكم تفلحون أي تفوزوا بالمطلوب وتظفروا بالمرغوب، وجاءت هذه مجملة وفصّلت في سورة المؤمنون التي افتتحها الله بقوله (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾).
وسورة المؤمنون سورة مكية تتحدث عن المؤمنين وعن الإيمان ودلائله والمكذبين به وعاقبتهم وتختم بمثل ما افتتحت به (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾)، بدأت بـ (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾) وختمت (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ). من هم هؤلاء المؤمنون يا ربنا؟ وصفهم بست صفات.
- (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾) وقد قيل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى رفع بصره إلى السماء فأنزل الله عليه هذه الآية فخفض بصره في صلاته ولم يرفعه لأن خفض البصر في الصلاة والنظر إلى موضع السجود دلالة على الخشوع والذل بين يدي الرب سبحانه وتعالى فلا يليق بالإنسان إذا دخل في صلاته أن يلتفت ببصره يمينًأ ويسارًا وأما رفع البصر إلى السماء فمحرّم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوشك أن تخطف أبصار الذين يرفعون أبصارهم في السماء.
- الصفة الثانية (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾) اللغو هو كل ما لا فائدة فيه وكثير مما يتحدث به الناس هو من اللغو قال الله عز وجلّ (لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) النساء)
- الصفة الثالثة (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾) ولاحظ أنه فصل بين الصلاة والزكاة بقوله (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾) نستفيد من هذا أن الخشوع في الصلاة لا يتهيأ للإنسان إلا إذا أعرض عن اللغو ولا تكاد تجد إنسانًا ثرثارًا يتحدث في كل قضية وفي كل شأن ولا يدع شاردة ولا واردة إلا لاكها بلسانه لا تتوقع أن يطرق الخشوع قلبه! قال الله عز وجلّ (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) هذه الصفة الثالثة يعني يؤدون الزكاة الواجبة
- (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾) يحفظون فروجهم سواء كان ذ لك الحفظ من جهة الشهوة فلا يضعونها إلا حيث أمر الله أو يحفظونها من جهة الستر فلا يطلعون عليها أحدا، قال الله عز وجلّ (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾) لا يستعملون فروجهم إلا مع هذين الصنفين (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾)
- (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾) هذه الصفة الخامسة
- (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾) هذه هي الصفة السادسة
ماذا لهم يا ربنا؟
في أول الأمر قال (قد أفلح) وفي الآخر بيّ، نوع الفلاح الذي سيكون لهم (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾).فإن قلت: كيف يرثون الفردوس؟ هل كان لأحد من قبلهم ثم يرثونه هم؟ فيقال: إن الله عز وجلّ خلق الجنة وهي ليست لهم أصلاً وإنما يورثهم إياها بفضله، هذا أولًا، ثانيًا وخلق الله الجنة وجعل لكل أحد منزلا فمن كفر حُرم من منزله فورثه المؤمن فصار هناك إرث فكأنهم يأخذون شيئا قد كان مقدرًا لغيرهم قد حرموا منه لأنهم لم يؤدوا ثمنه أو قيمته التي يستحقون بها ذلك الجزاء.
ثم تحدثت السورة على قدرة الله وفضله على عباده سواء كانت هذه القدرة في النفس أو كانت في المخلوقات (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً) يذكّرنا الله بقدرته ونعمته علينا (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا) على هذه الأنعام (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾) ولما ذكر الفلك ناسب أن يذكر قصة نوح لأن قصة نوح أقرب قصة إلى موضوع الفلك فأول من صنع الفلك وعلّم البشرية صناعة السفن هو نوح وقصته هي قصة الإيمان التي جاءت في سورة المؤمنون عندما قال الله عز وجلّ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾) هذا هو الإيمان وذكر الله عز وجلّ موقفهم وجزاءهم وماذا حصل لهم ثم انتقل بعذ ذلك إلى قصة هود وقومه علما أنه لم يصرّح بالقوم ولا بالنبي لكن من يقارن القصة بالأخرى الواردة في السور الثانية يعلم أن المراد بها قصة هو ثم ختمها بقوله (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آَخَرِينَ ﴿٤٢﴾) أممًا كثيرة (مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾) ما في أمة تتعدى أجلها ولا تستأخر عنه (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ) وهذا ضد الإيمان (فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) ونحن في سورة المؤمنون. (ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾) ثم بيّن الله أن هذا الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيه النبيون من قبله (وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾)
ثم أكّد على نفس القضية التي وردت في سورة الأنبياء (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾) ملتكم ودينكم يا أهل الإسلام في كل الأمم ملة واحدة فالذي دعا إليه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى واحد لا يختلف كلهم يدعون إلى عقيدة واحدة لا تتغير (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾) كلٌ يأتي بدين من عنده ويشرك مع الله غيره.
ثم قال الله عز وجلّ مبيّنًا صفات المؤمنين مرة أخرى (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾). ثم تسترسل السورة إلى أن تأتي في الأخير ماذا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو قومه إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر ونبذ الشرك يقول الله له (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾) يحضرني هؤلاء الشياطين (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾) ثم ذكر موقفهم في يوم الجزاء والحساب وكيف أنهم يندمون أشدّ الندم على ما بدر منهم في الدنيا وبهذا تختم هذه السورة الكريمة العظيمة.
#رمضان_١٤٤٢
#وقفات_تدبرية
#الجزء_١٨
“طريق الفلاح، مقوماته وعوائقه”
سورة الأنبياء عرّفتنا بالنماذج القدوة عبر تاريخ الرسالات، هم القدوة في الاستسلام لله تعالى والعبادة والذكر والدعاء
وسورة الحج دورة تدريبية على جهاد النفس استعدادا للجهاد الأكبر وأول ما تعلمنا إياه تعظيم الله تعالى وتعظيم حرماته وبالتالي الخضوع والاستسلام لأوامر وأحكامه وتشريعاته وختمت بخلاصة المهمة المطلوبة من العبد (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)
وتلتها سورة المؤمنون تؤكد فلاح المؤمنين وذكرت مجموعة من أوصافهم العملية في بدايتها ومجموعة أخرى قلبية إيمانية في وسطها وجزاؤهم (يرثون الفردوس هم فيها خالدون) تعلمنا إلى ختام سورة الأنبياء (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون)
سورة المؤمنون تعلمنا أن طريق الجهاد والفلاح محفوف بالصادّين عنه وتعلمنا أن من سبل الفلاح معرفة أساليبهم (استكبار، استهزاء بالرسول، نكوص، سخرية) لنتنبه لها وخير معين على ذلك الصلاة فهي العون والمدد من الله الذي يجير ولا يجار عليه ومن المعينات الاستعاذة من الشيطان الذي يقعد للعبد على صراط الله المستقيم يحاول صدّه عنه.
من سبل الفلاح في السورة: (ادفع بالتي هي أحسن السيئة) لأنه من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازين فأولئك هم الخاسرون..
من سبل الفلاح معرفة العبد أنه مخلوق لمهمة وغاية وليس عبثا (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون)
وبعد أن رسّخت سورة المؤمنون المكيّة العقيدة تأتي سورة النور المدنية للتطبيق العملي في حياة العبد، ماذا تعلم من السور السابقة؟ ما مقدار وتعظيمه لله تعالى وطاعته له؟
في سورة النور آيات لخصت القضية كلها: طاعة الله وطاعة رسوله هي مفتاح الفلاح للمؤمنين حقا وتفرق بينهم وبين مدّعي الإيمان (لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (46) ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين (47) وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون (48) وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين (49) أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون (50) إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم [أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون] (51) ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه [فأولئك هم الفائزون] (52))
(قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين (54) وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (55) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون (56) لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير)
الإيمان بالله تعالى وطاعته فيما أمر وتعظيم حرماته التي تصون العبد فردا وأسرة وأمة ليكون طاهرا زكيا عفيفا وطاعة رسوله خير المؤمنين على الإطلاق إيمانا وعفّة وطهارة وأدبا وأخلاقا، الطاعة مفتاح الفلاح في الدنيا والآخرة ومفتاح التمكين في الدنيا أما طاعة البشر فنهايتها الخسران..
هذا والله أعلم
#رمضان_١٤٤٢
#وقفات_تدبرية
#الجزء_١٨
صفات المؤمنين المفلحين بين سورتي المؤمنون والنور:
🔸في سورة المؤمنون (الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون)
وفي سورة النور المؤمن الخاشع لا ينبغي أن يخوض في أعراض الناس ولا يتهمهم ولا يلغو مع اللاغين ولا يحب أن تشيع الفاحشة ولا يساهم في نشرها.
🔹في سورة المؤمنون (والذين هم للزكاة فاعلون)
وفي سورة النور (رجال لا تلهيهم تجارة ولا يضيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)
وفيها آية ذكرت ما كان من أبي بكر رضي الله عنه بعد أن أوقف النفقة على مسطح بعد حادثة الإفك ثم أعاد الإنفاق عليه طاعة لأمر الله بالعفو (ألا تحبون أن يغفر لكم) قال الصدّيق: بلى
🔸في سورة المؤمنون (والذين هم لفروجهم حافظون)
وسورة النور حصون من العفاف لحفظ الفروج.
🔹في سورة المؤمنون (والذين هم على صلواتهم يحافظون)
وفي سورة النور مكان وجود هؤلاء المفلحين (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار)
🔸في سورة المؤمنون (وأولئك هم الوارثون)
وفي سورة النور (فأولئك هم الفائزون) (وأولئك هم المفلحون)
هذا والله أعلم
الحلقة 23
ضيف البرنامج في حلقته رقم (117) يوم الخميس 23 رمضان 1431هـ هو فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود .
وموضوع الحلقة هو :
– علوم سورة المؤمنون .
– الإجابة عن أسئلة المشاهدين حول الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم .
————————-
سورة المؤمنون
إسم السورة
د. مساعد: هذه السورة سورة المؤمنون هذا هو الإسم المعروف لها وبعض قد يقول المؤمنون والبعض يقول المؤمنين والخلاف في هذا لا يؤثر على إسم السورة. وهذا الإسم هو الذي اشتهر منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم وقد تسمى سورة (قد أفلح) أو سورة الفلاح ولكنها تسمية نادرة جدًا ولم ترد إلا عند بعض المتأخرين وهذا يُشعر بأن هذه التسمية تسمية من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق التنبيه على مثل هذا الضابط أنه إذا لم يعرف للسورة في عهد الصحابة رضي الله عنهم بالذات إلا إسم واحد ويتداول بينهم فهذا يشعر أنه قد تلقي من الحضرة النبوية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذا الإسم. ولهذا يبحث عن سر هذه التسمية وهي تسمية هذه السورة بـ (المؤمنون) ونجد في أول آية قول الله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)) ظاهر سبب التسمية أنها أخذت من أول السورة.
د. عبد الرحمن: تعليق إذا أذنت لي هو أنك قلت يجوز أن تقول سورة المؤمنون وسورة المؤمنين، توضيح للمشاهدين أنه إذا قلت سورة المؤمنون تقصد بها الحكاية كما يقول النُحاة وإذا قلت سورة المؤمنين فأنت أجريت عليه حكم المضاف إليه. وأذكر للفائدة رحمه الله الشيخ طاهر الجزائري له كتاب إسمه التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان، كتاب حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تكلم في فصل طويل عن كيفية إعراب أسماء السور
د. مساعد: الشيخ طاهر رحمه الله تعالى كتبه نفيسة وكان صاحب فوائد ودرر ولهذا أنصح بقراءة هذا الكتاب وكتابه توجيه النظر في مصطلح الحديث. قلنا لماذا؟ الغالب حكاية هي سورة المؤمنون لكن بعض من كتب في تفسير السورة أو بعض كتب السنة قال سورة المؤمنين على الأصل الإعرابي وإلا في الغالب الحكاية سورة المؤمنون.
لو تأملنا موضوعات السورة سنجد أنها بالفعل منصبة على الإيمان وما يقابله.
وقت نزول السورة
د. مساعد: السورة مكية باتفاق وبما أن السورة مكية فمعنى ذلك أنها ستتحدث عن القضايا المرتبطة بالعقائد الكبرى التي كان يناقش فيها أهل مكة بالذات.
د. عبد الرحمن: وهذا مر معنا في السور المتقدمة سورة يونس وسورة هود أغلبها تتحدث عن قضايا العقيدة
د. مساعد: أغلب السور المكية تتحدث عن قضايا العقيدة وركائز العقيدة المعروفة قضية الألوهية والربوبية وما يتعلق بها من أسماء الله وصفاته، قضية الوحي وما يتعلق به، المرسِل وهو الله سبحانه وتعالى والرسول الأول جبريل والمرسل إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة وهو القرآن تتحدث عن كل هذه الأمور عن البعث قضية التوحيد وإثبات البعث قضايا كلها تجدها في السور المكية لكن هذه السورة ستأخذ جانبا معينا وهو ما يرتبط بقضية الإيمان يعني آمنوا ولماذا لا تؤمنوا؟
موضوع السورة:
الإيمان وصفات المؤمنين وصفات من يقابلهم من أهل الكفر وستجد أنها ذكرت وبشكل سريع جدًا مجموعة من الأنبياء إشارة إلى قضية الإيمان والعبادة فقط يعني اتقوا الله واعبدوا الله هذه مجرد إشارات وتذكير لأهل مكة بهؤلاء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم وما آل أمرهم إليه. أيضًا حديث مباشر عن الكفار أنفسهم وسيأتي كلامهم واعتزازهم بالحرم المكي وكونهم أهل بيت الله وكانوا يجعلون هذا نوع من القربة لهم كأنهم يجعلون بينهم وبين الله نسبًا كونهم أهل الحرم فالله سبحانه وتعالى عاب عليهم هذا الأمر كيف تكونوا أهل الحرم أهل بيت الله وأنتم تعرضون عنه ولا تؤمنون به ولا برسوله.
د. عبد الرحمن: لف نظري نلاحظ في القرآن الكريم أن سورة المؤمنون 118 آية وفيها تفاصيل عن الإيمان لعلنا نتطرق إليها وسورة الكافرون سورة قصيرة كانت واضحة في المفاصلة والولاء والبراء وسورة المنافقون خصصت للحديث عن المنافقين فكأن كل فئة من الفئات التي كانت ذات موقف من الوحي خصصت بسورة المؤمنون والكافرون والمنافقون.
د. مساعد: هذا ملحظ جيد لكن لا يأتي واحد ويقول أين أهل الكتاب؟!
د. عبد الرحمن: هناك بعض السور مثل سورة البقرة وسورة آل عمران وغيرها
د. مساعد: لكن من دون تسمية. ملحظ آخر بما يتعلق بتناسب السور وهذا أيضًا من الأشياء التي يحسن أن يعتنى بها وإن كان كما هو معروف قد يقع فيه نوع من التكلف أو عدم إدراك السرّ وسواء قيل ترتيب السور توقيفي أو اجتهادي أيّا ما كان فإنه لا يمنع من البحث عن علة المناسبة
د. عبد الرحمن: لأن فعل الصحابة على بينة
د. مساعد: نعم على بينة، لو قيل مع أن الصواب الأرجح أنه توقيفي. لو تأملنا آخر سورة الحج في قول الله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)) ثم قال بعدها (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (78)) ستجد أن الصحابة قد طبقوا هذه الأوامر فكأنه جاء جواب لآخر هذه السورة (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) إخبار أن هؤلاء الذين أمروا بهذا الأمر قد طبقوا هذه الأوامر فماذا حصل؟ أعطاهم الله هذا الجزاء. لما تأتي هذه الآيات المبشرات (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) إذا جاء إنسان في حالة قنوط في حالة يأس في حالة ضعف تقول له ألست تؤمن؟ ألست تصلي؟ ألست كذا؟ يقول بلى، قل إسمع هذا الخبر (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) مؤكد هذه براعة استهلال إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل الفلاح للمؤمنين قال (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) فهي واضحة جدًا ولا تحتاج الإنسان أن يشك فيها طرفة عين. ولهذا بدأ يذكر صفات هؤلاء المؤمنين.
د. عبد الرحمن: إسمح لي أن أناقشك في مسألة المناسبات بين السور وما يكتبه المفسرون في كتب التفسير تلاحظ أن المتقدمين لم يكونوا يعتنون بهذا مثل الصحابة والتابعين أو لم يُحفظ عنهم في كتب التفسير ذلك ثم جاء بعض المتأخرين وبدأوا يكتبون في هذا مثل الرازي وغيره واذكر كلامًا جميلًا للرازي عندما قال وإنما “هو أمر معقول إذا عُرِض على العقول تلقته بالقبول”. هل برأيك هناك ضابط يمكن أن نقول هذه مناسبة مقبولة وهذه مناسبة أفضل من هذه وهذه مناسبة لا يؤتى بأفضل منها؟ لأن البعض يقول أنت جئت الآن بمناسبة فيقول هذه مناسبة غير صحيحة ويأتي بمناسبة يرى هو أنها أصح فيقع الاختلاف
د. مساعد: المناسبات متعددة طبعًا أنا جئت بنوع من أنواع المناسبات وإلا هي متعددة جدًا. وأنا أتيت بمناسبات لفظية معنوية من جهة الألفاظ، (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) هذه لفظية ومعنوية أن هناك أوامر لهؤلاء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) فكأنه حصل منهم هذا فقال قد أفلح هؤلاء الذين ذكرتهم في آخر السورة. هذه مناسبة معنوية فالمناسبات متعددة لكن أحيانًا بالفعل يظهر لكثير من المتأملين أن هذه المناسبة فيها نوع من التكلف فالمسألة مبنية دائمًا على الاجتهاد يقع فيها منازعات
د. عبد الرحمن: هل هناك ضوابط تذكرها في بعض الكتب؟ أوليست المسألة جديرة أن يوضع لها بعض الضوابط؟
د. مساعد: لا شك. أنا أذكر “كتاب الإعجاز البياني في ترتيب سور القرآن وآياته” وهذا الكتاب ما دمنا على الهواء أعرته لا أدري لمن ولعله يسمع ويعيده، وهذا كتاب أنفس ما كتب في هذا الموضوع وجاء بجميع أنواع المناسبات اللفظية والمعنوية والسياقية ورتبها وكتب عنها وأفضل ما كتب في نظري في هذا الباب وطبعًا هناك كتب علوم القرآن مثل البرهان للزركشي كتب مجموعة من أنواع المناسبات هي موجودة بين مناسبة خاتمة السورة وأول السورة
د. عبد الرحمن: والسيوطي له كتاب إسمه “أسرار المطالع والمقاطع” بين مطلع السورة وخاتمتها
د. مساعد: وله أسرار ترتيب القرآن الذي سمي هكذا وأيضًا في ترتيب السور لعبد الله صديق الغماري في تاسب سور القرآن وأبو جعفر بن الزبير الغرناطي وهو من علماء القرآن له كتاب تناسب سور القرآن حققه الدكتور سعيد الفلاح هناك مجموعة من الكتب في هذا يمكن الرجوع إليها ولعل بعض الإخوة يجتهد في استنباط أشياء في المناسبات غير هذه وهو لا شك باب مفتوح. ولعلي أشير إلى اصل وإن كان الحديث فيه كلام عند بعض المحدثين وهو حديث إبن عباس لما قال لما عمدتم إلى سورة التوبة فجعلتموها بعد الأنفال ولم تجعلوا بينها سطر بسم الله؟ وجواب عثمان يشير إلى المناسبة لأنه قال وجدت إن قصتها شبيهة بقصتها فجعلتها فيها فهذا إن صح فإنه أصل في مراعاة المناسبات.
د. عبد الرحمن: نعود إلى بداية سورة المؤمنون وحديثها عن صفات المؤمنين هنا عندما قال (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)) وسبق أنه في أكثر من حلقة تنبيه إلى أن الله تعالى يذكر الصفات مثلا يقول (إن الأبرار لفي نعيم) للإشارة إلى أن هذا النعيم بسبب بِرِّهم (وإن الفجار لفي جحيم) بسبب فجورهم وهنا نفس القضية (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) إشارة أن فلاحهم بسبب إيمانهم ولذلك يزيد فلاحهم بزيادة هذه الصفات، هذه الصفات هل من حكمة في ترتيبها بهذه الطريقة؟
د. مساعد: لا شك أن هناك حكمة، (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)) وبعدها بآيات قال (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4)) ثم قال بعدها (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9)) كرر الصلاة مرتين لكن بوصفين مرة ذكرها بالخشوع ومرة ذكرها بالمحافظة فمثل هذا لا شك يستوقف القارئ. لما قال (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) هنا خصّ صفة الخشوع ما يدل على أهمية صفة الخشوع معنى ذلك أنه قد تداوم على الصلاة لكن لا تخشع فيها فتقديم صفة الخشوع على المداومة والفصل بينهما بمجموعة من الصفات دل على أن هذا الخشوع جنس والمداومة جنس آخر لا يلزم أنهما مع بعض دائما يعني كل ديمومة لا يلزم منها الخشوع لكن الخشوع هو من لوازم المحافظة والديمومة
د. عبد الرحمن: نعود للحديث حول هذه السورة، نعود للحديث عن الصلاة، الله سبحانه وتعالى ذكر أول صفة من صفات المؤمنون قال (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) ثم بعد أن ذكر عدة صفات قال (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) أريدك أن تضيف في هذه الفائدة أن هناك أمر بالإقامة وهناك المحافظة وهناك الخشوع في الصلاة
د. مساعد: هناك رسالة في الصلاة للدكتور فهد الرومي وهي “الصلاة في القرآن” وأيضًا هناك رسالة في الصلاة في القرآن رسالة ماجستير أو دكتوراة موجودة اطلعت عليها في الملتقى وهي موجودة على ملف بي دي أف يمكن مراجعتها. قضية الصلاة وأهمية الصلاة وعظم الصلاة الأمر فيه يطول لكن من هذا الوصف الذي أمامنا الآن لما قال (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) لا بد أن يتأمل المسلم في صلاته هل هو بالفعل يحقق هذا الوصف أو لا؟ لما قال سبحانه وتعالى (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9)) وهذا الوصف ورد أيضًا في سورة المعارج (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34)) (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) المعارج)
د. عبد الرحمن: دائمون مثل محافظون
د. مساعد: نعم هذه أحد الأقوال فيها فالمعنى هذا معنى المحافظة لا شك أنه وصف لكنه ليس الوصف الأعلى والوصف الأعلى هو قضية الخشوع. ولهذا لا بد من التركيز على وصف الخشوع ومعرفة أسباب الخشوع وحضور القلب في الصلاة لأننا كثيرًا ما نصلي ونسهو في صلاتنا لهذا لو تأملنا قول الله تعالى (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الماعون) معنى أنهم لا يحافظون عليها وليس المراد السهو بالصلاة كما هو معروف فأحد أسباب عدم الخشوع هو عدم المحافظة على الصلاة لكن المحافظة على الصلاة هي طريق من طرق الخشوع لكن لا بد أيضًا من إضافة طرق أخرى
د. عبد الرحمن: ولا بد من مجاهدة النفس وتربيتها
د. مساعد: لا شك وخاصة في رمضان فرصة عظيمة جدًا جدًا لتربية النفس على الخشوع بحيث أن المسلم يصلي التراويح فيستحضر مع الإمام الآيات ويحاول أن يتأمل في الآيات ويقرأها ويفكر فيها فإذا مر بآية عذاب يتعوذ وإذا مر بآية رحمة يطلب الله سبحانه وتعالى سيجد أنه بدأ بمرحلة الخشوع أما حال كثير من الناس وحالنا نسأل الله أن يرفع عنا ذلك حال الإنسان الذي يكثر السهو في صلاته.
د. عبد الرحمن: صفات المؤمنين في هذه السورة كل واحدة تستحق أن نفردها بحديث لكن نكتفي بما ذكرنا. يلفتني في قوله (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ (68)) ما دام تحدثت عن التدبر في القرآن والخشوع فيه فهو باب من أبواب الخشوع في الصلاة الآن تدبر القرآن الكريم الذي يقرأه الإمام في الصلاة هو طريق من طرق الخشوع في الصلاة لأن بعض الناس يدخل في الصلاة ثم ينشغل بأمور دنيوية ببيت يشتريه أو بسيارة وأمور الدنيا ما أكثرها لكن لو اشتغل بتدبر الآيات التي يقرأها الإمام والتأمل فيها لكان هذا معينًا له بإذن الله على الخشوع في الصلاة.
د. مساعد: هذا صحيح، معرفة المعاني من أكبر وسائل الخشوع سواء معاني الآيات أو معاني الأحاديث التي يذكرها الإنسان في صلاته والأذكار المرتبطة بالصلاة في وسط الصلاة نغفل عنها ونغفل عن معانيها لهذا الإنسان يرددها مجرد ترداد دون أن يكون لها حقيقة في قلبه. الآيات هي استوقفتني كثيرا من قوله تعالى (قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ (66)) الآيات تتحدث عن أهل مكة كما هو ظاهر قال بعدها (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67)) وفي قرآءة تُهجِرون ثم قال (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ) لو تأملنا الآيات تتحدث عن أهل مكة وعن موقف أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن ومن الحرم لأنه قوله (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ) كلام السلف على أن الضمير في (به) يعود إلى الحرم (وأنتم تسمرون في الحرم وأنتم تهجرون في قولكم) تهجرون القرآن أي تعرضون عنه أو تُهجرون يعني تقولون الفحشى والسبّ قراءتان ولكل قرآءة معنى
د. عبد الرحمن: معاني لا تتعارض وإنما تتوافق
د. مساعد: بل هي متوافقة هذه مع تلك. الله سبحانه وتعالى ينعي عليهم هذا الوصف يعني مستكبرين أنتم في حرم الله وتتكبرون على ذكر الله وتعرضون عنه وتقولون الهجرى من القول ولذا قال (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ) المقصود به القرآن. الآن لما يقول لهم (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ) هذا واضح أنهم يفهمون هذه المعاني التي تليت عليهم (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) يوسف) فكون الله سبحانه وتعالى أنزله بلسان عربي مبين واضح فمثل هؤلاء ما كانوا يحتاجون أن يبين لهم فهم يعرفون معانيه فطُلب منهم التدبر لأنهم يعرفون المعنى ولهذا أنا أنبه أن بعض من يتكلم في التدبر يضع قاعدة أن التدبر للعامة والتفسير للعلماء وهذا يحمل شيء من المناقضة وإنما الصواب أن نقول إن التدبر لا يمكن إلا أن يكون بعد فهم المعنى التي هي وظيفة التفسير فليس هناك انفصال بين التفسير والتدبر لا يمكن للإنسان أن يتدبر شيئًا لا يفهم معناه وإنما يتدبر فيما يفهم معناه فنقول له تدبر فيما تعرف معناه فإن جهلت المعنى فاسأل عنه فإذا فهمته تدبره، هذا هو الصواب في هذه القضية.
د. عبد الرحمن: الحقيقة حتى التفسير هو باب من التدبر وإلا نحن مولعون الآن بأننا نفصل بين المصطلحات فصلًا وإلا المسألة متقاربة
د. مساعد: هذا ملحظ جميل أننا في بعض الأحيان نريد أن نضع حدّا فاصلًا نقول هذا تفسير وهذا تدبر ويصعب في بعض الأحيان. وما دام أنك ذكرت هذا أنا أرى أن موضوع المصطلحات موضوع مهم جدًا والبعض يتهاون به يقول لا مشاحة في الاصطلاح وهذا ليس بصحيح هذه القاعدة ليست صحيحة على إطلاقها بل هناك مشاحة في الاصطلاح أحيانًا ولذلك أنا أرى أن نفكر في مصطلح “فهم القرآن” فهو أوسع دلالة من تدبر القرآن ويدخل فيه التدبر والتفسير والاستنباط، وهذا المصطلح “فهم القرآن”
د. عبد الرحمن: وهذا عنوان كتاب الحارث المحاسبي
د. مساعد: لو قرأت كتاب الحارث المحاسبي تجد أنه يتكلم عن قضايا مرتبطة بعلوم القرآن وتفسيره وهو يجعلها من باب فهم القرآن ولهذا يكثر عنه عبارة “من عقل عن الله كلامه” فبما أننا نحن الآن نجتهد أو نحرص على أن نبرز أو نقدم هذا القرآن للناس فأرى أن نقدم لهم القرآن كما قدمه السلف لما جاء من الأمم نقدمه نحن كذلك فلا نخصصه في جزء دون جزء بل يكون عندنا النظر الشمولي وما يرتبط بفهم القرآن على الوجه الأعم، هذا في نظري أولى لأنه لما نقول التدبر التدبر يحتاج إلى علماء ما يكفي فيه النظر الأولية، كل واحد يتدبر على مستواه لكن إذا أردنا التدبر الحقيقي الذي يبنى عليه أشياء فيجب أن ننتبه أنه هناك أشياء لا يتدبرها إلا العلماء
د. عبد الرحمن: يتفاوت فيها الناس والعبرة ربط الناس بالقرآن الكريم وجعله منهج حياة وكلٌ بحسبه
د. مساعد: الغاية التي نريدها يجب أن تكون الوسائل إليها صحيحة فوصول بعض الناس إلى هذه الغاية بطرق غير صحيحة لا يعني أن الطرق التي وصولوا إليها صحيحة ووصولهم إلى بعض الطرق التي قد يكون فيها إشكال لا يعني أن هذه الطريقة صحيحة فإنه يلزمنا نحن الطريقة الصحيحة كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب وعلمه لصحابته وكيف علمه الصحابة لمن جاء بعدهم هذه هي الطريقة المثلى فنحن نحاول أن نتتبعها ونبحث عنها ونعلمها للناس.
د. عبد الرحمن: هناك لفتة أريدك أن تعلق عليها، في هذه السورة ذكر الله تعالى قصة نوح عليه الصلاة والسلام ثم ذكر رد قومه (فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (23)) ثم جاء بعدها فذكر قصة نبي لم يذكره فقال (ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (32)) لم يحدد الله في هذا المقطع من هم هؤلاء القوم؟ ومن هو هذا النبي؟ وهذا سؤال ورد في ملتقى أهل التفسير وهو سؤال وارد في كتب التفسير، من هم هؤلاء القوم؟ وهل من حكمة في إبهامه؟
د. مساعد: إذا كان بالفعل هو موضوع الإيمان ومن يقابله بالفعل هو موضوع السورة فالمسألة واضحة جدًا أن المراد الإشارة بالعبرة بهؤلاء القوم الذين أنكروا رسولهم وكفروا به فوقع عليهم العذاب هذا هو المراد والله سبحانه وتعالى يخبر بخبره الصادق ولهذا هو خبر ثقة بل هو أوثق الأخبار وإلا ما كان الله احتاج في هذا الخبر أن يقول تثبتوا منه هل وقع أو لم يقع، هو يقول هذا حصل وانتهى. لو تأملنا لفظة الصيحة التي وردت في آخرها، الصيحة هي التي جعلت البعض يقولون هم قوم شعيب لأنهم عذبوا بالصيحة وآخرون قالوا قوم ثمود عذبوا بالصيحة فهل هم هؤلاء أو غيرهم الله أعلم فالإبهام هنا مقصود لأن العبرة متحققة أنهم قوم أرسل إليهم رسول فكفروا برسولهم فعاقبهم الله بالصيحة من يكون هؤلاء القوم؟ الله أعلم فهذا الإبهام يبدو لي أنه مقصود، يحتمل هذا ويحتمل هذا والله أعلم. ولهذا يأتي بعده في قوله سبحانه وتعالى (فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ (32)) إلى أن جاء إلى موسى وهارون وهذا الفصل الطويل يعطي فرصة في احتمال أكثر من نبي.
د. عبد الرحمن: من فوائد الإبهام في القرآن الكريم أن العبرة تتحقق دون التنصيص على شخص ولذلك تلاحظ سورة المنافقون سورة التوبة تحدث القرآن الكريم عن المنافقين كثيرا في القرآن لكن لم يذكر أي واحد باسمه وهذا مطلب وها معناه أن المسألة ليست متعلقة بالأسماء وإنما بالأوصاف.
د. مساعد: بقي ملحظ في آية التدبر لما قال (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (69)) نقف عند القول والرسول وهذه نستفيد منها الآن، الآن مع الأسف نجد أن بعض الناس يعرض عن الحق لأنه جاءه من فلان، مجرد أن يسمع قال فلان يلغي الاستقبال عنده مباشرة ولهذا نقول يجب على المسلم أن يكون دائمًا يدور مع القول مع الحق الله أعطاك علما وعقلا فتأمل قد يكون عندك الخطأ وأنت لا تدري وكذلك خصمك قد يكون عنده الخطأ ولا يدري فتأمل في القول وليس في الشخص. لكن الله سبحانه وتعالى قال (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ) هل هذا الرسول لا تعرفونه؟ لو كان جاءهم من خارج ديارهم من خارج مكة وقالوا هذا القول يمكن أن يُعذروا لكن إنسان عاش معكم أربعين سنة (وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ (22) التكوير) مصاحب لكم معروف وما كان يتكلم بهذا الكلام فكأن الله سبحانه وتعالى ينعى عليهم هذا الأمر لكن التركيز على قضية القوم هذه قضية مهمة. ولهذا نلاحظ أن المحققين من العلماء إذا جاؤوا يناقشون بعض الأقوال لا يذكرون أسماء من قال بها في بعض الأحيان يذكروا القول وينتقدوا يعني يقول وقال بعضهم كذا مع أننا نحن في بعض الأحيان نتمنى راجع رسالة الخطابي في بيان إعجاز القرآن لما تأتي إلى الخطابي يذكر أقوال أقوام يذكر القول مجرّدًا عن من الذين قال به نحن تاريخيا يفيدنا الآن لو قال قال فلان نربط قضايا تاريخية لكن نحن فقدنا هذا الجانب من المعلومة وبقي الكلام فصرنا الآن نقرأ كلام الخطابي ونقرأ النقل الذي نقله ونقرأ نقد الخطابي ونحكم بعقولنا وليس عندنا أي تحيّز. وتعجب من بعض الناس عندما تقول ما رأيك بهذا القول؟ أو تنتقد قولا معينا يقول لك المفترض أن تقول من الذي قال به وهذا ليس لازمًا لأنك تريد أن تعرف هذا القول هل هو صواب أو غير صواب نحن مشلكتنا مقوماتنا من قال به؟ لو قلنا قال به فلان إذن هو حق وهذا ليس صحيحًا وهو ليس معصومًا.
د. عبد الرحمن: لكن هناك قرائن عندما تقول قال فلان وأنت تعرف مكانته في العلم تضعه في مكانه ثم تختبره بطريقة معينة مثل إذا قلت قال ابن تيمية او الطبري ليس مثلما قال شيء مجهول. أريد أن أنبه إلى فائدة في قوله تعالى (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ) في هذه الاية فائدة أن الجهل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهل به من أسباب تكذيبه ولذلك الآن هذه الآية تصلح للشيخ عادل الشدّي في التعريف بنبي الرحمة لأن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته ومعرفة تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام مما يزيد في الإيمان لأن الجهل به يودي إلى التكذيب به والاستهزاء بسنته.
د. مساعد: نحن بحاجة إلى برامج في بيوتنا ومدارسنا وفي مساجدنا برامج مرتبطة بهذا النبي الكريم في سييرته وشمائله وخصائصه وكل ما يتعلق به لأننا نحن نجهل أشياء كثيرة لما تقول لأحد خاتم النبي الذي كان يلبسه في أي إصبع؟ من اي شيء هو؟ ماذا كان مكتوبًا فيه؟ فمعرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من الأمور أرى حقيقة أنه من الأمور اللازمة التي نعرف به النبي صلى الله عليه وسلم ونعرِّف به.
سؤال الحلقة
قال تعالى في سورة الصافات (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12)) فكم قرآءة وردت في كلمة (عجبت)؟.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1436 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة المؤمنون – 1
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
إجابة على أسئلة المشاهدين:
سؤال من الأخ أبو محمد من البحرين: في سورة النور أربعة شهادات يقول الله تعالى فيها (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ النور) لماذا الخامسة (لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) أما في حال الزوجة أربع شهادات ثم (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾)؟
د. المستغانمي: سؤاله وجيه جدًا وإن كان كثير من المفسرين لم يتعرضوا لهذا إلا القليل النادر. هذا التفريق يسمى عند الفقهاء التفريق بالملاعنة، المعروف أن حد الزنا لا يجب إلا إذا أتى الذي رأى بأربعة شهود لكن في حال رمى إنسان أو تحدث عن زوجته وجد معها زانيًا والعياذ بالله – كما وقع في عهد الصحابة – لا يستطيع أن يُحضِر الشهود فخصص الله سبحانه وتعالى هذه الحالة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ) تعادل أربع شهادات شريطة هذا أن يأتي إلى القاضي ويفرّق بينهما بالملاعنة يحلف ويُقسم: أشهد بالله إني لصادق فيما ادّعيت عليها أربع مرات والخامسة يقول: أن لعنةُ الله عليّ إن كنت من الكاذبين. السائل يقول لماذا خصص الرجل باللعنة وخصص المرأة بالغضب؟ المرأة تُقسم بالعكس: تبطل المرأة ادّعاءه وتقول أُشهد الله إنه لمن الكاذبين أربع مرات، تُبطل كلامه، والخامسة تقول: أن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين. لماذا اللعنة ولماذا الغضب؟ ثمّة توجيهان:
التوجيه الأول أن هذا الرجل عندما اتهم زوجه بالزنى إن كان صادقًا فليس عليه شيء لكن إن كان رماها بالزنا ايفرّق بينه وبينها بالملاعنة تفريق أبدي، هذا أبعدها من كل رحمة وأبعدها من المجتمع ودمّر بيتها وخرّب عائلتها والناس يلعنونها وينبذونها، فإن كان كاذبًا تحل اللعنة عليه لأن الجزاء من جنس العمل إن كان كاذبا فعليه اللعنة وإن كان صادقا لا شيء عليه. واللعنة هي الطرد من رحمة الله والطرد من المجتمع والطرد من كل شيء. فهو كما نبذها من المجتمع فالجزاء من جنس العمل. في شأنها هي تقسم بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين والخامسة تقول: أن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين. لماذا تقول هي (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا) إن كان هو صادقًا فيما رماها في الحقيقة هي سعت لإغضابه حتى لم يتمالك نفسه وجاء إلى القاضي ولاعنها وخرج من الحياء وكشفها، هنا أغضبته غضبا شديدا فكان جزاؤها الغضب والجزاء من جنس العمل.
التأويل الثاني: إن كان صادقًا فيما رماها به فهذا حق، إن كان كاذبا هو بدأ والبادئ أظلم، اللعنة هي أشد من الغضب. نذهب إلى سورة النساء (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾) الترقّي، اللعنة أشد من الغضب: اللغضب فالعنة فالعذاب العظيم فلو كان مفتريا عليها وادّعى عليها لينبذها المجتمع وفارقها بالطلاق والملاعنة ففي الحقيقة جزاؤه أغلظ من جزائها. هذا رأي وجدته عند بعض المفسرين.
سؤال من الأخت سمر الأرناؤوط: في كل الآيات التي ورد فيها ذكر إبراهيم أنه حنيفا جاء بعدها كما ذكر الدكتور (ولم يكن من المشركين) من باب الاحتراس والاحتراز إلا في آية واحدة في سورة النساء جاء بعدها (واتخذ الله إبراهيم خليلا) لم يأتي بالاحتراس.
(وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) البقرة – الآية 135
(مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) آل عمران – الآية 67
(قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) آل عمران – الآية 95
(وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) النساء – الآية 125
(إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الأنعام – الآية 79
(قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الأنعام – الآية 161
(وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) يونس – الآية 105
(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) النحل – الآية 120
(ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) النحل – الآية 123
د. المستغانمي: (وما كان من المشركين) احتراس لأن المشركين كانوا يقولون نحن نتبع ملة إبراهيم.
المقدم: عقّب الله (لم يكن من المشركين) لأن المشركين كانوا يقولون نحن على دين إبراهيم حنفاء فالله تعالى يريد أن يقول لهم: إبراهيم لم يكن من المشركين
د. المستغانمي: ورددها في سورة البقرة (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135)) وفي سورة آل عمران (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)) حتى لا يتوهم المتوهم بأن إبراهيم كان مشركًا مثلهم يأتي من باب الاحتراس نفي الشرك عنه. في كل المواضع التي ورد فيها الاحتراس كانت تتحدث عن الشرك وعن نفي الشرك عن ملّة إبراهيم الحنيفية السمحاء في سورة آل عمران (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)) تناسق، في سورة آل عمران في نهايتها (قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95)) في سورة الأنعام إبراهيم الخليل كان يتساءل (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾) السياق في نبذ الشرك ودحض الشرك وإثبات الإيمان والتوحيد.
المقدم: ليس فقط في الحديث عن إبراهيم ففي سورة يونس (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105))
د. المستغانمي: هذا حديث موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. في كل الآيات الأخرى وردت في السياق النهي عن الشرك وإثبات الحنيفية السمحاء بينما آية سورة النساء (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾) هذه الآية جاءت في الحديث عن أعلى مراتب الإيمان (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) (أسلم وجهه لله) يعني أخلص دينه لله كناية عن شدة العبودية لله والرضى والطاعة وهو محسن ودرجة الإحسان أعلى من درجة الإيمان فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أعلى المراتب. فهو مسلم وجهه لله ومحسن وحنيفًا مائلًا عن الشرك إلى التوحيد ثم وصفه بالخُلّة (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) الخُلّة هي الدرجة وصلها إبراهيم الخليل فقط. الخلّة هي الملازمة، إبراهيم خليل الرحمن وعندما نقول فلان خليل فلان فهي درجة الرضى الشديد أنت لا تكون خليلا لفلان إلا إذا كنت راضيًا عن كل شيء فهو وصفه بإسلام الوجه لله والإحسان والخُلّة فلا يليق في هذا المقام أن يقل (ولم يكن من المشركين) وصفه بأعلى الدرجات وأثنى على إبراهيم وعلى أحسن ممن اتبعه. من باب أولى لما وصفه هذا الوصف (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ) ثم أثنى على إبراهيم بالخُلّة من باب أولى أنه أسقط عنه الشرك فليس المقام مقام احتراس.
المقدم: الاحتراز يقال حين يُخاف التوهّم وسوء الفهم
د. المستغانمي: لكن هنا لا يحدث توهم لأن الله تعالى أثنى على إبراهيم بأحسن الصفات.
سؤال من الأخت سمر الأرناؤوط: ذكر الدكتور جزاه الله خيرا في الحلقة الماضية عن مناسبة ذكر (وكُذِّب موسى) مختلفة عن غيرها في السياق مبنية لما لم يسمى فاعله (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ) ألا تحتمل أن تكون الصياغة التي ورد فيها ذكر تكذيب موسى بصغة ما لم يسمى فاعله والتضعيف تأنيسًا للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن تكذيب موسى جاء من فرعون الذي هو رأس الطغيان والبطش والجبروت في زمانه وهو ووزراءه وجنوده هم أطغى المذكورين من الأقوام ومع هذا نصر الله موسى عليه وصناديد قريش مهما بلغوا من القوة والبطش والتكذيب لن يصلوا لدرجة فرعون الذي ادّعى الألوهية! هذا والله أعلم
د. المستغانمي: فرعون هو أطغى من أطغى البشر حتى أنه ادّعى الألوهية وقال (ما علمت لكم من إله غيري) ومن المعاني التي استنبتطها السائلة أنه إذا كان أعتى المشركين وأعتى الكافرين كذّب موسى فهؤلاء الذين كذبوك يا محمد ليسوا مثل فرعون في غلظته وجلفته وشدته ولذلك كانت الآية تسلي النبي صلى الله عليه وسلم.
سورة المؤمنون
سورة المؤمنون يجوز الوجهان: نقول سورة المؤمنين على الإضافة وسورة المؤمنون على الحكاية حتى لا يقع المشاهد في الوهم. سورة مكية باتفاق جميع علماء التنزيل كل من كتب في علوم القرآن وكل من كتب في التفسير ذكروا بأنها مكية، وقعت في المصحف الشريف بعد الحج وقبل سورة النور ولها مناسبة عظيمة في موقعها وهي السادسة والسبعون في ترتيب التنزيل بعد اقرأ والمدثر المزمل سبقتها سورة الطور وبعدها سورة الملك. سورة الحج في نهايتها جاء خطاب موجه للمؤمنين وذكرنا في الحلقات السابقة أن معظم سورة الحج موجهة للمشركين (يا أيها الناس اتقوا ربكم) (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له) الحديث كان موجهًا للناس وبالدرجة الأولى إلى المشركين وعالجت قضية العقيدة، وفي نهايتها وجه الله الحديث للمؤمنين
المقدم: وهذا يستقيم مع سياق السورة لأنه ورد فيها تصريف الناس وهذا صنف من الناس
د. المستغانمي: بعدما أفاض الحديث عن الناس قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾) نهاية عظيمة توجه الخطاب للمؤمنين والآية فيها سجدة (لعلكم تفلحون) فلما كانت هذه الآية التي هي نهاية سورة الحج تقول لهم عليكم أن تركعوا وأن تسجدوا وأن تعبدوا الله وأن تفعلوا الخير رجاء أن (لعلكم تفلحون) (لعل للترجي في حق الناس لا في حق الله تعالى) إن كنتم تريدون الفلاح حقيقة فاتبعوا هذه الطريق وطبّقوا هذه الأوامر (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) فجاءت سورة المؤمنون تثبّت فلاحهم وتؤكد نجاحهم بـ(قد) التي تفيد التحقيق (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾) كان نجاحهم وفلاحهم رجاء فأصبح محققًا فعلًا صادقًا واقعًا (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) (قد) عندما تسبق الفعل الماضي تفيد التحقيق والتأكيد (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) وذكر من صفات المؤمنين ما ذكر.
ثانيا أشير إلى الترتيب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) هذا الترتيب من الخاص إلى العام، القرآن في الترتيب والتقديم يتبع طرقًا مختلفة لما يقول (كذبت عاد وثمود) الأسبقية الزمنية، (لا تأخذه سنة ولا نوم) السِنة تسبق النوم، لما يعكس التريب يعكسه لنكتة ولمسة بيانية كما يقولون. هنا (اركعوا واسجدوا) الركوع أقل من السجود وهو قبله وهو أقل منه في العدد، عندما تصلي ركعة تركع ركوعا واحدا وتسجد سجدتين مهما ركعت في الدنيا سجودك أكثر من ركوعك مهما صلّيت ركوعك أقل، سجودك سجدتين في كل ركعة حتى هناك سجود السهو وسجود التلاوة. (واعبدوا ربكم) الصلاة عبادة ولكن العبادات أوسع وأكثر، الصلاة أهم عبادة لكن العبادات أكثر. (وافعلوا الخير) صلة الرحم، مكارم الأخلاق، الخير لا ينتهي فهي مرتبة من الخاص إلى العام ومن القليل إلى الكثير. ثم بدأت سورة المؤمنون بالتحقيق (قد أفلح المؤمنون) ما صفاتهم؟ (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾)
المناسبة بين بداية سورة المؤمنون ونهايتها قال في بدايتها (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) وذكر من صفاتهم سبع صفات وفي نهايتها يقول (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾) قد أفلح المؤمنون عكسها إنه لا يفلح الكافرون، فالسورة ملمح من ملامحها “الفلاح” (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) في البداية (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) في النهاية، وفي وسطها (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾) فهي ممسوكة من ثلاثة أطراف. وعندما ذكر فريق المؤمنين وذكر بعض أوصافهم (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾) وهل الفوز إلا النجاح والفلاح؟!
سورة المؤمنون سنعيش في رحاب المؤمنين، محورها العام هو: ذكر صفات المؤمنين من البداية إلى النهاية.
ذُكرت فيها صفات الكافرين لكن ليس بالكثرة والوفرة التي ذُكرت بها صفات المؤمنين.
محورها العام ذكر صفات المؤمنين: وردت صفات المؤمنين السبع (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾) ذكرت صفات المؤمنين التي يقومون بها من شعائر (صلاة، والابتعاد عن مجالس اللغو، والزكاة أداء) يقصد الفعل الخارجي، الشعائر حفظ الفروج.
المقدم ما دلالة استخدام هذه الصيغة اسم الفاعل (خاشعون، فاعلون، معرضون، حافظون) لماذا لم يقل مثلا في غير القرآن: الذين يحفظون فروجهم، الذين يخشعون في صلاتهم، الذين يؤتون الزكاة؟؟
د. المستغانمي: استخدام اسم الفاعل في حالة الجمع في سورة المؤمنون هو أيقونة من أيقوناتها اللفظية. كل كاتب عندما نقارن أساليب البلغاء ومن أعلى البلغاء الجاحظ أسلوبه لا يتغير، اقرأ الجاحظ في البيان والتبيين، في الحيوان (سبع مجلدات)، في البخلاء، في رسائل الجاحظ أسلوبه يقوم على الازدواجية ولكل كاتب أسلوب ولكل شاعر أسلوب، وأنا أقرأ في التفاسير عندما يقول: “وذكر أحدهم: أعرف من هو بالمقارنات، بأسلوبه لكن القرآن فريد بأسلوبه، هذا تنزيل رب العالمين. سورة المؤمنون لها أسلوب خاص، سورة الحج قبلها لها خصائص، وخصائص سورة المؤمنون تختلف. في سورة المؤمنون نجد خصائص: (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾) (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾) (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾) (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾) هذه لم ترد في سورة الحج ولم ترد في سورة الأنبياء، للقرآن خصائص وفي سورة المؤمنون (فاعلون) من خصائصها.
صفات المؤمنين تتجلى في السورة كلها في بدايتها (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾وفي القصص القرآني الذي ورد فيها بمقدار بسيط ولكن بما يخدم محورها ثم في وسطها يقول (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾) صفات داخلية، صفات القلوب وفي بدايتها كانت صفات الجوارح: صلاة، زكاة، حفظ فروج، ابتعاد عن اللغو وفي وسطها انتقل لدرجة أعلى الخشية (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾) هنا الخصائص الإيمانية للمؤمنين. وقبلها قال للنبي صلى الله عليه وسلم (فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ) المشركون، والغمرة يقال مكان مغمور بالماء، في غفلتهم، في غرقهم، غرقهم في الماء؟ غرقهم في الكفر والشرك؟ غرقهم في الجهل؟ أجملها الله قال (فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ) أبداً، (بَل لَا يَشْعُرُونَ) وصفهم بعدم الشعور ومن باب أولى لا يدركون، (بَل لَا يَشْعُرُونَ) نفى عنهم الشعور الإحساس البسيط ومن باب أولى هم لا يدركون لا يميّزون، ثم ما أعطى أوصاف المشركين هنا وإنما تكلم عن المؤمنين (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾) هذا الوصف للمؤمنين يدل على أن الغمرة التي وقع فيها المشركون هي ضدها، المشركون اتصفوا بضد هذه الصفات. لذلك لم يذكر صفات المشركين الكافرين وإنما ذكر صفات المؤمنين لأننا نحن في سورة المؤمنون لا يستقيم ذكر صفات المشركين وإنما السياق يدل عليها. أعطيك دليلًا عليها: عندما تكلم عن غمرتهم الشركية قال (فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾) لما تكلم عن المؤمنين قال (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾) إذن ما دام هؤلاء يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وأقرهم الله على ذلك معنى ذلك أن الذين لا يسارع لهم بالخيرات هم بأضدادهم وبضدّها تتميز الأشياء.
(بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾) بل تفيد الاضراب الانتقالي هو قال في البداية (فذرهم في غمرتهم) في غرقهم في الشرك، ثم لما وصف المؤمنين وقال عنهم (وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) أما المشركين فكرر غمرة مرتين في سورة المؤمنون (بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ) لكن لم يفصل في صفات الكافرين المشركين لأنه فصّل في صفات المؤمنين وبضدّها تُعرف الأشياء.
في نهاية السورة لما هزّ الكافرين المشركين وقال لهم (أَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾) اعتذروا وقالوا (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾) قال (قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾) إلى أن قال (إ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾) تحدث عن المؤمنين في البداية بصفاتهم وتحدث في وسط السورة عن قلوبهم وتحدث في نهاية السورة عن دعائهم (يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) للأسف اتخذهم المشركون سخريا (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾) فما جزاؤهم يا رب؟ (جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾) فالسورة يمسكها قالب الإيمان وصفات المؤمنين وهذا لا يعني أن صفات الكافرين لم ترد، ورد بالتبع هنا وهناك بين ثنايا الآيات.
وصف المؤمنين (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾) ووصف الكافرين (قَدْ كَانَتْ آَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴿٦٦﴾) قال عن المؤنين (وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾) قال عن المشركين (قد كانت آياتي تتلى تكذبون) لما وصف المؤمنين قال (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) وقال عن المشركين (بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ)، قال (أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) ويقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم (وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾) يقول في آية (وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾) ما جمعه في وصف المؤمنين شتته في وصف الكافرين. القرآن يُقرأ بالتناظر، تناسق عجيب هذا كلام مُحكم! والله لا نقرأ التفسير إلا نقول كلام عجب! فإذا كانت سورة الحج عجيبة والله عجيبة وهذه السورة عجب والقرآن كله يفيض بالمعاني.
من خصائص السورة أيضًا من البداية قسمها الله تعالى إلى مقاطع (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾) بعد ذلك قال (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾) تكلم عن صفات المؤمنين وتكلم عن خلق الإنسان، علاقة هذا الأمر بمحور السورة أن هذا الإنسان الذي خلقه الله من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة ثم مضغة كل هذا عبث؟! آخر آية تقول (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾) رد العجز على الصدر. ذكر الله كيف خلقكم من البداية (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾) وفصّل في خلقه هذا الخلق العجيب، هذه المراحل الذي تتتحدث عن رحلة الجنين في رحم أمه في النهاية قال (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾) هذا رد العجز على الصدر.
قال (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾) ثم قال بعدها (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾) انتقال، شوط عن خلق الإنسان ثم جولة وحلقة عن خلق السموات، (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾) تكلم عن الخلق وعن إنزال الماء من السماء ثم تأتي جولة رائعة مع القصص (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾) الألفاظ تقسّم السورة إلى مقاطع (ولقد خلقنا الإنسان – ولقد خلقنا فوقكم – ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) القرآن فيه تقسيم عجيب! الكُتّاب لا يفعلون هكذا وإنما يقول: وبحثي ينقسم إلى أربعة فصول أما الفصل الأول كذا.. القرآن فيه تقسيم عجيب ولا توجد فكرة إلا لها سبب ولا لفظ، حتى في هذه الآية (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾) في جميع القرآن تكلم الله عن خلق الإنسان في الرحم ما ذكر القرار المكين، هذه الكلمة تجذب أختها عندما تحدث عن مريم وابنها قال (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾) ألفاظ تتجاذب، مقاطع تتجاذب، سورة المؤمنون عجب في الوصف!
المقدم: ذكرت السورة بعضًا من قصص القرآن لكنها لم تتحدث عن كل القصص كسابقاتها من السور، ذكرت نوح وموسى ولم تذكر عادا وثمود وغيرهم من الأنبياء فهل لأن هذا الأمر لا يتناسب مع محور السورة؟ مع العلم أنك ذكرت أن محور السورة هو ذكر صفات المؤمنين.
د. المستغانمي: هذا رقم واحد، وأيضًا فيها توحيد الله ونبذ الشرك وإثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل القرآن المكي يثبت العقيدة والعقيدة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، توحيد ونبذ الشرك وشهادة أن محمدا رسول الله. يُذكر من القصص في كل سورة ما يخدم محورها وشخصيتها والمواضيع التي تلتف حول محور السورة وهنا من هذه المواضيع التي تلتف حول هذه السورة: إنكار بشرية الرسول فأتى البيان القرآن من القصص ما يخدم هذا (فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾) ركّز البيان القرآني على إنكار قوم نوح لبشريته كأن البشرية تناقض الرسالة فأتى بهذا المقطع الذين كفروا من الملأ قالوا (مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ) ثم قال (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ ﴿٣١﴾) لما أنكروا على الرسول قالوا (مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾) أنكروا البشرية فأتى القرآن من قصص الأنبياء بما يخدم هذه الفكرة إلى أن جاء عند محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء عند موسى عليه السلام (ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾) استنكر فرعون وجنوده وملؤه أن يكون موسى وهارون بشرين. مع أن هذه الفكرة تكررت في سور أخرى في القرآن لكن القرآن أتى بمقاطع التي تخدم السورة ولما تكلم عن عيسى وأمه (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾) وبعدها قال عن الرسل جميعا (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾) كلوا، هم أنكروا أن الرسول يأكل ويشرب ويكون بشرا لما أنكر المشركون على رسول الله (وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾) لإثبات أن وهمهم باطل وليدحض متمسكهم كأن البشرية تناقض الرسالة فأتى من القصص ما يخدم هذه الفكرة. أحد المفسرين أعجبني قال: والله عجيب أمر المشركين والكفار تعجبوا من كون بشر رسول ولم يتعجبوا من كون حجر إله!!! لذلك السورة تنبذ الشرك وتؤكد التوحيد وتصف المؤمنين فجاء فيها من القصص ما يخدم محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام.
المقدم: محور السورة يتحدث حول صفات المؤمنين وحول تأكيد توحيد الله عز وجلّ ونبذ الشرك وبرز فيها موضوع البعث كثيرًا من البداية وفي وسطها وفي النهاية، قال (قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾) وفي نهايتها (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾)
د. المستغانمي: وفي بدايتها (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾) دائمًا السورة القرآنية محكمة في البداية يعطي تمهيدا ثم يفصل التمهيد ويبلوره ويعطي الحجج ثم في النهاية يختمها بضرورة العودة إلى الله سبحانه وتعالى.
من خصائص السورة أن فيها أيقونات لفظية معينة مثال: لما تحدث عن خلق الإنسان قال (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾) السلالة هي جزء من شيء، لما نقول فلان من سلالة بني هاشم يعني من خيارهم، هو ينحدر منهم ومن خيارهم، هذا من سلالة بني هاشم أو من سلالة بني أمية، سليل بني فلان، سليل دوحة الكرم، والسلالة هي الصفوة أيضًا، المنتقى والمعتَصَر وخلاصة الخلاصة، علميًا الإنسان خلق من 16 مادة: المغنيزيوم والكالسيوم والحديد ومكونات الجسد البشري 16 عنصرا من أصل 92 عنصرا المواد العضوية الموجودة في الأرض فالله يقول لنا إشارة واضحة (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾) مكونات الطين 92 عنصرًا، سلالتها من الحديد والكالسيوم وغيرها هي 16 إلى أن يقول (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾) كيف أنشأ الإنسان؟ لما تحدث قال (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾) هذه الوحيدة في القرآن (فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ) في كل القرآن يقول (أنزلنا من السماء ماء فأخرجنا، أنزلنا من السماء ماء فأحيينا به الأرض) (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾ الزخرف) (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ البقرة) في سورة البقرة، هذا يساعدنا في المتشابه اللفظي، لماذا هنا أخرجنا وهنا أنشانا؟ (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾) الأنعام، (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا)[الرعد:17] هذا يستقيم مع الماء، مع الواد، مع الزَبَد، في سورة النحل عنما تكلم عن النعم ونعمة شراب الماء (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ النحل) (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)، لما تحدّث (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ الحج) في سورة الحج تكلم عن لون الأرض وكان السياق في الدعوة إلى النظر. في سورة المؤمنون هنا (بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ) وقال بعدها (فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ) ويقول في آية أخرى (وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ) [النمل:60]. لكل سورة سياقها ومن هنا تتعدد الأفعال، لا تظنن أن أنتبنا وأخرجنا وأحيينا وأنشأنا نفس الشيء، هنا مراعاة إنشاء الإنسان قال (فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ) أنشأ بالماء جنات. تكلم في جميع الأنبياء والرسل (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾) ولما تكلم عن قصص باقي الأنبياء قال (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ ﴿٣١﴾) لم يقل أرسلنا كما هو ديدن القرآن: بعثنا رسلا أو أرسلنا وهنا قال (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ ﴿٣١﴾)، والآية القاطعة (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾) في القرآن (هو الذي جعل لكم السمع والأبصار) أيقونة لفظية عجيبة يستعملها القرآن، الأمر هنا مراد. اقرأ سورة النحل (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ النحل) لماذا (جعل) في سورة النحل؟ لأن السورة مبنية على جعل في كل شيء، وردت عشر مرات (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾) (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾) (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾) (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾) (إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾) وفي سورة المؤمنون الإنشاء هذا من خصائصها وأيقوناتها اللفظية. ذكر (جعل) مرة واحدة في سورة المؤمنون (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾) أما في سورة النحل وسورة الزخرف كلها (جعل)..
المقدم: ورد كثيرًا فعل الخلق (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾) (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾) وفي النهاية (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾)
د. المستغانمي: وورد الخلق أيضًا في سور أخرى لكن أتكلم عما يلفت النظر إلى سورة المؤمنون بوجه دقيق من خصائصها اللفظية. ومن خصائصها أيضًا (حتى إذا) لا يوجد هذا في سورة الحج، (حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾) بالدعاء. أسلوبها يختلف عن غيرها في هذا اللفظ (حتى إذا) (حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ) بعد قليل قال (حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾) في النهاية يقول (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾) القصد والإرادة والحكمة في بناء السورة بأسلوب خاص، هذا الذي ذكرته لكل كاتب أسلوب، للجاحظ أسلوب لكن في القرآن ثمة خصائص لكل سورة تفردها عن غيرها.
إذا جئنا إلى الانسجام والتناسق لما تكلم عن إنزال الماء قال (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾) هناك أودية في باطن الأرض إن يشأ الله يكرم هؤلاء القوم وإن يشا يذهب في المياه الجوفية فقال (وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ) جلّ جلاله ولما تكلم عن عذاب المشركين قال (وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾) قدرة الله في الخلق وقدرة الله في التعذيب سيّان جلّ جلاله، هذا من أيقونات السورة وخصائصها.
لما تكلم عن الفواكه وعن النعم في سورة المؤمنون قال (فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾) وردت في آيات أخرى (لكم فيها فواكه) بدون وصف (كثيرة)، التجاذب اللفظي: (لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) ولما تكلم عن الأنعام (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾) لما ذكر المنافع الكثيرة في الأنعام ذكر الفواكه الكثيرة، ولما تكلم عن الفواكه الكثيرة (وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) ذكر الأنعام (وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾) لماذا ذكر الأكل بالدرجة الأولى من الأنعام وفي مواقف أخرى ومواضع أخرى لم يذكرها؟ لأنه يريد إثبات خصائص الرسل، الرسل يأكلون ويشربون، وهذه الفواكه لهم، لذلك قال لهم (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ) ذكر الفواكه قال (وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) وذكر الأنعام وقال (وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) وقال (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآَكِلِينَ ﴿٢٠﴾) هذا مقصود، ثم وجّه الكلام مباشرة (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ) إذن لا تتعجبوا إذا كان محمد يأكل من الطعام ويمشي في الأسواق فإذن ثمة إشارات، هذا القصص يخدم روح السورة ويخدم محورها، ثمة سور تحدثت عن بشرية الرسل ولكن هذه السورة كثّفت الحديث عن بشرية الأنبياء: الرسل بشر يأكلون ويشربون وأعطى بعض الآيات التي تدل على ذلك.
أمر آخر: ردود الأقوام (وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾) المشركون في عهد محمد صلى الله عليه وسلم قالوا (قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾) نفس التعليق: ما علّق به المشركون على الرسل، على نوح وعلى صالح (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ) (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾) يقول العلماء هو صالح بدليل (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ) نفس تعليق المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم وحتى نفس التعبير (أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا) وفي آيات أخرى (أئذا كنا تراباً) لماذا (متنا) تناسب (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾) والموت هو من خصائص البشرية.
728 ربيع آخر 1436هـ الموافق /2/2016م
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة المؤمنون – 2
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
إجابة على أسئلة المشاهدين:
سؤال من د. شهاب الجبوري من العراق: هل هناك لفتة بيانية في قول الله سبحانه وتعالى (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ المائدة) في الأولى ألصق اليد بالقتل وفي الثانية فصل بين اليد والقتل بـ(إليك)؟
د. المستغانمي: سؤاله وجيه، القرآن الكريم كما قال جل ثناؤه (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ هود) ما من كلمة إلا هي في موضع دقيق، ولا حرف من حروفه، تقديم جملة عن جملة، تقديم فعل عن فعل، ليس اعتباطًا، هو استنبط من قوله (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ) قرّب ما بين اليد والقتل للدلالة على إرادة قابيل لقتل هابيل وهو لم يكن يريد ذلك فقال (مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ) باعد بينهما، وهذا تأويل جيد وإن كان العلماء يقفون من الناحية البلاغية وهي أنه استعمل الناحية الفعلية من جانب القاتل قال (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي) واستعمل اسم الفاعل والجملة الإسمية من جانب المقتول (مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ) أكّد أنه لن يناله بأذى حتى لو ناله أخوه بأذى، هذا من ناحية، نفى الأمر باسم الفاعل لم يقل لن أبسط يدي إليك لأقتلك قال (مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ) الجملة الإسمية أشد توكيدًا، والباء النافية تزيد النفي وتؤكده، فقال له: لئن نالني منك أذى فلن ينالك مني أذى أبدًا، هذا التأبيد أفادته الجملة الإسمية. ثانيًا هو في موضع النُصح لأخيه فأراد أن يستدرّ عطفه فقدّم (إليّ) قال: لئن بسطت إليّ أنا أخوك وتمتد يدك إليّ لتقتلني فقدّم ما به هو أعنى، وهذه نظرية سيبويه العظيمة في كتابه: العرب يقدمون في كلامهم ما هم ببيانه أعنى. فأراد أن ينصحه وأن يوقظ شحنة وجذوة الأخوة فقال (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ).
الأخ السائل طلب أمثلة والقرآن مليء بالتقديم والتأخير وفي بناء الكلمة قوله تعالى (أَنُلْزِمُكُمُوهَا)[هود:28] الضمائر كما قال العلماء مُكرهة فيما بينها: (أ: همزة الاستفهام)، نون المضارع، (كم) ضمير الجمع، (وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ) النبي وهو يدعو قومه قال لهم أنكرهكم على العقيدة وأنتم لها كارهون؟ ولكن البيان القرآني أكره الضمائر فيما بينها وذلك مقصود أيضًأ من الناحية الصوتية (أَنُلْزِمُكُمُوهَا) إكراه الضمائر وإلصاقها وهذا عظمة البيان القرآني.
مثال آخر (حتى إذا جاء أحدكم الموت) دائمًا في القرآن، المقتضى اللغوي: إذا جاء الموت أحدكم، أو جاء الموت أحدكم، المقتضى تقديم الفاعل على المفعول به لكن في الموت دائما يؤخره لأن النفوس تكره الموت وتريد تأخيره، هل ثمّة إنسان يحب تقريب الموت؟! القرآن نزل يعالج النفس الإنسانية لأنه يعلم أننا نكره الموت ونفر منه (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ الجمعة) ففي التعبير يؤخره وإن كان المقتضى حتى إذا جاء الموت أحدكم.
سؤال من الأخ فيصل: هل هناك فرق ما بين المعجزة والإعجاز؟
د. المستغانمي: كلاهما من الفعل أعجز، وعجز أي قصُر عن فعل شيء وعجز عن الإتيان به، أعجزه أي دعاه أو حدا به إلى عدم الإتيان بذلك الأمر وفي القرآن الكريم (وما أنتم بمعجزين) لن تستطيعوا أن تجزوا الله سبحانه وتعالى فكلمة معجزة من الفعل عجز وأعجز، عجزتُ أي لم أستطع أن أفعل الشي وأعجز أي ذهب به إلى الجانب الآخر فلم يستطيع أن يفعل ما يجاري تلك المعجزة. فالرسل عليهم السلام أيدهم الله بالمعجزات والمعجزة كما وصفها العلماء، أعطي التعريف الدقيق للمعجزة: هي الأمر الخارق للعادة والمقرون بالتحدي وسالم عن المعارضة، أمر خارق للعادة يُراد بها التحدي كما فعل موسى عليه السلام بعصاه وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص المعجزت الحسية ولما جاء القرآن جاءت المعجزة القرآنية القرآن هو المعجزة القرآنية الخالدة. بينما الإعجاز مستمر، الرسل أيدهم الله بمعجزات، الإعجاز مصدر أعجزه أعجازًا وعندما نتحدث عن إعجاز القرآن لأنه مستمر، الإعجاز في علم الأجنّة، الإعجاز في علم الفلك، الإعجاز في اللغة، أعجز البشر أن يأتوا بمثله وتحداهم فالكلمتان متقاربتان إلا أن المعجزة تطلق على معجزات الرسل وحتى لما نقول معجزة الإسراء والمعراج.
سؤال من الأخت بكار: يقول الله تعالى في القرآن كثيرا (إنا نحن نزلنا الذكر) (إنا أنزلناه في ليلة القدر) (إنا أعطيناك الكوثر) كلنا يعلم أن الله أحد صمد فرد فلماذا يستعمل نون العظمة؟
د. المستغانمي: هذه تسمى نون العظمة، (نا) الفاعلين وعندما يستعملها الله جلّ جلاله (إنا أعطيناك الكوثر) (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) تفيد العظمة والتفخيم ما لا تفيده تاء الفاعل فعندما يراد التوحيد (إنني أنا الله رب العالمين) يوحّد في سياق التوحيد أما لما يكون السياق جللًا وعظيمًا (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) صلح الحديبية، (إنا أنزلناه) تعود على القرآن، عظمة القرآن، تفخيم مقام القرآن فتأتي (نا) الفاعلين لإفادة هذه العظمة، (إنا أعطيناك الكوثر) الكوثر هو القرآن هو الإسلام هو هذا الدين، هو الخير الكثير والنهر العظيم يوم القيامة، تستعمل دائمًا للتعظيم.
سؤال من الأخت مجدولين: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) ما المقصود بالأذان؟ وكيف يكون ذلك؟
د. المستغانمي: شرحنا ذلك في سورة الحج ، (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) أي أعلِمهم، الأذان هو الإعلام عندما تعلم إنسانًا وتشعره وتنبؤه بأمر أنت تؤذنه، تؤذّن. فكلمة الأذان بمعنى الإعلام حتى المؤذن عندما يؤذن للصلاة يُعلن ويُعلم الناس بوقت الصلاة. ارتقى إبراهيم عليه السلام جبل أبي قبيس كما يقول الرواة وقال ألا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجّوا. قال وأين يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان وعليّ البلاغ. الأذان هو الإعلام بشكل عام والمؤذن يعلمنا بأوقات الصلاة.
سؤال من الأخت صابرينا يحياوي: يقول الله تعالى في سورة الحج (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)[الحج:37] كنت أظن أن (الله) تعرب فاعلًا ومعنى الآية لن يأخذ اللهُ لحومها ولا دماؤها، أرجو أن تفسر لي معنى (ينال) حتى تصبح كلمة (الله) مفعولا به.
د. المستغانمي: الله لفظ الجلالة منصوب على العظمة (مفعول به)، لحومُها فاعل مؤخَّر، دماؤها معطوف.
المقدم: لا يقال للفظ الجلالة مفعول به، منصوب على العظمة.
د. المستغانمي: أولًا تقديم (الله) وهو الأول والآخر والفاعل هو لحومها من الناحية الإعرابية، حتى يستقيم الكلام، أصلها: لن يقبل الله هذه الدماء ولا اللحوم لكن يتقبل التقوى، هكذا المعنى الصحيح لكن الإعراب: (اللهَ) لفظ الجلالة منصوب على العظمة، لن يبلغ اللهَ لحومُها لن تصعد إليه لحومها فعلماء التفسير والنحاة دون استثناء يعربون هذا اللفظ منصوب والقراء دون استثناء كأننا نقول: لن يبلغَ اللهَ لحومها، أو لن تبلغ اللحومُ اللهَ جلّ جلاله.
المقدم: لماذا جاء الفعل هنا (ينال) مذكرا وليس مؤنثا؟
د. المستغانمي: هذه قضية أخرى.عندما يفرّق بين الفعل والفاعل يجوز أن يذكّر الفعل ويجوز تأنيثه نقول جاءتهم آياتنا وجاءهم آياتنا.
المقدم: ولأن المؤنث مجازي وليس حقيقي
د. المستغانمي: في القرآن عندما نقول جاءتهم آياتنا، جاءهم آياتنا، إذا تم التفريق بين الفعل والفاعل بمفعول به يجوز التذكير والتأنيث وهذه قضية لغوية. إذن لن يبلغ اللهَ لحومها أي لن تبلغ اللحوم الله لأن القرشيين والمشركين كان عادتهم أنهم إذا ذبحوا الضحايا تقربا لله كانوا يشرّحونها وينضحون دماؤها حول النُصُب وحول الكعبة فقال الله تعالى قاطعًا الطريق أمام هذه الظاهرة: اللحوم لن تصعد إلى الله والدماء لن تصعد إلى الله، إنما التقوى الحقيقية تصعد إلى الله.
سؤال آخر من الأخت صابرينا يحياوي: قلت في الحلقة الماضية يجوز الوجهان، سورة المؤمنين وسورة المؤمنون على الحكاية، ما معنى الحكاية؟ وأنا مهتمة بالإعراب والبلاغة وأنت قلت القرآن لا يفهمه إلا من عرف عادات العرب في الكلام وأريد أن تخبرني عن بعض أمهات الكتب حول عادات العرب في الكلام.
د. المستغانمي: (سورة المؤمنون) على الحكاية وسورة المؤمنين على الإضافة، المضاف إليه يكون مجرورا بالياء هنا لأنه جمع مذكر سالم. أما لو قال سورة المؤمنون على الحكاية يعني نترك الكلمة كما وردت في النص الأصلي (قد أفلح المؤمنون) العلماء يقولون: سورة المؤمنون، على الحكاية، أو إذا رويتُ أقول: “الصيف ضيعتِ اللبن” حتى لو تحدثت مع رجل أقول له: الصيف ضيّعتِ اللبن لأن المثل ورد في الحديث مع امرأة فأحافظ عليه حفاظًا على الحكاية، المحافظة على النص كما ورد.
المقدم: مثل مدينة أبو ظبي يقال زرت أبو ظبي ومررت بأبو ظبي على الحكاية.
د. المستغانمي: الكتب التي تتناول سنن العرب في كلامها من أحسنها فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي ومن أحسنها أيضًا: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها للإمام ابن فارس, فقه اللغة يعني أن نفقه الكلمات العربية والجذور والفروق بينها إذا ذهبت إلى فقه اللغة للثعالبي يقول لك: الجمال في الوجه والحلاوة في العينين والرشاقة في الجسم، كيف نفرق في استعمال الكلمات، والفوارق اللغوية، ومنها الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري وكتب اللغة كثيرة ومنها أيضًا كتب الأدب، أدب الكاتب والأدب للكامل والمبرّد.
ورد تنبيه من د. صالح رضا بعث لنا أن الحديث صحيح: ثمة حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنها أخوة الإسلام” طبعًا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وهو خليل الله، الدكتور جزاه الله خيرا لتذكيرنا، أنا كان ينبغي أن أشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وخُلّته لكنها ليست مذكورة في القرآن، ما قلته صحيح بالنسبة للقرآن الكريم ما ذكر الله رسولا بالخلّة في القرآن الكريم إلا إبراهيم الخليل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم هو أفضل الرسل إطلاقا والحديث رواه الإمام مسلم، ونحن نرحب بكل من يدلنا وينصحنا جزاه الله خيرا.
المقدم: موسى عليه السلام هو كليم الله هل ورد كذلك أن نبينا محمد كليم الله؟
د. المستغانمي: لا، ما ورد هذا في الأثر، حتى في ليلة الإسراء سألته عائشة هل رأيت ربك؟ ورد في جوابه: نور أنّى أراه سُبُحات وجهه… لم يثبت على علمي أنه كليم الله والله أعلم.
سورة المؤمنون
المقدم: تحدثنا عن علاقتها بسورة الحج ولما بدأ الله عز وجلّ بهذا الاستهلال وقلنا أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الفلاح في أواخر سورة الحج (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩﴿٧٧﴾) (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾). ورد ذكر مجموعة من الخصال للمؤمنين هل من الممكن أن نقف عندها ولماذا وردت بهذه الصياغة (الذين هم صلاتهم خاشعون، معرضون، فاعلون، حافظون)؟
د. المستغانمي: هذا لبُّ لباب حديثنا إن شاء الله. (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) قد تفيد التحقيق، قد لما تسبق الفعل تفيد التحقيق والتأكيد كما تفيد (إنّ واللام) في الجملة الإسمية (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) كما قلنا إن المؤمنين أفلحوا، للتوكيد. (قد) عملها مع الفعل الماضي كعمل (إنّ) مع الجملة الاسمية. وبدأ في تفصيل صفاتهم والذين يتلبسون بالشعائر الإسلامية بشكل عام، في البداية ذكر الشعائر ومنها بعض صفات القلوب ولكن في وسط السورة فصّل في ذكر الأعمال الباطنية ثم في النهاية ذكر بعض أدعيتهم.
هنا (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾) الذين هم يتّصفون بالخشوع في الصلاة. الشيء الأول وصفهم بالجملة الاسمية (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) لم يقل الذين يخشعون في صلاتهم أو الذين في صلاتهم يخشعون، الجملة الإسمية أوكد وأدوم تفيد الدوام والاستمرار والجملة الفعلية مؤقتة فوصفهم بالدوام.
المقدم: لأنها مرتبطة بالفعل والفعل له زمن
د. المستغانمي: سواء في الماضي أو المضارع. ثانيًا: نجد التقديم: (فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) وهذا التقديم هنا لا نقول إنه يفيد الحصر وإنما يفيد الاهتمام، لأن المؤمن أيضًا يخشع في أشياء أخرى، لو وقفت موقفا في وفاة تخشع، أمام القبور نخشع، أمام ذكر الآخرة نخشع، لكن هنا قيّد الخشوع بالصلاة فلذلك قدم الصلاة للاهتمام بهلا، للاهتمام الخشوع فيها ولأن الصلاة من أدعى العبادات للخشوع لأن الصلاة متلبسة بالقرآن، هل ثمّ’ صلاة بدون قرآن؟!
المقدم: ما معنى الخشوع؟
د. المستغانمي: الخشوع هو الخوف مع الخضوع مع التعظيم، نخشع لله نخاف منه ونعظّم جلاله جلّ جلاله
المقدم: هذا ما يتعلق بالصفة الذهنية ولكن الصفة الفعلية، كيف يخشع الإنسان فعليًا؟
د. المستغانمي: يخشع الإنسان عندما يتدبر الإنسان فيما يقرأ وأنه في حضرة الله سبحانه وتعالى وأنه مستمع لتلاوته وهو يتدبر هذا الكلام فهو موجّه من الله عز وجلّ فينعكس ذلك على جوارحه فيخشع بحيث لا يتحرك في صلاته
المقدم: لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي كان يعبث بلحيته قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.
د. المستغانمي: كثرة الحركة، كثرة الالتفات، النظر في السماء تتنافى مع الخشوع
المقدم: ناهيك عن أن هذه الآية قالوا أنها نزلت وبعدها كان الصحابة لا ينظرون إلى الأعلى وإنما كانوا ينظرون إلى محل سجودهم.
د. المستغانمي: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾) التقديم للعناية والاهتمام. وهنا قيد الخشوع بالصلاة، السؤال المطروح: العبادات الأخرى فيها خشوع؟ بلى، الخشوع أفضل لكن لو خلت من الخشوع لكانت مقبولة وتستقيم، لو قلنا الزكاة، الزكاة عبادة لكن تتحقق الزكاة ويتحقق الغرض من الزكاة بمجرد إخراج المال دون خشوع، إخراج المال يُخرج منك الشحّ والبخل وإغناء الفقراء يتحقق، لو أخرجت الزكاة ولم تكن خاشعًا في تلك اللحظة فزكاتك مقبولة. صيامك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لو خشعت زيادة في الخير، الحج مثلا يريد مجاهدة وقد تنام وقد تغفل وقد تُلبّي، نعم، لكن الخشوع في الصلاة لا يبارحها ولا يزول عنها، ليس لك من صلاتك إلا ما عقل منها فؤادك وقلبك.
(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾) أنبّه إلى أنه كرر اسم الموصول (الذين) في كل الآيات (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾) لو قال بدون (الذين) لتوهّم القارئ ولظنّ ظانٌّ أنه لن يفلح إلانسان المسلم إلا إذا جمع بين جميع الصفات، لا، أراد بإعادة تكرار وتكرير (الذين) للتصريح بأن كل صفة جديرة بأن توصلك إلى الفلاح، هذه النكتة البلاغية.
المقدم: بمعنى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون، وقد أفلح المؤمنون الذين هم للزكاة فاعلون وهكذا..
د. المستغانمي: يعني كل صفة من هذه الصفات جديرة بأن تقودك إلى الفلاح، لو جمعها بدون تكرار اسم الموصول (الذين) قد يعتقد (أنا أقول (قد) تفيد التوقع) يعتقد وتحتمل أن الإنسان لن يفلح إلا إذا جمع بين الصفات. وحتى الواو هنا تفيد المغايرة بين الصفات.
(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾) اللغو هو الكلام الباطل، كل كلام لا فائدة فيه فهو لغو ومن باب أولى الذين يلغون في القرآن (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فصلت) اللغو كل كلام باطل والمؤمن الحقيقي يبتعد عن اللغو ويجنّب لسانه اللغو من الكلام، وجاءت بعد الصلاة مباشرة لأن الخشوع في الصلاة يقتضي البعد عن اللغو، مقابلة جميلة جدًا: الذي يخشع في صلاته ويتدبر القرآن وهو يتلوه ويخاف من الله ويعظّمه هذا تجده أبعد الناس عن اللغو، الذي لا يخشع في الصلاة تجده أقرب الناس إلى اللغو. لذلك تقريبًا المقام الوحيد[1] الذي تم فيه التفريق بين الصلاة والزكاة. بعد ذلك قال (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾) هكذا قال العلماء: ربط الله تعالى وقرن بين الصلاة والزكاة في أكثر من اثنين وثمانين موضعا (وأوصاني بالصلاة والزكاة) (يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) وهنا جاء وصف المؤمنين المفلحين بأنهم يعرضون عن اللغو لأن الخشوع في الصلاة يؤدي بهم إلى البعد عن اللغو.
المقدم: (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) ما هي الزكاة؟ ما المقصود بالزكاة؟ ما قال مؤتون أو مؤدّون؟
د. المستغانمي: الفعل الذي يرتبط بالزكاة المالية هو الإيتاء (آتوا الزكاة) لم يقل: والذين هم للزكاة مؤتون، لو قال مؤتون لانحصرت الزكاة بأنواع الزكاة المالية والغنم والذهب في الزكاة التي نؤديها لكن فعل زكى له معنيان: بمعنى طهُر (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)[التوبة:103] (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ الشمس) من طهّر نفسه (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ الشمس)، التزكية بمعنى التطهير. والزكاة بمعنى النماء والنمو، زكا الزرع بمعنى نما، فالمعنيين مرعيان هنا، لما قال جل ثناؤه (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) لم يقل مؤتون حتى لا يحصرها في أنواع الزكاة التي نؤديها، للزكاة، للتطهير فاعلون، تحتمل، لتطهير أنفسهم وللزكاة المالية وأنواع الزكوات فاعلون، ففاعلون كلمة الفعل مرتبطة بالخير لذلك يقولون: فِعال الخير. فإسداء المعروف هو الفَعال فربط بين الزكاة والفَعال لتوسيع الدلالة، لو قال مؤتون لانحصرت ونحن في سورة المؤمنون أراد الله أن يثني على المؤمنين بأنهم يعملون أعمالًا متنوعة من بينها أداء الزكوات المالية والغنم والذهب ومن بينها تطهير النفس.
المقدم: هنا الله سبحانه وتعالى يسترسل في ذكر صفات المؤمنين حتى يصل مرة أخرى إلى (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾) لماذا؟ ذكر (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾) ثم ذكر الصلاة مرة أخرى، هذا سؤال. والسؤال الآخر هذا النص من سورة المؤمنون يذكرنا بسورة المعارج حينما يقول الله سبحانه وتعالى (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾) هناك تشابه كبير بين السورتين.
د. المستغانمي: أولًا لماذا بدأها بالصلاة وأنهاها بالصلاة لكن بطريقتين مختلفتين، (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾) هنا تحدث عن الخشوع في الصلاة كأنه يقول قد أفلح المؤمنون المصلّون الخاشعون وهنا قال (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) المحافظة على الصلاة، قد سكون إنسان مسلم يحافظ على الصلاة ولكن لا يخشع فيها، ضرورة الجمع بين الخشوع في الصلاة وبين المحافظة عليها لذلك فرّق بينهما كل واحدة في آية. ثم جاء في الصفة الأولى والسابعة بالمحافظة لربط الدائرة أو من الناحية البلاغية يسمى: ردّ العجز على الصدر وهذا من تحسين الكلام والعرب يحبون الكلام البليغ، القرآن خاطب العرب البلغاء
ومن يسقي ويشرب بالمنايا إذا الأبطال لم يسقوا ويُسقوا
بمجرد ما بدأ بفعل (يسقي) ردّ العجز على الصدر، العرب كانوا يستسيغون (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) العرب ينتظرها ويتوقعها أما أنا وأنت قد لا ننتظرها، وهكذا كان الأعراب، فالقرآن يأتي بطريقة تشدّ العربي.
لما قال (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾) هنا النهي عن الزنا والمؤمنون الصادقون الخاشعون يتزوجون الزواج الشرعي (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾) (فأولئك) ميّزهم (هُمُ الْعَادُونَ) هم المبالغون في العدوان، ما قال المعتدون لأن معظم الصفات جاءت على صيغة اسم الفعل (خاشعون، فاعلون، عادٍ فهو عادون، وارثون) وبعدها قال (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾) الإيقاع الصوتي مطلوب. (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾) الأمانات هي الأمانة والمسلم مطالب بأداء الأمانة والدين كله يراعي الأمانة، الذي لا يرعى الأمانة قد لا يتوضأ، الذي لا يرعى الأمانة قد لا يصوم، الصوم أنت في بيتك وقد أرخيت السدول ما الذي يجعلك تخاف من الله؟ من الذي يمنعك أن تأكل؟ ضميرك وأمانتك إذن رعي الأمانة مطلوب، وعطف عليها العهد لأن العهد جزءٌ من الأمانة، عندما يتعاهد اثنان، انت تعاهدني على أن تفعل كذا وكذا وأنا أعاهدك، لقد ائتمنتني وأنا ائتمنتك فالعهد جزء من الأمانة.
بعد ذلك لما وصفهم (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾) اختلف هنا الأسلوب بعد أن كرر وصفهم بـ(الذين) قال (أولئك) أشار إليهم إشارة البعيد ليس بعد المكان بل بعد المكانة كما نقول (ذلك الكتاب) هو ليس بعيدًا، القرآن بين يدينا لكن ذلك القرآن علة المكانة، (أولئك) ميّزهم كأنه يقول هؤلاء أحرياء بأن أميزهم وبأنهم الوارثون وحذف المفعول به للوارثون، يرثون ماذا؟ الجنة، الأسلوب اختلف، كان المقتضى: أولئك هم وارثو الفردوس (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾) ابتغى وراء ذلك أي ابتغى وراء زوجته وما ملكت يمينه فأولئك هم العادون، وهنا قال (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾) ميّزهم كأنه يقول هم جديرون بالتمييز أحقّاء أحرياء أن يرثوا ماذا؟ (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾) لم يأت بها مباشرة والنكتة البلاغية هنا: لو قال أولئك هم وارثو الفردوس، انتهى الكلام، لكنه قال (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾) يتطلع القارئ والسامع والخاشع: ماذا يرثون؟ يرثون الفردوس، الإبهام ثم الإجمال يعطي حلاوة للقرآن ثم يشوّق السامع. (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾) الميراث يكون في المال، عندما يموت ميّت يتوفى متوفّى يرثه أهله أبناؤه وزوجه، الميراث هو أقوى الأسباب لاستحقاق المال ثم تأتي التجارة فكأنه يقول أولئك هم المستحقون للفردوس، هم الجديرون بأن أن يرثوها كأنما ورث الابن أباه، هنا استعارة، – ونحن نتذوق وكم من سائل في الإيميلات قال دعنا نتذوق بلاغة القرآن!- فأولئك هم الوارثون المستحقون لم يقل المستحقو واستعار الوراثة لأن الوراثة هي الاستحقاق، يرثون الفردوس وهي أعلى مراتب الجنة وهي كلمة كما يقولون رومية أو فارسية.
المقدم: هل في القرآن كلمات ليست عربية؟ أحدهم اعترض عليّ في أحد البرنامج حينما قلت أن في القرآن بعضًا من الكلمات التي أصلها غير عربي وقال كيف تقول هذا الكلام والله تعالى قال (إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا)؟!
د. المستغانمي: ذكرها الإمام السيوطي، عرّبها القرآن، اصطفى العرب لأنهم كانوا فصحاء وبلغاء استقوا من اللغات أجملها واختاروا من الفارسية أجمل ما لديها ومن الهندية ومن الرومية والحبشية فعرّبها العرب بالاستعمال فجاء القرآن وأخضعها للقواعد: استبرق وسندس وفردوس وكثير من الكلمات
المقدم: نأتي للمقارنة بين مطلع سورة المؤمنون ومنتصف سورة المعارج
د. المستغانمي: الكلمة المفتاحية هي (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾) والآية (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ المعارج) الكلمة المفتاحية هي: المصلين هذا الوصف جاء إثر وصف المصلين وهنا الوصف للمؤمنين الخاشعين في صلاتهم، سورة المؤمنون تثني على المؤمنين وترفع من شأنهم. هنا قال (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) في المعارج وصفهم بالمداومة على الصلاة، (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) الحق المعلوم كما يقول العلماء: الزكاة، 2.5% مقدّر لأنه إذا قرأت في آية أخرى غير محدد فهو ليس الزكاة وإنما الزكاة وغيرها (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾) في سورة الذاريات.
المقدم: وهنا أيضًا لم يفرّق بين الصلاة والزكاة (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾)
د. المستغانمي: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾)) يتحدث عن طائفة المصلين، وهنا يتحدث عن طائفة الخاشعين المؤمنين الذين لهم أكثر من صفات جاء التعبير يختلف ولكل مقام مقال، هنا قال يداومون على الصلاة، يؤدون الزكاة المفروضة (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾)) (وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾) هذه لم تذكر في الصفات السبع الأولى ولكنها ذكرت في وسط سورة المؤمنون (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾) سورة المؤمنون تفصل وفي المعارج أوجزها في مكان واحد. (وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾) هم من عذاب ربهم خائفون مشفقون من الإشفاق، لكن في سورة المؤمنون قال (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾) في سورة المؤمنين وصفهم بأنهم مشفقون من الخشية ومن تعظيم الله وهنا مشفقون من العذاب لأن سورة المؤمنين جاءت تثني على المؤمنين فأتت بأعلى درجات الإيمان (الخشية والوجل والخشوع) كلمات كأنها من عائلة واحدة بينما سورة المعارج سورة العذاب (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾) وفي وسطها يقول (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾) كلها عن العذاب فالأحرى أن يقول (مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) لا أن يقول من خشية ربهم مشفقون، لكل سياق مقال والقرآن دقيق. (إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾) بينما في سورة المؤمنون الخشية تكفيهم. (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) ذكرها في السورتين (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) ذكرها أيضًا وهي من أساسيات صفات المؤمنين، المصلّين الخاشعين.
المقدم: لماذا بالتحديد سورة المؤمنون وسورة المعارج ورد فيها هذا التشابه الكبير جدًا في الصفات؟
د. المستغانمي: الله سبحانه وتعالى تكلم عن المصلين في عدة مواضع لكن ليس بهذه الدرجة من التشابه، هنا وصف المصلين بأدنى ما يمكن أن يقدموه بما أن الآية قال (إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾) يؤدون الزكاة، يحفظون فروجهم، يخافون من عذاب ربهم، هذا أدنى شيء. لو ارتفعنا قليلًا في سورة المؤمنون: خشوع، بعد عن اللغو، فعل الزكاة بأوسع معانيها بالمعنى الشامل للزكاة، المحافظة على الأمانات، لو ارتفعنا أكثر نذهب إلى المحسنين في سورة الذاريات (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾) لا يتكلم عن الصلاة العادية هؤلاء يصلّون بالليل، فهم يصلون الصلاة العادية من باب أولى لكن في الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه درجة الإحسان، (وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾) ليست الصلوات العادية (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾) ما قال معلوم، حق أوسع من الزكاة، أبو بكر رضي الله عنه لما تصدق بماله سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هؤلاء من المحسنين يعني ليس الزكاة المعلومة فقط، بل أوسع: الصدقات، الهبات، الإحسان. وصف المحسنين (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾) فلكل مقام مقال. (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾) في سورة المدثر (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾) ما صفات الذين سلكوا في سقر؟ (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾) عكس (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾) (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾) عكس سورة المعارج (وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾) نحن بحاجة أن نقرأ القرآن بذكاء. (حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾)
عندما وصف هؤلاء المصلين بهذه الصفات ختمها وقال (أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾) أما في سورة المؤمنون (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾) والفردوس أعلى جنان الجنّة. كما ورد في الحديث الصحيح.
في سورة المعارج العذاب أثّر على كل شيء، لما تحدث عن خلق الإنسان في سورة المؤمنون (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾) لما كان القرآن ينزل – ورد في الأثر في التفاسير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لأول مرة على كتبة الوحي، أبيّ بن كعب، كتبة الوحي الذين يكتبون زيد بن ثابت، عمر بن الخطاب، كما تقول الرواية – لا ندؤي سندها يذكرها المفسرون وليس ذلك ببعيد عن عمر بن الخطاب – لما وصل إلى (ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ) نطق عمر وقال (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبها يا عمر هكذا نزلت. لأن عمر له مواقف كثيرة وافق فيها القرآن، فليس ذلك ببعيد.
المقدم: وهذا مما ذكرتم أن العرب كانوا يتوقعون نهايات الشعر أو الآيات لأن هذه من البلاغة ومن البيان الذي آتاهم الله إياه.
د. المستغانمي: عندما ذكر صفات المؤمنين ثم عقّب ذلك بالخلق (وَلَقَدْ خَلَقْنَا) اللام تفيد التوكيد وقد تفيد التحقيق و(نا) تفيد التعظيم وذكر المراحل (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾) سلالة أي صفوة الطين، من سلّ الشيء والسيف المسلول وفلان سليل دوحة الكرم من أعظمهم نسبًا وأرومة ومحتدا. إذن سلالة الطين عناصر، ثم ذكر المراحل بدقة وهذا ما أثبته علم الأجنة، إعجاز علمي عجيب نحن لا نخوض في علم الأجنّة، ثمّة علماء. نطفة فعلقة فمضغة (ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)
انظر كيف ذكر مراحل الخلق في سورة المعارج (فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾) قبلها قال (أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾) هنا أبى البيان القرآني أن يفصّل، ما ذكر حتى كلمة منيّ أو نطفة، قال (إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ) للتحقير، ألا يعملون مم خلقناهم؟! كلمة نزّه الله القرآن عنها
المقدم: سورة المعارج فيها عذاب وفيها غضب من الله سبحانه وتعالى فبالتالي حريٌ بالإنسان الغضبان أن لا يفصّل كثيرًا، أنتم تعلمون مما خلقناكم
د. المستغانمي: أسلوب تحقير وتهوين من شأن هذا المخلوق الذي يتكبر، أيطمعون أن يدخلوا الجنة؟! ألا يعلمون مم خلقتهم؟! (كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ) السياق والمقام يتطلب هذا النوع من الأسلوب لكن لما أراد الإعجاز في هذا الماء قال (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾) سمّاه من ماء دافق، تكلم عن الإعجاز (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾) صلب الرجل وترائب المرأة، صلب الرجل العظام الظهرية وترائب المرأة العظام الصدرية والعلم الحديث أثبت أن الماء يصنع في هذه الأماكن.
أنبه إلى أن نقرأ القرآن قرآءة تكاملية، لما أراد أن يبين الإعجاز قال (خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾) في آية أخرى هذا الإنسان الذي تكبر وتمطى وأعرض عن الله قال له (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿٣١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿٣٣﴾ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ﴿٣٧﴾ القيامة) لم يقل من ماء دافق لأنه لا يستقيم، قال (مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى) مهين لأنه يتمطى ويتطاول ويتكبر فذكّره الله سبحانه وتعالى بأصله.
سورة المؤمنون أثنت على المؤمنين في مواضع فجاء الأسلوب مزركشًا مزخرفًا بما يتناسب مع عظمة المؤمنين.
[1] ووردت أيضًا في سورة الشوى في الآية (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾) حيث فرّق بين الصلاة والزكاة بالحديث عن الشورى لأهميتها في سورة الشورى والله أعلم.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة المؤمنون – 3
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
إجابة على أسئلة المشاهدين:
سؤال من الأخت عبير الحلّاق: ما المقصود بالآية الكريمة (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ البقرة) ومن هم الذين هادوا والنصارى والصابئين؟
ما المقصود بالآية (إني متوفيك)؟ وقوله تعالى (فلما توفيتني) كيف توفى الله عز وجلّ سيدنا عيسى عليه السلام ونحن نعلم أن الله لم يتوفى عيسى بل رفعه الله إلى السماء وسيبعث؟
د. المستغانمي: السؤال الأول المتعلق بقوله تبارك وتعالى (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ) من سورة البقرة هذا ذكر لما بين النِحل والمِلل المختلفة من تنازع فاليهود يضللون النصارى والنصارى يضللون اليهود، فالآية معناها قالت اليهود ليست النصارى على شيء حق يُعتدّ به ويُعترف به والنصارى ردوا عليهم بالمثل وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يعتد به وليسوا من أمر الديانة من شيء صحيح وكذلك قالوا عن الإسلام لكن الحق أبلج كما يقول العلماء، فهذا التنازع بين الملل موجود.
المقدم: تأكيدًا لهذا التفسير قول اليهود (وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)[المائدة:18] (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ)[التوبة:30]
د. المستغانمي: وردّ عليهم القرآن كثيرًا خصوصًا في سورة آل عمران وسورة المائدة بشكل تفصيلي.
السؤال الثاني حول الذين هادوا هم اليهود، هادوا بمعنى تابوا إلى الله، (إنا هدنا إليك) تبنا إليك، هم في عهدهم تابوا إلى الله عز وجلّ مع موسى عليه السلام، النصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، الصابئة تحدثنا عنهم في سورة الحج (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾) الصابئة هم فرقة يدّعون أن دينهم سماوي ويؤمنون بأبناء آدم، بشيث وبنوح عليه السلام وببعض الأنبياء ويؤمنون بيحيى عليه السلام ولكن الحقيقة دينهم ليس صحيحًا وهم يعبدون الكواكب ويقولون نحن لسنا في محل نستطيع أن نعبد الله فنستطيع أن نعبده عن طريق وسيلة فيعبدون الكواكب لتقربهم إلى الله زلفى وفي الوقت نفسه هم يوجدون في جنوب العراق خصوصًا وفي كثير من الدول وفيهم خلاف، بعضهم يقول هم فرقة من النصارى وبعضهم يقول هم قبل النصارى ويدّعون أن لديهم دينًا سماويًا وورد في الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب” يعني اعتبروهم في بعض الأمور لكن في الحقيقة حكم القرآن بضلالهم في الاعتقاد وبطلان دينهم.
السؤال الثالث: ما المقصود بـ(إني متوفيك) ونحن نعلم أن الله لم يتوفى عيسى بل رفعه؟
د. المستغانمي: هنا الآية تحتاج إلى تفصيل دقيق وأنا بحثت فيها عند جملة من العلماء ووصلت إلى ما يلي: (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ آل عمران) (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) ثمة طائفة من العلماء يقولون توفاه الله وفاة حقيقية ومن بينهم ابن عباس رضي الله عنه (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) أي إني مميتك، من الوفاة لأن التوفّي هو أن يقبض الله الروح، والتوفي لغة هو قبض الشيء مستوفًى، لما تذهب عند تاجر تقول وفّاني حقي، بلغ توفية الشيء حقّه ونصابه ثم اختار الله هذا الفعل وخصّصه في القرآن بالتوفّي بمعنى أن يأخذ روح الميت (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا)[الزمر:42] (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ السجدة) فعل التوفّي في القرآن مستعمل في هذا المجال، فقال العلماء لماذا نخرجه من سياقه؟ فالله توفى عيسى عليه السلام قبض روحه ورفعه وعندما يحين وقته ينزله والأحاديث في ذلك صحيحة والقرآن الكريم يقول (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ)[الزخرف:61] أي إنه لعلامة للساعة وورد (وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ)[النساء:159[ قبل موته المرة الثانية، هذا تأويل.
الرأي الثاني أن كثيرًا من العلماء يقول أنه رفعه وقبضه إليه دون موت وهو عنده جلّ جلاله وسيُنزله قبيل نهاية مدة الدنيا ويصلي وراء إمام المسلمين ويقتل الدجّال كما ثبتت الأحاديث الصحيحة ويوفِّقون بين هذا وذاك.
المقدم: هل هناك أقوال معتبرة في علماء المسلمين أن عيسى عليه السلام توفّاه الله؟
د. المستغانمي: نعم موجود، الإمام الحسن البصري وابن جريج يقولون متوفيك أي قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت، ابن زيد يقول: متوفيك وقابضك ومتوفيك ورافعك نفس الشيء، الربيع عن ابن أنس: وهي وفاة نوم (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ)[الأنعام:60] النوم وفاة قصيرة، الإمام القرطبي يعلق قائلًا: والصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير موت ولا نوم وهو قول الحسن البصري وابن زيد، صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور يقول: إني متوفيك أي إني مميتك، هذا هو معنى هذا الفعل في مواقع استعماله في القرآن كله بالاستقراء، ويستدل أيضًا بقول الله تعالى على لسان عيسى (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ)[المائدة:117] لأنه لا يدري فالوفاة تقطعه عن الدنيا فهو لا يعلم ما وقع بعده، فالقضية خلافية بين العلماء وابن عباس يقول مات موتًا حقيقيًا وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، والحديث في صحيح مسلم “يبعث الله عيسى” كلمة “يبعث” يعني بعد موته. فثمة أدلة متنوعة في هذه القضية والدقيق أن الله سيبعثه وسيصلي خلف إمام المسلمين ويُحق الحق ويصلي وراء جنازته المسلمون.
المقدم: عيسى عليه السلام ليس موجودًا بيننا الآن وسوف يعود بإذن الله كما تدل النصوص والأحاديث الواضحة في هذا الشأن، لكن الآن هل هو متوفى أو عند الله فهذا علمه عند ربي
د. المستغانمي: نحن ذكرنا أقوال العلماء ومن شاء مزيدًا من التفاصيل يمكن الذهاب إلى مفاتيح الغيب للرازي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
سؤال من الأخ أحمد الشرفات من الأردن: (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ هود) هل يُفهم من هذا أنه من دخل الجنة يخرج منها إن شاء الله وهل نسخت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ أنهما وردتا في سورة مكية؟
د. المستغانمي: سؤال وجيه جدًا ويلفت كل قارئ متدبر والآية لا بد أن نحملها على عادات العرب في كلامهم. كلام العرب عندما يقول (يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ) ليس معنى ذلك إذا انقضت السموات والأرض يخرجون، هذا المعنى غير مقصود.(ما دامت) على لسان العرب يقولون: سأدعو الله ما لاح برقٌ وما لاح كوكب، العرب يقولون في كلامهم هذا للدلالة على الديمومة وعدم الانقطاع، وهذا الرأي الراجح عند المفسرين (ما دامت السموت والأرض) تفيد التأبيد على لسان العرب أي كأنه يقول خالدين فيها أبدًا لأن العرب يقولون: والله سأفعل ذلك الأمر ما لاح قمر، وما لاح كوكب، ما دام الليل والنهار.
المقدم: هنا لفتة لغوية أسأل عنها (ما دامت السموات والأرض) أين خبرها؟
د. المستغانمي: باقيتين، لم يذكره، الحذف موجود في اللغة العربية ما دامت السموت والأرض مستمرتين باقيتين لكن نحن نعرف في القرآن الكريم (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) لو ربطناها بوجود السموات والأرض معنى ذلك لا يدومون، لا. هو في الحقيقة تفيد الدوام والتأبيد. الإشكال يقع في قوله (إلا ما شاء ربك) الاستثناء سواء في حق أهل النار أو في حق أهل الجنة، الاستثناء هنا ليثبت عقيدة المشيئة المطلقة عند الله سبحانه وتعالى وهذا كلام الإمام القرطبي، كلام الإمام الرازي، كلام صاحب تفسير المنار محمد رشيد رضا وصاحب محاسن التأويل جمال الدين القاسمي يقول (إلا ما شاء ربك) يعني الله سيخلِّد الكافرين المشركين في جهنم ولكن تبقى المشيئة مطلقة، خلودهم ليس طبيعيًا إنما هو خلود بمشيئة الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يغيّر النظام لفعل لكن شاءت قدرته ومشيئته أن يخلد الكافر في النار، فهي من باب فتح باب المشيئة المطلقة دائمًا الله تعالى مشيئته مطلقة. في القرآن الكريم سيدنا شعيب عليه السلام قال له قومه (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا)[الأعراف] شعيب متأكد وموقن، هو نبي ومع ذلك ترك استثناء المشيئة بيد الله (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾ الأعلى) فتح باب المشيئة هذا شيء عظيم. الدليل على أن عذاب الكافرين ثابت وخالدين في النار ونعيم المؤمنين الصادقين الموحّدين ثابت نعيم في الجنة أن الله تعالى لما علق على المؤمنين قال (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) أي غير مقطوع، الجذاذ هو القطع (جعلهم جذاذا) أي قطعًا، عطاء غير منقطع هذا دليل على الاستمرار، ذكرها في الجنة ولم يذكرها في النار لأنه في الجنة فيها امتنان وإحسان فيحسن تذييل الآية (عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) لو قال لأصحاب النار “عذابا غير مجذوذ” ليس فيها تفضّل، أنهى آية النار بقوله (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) وهذا فعله العدل وأنهى آية الجنة (عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) هذا الخلود في الجنة دليل على الخلود في النار، إنما جاءت الآية على وفق لسان العرب.
سورة المؤمنون
المحور العام للسورة والأفكار الرئيسية في السورة:
سورة المؤمنون تتحدث عن صفات المؤمنين ذكرتها في بداية السورة وفي وسطها وفي نهايتها. هذا المحور العظيم أيضًا يدور حوله مواضيع تلتفّ حوله هي تعتبر ملامح رئيسة للسورة: أول ملمح التوحيد، وإن كان ثمة سور كثيرة محورها التوحيد، محور التوحيد موجود في كثير من الآيات، محور رسالة الأنبياء، محور نفي البشرية الذي عوّل عليه المشركون (مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) جاءت السورة تبين أن حقيقة الرسل هم بشر بدليل أنهم يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون وجاء كثير من الأدلة لإثبات بشرية الرسل أنهم بشر بعثوا لبشر لأنه لو بعث الله ملائكة كما يقولون لقالوا هؤلاء ملائكة يطيقون ما لا نطيق، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون،
المقدم: وذكر ذلك واضحًا جليًا في سورة الإسراء (قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾)
د. المستغانمي: وذكر هنا أيضًا (مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ) هذا ملمح من ملامح السورة. ثم ورد في السورة أدلة الخلق وأدلة الكون كما تكلمنا على خلق الإنسان، خلق السموات، إنزال المطر، من بيده ملكوت السموت والأرض، من الذي يجير ولا يجار عليه؟ للتذكير بالعقيدة الصحيحة لكن المحور الأساسي سماها الله سورة المؤمنين كما سمى سورة للكافرين وكما أن ثمّة سورة للمنافقين.
المقدم: ندخل موضوعًا جديدًا وهو حديث الله سبحانه وتعالى في هذه السورة حول الجنات والنخيل وقبل ذلك حول الماء الذي أنزله من السماء. هنا ذكر الجنات والنخيل والأعناب والزيتون ليس مقتصرًا على هذه السورة بل ذكره في مواضع كثيرة لكن ليس بنفس الترتيب، هنا قدّم الجنات النخيل والأعناب والفواكه على شجرة الزيتون ولم يقل شجرة الزيتون لكن قال (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ) نريد أن نقف عند هذه الآيات.
د. المستغانمي: من نعم الله على البشر أن أنشأ الله الجنات في الأرض أكلًا سائغًا للبشر حتى تستمر حياتهم، فأنواع الثمار وأنواع الفواكه أنواع القوت تختلف وتتنوع. هنا يمتن الله عز وجلّ على البشر جميعًا أن أنشأ لنا جنات من نخيل وأعناب ودائمًا يتحدث الله عز وجلّ عن النخيل والأعناب لأنها من الثمرات التي يعرفها العرب في بلادهم. أحيانًا يقدّم الخضراوات: الزيتون والزرع (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ النحل). هنا للامتنان، بيان الامتنان والإحسان فبدأ بالنخيل والأعناب، النخيل يعطينا التمر والتمر قوت وفاكهة منه الرُطب ويقتات منه الناس، يتقوّت منه الناس ويقتاتون ويأكلون، القوت والفاكهة مرعيان فيه، والعنب نأكله عنبًا ونأكله زبيبًا، هو قوت وفاكهة وأخّر الزيتون لأنه قوت فقط بينما عندما يقول في سورة النحل سورة النعم قال (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ)
المقدم: مع أنه في هذه الآية (فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾) قدّم الفواكه على القوت
د. المستغانمي: والفاكهة تؤكل، هو يتكلم عن (منها تأكلون) من جنات التمر من النخيل من الأعناب من الفواكهة، أنهاها بالفواكه وهنا أسلوب امتنان (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ) (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ) ذكر خلق الإنسان بطريقة الامتنان عليه وهنا أيضًا قدّم الفاكهة والقوت على الزيتون بينما في سورة النحل قدّم الزيتون والزرع على الفاكهة لأنها سورة النعم بسط فيها جميع النعم من مأكولات ومشروبات. في سورة المؤمنون يمتنّ الله تعالى على المؤمنين أن سخّر لهم كل هذا.
(فواكه كثيرة) أحيانًا نجد آيات فيها فواكه بدون وصف كثيرة، فاكهة الجنة كلها كثيرة (لا مقطوعة ولا ممنوعة) لكن أشير فقط أن (فواكه كثيرة) للمؤمنين الصادقين الخاشعين تتناسق مع المنافع الكثيرة في الأنعام لما قال (و وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ) بينما في آيات أخرى ذكر (ولكم فيها منافع). في سورة الصافات يقول (أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾) لم يقل هنا فواكه كثيرة لأنه ليس في سورة الصافات ما يقتضي هذا الوصف، كان يتكلم عن الأبرار في الجنة. في سورة المرسلات يقول جلّ جلاله (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾) لم يقل وفواكه كثيرة، في سورة ص (مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾) هنا وصف الفاكهة الكثيرة والمفروض: وأشربة كثيرة، لو قال بفواكه بالجمع تأتي (وأشربة) حتى لا يختلّ إيقاع سورة ص، جمعٌ فإفراد، شراب إفراد، فصل الخطاب، إنه أوّاب، هي نفسها، هي في الحقيقة نفسها، الجنة فيها فاكهة وفواكه، عندما يقول فاكهة ليس المقصود بها حبة وإنما جنس الفاكهة، كل أنواع الفواكه إلا أنه هنا قال (بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ) لم يقل بفاكهة وشراب لأنه موجود في سورة ص (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ) هذا نظرية التجاذب.
لو جئنا إلى سورة يس (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾) لا يوجد ما يقتضي كثيرًا بينما في سورة المؤمنون ثمّة ما يقتضي (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾) وهذا من الامتنان العظيم في سورة المؤمنون على المؤمنين الخاشعين الصادقين.
المقدم: قال (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ) ما قال زيتون ولكنها الزيتون؟
د. المستغانمي: هي الزيتون، وأنا أقرأ لدى المفسرين (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ) وهل شجرة الزيتون تخرج فقط في سيناء؟ أول ما أنبتها الله في هذا المكان بدليل (أنشأنا) الإنشاء من البداية، أنشأ الإنسان (ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ)، أنشأنا الجنات، أنشأنا رسلًا، فهو لم يقل عن الإنبات، بعدما أنشأها في بلد الطور وفي سيناء بعد ذلك أُخِذت وكان الإنبات في جميع الأرض، هنا يتحدث عن البدايات.
المقدم: لعله هنا يستقيم مع قول الله سبحانه وتعالى (فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ) كأنه يستقيم قول: فأنشأنا به شجرة تخرج
د. المستغانمي: هذا هو المطلوب، العطف هنا وارد والواو عاطفة ليست استئنافية: أنشأنا به جنات وأنشأنا به شجرة والفعل لا يُعاد لأنه مفهوم.
المقدم: وكيف استدللت على ذلك؟ هل في القرآن موضع آخر ذكر فيه: أنشأ الزيتون؟
د. المستغانمي: السياق كله عن الإنشاء وإنما جاءت الواو عاطفة (فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ) (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ) أي وأنشأنا شجرة لأن التعاطف نعطف على ما سبق والجملة السابقة فيها فعل ماضي و(شجرةً) مفعول به.
المقدم: (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآَكِلِينَ) ما معنى صبغ للآكلين؟
د. المستغانمي: يصبغ به، “كلوا منه وادّهنوا” زيت الزيتون الذي يُعصر من الزيتون هو صبغ للآكلين كانوا يأتدمون به وانظر إلى الآكلين كيف أضافها، كل هذه الكلمات جمعها الله في سياق واحد ثم يعطينا الخلاصة عندما نصل إلى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ) كل هذا تمهيد وإلا الله جلّ جلاله كان يستطيع أن يقول وهو مستطيع وشجرة تخرج من طور سيناء وصبغ، (لِلْآَكِلِينَ) هو يمهّد للبشر والرسل بشر.
المقدم: يستمر الحديث حول الأنعام (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾) حتى يأتي بداية القصص، نرى الحديث حول الأنعام والامتنان على المؤمنين بالأنعام واضحًا جليًا في هذه السورة فما دلالة هذا الأمر؟
د. المستغانمي: أولًا الأنعام ذكرهم في كثير من السور، في سورة الأنعام وفي سورة النحل ذكرهم ذكرًا مفصًلا للأنعام وفي سورة المؤمنون وأيضًا (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ يس) فالأنعام نعمة عظيمة والعرب كانوا على صلة بالإبل على وجه الخصوص، هي سفينة الصحراء ومنها يشربون اللبن ويتفاخرون بما لديهم. (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً) (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ الغاشية) العربي عندما كان يحبّ بعيره ويحبّ ناقته أحيانًا أكثر من حبه لأولاده أو حتى لنفسه. ثم قال (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا) اللبن، هذه نعمة، ونأكل من لحومها، جلودها وأصوافها وأوبارها نستفيد منها أيضًا، الأنعام يقصد بها الإبل والمعز والبقر والغنم لكن يرجح دائما لما قال (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) الإبل لأن العرب يعرف قيمة الإبل، هذا الحضور واضح في سورة المؤمنون لأنها تمتنّ على المؤمنين بهذه النعم.
في سورة النحل ذكر الله تبارك وتعالى الأنعام في ثلاثة مواضع: في بداية السورة وبعدها بقليل وفي نهايتها، شيء لافت للانتباه، في البداية يقول (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ) قال منافع ولم يقل كثيرة (وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) ثم قال (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾) سياق سورة النحل هي سورة النعم وسورة الرحمن هي سورة الآلآء، ذكر نعمة الله في الأنعام وقال (لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ) الدفء يؤتى من الجلود، جلود الغنم وجلود البقر وجلود الماعز، هذا الدفء الذي يجده العربي ويجده غير العربي (وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) ربط الدفء الذي نجده في تلك الجلود (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) العربي كان يجد متعته عندما يكون القطيع عائدًا (حِينَ تُرِيحُونَ) العودة من الرعي (وَحِينَ تَسْرَحُونَ) قدّم العودة على الذهاب لأن الفلاح يكون فرحًا مسرورًا بعودة النوق وهي محمّلة، بعودة القافلة، النظرة الجمالية في القرآن مقصودة فقال (لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ) الناس يتفاخرون بالملابس الجلدية.
في وسط السورة (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ) – وفي سورة المؤمنون قال (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا) – من لبن (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا) هنا التركيز على نعمة اللبن لأن السياق يتحدث عن المشروبات (سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ) وعطف عليها (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾) النبيذ ولم يكن قد نزل تحريمه في مكة، (سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا) هذا إشارة إلى أن البيع والتجارة والأكل أحسن من الشرب لكن هو ذكر ما يستخرج من النخيل والأعناب وقال (سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا) وبعدها قال (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ) في سياق الشراب الذي يخرج من النحل وهو العسل وما يخرج من الثمرات ذكر ما يخرج من الأنعام.
في نهاية السورة قال (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا) كيف كان العربي يصنع خيمته من جلد الناقة ويستخفّها يحملها وهو يرحل (تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ) جاء هذا المقطع في المقطع الذي يتحدث عن البيوت وعن الأكنان وعن الجبال (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ) فالقرآن دقيق جدا يأتي بالنعمة في سياقها.
في سورة المؤمنون (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً) امتنان وإحسان (مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) كأنه يقول تنتفعون بها في أسفاركم ومنها أيضًا تأكلون (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾) وجاء بالفلك هنا في الحديث عن الأكل والأنعام لأن الفلك هو وسيلة من وسائل النقل البحرية المواصلات البحرية وزالأنعام وسيلة العربي سفينة الصحراء فجمع بين النعمتين نعمة وسيلة التنقل البرية ووسيلة التنقل البحرية (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾) ثم جاء بعدها (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا) هذا يسمى حسن التخلّص وهو شيء رائع في القرآن. حسن التخلص في البلاغة هو أن يأتي المتكلم البليغ وفضلًا الله تعالى أبلغ البلغاء، القرآن كله بلاغة، يأتي المتحدث بكلام ثم يشفعه بجملة يتخلّص منها إلى موضوع آخر هو الأساس وهو المطلوب -إن صح التعبير- وهنا قال (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ) نوح مشهور بصناعة الفلك وقومه يسخرون منه.
المقدم: ما الفرق بين (من بطونه) (من بطونها)؟
د. المستغانمي: في اللغة العربية دائمًا التأنيث أكثر من التذكير، المؤنث كثير في القرآن، (وقال نسوة) نسوة مؤنث وجاء الفعل (قال) مذكرًا لأن عدد النسوة قليل، نسوة هو جمع تكسير يجوز فيه الوجهان قال نسوة وقالت نسوة، نسوة مؤنث حقيقي لكن لأنه جمع تكسير يجوز فيه تذكير وتأنيث الفعل، قال رجال وقالت رجال، قالت العرب وقال العرب، هذه قاعدة معروفة، قالت الأعراب وقال الأعراب. النسوة اللواتي قلن حديثًا عن امرأة العزيز عددهم قليل فمع القليل جاء بالفعل مذكرًا ومع الأعراب وهم قبائل كثيرة جاء الفعل مؤنثًا (قالت الأعراب آمنا) هذه قاعدة معروفة في اللغة العربية، المؤنث دلالة على الكثرة.
في سورة النحل عندما قال (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ) أتى بهاء الغائب التي تدل على المذكر (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا) كم عدد الأنعام التي يسقينا من بطونها لبنا؟ قليل، اللبن يؤتى من الإناث فقط ليس من الذكور ومن الإناث في أزمنة معينة، إذن العدد قليل فجاء (مِمَّا فِي بُطُونِهِ). في سورة المؤمنون الحديث عن الأنعام، كل الأنعام (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا) أتى بالمؤنث لأنه ذكر كثيرًا من منافعها. في سياق سورة النحل ذكر فقط اللبن، في سياق اللبن الإناث فقط، في سياق الأكل والشراب والمنافع الكثيرة عدد كبير من الأنعام ذكورا وإناثًا، التي تلد والتي لا تلد فناسب (مِمَّا فِي بُطُونِهَا) جميعًا، سياق الكثرة اقتضى الهاء (مِمَّا فِي بُطُونِهَا) وهذا معهود في اللغة العربية.
المقدم: بدء القصص في سورة المؤمنون والبداية كانت من قصة سيدنا نوح عليه السلام ولا شك أن القصص في القرآن حافل وهو في سورة المؤمنون لم يذكر قصة نوح فقط وإنما جاء بقصص أخرى كذلك. نتوقف وقفة عامة حول القصص التي وردت في سورة المؤمنون والاختلاف بين ما ورد هنا وبين ما ورد في أماكن أخرى، مثلًا قصة نوح من الأماكن القليلة التي جاءت مفصّلة كما وردت في سورة المؤمنون، ربما في سورة نوح كذلك؟
د. المستغانمي: وفي سورة هود، في سورة المؤمنون فيها تفصيل ولكن موضع سورة هود أكثر تفصيلًا وثمّة أسباب. (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾) مثيلتها من سورة هود (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾) تشبهها لكن هناك خلاف (أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾) أما هنا في سورة المؤمنون ليس فيها تهديد ولا يوجد وصف الإنذار (إني لكم نذير مبين). القصص في كل القرآن وهذه قاعدة عامة يخضع لجو السورة يخضع لهدف السورة، سورة تتحدث عن التكذيب يؤتى من قصص الأنبياء ما يؤيد أن الأقوام السابقين كذّبوا فنالهم العذاب وأهلكهم حتى يتعظ المشركون والمخاطبون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذوا العبرة من الأقوام السابقين.
لو ذهبنا إلى سورة القمر (كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾) (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾) وتحدث عن تكذيبهم وعن إلحاق العذاب بهم. هنا جاء التركيز على الأمر بالعبادة والأمر بالتقوى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾) ما ورد من قصة نوح في سورة المؤمنون هو في الحقيقة مرآة صغيرة لما عاشه محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما أنطق الله نوحًا في قصته وما صوّرته لنا جاء في سورة المؤمنون ما يشبهه من حياة محمد صلى الله عليه وسلم. مثلًا نوح عليه السلام قال لقومه (اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) نوح أمر بالعبادة وسورة المؤمنون تأمر بالعبادة (في صلاتهم خاشعون، للزكاة فاعلون) عبادات. سيدنا نوح قال لقومه (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) توحيد، تقرأ في سورة المؤمنون (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾) ما جاء على لسان نوح موجزًا جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مفصّلًا لأن القرآن موجّه للعرب ولأمة الإسلام والمسلمين ليس لقوم نوح، نوح ذكّرهم ما قال فقط (اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) هو قال كثيرًا لكن أوتي بهذه العبارة الجامعة وفي عهد محمد صلى الله عليه وسلم تم تفصيلها (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾) هذه دعوة للتوحيد، (وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾) من هو الله، عرّفنا بالله الذي تأمرنا بعبادته، الله الذي أأمركم بعبادته هو الذي ذرأكم في الأرض، الله الذي أأمركم بعبادته هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. فما جاء على لسان نوح موجزًا أو أي نبي موجزًا جاء مفصّلًا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
نوح قال (أَفَلَا تَتَّقُونَ)، محمد صلى الله عليه وسلم قال (أفلا تتقون، أفلا تذكّرون، أفلا تعقلون، فأنّى تسحرون) أيّها أكثر تفصيلًا؟! القرآن موجه للعرب، للمسلمين، للأمم. في قصة نوح عليه السلام قال قومه عنه (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ) به جنّة يعني مجنون، هم تحرزّوا ما قالوا مجنون، تأدبوا لكنهم سيقولونها في موضع آخر لما أراد الله تعالى تصوير هلاكهم في سورة القمر (وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ) وقتها انتهى الكلام (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾) فجاء العذاب. بينما هم قالوا (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ) لغويًا: ما هو إلا رجل به جُنّة. المشركون قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ) كل ما جاء هناك جاء مفصّلا مفرّقًا (أم يقولون به جنّة) لكن الفرق أن نوحًا جاءت القصة أقول مجرّدة والقصة في عهد محمد جاءت بردّ من الله (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ) الله تعالى لم يتخلى عن محمد صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب موجه لقومه اتهموه بالجنون الله تعالى رد عليهم (بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ). سنقرأ بعد قليل الرسول الذي سيأتي (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾) نفس الكلام ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم، قال (فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ) لماذا كل هذا التفصيل؟ أرسلنا فيهم رسولًا منهم وهذا الكلام ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولا فيهم، في قريتهم، منهم، من نسبهم ينحدر من أصولهم، لما جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) هو ولِد فيكم، هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، قال أحد المفسرين: وكفى بالخطبة التي ألقاها أبو طالب في نكاح خديجة – ذكر كل النسب وكل حسب ونسب – قال كفى برُغائها مناديًا. كفى بهذه الخطبة العصماء منادية عليه، كانوا يسمونه الصادق الأمين (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ)؟!.
نوح عليه السلام، أفصّل حتى يعكس القارئ القصص على حياة محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب، لما دعا ربه (قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾) قال (فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا) وذكر عذابهم بشيء من الاختصار ذكر عذاب المشركين (لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾) ثم قال (حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾) ذكر كيف عذبهم في الدنيا وسوف يعذبهم في الآخرة من مات على الشرك. في قصة نوح الموجزة قال(فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾) علّمه كيف يدعو. البيان القرآني ركّز على دعاء نوح، سورة المؤمنون علّم الله تبارك وتعالى محمدًا كيف يدعو (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾) وفي الآخر قال (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾) علّمه كيف يدعو كما علّم نوحًا عليه السلام (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾) نفس التعليم موجه لنوح، نفس التعليم موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم وثمّة تفاصيل عندما نصل إلى القصص الآخر.
المقدم: هنا نجد في الآية الأولى (فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ) ونجد في الآية الأخرى (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) ما الفرق بين التعبيرين؟
د. المستغانمي: التعبير في قوم نوح (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) الملأ هم الذين يملأون العيون بهجة ووقارًا ويملأون العوين أبّهة، بينما الفقراء لا يملأون العيون حتى وإن زاد عددهم، المقصد قال الملأ كبار القوم من قوم نوح كفروا، الآية عبّرت عن الملأ الذين كفروا. بينما الآية الثانية (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) هنا كل قومه الذين كفروا، الرسول الثاني عانى عناء أكثر، نوح (وما آمن معه إلا قليل) هذا أكثر لأن الآية قالت (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) الذين كفروا صفة للقوم وليست صفة للملأ بينما التعبير الأول ركزت على الملأ الكافرين هنا الموقف الثاني لما قال (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾) ما قال هذا الكلام في الأول قال (كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ) أخّر الصفة ليعطف عليها، أخّر صفة الكفر لأنه لو قال: “قال الملأ الذين كفروا من قومه وكذبوا” يلتبس الكلام.
القصة الثانية -والعلماء يقولون إنها تخص سيدنا صالح عليه السلام- (رَسُولًا مِنْهُمْ) بدليلان اثنان: (لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ) (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ) وفي سورة الحجر (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾)، هذا رأي العلماء المفسّرين في الاستنباط، لكن الله تعالى ما ذكر اسم النبي إنما العبرة أن النبي كان منهم ودعاهم والذي يهمنا في هذا السياق أنهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم، نفس الصفات كانت في المكذبين من قريش كفروا وكذبوا (أَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾) ثم قال (وَأَتْرَفْنَاهُمْ).
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة المؤمنون – 4
تفريغ سمر الأرناؤوط لمموقع إسلاميات حصريًا
إجابة على أسئلة المشاهدين:
سؤال من الأخت سمر الأرناؤوط: سؤالي في سورة الكهف التي تحدث عنها الدكتور جزاه الله خيرًا سابقًا لفت نظري أن السورة تعدد ذكر المال بألفاظ متعددة هي: (المال، الوَرِق، أجر، كنز، وخَرْج) وحذّرت من أن المال زينة الحياة الدنيا (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا). وقد عُبّر عن المال في قصة فتية الكهف (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا) وفي قصة صاحب الجنتين (فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا) وفي قصة بناء الجدار (فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) وسمّاه كنزا (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا) وفي قصة بناء السد (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) فهل من الممكن توضيح الاختلاف بين هذه الألفاظ وتناسب كل لفظ منها مع سياق الآيات التي ورد فيها؟
د. المستغانمي: من بين أيقونات السورة اللفظية المال وأنواع المال بدليل (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) والمفتاح موجود في أول آية عندما قال (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾) هذا هو المفتاح، معناه أنه في السورة سنجد كثيرًا من الحديث عن هذا، ووجدنا ذلك مع صاحب الجنتين الذي افتخر بجنتيه وماله. جاء ذكر المال وجاء ذكر الوَرِق بكسر الراء وهو الفضة وجاء ذكر الأجر (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) وهو العوض، الأجر الذي يأخذه الإنسان بدل ما قدمه من عمل والخرج (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) هو أيضًا مقابل يحدده صاحب العمل لمن يقدّم له شيئًا.
المقدم: والغريب أنه في لهجتنا المحلية إلى اليوم نقول: خرجية
د. المستغانمي: ربما منها وكثير من الكلمات العامية فصيحة، ولما نصل إن شاء الله في سورة المؤمنون نجد (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾ المؤمنون) الخرج هو ما يُعدّ مقابل عمل معين. الخرج غير الخراج: الخراج هوزيادة، في سورة المؤمنون قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: هل أنت تطلب منهم مالًا قليلا، صغّر الكلمة (خرجا) مال، فخراج ربك خير (خَراج: الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى) (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)، ما يعطيك الله أكثر بكثير مما يعطيك هؤلاء إن صح أنه سألهم ولكن محمدًا صلى الله عليه وسلم ما سألهم. الخرج هو المقابل، الكنز هو المال المدفون أو المال المدّخر المكنوز (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ)[التوبة:34] وفي سورة الكهف (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا) إذن ثمّة أنواع المال ذُكرت ولكن شرح كل واحدة مع سياقها سيأخذ وقتًا.
سؤال من الأخ بن علي: كنت أريد أن أسأل عن الروايات مثلًأ لما نقرأ في الجزائر برواية ورش (قد افلح المومنون) بالتسهيل أو (قد أفلح المؤمنون) برواية حفص، في سورة الفاتحة مالك وملك، هل هناك اختلاف في هذا الأمر؟
د. المستغانمي: كأنه يريد أن يقول ما جدوى هذه الاختلافات وهل ثمة خلافات كبيرة؟ نقول لا، أولًا القرآءات القرآنية هي سنة متبعة وهكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منه المسلمون القرآءة ورواها العلماء كابرًا عن كابر وتلقفوها بالرواية والقرآءات هي وجوه قرأ بها كبار القرّاء الذين أخذوا عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي توقيفية هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ، كلها العشر الصحيحة، نقول: سبع متواترة وعشر صحيحة، المتواترة التي رواها جمعٌ عن جمع والثلاثة بعد المتواترة هي صحيحة وثمة قرآءات شاذة يستأنس بها في التفسير ولا يقرأ بها في الصلاة وفي العبادة، فهي وجوه، مثل الإدغام، فكّ الإدغام، إطالة المدود، تحقيق الهمز (قد أفلح المؤمنون) في رواية ورش عن نافع (قد افلح المومنون)، بعضهم يقرأ بالتقليل وبعضهم يقرأ بالإمالة فهذه كلها وجوه للفظ العربي وبالعكس هذا دليل الإعجاز، دليل ثراء اللفظ القرآني يُقرأ بطرق مختلفة: ملك يوم الدين هو الملك ومالك يوم الدين هو الذي يملك، إذن الله هو ملك ومالك والقرآءتان يقوي بعضهما بعضًا فجميع القرآن كتب ابن فارس الحجّة في القرآءات (أربع مجلدات) وثمة علماء ناقشوا توجيه القرآءات والفوائد التي تنجم وتنبثق عنها، شيء جميل جدًا، لكن الفقهاء يفضّلون أن القارئ إذا كان في الصلاة لا ينتقل من قرآءة لقرءآة بغير ما سبب إنما يقرأ برواية واحدة حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو السوسي عن الدوري ولا يخلط بين القرآءات.
المقدم: وإذا كان إمامًا عليه أن يقرأ بقرآءة أهل البلد حتى لا ينكروا عليه قرآءته إن كانوا لا يعرفونها.
سورة المؤمنون
المقدم: في الحلقة الماضية ذكرنا وبالأمثلة كيف أن كل ما ورد في قصص الأنبياء من حديث الله تعالى على لسان الأنبياء ورد كذلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة ودلّلنا على ذلك أدلة كثيرة منها (فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾) يوضح هنا أن الرسول جاء فيهم ومنهم فبالتالي حينما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿٦٩﴾) هذا الذي يتضح واضحًا جليًا فيما يتعلق بالقصص الذي ورد في سورة المؤمنون وهذه من ملامح هذه السورة القَصصية.
د. المستغانمي: ليس ذلك فقط لكن أيضًا القصص القرآني، القصص في سورة الشعراء يتناغم وينسجم مع موضوع سورة الشعراء، القصص في سورة هود ينسجم مع موضوعها. نفس الآية لما ذكرنا (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾) توافق هذا المطلع مع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعبادة في سورة المؤمنون وأمر بعبادة الله وحده ودلّل (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾) (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾) ما جاء موجزًا على لسان نوح وعلى لسان الرسل الآخرين جاء مفصلًا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
المقدم: حتى في سورة نوح يقول الله سبحانه وتعالى (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٣﴾ نوح) ذات المعنى
د. المستغانمي: هي كلها متشابهة، لماذا يقولون المتشابه اللفظي في القرآن؟ لما تقرأ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾) أين وردت هذه؟ في سورة المؤمنون ونفس الآية وردت في سورة هود (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾) قال (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) هذا ينتناغم مع سورة هود لأن فيها نفس المقاطع (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) وفي بدايتها (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾) من البداية من أول آية في سورة هود وأيضًا في قصة عاد (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾) يستقيم مع ما ورد في حق محمد صلى الله عليه وسلم في سورة هود. هود عليه السلام قال لقومه في سورة هود (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) ومحمد صلى الله عليه وسلم قال (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى)[هود:3]. سيدنا هود قال (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾) وعلى لسان محمد (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) ثمة تشابه بين المضامين لذلك ما أورده الله في سورة هود من قصص هود ونوح وصالح ولوط ثمة ما يربطه بقصة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته مع قريش ومع المسلمين. مثلًا لما قال قوم نوح لنوح (وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ) [هود:27] ردّ عليهم القرآن (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ)[هود:3] هو الذي يفضّل ويعلم أين يجعل رسالاته، في حق محمد صلى الله عليه وسلم, عندما قال نوح (وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ هود) وفي قصة محمد قال (إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ هود) في كل مشهد من المشاهد القصصية جاءت لتخدم حياة محمد. تعجبت كثيرًا وأنا اقرأ على لسان سيدنا هود (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾) هذا الكلام ورد تمامًا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾ هود) في بداية السورة، هذا الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه، ثمة تشابه عجيب لذلك ما ورد في سورة المؤمنون ينسجم مع ما ورد فيها من أحكام ومن مضامين محمدية إسلامية.
المقدم: (فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) وفي سورة هود قال الله سبحانه وتعالى (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) [هود:40] فما الفرق بينهما؟
د. المستغانمي: أولًا: سلك غير حمل، اسلك يعني أدخل (اسلك يدك في جيبك) في سورة طه يعني أدخِل. (فسلكه ينابيع في الأرض) سيّره أو جعله يمشي في ينابيع وأنهار جوفية، سلكه ينابيع متعددة. اسلك في السفينة أو في الفلك بمعنى أدخلهم واطمئن عليهم كأن فيها شيء من الطمأنينة لأن العذاب لم يحلّ بعد، هو هنا في قصة نوح لم يذكر العذاب فقط ذكر (فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ). ثانيًا: سبق كلمة الحمل، قلنا المرة الماضية لما قال (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ المؤمنون) لما قال (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) مهّد للحمل فقال (فاحمل فيها) وهنا أتى بفعل من عائلة الحمل ولكن فيه العناية (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ) فهو يخبره قبل وقوع الحادث (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾). في سورة هود لما وقع الأمر ما قال (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ) وإنما قال بسرعة (احمل فيها) قام نوح ينادي (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) في سورة هود ركز البيان القرآني على الطوفان وهو يجري بدليل (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾) وهو كاد يغرق. إذن أثناء حدوث الطوفان قال (احمل) بسرعة وقبل ذلك عندما أخبره قال (اسلك) فيها نوع من التأنق في التعبير- إن صح التعبير- وعلّمه كيف يدعو قبل ذلك (فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾) استنبط منها أحد العلماء المفسرين ثلاثة أشياء جميلة: من أراد أن يدعو الله عليه أن يحمده ويدعوه ويثني عليه، هذا من آداب الدعاء. قال: علّمه كيف يحمد (فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا) ثم ادعُ الله (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا) ثم أثنى على الله بما يستحق (وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) فإذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فاحمده وادعُ ثم أثنِ عليه. كل الأدعية في القرآن فيها أسرار.
نكتة: ثمة أدعية في القرآن بالإفراد وثمّة أدعية بالجمع (اهدنا الصراط المستقيم) جمع، فلا ينبغي لك عندما تدعو الله أن تقول اهدني بل اطلب الهداية للجميع لأن البشرية جميعًا بحاجة للهداية في كل وقت وحين. قل (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا) كل البشرية محتاجة للمغفرة، (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾ المؤمنون) هذا عام، هذا تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء في القرآن ورد جمعًا وورد إفرادًا. الإفراد عندما قال (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا) الحديث موجه لنوح عليه السلام، إذن أنت لما تكون في طائرة مثلًا ليس كل الناس مسافرين معك، لو قلت أنزلنا منزلا مباركا، جميل، لكن تبرّكًا بالقرآن ادعُ بالإفراد (أدخلني مدخل صدق، أخرجني مخرج صدق، أنزلني منزلا مباركا) أنت تتبرك بالأسلوب القرآني. في المرض لما تكلمنا في سورة الأنبياء (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾) بالإفراد، ليس كل الناس يكونون مرضى في نفس الوقت لم يعلمنا الله أن ندعوه: ربنا إننا مسنا الضر جميعا لأن المرض يصيب أفرادًا والأصل أن يكون الناس أصحاء. لما يأتي الدعاء جمعًا اتركه جمعًا لا تصيّره إفرادًا تقول (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) تدعو بهذا الدعاء وأنت تطوف بالكعبة تدعو لك ولبقية الناس ولما علّم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سكرات الموت (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ المؤمنون) علّمه بالإفراد وسكرات الموت تأتي بالإفراد.
المقدم: (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ ﴿٣١﴾) من هم القرن الآخرين؟
د. المستغانمي: بعضهم يقول هود عليه السلام وقومه عاد لكن أنا أرجّح سيدنا صالحًا وثمود والدليل (قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾) ذكر أن ذلك وقع في وقت الإصباح وذكر أن الصيحة هي التي أصابتهم وليست الرجفة أو أي شيء آخر، بينما قوم عاد أصابتهم الريح (أرسلنا عليهم ريحا صرصرا)، في سورة الحجر قال (فأخذتهم الصيحة مصبحين) هذا الدليل يرجّ؛ أنهم قوم صالح عليه السلام لكن العبرة ليست بالتحديد وإنما بالعذاب الذي وقع لهم وبما قالوا لرسولهم.
المقدم: سؤال لغوي: (فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ) أرسل يتعدّى بـ(إلى) أرسلنا إلى، وورد في القرآن لكن هنا يقول (أرسلنا (في))
د. المستغانمي: أرسل يتعدّى بـ(إلى) وباللام، نقول أرسلت إليه وأرسلت له، يجوز لكن (إلى) هي الأفصح عندما يكون الإرسال إلى قوم، أرسلت إليه بريدًا، في القرآن كلها (إلى) (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) لكن ثمّة أحيان يقول (في) التي تفيد الظرفية. نحن لا نقول أرسل يتعدّى بـ(في)، لا، هنا القرآن استعمل (في) لإفادة الظرفية أرسله فيهم، منهم، يعني أتى بمعنى الظرفية للقوم، في آية أخرى يقول (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍمِّن نَّذِير)[سبأ:34] هنا لا يأتي السؤال لأن (في) ظرفية، كأن البيان القرآني أتى بظرفية القرى وأتى بظرفية المدن ووضع الأقوام ظرفًا لذلك الرسول (أرسلنا فيهم)، حتى موجود (إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ)[آل عمران_164] يقال (بعثنا إلى) لكن بعثنا فيهم كأنه يقول بعثنا فيكم يعني فيكم ومنكم وصيّر القوم كأنهم ظرف لذلك الرسول.
المقدم: وارد في القرآن كثير (ولئن أطعتم بشرا) (ولئن أذقنا الإنسان) (ولئن مسهم الضر) ما هي هذه اللام؟
د. المستغانمي: هذه اللام تسمى الموطئة للقسم، (وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ المؤمنون) هذه موطئة ممهِّدة لقسم محذوف كأن القوم يقول بعضهم لبعض: والله لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، توطيء، تمهد للقسم، (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة) ثمّة قسم محذوف: والله لئن، تالله لئن. هذه اللام حريٌ بنا أن نفهمها حيثما وردت في القرآن الكريم. (إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ) جواب القسم وهنا التقى شيئان: التقى شرط وقَسَم، أصل الكلام: والله (إن) شرطية، القسم يتطلب جوابًا والشرط يتطلب جوابًا. بدون قسم لو قال: إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون، لكن لما سبقه القسم نقول (إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ) جواب القسم أغنى جوابه عن جواب الشرط بمعنى جواب واحد جاء للإثنين. لكن النحويون يقولون: جواب القسم المحذوف أغنى عن جواب الشرط، أدمجهما معًا.
المقدم: (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ المؤمنون) أحيانًأ يقولون ترابًا وأحيانًا يقولون ترابًأ وعظامًا كأنهم في حيص بيص؟
د. المستغانمي: لا نستطيع أن نقول هم في حيص بيص ولكنهم ينوّعون في الأساليب لأن العرب ينوعون، العرب أولو بلاغة وفصاحة كانوا مصاقعة خطباء، العربية كانوا يتذوقونها والقرآن جاء على لسان العرب وذكر ما ذكروا في مواضع مختلفة أحيانًا يقول (أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ ق) في سورة ق، لم يقولوا عظامًا، هنا يأتي البيان القرآني ودوره العجيب يأتي من الكلام ما يتناسب مع شخصية السورة التي نحن بصددها (قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾) ذكر الموت في سورة المؤمنون (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾) (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾) وذكرت العظام (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا) إذن ثمة ما يقتضيه التجاذب اللفظي فقال (ترابا وعظاما). لو ذهبنا إلى سورة الرعد (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ)[الرعد:5] لم يذكر عظامًا لأن السورة ليس فيها ذكر العظام، فالقضية تخضع لجو السورة إذا كان يناقش أمر العظام، يناقش خلق الإنسان يأتي بهما. في سورة الإسراء قال (وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾) لم يقولوا ترابًا لأنهم كانوا يعتدون والرفاة هو الحطام، بقايا عظام الجسد عندما تصبح رميمًا (من يحيي العظام وهي رميم) المرميم هي الرفاة العظام التي تتكسر. وكأنهم قالوا: يا محمد هذا العظم يتفتت ويصبح حطامًا –وبالمناسبة صيغة (فُعال) في اللغة العربية تدل على كل ما يتحطم: حُطام، جُذاذ، رفاة، فُتات – قالوا أئذا كنا عظامًا ولم يكتفوا (ورفاتا) ردّ الله عليهم (قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) حجارة أو حديدًا في الصلابة، الله عز وجلّ سيرزق هذه المادة الحياة (قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) إذا كان ثمة ما هو أقسى من الحجارة والحديد وهذا للتعجيز، لو كنتم كذلك سيبعثكم الله فما بالكم بالعظام والرفاة؟! وفي نهاية السورة قال أيضًا (وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا)[الإسراء:98] التجانس، التناسق، التناغم في القرآن، أنا أقرأ في التفاسير وأحب كلمة الإمام الفخر الرازي يقول: القرآن كلمة واحدة. نحن نقول القرآن متكون من جمل وآيات وكلمات وحروف هو رآه كلمة واحدة في الانتظام والدقة لا اختلاف فيها ومتناسقة جدًا.
المقدم: قال الله سبحانه وتعالى (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ ﴿٣١﴾) وهنا يقول (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آَخَرِينَ ﴿٤٢﴾) ويتكرر كثيرًا فعل (أنشأنا) في السورة ويتحدث في خلق الإنسان (ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ).
د. المستغانمي: وسوف تأتي آية أخرى (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾) في سورة المؤمنون بينما في سورة النحل (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [النحل:78] هذا كله يصب في برنامجنا، كل سورة لها ألفاظ، كل سورة لها أسلوب، لها اختيارات حتى أسلوب النفي: ثمّة نفي بـ(ما) والنفي بـ(لن) والنفي بـ(لا) والنفي بـ(إن هو إلا) الله سبحانه وتعالى يختار من أساليب النفي ما يتفق لذلك ليس القرآن كله معجز فقط، بل كل سورة معجزة، (أنشأنا) أيقونة لفظية مستعملة بإحكام دقيق وذلك شيء ربّاني.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول هنا (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آَخَرِينَ) وقبلها قال (قرنا آخرين) وقلنا أن المقصود بها والله أعلم صالح عليه السلام ودلّلنا على ذلك بأدلة، لكن هنا (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آَخَرِينَ) فمن المقصود بـ(قرونا) هل يقصد بهم أناسًا معينين؟
د. المستغانمي: يقصد بها أناسًا معينين لكن لم يذكرهم، لم يحدد أحد من المفسرين بل ترك الجملة نكرة (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آَخَرِينَ) العبرة بما سيأتي (كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ) كأن الحديث على رأي المثل العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة. هؤلاء القرون ماذا أصابهم؟ ما الذي فعلوه؟ (كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ) ماذا فعل الله بهم؟ (فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا) بمعنى توالوا (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) جعلناهم أُحدوثة يتحدث الناس عن إهلاكهم، جعلناهم في خبر كان، (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) أي عذّبناهم، عوض أن يقول دمرناهم وأهلكناهم قال (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) جعلنا الناس يتحدثون عن شؤونهم، فإياكم يا أيها المخاطَبون أن تكذبوا رسولكم الذي بين أيديكم فتصبحوا أحاديث للآخرين. العبرة بالقصة لا بمن هم القوم، إذا ذكر الأقوام فثمة معاني أخرى ودلالات يريدها الله سبحانه وتعالى.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾) هذا في سورة المؤمنون ويقول في سورة أخرى (مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا) ما الفرق بين التعبيرين؟
د. المستغانمي: أساليب النفي كثيرة، الله جلّ جلاله يستعمل ما يتناسب، أساليب الإستثناء كثيرة، أساليب التوكيد، البيان القرآني يختار لما نقول (ما هذا إلا نذير) (إن هذا إلا نذير) كلاهما نفي لكن لا تستوي العبارتان! هنا (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾) (إن هو إلا رجل) هنا النفي جاء بـ(إن النافية) والنحاة يقولون (إن) أقوى وآكد في النفي من (ما) على الرغم من أن العبارة ذاتها تكررت في سورة الجاثية (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾) لكن التوكيد في سورة المؤمنين كثير حيث إنه ذكر كثيرًا من تكذيبهم وذكر كثيرًا من كلام المشركين (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾) انظر إلى البسط، فصّلت الآيات في كفرهم وفصّلت في كلماتهم الكفرية، قالوا (هيهات) وهيهات بمعنى بعُدَ ما توعدون، هم يقولون بما معناه: أبدًا لن يحدث ما يقول الرسول! (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾) ينكرون على الرسول (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾) نرى أن المشركين هنا كانوا أشد بطشًا وأشد تكذيبًا وأكثر جحودًا جاءت (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا) بينما لو ذهبنا إلى مقطع سورة الجاثية التكذيب حاء بآية واحدة (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ) ثم أكمل الحديث، فالنفي بـ(ما) أقل في التوكيد من (إن). لما نقول (إن هذا إلا أساطير الأولين) وهناك آية (ما هذا إلا أساطير الأولين)، اذهب إلى السياق تجد (ما هذا إلا أساطير الأولين) فيه تكذيب لكن التكذيب (إن هذا إلا أساطير الأولين) التكذيب كثير وشديد. قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾) هذه آية واحدة يقول المفسرون أنها وردت في ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما رفض الإيمان. لو جئنا إلى آية أخرى في سورة الأنعام ورد أسلوب مشابه (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) منهم، من عدد من المشركين (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً) أغلفة جمع كِنان (أَنْ يَفْقَهُوهُ) يفقهوا القرآن (وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا) هذا كفر شديد (وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾) لو قالوا (ما هذا) لا تتسق! هنا أنكروا إنكارًا شديدًا بأشد العبارات وردت في السياق فصوّر السياق كفرهم بأشد التصوير. فـ(إن) أقوى في النفي من (ما) فالقارئ الكريم عليه أن يستحضر ذلك.
مثال آخر: في القرآن ورد (وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) وفي آيات (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) (إن أنا) أشد توكيدًا في النفي، (إن أنا إلا نذير) أي ما أنا إلا نذير ولكن قالها الرسول بشدّة لأن السياق يتطلب. (قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ) في سورة الأحقاف وأسلوبها خفيف، تلطّف البيان القرآني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء على لسانه (قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٩﴾ الأحقاف) (وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) أخفّ. نوح عليه السلام في سورة الشعراء (قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾) سياق سورة الشعراء في التكذيب أشد، فوصف تكذيبهم وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم نفى نفيًا قاطعًا، أتى الأسلوب التقريري عن طريق النفي والاستثناء، هذا يسمى أسلوب حصر وقصر فقال (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) بينما محمد صلى الله عليه وسلم في الأحقاف قال (وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) استثناء زائد نفي يسمى حصر وقصر.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا) ما معنى تترا؟ وكيف تكتب في اللغة العربية وكيف كتبت في القرآن؟
د. المستغانمي: في القرآن كتبت بالألف الممدودة ولكن أصلها بالألف المقصورة. الكتابة المصحفية توقيفية كما ذكرنا في أول حلقة ولا أستطيع لا أنا ولا غيري الإجابة.
المقدم: لكن أليس لها سببًا معينًا؟
د. المستغانمي: ممكن، لكن شخصيًا لم أقف على شيء. (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا) يعني أرسلنا رسلنا متواترين متعاقبين كلمة (تترا) أصلها اللغوي (وترا) هكذا يقول الزمخشري ويقول القرطبي وعدد من التفاسير. (تترا) من وَتَر معناها تتابع. فرق بين الوِتر والوَتر: الوِتر بكسر الواو هو الإفراد أو الوَتر بمعنى التتابع. أصلها وَترا بمعنى تترا متتابعين. هذه الآية تريد أن تفيدنا أن كثيرًا من الرسل عليهم السلام تعاقبوا على كثير من الأقوام ولكن الأقوام لجحودهم، لإنكارهم كذّبوا وبالتالي جاءهم الهلاك فإياكم أيها المخاطبون أن يصيبكم ما أصابهم. من الناحية الإعرابية (ثم أرسلنا رسلنا (تترا)) تكون حالًا، حال كونهم متعاقبين وبعضهم أعربها نائب عن المفعول المطلق: ثم أرسلنا رسلنا إرسالًا متواترًا، حذف المفعول المطلق فنابت عنه. ثمّة إعرابان في اللغة العربية.
المقدم: (فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)[المؤمنون:41] وبعدها (فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ)[المؤمنون:44]
د. المستغانمي: ذكرناها بطريقة غير مباشرة، (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ ﴿٣١﴾) وعرّفهم عن طريق كلمة (يصبحنّ) وعن طريق الصيحة، فهم معروفون تقريبًا للقارئ الكريم الذي له عهد بالقرآن فقال (فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) عرّف القوم ووصفهم بالظلم والظلم هنا بمعنى الشرك وبمعنى الظلم بينما القرون أتى بها نكرة (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آَخَرِينَ ﴿٤٢﴾) وتوالت القرون هنا جاءت نكرة فحافظ على نفس البناء فقال (فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) لم يقل للقوم وإنما لقوم، التذييل يتناسب مع صدر الآية دائمًا في القرآن الكريم.
المقدم: من القصص التي ذكرت كثيرًا في القرآن قصة موسى عليه السلام وذكر موسى مفردًا وذكر مع أخيه هارون وهنا وهنا ذُكر مع هارون، (ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾) هناك تفصيل كثير في القصة لكن السؤال ما علاقة قصة موسى وأخيه هارون بمحور السورة؟
د. المستغانمي: أولًا موسى عليه السلام قصته أشبه بقصة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ذكرناه في سورة طه، فهو أكثر الأنبياء شبهًا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقصة موسى هي أكثر القصص دورانًا في القرآن الكريم. هنا قال (ثم أرسلنا) ما قال أنشأنا لأن أنشأنا قالها في البدايات لكن لما جاء إلى عهد موسى وعيسى عليه السلام قال (أرسلنا) وموسى يعتبر متأخرا مقارنة بالأنبياء السابقين، نوح وغيره. مع الأمم المتقدمة قال (أنشأنا) ثم قال (ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآَيَاتِنَا) المعجزات (وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ) البرهان المبين سواء كان في التوراة، أو العصا أو اليد أو غيرها (إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾) التركيز على من هنا؟ ذكر موسى لكن كيف كان قومه؟ (قَوْمًا عَالِينَ) ماذا أصابهم؟ (فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾) المشهد هنا ركّز على بشرية موسى وبشرية هارون عليهما السلام إذن أتى الله بالقصص الذي يخدم محور السورة والرسول بشر يأكل ويشرب (فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا) وكانوا قوما عالين عندهم جلفة وغلظة وفيهم استكبار فالنتيجة التي أحاقت بهم (فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾) لم يقل فأهلكناهم، لم يقل فكذبوهما فأهلناكم وإنما قال (مِنَ الْمُهْلَكِينَ) من المهلكين جعل قوم موسى المكذبين من المهلكين فأنتم أيها المخاطبون احذروا أن تكونوا من المهلكين، لو قال فأهلكناهم فالقارئ يقرأها ويقول: أهلكهم بسبب فعلهم وانتهى لكن لما قال (فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ) معناه أن ثمة مهلكون كثيرون فاحذروا أن تكونوا منهم. ثانيًا: تكبّروا كثيرا واستكبروا، ما كان من قوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ (حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾ المؤمنون) إذن سيقع لكم ما وقع لقوم موسى. إذن أتى لهم بقصص فرعون وقومه ما يخدم قصة محمد صلى الله عليه وسلم وقومه.
المقدم: ثم يأتي الحديث عن الرسل بشكل عام (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾) ثم تحدث مرة ثانية عن الأكل
د. المستغانمي: هذا خلاصة الأكل الذي ذُكر، ذكر الأكل من الفواكه، ذكر الأكل من الأنعام، ذكر شجرة الزيتون صبغ للآكلين ثم قال لهم (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) الأمر للإباحة، الأكل أمرٌ جبليّ لا يُلزمك بالأكل لكن الله قال (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) انظر إلى هذا التقديم كأني بالآية يقول: الأكل الطيب يؤدي إلى العمل الصالح، ألم يقل صلى الله عليه وسلم: أطِب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كلوا من الطيبات المقصود من الحلال، الحلال جاء في المدينة المنورة، هنا من الطيبات بشكل عام. (وَاعْمَلُوا صَالِحًا) الفخر الرازي يقول: الأكل من الطيبات يقود إلى العمل الصالح والأكل من الحرام والعياذ بالله يؤدي إلى غير ذلك. الرسل خاطبهم الله (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) وخاطب المؤمنين
المقدم: كما أن العكس كذلك يستقيم أن العمل الصالح يؤدي إلى الطيبات
د. المستغانمي: لكن المسلم حتى يعمل صالحًا وحتى يعبد الله تعالى لا بد أن يتزود بشيء من الأكل “اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك” عندما تأكل الطعام تقول: يا رب بهذا الطعام أعني على ذكرك، شيء جميل وذكرك والتزامك بقواعد الشرع وأكلك من الحلال يقود بك إلى اختيار الطيبات والحلال.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول هنا (إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)
د. المستغانمي: هذا تهديد مبطن
المقدم: يرد كثيرًا (بما تعملون عليم) و (عليم بما تعملون) لا شك هو نفس المعنى لكن لا يقدمه ولا يؤخره الله سبحانه وتعالى إلا لسبب.
د. المستغانمي: الرسل عليهم السلام خاطبهم الله (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) علم الله، فيه إشارة تلميحية أنه يجب أن يأكلوا من الطيبات ويجب أن يعملوا صالحًا، عندما تقول لأحد إني بما تعمل عليم فاحذر!- احذر بطريقة مبطنة لأن الله تعالى لا يقول للرسل احذروا!- وخاطب المؤمنين بما خاطب المرسلين في سورة البقرة قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾)
هنا قضية تستوقف الكثيرين: مرة ترد: بما تعلمون عليم، عليم بما تعملون، بما تعملون خبير، خبير بما تعملون.
القاعدة: في جميع القرآن إذا قدّم (بما تعملون عليم) فالسياق في العمل، هذا هو السبب وهذا ذكره العلماء، قبلها قال (واعملوا صالحا) في سياق العمل (إني بما تعملون عليم). مثال (وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ) عمل (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)[البقرة:265] الحديث عن العمل. في سورة هود (وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ) لما قال أعمالهم قال (إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) في كل القرآن لما يكون الحديث عن العمل يقدم (بما تعملون) عن صفة الله تعالى.
لما قال سبحانه وتعالى (أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِيالسَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11)سبأ) ان اعمل – بما تعملون بصير.
لو جئنا إلى العمل، بصير عليم خبير هي أسماء من أسماء الله يتم تقديمها، ينطبق على العمل والخبرة مثال: (إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) البقرة) تقديم العمل على الخبرة.
إذا جئنا إلى العلم (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ البقرة) الحديث عن العمل. دائمًا في سياق العمل تقديم (بما تعملون)
في سياق الله والحديث عن أسمائه والحديث عن صفاته جلّ جلاله يقدّم الصفة (بصير بما يعملون) (عليم بما تعملون) مثال: (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّاظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36) يونس) لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الظنّ.
(وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) النمل) حديث عن الله (إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) فهذه قاعدة مطّردة في القرآن حيثما قرأنا في سياق العمل الله يقدم شبه الجملة (بما تعملون) ولما يكون في سياق الحديث عن ذاته العلية يقدّم (خبير بما تعملون) (بصير بما تعملون) (عليكم بما تعملون)
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة المؤمنون – 5
تفريغ الأخت نوال جزاها الله خيرا لموقع إسلاميات حصريًا
إجابة على أسئلة المشاهدين:
الأخت عبير الحلاق سألت مجموعة من الأسئلة وكنا قد أجبنا على أحد أسئلتها في حلقات سابقة، ومن الجيد كذلك أن نعود مرة أخرى إلى بريدها الإلكتروني للإجابة عن سؤال آخر، كانت تقول: في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ}، هل هذا له علاقة بما يحدث هنا في أمريكا؟ هي مقيمة في أمريكا يبدو أنها، حيث أن كثيرًا من المشركين والعياذ بالله سمعنا أنهم قتلوا أبناءهم ومنهم أطفال بدون سبب، يعني هو الأبلغ في اللغة العربية أن تقول: من دون سبب أو المقصود منها معنىً آخر؟
د. المستغانمي: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، في الحقيقة الآية عامة ونزلت في الاعتراض على ما كان يقوم به أهل الجاهلية من وأد البنات وقتلهن، فكما قال جل ثناؤه: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ}.
– لكن هنا قال: {أَوْلَادِهِمْ}.
– الأولاد بشكل عام.
– إي يجوز للولد والبنت.
– والمقصود بها بالدرجة الأولى البنت، لماذا؟ لأنهم كانوا يقتلون البنات مخافة العار ويقولون: إن البنات يجبن الآباء، يعني يجبنهم أي يجعلن الآباء في جبن عن الذهاب إلى المعارك وخوفًا من العار.
– وإن كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق كذلك.
– نعم، لكن هنا الآية عامة كما تفضلت، {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ}، يعني بناء الآية عجيب نوعًا ما نقف عنده. فيها تقديم وتأخير وفيها التزيين كذلك، {كَذَلِكَ} الكاف هنا تعود على هذا التزيين، يومًا ما تكلمنا عندما جئنا إلى تشبيه القرآن بالقرآن، هنا {كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} كذلك التزيين، زين كثير الشركاء قتل الأولاد؛ يعني بلغة بسيطة إذا جئنا إلى أن نشبه هذا عملية القتل، هذه العملية عملية القتل في بشاعتها وفظاعتها فلن نجد مشبَّهًا به أكثرًا منها. {كَذَلِكَ} كذلك القتل، {زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ}
– يعني أشبه هذه الحادثة بذاتها.
– نعم، “والسفاهة كاسمها” هكذا يقول العرب، فشبه قتلهم أولادهم بقتلهم لأولادهم في الفظاعة والشناعة هذا أمر غير جيد، ما الذي يجعل إنسانًا يقتل ابنه خوف الفقر أو يقتل ابنته خوف العار؟ هذا شركاء يعني شياطين الجن والإنس، لذلك الآية تصف ما كان يقدم عليه الجاهليون وتبطل أعمالهم الباطلة.
– الآن هو ينطبق على أمريكا ولا لا ينطبق على أمريكا؟
– ليس شرطًا يعني هذا يعني نحن نقول: الآية فيما نزلت فيه وهؤلاء طبعًا المشركون الكفار يعني يفعلون العجب، وساوسهم وتصرفاتهم تدعوهم إلى أن يفعلوا الكثير
– بل يفعلون أكثر من ذلك أحيانًا.
– نعم، لكن هذا هو معنى الآية والشركاء يزينون لهم قتل أولادهم {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ}، {وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ} يظنون أن هذا يتقربون به إلى الله، وإلى آلهتهم. (ليلبسوا): ليجعلوا دينهم ملتبسًا في أذهانهم، أثمة عقيدة تدعو إنسانًا إلى قتل أحب خلق الله إليه وهو ولده؟ ولذلك ورد في آيات أخرى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ}، {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} حاضر خشية إملاق متوقع أو من إملاق حاضر.
– من هذه من السببية أو من؟
– ولا تقتلوا أولادكم بسبب الإملاق الحاضر {مِنْ إِمْلَاقٍ}، والثانية {خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} متوقع.
– المستقبلي.
– لذلك في {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ} لما يكون الفقر الإنسان يريد يطمئن على نفسه، فقال: {نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}.
– يعني إذا كان الفقر حاضرًا فنحن نرزقكم بداية منكم.
– ثم نرزق أبناءكم.
– ثم نرزقهم.
– أما خشية الإملاق المتوقع.
– وأنتم تستطيعون العيش الآن.
– {نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ}. والآية في سورة الإسراء موجهة للأغنياء بدليل {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}، والمبذر يعني لا يخاطب الفقراء بالتبذير لأن ليس لديهم شيء. فأنا فقط أقول للأخت السائلة: بأن الآية عامة وقد تنطبق على الجميع يعني.
سؤال آخر ورد من الأخ بكار عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، قال: جزاكم الله خيرًا، ما هو الفارق بين أتاك وجاءك في التعبير القرآني بشكل عام ومثال ذلك: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}، و{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا}، بشكل عام ما الفرق بين جاء وأتى؟
– هذه في الحقيقة بحثت فيها وتكلم عنها العلماء الذين تكلموا عن المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، هو أتى وجاء من الأفعال المتقاربة المترادفة، لكن في القرآن
– لكن ليس في القرآن مترادف.
– نعم أقول: متقاربة مترادفة في المعنى، لما يقولوا: أتى أو جاء، لكن في القرآن ثمة أسباب في كل سياق، لا يوجد ترادف بمعنى الترادف.
– لماذا استعمل أتى هنا ولم يستعمل جاء، واستعمل جاء هنا ولم يستعمل أتى؟
– لا بد على المفسر أن يطرح السؤال، من بين الأسئلة الإجابات التي ذكرها المفسرون أن الفعل أتى فيه سهولة، سهولة في النطق وسهولة في المأتى، لذلك الفعل أتى جاء بجميع التصرفات في القرآن أتى، يأتي في المضارع، آتٍ.
-إيتوني.
– إيتوني في الأمر، مأتيًا اسم مفعول بينما جاء لم يأتِ إلا في صيغة الماضي، لم يأتِ منه المضارع يجيء.
– ما جاء يجيء؟
– أبدًا والمصدر المجيء.
– جيء.
– أو جاءٍ.
– جيء.
– جيء في نعم، وجيء بجهنم، نعم.
– وجيء بجهنم.
– في الماضي المبني للمجهول، أما المضارع يجيء أو المجيء أو الإنسان جاءٍ على اسم فاعل، لم تأتِ في القرآن أبدًا إلا الماضي منها، لماذا؟ نظرًا لصعوبة الجيم والألف والهمزة في التلاقي بين هذه الحروف صعوبة، فالملاحظ من قراءة السياق القرآني في عدد من المواضع أن جاء تستعمل في الشدة. {فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ}، جاء فيها شدة، المرسلون من الملائكة جاءوا لينفذوا قضية معينة. لما نقول: إبراهيم الخليل قال لأبيه {يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ} لم يقل أتاني، جاءني فيها ثقة في النفس، {جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي}.
– {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} جاء نصر الله نعم، أتى تستعمل فيما يكون فيه سهولة وأحيانًا تنوب هذه عن هذه لكن السياق يحدد. مثال: أتى، {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} {مَذْكُورًا}، أو {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ}.
– معنى الحديث هنا حول أمر شديد.
– جميل لكنه في أمر الله وفي يده، أتى.
– {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
– {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}، كل ما أتى من قبل الله سبحانه وتعالى.
– للنبي صلى الله عليه وسلم.
– صلى الله عليه وسلم، فيه سهولة، نعطيك مثال أن جاء، جاء تستعمل لما فيه مشقة مثلًا، المثال الذي يوضح {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا} يثبتهم، الرسول وما أدراك ما رسول وأحيانًا يستيئس من إيمان قومه ويكون في حالة نفسية قوية وشديدة.
– بينما هناك قال: فأتياه {فاتياه فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا}.
– جميل جدًا، فأتياه بطريقة ذكية وسهلة، لا، الآية ثمة آية مشابهة للأولى بتقول: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا}، هنا يقول: جاءهم نصرنا، وهنا يقول: أتاهم نصرنا.
– طيب هنا نفس المعنى.
– لا، كذِّب الرسل تكذيب الرسل معهود، كم من الرسل كُذِّبوا؟ كثير معظمهم، لكن {اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ} أي دخلوا في مرحلة الشدة واستيأسوا. استيأسوا بمعنى وصلوا إلى درجة في الشدة.
– مع أن استيأس استفعل يدل على طلب الشيء
– نعم، فيها مبالغة التصوير، مبالغة اليأس الذي كاد أن يصيب قلوبهم، هنا جاءهم نصر يعني نصر الله سبحانه وتعالى يثبت قلوبهم، فمرحلة الشدة جاء فيها جاء، مرحلة العادية إن صح التعبير جاء أتى، هذا ما يقوله العلماء يعني ليس كلامي فقط، يعني ومن أراد مزيدًا يعني فليذهب إلى كل السياق. يتحدث عنه المفسرون في كل سياق يفسر ذلك، بارك الله فيك.
سورة المؤمنون
توقفنا في الحلقة الماضية حول قول الله سبحانه وتعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}. كنت أريد أن نعود قليلًا إلى الوراء، تذكرت أننا في حلقات ماضية تحدثنا حول قول الله تعالى: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً}. في سورة الأنبياء وردت آية مشابهة: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا}، وشرحنا هذا في سورة الأنبياء. لكن من الجيد كذلك أن نعود فنشرح هذا الأمر للإخوة المشاهدين، لماذا قال الله سبحانه وتعالى: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} ولم يقول: آيتان، ومباشرة بعدها قال: {وَآوَيْنَاهُمَا} بالمثنى، بينما هنا قال: {آيَةً} واحدة وليس آيتان؛ هذا شيء، والشيء الثاني كذلك من الملاحظ حينما يقول الله سبحانه وتعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى}، {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ} { إِلَى فِرْعَوْنَ}، {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى}، ثم يقول بعد هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا}، كل الحديث عن الرسل وعن رسالاتهم إلا أنه عن ابن مريم تحدث عن خلقه وعن أمه فبالتالي هذا ربما فيه كذلك وقفة.
– {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً}، أولًا: قصة عيسى ابن مريم وقصة أمه وردت في آية واحدة هذه{وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} أقصد في سورة المؤمنين في آية واحدة. المراد {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} لأن في مولده وفي خلقه معجزة، هو ولدته أمه من دون أب ومن دون زواج. {وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ}، فخلقه الله خلقًا مباشرًا، كن فيكون {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ}، {قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}، أولًا: أتطرق إلى المقارنة الأولى التي تحدثنا عنها، هنا قال: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ} بينما في سورة الأنبياء كما ذكرنا {جَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا} قدم مريم عن ابنها؛ لأن النعمة، أراد في سورة الأنبياء أن يذكر نعمته على مريم ونعمته على عيسى عليه السلام وذكر حصانة مريم وعفتها وطهارتها {نَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا} كرّم مريم وكان السياق يتناسب مع التكريم. هنا الحديث موجه إلى الأنبياء مباشرة، بدليل {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ} الحديث يتحدث مع الأنبياء، والخطاب للأنبياء تحدث عن نوح وتحدث عن {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} إلى أن يقول: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ}، هنا حري بالسياق أن يقدم ابن مريم وليس أمه. هذه رقم واحد، (جعلناهما آية) لأنهما مشتركان في المعجزة فوحّدها، تقول: لماذا لم يقول: آيتين؟ ابن مريم أو عيسى لوحده ليس آية ومريم لوحدها ليس آية وإنما أن يأتيا معًا من دون أب هي الآية. إذًا خلق عيسى في رحم مريم دون أب بنفخ رباني وملكي هو الآية، إذًا اشتركا، ثم قال: {وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ}.
سؤالك الثاني هنا لم يتحدث عن رسالة عيسى، بينما في سورة الصف {إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ}، وفي سورة مريم وفي المائدة أيضًا تحدث عن رسالته، هنا تحدث عن خلقه، لماذا؟ أسلفنا في الحلقة الماضية أو ما قبلها أن القصص، يؤتى من القصص ما يخدم روح السورة وشخصيتها والمراد منها، هنا المراد إبطال الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى والملمح العام هو الحديث عن خصائص المؤمنين، لكن في إثبات التوحيد وإبطال الشرك خلق عيسى من دون أب هو المعجزة، بدليل أنه بعد قليل سنصل {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ}، الآية كما وردت تخدم الآية التي بعدها، كأن الله يريد أن يقرر ما اتخذ الله من ولد، هل اتخذ ولدًا؟ أبدًا، {وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ}، أتى من قصة عيسى ما يثبت هذا المعنى. ولو تكلم عن رسالته شيء آخر، أحد المفسرين يقول، وهو الطاهر ابن عاشور يقول: في مولده وفي خلقه بهذه الطريقة دليل على رسالته دليل على صدق رسالته، ما دلالة صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم، دلالة أو معجزة موسى عليه السلام؟ العصا واليد و و و، دليل على صدق رسالة عيسى؟ مولده معجزته، فذكر مولده وهو يدل على الرسالة أيضًا. لكن أنا أفضل الرأي الأول الذي هو أراد الله أن يفنّد أنه اتخذ ولدًا فأتى بمولده الذي يخدم القرار الإلهي العظيم بعد قليل.
– الله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا} هذه الآية وردت كذلك مررنا عليها في سورة الأنبياء لكن هناك لم يقل {زُبُرًا}، قال: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ}. هنا يقول: {زُبُرًا}، ثم ما الداعي لأن يقول: {زُبُرًا} وهو يوضح يقول: {تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ} اختلفوا أو تفرقوا. فلماذا قال: {زُبُرًا} حال كونهم زبرًا؟
– هذه الآية فيها عدد من اللطائف حتى نوضحها؛ أولًا: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ} لو سألتك أو سألت أي متحدث: (هذه أمتكم) مبتدأ وخبر. (إنّ) مؤكدة، هذه أمتكم، مبتدأ وخبر. ألا يعرفون أن هذه هي أمتهم؟ بلى. النحويون يقولون: والخبر الجزء المتم الفائدة، ابن مالك يقول: والخبر الجزء المتم الفائدة كالله برّ والأيادي شاهدة، الخبر يتم الفائدة نقول: هذا كتابي، أنا أفيدك بأن هذا كتابي، الرسل والمخاطبون يعلمون أن هذه أمتهم.
– ما الفائدة؟
– في الحقيقة في مثل هذا التعبير الفائدة لا تكمن في الخبر إنما تكمن في الحال بعدها {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} حال كونها أمة واحدة، (أمة واحدة) حال عند جميع المفسرين، {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ} إن هذه أمتكم خبر، أمة واحدة حال كونها أمة واحدة.
{هَذِهِ} هو اسم إن، و{أُمَّتُكُمْ} خبر إن. (أمة) حال منصوبة بالفتح لأنه أصلًا لا يأتي الخبر منصوبًا، خبر إن لا يأتي منصوبًا.
– أنا أنبهك إلى هذه النقطة اللطيفة، هنا النحويين يقولون – أنا لا أستند إلى رأيي -: إذا كان المخاطب يعلم الخبر الفائدة تكمن في الحال، كأنه يقول: إن هذه أمتكم حال كونها أمة واحدة، يعني ركزوا، عليكم أن تنتبهوا إلى ما يوحدكم وهو الإيمان والتوحيد.
أعطيك مثالًا آخر حتى يتضح لك المقال وللمشاهد الكريم ، لما جاء الملائكة وبشروا سارة زوج إبراهيم الخليل بشروها بإسحاق. قالت: أألد وأنا عجوز؟ الملائكة تبشر سارة يعلمون أن إبراهيم زوجها أم لا؟ بلى يعلمون، قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي، هذا بعلي ما الإعراب؟ وهذا بعلي شيخًا . أنا أقول لك أدلل على ما أقول، هذا بعلي مبتدأ وخبر هل الفائدة في الخبر؟ هم يعلمون ذلك، هي تقول لهم: وهذا بعلي حال كونه شيخًا كيف تبشروني بالولد حال كون زوجي شيخًا لا يستطيع أن ينجب وأنا عجوز عقيم، فالفائدة تكمن في الحال التي بعد الخبر؛ هذه النكتة، هنا الكلام ذاته. {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} حال كونها أمة هي المهم، لذلك نصبها وأتى بها بعد الخبر، {وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}
– {وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}، في سورة الأنبياء ماذا قال؟ {وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} وذكرنا ذلك من باب الفائدة، سورة الأنبياء بنيت على ملمح العبادة وهنا ملمح التقوى من البداية إلى النهاية، {أَفَلَا تَتَّقُونَ}، نوح قالها عليه السلام، صالح قالها، محمد صلى الله عليه وسلم قالها، مبنية على التقوى إذًا هنا {وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}.
رقم 3 سؤالك وجيه، بمجرد ما قال لهم {فتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} الفاء ماذا تفيد؟ التعقيب يعني فلم يتعقلوا أبدًا. بل سرعة التعقيب {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا} مباشرة، كأنهم يستعجلون على التفرق والتقطع فيما بينهم، تقطع هو مطاوع قطع، المطاوع لما نقول: كسرت القلم فانكسر، فانكسر مطاوع كَسَر. الفعل في اللغة العربية نقول: كسرت فانكسر. هنا قطعوا أمرهم بينهم، أو قطّعوا أمرهم فتقطّع. الأصل قطعوا أمرهم وقطعوه قطعًا بالتضعيف. فتقطع أمرهم، هذا مطاوع قطع، الفائدة هنا ليس في التشديد فقط والمبالغة وإنما يدل على أن بعضهم طاوع بعضًا في التفرّق، هؤلاء قالوا: نتخذ فرقة، والثاني قال: ونحن نتخذ أخرى، وطاوع بعضهم بعضا، فعل المطاوعة مثل فعل المشاركة يدل على المشاركة وعلى التقطع، نقول: فعلت ذلك الشيء فانفعل، هذا فعل المطاوعة، هنا تقطعوا مطاوع قطعوا. إذًا {تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ} بمعنى أمر بعضهم بعضًا وزين بعضهم لبعض حتى تقطّع أمرهم شذر مذر وتفرقوا أيدي سبأ كما يقول المثل العربي، هنا لأن السياق يتحدث عن المشركين وفي ذمّهم سوف تقول: السياق في سورة الأنبياء يتحدث عنهم أيضًا، لكن في سورة الأنبياء تكريم عظيم للأنبياء، قال: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} وهنا قال: {تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا} قطعًا، وأضاف: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} الإضافة هذه لم تأتِ في الأنبياء. هنا قال: {زُبُرًا}: زبرًا لها معنيان اثنان: إما نقول: زبر جمع زَبْرة وهي زبرة الحديد؛ أي تقطعوا أمرهم قطعًا قطعًا قطعًا بمعنى فرقًا، متفرقين وهذا يستقيم مع المعنى و{كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} جزلون مسرورون، أو نقول: {تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا} كتبًا، أصحاب الملل والنحل كلهم يدعي أن له كتابًا، الزبر من زبور، جمع زبور، ويقال: الزبور سمي زبورا لأنه جمع من مفرّق، أنا أعطيتك المعنيين، إما بمعنى زبَر الحديد وإما بمعنى زُبُرًا بمعنى كتبًا، فالمعنى هنا استعارة تهكمية بلاغية، كأن الله تعالى يقول: فتقطعوا أمرهم بينهم مللًا ونحلًا كل أمة تدّعي أن لديها كتابًا، فهذه استعارة تهكمية، وهل المجوس لديهم كتاب؟! وهل اليزيديين وأيًا كان لأن هؤلاء الذين ليس لهم كتب صحيحة، وإن كانت لهم فأتونا بها، فكأن القرآن يقول: تقطعوا أمرهم بينهم كتبًا ادّعوا وانتسبوا إلى بعض الأنبياء والأنبياء منهم برآء، واضح؟ هذا هو المعنى.
– هناك إشارة كذلك يعني بلاغية في الموضوع {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} وهنا يقابلها {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ} هذه مقابلة رائعة بين توحيد الأمة وبين تفرّقها شذر مذر.
– يقول الله سبحانه وتعالى: {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ}، ما علاقة هذه الآية التي ختم الله بها ما قبلها من حديث، ما علاقتها بما قبلها من حديث.
– نعم، هي شديدة الصلة، ألم يتحدث عن الفرق والملل والنحل {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ}؟ وكان المشركون إحدى الفرق.{فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ} بما أنهم اختاروا لأنفسهم. الغمرة هي أن يغمر الماء قامة الإنسان، الغمرة من الماء المغمور.
– يعني فذرهم في انهماكتهم وفي غرقهم وفي انغماسهم. الغمرة معناها اللغوي الدقيق هو أن يغمر الماء إنسان حسب قامته، فنقول: هو في غمرة في غمرات. ولذلك استعملت أيضًا في سكرات الموت والعياذ بالله، اللهم ينجينا إن شاء الله. {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ}، {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ} هنا في غمرة الشرك وغمرة الإلحاد وغمرة الجهل واللهو والإعراض وغمرة عدم الإيمان باليوم الآخر،،، إلى غير ذلك، {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ} الخطاب الآن توجه مباشرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم متحدثًا عن المشركين.
{ذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ} إلى أجل غير محدد، محدد لكن (حين) زمن مُبهم.
ثم يقول: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ} هاتان الآيتان يراد التوقف عندهما، ما العلاقة بين الآيتين؟ هو في الحقيقة في أول الحلقة ذكرنا: فذرهم في غمرتهم حتى حين، جيد ما هي الغمرة؟ غمرة الجهل كما قلنا غمرة الشرك، غمرة عدم التصديق باليوم الآخر، غمرة عدم الإيمان بالآيات، سوف تقول لي: من أين لك هذه المعلومات؟ من المقطع الذي أتى بعدها {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} فهم في غمرة عدم الخوف من الله، {وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ} فهم في غمرة عدم الإيمان بآيات الله. {وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ} هم في غمرة الشرك. وغمرة أخرى وهي أن لديهم أموالًا كانوا مترفين، قريش صناديدها كانوا يعيشون في ترف وكانوا تُجبى إليهم ثمرات كل شيء، وجعلهم الله في حرم آمن، هذا الترف جعلهم يعيشون في غمرة ويظنون أن الله يسارع لهم في الخيرات، الحقيقة غلط تقييمهم ليس دقيقًا، لذلك قال تعالى: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ} ونعطيهم {مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ} أبدًا {بَلْ لَا يَشْعُرُونَ}، (أنما): (ما) هذه موصولة يعني أن الذي نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم به بالخيرات بل لا يشعرون أبدًا، ما معنى لا يشعرون؟ لا يشعرون بمدى الاستدراج الذي وقعوا فيه، الله استدرجهم أعطاهم {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ}، بل لا يشعرون الغمرة التي هم فيها ولا يشعرون الاستدراج الذي وقعوا فيه، إذا رأيت كافرًا وأن الله تبارك وتعالى أعطاه من المال وهو في غمرات كفره ليس معنى ذلك أن الله يحبه، الله يعطي الدنيا لمن شاء للجميع، كل من يجتهد واضح؟ فهنا قال: أيحسبون أنما نسارع لهم في الخيرات؟ أبدًا، بل لا يشعرون، (بل) إبطال لما قبلها، إضراب إبطالي لما قبلها، بل انعدم عندهم الشعور فهم لا يميزون، وكما ترى المتعلق محذوف.
هذه تذكرني في آية أخرى في القرآن في قوله تعالى: {وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ}، الإملاء، في ذات المعنى هنا قال: {نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ}.
– ثم بعدها بآيات قليلة قال: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} هذا في وصف المؤمنين. بينما هنا في وصف المشركين قال: {نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ}، ثم يُعرض فيتحدث أو يفتح موضوعًا جديدًا {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ}، هنا لماذا جاء بفعل الإسراع هنا وهنا؟ وإن كان هناك اختلاف. اختلاف في إسناد الفعل لأي ضمير؟ لفاعله. هنا قال: نسارع نحن. لما تحدث عن المشركين الذين مكنهم والذين أمدهم بمال وبنين، قال: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا} نسارع نحن {نُسَارِعُ لَهُمْ}، وهذا ظن خطأ وفهم خطأ، بينما عندما تحدث عن المؤمنين وذكر إيمانهم وخشيتهم وتوحيدهم، وهم يعملون هم يسارعون لست أنا الذي أسارع لهم أنا أوفقهم جل جلاله يقول: أوفقهم، لكن هم يسارعون، أسند الفعل إليهم {وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} يسابقون إلى الخيرات.
– لماذا قال: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ} بالمضارع، ثم قال: {وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ}؟
– هذا الآن أمر آخر، يسارعون يفيد التجدد الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، فهم يسارعون ولا يتوقفون، والمسلم لا يتوقف عن العبادة وعن المسارعة إلى أن يتوفاه الله، {وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} أراد الله مدحهم والثناء عليهم بالجملة الاسمية وهم سابقون لها، وهم سابقون إليها، وهنا سأشير لك فيما بعد إن شاء الله {لَهَا سَابِقُونَ} يعني ورد كثير من اللام التي تفيد التقوية، اللام تفيد التقوية {لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} لما يقول: في سورة المؤمنين وردت لام التقوية بطريقة {هُمْ لَهَا عَامِلُونَ}، لها عاملون أنت لو قلبنا وقلنا: عملت هذا العمل، ما تقول: عملت لهذا العمل. فلما فرّع عن فعل العمل اسم الفاعل فأتى باللام التي تفيد الجر وهي تقوي العامل الفرعي؛ لأنا لما نقول: اسم الفاعل، اسم الفاعل فرعًا الفعل، لما اسم الفاعل فرع عن الفعل جاء باللام تسمى لام التقوية وهي ظاهرة بارزة في سورة المؤمنون {لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ}، الزكاة نقول: مؤتون الزكاة ولا مؤتون للزكاة؟ آتوا الزكاة يعني فعل أتى، الفعل أتى يتعدى بذاته والفعل فعل الخير يتعدى بذاته، لما قال: {لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} قلب السياق وأتى بلام التقوية، هنا الأمر ذاته {هُمْ لَهَا عَامِلُونَ} أصلها هم عاملون لها أو هم يعملونها لما أتى باسم الفاعل أتى بلام التقوية، أقول لك شيئًا آخر: {وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} لو أتينا بالفعل نقول: أكثرهم يكرهون الحق أو يكرهون للحق؟ يكرهون الحق. لما عكس أتى بلام التقوية، {لِلْحَقِّ كَارِهُونَ}، هذه يعني تقنية لغوية رائعة ووظفها القرآن بطريقة يعني دعني أقول: حكيمة في سورة المؤمنون.
– وهنا استعملها {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} وهم يسبقون إليها لكن أتى بلام التقوية للتناسق اللغوي بين الآيات السابقة.
– بعد ذلك الله سبحانه يقول: {وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} ما دلالة هذه الآية عما سبقها، الحديث عن المؤمنين في شق والحديث عن الكافرين في شق آخر؟ .
– هذه الآية هي ناطقة بمعناها، ربطها حتى {وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} كأن هذه الآية تقول: عندما كلّف الله المؤمنين بأن يخشوا من الله تعالى وبأن يؤمنوا بآياته وبأن يسارعوا إلى الزكوات أنواع الزكوات، ونحن لم نشر إلى {يُؤْتُونَ مَا آتَوْا}، ما معنى ما آتوا؟ أيًا كان الذي أتوه، لم يقل: يؤتون الزكاة، لا، يؤتون كل الذي أعطوه: زكاة صدقة، زكاة مال، علم، كل أنواع، عمل صالح، إذًا {مَا آتَوْا} تفيد العموم، الله في فرضه لهذه الأشياء والمؤمنون في فعلهم لهذه الأشياء لم يكلفهم الله فوق طاقتهم، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسعها}.
– هنا أفهم من هذه الآية ومن حديثك فضيلة الشيخ الدكتور {لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} يعني للمؤمنين لم نكلفهم أكثر من طاقتهم ولكنهم سارعوا للخيرات وعملوا أكثر مما يعني هو مطلوب منهم من الفريضة ولكن المشركين كذلك لم نكلفهم فوق طاقتهم لكنهم انحدروا في الشرك والضلال والكفر فمعنى ذلك لدينا فريق أقل، جاء بأقل مما طلب منه وفريق بأكثر مما وجب عليه، وفي النهاية المؤمنون يتفاوتون درجات والجنات درجات الأنبياء فالصديقون فالشهداء،،، إلى غير ذلك، فالكل يجتهد ليسارع في الخيرات وفي النهاية لم يكّلف الله نفسًا إلا وسعها ولدينا كتاب، انظر إلى التكملة {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} أيّ كتاب هذا؟ كتاب الذي تكتب فيه الأعمال، لكن كلمة الكتاب في القرآن تعني القرآن وتعني اللوح المحفوظ في كتاب محفوظ وكتاب الأجل، هنا كتاب الأعمال، الدليل: {وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ} ما معنى ينطق بالحق؟ يعني يدل على أعمالهم، {وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} فيما قدّموا من أعمال، كل ما قدّمه الإنسان يجده أمامه، الدليل من سورة الدخان على ما أظن {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} كتاب الأعمال، لما نقرأ {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ} ليس ننسخ، نستنسخ يعني قوة الكتابة، شيء لا يضيع من العمل مثقال ذرة.
– حتى هنا أريد أن أسأل دكتور {وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} ينوع القرآن كثيرًا في هذا الأمر يقول: {لَا يُظْلَمُونَ}، {لَا يُبْخَسُونَ}، ما الفرق بين البخس والظلم؟
– هنا {لَا يُظْلَمُونَ} بمعنى لا ينقص من أعمالهم، ذكرنا في سورة الكهف لم تنقص منه شيئًا الجنة {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا} ما معنى لم تظلم؟ ولم تنقص، نفس المعنى. {وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} ولا ينقصون. معناها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا ينقصون لا ينقص من أعمالهم مثقال ذرة.
– سؤالك الثاني وجيه، مرات يقول: {وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ} بمعنى لا يظلمون ولا ينقص من أعمالهم ومن أجورهم، لماذا وردت يبخسون في سورة هود؟ لأن في سورة هود نجد حديثًا بين شعيب وبين قومه يا قوم، قال لهم أوفوا المكيال والميزان، الكلام عن البخس (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، شعيب يتكلم يا قوم أوفوا المكيال، ما معنى أوفوا المكيال؟ وفّوا وأعطوا الناس حقهم، أتموا، اعدلوا وأوفوا المكيال حقه، ولا تبخسوا الناس ماذا؟ ولا تنقصوا، إذًا الإيفاء والبخس في الميزان، من باب التشاكل والتناظر والتناسق قال: {وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ}، لما تحدث {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ}، إذًا قال: نوفّ، ما قال: نؤتهم، من باب الوفاء لأن قصة شعيب قريبة وألفاظها تدل على العدل والوفاء وعدم البخس، قال: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ}، هذا قاموس في القرآن. تقول لي: لماذا؟ التناسق مرعيّ والتجاذب مرعيّ، نفس الكلام لو ذهبنا إلى سورة الشورى، قال: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا}، {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا} ما قال نوفّه، قاموس آخر.
– يعود مرة أخرى ويقول: {بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ}، والآن قبل قليل قبل عدة آيات قال: فذرهم في غمرة، {فِي غَمْرَتِهِمْ} ثم يقول: {بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ}.
– في الحقيقة هذا كلام عظيم، القرآن مرتب بطريقة، {بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ} معطوفة على ما سبق، يعني كأن هنا (بل) هذه جاءت للإعراض يعني كأنه يقولك فذرهم في غمرتهم بل قلوبهم في غمرة. هذا هو التركيب، والجملة الاعتراضية الكبيرة {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} جاءت لوصف أعمال المؤمنين لتدل على أضدادها، أعمال المشركين هي ضد أعمال المؤمنين، سوف تقول لي: لماذا؟ اقرأ الآية التي بعدها {بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ} {لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ} من دون أعمال المؤمنين، دونها وبعضهم قال: ضدها، أعمالهم ضد ما تم وصفه. أراد الله جل ثناؤه في هذا المجال أن يأتي بأوصاف المؤمنين ليستدل بها على أوصاف المشركين وأعمالهم. وروعة في التعبير وجاءت هذه الجملة الطويلة {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} وإن وإن كذا، معترضة بين بل {ذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ} {بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ}،
– هنا كذلك استعمل اللام {هُمْ لَهَا عَامِلُونَ}، هذه اللام لتقوية العامل الفرعي الذي هو اسم الفاعل.
– هنا طبعًا يقول: {حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ}، هل العذاب فقط على مترفيهم؟ ولماذا ذكر بالتحديد المترفين {حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ}، ما قال: حتى إذا أخذناهم جميعًا، هم كلهم مشركون؟
– أولًا: عندما العذاب السماوي عندما يصيب يصيب الجميع، العذاب إما أرضي في الدنيا وإما أن يأتي العذاب السماوي من الله.
– معنى ذلك أنك ما قلت: العذاب السماوي، إلا أنك تقصد أن هناك عذابًا أرضيًا كذلك؟
– نعم، العذاب الأرضي كما يقول المفسرون: هو عذاب يوم بدر، عذاب يوم بدر يوم سلط الله المؤمنين على صناديد المشركين وقتل كثير من صناديدهم، وهنا ذاقوا العذاب الحقيقي، وبعضهم يقولون {أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ} أي نوع من العذاب؟ لم يوضح، قد يكون – هذا كلام المفسرين ونحن نحترم كلام المفسرين – قد يكون عذاب يوم بدر حيث قتل من صناديدهم العديد، وقد يكون عذاب الجوع عندما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جعلها سنين كسنيّ يوسف عليه السلام، حتى إن يقولون: إن أبا سفيان قبل إيمانه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا محمد، ألم تقل بأنك بُعثت رحمة للعالمين؟ الحديث يعني القصة واردة، فقال: بلى، قال: أهلكت الآباء بالسيوف والأبناء بالجوع. هذه واردة في كلام أبي سفيان: أهلكت أو قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، عندما دعا عليهم، فالآية تحتمل لكن ليست عذابًا سماويًا. {حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ} لماذا تحديد المترفين؟ هو في الحقيقة العذاب جاء على الجميع لكن المترفين كانوا سببًا، العوام دائمًا يتبعون المترفين، والمترفون في كل بلد – إلا من رحم ربك – هم الذين يسوقون رعاء الناس وعامة الناس هم من يتسببوا بهلاك الأمم، هم الذين يمنعهم مالهم وصولجانهم يقول الله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا} وفي قراءة {أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} أمرناهم بالخير فكفروا {فَفَسَقُوا} هذه الفاء تسمى الفصيحة تعطف على فعل محذوف {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا} يعني أمرهم ليفسقوا؟ لا، أنهم جاءوا بجواب أمر، أو استجابوا لأمر الله، لا، هذا المعنى غير مقصود، المقصود إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالإيمان والعمل الصالح فكفروا وفسقوا، فهنا الفاء تسمى الفصيحة تعطف على فعل محذوف ضرورة في القرآن. ومثلها {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} فضرب فانفجرت، وإلا كيف يستقيم؟! يعني هو قال، ما ضرب بعد، هذه تسمى الفاء الفصيحة تعطف على شيء محذوف. لكن الذي كنت أريد أن أشير إليه أنه المترفين هم من يتسببون بالعذاب والدليل على ذلك الآية التي ذكرناها في سورة الإسراء التي ذكرناها، وبعضهم قال: أمّرنا مترفيها في قراءة أخرى، فما بالك إذا كان المترفون أمراء ولا يخافون الله سبحانه وتعالى؟! هذا بلاء كبير! وأيضًا أخذنا مترفيها تنظر إلى الآية التي ذكرناها قبل {قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ}، ألم يذكر قومًا من الأقوام؟ كفروا وكذبوا وأترفناهم، هنا التناسق والتجاذب يقول: {حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ} والعذاب عندما يأتي يعمّ الجميع ولكن هؤلاء كانوا السبب.
– {حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ} {يَجْأَرُونَ} يعني يتضرعون ويرفعون أصواتهم بالصراخ: يا رب يا رب يا رب، ولكن لا ينفعهم ذلك لأنهم لو تركهم ولو رحمهم لعادوا لما نهوا عنه، {إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} هذه آية عجيبة وقفت عليها ، في آية أخرى نفس المعنى {وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ} المعنى ذاته هنا، {إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} فستأتي الآية على ذات المنوال.
– هنا حتى يقول: {لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي} هو طبعًا يفسر لماذا جاءهم هذا العذاب، {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ} تعليل {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ} نريد أن نقف عند هذه الآية، يعني أنا شخصيًا قد يعني لا أفهمها في هذا السياق ممكن نشرحها؟
– هو أولًا: {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ} هذا تعليل لما سبق، لماذا هم يجأرون وكذا ولا يستجيب الله تبارك وتعالى لهم؟ {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ} المؤمنون كانوا بآياتنا يؤمنون أنتم كنتم بها تكذبون، هنا على أعقابكم كنتم ترتدون على أعقابكم، الأعقاب جمع عَقِب وهو مؤخرة القدم، لو قال: كنتم على أعقابكم، {تَنْكِصُونَ} ما معنى تنكصون أي ترتدون إلى الوراء.
نكتة بلاغية رائعة، لو قال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم تنكصون عنها، كلام صحيح، ترتدون عنها، على أعقابكم، هذا يسمى ترشيح للتمثيل، عندنا استعارة مرشحة، ما معنى ترشيح؟ يعني هو تمثيل شبّه ارتدادهم بنكوصهم إلى الوراء ولزيادة الترشيح أضاف الأعقاب، صورة عجيبة جدًا. في البلاغة عندنا إذا أتينا في الكلام بكلام يتناسب مع المشبه به ترشيح، وإذا أتينا بكلام يتناسب مع المشبه تجريد، وسنقف عنده بعد ذلك، هنا رائع، ثم يقول بعدها {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ} الحديث موجه للمشركين، أين كان يعيش المشركون؟ في مكة، الخطاب في مكة والسورة مكية {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ} فيها معنيان اثنان وكل ما أقوله ذكره أبو حيان في البحر وذكره الرازي وذكره الزمخشري إلى غير ذلك. مستكبرين بالحرم مستكبرين بالمسجد الحرام، وكان الأوْلى أن تتواضعوا وأن تطامنوا من كبريائكم، عوض أن يتواضعوا في هذا البلد الحرام العظيم هم يستكبرون بها، هذه رقم واحد. مستكبرين مستهزئين به؛ بالقرآن، ثمة معنيان وكلاهما مرعي والتوسع الدلالي موجود في القرآن، {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِين} مستهزئين بالقرآن، هذا المعنى رقم واحد الذي هو تضمين، ضمن الفعل استكبر الاستهزاء والسخرية. مستكبرين مستهزئين بالقرآن، وهذا كان ديدنهم لأن الحديث هنا عن الآيات {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ} وهو القرآن فكنتم بها. والمعنى الثاني أيضًا جميل، مستكبرين بالمسجد مستكبرين {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ} ما معنى سامرًا؟ السامر هو جمع، السامر من السمر والسمر هو أن يتحدث الناس فيما بينهم على ضوء القمر أو في ظلمة الليل، نقول: يتسامرون فالمشركون أين كانوا يتسامرون؟ حول الكعبة هذا ديدنهم، التاريخ يقول ذلك، كانوا يجتمعون حول فناء الكعبة ويذكرون، قديمًا كانوا يذكرون آباءهم وأجدادهم وأشعارهم، لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كان حديثهم فقط لتفنيد – أستغفر الله – وإبطال الإسلام، سامرًا بالليل تهجرون تأتون بالهجر، وفي قراءة نافع (تُهجِرون) تأتون بالهجر من الكلام والفحش، يتحدثون فقط لتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجعلنا يعني أيضًا نرجح المعنى الثاني.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة المؤمنون – 6
تفريغ الأخت نوال جزاها الله خيرا لموقع إسلاميات حصريًا
إجابة على أسئلة المشاهدين:
الدكتور حمود من موريتانيا يقول الله تعالى: {مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ} من المخاطب في هذه الآية؟
د. المستغانمي: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، طبعًا حتى يتضح المقال ومن هو المخاطَب أذكر شيئًا، أولًا آية من سورة آل عمران {مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ}، وأنت تعلم والمشاهد الكريم يعلم أن كثيرًا، جزءًا كثيرًا حوالي ثمانين آية من سورة آل عمران نزلت تعقيبًا على غزوة أحد من قوله تبارك وتعالى: {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، عندما انتهت معركة أحد في الميدان بدأها الله في القرآن تعقيبًا وتعليمًا، وهذا أحد دروسها، الخطاب باختصار هو للمؤمنين للمسلمين، وإن كان في السورة حديث عن غزوة بدر كذلك لكن بالدرجة الأولى هي تعقيب عن غزوة أحد وضرب مثل في غزوة بدر، حوالي ثمانين آية.لماذا؟ غزوة بدر تحدث عنها في الأنفال وتحدث عنها في مقتطفات بسيطة هنا، لكن غزوة أحد وقع المسلمون والمؤمنون فيها في شدة ومحنة، ودائمًا المحنة يستفيد منها المسلمون دروسًا. فيها دروس كثيرة، وبعضهم قيل: قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم نكص على عقبيه لم يستمع إلى نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السيرة النبوية، هنا جاءت دروس متوالية قالت، {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ}، وجاءت تعالج. من بين النقاط التي عالجتها أن غزوة أحد فصلت بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين، أول الهجرة إلى المدينة كان المؤمنون موجودين في المدينة وكان ثمّة منافقون. ولكن القرآن لم يتحدث عنهم، لماذا؟ لأن المسلمين كانوا في ضعف وكانوا في بداية {آزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى} يعني عُشب الإسلام كان ينمو، لمّا يستغلظ بعد. لما جاءت غزوة بدر قويَ عود المسلمين فرِح من فرح وكتم المنافقون غيظهم، أتكلم عن النفاق العقائدي،النفاق العقائدي يعني يضمر الكفر ويظهر الإسلام وليس النفاق العملي، العملي يعني واحد ممكن وعدك أخلف، هذا لا نقول عنه منافق نقول فيه خصلة من النفاق ، أما الذي يدخل المسجد وهو كافر بالله ويكره القرآن والدين والعياذ بالله، هذا نفاق عقائدي، يُضمر الشرك ويُظهر الإسلام، فهؤلاء مردوا على النفاق. لما قوي المسلمون سكتوا، لما جاءت غزوة أحد أصاب المسلمين ما أصابهم من قرح ومن شدة، هنا أظهروا فرحهم. هنا قال: والله تستحقون هذه الهزيمة!! جاء قوله تعالى: {مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ}، حتى يميز المؤمنين الصادقين ويذهب عنهم خَبَث المشركين المنافقين غير المؤمنين، فحتى يميز، هو تحير السائل الكريم جزاه الله خيرا الخطاب لمن؟ الخطاب للمسلمين لكن فيها نكتة رائعة أقولها: {مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ}، لم يقل: ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه، لا، قال: {لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ}، أنتم فيها الكثير فيها مؤمنون ومنافقون، قال: ما كان الله ليترك المؤمنين غير مميَزين مع فئة مشركة المنافقين، مع ما أنتم عليه بمن فيكم من المنافقين فـ{أَنْتُمْ} لا تنطبق فقط على المؤمنين، تنطبق على المجموع، هذه النقطة في المجيء بالمؤمنين وأنتم. إذًا {مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ} حتى يميز هؤلاء من هؤلاء، وجاءت غزوة أحد وميّزت الصادقين من غير الصادقين، والله أعلم.
سورة المؤمنون
– يفصل الله سبحانه وتعالى يقول: {أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ} {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ}، ثم يقول: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}. تكرر هذا الاستفهام بـ(أم) كثيرًا نقف عنده.
– {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ}، أولًا: أشير إلى شيء {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ} ما المقصود بالقول هنا؟ القرآن، والدليل {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ} قبلها بآية. {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ} هو القرآن الكريم. لكن سؤال: هنا عبّر عن القرآن بالقول، وفي سورة النساء {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ}، أنا أريد أن أعطيك نكتة جيدة بإذن الله، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}. هنا أولًا: الملاحظ أن سورة المؤمنين لم يأتِ فيها ذكر القرآن أبدًا، ورد باسم القول وورد باسم الذكر على ما ذكرنا في سورة الأنبياء، هذا ديدن القرآن. والآيات {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي} لكن لفظ القرآن ورد في سورة الإسراء إحدى عشرة مرة. إذًا هذا شيء مقصود، هنا ذكره بلفظ القول، القول هو جزء من القرآن قد يعني القرآن كاملًا وقد يعني جزءًا، لما نقول: قلت قولًا، أما القرآن هو الشامل. لماذا قال: القول، هنا؟ القول هو جزء من القرآن، آية هي قول من القرآن. لما ذكر (القول) أتى بالفعل مجزومًا {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ} أولًا أتى بالفعل مجزومًا، {أَفَلَمْ} وعلامة جزمه حذف حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة. {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا} (لم) جازمة، (يدبروا) فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، لما أتى بالقول الذي هو جزء من القرآن أتى بالفعل ناقصًا مجزومًا وأتى بالفعل مدغمًا {يَدَّبَّرُوا}، لما أتى بالقرآن وافيًا أتى بالفعل كاملًا. {يَدَّبَّرُوا}، لم يقل: أفلم يتدبروا، أتاه في سورة النساء بالصيغة الكاملة {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ} (لا) لا تجزم، (يتدبرون) الصيغة الكاملة والقرآن كاملًا، أنا أعطيك بعض التناسق الجميل. (يتدبرون) أتى الفعل كاملًا بالتاء والنون للقرآن كاملًا، لما أتى بجزء من القرآن وهو القول اختصر الفعل. كله مقصود، القرآن لا يوجد فيه شيء جاء هكذا. كان بإمكان الله سبحانه وتعالى – وجل جلاله – أن يقول كما قال في آيات أخرى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} لكن لا وجود للقرآن من البداية إلى النهاية في سورة المؤمنون {بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُون} هنا لم يأتِ بالقرآن، هذه السورة بنيت على ذكر المؤمنين وذكر الآيات التي يؤمنون بها وعبّر عن القرآن بالقول وبالذكر وبالآيات، لم يعبّر عنه صراحة وبما أنه عبّر عن القرآن بالقول اختصر الفعل بحذف حرف النون وبإدغام التاء في الدال، وهذا من شدة التناسب بين الكلمات المستعملة في القرآن.
سؤالك الآن نعود إليه، {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ} يتحدث عن من؟ عن المشركين، ألم يدبروا هذا القول الذي يسمعونه وهم فصحاء بلغاء لا ينقصهم ويعرفون جماليات اللغة العربية؟! {أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ} (أم) هذه تسمى أم المنقطعة، في الحقيقة تكررت هنا: {أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ}، {أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ} {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ} (أم) هذه عوض عن (بل) + حرف الاستفهام همزة، أعيد القراءة: أفلم يدبروا القول بل أجاءهم ما لم يأتِ آباءهم؟ بل أم لم يعرفوا رسولهم، بل أيقولون به جنة، أم هذه المنقطعة تفيد بل الإضرابية والإبطالية + همزة الاستفهام. فهي جميلة جدًا هنا ومستعملة بطريقة كما نقول: حكيمة جدًا. وهنا القرآن يوجه لهم الحديث، هل إعراضهم عن هذا الذكر وعن هذا القول وعن الإسلام لأنهم لم يدّبروا؟ هذه رقم واحد، {أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ}، فلينظروا إلى آبائهم من آتاهم من الرسل؟ {أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ} والله هم يعرفون صدقه ونسبه وقالوا: الصادق الأمين، {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ}؟! كل هذه الاستفهامات موجهة إليهم يحركهم وهي كلها ليست صحيحة، يعني الجواب معروف لديهم، يقررهم، يعني هذا استفهام تقريري، يقررهم، المفترض يقولوا: لا، جاءنا، لأنهم لم يدبروا، يعني القصة أن التكذيب جاء من قِبَلهم. ليس الغرض من الاستفهام المعرفة أو معرفة الإجابة، فالإجابة معروفة لديهم. فهو ينكر عليهم ويقررهم بأن الرسول يعرفونه وبأن هذا الرسول ليس به جنّة وبأن آباءهم جاءهم من الرسل وهم جاءهم رسول كريم.
– هنا كذلك قول الله سبحانه وتعالى: {أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ} {لِلْحَقِّ كَارِهُونَ}، {عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} هذه كلها فيها تقديم وتأخير، هنا يقول: {لَهُ مُنْكِرُونَ} أصل الكلام في غير القرآن منكرون له وكارهون للحق، معرضون عن ذكره، لكن هذا التقديم في اللغة العربية لما نقدّم له عدة أغراض: أحيانًا للتخصيص والحصر، نقول: إياك نعبد لا نعبد غيرك أبدًا، هذا نقول: للتخصيص والحصر، هنا لا نقول للحصر، هم هنا الله تبارك وتعالى قدّم هذه المتعلقات للتعجيب من أمرهم فهم للحق كارهون، للحق، المفترض لا يكرهون الحق، العاقل لا يكره الحق! بعد ذلك يقول: {بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} يا للعجب! عن ذكرهم عن شيء يرفع من شأنهم يعرضون! للتعجيب من أمرهم قدّم لهم هذا، ألم يقل جل جلاله في سورة الأنبياء: {لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ}، كان الأولى أن يتلقفوا هذا الكتاب بالترحاب، فيه ذكركم، فيه عزّكم وفيه شرفكم، هنا يقول: {فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} ألا تتعجبوا معي؟! يعني التقديم يفيد التعجيب من سلوكهم.
– يقول الله سبحانه وتعالى: {أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا} هم {رَسُولَهُمْ}، {أَمْ يَقُولُونَ} هم {بِهِ جِنَّةٌ} ثم يقول: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ} أنت، الحديث موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم {أَمْ تَسْأَلُهُمْ} أنت، لماذا أعرض عن الحديث إليهم للحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
– هو في الحقيقة في البداية ذكر أربع متمسكات، يعني إن صح التعبير هل لم يدبروا القول من جهتهم؟ يعني ذكر أربع أسباب من جهتهم، ما الذي منعكم عن أن تسلموا؟ ألأنكم لم تتدبروا القول؟ أم لأنكم جاءكم ما لم يأتِ آباءكم؟ أم أنكم لم تعرفوا رسولكم؟ كل هذا من قِبَلهم، أم تقولون به جنة؟ هذه الأسباب من قِبَلهم كلها خطأ وليس ذلك صوابًا. ثم توجه الحديث إلى محمد، أم أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم طلبت منهم أجرًا؟ طلبت منهم جُعلًا كي يؤمنوا؟ هل تم ذلك منك؟ كأن القرآن يوجه له الحديث: هل صدر منك يا محمد –والله جل جلاله يعلم – فقط يقول، هل صدر منك ما يمنعهم عن الإسلام وعن الإيمان، وطلبت منهم جعلًا وخرجًا؟ نحن قلنا: خرجًا بمعنى جُعلًا، مقابلًا عِوَضًا جُعْلًا أجرًا، كما ورد في آيات أخرى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ} وهنا قال: {خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ}، ستقول: لماذا هنا خرجًا وهنا أجرًا؟ هنا أراد القرآن أن يتم قال: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا} جُعْلًا عِوَضًا، {فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْر}، هل تسألهم أجرًا قليلًا، خرجًا واحدًا بينما الخراج {فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} ما يعوضك الله خير. اسم جنس هنا، والخرج في اللغة العربية هو المقابل، العِوَض، على هل تسألهم خرجًا عوضًا عما تريد؟ الخراج هو ما يستمر؛ الخراج على الأراضين. خراج الزروع. يقولون: خراج الأرض، حتى إن الإمام أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما، له كتاب “الخراج”، الخراج يعني ما تخرج الأرض، الخراج مرة أم يستمر؟ يستمر، فكأن القرآن يقول: أم تسألهم خرجًا مرة واحدة؟ فاستمرار الخراج من ربك خير وفي الاثنين عطاء ربك أكثر، بالعكس زاده توكيدًا {وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}، الله أكبر على هذا الكلام!!. {فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}، لم يقل له: أم تسألهم أجرًا؟ لأن لا يوجد كلمة أخرى. {فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ}، ما قال: أخير، خير هو اسم تفضيل لما نقول: فلان خير من فلان كأنه قال: أخير، ولكن العرب تختصر في خير وشر. وردت هذه اللفظة في سورة الكهف كذلك: {نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} وفي قراءة سُدًا.
{وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} هذا التذييل لتأكيد الجملة السابقة، والتذييل في اللغة العربية يؤتى به لتأكيد ما سبق، {وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}.
– حينما الله سبحانه وتعالى تحدث في القرآن وقال: {وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ}، هنا من هؤلاء الذين يتحدث عنهم الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين؟ {وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ}، هل القومان هنا مختلفان؟
-لا، هما ليسوا مختلفين لكن المقصد من هذا السؤال يعني الآية الكريمة {وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ} بالعكس هم يظنون أنك تدعوهم إلى الشر وهذا غلط، إنك تدعوهم إلى صراط مستقيم، يعني هذا ثناء بعد ما تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الرسالة الآن {إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلَى} اللام للتوكيد {إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ} للتوكيد {إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} يثني على الإسلام فهو صراط الله المستقيم. إنك تدعوهم تحدث عن المشركين بالضمير (هم) ثم قال: {وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ} هذا عدول، عدول عن (هم)، وكان القياس اللغوي أن يقول: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنهم عن الصراط لناكبون، هم المشركون لكن عوض الإضمار أتى بالذين لا يؤمنون بالآخرة، هم أنفسهم. كأنه يقول: عدم إيمانهم بالآخرة جعلهم ينكبون عن الصراط وجعلهم يعدلون عن الصراط. {وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ} الحديث عن المشركين، أتى بهم بالضمير {إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}، كان القياس أن يقول: وإنهم عن الصراط لناكبون، هو قال: {وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} ليبين لنا أن عدم إيمانهم بالآخرة كان سببًا في تنكّبهم عن الصراط المستقيم. هذه النكتة البلاغية رقم 1، النكتة البلاغية رقم 2: في البداية ماذا قال؟ {إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} صراط مستقيم، لما تحدّث في المرة الثانية قال: {وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ} لم يقل: عن الصراط المستقيم {عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} الألف واللام تفسيرها لها تأويلان: {وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ} المذكور قبل قليل إذًا اللام العهدية هذه فبالتالي لا داعي لأن نصفه مرة أخرى، هذا المعنى رقم 1 {وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ} المعهود {لَنَاكِبُونَ} إذًا الألف واللام عهدية. لكن هناك تفسير أولى وهو: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن جنس الصراط لناكبون، عن أيّ صراط فهم لا يهتدون فمن باب أولى لا يهتدون إلى الصراط المستقيم، وهذا أتم في بيان ضلالهم. المعنى الثاني: الألف واللام جنسية تفيد جنس الصراط، هم ناكبون عن أيّ طريق موصلة إلى الخير، موصلة إلى مكان آمن، من باب أولى هم ناكبون عن الصراط المستقيم.
– يقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}، هنا يقول: {فَمَا اسْتَكَانُوا}، استكانوا في الماضي (لربهم) ما قال وما تضرعوا، لماذا قال {وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}؟ لماذا في الماضي ثم يعدل عنه إلى المضارع؟
– هو الله سبحانه وتبارك وتعالى ابتلاهم بالعذاب، والعذاب قلت هنا دنيوي بدليل أنه قال: {فَمَا اسْتَكَانُوا} {وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}، وكاد الحديث موجودًا يعني يخاطبهم فالعذاب دنيوي. بعض العلماء يقولون: يقصد به عذاب السيف في يوم بدر وبعضهم يقول: عذاب الجوع عندما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ {فَمَا اسْتَكَانُوا} بمعنى فما خضعوا، استكانوا استفعل من الكون، من السكون، ما خضعوا لأن من شأن الإنسان عندما يخضع أن يقطع الحركة، الإنسان عندما يخضع للذي يخاف منه أو للذي يصيبه يسكن في مكانه، يقطع الحركة ويخضع، قال: {فَمَا اسْتَكَانُوا} وما تواضعوا وما خضعوا، {وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} جاء بها في المستقبل لإفادة الاستمرار يعني للأسف أنهم لا يتضرعون، كان الأولى بهم أن يستمروا في التضرع وأن يعودوا إلى ربهم ويتوبوا من كفرهم وبالتالي قد تدركهم رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا {فَمَا اسْتَكَانُوا} في الماضي، عدول إلى المضارع لإفادة عدم تجدد تضرّعهم {وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}.
– الآية التي تلي هذه الآية: {حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} هذه الآية فيها صورة عجيبة جدًا، نفسرها ثم نشرح الصورة التي فيها.
– (حتى) من التقنيات اللغوية المستعملة في سورة المؤمنين، قلنا: (حتى إذا أخذناهم بالعذاب)، وهذه حتى تسمي الابتدائية، ليست للغاية هنا لابتداء الكلام {حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ}، {حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ}، {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ}، الأخيرة فيها معنى الغاية لكنها تقنية مستعملة والتناسق مرعي في التركيب القرآني – يعني إلى أن جاء أحدهم الموت-. هنا {حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ} إلى أن فتحنا عليهم بابًا، هذا المعنى وارد لكن هي تسمى حتى الابتدائية، لماذا؟ يبتدأ بها كلام جديد، {حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا} لم يقل: حتى إذا عذبناهم بعذاب الجوع أو عذاب بدر أو، لا، {فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ} هنا انتقلنا إلى صورة بلاغية رائعة، صورة شبّه تسليط العذاب عليهم بقوم آمنين مطمئنين في غرفة فُتح عليهم باب عذاب يعني كأنه تسونامي، زلزال في البحر فأتى على الأخضر واليابس! هكذا لك أن تتصور، لم يقل: فتحنا عليهم باب عذاب قال: {بَابًا ذَا عَذَابٍ}. لأنه لو قال: باب عذاب، صحيح المضاف والمضاف إليه يدلّ، لكن (بابًا ذا عذاب) شدة الاتصال بين الباب والعذاب ولكي يمكننا هذا التعبير من وصفه بالشدّة. لو قال: حتى إذا فتحنا عليهم باب عذاب، شديد تأتي ثقيلة، بابًا ذا عذاب شديد، لكن في سورة الفجر قال: {فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ} أضافه، هنا لم يقل: صب عليهم ربك سوطًا ذا عذاب، لماذا؟ لأن صب تكفي؛ الصب فيها وفرة نزول العذاب، صبّ صبًا. فهنا كفت عن الشدة أو عبّرت عن الشدة. هنا قال، لكن الصورة جميلة: {فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عذاب شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} (إذا) الثانية تفيد المفاجئة، الأولى تفيد الظرف والشرط {حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ} النتيجة؟ {إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ}، (إذا) فجائية، مبلسون: يعني موقنون بعدم النجاة، ما معنى الإبلاس في اللغة العربية؟ أبلس أي استيأس من النجاة. تلبس بحالة معينة، أيقن بهلاكه. والإنسان الذي يوقن بالهلاك كيف يكون؟ مسرورًا؟! يكون شديد الحزن، الإبلاس هو شدة الحزن مع تيقّن عدم النجاة.
– منها إبليس؟
– لا، إبليس الله أعلم، الشيطان من شطن وإبليس من، لا أدري إذا كانت من نفس المادة، لكن الإبلاس. يراد لها بحثًا أبحث فيها، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} عندما لا أعرف أنا أبحث وهذا يدعوني إلى البحث، لكن الإبلاس هنا شدة اليأس من النجاة يعني ما عندهم نجاة وتيقنوا.
– وكذلك إبليس يئس من النجاة
– بعد ما حكم الله عليه باللعن والطرد – لكن سأنظر فيها إن شاء الله-.
– فقط قال: ربِ، أنظرني.
– {إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} صورتهم الآية بأنهم في حزن شديد وتيقن من عدم النجاة. هذه الصورة سبحان الله يعني بقدر ما هي جميلة من الناحية البلاغية هي مخيفة كذلك في ذات الوقت لا بد أن نحذر عندما نتعلم.
– {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ } ما علاقة هذا الكلام بالآيات التي قبلها؟ أجدنا كأننا دخلنا إلى موضوع آخر أو دخلنا إلى موضوع آخر أو ربما استأنفنا موضوعًا كان قد فُتح سابقًا.
– هو هذا، الآية التي، لو أردنا أن نتدبر هذه الآية مع سابقتها يعني لا يستقيم الكلام؛ لأنه كما تفضلت {حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ}، هنا يتحدث عن تعذيبهم وفتح العذاب باب العذاب، وهنا انتقل إلى الامتنان بنعمة السمع والبصر والأفئدة. امتنان {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ}، هنا عودة للموضوع الذي فتح سابقًا، هذه روعة النظم القرآني.الموضوع الذي بدأه الله تبارك وتعالى من قوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ}، الامتنان في بداية السورة {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ}، امتن على خلق الإنسان وذكر المراحل ثم قال: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ} خلق السموات، ثم قال {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ} {فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ} ثم ذكر {إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً} ولما تحدث عن {إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً} وقال: {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}، قال: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ}، بدأ شوطًا طويلًا في النقاش في العقيدة {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا} قصة نوح، يعني كأن ما بعد هذه الآية إلى أن نصل إلى هذه الآية هذه كلها جمل اعتراضية، كلها هذه الصفحتين ونصف، المقصد من كلامي ذكر الامتنان ثم فتح بابًا للقصص بين قوسين، ثم بعد القصص أعقبه الحديث عن الأمة المحمدية التي يشبه مشركوها مشركي الأمم السابقة ثم عاد الحديث عن الامتنان من جديد إلى الموضوع الرئيسي. {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ} عودة إلى الاستدلال بالامتنان على الناس، يعني هذه الواو ليست استئنافية وإنما عاطفة على ما سبق، وهكذا ينبغي أن نقرأ القرآن ونستطيع أن نقول هي جمل اعتراضية أخذت صفحتين أو ثلاث، هذا ديدن القرآن ولا يشبه أسلوبَه أسلوب!.
– نبين العلاقة ما بين صدر الآية ونهايتها: حينما يقول الله سبحانه وتعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} ثم {ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} {الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ} {أَفَلَا تَعْقِلُونَ}، هل هناك علاقة ما بين ذكر النعمة والتذييل؟
– سواء عرفت أو لم أعرف ثمة حكمة، مليون بالمئة كل صدر آية وكل نهايتها بينهما أسرار وثمة توافق عجيب، لأن المنطق السليم – لا يستقيم إلا كما قال الله سبحانه وتعالى، {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ}، أولًا: نذكر المشاهد الكريم أن أنشأ هنا وهي أيقونة لفظية لسورة المؤمنين سيذكر كل قارئٍ لها فأنشأنا أنشأنا. {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ} بالإفراد {وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ} ذلك الإفراد هنا لأن متعلقات السمع واحدة وهي الأصوات بينما الأبصار لها متعلقات كثيرة؛ في السموات في الإنسان في الزرع، الأبصار. والأفئدة طرق عقل الفؤاد يعقل ويفكر بطرق مختلفة، وقال العلماء: وحّد السمع نظرًا لوحدة المتعلّق وهو الأصوات وجمع الأبصار والأفئدة نظرًا لكثرة المتعلقات، هذه فائدة فقط. {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} خطاب للمشركين بالدرجة الأولى يمتن على المؤمنين ولكن بما أنه تحدث عن المشركين كثيرًا فقال: {قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} أي تشكرون شكرًا قليلًا للأسف الشديد {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} ما يشبه هذه الآية، ألم نقل: في سورة النحل {جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ}، لم يقل: أنشأ لكم السمع، قال: {جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}. لماذا قال في سورة النحل {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}؟ كان الحديث عن المؤمنين بالدرجة الأولى، {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} يمتن على المؤمنين أكثر، {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} رجاء أن تشكروا أنتم، طبعًا الترجي في حق البشر لا في حق الله تعالى، والمفسرون يقولون: (لعلّ) هنا نفيد التحقيق؛ لو أنكم استعملتم السمع والبصر والفؤاد سيقودكم ذلك إلى الشكر حقًا وصدقًا، الدليل بعد ذلك: {أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} لما كان في سياق الإيمان قال: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، لما كثر الحديث في سورة المؤمنين عن المشركين و{فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ} وبعد قليل سيأتي {بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ}، قال: {قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ}، إذًا ثمة تناسب بين صدر الآية والتذييل، أعطاك هذا السمع والبصر والفؤاد حريٌ بك أن تشكر. بعدها {وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ} ذرأكم بمعنى خلقكم وبثكم على الكرة الأرضية، ذرأ بمعنى خلق وبث ونشر، ثم ماذا قال؟ {وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} ذرأكم ونشركم وسيجمعكم هذا طباق جميل جدًا، ذرأ وحشر، بثكم في الأرض هكذا؟ {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} سيُرجعكم. إذًا هنا قال: {ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ} وخلقكم واستدل عليهم وامتن عليهم بنعمة الإيجاد والذرء ثم قال: لا بد أن تحشروا إليه. ثمة تناسق. بعد ذلك قال: {وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} والله هذا يدعو إلى {أَفَلَا تَعْقِلُونَ}، كان حريًا بكم ما دمتم عرفتم أن الله وهبكم السمع والأبصار والأفئدة، وما دمتم أيقنتم أنه هو الذي خلقكم وذرأكم في الأرض، سيقودكم ذلك إلى الإيمان بالله الذي يحيي ويميت، في النهاية استخدموا قدرات العقل، الذين لا يؤمنون، مع كل الأدلة السابقة في الحقيقة هم إلى الجنون أقرب لأنهم لا يستخدمون عقولهم ولو استخدموا عقولهم لفاءوا وعادوا على الله سبحانه وتعالى. يعني لا ينكر هذه الآيات الواضحات إلا مجنون لم يستخدم عقله الصحيح وثمة تناسق عجيب بين التذييل دائمًا وبين صدر الآية.
– ثم يقول الله سبحانه وتعالى: {بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ} ماذا قالوا؟ {قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ}. {لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}، {لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا} كأنها وردت {لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا} في سورة النمل بينما هنا يقول: {لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا}.
– أولًا: {بَلْ قَالُوا} الحديث عن المشركين، {مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ} {أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا}، هم يرددون الكلام الذي ذكره قوم سابقون {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا}، أقوام الرسل السابقين، هم قالوا: {لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ}، التعبير في سورة المؤمنين أتى على وجهه الصحيح؛ لأن في التعبير الصحيح يقدم الفاعل ويقدم نائب الفاعل عن المفعول، {لَقَدْ وُعِدْنَا} فعل بني للمجهول، {نَحْنُ} نائب فاعل. أو دعني أقول: {وُعِدْنَا}، {نَا} هو نائب الفاعل و{نَحْنُ} توكيد له، {لَقَدْ وُعِدْنَا} الضمير (نا( المتكلم أو المتكلمين هي في محل رفع نائب الفاعل، و{نَحْنُ} تأكيد لها، هذه تسمى نا الفاعلين، نا الفاعل، ونحن ضير منفصل يؤكد هنا توكيد مثل {يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ} {اسْكُنْ أَنْتَ}، أنت توكيد للضمير. هنا {لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ} هذا أتى على الكلام العربي الصحيح؛ لأن العرب تقدم الفعل ثم الفاعل أو نائب الفاعل ثم المفعول به. وعدنا هذا. ماذا في سورة النمل؟ {لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ} تم تقديم {هَذَا} هي بالفعل {لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ} {وَآبَاؤُنَا}؛ لأن الآية في سورة النمل والسياق في إنكار البعث أكثر منه في سورة المؤمنين في إنكار البعث، تقول: لماذا؟ {أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} السياق، {وُعِدْنَا} قلنا: فعل مبني للمجهول ونائب فاعله {نَا} و{نَحْنُ} توكيدًا لها، {هَذَا} اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول، (وعد) متعدي لمفعولين لأن لو كان الفعل وعد متعدي لمفعول واحد لكان اكتفى بنائب الفاعل. هنا هذا المفعول الثاني، فأصبح المفعول الأول وعدنا نحن وآباؤنا هذا. فهذا أصل الكلام يستقيم هكذا، وعدنا نحن وآباؤنا هذا. على الترتيب العربي الفصيح وما أتى على الأصل لا يسأل عنه.
– العكس، {لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا} قدم المفعول به لأن السياق يتحدث عن البعث والعرب تقدم ما هم ببيانه أعنى، السياق {أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} بعدين يقول: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} البعث، الحديث عن البعث، بعد ذلك يقول: {بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا} يوم القيامة، {بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ} عُميٌ عن الآخرة، ثم يقول: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا} نكتتان اثنتان {أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا}، أولًا: السياق في البعث رقم 1، رقم 2: حتى عندما استنكروا ماذا قالوا؟ قالوا: {أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا} قدّموا التراب الذي هو خبر كان على الآباء المعطوفة على اسم كان. المفروض أإذا كنا وآباؤنا ترابًا، ماذا قالوا في سورة النمل أو أنطقهم القرآن؟ {أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا} قدموا خبر كان على المعطوف وهو المراد لأن القضية تتحدث عن البعث، حسن أن يتناسق ما بعدها، فقالوا: {لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا} الإتقان في القرآن عجيب والله! والتناسق والنظم على ما أتى به النظم الجليل شيء عجيب!.
كان محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في غار حراء ما خرج من غار حراء ولم يتتلمذ على أستاذ ولم يدرس البلاغة العربية أنّى له أن يأتي بمثل هذا؟ في عيشة كان يعيش فيها مصاقعة البلغاء والوليد ابن المغيرة وعنتر ابن شداد، وأتاهم بكلام أعجزهم وأفحمهم وخروا له سجدًا وهذا الكلام ليس إلا لله!
– هنا يسأل الله سبحانه وتعالى يعني أسئلة كثيرة: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ} طبعًا يسأل ويجيب، {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ}، أنا أفهم أنه حينما يسأل الله سبحانه وتعالى: لمن الأرض؟ أن يكون الجواب: لله، وهكذا جاءت الجملة الأولى، لكن حينما يسأل الله سبحانه وتعالى {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} في غير القرآن سأجيب: سيقولون: الله، فلماذا يقول: لله؟ {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} في غير القرآن سأجيب: سيقولون: الله، الله هو بيده ملكوت كل شيء، فلماذا هنا كرر لله ولله؟
– المفسرون جزاهم الله خير وقفوا عند كثير من هذه اللقطات واللمسات؛ أولًا: تحوّل الآن بعدما ذكر الامتنان بالسمع والبصر كما ذكرنا انتقل إلى تلقين محمد، قبل، لم يلقنه، قال: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ} {وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ} الآن {قُلْ} لقنه ماذا يقول لهم، قل لهم يا محمد من، {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ} وهذا أمر جميل، وهو التنويع في مخاطبة؛ لأن هذا كل الخطاب على المشركين الذين أنكروا وجحدوا وأشركوا، فهنا حدثهم ثم تحدث إليهم أو تحدث عنهم، والآن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطبهم واسألهم عن هذه الأسئلة ولو كانوا ذوي عقول راجحة لأجابوك وقالوا: سيقولون: لله، هو يطرح السؤال ويجيب أو الاستفهام ويجيب، الذي يستوقفنا {قُلْ} و{قُلْ} و{قُلْ} ثلاث مرات، كان يستطيع أن يذكرها مرة ثم يعطف، لكن التعداد مقام التعداد والتلقين يحتاج إلى (قل)، لما أنت تقول لابنك: اذهب إلى معلمك غدًا وقل له: هل لدينا امتحان؟ وقل له، أنت تلقن ابنك كيفية السؤال، فهو الله جل جلاله – ولله المثل الأعلى – يلقن محمدًا كيفية الأسئلة صلى الله عليه وسلم، {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا} سؤال تقريري المفترض لو كانت لديهم عقول راجحة سيقولون: لله، لكن الذي أريد أن أقفك عنده {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (إن) شرطية، {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أين الجواب؟ محذوف، جواب الشرط محذوف. {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} فسوف تجيبوني بالإيجاب، {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} فسوف تعودون لما أقول سوف توافقون على ما أقول لكم، واضح الكلام أستاذ محمد؟ {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} فسوف تقرون بما أقول لكم، {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ} هذه رقم 1. السؤال الأول أتى على الأصل، لمن؟ لله، يعني إن كنتم تعلمون فستقولون: لله. فأجيبوني لكن هو لم يأتِ بالجواب حذفه وقال: {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ} جملة استئنافية تقرر ما سوف يقولون. رقم 2: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} القياس سيقولون: الله، هم قالوا: سيقولون لله. لماذا؟ هم عوض أن يقولوا له: من هو رب السموات والأرض، ويعترفوا له بالربوبية كما اعترفوا في جهة أخرى، لكن هنا أرادوا أن يبتعدوا عن الإقرار بالربوبية المطلقة لله؛ لأنهم يتخذون مع الله الملائكة أربابًا، فعوض أن يجيبوا إجابة مباشرة عن من هو الرب، أجابوا عن المُلك، قالوا: لله، يعني كأن، ملك السموات والأرض لله، يشيرون إشارة غير دقيقة غير صحيحة، لم يجيبوا بشكل مباشر أن الله هو رب السموات السبع ورب العرش العظيم، بل أجابوا: لله، كأن السموات السبع والعرش العظيم هي لله ولم يجيبوا إجابة مباشرة حتى لا يصطدم ذلك بإيمانهم ببعض الأرباب بمعتقداتهم، {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} سواء من الأصنام أو ممن يعبدون من الملائكة أو من الكواكب والنجوم، في اليمن كانوا يعبدون الشعرى، فالله قال لهم: من رب السموات والأرض؟ فيقولون: لله، هنا يعني عدلوا عن الإجابة الصحيحة حتى لا يخدشوا معتقداتهم. ولكن في النهاية سيقرون. وهنا حذف (إن كنتم تعلمون)، كان القياس حسب الأولى. {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} إن كنتم تعلمون، ما اشترط عليهم لأن الأولى أغنت عن الثانية، انتهى الموضوع. {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ}، بعدين التذييل {أَفَلَا تَتَّقُونَ}، هذا الرب الإله الذي تقرون أنه يملك الأرض ويملك السموات السبع ويملك العرش العظيم أفلا تخشونه؟ أفلا تتقونه؟ لم يقل: أفلا تذكرون، {أَفَلَا تَتَّقُونَ} هذا الإله. أفلا تجعلون بينكم وبينه وقاية ووقاءً، إذًا زاد الكلام. السؤال رقم 3: {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} ما معنى الملكوت؟ التصرف في الملك. الملكوت من الملك لكن لم يقل: قل لمن بيده الملك، لا، الملكوت، هنا أقول: الملكوت هو التصرف المطلق في ملك السموات والأرض وما فيها. وهي لفظة عربية ووردت في القرآن أربع مرات فقط في هذا المقام وفي مقام سورة الأنعام {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}. و{فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون}[يس] و {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء}[الأعراف]. ملكوت على وزن (فَعَلوت) وفعلوت على رهبوت ورحموت، لكنها لم تستعمل إلا ملكوت في القرآن الكريم. – القرآن فيه أوزان عجيبة وهذه الصورة وهذا الوزن عجيب وزن يفيد الإحاطة، {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ}، ستقول: الملكوت الملك الكامل، {كُلِّ شَيْءٍ}كل لفظ يفيد الإطلاق والشمول، قضية موجبة كلية لا يشذ عنها شيء، يعني هو إن قال: من بيده الملكوت، لكفته لكن قال {ملكوت كُلِّ شَيْءٍ}. بعد ذلك انظر {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ} هو الذي يمنع ولا أحد يستطيع أن يمنع منه جل جلاله، هو الذي يستطيع أن يحمي ولا أحد يحمي حماه أو يصيبك شيء والله حاميك، {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}، {وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ}، لا أحد يستطيع أن يخرج من ملك الله أو أن يتصرف بغير إذن الله، {فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} أنى تسحرون ولا تستعملون عقولكم، بلغتنا أنّى تخدعون، ما هو السحر؟ هو الخداع.
– كيف تخدعون على عقولكم ولا تستعملونها ما دمتم أقررتم أن الله مالك الأرض وأن الله مالك السموات السبع؟ صح؟ ومالك العرش العظيم ومالك الملكوت بيده الملكوت، فأنّى تسحرون عن عقولكم؟! انظر إلى التناسق بين البداية والنهاية، وهنا لأن {مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} ذكر {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} للتذكير لأن ملكوت كل شيء هزهم هزًا عنيفًا. أضيف لك قبل أن ننتهي إن شئت من هذه الآية، هذا أسلوب الترقي سألهم عن الأرض لأنهم يعيشون في الأرض وهم أعلم بمن في الأرض
{قُلْ مَنْ بِيَدِهِ} أو ماذا قال؟ {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا} هم يعيشون في الأرض سألهم عن الأرض، ثم ترقى بهم إلى {السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}، أقروا {أَفَلَا تَتَّقُونَ} ثم ترقى بهم إلى {مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} أسلوب الترقي يعني يلقن محمدًا صلى الله عليه وسلم كي يترقى بهم إلى أن تأتي الحجة القاطعة فتقطع قول كل خطيب.
– حتى يقول الله سبحانه وتعالى:{ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}، أول شيء هنا محذوفات كأنها في الآية؟
– مئة في المئة، نعم. لأن يعني في الكلام العربي لا يستقيم هذا الكلام إلا إذا حذف منه شيء والله سبحانه وتعالى حذف أشياء والقرآن فيه حذف كثير جدًا، حتى دعني أقول لك لماذا لم تسألني قبل قليل، قلنا: أفلا تعلقون، أفلا تعقلون ماذا؟ أيضًا مفعول به محذوف، أفلا تتقون الله، محذوف، كثير من، خصوصًا الحذف في القرآن كثير، {أَفَلَا تَتَّقُونَ} هذا الذي بيده السموات والأرض؟ محذوف، {فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} عن استعمال عقولكم؟ الحذف سبحان الله عما يصفونه به.
– يعني كل شيء عُلِم للقارئ لا داعي لذكره.
– هكذا، لما نحن نقول: {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}: أي سبحان الله عما يصفونه به من شرك ومن ومن، محذوف. وهنا أيضًا {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}، أول شيء أريد ما علاقة هذه الآية بما قبلها أو بمحور السورة كله؟ الشيء الثاني: لما يقول الله سبحانه وتعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ} في شيء هنا {إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ} ما أعرف ما الذي هنا يعني يجب أن يكون؟ {إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}، كل هذا سنجيب عنه في الحلقة القادمة.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة المؤمنون – 7
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
المحور التي تدور حوله السورة:
د. المستغانمي: نحن أسلفنا فيما سبق من حلقات أن سورة المؤمنون محورها العام هو الحديث عن فريق المؤمنين الكبير وأعمالهم التي يتميزون بها (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾) مطلع السورة حدد كثيرًا من أعمال المؤمنين ما يقومون به وأفعالهم، وفي وسط السورة أيضًا جاء حديث عن صفاتهم الإيمانية الداخلية (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾) وفي نهاية السورة أيضًا جاء ذكر لهم (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾)، فالمحور العام هو الحديث عن المؤمنين كما أفرد الله تعالى سورة للكافرين (قل يا أيها الكافرون) وأفرد سورة للمنافقين، أفرد سورة لأهل الإيمان. يتخلل ذلك كما ذكرنا شيء من القصص القرآني الذي تمثل في قوله (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾) وما جاء بعده وشيء من دلائل التوحيد (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾) (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ) (قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾) هذه دلائل التوحيد ودلائل نفي الشرك فلذلك السورة تحدثت عن أهل الإيمان وعن صفاتهم وتخللها شيء من المواضيع العقائدية التي تتناول في القرآن المكي بشكل عام.
المقدم: نحن تقيبا في نهاية السورة وكنا قد توقفنا عند الآية 91 (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾) سياق الحديث في خارج القرآن لن نقول هكذا سنقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ولو حدث هذا لصار كذا وكذا، لكن هنا كأنه هناك شيء محذوف، لماذا هذه المحذوفات وهو كثير في القرآن؟
د. المستغانمي: هذه الآية عظيمة جدًا (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ) هل اتخذ الله ولدا؟أبدًا، هذه (ما النافية) تقرر هذا المعنى الذي يتعلق بنفي أن يتخذ الله ولدا (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ) (من) تعبر عن الجنس وتستغرق كل شيء، في الإعراب يقولون (من) زائدة ولكن (من زائدة) للتوكيد لأنه لما نقول ما اتخذ الله من ولد أي ما اتخذ من ولد أبدًا.
المقدم: هي زائدة في الإعراب وليست زائدة في المعنى
د. المستغانمي: أبدًا، لا يوجد شيء زائد في المعنى. قبل أن أجيب عن سؤالك، ما موقع هذه الآية من السورة كلها؟ هذه الآية تثبت الإيمان وتثبت التوحيد ودلائل التوحيد، الآيات التي سلفت (قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾) هذه الآيات السابقة مباشرة تثبت توحيد الله، أردفها بما يثبت نفي الشرك، الإنسان لا يسلم اعتقاده حتى يثبت الوحدانية لله وينفي عنه الشركاء وهذا مقتضى (لا إله إلا الله) نثبت إلهية الله وننفي الشركاء عنه، فهذا التجاور. في الوقت نفسه سبق في القصص أن ذكر سبحانه وتعالى (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾) لماذا اكتفى القصص القرآني بهذه الآية فقط؟ كأن تلك الآية في القصص كانت تمهيدًا لهذا الكلام مع أن بينها فاصل طويل، الله سبحانه وتعالى جاء من القصص ما يخدم فكرة التوحيد ونفي الشركاء وإلا فقصة عيسى فيها كثير من التفاصيل لكن أتى هنا بما يخدم محور السورة تثبت التوحيد وتنفي الشركاء (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً) مولده من أم دون أب كان آية كأنه يقول: وهذا يثبت ما يأتي (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ) فكونكم اتخذتموه ابن إله أو إلهًا فهذا خطأ (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ) تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون ثمة إله.
المقدم: حتى من قال بأن عيسى بن مريم ليس ابن إله وإنما إله فهذا ينفي كذلك
د. المستغانمي: هذا ينفي والذين عبدوا الملائكة من دون الله هذا ينفي، ينفي كل جنس الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى من عبادة الملائكة، عبادة عيسى، عبادة الأصنام. (إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ) المحذوف شرط المحذوف: لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق، هذا دليل برهاني على نفي الشركاء وهذا الدليل عظيم جدًا. سوف تقول لماذا قدّرت (لو كان)؟ أن يكون مع الله إله مستحيل لأن الدلائل “وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد” (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسَدَتَا) [الأنبياء: 22] والمستحيل في اللغة العربية النُحاة والعرب أعدّوا له حرف (لو) حرف امتناع لامتناع، امتناع وقوع الجواب لامتناع الشرط، لو جئتني لأكرمتك أنت ما جئتني وبالتالي لم أُكرمك بينما (لولا) حرف امتناع لوجود. إذن لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق، غالبًا في جواب (لو)
المقدم: لكن هنا ما ذكر (لو)
د. المستغانمي: هذا الكلام المحذوف
المقدم: (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ) في غير القرآن لو حدث هذا أو لو اتخذ ولدا أو لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق.
د. المستغانمي: اللام الواقعة في جواب الشرط تدلّ على أن ثمّة شرطًا محذوفًا وهو (لو) وليس غيره لأن (لو) غالبًا يرتبط جوابها باللام بينما (إن) تقول إن جئتني أكرمتك ولا تقول إن جئتني لأكرمتك. لكن (لو) غالبًا أقول وورد في القرآن (لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾) كما في سورة الواقعة (جعلناه) بدون لام. مثال آخر في القرآن الكريم يقول جلّ جلاله (وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) العنكبوت) لو كنت تتلوه وكنت تخط من حقهم أن يرتابوا إذن لارتاب المشركون وشكّوا، فاللام الواقعة في الجواب تدل على أن المحذوف فعل الشرط مع (لو). (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ) [النساء: 140] ما قال هنا (إنكم إذن لمثلهم) هنا يجوز تقدير (إن) إن قعدتم معهم إنكم إذن مثلهم. فعل الشرط وإن المحذوفة. قدّرنا (لو) والعلماء والمفسرون قالوا غالبًا يرتبط جواب (لو) باللام.
المقدم: آية سورة الواقعة (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ الواقعة)
د. المستغانمي: وقبلها (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾) عندما تكلم عن الزرع وفي الماء قال (جعلناه)، والعلماء يقولون يجوز ولكن في الغالب ترتبط مع اللام.
هذه الآية الكريمة من محاور السورة تثبت الإيمان وتنفي الشركاء (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ) تقرير، (وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ) نتيجة ثم أعطى الدليل (إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) الدليل العقلي البرهاني، لو كان ثمّة آلهة لكان لتلك الآلهة مخلوقات وآراء وأشياء في هذا الخلق لأننا نقول نحن مخلوقات الله، الإله الذي لا يخلق ما فائدته؟! الإله من خصائصه أن يخلق، أين هذه المخلوقات؟ هذا يستلزم أن مخلوقات هذا الإله تذهب معه ومخلوقات الإله الثاني لا يتصرف فيها الإله الأول هذا يدلّ على أن ثمّة عجزًا في هذا الإلعة والعجز يناقض الإلهية، هذا مدلول قوله تعالى (إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ) هذا الجانب الأول. لو كان ثمة آلهة مخلوقاتها تتفاوت، نحن الآن الأقمار والشموس والكواكب تتفاوت والبشر يتفاوتون والحيوانات تتفاوت عندنا النملة والحشرة والفيل. بعض المخلوقات فيها قوة أكثر من مخلوقات أخرى – هذا عقليًا – لعلا بعضهم على بعض، لو كان ثمة آلهة أخرى يستلزم أن يكون أن تكون لها مخلوقات مختلف والمتفاوتة تتفاوت، إذن لتفاوت هذا الإله عن هذا الإله والتفاوت في الإلهية لا يجوز
المقدم: يعني سيكون هناك إله يتفاوت عن إله آخر
د. المستغانمي: هذا يثبت أن الثاني ليس إلهًا وهذا الاستدلال العقلي فالله أتى بأدلة عقلية (إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) بما أن الواقع يثبت أن ذلك غير موجود فالإله الواحد هو الله الأحد الذي الكل مخلوقاته.
المقدم: ثم أردفها بلفظة (سبحان)
د. المستغانمي: هذه نتيجة، بما أن كلامكم خطأ سبحانه وتعالى عما تصفونه به من شِرك ومن جعل الشركاء معه، هذه كلمة تنزيه. نفى أن يكون معه إله ولم ينفي أن يكون معه ابن
المقدم: بطبيعة الحال
د. المستغانمي: لأنه لو كان له ابن لكان إلهًا بالضرورة
المقدم: لأن ابن الإله إله، ابن الشيء من جنسه
د. المستغانمي: ابن الإنسان إنسان وابن الحيوان حيوان. لو كان له ابن لكان إلهًا بالضرورة وما دام نفى الإلهية عن الآخرين فنفى عن ابنه
المقدم: وبالتالي لا داعي لأن ينفي عن ابنه
د. المستغانمي: عن الابن المزعوم. وثمة آية في سورة الزمر عجيبة، الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم لقّنه أن يقول للمشركين (قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) الزخرف)
المقدم: وهذه (لو) الامتناعية
د. المستغانمي: يمتنع أن يكون له ولد لكن لو كان فرضًا وجدلًا وإفحامًا وجاراهم لكنت أول العابدين لأني أعلم عقلًا أن ابن الإله إله.
المقدم: لا يقول هذا الكلام إلا من يثق أن هذا الكلام لا يستقيم
د. المستغانمي: لو الامتناعية تمنع والمتحدث عاقل وهو رسول فيمنعنا نحن أن نفكر فيه الشرك فقال جارِهم وقل: لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لكن لم يكن ذلك لا عقلًأ ولا منطقًا فأنا أول الموحدين.
المقدم: بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾) بداية ما مناسبتها مع ما سبقها من آيات؟ ثم ما الفرق بين في القوم الظالمين أو مع القوم الظالمين أو من القوم الظالمين؟
د. المستغانمي: هذه الآية لما أوضح الله جلّ جلاله وجل ثناؤه لرسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك الذي انغمس فيه أهله الرسول يهتز بدنه ويخاف: هؤلاء قومه ويحيطون به، يدّعون على الله أشياء فظيعة! منهم من قال اتخذ الله ولدا ومنهم من قال اتخذ الملائكة بنات وجعلوا له شركاء فهذا مصير مؤلم ورأى في القرآن السابق من قصص الأنبياء ما حلق بالأقوام المكذبين فهو يخاف عليهم وعلى نفسه علّمه الله في القرآن أن يقول (قل) في القرآن (قل) للتلقين الله سبحانه وتعالى يلقّن رسوله في المواضع الحساسة (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي) إذا كان صعب عليك ما ترى من شركهم قل (رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي).
المقدم: ما هذه (إمّا)؟
د. المستغانمي: (إمّا) أصلها (إن) زائد (ما) شرطية جازمة (إن ترني) (ما) صلتها مؤكّدة (تريَنّي) أُلصقت بنون التوكيد الثقيلة والفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة يُبنى. يُبنى في حالتين: إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة ونون النسوة. (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي) أصلها: إن تُرِني، هذا كلام شديد يحتاج إلى توكيد: إما تريني ما يوعدون من العذاب، العذاب الدنيوي، العذاب الأخروي الرسول صلى الله عليه وسلم لن يكون من بينهم ولا فيهم، يمتاز الناس والرسول يكون مع الملأ الأعلى في الجنة لكنه هو خشي أن يلحق بهم العذاب في الدنيا لأن الأقوام السابقين لحقهم العذاب في الدنيا. إذن (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾) (في القوم) (في) في العرب تفيد ظرفية (الماء في الإناء) ظرفية، نقول: في المدرسة، داخل المدرسة أو في المسجد، ظرفية. (مع) تفيد المعيّة، (من) من إلى أو من الجزئئة لا تجعلني منهم أي جزءا منهم. هنا قال (رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) لا تجعلني فيهم هذا تعليم وإيماء وإشارة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه حين ينزل الله العذاب عليهم لن يكون الرسول فيهم وكان في المدينة المنورة، إيماءة وإشارة للهجرة النبوية، الظرفية هنا قال (فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) قال اطمئن يا محمد سوف يحيق بهم العذاب وأنت بعيد عنهم ولكن ترى وحاق بهم العذاب يوم بدر والرسول يرى
المقدم: وقال الله تعالى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ الأنفال) قال وأنت فيهم ما قال وأنت معهم.
د. المستغانمي: (في) الظرفية، فالقرآن دقيق. فيه إشارة تلميحية أنه يوم يُنزل بهم العذاب لن تكون فيهم إنما تكون بعيدًا عنهم وفعلا أراه الله تعالى ما يسرّه في غزوة بدر وكان يرى مصارع القوم، قال: إني أرى مصارع القوم. أريد أن أعلق على شيء آخر في الآية وأنا أقرأ في التفاسير انظر إلى تكرار (ربِّ) أصلها يا ربي حذفت أداة النداء وحذفت ياء المتكلم، انظر إلى عظمة القرآن لكن جاء تكرير فعل المنادى في الشرط وفي جواب الشرط لزيادة التضرع، الله علمه أن يتضرع (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾).
المقدم: حينما يدعو الله سبحانه وتعالى مناجيًا ربه يكرر رب رب رب
د. المستغانمي: هذا تضرع وإلحاح علّمه فن الدعاء فجاء بكلمة (رب) للمنادى التي تفيد التضرع في فعل الشرط وفي جواب الشرط. عندما أجابه جلّ جلاله قال (وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾) هنا وقفة جميلة، الله جلّ جلاله قادر، الله على كل شيء قدير قال هنا: وإنا على أن نريك ما نعدهم من العذاب في الدنيا (لقادرون) وفي آية أخرى في سورة الزخرف قال (أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ (42) الزخرف) لماذا قال هنا قادرون وهنا مقتدرون؟
المقدم: قادر اسم فاعل من قدَر،
د. المستغانمي: مقتدر من اقتدر افتعل الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى وكلاهما من القدرة وكلاهما اسم فاعل. قادر من فعل قَدَر ثلاثي ومقتدر من اقتدر خماسي لكن لماذا هذا التباين؟ هنا أولا العذاب المذكور في سياق سورة الزخرف شديد (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ (41) الزخرف) ونميتك ونقبضك إلينا يا محمد فإنا منهم منتقمون وسورة الزخرف بنيت على الانتقام وليس على الهلاك. (أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ (42) الزخرف) زيادة البناء تدل على زيادة المعنى يعني أخذهم أخذ عزيز مقتدر فالزيادة تدل على المبالغة في أخذهم والاقتدار عليهم. والذي اقتضى قادرون في آية سورة المؤمنون أنه في بداية السورة ذكر (وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ) [المؤمنون:18] فالتجاب اللفظي في سورة المؤمنين (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾) فهنا ناسبها أن يقول (وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾) أما مقتدرون فناسبها السياق اللفظي في سورة الزخرف فيها مقترنين، مستمسكون، مهتدون، مقتدرون، يناسبها لفظيًأ ومعنوياً.
المقدم: (لقادرون) هذه اللام هي المزحلقة؟
د. المستغانمي: نعم لام المزحلقة.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي بعد ذلك (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾) لماذا قال ادفع بالتي هي أحسن وفي آية أخرى يقول (وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) وفي آية أخرى في سورة فصلت يقول (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) فصلت) لم يذكر حتى السيئة، نقف على هذه الاختلافات.
د. المستغانمي: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) موقع الآية مع ما قبلها هو قال علّمه أن يدعو الله تعالى قال مهما فعلوا فعليك أن تصفح عنهم ادفع بالتي هي أحسن، الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالدعوة بالدعاء بالتعليم ثم أن يعاملهم معاملة حسنة. عندما وصف المؤمنين قال (وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) واحد فعل معك سيئة افعل معه حسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من هذا ومطالَب إذا فعل معه أناس سيئة أن يدفع بالتي هي أحسن، أحسن من الحسنة فهذا اسم تفضيل، فقال العلماء الأسلوب فيه مبالغة، أقول ادفع بالحسنة وادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن أفضل، هذا رسول الله فعلوا معه ما فعلوا وآذوه فقال له (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أما عندما وصف المؤمنين هذا هو المطلوب قال (وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) شيء مقابل شيء حسنة مقابل سيئة. ثم قال (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) بينما في فصلت قال (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) لم يذكر السيئة لأنه ورد ذكرها قبل قليل (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) فصلت) لم يكرر السيئة لأنه كل ما ذُكر وعُلم لا داعي لتكراره أما هنا لم تذكر السيئة فقال قال (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) ثم قال له (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ) وصفوك بأنك شاعر، ساحر، مجنون،
المقدم: كأنه يقول له لا عليك من هذه الأوصاف كلها ادفع بالتي هي أحسن
د. المستغانمي: نحن أعلم بما يصفون، نحن نجازيهم على ما يصفونك به.
المقدم: في سورة فصلت أعطاه النتيجة (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) فصلت)
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هل يستطيع الشيطان أن يضرّ النبي أو أن يوسوس للنبي؟ لماذا يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من همزات الشياطين وهو معصوم؟
د. المستغانمي: هذا كلام جميع أهل السنة والجماعة والإمام القاضي عياض في الشفا يقول أجمعت الأمة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم أن تأتيه الخواطر الشيطانية ومعصوم في جسمه فالشيطان لم يصيبه في جسده
المقدم: وإن كان سُحِر صلى الله عليه وسلم؟
د. المستغانمي: كل شيء بقضاء الله وقدره لكن الله غلّبه على الشيطان يوم صفّده ثم أطلق سراحه عندما تذكر دعاء سيدنا سليمان عليه السلام. هو يعلّمه ويعلم أمته من خلفه وخوطبت الأمة بشخص نبيّها، كل حديث موجه للرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نقتدي به حتى لما يقول له (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾ الإسراء) علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن تقتدي بالرسول وأن تمارس وأن تداوم على صلاة الليل فهذا شيء جميل. (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾) يسأله أن يثبته الله على العصمة من الشياطين. ثانيًا قريش والمشركون يسيؤون إليه ويفعلون المستحيل لإحباط دينه وللقضاء عليه، هل هذا من السهل أن يدفع بالتي هي أحسن؟! يأتي الشيطان يقول له هذا عليك أن تجازيهم بمثل
المقدم: كما فعل موسى مع الخضر قال كيف نطلب من القرية الماء والأكل ولم يطعمونا ثم نبني لهم الجدار؟! هم عاملونا بالسيئة كيف نعاملهم بالحسنة؟
د. المستغانمي: بشر! بعض المفسرين يقول: المطلوب منه عظيم (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) قد يأتي خاطر ولو خاطر فقال له (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾) الشياطين لن تقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله واستخلصه. هذا أمر (وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ) أن يحضروا معي، من الحضور، وبعض العلماء قال أن يحضرون يوم الممات “اللهم ثبتنا عند الممات: والعياذ بالله عندما يأتي ملك الموت وتأتي الملائكة التي تقبض الإنسان يأتي الشياطين يقولون قل كذا وكذا (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) [إبراهيم: 27] عند الاحتضار
المقدم: والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
د. المستغانمي: (وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ) دعاء عام علّمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. سألتني يوما ما إبليس لعله من الإبلاس صحيح هذا الكلام. وأنا بحثت هذه القضية فوجدت أن كلمة إبليس كلمة أعجمية ليست عربية ابن عباس يقول: ومنه الإبلاس اشتق العرب من إبليس أبلس بمعنى يئس من رحمة الله والعرب تشتق من لغتها، نقول فلان تفرعن أي فعل فعل فرعون أو تشيطن فعل فعل الشيطان أو تمرّد فعل فعل المَرَدَة. إبليس هو اسم أعجمي يئس من رحمة الله وأيقن أنه هالك فجاء منه كلمة أبلس. هنا لم يقل له أعوذ بك من همزات إبليس وإنما قال من الشيطان. دائمًا الله يستعمل الشيطان في الوسوسة في كل القرآن وإبليس في الكبر والاستكبار والإباء، إبليس يذكر دائمًا في قصة آدم (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) البقرة) في جميع المواطن (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) [الكهف: 50] كلمة إبليس استعملت في القرآن لما يأبى ويرفض ويكفر ويستكبر أما الشيطان ذكرت سبعين مرة كلها في الإغواء (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) [البقرة: 168] (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ) [البقرة: 268] (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 43] بحكم كونه شيطانًا يوسوس وبحكم كونه إبليس يرفض ويأبى. فقال له (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾)
المقدم: (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾) (هو قائلها) من القائل؟
د. المستغانمي: الإنسان، عندما يأتيه ملك الموت يخاطب ربه بالتعظيم ارجعون أنتم يا رب لأنه أيقن
المقدم: (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا) الله سبحانه وتعالى يرد عليه (كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا)
د. المستغانمي: هو سيقولها، الآن مهما قرأ القرآ واستمع لكن عندما يأتيه ملك الموت سيقولها (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا) الكل سيندم المؤمن سيندم يقول ليتني استكثرت من العمل الصالح والإيمان والكافر سيندم لكن درجات..
المقدم: (ارجعون) من المخاطَب؟
د. المستغانمي: المخاطَب هو الله سبحانه وتعالى، هو عندما تأتيه سكرات الموت يدرك (لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ ق) يعظّم الله، لماذا لم تكن تعظم الله في الدنيا عندما كان مطلوبا منك ذلك؟! (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا) لم يقل الأعمال الصالحة ولكن صالحًا واحدًا، التنكير يفيد التقليل. وبعض العلماء علّق فقال: ما قال لعلي أؤمن. أيهما أفضل أن يؤمن بالله أو أن يعمل صالحًا؟ الإيمان أولى ولكن عند سكرات الموت أدرك كل شيء وصحح اعتقاده وآمن لكن لات حين مناص! كأنه يقول لعلعي أعود إلى الدنيا فأؤمن ويحسن إيماني وأعمل صالحا فيما تركت، كلا، إنها كلمة سيقولها حتمًا ولكن حين لا ينفع الندم.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) فيها دلالة على أن الموت هو الذي يأتي الإنسان وليس الإنسان يختار الموت.
د. المستغانمي: دائمًا (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) أحدهم مفعول به والموت فاعل وهنا تقديم وتأخير لم يقل حتى إذا جاء الموت أحدهم، القرآن دائما يعكس لأن الإنسان يحب تأخير الموت، لا أحد مهما كان صالحا يحب تأخير الموت، يقال في الآثار أن ملك الموت لما جاء ليقبض روح إبراهيم الخليل ساله أقابضًا أم زائرًا فقال قابضًا فقال له اسأل الله هل رأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فجاءه الجواب من الله: وهل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟!. فالبشر يحب الخلود والنملة عندما رأت جيوش سليمان قالت (حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ النمل) فحب الخلود غريزة، دائما يؤخر الموت التقديم والتأخير في القرآن دقيق جدًا.
المقدم: إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما حانت ساعته قال: بل الرفيق الأعلى. حتى من الناحية اللغوية حينما يقال “مات زيد” صحيح زيد من الناحية اللغوية هو الفاعل لكن من الناحية المعنوية هو الذي وقع عليه الموت.
المقدم: يقول سبحانه وتعالى (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾) في سورة عبس يقول الله سبحانه وتعالى (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ عبس) الإنسان يعرف أمه ويعرف أباه ويعرف أخاه فكيف يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذن كيف يعرفون بعضهم بعضا؟
د. المستغانمي: هذا سؤال طرحه المفسرون من قبل. النفي هنا ليس معنى فلا أنساب بدليل الآية التي ذكرت (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾) يعرف أمه يعرف أباه ويعرف أخاه وأقاربه. نحن الآن نعيش في مجتمعات وسمي الإنسان لأنه يأنس، ما جدوى الأنساب في الدنيا؟
المقدم: قالها الله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) [الحجرات:13]
د. المستغانمي: لنتعارف ولنتعاون ونتراحم صلة الرحم، علاقتي بعائلتي بأمي بأختي بزوجتي، النسب هذا يجعلك تتراحم أنت تتراحم مع والديك، تتعاطف، هذه فائدة وزبدة الأنساب، إوإلا ذا كانت عائلتك لا تفيدك فما جدواها؟!
المقدم: (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) [الشورى: 23]
د. المستغانمي: المقصد أن الله جعلنا شعوبا وقبائل وأنسابًا لنتعارف ونتراحم ونتواصى وأمر بصلة الرحم وهذا كله لا يوجد يوم القيامة أنت ترى أمك لكن لا تفيدك أمك. الإمام قتادة إمام تابعيّ جليل وأنا أقرأ في التفسير – يقول: من أصعب وأشقّ المواقف أن يرى الإنسان واحدا من عائلته يوم القيامة. نحن في الدنيا نتراكض ونشتاق أن نرى أهلنا، في الآخرة تفضل أن لا ترى والديك لأنك تخشى أن تُطالَب لأنك فرّ”ت يومًأ ما فيقال لك أنا بطني كان وعاء لك وثديي سقاء لك أريد منك حسنة، الأب يقول أنا الذي فعلت وفعلت (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ عبس) ترى زوجتك تتمنى أن لا تراها لا كُرها لها إنما تخشى أن تطالبك ببعض الحقوق فالموقف صعب! لذلك قال (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) ثمة آية أخرى يقول (يتساءلون) قال العلماء يوم القيامة خمسون ألف سنة، هناك مواقف يسأل بعضهم بعضا ويقولون ما الذي وقع؟ (فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ المدثر) وهناك مواقف لا سؤال. صحيح نحن لا نتراحم يوم القيامة (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ)
المقدم: كيف إذن يشفع الشهيد وحافظ القرآن كذلك يلبس والديه تاجا
د. المستغانمي: هذا عندما يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بتفضل الله سبحانه وتعالى. الآية في سورة عبس (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾) أتى من الأبعد للأقرب، أقرب شيء إليك ولدك، ما السبب يا رب؟ (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ عبس) والشأن هو الشيء العظيم. صحيح أننا لا نتارحم لكن هناك آية أخرى في سورة المعارج (يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ المعارج) يريد أن ينجي نفسه لكن انظر إلى عظمة القرآن هنا لم يذكر الأم والأب لم يقل (أمه وأبيه) لأن الله سبحانه وتعالى حفظ على آصرة البنوة والأمومة والأبوة حتى في الآخرة، صحيح ليس هناك تراحم لكن لو قيل للمجرم العاتي نلقيك في النار أو نلقي أمك لا يضحي بأمه، لا ينبغي لمجرم أن يفتدي نفسه بأمه يلقيها في النار، هذا شيء عجيب! والله ما أحوجنا وما أحوج العاقّين إذا ما قرأوا هذه الآية العجيبة أن يعودوا لآبائهم وأمهاتهم حتى يوم القيامة وتريد أن تنجي نفسه الله لم يذكر الأم والأب.
المقدم: الله سبحانه وتعالى يقول (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾) هنا ربما يقول قائل الذي نعرفه أن الله سبحانه وتعالى يُدخل المؤمنين الجنة ومن فاقت سيئاتهم حسناتهم يدخلهم الله سبحانه وتعالى النار فيطهّرهم ثم يدخلهم الجنة كيف يقال (فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) كأنهم لن يخرجوا من جهنم؟!
د. المستغانمي: لأن الحديث هنا عن فريق المؤمنين وعن فريق الكافرين المشركين الذين لا يعتقدون إلهية الله ويجعلون معه شركاء يعبدونهم
المقدم: حتى لا يلتبس علينا حديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة
د. المستغانمي: الحديث في (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾) حديث يقيني عن أهل الشرك والكفرالذين لم قالوا لا إله إلا الله مرة، أما من قالها ولو مرة كما يقول العلماء مصححًا بها اعتقاده يعذّب حسب ما اقترفت يداه من كبائر ثم يخرجون ويسمون الجهنميين ذاقوا من عذاب جهنم ثم يغمسون في النهر يطهّرهم كما ورد في الحديث ثم يدخلهم الله الجنة، هؤلاء أهل الإيمان وعصوا بينما الآيات الحديث عن الشرك. يحضرني حديث البطاقة رواه الإمام الحاكم وصححه: يؤتى تنشر له تسع وتسعون سجلا من الخطايا يسأله الله هل لك من حسنة اليوم فيقول لا فتظهر بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله فترجح لبطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء في السموات والأرض. من كان مؤمنًا موحدًا وارتكب ذنوبا أن يعاقب عليها، نحن ندعو إلى الإيمان والعمل الصالح
المقدم: نحن لا ندعو الناس ليتقاعسوا ويتهاونوا. لكن هذه دعوة واصحة من القرآن بأنه فلنبتعد عن التيئيس من رحمة الله أو الحكم على الناس أنت مشرك أنت كافر أو منافق أو ستدخل النار أو مأواك جهنم فقد باء بها أحدهما
د. المستغانمي: الاعتقاد الصحيح ينجي صاحبه ولو بعد حين، الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح يدخلك الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى
المقدم: ما معنى اللفح والكالح؟
د. المستغانمي: اللفح هو شدة الإحراق (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ) والعياذ بالله! والتعبير بالوجه هنا لأنه كما يقولون نحن نحافظ على وجوهنا أكثر لو رأيت شيئا يريد أن يصيبك أنت تحمي وجهك بالدرجة الأولى والإنسان يعرف من وجهه. فلذلك تلفح وجوههم وتلفح ظهورهم من باب أولى فاللفح هو شدة الإحراق. (وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ) الكلوح هو تقلص الشفتين عن الأسنان يعني يحترق الوجه وتحترق الجلود فتتقلص الشفتان وتظهر الأسنان فيكون منظر الكافر بشعًا فظيعًا والعياذ بالله.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى (أَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾) ما معنى اخسأوا فيها ولا تكلمون؟
د. المستغانمي: نقلنا البيان القرآني لأن نعيش في جو الآخرة، مشهد إيماني عجيب انتقلنا كأننا في الآخرة (أَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ) توبيخ وتقريع و(فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) اعتذروا، سؤال استنكاري يعاتبهم ويقرّعهم (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا) وفي قرآءة شقاوتنا يعتذرون شرّ اعتذار وهذا ليس بعذر! (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا) كان المفترض في الدنيا يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هم الآن في الآخرة ولات حين مناص (فَإِنْ عُدْنَا) إلى الكفر إلى الشرك فإنا ظالمون. (قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا) اخسأوا بمعنى ذُلّوا، خسأ تقول للكلب اخسأ، تقريع وزجر لهم بلفظ يستعمل مع طائفة الكلاب (قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) لأنه أغاظهم كثيرًا (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي) لماذا لم تكونوا منهم؟! بل كنتم منهم تستهزئون! اختار لهم الجواب من رحاب السورة، في سورة المؤمنين قال (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي) في سور أخرى طلبوا الخروج فأجابهم من رحاب السورة، في سورة فاطر (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾) يصطرخون وليس يصرخون (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا) قال لهم (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ) ستين سنة سبعين سنة مائة سنة لم تفعل بها شيئا، الآن تقول فإن عدنا؟! قال في فاطر (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ) لأن فيها حديث عن خلق الإنسان ثم قال (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ) [فاطر: 11] فالجواب من جنس السورة.
في رحاب سورة – د. محمد صافي المستغانمي
قناة الشارقة – 1437 هـ – تقديم الإعلامي محمد خلف
في رحاب سورة المؤمنون – 8
تفريغ موقع إسلاميات حصريًا
تتمة سورة المؤمنين
المقدم: توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾) ما المراد من ذكر العباد ولم يسمهم بالمؤمنين من بعد ذكر مناجاة الكافرين في إخراجهم من جهنم؟
د. المستغانمي: ذكرنا في الحلقة الماضية أن المشركين والذين يدخلون النار يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى ويصرخون ويصطرخون ولكن الإجابات جاءت في سور القرآن الكريم متنوعة حسب سياق كل سورة، في سورة المؤمنين قال (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا) فإن عدنا إلى المعاصي وإلى الذنوب وإلى ما اقترفنا (فَإِنَّا ظَالِمُونَ) فأجابهم الله جلّ جلاله (قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا) وشرحنا كلمة اخسأوا – تقال لطائفة الكلاب- اخسأوا انزجروا ولا تكلمون. بعد ذلك قال –ليس من باب التعليل – أراد إغاظتهم، أسلوب إغاظة (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا) أنتم للأسف لم تكونوا منهم وكنتم منهم تضحكون وكنتم بهم تستهزئون زيادة في التقريع وزيادة في تلهيفهم وتحسيرهم يتحسرون أكثر ويتلهفون: كان فريق من المؤمنين ولم نكن نحن معهم! بالعكس كنتم منهم تسخرون وسخريتكم بهم أدّت بهم إلى الجنة صبروا وهناك آية تقول (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا) صبروا على سخريتكم فكانت سخريتكم مدعاة ومساعدة لهم وسببًا لدخولهم الجنة. يستوقفني (إنه) لم يقل إن فريق من عبادي، (إنه) هذه الهاء تسمى ضمير الشأن والتفخيم والتعظيم، الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يفخّم يقول (إنه) لو قيل: اخسأوا فيها ولا تكلمون إن فريقا من عبادي، الأسلوب صحيح ولكنه قال (إنه) هذا أسلوب التعظيم، ضمير الشأن يفيد التعظيم. في القرآن (يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) النمل) لما تأتي الهاء ضمير يفيد التعظيم والشأن، يعني الله سبحانه وتعالى ينوّه بعباده المؤمنين. في سورة فاطر (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ) ولما رد عليهم الله سبحانه وتعالى قال (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ) وذكرنا سابقًا لماذا قال يعمّركم هنا لأن سورة فاطر تتحدث عن تعمير الإنسان (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ) [فاطر: 11]. في سورة الزخرف قال (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) [الزخرف: 77] القرآن كل مرة يأخذ قولهم من زاوية، قالوا (يا مالك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) من شدة العذاب الموت أهون فقال (قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ) لماذا اختار القرآن هنا قولهم (يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا)؟ لأن هذه السورة تقول (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ الزخرف)
المقدم: وهذا يتنافى مع الخلود
د. المستغانمي: هم يريدون أن يبطلوا هذا
المقدم: فكأنهم يطلبون شيئا يتنافى مع ما تدعو إليه السورة
د. المستغانمي: نعم، (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ الزخرف) لا يفتّر عنهم أي لا ينقطع (مبلسون) آيسون من رحمة الله فدعوا بالعكس فقالوا (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) (قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ) ثم قال (لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾) وكل السورة مبنية على الحق (بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٢٩﴾) وكراهية المشركين للحق فلذلك يتناسب.
المقدم: (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾) ما علاقة هذه الآية بالمحور؟
د. المستغانمي: قلنا (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي) ونحن في سورة المؤمنين
المقدم: لم يقل لم تكونوا من المؤمنين لأن السورة سورة المؤمنين ويفهم منها هذا الكلام.
د. المستغانمي: (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا) سِخريا مصدر تُقرأ سِخريا وسُخريا وكلاهما حول الهُزء، من سخر، سخِر منه أي هزئ منه وليس من السُخرة العمل بدون مقابل. (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا) أصل الكلام فاتخذتموهم مسخورًا بهم مستهزأ بهم استعمل المصدر بدل المفعول به للمبالغة (وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ) والجواب (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾) كان يمكن أن يقال إني جزيتهم اليوم أنهم هم الفائزون وإنما قال (بِمَا صَبَرُوا) وهذا في البلاغة يسمى الادماج وهو أن يدخل معنى في معنى، لو قيل في غير القرآن: إني جزيتهم اليوم أنهم هم الفائزون كلام صحيح لكن قال (بِمَا صَبَرُوا) على استهزائكم وسخريتكم فزاد من إغاظتهم أنهم هم الفائزون.
المقدم: هم طلبوا أمرًا ورد الله سبحانه وتعالى عليهم بعدم تحقيق ما يطلبون وكذلك قرّعهم بأنه أنا جزيت من كنتم تستهزئون وتسخرون وتضحكون منهم بأني جزيتهم بما صبروا من سخريتكم زيادة في التقريع. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ويكمل السورة (قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾) ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟
د. المستغانمي: ما زلنا في نفس السياق الله سبحانه وتعالى يتكلم بعدما قرّعهم ولهّفهم وجعلهم يتحسرون وأنتم تطلبون الخروج كم لبثتم في الأرض؟ أم تطلبون واحد مكّنه الله في الأرض يعيش خمسين ستين مائة سنة لم يصلي لله يوما ولم يركع كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟! بعض العلماء يقولون هذا يحدث بعد إدخالهم جهنم، البعض الآخر يقول لا، هذا السؤال عندما يفيقون ويبعثهم من القبور كأن هذه الاية جواب فإذا نفخ في الصور (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾) قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. لما أفاقوا اندهشوا، كم لبثتم؟!
المقدم: كأن كل ما بينها جملة اعتراضية
د. المستغانمي: جملة اعتراضية عن طريق التفريع عن طريق الفاء (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ). الإنسان الذي كان نائمًا يعرف كم نام خمس ساعات أو ست ساعات فما بالك بإنسان مات قرونًا! هم يظنوا أن الدنيا قائمة على حسابهم وهم لا يستطيعون ضبطها، بعض المفسرين يقول: فاسأل الملائكة وبعضهم يقول اسأل من في الدنيا ظنًّا منهم أن الناس ما زالت والحياة مستمرة وهم فقط الذين أحياهم الله. هنا السؤال يبين لهم خطأهم وظنّهم الخطأ.
المقدم: (قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾) ما تفسير الآية؟
د. المستغانمي: (إِنْ لَبِثْتُمْ) هم ما ضبطوا المدة الزمنية قال (فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ) قال لهم (إِنْ لَبِثْتُمْ) اي ما لبثم إلا قليلا (إن) هنا نافية، لو أنكم كنتم تعلمون لعلمتم أنكم لبثم مدة قصيرة، هنا جواب الشرط محذوف. قال (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا) أي إلا زمنّا مهما كان قليل (لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) جواب الشرط هنا محذوف كأنه يقول: لو أنكم كنتم تعلمون لعلمتم واستيقنتم أنكم لبثتم قليلًا وهذا الزمن بسيط جدًا في عدّ الله سبحانه وتعالى.
المقدم: يقول الله سبحانه وتعالى (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾)
د. المستغانمي: هذه خلاصة السورة وكما سماها أحد المفسرين روعة المقطع. عندنا في البداية براعة المطلع وفي النهاية روعة المقطع (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)
المقدم: لماذا قال الكريم؟ وفي سورة أخرى قال (العرش العظيم)
د. المستغانمي: قالها في هذه السورة (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾) وهنا قال (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) هو عرش عظيم وهو عرش كريم، الكريم من أي جنس هو ما نال أشرف صفات الجنس، عندما نقول جنس الإنسان أكرمهم (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات: 13] ما نال الصفات الحسنة من جنس الإنسان. عندما نتكلم عن الحجارة ما أنواع الحجارة؟ نقول الحجارة الركامية والبركانية وعندنا الأحجار الكريمة أكرم أنواع الحجارة التي نالت الحسن والجمال وهنا وصف العرش بصفة الحسن، أجمل شيء
المقدم: حتى كفار قريش حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم.
د. المستغانمي: هنا قرآءتان (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) على قطع الكريم صفة لله لكن وردت (رب العرش الكريمُ) هو الكريم على القطع لكن القرآءة المستفيضة صفة العرش (الكريم).
المقدم: يذكرني هذا بآية سورة البروج (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾)
د. المستغانمي: هي (ذو العرشِ المجيدُ) وثمّة قرآءة صحيحة (ذو العرش المجيدِ) فيجوز وصف الله جلّ جلاله بأنه المجيد ووصف عرشه بأنه مجيد. لماذا في سورة البروج قال (ذو العرش المجيد)؟ لأنه ورد فيها (بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾ ) لما وصف القرآن بأنه نال صفة المجد (مجيد) فقال (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾) وهو الله أو ذو العرشِ المجيدِ. وهنا في نهاية سورة المؤمنون (رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) وعلّم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يدعو (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ). أحد الأعراب سمع قارئًا يقرأ (ما غرك بربك الكريم)؟ الأعرابي على البديهة قال: أقول له: غرّني كرمك! كرم الله واسع. هنا في سياق الدعاء الكريم أولى وفي سياق الاستدلال على الوحدانية والعظمة العظمة أولى (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾) لأنه يثبت عظمة الله فأتى بصفة العرش العظيم.
المقدم: (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ) لمن يدعو (به) تعود على من؟
د. المستغانمي: لا برهان له بما دعا مع الله إلهًا آخر، من يشرك به آلهة وليست له أدلة كما اسلفنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن الدليل العقلي (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ) الله دلنا في القرآن على وحدانيته هل يمكنكم أنتم أيها المشركون أن تدللوا على صحة عبادتكم ولآلهتكم المزعومة؟! لا أدلة لديكم، إذن ما الجواب؟ (فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ) لو شاء الله تعالى لقال: فعذابه جهنم، فعذابه سقر، قال (فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ) جرمه كبير وحسابه لا يعلمه إلا الله!
المقدم: ووضح بعذ ذلك (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ)
د. المستغانمي: العبارة تهوّل (فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ) هذا الأمر حسابه على الله.
المقدم: حتى لا يهم البعض ويقول فإنما حسابه على الله ربما يكون حسابه هينا أو ربما يعفو الله عنه فرد الله سبحانه وتعالى (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ)
د. المستغانمي: أبدًا. كما بدأت (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾) ختمت (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ). (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) هذه نهاية المقطع العجيبة وتعليم للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحين، هو تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم لنا. أعطي نكتة للمشاهد الكريم: لنا في الأنبياء قدوة كما أن لرسولنا صلى الله عليه وسلم في الأنبياء قدوة (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)[الأنعام: 90] الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فبهداهم اقتده أي اقتدي. كيف دعا الأنبياء في القرآن الكريم؟ نوح علمه الله سبحانه وتعالى قال (وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ (29) المؤمنون) لاحظ الثناء على الله في نهاية الدعاء (وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ)، سيدنا شعيب عليه السلام مع قومه مدين (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) [الأعراف: 89] زكريا عليه السلام قال (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) الأنبياء) والأنبياء خير من يعرفون الدعاء وأولهم نبينا عليه الصلاة والسلام.
المقدم: ولكن وردت كذلك (وأنت أرحم الراحمين)
د. المستغانمي: هذه لأيوب عليه السلام قال (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) الأنبياء) في سورة الأنبياء، سياق الضر والألم يقتضي الرحمة فهو يستدر الرحمة بأرحم الراحمين، دعاه بالأرحمية، لو قال وأنت خير الراحمين صحيحة لكن أرحم الراحمين أبلغ. أما النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالرحمة الشاملة (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) تشمل كل شيء. المرض أدّى إلى أرحم الراحمين. معظم الأنبياء موسى عليه السلام لما أخطأ بنو إسرائيل معه قال (أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ) [الأعراف: 155] لأنهم أذنبوا فطلب لهم المغفرة علينا أن نقتدي بالأنبياء وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء.
إجابة على أسئلة المشاهدين:
تصحيح من سمر الأرناؤوط: ذكرتم في حلقة ماضية عن كلمة ملكوت في القرآن وانها وردت في آية سورة المؤمنون وسورة الانعام (وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض) ولكنها وردت أيضاً في موضعين آخرين: في سورة يس (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون) وفي سورة الأعراف (أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء).
سؤال من الأخ ماهر توفيق: (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾) في سورة المؤمنون، هذه الآية تنفي الخروج من النار وتلغي الشفاعة.
د. المستغانمي: الخلود في النار المقصود به خلود الكافرين المشركين الذين لا يعتقدون اعتقادا جازما أن الله هو إلههم الأوحد وأنه هو الواحد الصمد، أي الذي ليس اعتقاده صحيحا هذا لا ينجو من النار أما الأحاديث التي وردت في الشفاعة ففي عصاة المؤمنين كانوا يؤمنون بالله ويحّجون لكن غلبت بعض المعاصي عليهم فيذوقون من العذاب ما يكفر عنهم السيئات وتدركهم رحمة الله وتدركهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالآية (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) تحمل على الكافرين المشركين الذين ما ارتدعوا من شركهم وما عادوا إلى التوحيد.
المقدم: وهذا لا ينطبق على من كان في قلبه التوحيد.
سؤال ماء العينين دحمود من موريتانيا: (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾) (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾) لماذا تم ذكر الصلاة مرتين؟
د. المستغانمي: ذكرنا ذلك في بداية سورة المؤمنين وفي شرحها وتجلية بعض معالمها، في الحقيقة من أخص خصائص المؤمنين أنهم يؤدون الصلاة، الآية الأولى تحدثت عن روح الصلاة (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾) الخشوع هو روح الصلاة وفي آخر آية (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾) كأن هاتين الصفتين تحيطان بالمؤمن فلا تتركانه يخطئ، الذي يحافظ على الخشوع في الصلاة والذي يحافظ على الصلوات في أوقاتها بأركانها وفرائضها وسننها يكون مغمورًا أو في وسط سياج يحميه. ولذلك كررت، وقد نقول ثمة من يخشع في الصلاة ولكن لا يحافظ عليها في أوقاتها أو في المساجد أو في الجماعات أو يقصر في أوقاتها ينسى يغفل وقد يتعب في العمل ولكن إذا صلّى خشع، وثمة العكس من يحافظ عليها دائمًا لكنه لا يكاد يخشع فذكرها لتكون بداية عمل المسلم ونهاية عمل المسلم وهذا شيء عظيم جدًا كأن المسلم يمسكه طرفان كما في سورة الإسراء ذكر كثيرا من الصفات وذكر التوحيد ثم ذكر التوحيد، في سورة الإسراء ذكر التوحيد وختم بالتوحيد وذكر صفات المؤمنين.
سؤال من الأخت آمال من جدة: لفت نظري في سورة القصص تكرار كلمة الظالمون سبع مرات في سرد قصة موسى فقط فلماذا هذا التكرار؟ وكذلك (لما) (وفلما) كثيرا ولم يقل (حين) فما الفرق بينهما؟. وفي سورة القصص والنمل وطه يقول موسى عليه السلام (امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا) لم يقل رأيت نارًا مع العلم أن رؤية النار لا تؤنس وإنما تخيف فما الفرق بين رأى وآنس وما الفرق بين فلما (فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ) و(فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ النمل) فما الفرق بين أتى وجاء؟
د. المستغانمي: سؤالها مركب من عدد من الأسئلة. في سؤالها حول كلمة الظالمون التي وجدتها متكررة هي فعلًا أيقونة من ايقونات السورة وما جاءت سورة القصص إلا لتقصص أظافر الظالمين وعلى رأسهم فرعون (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ) [القصص: 8]. الفرق بين حين ولمّا، (حين) حرف وقد تكون ظرفية و(لمّا) أيضًا تفيد الظرف لكن لها خصوصية في اللغة العربية. (حين) الظرفية (هي ظرف زمن مبهم) في الأزمنة مثل (حيث) في الأمكنة تحتاج إلى إيضاح يأتي ما بعدها يوضّحها (ولات حين مناص) لات الحينُ حين مناص. وقد يأتي لفظ (حين) متصرّفًا يتقبل كل الحركات، مُعربًا (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿١﴾ الإنسان) فاعل، (ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴿٣٥﴾ يوسف) (حين) تفيد الزمن ووردت في القرآن (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ) [البقرة: 177] ظرفية (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِين الْوَصِيَّةِ) [المائدة: 106] (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا) [القصص: 15] كلها تفيد الظرفية. (لما) في اللغة العربية يسميها النحاة حرف وجود لوجود (درسنا أن لو حرف امتناع لامتناع ولولا حرف امتناع لوجود) والآن (لما) حرف وجود لوجود. يقع الكلام الثاني عندما يقع الأول يقع الحدث الثاني عندما يقع الحدث الأول (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ)[القصص:23] وجد الثاني عند وجود الأول، هذه تسمى (لمّا) الحينية وحرف وجود لوجود. مثال (ل فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ القصص) وجد الحدث الثاني عند وجود الأول، هنا (حين) لا تصلح. (لما) تتطلب جملتين وتقتضي حدثين لا يحدث الثاني إلا عند حدوث الأول، مثال في سورة القصص (فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا) (فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾). الغالب أيضًا في القرآن وفي اللغة أن الحدث الثاني يأتي بـ(إذا الفجائية) مع (لما) (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً)[النساء: 77] (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (135) الأعراف) (فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) [يونس: 23] (فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ (12) الأنبياء) إذن هذه (لما) حرف وجود لوجود أما (حين) ظرف تستعمل ظرفية في زمان معين.
المقدم: (امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا) لم يقل إني رأيت نارا مع أن النار لا يُستأنس بها
د. المستغانمي: آنس في العربية تعني أبصر وأحس بالشيء لأول وهلة، نقول آنسه في أول الأمر، فهو كان يمشي في شدة الظلام المغطش فآنس، في أول الإبصار لأنه استأنس بها، هي تقول النار تخيف صحيح، لكنه هو كان في ظلمة وفي ليل بارد والنار هنا كانت له نعمة لم تكن مخيفة. (آنس) في اللغة العربية، الإيناس هو الاستيضاح استوضح أمرًا وأبصره وهو الإبصار البيّن الذي لا شبهة فيه وموسى كان في شدة الظلام فآنس وأبصر يعني رأى ما يؤنسه، فلذلك عبّر القرآن بـ(آنس). يوجد في القرآن رأى ونظر وأبصر ولكن هنا استأنس بها فكانت أدق في المجال. عندنا آنس، عندنا أحسّ وعندنا شعر وكلها متقاربة، آنس استأنس بها، أحسّ أدركها بالحواس (فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا) أدركوا بحواسّهم، شعر أدركه بالشعور وهي من الشِعار وهو اللباس الخفيف الرقيق الذي يُلبس. موسى عليه السلام لما رأى النار فعلًا استأنس بها فمن معاني آنس استبصر مع إيناس وهي أدق في بابها.
المقدم: ما الفرق بين أتى وجاء؟
د. المستغانمي: الإتيان يكون بسهولة ومنه الأتيّ النهر الجاري الذي يأتي بسهولة وجاء فيها قوة وشدة ولذلك في القرآن لم يأت (جاء) إلا في الماضي لم يأتي (يجيء) لأنها شديدة، الياء وبعها الهمزة فيها شدة، جاءت بصيغة (جيء وجئت وجاءهم) كلها بالماضي بينما(أتى) عندنا أتى وآتٍ ومأتي ويأتي، ائتوني، أتت بمعظم التصرفات. بحصت عن المسألة ووجدت أن الدكتور فاضل السامرائي جزاه الله خيرا تحدث عن هذه الحقيقة وأنا أجيبها بما ذكره وهو لمّاح وغوّاص: الفرق بين فلما أتاها ولما جاءها في سورة النمل السياق تحدث عن مجيئه بقوة لأنه قطع على نفسه أشياء قال (إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا سَآَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ النمل) في سورة القصص قال (لعلي) لم يقطع على نفسه بمعنى استعمل الأشق (فلما جاء) ولما لم يجزم وقال (لعلي آتيكم منها) (قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) استعمل الله سبحانه وتعالى فعل (فلما أتاها)، هذا جواب د. فاضل السامرائي جزاه الله خيرا لكن المجيء فيه شدة والإتيان فيه سهولة هذا ما يقوله اللغويون.
أم تسنيم من بلجيكا: في حلقة سابقة من سورة المؤمنون تكلم الدكتور في موضوع التقديم والتأخير في فواصل الآيات مثل (بصير بما تعملون) (بما تعملون بصير) وفسّر لنا جزاه الله خيرا أن الله سبحانه وتعالى يُسبق العمل على صفته العليا إذا كان السياق في العمل ويقدم اسمه إذا كان الكلام عن ذاته وصفاته. وهناك أيضًا عندما تكون الأمور قلبية أو سريّة للعباد يقدّم الله سبحانه وتعالى صفاته على العمل كما في سورة البقرة (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ البقرة) وكقوله في سورة آل عمران (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾ آل عمران)
د. المستغانمي: نشكرها على هذا التوضيح وصحيح قد يرد الحديث عن صفات الله عندما يكون الأمر متعلقًا بالأمور القلبية التي لا يعلمها إلا الله. القرآن لا تنتهي عجائبه!
نبيل من بريطانيا: ما الفرق بين الفعل والعمل في هاتين الآيتين (فلا تبتئس بما كانوا يعملون) (فلا تبتئس بما كان يفعلون)؟ وما الفارق بين جنات وجنة؟ وما الفارق بين الذنوب والخطايا؟
د. المستغانمي: كل أسئلته جيدة وهي من المتشابه اللفظي، لما الله سبحانه وتعالى يقول (وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ هود) هذه وردت في سياق سورة هود والحديث موجه إلى نوح عليه السلام فقال له (فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) بينما يوسف عليه السلام وفي سورة يوسف قال لأخيه الصغير بنيامين كما ورد في التاريخ والسير (وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ يوسف) وحتى نفرّق بين يفعلون ويعملون جئتك ببحث بسيط حتى نفسّر علميًا الفرق بين اللفظين: في اللغة العربية ثمة فرق كبير بين العمل والفعل، الفعل واسع أعمّ والعمل أخص ونحن نتكلم في الاستعمال القرآني. الفعل هو التأثير في شيء فأنت تفعله والعمل أيضًا لكن في القرآن جاء استعماله خاصًا والصنع أخصّ أيضًا.
المقدم: الفعل عام والعمل أخصّ والصنع أخصّ من العمل
د. المستغانمي: وكلها مستعملة في القرآن (بما كانوا يفعلون) (بما كانوا يصنعون) (بما كانوا يعملون) لما قال (بما كانوا يفعلون) الفعل في القرآن ارتبط بشكل عام (افعلوا الخير) وارتبط أيضًا من بين استعمالاته بأخذ الله الكافرين (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ الفجر) يعني كيف أهلك هاد (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾)، فعل عندما تأتي مطلقة من بين معانيها تحقيق وعيد الله في المشركين والكافرين (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ) [إبراهيم: 45] لم يقل كيف عملنا، هنا من معانيها كيف حق وعيد الله للمشركين، لأن هذا الفعل ارتبط بفعل الله بالمشركين فأصبح كأنه يقول ألم تر كيف أهلك الله الكافرين أيضًا جاء استعماله في حق البشر في الفعلة الشنعاء الفظيعة فرعون قال (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) الشعراء) عندما نقول يا فلان فعلت كذا كأنك تشير إلى أنه فعل شيئا شنيعًا، فهذا من التناسق المرعيّ، في حق الله تعالى يجازيهم أشد الجزاء وأسوأ الجزاء والبشر أيضًا ورد في حقهم أن كلمة فعل (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ) (أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا) [الأعراف: 155] أتهلكنا بما أساء السفهاء منا، في آية أخرى (قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ) [يوسف: 89] من شرّ لكن هذا لا يعني أنها تأتي فقط في الشر، تأتي في الخير أيضًا (للزكاة فاعلون) (وافعلوا الخير). العمل جاءت أيضًا في الشر والخير لكن بما فيه امتداد (من يعمل صالحا) (عملوا الصالحات)، في القرآن كثيرًا العمل الصالح، وهناك من يعمل العمل السيء، لما ارتبط فَعَلَ بالعمل السيئ الذي كانوا يفعلونه قال في سورة هود (فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) من سوء ومن إيذاء لك يا نوح بينما يوسف عليه السلام خفف اللهجة مع إخوته لأن الله أعلمه وأوحى إليه، لما خاطب أخاه بنيامين قال (قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) قال المفسرون كأنه يلوّح إلى الصفح والعفو، أخفّ وهذه دقة القرآن فقال (فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) فلا تحزن ولا تغتم بما كانوا يعملون لو قال بما كانوا يفعلون لفهم بنيامين أن السوء في عملهم فخففها. بينما الفعل والصنع: الصنع فيه دقة دائمًا، هو عمل ولكن دقيق (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) [النمل: 88] ولما يقول (بما تصنعون) أي بما تعملون وتتقنون من عمل لذلك في سورة النور (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ النور) بما يتعمّلون ويتصنعون الله أمرنا بالغض من البصر فإذا كنت تتفعل وتتصنع فالله أعلم بك. فالصنع دائمًا يستعمل في القرآن بشيء من الإتقان. آية عجيبة في القرآن الكريم بحاجة أن نقف عندها وهي قوله تعالى في سياق واحد يقول (وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾ المائدة) (وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ) من أهل الكتاب (يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) عن من يأكلون السحت والحرام، لما تكلّم عن علمائهم وأحبارهم قال (لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾) في العامّة قال يعملون وفي الأحبار والمتخصصين قال يصنعون لأن المتخصصين من أحبار ورهبان يعلمون بوضوح ماذا أمر الله أما العامة كانوا يأكلون السحت ويأكلون الحرام عبّر عنهم (بما كانوا يعملون) دون دراية ولكن عند الأحبار قال (بما كانوا يصنعون)
المقدم: هي جنة أو جنات؟
د. المستغانمي: في سياق جنة وفي سياق جنات، لما يقول جنة لا يقصد بها مفرد ولكن جنس الجنة. في سياق يستعمل الإفراد وفي سياق يستعمل الجمع وفي سياق يستعمل الزوجية (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾ الرحمن) إذن لكل سياق ما يتناسب، في سورة الرحمن بنيت على الزوجية (جنتان) أحيانًا في سياق المبالغة يقول (جنات) لكن لما يقول جنة ويفردها فلا يقصد جنة واحدة وإنما جنس الجنة العظيم الواسع.
سمر الأرناؤوط من السعودية: ما دلالة استخدام هذه الألفاظ: الفلك، الفلك المشحون، السفينة، الجارية في قصة نوح عليه السلام؟ ورد وصف سفينة نوح في سورة الشعراء ويس والصافات بصيغة (الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) وورد وصفها بالجارية في سورة الحاقة (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾) وورد وصفها بالفلك في عدة سور منها الأعراف ويونس وهود ووردت في سورة المؤمنون في ثلاث آيات (22، 27 و28) وورد وصفها بالسفينة في سورة العنكبوت (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ) ووصفها بـ(ذات ألواح ودُسُر) في سورة القمر. فهل يمكن تحديد سياق معين لورود كل لفظ في السور التي ذكرت فيها؟
د. المستغانمي: الأصل فيها الفلك هي أتت ببعض المترادفات المتقاربات وإن كان كل مفردة في القرآن لها دلالة كما قال ابن عطية الأندلسي: لو أدرت لسان العرب لتجد لفظة هي أدق في بابها لن تجد إلا في القرآن الكريم، والشيخ الشعراوي رحمه الله يقول: اللفظة عاشقة لموضعها. الفلك هو الأصل (وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ) [هود: 38] وهي وردت كثيرًا والفلك ترتبط بالجريان (لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ) [الجاثية: 12] وحتى في الفلك الكواكب والنجوم السيارة تجري في فلك معين فكلمة الفلك مرتبطة بالجريان فهي التي وردت كثيرا في القرآن وعندما قال الفلك المشحون الفلك المملوء هذه صفة للفلك كما تحدث في سورة يس (وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) يس) المملوء. استعمل السفينة عندما أرادت الرسوّ عندما أرادت التوقف عند الجبل قال (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ العنكبوت) لأن كلمة سَفَنَ في اللغة العربية يعني رسا وتوقف. وهي موجودة في سورة يونس (فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ) [يونس: 73] لأن في السورة ورد كلمة الفلك أكثر من مرة فمحافظة على التناسق القرآن متناسق لا يتناسب أن يقول (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ) [هود: 38] ثم وأنجيناه ومن معه في السفينة، عندما ذكر في سورة يونس الفلك (حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ) [يونس: 22] قال (فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) الشعراء) لما جاء في سورة هود الفلك في هدة مواضع راعاها الله سبحانه وتعالى ولما جاء في سورة العنكبوت قال (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ) لأن السفينة من شأنها أن ترسو. سمّاها (الجارية) في سورة الحاقة (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾) في هذه السورة فيها كثير من الكلمات التي جاءت أوصافها وحذف الموصوف. الحاقة وصف ليوم القيامة (وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾) بالفِعلة الخاطئة، (في الجارية) أي في السفينة الجارية، (واهية) فهي سماء واهية، (لا تخفى منكم خافية) لا يخفى منكم فِعلة خافية، ورد فيها كثيرًا ذكر الوصف اكتفاء بالوصف وعدم ذكر الموصوف وذكر الموصوف أحيانًا (عيشة راضية) (جنة عالية) واللفظة تتناسب مع الإيقاع الصوتي (الحاقة، الجارية، القارعة، خاوية، الخاطئة، رابية، واعية…). في سورة القمر (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾) هي السفينة، دسر جمع دسار وهو المسمار الكبير المعدني، لماذا في سورة القمر؟ ما قال حملناهم على الفلك أو على الجارية، ذكرها بما سوف تكتشف به وسورة القمر فيها إعجاز عجيب اكتشف الناس علوم الفضاء وجدوا أن بالقمر شقًا عجيبًا ولما جاءت السفينة ذكرها بما سوف تكتشف به (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آَيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ القمر) أي معجزة سوف يكتشفها من يكتشفها ودلتنا الآن العلوم الحديثة في الجيولوجيا عن طريق الأقمار الصناعية اكتشفوا الدسر المعدنية الكبيرة، الدسار الواحد مترًا في جبل الجودي الذي يقع في تركيا 300 قدم سفينة كبيرة جدا تقريبا مئة متر والمعادن ظاهرة للإيماء والإشارة بأنها ستكتشف ببعض مكوناتها جاءت الكناية عن موصوف (ذا ألواح) الألواح المتحفرة التي مضت عليها القرون (ودسر) وهذا يتناسق مع ذكر القمر وانشقاق القمر.
المقدم: يتناسق مع الإعجاز ويتناسق مع الدلائل ولذلك في ذات السورة يقول الله سبحانه وتعالى (كذبوا بآياتنا) هذا شيء من الآيات
د. المستغانمي: وأنا أضيف لك دليلًا قاطعًا قوله تعالى (وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آَيَةً) لما تحدث عن فرعون في سورة يونس وأخرج جثته نكالا قال (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً) [يونس: 92] وموجود تركناه آية، عبرة. فهذا الدليل اللغوي يدل على الإعجاز العلمي.